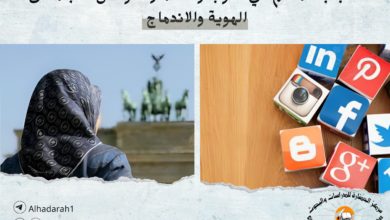العلاقات العربية -الإيرانية في ضوء الواقع الراهن: مداخل التناول واستراتيجيات التطوير

مقدمة:
عند قيام إسرائيل بهجومها العسكري على إيران في 13 يونيو 2025، قام سجال واسع على المستويين العربي والإسلامي؛ سجال بين المؤيدين للاصطفاف مع إيران -باعتبارها أولًا دولةً مُعتدى عليها ظلمًا وجورًا وعدوانًا، وباعتبارها ثانيًا دولةً إسلاميةً تتصدى لعدوانٍ صهيوني غاشم- وبين المعارضين للاصطفاف مع تلك الدولة “الشيعية” التي يرونها لا تقل عداوةً عن عداوة الكيان الصهيوني، آخذين في الاعتبار الصراع الدموي الطائفي والمذهبي بين السُنة والشيعة على مر التاريخ الإسلامي، بل على مر العقدين الماضيين على وجه الخصوص، في ضوء ما حدث بعد الغزو الأمريكي للعراق، أبريل 2003، من تعاضد شيعي مع المحتل الأمريكي، ثم ما حدث إبان الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد (2011)، من استقدام الأخير لحزب الله المدعوم من إيران إلى الأراضي السورية، وما اقترفه “الحزب” من مذابح شنعاء بحق السوريين السُنة، طيلة عقدٍ كامل.
ومن أجل تناول هذا السجال بطريقةٍ علميةٍ موسعة، يجب علينا التطرق إلى ثلاثة مداخل رئيسية، تساعدنا على فهم القضية فهمًا كليًا جامعًا شاملًا: المدخل الشرعي، المدخل التاريخي، مدخل الواقع الاستيراتيجي الراهن. ماذا يقول الشرع الإسلامي الحنيف؟ وبماذا يخبرنا التاريخ؟ وماذا يكشف الواقع الراهن؟، لنحاول عقب ذلك تقديم رؤية ومقترحات لترميم العلاقة بين الجانبين العربي والإيراني.
المدخل الأول- شرعي مفاهيمي
من الناحية الشرعية، فنحن بصدد سؤالٍ أساسي، وهو: هل يجب شرعًا الاصطفاف مع الدولة الإيرانية في هذه الحرب التي ما لبثت أن وضعت أوزارها بعد اثني عشر يومًا من اندلاعها؟ وهي الحرب التي لم تنته بعد؛ فوقف إطلاق النار الأخير -بضغطٍ أمريكي- لم ينه الحرب أو الصراع بين قوتين إقليميتين (إيران وإسرائيل)، ما زالتا تتنافسان، حتى لحظة كتابة هذه الدراسة، على ريادة الإقليم، والسيطرة عليه كليةً؛ إما من خلال مشروع إسلامي مقاوم ذي صبغةٍ صفوية شيعية، أو من خلال مشروع صهيوني إحلالي استعماري.
يركز التأصيل الشرعي، في هذه المسألة، على عدة مفاهيم مركزية؛ يُفهم ويُستنبط من خلالها تأييد شرعنا الحنيف للاصطفاف مع الدولة الإيرانية في معركتها ضد ذلك العدوان الصهيوني الغاشم الذي يُهدد المنطقة بأسرها، بل الأمة بكاملها؛ يُهدد الدين والنفس والنسل والعقل والمال التي تمثل جميعها مقاصد الشريعة الأساسية. تتمثل تلك المفاهيم المركزية في مفهومين رئيسيين؛ “الوحدة” و”التوازن”. ولنأخذ كل مفهومٍ على حدي، موضحين كيف يخدم هذا التأصيل الحُجة الموجبة بدعم إيران في حربها مع إسرائيل.
- مركزية مفهوم الوحدة
حدثنا النبي “صلى الله عليه وسلم” عن أهمية -بل الضرورة القصوى- لوحدة الصف الإسلامي، محذرًا من مخاطر التقسيم والتفريق. ولعل من أبرز الأحاديث النبوية في هذا الصدد، الحديث التالي: “دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيدي، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلم بينكم” (الراوي: الزُبير بن العوام؛ التخريج: أخرجه الترمذي).
نعم، اختلف الصحابة في عهد رسول الله “صلى الله عليه وسلم”، لكنهم لم يسلوا حينذاك السيوف على أنفسهم، عملًا بقوله عليه الصلاة والسلام: “من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تُخفِروا الله في ذمته” (الراوي: أنس بن مالك؛ التخريج: أخرجه البخاري). وهو حديث يُبين لنا أهمية الظواهر في الحكم على الأشخاص؛ فمن أظهر علامات الإسلام فهو مسلم، يلزم احترامه وحفظ حقوقه وأمانه، ويُمنع من الاعتداء عليه والتعدي على حقوقه[1].
لقد أقر النبي باختلاف الصحابة، لكنه لم يُكفر أحدًا منهم، فالاختلاف كان اختلاف رأي وفكر، لا اختلاف دين. وإذا كان الاختلاف مهددًا لتماسك ووحدة الأمة في العصور السابقة، فإن تهديد اليوم صار أضعافًا مضاعفة، ومن ثم لا يجوز شرعًا الاختلاف بأي حالٍ من الأحوال. فالأمة حاليًا في أمس الحاجة إلى الوحدة في القوة والرأي للانتصار على أعداء الأمة، المتمثلين في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وغير ذلك من قوى مساندة للعدوان. ومن ثم، فإذا كان هناك كيانات قد اتحدت دون وجود ما يوحدها، لضروراتٍ ملحة، فنحن أولى منهم، لما يربط بيننا من مشتركاتٍ عقدية وحضارية وثقافية وجغرافية وتاريخية[2].
ثم إنه لا يجوز شرعًا تكفير الشيعة، لكونهم مسلمون بشهادة جمهور علماء الأمة، وبشهادة الأزهر؛ فإن معصيتهم لا تخرجهم من الملة. صحيح أنهم مبتدعون، لكنهم ليسوا بكافرين. وإن قضية التقريب وتوحيد الصفوف، ونزع فتيل التفاخر على الخطوط لهو أمر مشهود على مر عصور تاريخ الأمة، إذ سعى دعاة التقريب إلى العمل سويًا على مستوياتٍ عدة، منها: تحريم النقاش حول أصول الدين وثوابته القطعية؛ التأكيد دومًا على مركزية الوحدة في قيم الإسلام ومبادئه؛ التصدي للخلاف بطريقةٍ علمية لا بطريقةٍ إعلامية أو خطابية (بما يؤكد على ضرورة معرفة الآخر من مصادره العلمية الموثقة القائمة على الحُجة والدليل، لا على البروباجندا والدعاية الرخيصة)؛ الكشف عن حقيقة العناصر التي تستغل الخلاف للوصول إلى مآربها الخفية (والحديث هنا عن دور الساسة في التفريق بين السنة والشيعة)؛ منع الخلاف الفكري من الوصول إلى الأرض وساحة العمل؛ نبذ الخلافات التاريخية في الوقت الذي يمتلئ فيه واقع الأمة بالتحديات والأخطار الداهمة التي توجب الوحدة. ويجب هنا التنويه عن نقطتين مهمتين، أولًا أن الفقهين (السني والشيعي) متقاربان إلى حدٍ كبير؛ ذلك لأن أصلهما واحد؛ وثانيًا، أن علم أصول الفقه كان له دور مشهود في عملية التقريب[3].
ويولي المستشار طارق البشري السُنة، باعتبارهم الأغلبية، المسؤولية عن رأب الصدع، وتقريب المسافات بين المذاهب، وحفظ وحدة الجماعة الإسلامية؛ إذ لا يجوز تحويل بأسنا ضد المعتدين إلى بأسنا كمسلمين ضد بعضنا البعض؛ كما أنه من الخطأ تعميم أقوال القلة الشيعية المستهجنة على حساب جمهور العامة[4].
وقد كان إصدار “ميثاق علماء الأمة حول طوفان الأقصى”، في 27 يونيو 2025، خير شاهد ودليل على تعزيز وحدة الصف الإسلامي تجاه قضية الأمة المركزية، وهي فلسطين؛ حيث قام مئات العلماء والفقهاء والمؤسسات الإسلامية، من أنحاء العالم، بالتأكيد على شرعية المقاومة الفلسطينية للعدوان الصهيوني، ووجوب نصرتها من قبل الحكام والمحكومين سواء. فـ “الوحدة والتصعيد الشامل واجبان شرعيان”، بينما الحياد والتخاذل خيانة وانسلاخ عن واجب الولاء. وإن معركة “الطوفان” -حسب الميثاق- من صميم جهاد الدفع المشروع في الشريعة الإسلامية، لا يُشترط إذن حاكم أو تكافؤ في القوة، بل هو فريضة وقتية (واجب الوقت)، يوجبها ضراوة العدوان وحق النصرة[5].
- مفهوم التوازن
التوازن سنة إلهية وقانون كوني، لا جدال فيه؛ إذ خلق الله التوازن في الكون والإنسان والشريعة؛ وأمرنا بالتوازن في كل شيء. ومن هذا المنطلق السُنني، توصل العلماء المسلمون إلى فقه الأولويات والموازنات، للموازنة بين المصالح والمفاسد في شتى أمور الحياة والمعاش، صيانةً وحفظًا لمقاصد الشريعة الخمسة: الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال.
ومن فقه الأولويات والتوازنات، الموازنة بين مخاطر التشيع -وهي حاضرة بالتأكيد- ومخاطر الهجمة الصهيوينة الراهنة التي لم يسبق لها مثيل، في اتساعها وقوتها وأدواتها واختراقاتها لجميع القوانين والمواثيق والمؤسسات الدولية دون رادع. وقد أكد الشيخ يوسف القرضاوي ذلك مبينًا، أنه لا بد من وضع خطوط حمراء بين السنة والشيعة فيما يخص ضرورة مواجهة خطر التشيع في البلاد السُنية الخالصة، ولكن دون إغفال في الوقت ذاته ضرورة مواجهة اكتساح الهيمنة الصهيونية لديار الإسلام. وهو الأمر الذي جعله مؤيدًا لحق إيران في امتلاك الطاقة النووية السلمية، على اعتبار إيران جزءًا من ديار الإسلام، لا يجوز التفريط فيه، وعلى اعتبار أن الشيعة الإمامية ليسوا بكافرين، على الرغم من كونهم مبتدعين، إلا أن إثارة ذلك الأمر يعد خطًا كبيرًا في السياق الراهن[6].
وكذلك من فقه الأولويات والموازنات، الوعي العميق بالوضع والشعور المركب الذي نحن بصدده. فمآسي التاريخ بين الطائفتين لا ولن تُنسى؛ وجرائم “حزب الله” بحق الشعب السوري لا ولن تُمحى من الذاكرة. ولكن حينما يصير استحضار تلك المآسي عائقًا عن اتخاذ الموقف الذي يحمي مصلحة الأمة في المستقبل، يكون النظر قد وقع فيه خلل، وتكون منهجية التعامل مع الأحداث قد وقع فيها علة. بمعنى آخر، إن انتصار الكيان الإسرائيلي على إيران -لا قدر الله- سيعني خطرًا مستطيرًا على جميع المسلمين، بكل طوائفهم واختلافاتهم؛ ولسوريا أولوية واضحة في ذلك الخطر المستطير[7].
لا شك، ولا جدال أن يكون للشعب السوري كل الحق في استشعارهم لذلك الظلم الكبير الذي أوقعته إيران بحقهم -من خلال ما اقترفه ذراعها العسكري (حزب الله) في سوريا على امتداد أكثر من عقد- ولكن لا ينبغي الوقوف في تقييم هذا الحدث عند هذا الأمر فحسب. ثم إن إيران -إذا انتصرت- لن تتمكن من نشر مذهبها كما كانت تريد؛ وذلك لسببين أساسيين: أولًا، أنها تواجه محيطًا سُنيًا معاديًا يمثل أغلبية مسلمي المنطقة. ثانيًا، أنها قد خسرت كثيرًا من ثقلها الإقليمي في المنطقة، بعد الضربات العسكرية الإسرائيلية الموجعة التي تلقتها، على مدار العامين الماضيين، منذ اندلاع “طوفان الأقصى”[8].
ومن فقه الأولويات والتوازنات أيضًا، الموازنة بين الدعوي والسياسي في العلاقات العربية مع إيران، وعدم الخلط بين الاثنين، كما يحدث حاليًا بكل أسف. فمن جانب، نجد الدعاة غير قادرين على تخيل السياسي، فيقومون بتكفير الشيعة، ويضعونهم مع إسرائيل وأمريكا سواء، بل يضعونهم في منزلةٍ أشر وأسوأ. ونجد الساسة، من الجانب المناقض، غير قادرين على تفهم الدعوة ومستلزماتها، فيرون إيران دولةً قوميةً، ساعيةً إلى إحراز هيمنة استراتيجية في المنطقة ضد منافسها الإقليمي (إسرائيل)، وضد خصمها الأيديولوجي والاستراتيجي (أمريكا)، مستغلةً القضية الفلسطينية غطاءً لمصالحها. ولكي نوازن بين الفريقين، فنحن بحاجة إلى بلورة منظور حضاري، يجمع بين تلك الثنائيات في رؤية إسلامية منظمة، يُسفر عنها تشكل نموذج “السياسي المتدين” الذي يُعنى بتفاعلات الدولة الإيرانية السياسية، وتفاعلات القوى المتحالفة معها، وكذلك يُعنى بمذهب إيران ومحورها الشيعي، وتطوراته في الانتشار[9].
وأخيرًا، إذا كان الإسلام قد أباح للمسلم التعامل مع الكافر المهادن، من أجل حفظ مصلحة الأمة، ومصلحة هذا الدين، ألن يُبيح التعامل مع المسلم العاصي، بغض النظر عن معصيته؟ فإذا كان بعض مسلمي الشيعة قد تجاوزوا فكرًا وممارسةً، فسيظلون مسلمين موحدين، وعاصين في الوقت ذاته. ألم يستعن رسول الله “صلى الله عليه وسلم” في غزوة حنين بأسلحة “صفوان بن أمية” المشرك، لمحاربة الكفار؟ وألم يستعن في هجرته من مكة إلى المدينة بـ”عبد الله بن أريقط” المشرك، ليدله على الطريق؟ إذا كانت الاستعانة بالكافر قد جازت شرعًا، من أجل تحصين وحماية مصلحة الإسلام، ألن تجوز الاستعانة بالمسلم الموحد العاصي لنفس الغرض؟
المدخل الثاني- دلالات الذاكرة التاريخية
تحمل الذاكرة التاريخية للصراع السُني الشيعي دلالاتٍ عدة، تشير جميعها إلى مرارة ذلك الصراع عبر التاريخ الإسلامي، إلا أنه كان أولًا صراعًا سياسيًا من الدرجة الأولى، اشتغل به الساسة وأقحموه في سياساتهم الدنيوية البحتة، وأقحموا فيه الأمة بالإجبار، دون اختيار حر منها؛ وكذلك كان صراعًا مسؤولًا عنه الساسة من الطائفتين معًا، السنة والشيعة، وليس الشيعة وحدها. وثانيًا، كان صراعًا ناتجًا عن موالاة بعض الساسة المسلمين للمحتل الخارجي، مما أضعف الأمة والدولة سواء، فأسفر عن هزائم المسلمين عبر التاريخ الإسلامي، وسقوط الدولة الإسلامية في نهاية المطاف. ولنا مثالان واضحان: سقوط الأندلس في القرن الخامس عشر الميلادي، وسقوط العراق في القرن الواحد والعشرين. وثالثًا، كان صراعًا ناتجًا عن “مرحلة التعددية المذهبية والطائفية والعرقية”، خلافًا لـ “مرحلة الوحدة والفتوح” التي سبقتها.
- الصراع السني الشيعي صراع سياسي
نعم، كان صراعًا سياسيًا بالأساس، لا صراعًا مذهبيًا، كما يُشاع. فمنذ البداية، كان صراعًا على الحيازة والتملك والتسيد والنفوذ؛ وهو ما أفضى إلى التفكك بين “الديني” و”السياسي”؛ وهو ما دلل على التناقض الفج مع المنطق الائتماني الأخلاقي الذي يعتبر الخلافة أمانة في عنق الراعي والمسؤول، وليس فرصةً للتسلط والنفوذ. وللاسف، لم يُجابه هذا الصراع السياسي بقوة العلماء في علمهم وموقفهم المنوطون به في مثل تلك الظروف؛ وإنما كان تقصيرهم هو سيد الموقف؛ إما بغض الطرف، أو بتزيين سياسات النفوذ وتجميلها[10].
لقد تفكك “الديني” عن “السياسي” منذ احتدام الفتنة بين الصحابيين الجليليين، “معاوية بن أبي سفيان” و”علي بن أبي طالب”. وهكذا انفصلت الأمانتان، وتحول الأمر من بعدها إلى صراعٍ تاريخي طائفي بين الطائفتين؛ لنصل اليوم إلى نزاعٍ سياسي سعودي إيراني في عصرنا الحالي. لقد ابتُلي النظامان بداء العداوة وعدم وصل “الديني” بـ “الـسياسي”. وبكل أسف، لم تتم محاصرة تلك العلل على أيدي العلماء والفقهاء، من الجانبين[11].
ولم يكن الساسة الشيعة هم المسؤولين وحدهم عن هذا الصراع؛ وإنما الساسة السُنة كان لهم باع في المسألة أيضًا، لا يقل سوءًا عن نظرائهم الشيعة. فقد بدأ الصراع أمويًا هاشميًا، حينما اتهم الهاشميون بني أمية بالحيازة المطلقة للملك؛ ثم صار الصراع عباسيًا فاطميًا، حينما اتهم العباسيون (السُنة) الفاطميين (الشيعة) بمنازعة الله في مالكيته بانتحال بعضهم صفة الألوهية؛ ثم صار سلجوقيًا بويهيًا حينما اتهم السلاجقة (السُنة) البويهيين (الشيعة) بالخيانة لاستعانتهم بـ”هولاكو” التتري للقضاء على السُنة؛ ثم صار عثمانيًا صفويًا، حينما اتهم العثمانيون (السُنة) الصفويين (الشيعة) بالاستعانة بالقوى الغربية وحملات التبشير للقضاء على الدولة العثمانية. ونستخلص من كل ذلك، أن الداء أو المرض الحقيقي هي الرغبة في التسيد، مما أدى إلى الخيانة من قبل الساسة في الطائفتين، الأمر الذي أدى إلى تهديد الأمة وإسقاط الدولة. وقد انتقل هذا الداء إلى النظامين السعودي والإيراني؛ فاتجه النظام السعودي إلى التحالف مع قوى الغرب، المناقض له في الدين والعقيدة والتاريخ والحضارة، على حساب الطرف الإيراني المسلم، المجاور له تاريخيًا وثقافيًا وجغرافيًا وحضاريًا. وعلى الوجه الآخر، أصيب النظام الإيراني بعلة “الاغترار بالقوة”؛ فصار يستخدم ميليشياته وأذرعه العسكرية لفرض التشيع بالقوة في الدول السُنية الخالصة[12].
- الصراع السُني الشيعي وموالاة المحتل الأجنبي
لأن الصراع أصله سياسي، ولأن الصراع محوره الرئيسي التسيد والنفوذ والتملك، فلم يكن لدى الساسة من الجانبين أي مانع من التحالف مع المحتل الأجنبي وصولًا إلى غاية التملك. ولنا في سقوط الأندلس، في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي، خير دليل وخير آية؛ إذ كان عصر ملوك الطوائف خير شاهد على تلك الخيانات السياسية ضد مصلحة الأمة. على سبيل المثال، “المأمون بن ذي نون” الذي أدخل القشتاليين إلى طليطلة عام 1085م، مما أسفر عن سقوطها. وكذلك الملك “أبو عبد الله الصغير” الذي خان والده وعمه، فتحالف مع الأسبان ليستولى على الحكم بمساعدتهم، ثم انتهى الأمر بتسليمه مفاتيح غرناطة للملكين الكاثوليكيين “إيزابيلا” و”فرناندو”.
وفي التاريخ الحديث، كانت موالاة بعض الجماعات الشيعية مع المحتل الأمريكي للعراق في أبريل 2003، إذ عادت قيادات شيعية عراقية من المنفى (إيران)، لتشارك في “مجلس حكم الانتقال”، تحت رعايةٍ أمريكية؛ مثل “عبد العزيز الحكيم” من “المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق”، و”إبراهيم الجعفري” من “حزب الدعوة الإسلامية”. وهكذا تعاونت تلك القيادات الشيعية مع العدو الخارجي في إدارة الدولة العراقية الجديدة المحتلة أمريكيًا.
وعلى الجانب الآخر، إذا كانت إيران يديها ملطختين بدماء المسلمين في سوريا، فإن العراق (صدام حسين) يداه ملطختان بدماء الشيعة.
- خبرة التاريخ الإسلامي في مرحلتي “الوحدة” و”التعددية”
تقول لنا خبرة التاريخ الإسلامي أن تمتع الدول الإسلامية بمركزٍ متميز في النظام الدولي كان بناءً على عدة عوامل، أهمها: تمسك الدول الإسلامية بالعقيدة الإسلامية؛ تنمية قدراتها العسكرية؛ احتلالها مركزًا متميزًا في هيكل النظام الاقتصادي العالمي؛ مناصرتها لبعضها البعض ضد العدو الخارجي؛ استقرار جبهاتها الداخلية، مما لم يمكن من تدخل القوى الخارجية في شؤونها. ومن ثم، كان انتفاء هذه العوامل نذيرًا بتدهور الدول الإسلامية وسقوطها في براثن القوى الخارجية[13].
في ظل وجود تلك العوامل، لم تكن مسألة المذهب أو الطائفة إشكاليةً إنما مصدرًا للتنافس الشريف والتنوع الثري. بمعنى آخر، إن تولي الأجناس المسلمة (العرب، الأتراك، الفرس) على قيادة المسلمين، ومواجهة الخصم، كان في مجموعه لصالح خدمة الإسلام ولصالح نهوض الأمة بعد كل مرحلةٍ خبو. فالضعف في الدور القيادي لطرفٍ مسلم كان يعوضه نمو طرف آخر، في مواجهة خصم آخر، في محور جغرافي آخر[14].
وهو ما شهدناه في مرحلة “الوحدة والفتوح والشهود الحضاري”، المتمثلة في خبرة القرون الهجرية العشرة الأولى، حيث لم تكن التعددية (الناتجة عن الاختلافات المذهبية، أو العرقية، أو الطائفية، أو القومية) مصدر تهديد لوحدة الأمة وإنجازاتها، بل كانت مكونًا من مكونات الإنجاز الحضاري، ومن ثم لم تنجح التدخلات الغربية حينذاك في اللعب بهذه الورقة. فرُغمًا من الحروب الصليبية والغزوة التتارية الأولى والثانية، فقد نجحت التعددية في الدفاع عن الثغور والمرابطة عليها. ذلك أن التنافس لم ينطلق أساسًا من المذهب أو القوم، إنما من القوى والمصالح في فضاءٍ حضاري ممتد، تمتزج فيه الشعوب مع الانتماء لكيانٍ أكبر، وهو الأمة. لقد كان تنافسًا في حماية الأمة من التهديد الخارجي؛ مثل دعم الترك السلاجقة للخلافة العباسية في التصدي للبيزنطيين، ودعم الدولة الفاطمية الشيعية في مصر بمقاومة البيزنطيين، ولو في إطار التنافس مع الخلافة العباسية والسلاجقة[15].
إلا أنه مع نهاية القرن العاشر الهجري (القرن الخامس عشر الميلادي) تبدلت الأحوال: فقد استمعت الفواعل الإسلامية إلى نوازع الفرقة والصراع؛ وباتت العلاقة بينها إما في صورة صدامات عسكرية مباشرة، أو في صورة تحالفات مع فواعل غير إسلامية ضد فواعل إسلامية. وانفرطت الرابطة العقدية، وصرنا أمام حروب إسلامية -إسلامية، ساهمت في تدهور الدول الإسلامية، وانهيارها وتفككها، وسقوط الوحدة الإسلامية، وصولًا إلى سيادة نمط التجزئة والانقسام والتعددية المفرطة، في وقتٍ تفوق فيه دور الطرف الآخر (الأجنبي المحتل). وهنا يجب القول، إن أنماط التفاعلات السلبية الخاطئة هي التي مهدت الطريق إلى التدخل الأجنبي. فما بين التحالف مع طرفٍ غير مسلم في مواجهة طرف مسلم منافس، والتحارب المباشر بين الفواعل المسلمة لتحقيق مكاسب طرف غير مسلم، وعدم نصرة طرف مسلم في مواجهة طرف غير مسلم، كان التدخل الخارجي هو النتيجة المنطقية لجميع تلك الأنماط التفاعلية الخاطئة التي لم تراع الرابطة العقائدية، ولم تراع مصلحة الأمة[16].
وفي ظل اندثار الرابطة العقدية بين الفواعل الإسلامية، تحولت التعددية من مصدر قوة إلى عبـءٍ ذي عواقب سلبية، ولا سيما في ظل تصاعد درجة التدخل الخارجي؛ إذ وظف الأخير ذلك التنافس البيني، المشروع والطبيعي، ليتحول بالتدريج إلى صراعٍ “تتآكل في ظله كل مفاهيم الوحدة الإسلامية”. وتتصف هذه المرحلة، المتباينة تمامًا عن سابقتها، بالتراجع (مرحلة التعددية والتراجع والهجوم الخارجي)؛ والتي امتدت منذ القرن العاشر الهجري (القرن الخامس عشر الميلادي) إلى يومنا هذا[17].
وتتكون هذه المرحلة الثانية، البائسة -إن جاز القول- من ثلاث مراحل فرعية: المرحلة الأولى (من القرن الخامس عشر حتى نهاية الثامن عشر الميلادي)، والتي شهدت الهجوم على أطراف العالم الإسلامي، ونجاح سياسات الاستحواذ الأسبانية (سقوط الأندلس) وبداية الأطماع الروسية في ذات الوقت. المرحلة الثانية (ما بين القرن التاسع عشر الميلادي واندلاع الحرب العالمية الأولى)، والتي شهدت الحملة الفرنسية على مصر، ومؤتمرات التوازنات الأوروبية الجديدة (من فيينا إلى فرساي) التي استقطعت من أوصال الإمبراطورية العثمانية، وهو ما دشن الموجة الثانية من التنافس الاستعماري الحديث؛ حيث كانت بداية مرحلة تقسيم الكيان المكتمل، مع دخول الإمبراطورية الروسية القيصرية على الخط، وتهديدها للدولتين الصفوية والعثمانية اللتين بدأتا في الضعف والتهالك، بينما رفضا التعاون سويًا.
والمرحلة الثالثة (ما بين نهاية الحرب العالمية الأولى حتى نهاية الحرب الباردة)، والتي شهدت استكمال استعمار العالم الإسلامي مع نشأة الدول الإسلامية الحديثة بحدودها الاستعمارية، في ظل تدخلات خارجية في طبيعة النظم السياسية والاجتماعية. وكانت المحصلة النهائية: تجزئة الكيان الحضاري الممتد المكون من عدة أقوام إلى دولٍ حديثة متصارعة على أسسٍ قومية أو مذهبية أو سياسية[18]. علمًا أنه خلال هذه الفترة اندلعت الثورة الإسلامية في إيران 1979، وتبعها الحرب العراقية -الإيرانية، على نحو جعل خريطة العلاقات الطائفية أكثر تعقيدًا.
ومع انتهاء الحرب الباردة وبداية عصر الأحادية الأمريكية والعولمة، شهدت المنطقة العودة للاحتلال العسكري من ناحية، وإعادة تقسيم المُجزأ من ناحيةٍ أخرى، مع صعود خطابٍ قوي للاختلافات المذهبية، إعدادًا لفضاء عربي إيراني تركي يتم تقسيمه طائفيًا ومذهبيًا وفق “مشروع الشرق الأوسط الكبير” (1991)؛ فيصير التقسيم في داخل الدولة الواحدة، بعدما كان بين الدول. وتعد العلاقات الراهنة بين العرب وإيران أحد مشاهد سيناريو “الشرق الأوسط الكبير”، حيث التدخل الخارجي بهدف إعادة تقسيم المنطقة من جديد، على أسس قومية ومذهبية[19]. وليس التغول الإسرائيلي الحالي، المدعوم أمريكيًا وأوروبيًا، إلا تمثيلًا لذلك التدخل الخارجي لتفتيت المنطقة.
المدخل الثالث- حسابات الواقع الاستراتيجي الراهن منذ “الطوفان”
ماذا يقول الواقع الاستراتيجي الراهن إزاء الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة؟ ذلك هو المدخل الثالث والأخير للنظر في قضية العلاقة بين إيران والعرب في ضوء اللحظة الراهنة. باختصار، فإن الواقع الاستراتيجي يشير بمنتهى الوضوح -ودون أدنى مواربة- إلى استفحال وتغول إسرائيل (بمساندة كلٍ من أمريكا وأوروبا) في المنطقة العربية، بشكلٍ مطلق لم يسبق له مثيل، مع وجود إيران كدولة مقاومة لهذا الطغيان في المنطقة، ومن ثم الدولة الوحيدة التي تتوازن استراتيجيًا مع إسرائيل؛ وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة حفظ صمود إيران كصمام أمان أمام إسرائيل.
وإذا كان الواقع الاستراتيجي الراهن يعكس غيابًا وتداعيًا وتخبطًا استراتيجيًا عربيًا واضحًا، فإنه يعكس على الوجه المناقض حضورًا إيرانيًا لا تخطئه العين؛ إلا أن هذا الحضور قد خفت مؤخرًا -منذ اندلاع “الطوفان” في أكتوبر 2023 بعد ضرب الأذرع العسكرية التابعة لإيران، واحدًا تلو الآخر، ثم الضربة الإسرائيلية الأخيرة، في 13 يونيو 2025، للمفاعلات النووية الإيرانية، والتي كشفت عن ضعفٍ وتراخٍ استخباراتي إيراني شديد، وانعدام للتوازن العسكري لصالح الدولة الإسرائيلية. خلاصة القول، إن الواقع الاستراتيجي الراهن يحمل في طياته من المخاطر التي تهدد ليس مصالح إيران فقط، وإنما مصالح العرب أيضًا، مما يستوجب التعاون بينهما، والكفاح سويًا من أجل القضاء على هذا العدو اللدود.
- استفحال إسرائيلي في المنطقة
في سبتمبر 2023، قبل “الطوفان” بأسابيع، ألقى نتنياهو كلمةً أمام الكونجرس الأمريكي، يعلن فيها اعتزامه إقامة “شرق أوسط جديد”، يقوم على فكرة “إسرائيل الكبرى الجديدة”؛ وهي فكرة قديمة كان قد طرحها شيمون بيريز في كتابه “الشرق الأوسط الجديد”، والذي افترض فيه أن الرخاء الاقتصادي مع دول المنطقة العربية هو السبيل الوحيد لتحقيق هذه الفكرة، والتي يحول دون تحققها حركات المقاومة صاحبة استراتيجة “وحدة الساحات”. وتطبيقًا لهذه الفكرة على الأرض، يصير دور إسرائيل الرئيسي هو مواجهة تلك الحركات المقاومة، حتى تُترَك الولايات المتحدة في انشغالها على جبهتي أوروبا وأوكرانيا من ناحية، وانشغالها في مراقبة صعود الصين من ناحيةٍ أخرى.
يقود هذا الطغيان الإسرائيلي حكومة إسرئيلية يمينية متشددة، تفرض إرادتها بالقوة على المنطقة، وترفض رفضًا قاطعًا لأية حلول سلمية تفاوضية. ويغذيها في ممارسة هذا الطغيان، تأييد كلٍ من الولايات المتحدة وأوروبا، وصمت بل تخاذل الدول العربية، وتقلص دور المؤسسات الأممية والدولية في التأثير على قرارات وسياسات الدول الغربية العظمى. تبغي إسرائيل إيجاد شرق أوسط جديد، تفرض فيه الحرب والسلام بالقوة، دون أن يحاسبها أحد، في ظل واقع فوضوي للمنطقة، يتعذر فيه وجود أية صيغ للأمن الجماعي، ويسهل فيه اندلاع أية حروب أو صراعات.
يتمثل الهدف الاستراتيجي الأوسع لإسرائيل في إعادة تشكيل ميزان القوى الإقليمي، تعزيزًا لهيمنتها وثقلها بالمنطقة. وتحقيقًا لهذا الهدف، كان قيام إسرائيل بضرب إيران في 13 يونيو 2025، والسعي المستمر والحثيث لإضعاف وكلاء إيران بالمنطقة (“حزب الله” و”أنصار الله”)، والقضاء الكامل على القضية الفلسطينية، بتهجير فلسطينيي غزة تهجيرًا قسريًا نحو مصر والأردن، واستغلال الصراعات الإقليمية الحالية (ومنها طبعًا العربية -الإيرانية) لإجبار القوى الإقليمية الأخرى بأسرها على الخضوع لها؛ وهو ما نسميه “مبدأ الصدمة والفرصة”، أي استغلال لحظات من عدم الاستقرار الإقليمي لتعزيز المصالح الإسرائيلية[20].
يستهدف نتنياهو قيادة المنطقة عبر أربعة مسارات: محو جميع الحقوق الفلسطينية عبر المستوطنات والتهجير؛ التطبيع مع الدول العربية على عدم الاعتراف بأي حق لتقرير المصير الفلسطيني؛ تجاهل جميع مقترحات الأرض مقابل السلام، وأي مباديء للأمن الجماعي؛ وأخيرًا، حرمان إيران من أية قدرات نووية وعسكرية[21].
وقد بدأت إسرائيل بالفعل في تحقيق الوسائل التي ستوصلها لهدفها الاستراتيجي؛ إذ فقدت إيران مؤخرًا الكثير من استراتيجيتها الردعية والدفاعية، بعد تلقيها ضربات إسرائيلية مفصلية منذ اندلاع “طوفان الأقصى”. تلك الضربات الإسرائيلية التي نالت من الأذرع العسكرية الإيرانية، والتي كشفت عن خللٍ واضح في القدرات العسكرية والاستخباراتية الإيرانية مقارنةً بنظيرتها الإسرائيلية.
وبناءً عليه، فإنه في ضوء تفاقم الخطر الصهيوني يصير حديث الفرقة بين السُنة والشيعة سببًا لشق الصف العربي الإسلامي؛ وهو ما يوجب منعه في كافة الأحوال. ذلك أن معايير الأمة والوحدة ومواجهة العدو المشترك متقدمة على معيار الطائفية، والانشقاق، والاشتباك مع الشقيق والأخ في الدين والتاريخ والحضارة. نعم، هناك نمطان من التفكير على الساحة الإسلامية: نمط مشغول بالدفاع عن الطائفة السُنية، ومستغرق في غيرته على المذهب السُني من التغول الشيعي المرصود، ونمط مشغول بالدفاع عن الأمة ومصالحها المستقبلية؛ النمطان مطلوبان، ولابد أن يتكاملا. إلا أن السؤال الجوهري المطروح الآن: هل معيار الطائفية صار يتقدم على معيار الأمة[22]؟
إضافةً إلى ذلك، لا بد من الوعي العميق بسعي الساسة الأمريكيين والإسرائيليين نحو عزل قوى المقاومة في محيطها العربي الإسلامي، ليسهل ضربها؛ مُحولين كراهة المسلمين تجاه الخطر الصهيوني إلى كراهةٍ تجاه خطر شيعي متوهم[23].
إن الواقع الاستراتيجي الراهن يُظهر لنا صورةً جديدة للمنطقة، لم نعهدها من قبل؛ وهي صورة لمنطقةٍ غير آمنة، يسهل فيها اندلاع الحروب والصراعات بطريقةٍ مباشرة أو عبر الوكلاء، مما يشير إلى غياب تام للأطر الدبلوماسية الجماعية. وهو أمر ناتج عن انعدام التوازن في القدرات العسكرية والاستخباراتية بين قوى المنطقة، والذي يصب لصالح إسرائيل ذات الحكومة اليمينية المتشددة والإرادة المترسخة في فرض الحرب والسلام (إن وُجد) بالقوة[24].
ومما ساعد على تفاقم الوضع لغير صالح العرب، التحول الاستراتيجي المشهود في إيران منذ اندلاع “الطوفان” في أكتوبر 2023؛ إذ فقدت إيران، كما ذكرنا، استراتيجيتها الردعية والدفاعية أمام إسرائيل والولايات المتحدة، ومن ثم فقدت تأثيرها على أية صفقات إقليمية أو أية صفقات مع واشنطن. وهو الأمر الذي شجع إسرائيل على التوغل أكثر فأكثر في المنطقة؛ ومن ثم استكمال ضرباتها العسكرية على إيران في يونيو 2025. وقد أعطت واشنطن الضوء الأخضر إلى إسرائيل، معتبرةَ ذلك فرصةً استراتيجيةً للقضاء على البرنامج النووي الإيراني مرةً واحدة. وبالرغم من إدراك إيران لذلك التحول الاستراتيجي، وبالرغم من محاولاتها الحثيثة في تغيير سلوكها السياسي تجاه الدول العربية (التقارب)، وسعيها للتفاوض مع واشنطن، إلا أن ذلك لم يُسفر عن منع الضربات الإسرائيلية ثم الأمريكية[25].
إن انتصار إسرئيل على إيران -إن حدث- سيعزز وسيدعم من ذلك الوضع الاستراتيجي. فالصراع الإيراني الإسرائيلي هو صراع صفري؛ الخطر فيه على المحارب والمسالم سواء؛ فالكل بات فلسطينيًا شاء أم أبى. فإما يتحالف ويصطف العرب مع إيران، للقضاء على النظام الإسرائيلي، وإما يصير البديل كارثيًا. بمعنى آخر، إن فرغت إسرائيل من إيران، ستنقلب بعدها على مسالميها من الدول العربية السُنية التي تبتغي تطبيعًا مع المحتل الإسرائيلي. وفوق ذلك، سيكون هناك نظامًا جديدًا في إيران، موالٍ لواشنطن وتل أبيب، مما سيُفضي إلى تقليل الوزن الاستراتيجي النسبي للدول العربية أمام النظام الجديد في إيران[26].
إن انتصار إسرائيل على إيران سيعني تباعًا القضاء على الأغلبية العربية في غزة، إما إبادةً أو تهجيرًا؛ كما سيعني استهدافًا لمصر التي تقف الأولى في طابور الدول المستهدفة إسرائيليًا (بغض النظر عن اتفاقية السلام)؛ وستكون المحصلة تغولًا استراتيجًا في الأراضي العربية لسد ذلك الجوع الاستراتيجي الإسرائيلي للأرض[27].
- الفراغ والغياب الاستراتيجي العربي
لم تستغل إسرائيل فقط التحول الاستراتيجي الإيراني السلبي منذ “الطوفان”، وإنما استغلت أيضًا حالة الفراغ الاستراتيجي العربي، بوضع الدسائس الطائفية، ومن ثم تعميق الاستقطاب. كما هو واضح للعيان، فنحن -العرب- في وضعٍ مأساوي، لم تشهده المنطقة من قبل. فمن ناحية، نجد غيابًا لأي رؤية استراتيجية عربية، سواءً إزاء ذلك العدوان الإسرائيلي الغاشم الكاسح، أو إزاء التوظيف الإيراني للميليشيات الشيعية في المنطقة. ومن ناحيةٍ أخرى، نجد سياسات أحادية تطبيعية مع الكيان الصهيوني، العدو المغتصب والمحتل صاحب المشروع الإحلالي، بديلًا عن إيران الدولة الإسلامية ذات المشروع الصفوي التبشيري.
والجامع بين الناحيتين هو حالة تخبط عربي تسير عكس اتجاه متطلبات الأمن الإقليمي، وتتخلى بوضوح عن خيار المقاومة حتى هذه اللحظة. وأكبر دليل على الفشل العربي، هو عدم قدرة الأنظمة العربية -ومعهم الدولة التركية- على اقتراح أفكار الوساطة والدبلوماسية وإحياء حل الدولتين، تحقيقًا للأمن الجماعي؛ ومن ثم فشلها جميعًا في ثني نتنياهو عن مواصلة سياساته الوحشية التي أوصلته مؤخرًا إلى مهاجمة إيران في يونيو 2025[28].
نحن نشهد، بكل أسف، واقعًا عربيًّا مزريًا، تداعيًا استراتيجيًّا، سياسات تجزيئية في التعامل مع التهديدات الإقليمية، أزمات اقتصادية، خلافات سياسية وطائفية، انهيار الدولة في عددٍ غير قليل من البلدان العربية، إذ تتصارع على مقدراتها مجموعات من الجماعات المسلحة (السودان، ليبيا، الصومال، اليمن). نحن في النهاية أمام “تيهٍ عربي متعمد”، يتمثل في حالة إقليمية مأزومة، تحفز قوى إقليمية وعالمية على العبث بمقدرات الإقليم[29].
لقد تخلَّت الدول العربية عن الصبغة المقدسية، مُضيعةً أمانة الأرض والفطرة، لتُسلم وجهها في النهاية صوب إسرائيل؛ ثم استخدمت وسائل مذهبية لتحقيق التسيد والنفوذ السياسي. فالصراع إذن كان ذا طبيعة سياسية لا مذهبية أو عقدية، كما يُراد به أن يكون، وأكبر دليل على ذلك، عدم ارتباط الجماهير المسلمة بهذا الصراع تاريخيًا ووجدانيًّا. وهنا نتساءل: أين دور المثقف المسلم في درء تلك الفتنة، وفي منع ظهور “عالم ما بعد الأمانة” المشهود حاليًا[30]؟
وإذا كان بعض العرب يشتكون من امتداد النفوذ الإيراني، عبر الميليشيات الشيعية، في العالم السُني العربي، وتوظيفه خلال الحرب على غزة، فلنسألهم: أين الرؤية الاستراتيجية العربية تجاه كل ذلك؟ ألم يكن أحرى بالدول العربية السُنية أن تقوم هي باحتضان مشروع المقاومة في مظلة من الأمن العربي الجماعي؟ ألم يكن أحرى بتلك الدول أن تبلور مفهومًا متكاملًا عن الأمن القومي العربي، فتحدد من هو العدو، ومن هو الحليف، وما هي مصادر التهديد؟! ولكننا -بكل أسف- نجد وضعًا مناقضًا لكل ذلك. نجد أنظمة إقليمية فرعية مفككة (“مجلس التعاون الخليجي” كمثال) عديمة الأثر والمعنى؛ ونجد انقسامًا في داخل الدولة العربية الواحدة؛ ونجد إدراكًا عربيًا عدوانيًا تجاه إيران، وفي المقابل إدراكًا مهادنًا تجاه إسرائيل؛ نجد غيابًا لاستراتيجية عسكرية عربية في ظل عدم تكافؤ مع القوى الإقليمية الأخرى (سواءً إسرائيل أو إيران)؛ نعيش ترديًا اقتصاديًا عربيًا بسبب حالة “العسكرة الوهمية”؛ نجد غيابًا للدولة القائد (تراجع دور مصر الإقليمي مع عدم فعالية الكيانات الجماعية العربية)؛ نجد قصورًا في التعامل مع المكون الشيعي في الدول العربية، وقصورًا في تقدير القيمة الاستراتيجية للمقاومة بالرغم من خطورة التهديدات. وفي مقابل كل ذلك، نجد تناميًا في القوة العسكرية الإيرانية لدرجة تحذير “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” باقتراب إيران من صنع القنبلة النووية (تقرير ديسمبر 2023). فأنى كل ذلك من الأمن القومي العربي[31]؟
وبالطبع، يصير الكيان الصهيوني هو المستفيد الأكبر من حالة الفراغ الاستراتيجي العربي، والمصاحبة لحالة الاستنفار الطائفي السُني الشيعي. وفي ذلك، تسعى إسرائيل جاهدةً نحو جعل الخليج العربي رأس حربة المواجهة مع إيران، وهو ما يستلزم تعميق الاستقطاب الطائفي، وفرز ما يُسمى “محور الاعتدال العربي”، والذي يصير منوطًا -حسب الإملاءات الإسرائيلية- بمجابهة ما يُطلق عليه “محور الممانعة” الذي تقوده إيران مع العراق وسوريا (قبل سقوط نظام “الأسد” في ديمسبر 2024) وقوى المقاومة العربية[32].
ملامح استراتيجية لتطوير العلاقات: ما هو المطلوب حاليًّا؟
وفي ظل تلك التهديدات الواضحة والمتصاعدة، يجب التحرك على النحو التالي:
- توثيق الصلة الاستراتيجية بين الدوائر الثلاث: العربية، والإيرانية، والتركية، إضعافًا للكيان الصهيوني، وتحجيمًا للسياسات الإسرائيلية والأمريكية. ومن ذلك، استغلال فرصة انشغال إسرائيل بانقساماتها الداخلية، وانشغال أمريكا بصدامها الاستراتيجي مع الصين، بهدف تنويع الشراكات العربية والإيرانية والتركية. ومن ذلك أيضًا، وضع عوامل الدين والتاريخ والجغرافيا في الحسبان، والتغاضي عن الفروقات القومية المصطنعة غربيًا[33].
- الاتفاق على ثوابت الأمن القومي العربي (التي من أهمها جعل القضية الفلسطينية محور ذلك الأمن)، واختيار المقاومة كخيارٍ استراتيجي لا بديل عنه، لا سيما بعد تحول المقاومة إلى فاعل إقليمي أساسي غير تابع، منذ أحداث “الطوفان”.[34]
- تطوير آليات دفاع الأمن الجماعي العربي، إذ لا استقرار للمنطقة دونه[35].
- الوعي بالمخطط الأمريكي الذي يريد تعزيز التحالف بين الاحتلال الإسرائيلي وجيرانه العرب، تحت رعاية أمريكية متزايدة؛ والوعي كذلك بأجندة إسرائيل السياسية والأمنية بخصوص مخطط التهجير القسري للفلسطينيين.
- التعامل مع إيران باعتبارها تحديًا وليس تهديدًا. فالوعي بعوامل التاريخ (المتمثلة في الوشائج التاريخية) والجغرافيا (المتمثلة في الجوار الطبيعي) بين العرب وإيران يجعل الأخيرة ليس فقط عمقًا حضاريًا للعرب، وإنما أيضًا عمقًا استراتيجيًا[36].
- الاستفادة من نقاط القوة التي تجلت بعد انتهاء الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة (يونيو 2025)، والتي من أبرزها وأهمها على الإطلاق، عدم انكسار إيران وعدم انتصار إسرائيل. وهناك دلائل كثيرة على ذلك، منها:
- قيام واشنطن بإيقاف الحرب بين الطرفين، الإيراني والإسرائيلي، دون الإشارة إلى صلب الأزمة.. “المشروع النووي الإيراني”.
- ما زالت إيران -رُغمًا عن الدمار الذي لحق ببنيتها التحتية النووية جراء الحرب- تمتلك الكثير من الأوراق السياسية والقدرات العسكرية لإطالة أمد الحرب، وهو ما لم ولن تتحمله دولة إسرائيل التي ضُربت لأول مرة في عمقها منذ نكبة 1948، ومن قبل دولة إسلامية[37].
- الكشف عن فداحة الخطأ الاستراتيجي الإسرائيلي -حينما شنت الحرب على إيران في 13 يونيو 2025- الذي أظهر هشاشة الأمن الإسرائيلي، والذي لفت انتباه الرأي العام الأمريكي إلى التكلفة السياسية والمالية لدعم دولة إسرائيل[38].
- ازدياد تمسك إيران بالحق النووي، ومنعها “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” من الاستمرار في مراقبة برنامجها النووي، كعقوبة لها عن صمتها إزاء الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية على المفاعلات النووية الثلاثة دون مسوغ قانوني[39].
- بالرغم عن الإظهار الدرامتيكي للقوة الأمريكية في ضربها لإيران، إلا أنها لم تستطع تدمير المعرفة الذاتية النووية الإيرانية. نعم، قد أخرت الضربة الأمريكية البرنامج النووي الإيراني، إلا أن عملية تخصيب اليورانيوم لا زالت موجودة، ومعها الإرادة السياسية والعمالة المدربة تقنيًا، رٌغمًا عن تدمير البنية التحتية[40].
- الاستفادة من مكتسبات الحرب المباشرة الأخيرة بين إيران وإسرائيل (يونيو 2025) بشأن منهاجية الصراع، فقد حدث تحول في منهاجية إدارة الصراع؛ من حروب “الظل” (الحروب السيبرانية وحروب الوكلاء) إلى حروب المواجهة المباشرة. صحيح أننا شهدنا نجاحًا استخباراتيًا إسرائيليًا واضحًا والذي قابله -بكل أسف- فشلًا استخباراتيًا إيرانيًا، تمت معالجته سطحيًا (من قبيل شن السلطات الإيرانية حملة اعتقالات واسعة ضد المشتبه فيهم)، بدلًا من معالجته هيكليًا. وصحيح أننا شهدنا تدخلًا أمريكيًا مباشرًا، لأول مرة منذ عقود، عبر عملية “مطرقة منتصف الليل” في 22 يونيو 2025؛ وهي العملية المخطط لها منذ 2004 لتطوير السلاح المطلوب للتعامل مع منشأة فوردو النووية، مما يكشف الطبيعة الاستراتيجية للتفكير العسكري الأمريكي؛ إلا أنه لا يجب إغفال رد الفعل الإيراني الذي حقق وأنجز، بالرغم من جميع تلك الخسائر.
أهم تلك الإنجازات، قيام إيران بإطلاق صواريخها على مواقع استخباراتية وعسكرية إسرائيلية (مقرات الموساد وأمان وقواعد سلاح الجو)، مع تنويع أسلحتها المهاجمة، لإرباك أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي، وهو ما حدث بالفعل. وقد أظهرت إيران قدرتها على الرد، وإظهار نقاط ضعف دفاعية لدى خصمها الإسرائيلي، دون الانزلاق في حرب شاملة[41].
- الاستفادة من التغير الإيراني تجاه العرب في الآونة الأخيرة، هناك محفزات داخلية وخارجية استدعت إعادة إدراك إيران للتهديدات الخارجية التي تحاصرها. وكان من أهم تلك التهديدات، بعد “الطوفان”، وصول “ترامب” إلى الرئاسة الأمريكية، وممارسته سياسة “الضغوط القصوى” على إيران حتى تتوقف عن أنشطتها النووية، ثم سقوط نظام “بشار” في سوريا، ديسمبر 2024، وقطع محور المقاومة بين إيران و”حزب الله”، وقطع الإمدادات البرية الحيوية بين إيران وسوريا ولبنان، وأخيرًا الاختراق الأمني الإسرائيلي للداخل الإيراني. حفزت جميع تلك التهديدات الدولة الإيرانية على التقارب مع المنطقة العربية، والانفتاح على الجوار العربي وكذلك التركي، متحديةً الحاجز الطائفي، متغلبةً عليه، متحديةً “اتفاقات أبراهام” للتطبيع الإسرائيلي العربي[42].
ومن المهم في هذا المقام، التطرق إلى القضايا المنهاجية المتعلقة بهذه المسألة، لكي نضع النقاط على الحروف، عند اقترابنا من قضية العلاقة بين إيران والمنطقة العربية؛ وهو ما سنوضحه على الوجه التالي[43]:
أولًا؛ عدم فصل العلاقة بين العرب والفرس عن التاريخ الإسلامي برمته، سواء ما يتصل بتاريخ العلاقات بين المسلمين أو تاريخ علاقتهم بالغير؛ وهو ما يعالج الاقترابات القومية والمذهبية والتجزيئية التي تنال من فكرة وحدة الأمة. فالعرب وإيران ليسا مجرد جوارين جغرافيين، أو دولًا قومية ذات مصالح متنافسة، ولكنهما ابتداءً ركنان أساسيان من أركان هذه الأمة، ومن أركان دائرة حضارية واحدة، انطبقت على كلٍ منهما السنن الإلهية في الاجتماع البشري.
ثانيًا؛ النظر إلى العلاقات بين إيران والعرب باعتبارها علاقات متغايرة ومتباينة على امتداد التاريخ. فهي علاقات شهدت تفاعلات إيجابية، وكذلك سلبية. وهو تداول سنني وطبيعي في شكل ونمط العلاقات؛ فتارة علاقات متأزمة، تعكس صدامات عسكرية مباشرة أو تحالفات مع الآخر غير المسلم؛ وتارة علاقات إيجابية تعكس الوحدة والتضامن. إلا أنه يجب القول إن التنافس بينهما كان تنافس قوة محمود في معظم الأحيان، يصب في عافية الأمة، لا صراع استبعاد أو استئصال أو إقصاء.
ثالثًا؛ تسليط الضوء على مركزية دور الخارج في تأزيم العلاقة بين العرب والفرس، وبين المسلمين بوجهٍ عام، على مر التاريخ؛ والبحث في تأثيراته من أجل فهم العلاقات الإسلامية الإسلامية تاريخًا وحاضرًا.
رابعًا؛ فض الاشتباك المزعوم بين الرابطة العقدية والمصالح القومية؛ إذ إن أصل العلاقة بينهما ليست علاقة تناقض كما يُشاع معرفيًّا وأكاديميًّا وسياسيًّا. ذلك أنه لا توجد فجوة، في الأصل، بين الإسلام والتطبيق في تاريخ المسلمين. فمتى كان التمسك بمتطلبات الرابطة العقدية، كان التمسك بمصالح الأمة ومصالح الأقوام والكيانات السياسية المختلفة؛ والعكس هو الصحيح.
خامسًا؛ نبذ التحيزات المعرفية والفكرية والسياسية التي سادت الدوائر الأكاديمية والإعلامية والسياسية عن العلاقات بين العرب وإيران، سواء آنيًّا أو تاريخيًّا؛ ومنها نبذ نظريات المؤامرة ودموية العلاقات، وكل اختزال يُعلي من الثنائيات، ويختزل الظاهرة الكلية. وتبني، بدلًا من ذلك، المنظور الحضاري الإسلامي للتاريخ، المتجاوز للثنائيات.
سادسًا؛ تخليص الوعي الجماعي لشعوب الأمة من براثن مفاهيم الكيانات القومية والقطرية ذات المصالح القومية المتنافسة على حساب مقتضيات الرابطة العقدية. فبدلًا من الحديث عن دول قومية متجاورة جغرافيًا، يصير الحديث عن أركان دائرة حضارية واحدة، وبدلًا من الحديث عن الجوار الإقليمي، يصير الحديث عن الجوار الحضاري، وبدلًا من الحديث عن الأمن القومي يصير الحديث عن الأمن الحضاري[44].
سابعًا؛ رفض ما تتبناه بعض التيارات السلفية والعلمانية فيما يخص تغذية العداء السُني العربي تجاه إيران. فأما التيارات السلفية، فقد تُخرج إيران من الأمة لاعتبارات عقائدية ومذهبية. وأما التيارات العلمانية (مثل التيار القومي المتطرف)، فهي تُخرجها من الأمة العربية، على اعتبار أن الأخيرة منقطعة الصلة عن الأمة الإسلامية. بينما المنظور الحضاري الإسلامي يرفض ذلك كله، ويتعامل بدلًا من ذلك مع إيران كجزء من الأمة الإسلامية، سواءً كان جزءًا إيجابيًّا أو سلبيًّا، إذ إن السياسات السلبية لا تفقد الانتماءات[45].
خاتمة:
شرعًا وتاريخًا وواقعًا، تصير مساندة إيران واجبًا وضرورةً، في معركتها مع المغتصب الصهيوني. فالشرع يأمر المسلمين بوحدة الصف في وجه العدو المشترك، كما يأمر بالتوازن في النظر إلى الأمور، ومن ثم في السلوك المبني عليه. فالموازنة بين المصالح والمفاسد، والموازنة بين السياسي والدعوي من أصول الفقه الإسلامي. وأما التاريخ، فيُظهر لنا من قوانينه وسنُنه التي أثبتت بالدليل القاطع والدامغ أن موالاة المحتل غير المسلم ضد المسلم (حتى ولو كان عاصيًا) يُنزل الهزيمة والسقوط بهذه الأمة، وأن التعددية المذهبية والطائفية والعرقية هي الشر المستطير الذي يجلب الهزيمة لهذه الأمة حال أسيء توظيفها. وأما الواقع الراهن، فيكشف لنا عن تغول إسرائيلي في المنطقة، لم يسبق له مثيل، سواء من ناحية الكم والكيف في طريقة التغول، أو من ناحية الدعم الدولي اللامتناهي، ليس من الدول الغربية فقط، بل الدول العربية أيضًا؛ كما يكشف لنا عن غيابٍ استيراتيجي عربي تم استغلاله وتوظيفه على يد المحتل الصهيوني.
ومن يشهد الوضع الراهن حاليًا، (يوليو/أغسطس 2025) سيلحظ اتجاهًا واضحًا نحو الأسوأ والأخطر بخصوص قضيتنا الفلسطينية، وما يتعلق بتضييق الخناق على حركات المقاومة للتوغل الصهيوني. فنجد موافقة الكنسيت على إعادة احتلال الضفة الغربية (24 يوليو)؛ ونجد قيام “يسرائيل كاتس” (وزير الدفاع الإسرائيلي) بتوجيه خطاب مباشر إلى القائد الأعلى في إيران، مهددًا إياه بالاغتيال (11 أغسطس)؛ ونجد إعلان قرار لـ”نتنياهو” (ومن بعده المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي) بالمضي قُدمًا في خطة احتلال غزة، بهدف إنهاء سيطرة “حماس” على القطاع (8 أغسطس)؛ ثم نجد توجهًا للترويكا الأوروبية (ألمانيا، انجلترا، فرنسا) ببعث رسالة مشتركة إلى “مجلس الأمن”، معلنةً فيه التزامها بالحل الدبلوماسي فيما يخص الاتفاق النووي لعام 2015، إلا أنها تعلن أيضًا، مع قرب انتهاء مفعول الاتفاق بتاريخ 18 أكتوبر 2025، احتفاظها أيضًا بالجاهزية والأساس القانوني لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات تلقائيًا إذا لم يتم التوصل إلى حلٍ مرضٍ بحلول نهاية أغسطس 2025؛ وأخيرًا، وليس آخرًا، اتخاذ حكومة “جوزيف عون” و”نواف سلام”، وبعد مشاورات مع “توم باراك” المبعوث الأمريكي الخاص، قرارًا يقضي بنزع سلاح كل الفصائل المسلحة غير الحكومية في لبنان (حزب الله والفصائل الفلسطينية) بحلول نهاية 2025.
وأمام ذلك الوضع الراهن الخطير، والذي تزداد خطورته يومًا عن يوم -بجانب اعتباري الشرع والتاريخ- تصير مساندة إيران (وليس التماهي معها)، في مواجهتها للعدو الإسرائيلي، واجبًا حتميًا لا بديل عنه، بل يصير التفريط فيه تخاذلًا عن الأخذ بأصول الدين، وتخاذلًا عن فهم سنن التاريخ والعمل بمقتضاها، وتخاذلًا عن قراءة الواقع الراهن، بكل مخاطره وسلبياته، وعن مواجهته كما يجب.
—————————————
الهوامش:
⁕ باحثة في العلوم السياسية.
[1] لؤي علي، “شيخ الأزهر: الاختلاف بين السنة والشيعة كان في الفكر والرأي وليس في الدين”، اليوم السابع، 2 مارس 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://short-url.org/1c4zg
[2] المصدر السابق.
[3] وسام الضويني، “التقريب بين السنة والشيعة: متطلبات ومعوقات”، (في) د. نادية مصطفى ود. سيف الدين عبد الفتاح (إشراف عام)، أمتي في العالم، العدد الثامن: قضية الأمة ومشروع النهوض الحضاري، القاهرة: مركز الحضارة للدراسات والبحوث، 2009، متاح عبر الرابط التالي: https://short-url.org/1gLmS
[4] المصدر السابق. وراجع: طارق البشري، “طارق البشري يرد على القرضاوي: فتنة السنة والشيعة”، الدستور، 27 سبتمبر 2008.
[5] علماء الأمة يطلقون “ميثاق طوفان الأقصى” لتوحيد الموقف الشرعي تجاه جرائم الاحتلال، الجزيرة نت، 27 يونيو 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/eMHsT3
[6] المصدر السابق.
[7] نواف هايل تكروري، “جدلية الخطر الصهيوني والخطر الإيراني والواجب حاليا في هذه المعركة”، هيئة علماء فلسطين، 18 يونيو 2025، علىonX @palscholars48))
[8] المصدر السابق.
[9] مدحت الليثي، “الأمة والطائفية من منظور حضاري إسلامي: الدعوي والسياسي في العلاقة مع إيران”، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، 20 أغسطس 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://short-url.org/1c4Av
[10] طه عبد الرحمن، ثغور المرابطة: مقاربة ائتمانية لصراعات الأمة الحالية، بيروت: منتدى المعارف، 2019.
[11] المرجع السابق.
[12] المصدر السابق.
[13] نادية مصطفى، “التدخلات الخارجية ومسيرة أزمات المنطقة: التجربة التاريخية وآفاق المستقبل”، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، 2 مارس 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://short-url.org/1c4B6
[14] المصدر السابق.
[15] المصدر السابق.
[16] المصدر السابق.
[17] المصدر السابق.
[18] المصدر السابق.
[19] المصدر السابق.
[20] هشام جعفر، خطة نتنياهو لسيادة الشرق الأوسط عبر ضرب إيران، موقع الجزيرة.نت، 20/6/2025، متاح عبر الرابط التالي: https://short-url.org/1c4Bw
[21] Amr Hamzawy, “Does Collective Security in the Middle East Still have a Chance”, Carnegie Endowment, June 25, 2025, available at: https://short-url.org/1gLow
[22] الضويني، مصدر سابق.
[23] المصدر السابق.
[24] Hamzawy, Op. cit.
[25] Ibid.
[26] تميم البرغوثي، “تحريرها كلها بدأ”، 16 يونيو 2025، TamimBarghouti X
[27] المصدر السابق.
[28] شيماء بهاء الدين، “المشروع الإقليمي الإيراني في ضوء الحرب على غزة.. هل من مسار لتوازن بين العرب وإيران (ورقة أولية)”، مركز الحضارة للبحوث والدراسات، 29 يناير 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://short-url.org/1gLpk
[29] المصدر السابق.
[30] طه عبد الرحمن، مصدر سابق.
[31] شيماء بهاء الدين، مصدر سابق.
[32] المصدر السابق.
[33] المصدر السابق.
[34] شيماء بهاء الدين، مصدر سابق.
[35] Hamzawy, Op. cit.
[36] شيماء بهاء الدين، مصدر سابق.
[37] جمال قاسم، “ماذا يعني ضرب أمريكا لإيران”، الجزيرة نت، 23 يونيو 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://short-url.org/1gLpS
[38] المصدر السابق.
[39] Nicole Grajewski, “The Most Significant Long-Term Consequence of the U.S. Strikes on Iran”, Carnegie Endowment, June 26, 2025, available at: https://short-url.org/1c4D3
[40] Ibid.
[41] عبد الرحمن فهيم، “الحرب بين إسرائيل وإيران، الذاكرة، دينامية المواجهة، والتعتيم الاستراتيجي”، 1يوليو 2025، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، متاح عبر الرابط التالي: https://short-url.org/1c4Dq
[42] سماح عبد الصبور، “التغيير والاستمرارية في السياسة الإيرانية تجاه العالم العربي منذ طوفان الأقصى”، تقرير اللقاء العاشر من منتدى مركز الحضارة للدراسات والبحوث، 27 أبريل 2025، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، متاح عبر الرابط التالي: https://short-url.org/1c4DA
[43] نادية مصطفى، مصدر سابق.
[44] المصدر السابق.
[45] سماح عبد الصبور، مصدر سابق.
نشر في العدد 39 من فصلية قضايا ونظرات – أكتوبر 2025