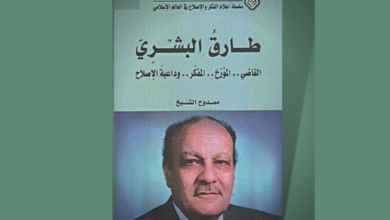إشكالية الوافد والموروث: قراءة في ضوء كتاب ماهية المعاصرة

مقدمة*:
“وقد دعوت الله تعالى أن أكون لا على ملك أحدٍ من الناس، وأن أكون على ملكه تعالى، ورجوته وأرجوه تعالى أن يُبقي على مُلكي التام تلك المساحة الصغيرة التي لا تُجاوز حجم الحصاة، والتي تقع بين سنّ القلم وسطح الورق، وأن يُبقيها لي حرمًا آمنًا لا تنفتح لغير النظر والفهم، ولا تنفتح لدخَل أو غصب أو غواية“[1].
بهذه الكلمات أوضح المستشار “طارق البشري” انتماءه وتموضعه في ظل تعدد خلفياته ومناصبه العلمية والعملية؛ فهو ابن لأسرةٍ اشتُهرت بالاشتغال في العلوم الإسلامية والقانون، حيث إن جده لأبيه تولى مشيخة المالكية في مصر، ووالده -المستشار عبد الفتاح البشري- كان رئيسًا لمحكمة الاستئناف، وعمه عبد العزيز البشري أديب معروف، ومن الناحية التعليمية فقد درس على يد كبار فقهاء القانون والشريعة أمثال عبد الوهاب خلاّف وعلي الخفيف ومحمد أبو زهرة، وتخرج في جامعة القاهرة عام 1953.[2]
وعلى مستوى الخبرات العملية، فقد عُيِّن نائبًا أول لمجلس الدولة، ورئيسًا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع واستمر في هذا المنصب حتى تقاعده عام 1998، كما عينه المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة في مصر 2011 رئيسًا للجنة تعديل الدستور عقب ثورة 25 يناير[3].
أي إننا أمام شخصٍ تتضافر فيه جوانب التربية والتعليم والعمل لتُجسد نموذجًا لا يُمثل تفرد الشخصية التي نحن بصدد الحديث عنها فحسب؛ بل يُجسد نموذجًا أوسع وأشمل للتفاعل مع الأزمة القديمة -الجديدة التي تمر بها الأمة منذ بدء أفول نجم الحضارة الإسلامية وبدء احتلالها عسكريًا وفكريًا. فالبشري بخلفيته العائلية المنتمية للأزهر الشريف وشخصه الذي درس القانون وعمل في مناصب تنفيذية في الدولة، والأهم، مروره بتجربة التحول من “العلمانية” -التي تُمثل العالم المادي الحديث- إلى الإسلامية لأسبابٍ أبرزها -في رأي الباحث- عدم قدرة الأيديولوجيات أو القناعات السابقة له على تقديم إجابات على أسئلته المعرفية والوجودية، إلى جانب ارتباط هذا التحول بالشعور بوجود خطرٍ حقيقي على الذات من الآخر، ما يجعلها تعود للتمسك بمرجعيتها التراثية لمجابهتها[4].
جميع ما سبق يجعل “البشري” لا يُمثل نفسه بوصفه الشخصي الفردي فحسب، بل يُجسد نموذجا للتعامل مع الأزمة الفكرية -الحياتية التي تعيشها الأمة المشتتة بين حضارتين ومنهاجين مختلفين للحياة؛ كلٌ منهما يتبنى أسس ومعايير، تتباين بدورها تباينًا كليًا أحيانًا، وتتفق جزئيًا أحيانًا أخرى. هذا، خصوصًا أن الجدل حول التحديث والتراث هو جدلٌ مستمرٌ ومتجدد في المجتمع الإسلامي الذي يبدو وكأنه يحيا بقلبين، أو كأنه يعيش في عالمين منفصلين: أحدهما هو عالم الإسلام الذي يفرض على المسلم مجموعةً من القواعد التي تحكم حياته وتنظمها وفقًا للمنظومة العقدية الإسلامية، والآخر هو العالم المادي الحديث الذي تحكمه قواعد الرأسمالية والوضعية وتُجبره على التخلي عن جزءٍ من قواعد منظومته العقدية لكي يتعايش وينجو في ظله.
هذه الفجوة بين العالمين دفعت المجتمع –وفي قلبه المفكرون- للتساؤل: ما العمل؟ وكيف يمكن التوفيق بين هذين العالمين؟ بل هل من الممكن أن يتم التوفيق بينهما من الأساس؟
في هذا السياق، تأتي سلسلة “في المسألة الإسلامية المعاصرة” التي كتبها المستشار البشري في محاولةٍ لتشريح الأمة الإسلامية في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية؛ سعيًا لاستكشاف أوجه الخلل التي أصابتها، وكيفية النهوض بها مجددًا. بعباراتٍ أخرى، يسعى البِشري لتفنيد التطورات والتحولات التي طرأت على المجتمع المسلم الذي يُحاول التحرر من قبضة التبعية الإدراكية -العملية للغرب، من خلال طرح أسئلة تتعلق بكافة مناحي الحياة لاستكشاف ماهية ومقدار التغير أو التشوه الحادث، وكيفية تعديله أو تغييره بما يُحرك المجتمعات الإسلامية نحو عملية تغيير حضاري اجتماعي وسياسي حقيقية تتناسب وعالمهم.
- منهج الكتاب:
انتهج البِشري في هذا الكتاب منهجًا يجمع بين العرض التاريخي للأحداث -مستندًا في ذلك لخبرته مؤرخًا- والخبرة العملية والتطبيقية (المؤسسية)، غير غافلٍ عن الجانب التحليلي والتفسيري لكلٍ من الجانبين؛ فهو حين يعرض التسلسل التاريخي للأحداث وتجلياتها العملية -التطبيقية في الواقع المعيش نجده يعمد إلى تكوين رؤية كلية لتاريخ العصر الذي يرصده من خلال “الأمة” التي يعتقد في “وحدة تاريخها”، وهو ما ينُم عن تصور واضح وقوي في ذهنه لمفهومها وتجلياته وأهميته في تحقيق نهضة إسلامية حقيقية[5].
هذا إلى جانب عدم التسليم بما يُروى تاريخيًا وإعادة قراءته مرةً أخرى؛ باعتبار أن عملية التأريخ تتأثر بالجانب الذاتي للمؤرخ الذي يجعل الواقعة نفسها تختلف في تحليلاتها من مؤرخٍ لآخر؛ ذلك لأن عملية التأريخ -في رأيه- أشبه بعملية حوارٍ جدلي بين ذات الدارس والحوار المدروس[6]، كما أعاد البشري تفسير ما قدمته الأيديولوجيات المختلفة كالقومية والليبرالية والاشتراكية وغيرها من المنظورات، فيما يتعلق ببعض القضايا المهمة الكلية والجزئية على حدٍّ سواء[7].
أهمية الكتاب في السياق الراهن:
تتصاعد أهمية موضوع الكتاب في سياق الأوضاع التي تعيشها الأمة الإسلامية من بعد طوفان الأقصى الذي أحدث تغييراتٍ كبيرة في المجتمعات العربية والإسلامية من حيث “الأسئلة الكبرى” التي طرحها؛ ففي ظل العدوان الغاشم على غزة وصبر أهلها بدأ الحديث عن العقيدة الإسلامية واسترجاع مفاهيم كان قد خفت حضورها في الذهن المسلم مثل مفهومي “الأمة” و”الجهاد”، إلى جانب الاتجاه إلى حركة مراجعة مجتمعية -فكرية حقيقية للمرجعية الحاكمة للأفراد فيما يتعلق بالنظرة للغرب والتماهي مع منظومته الفكرية والأيديولوجية ومدى توغلها وهيمنتها على العقل العربي المسلم. أي نستطيع القول إننا ربما نكون في بداية مرحلة “صحوة إسلامية-عربية” كتلك التي حدثت في أعقاب نكبة 1967 وأعادت بعض المفكرين العلمانيين -ومنهم البشري- إلى “أحضان السماء” مرةً أخرى. وبغض النظر عن آفاق هذه المرحلة وعن المدى الذي قد تصل إليه، فإن قضية “المرجعية الحاكمة” تُعد قضية حساسة لا بد من التعرض لها مجددًا في هذه الظروف لتجنب أخطاء الماضي، وإننا في هذه الورقة نسعى إلى ذلك من خلال التعرض لأحد أهم كتب البِشري ضمن سلسلته، وهو كتاب “ماهية المعاصرة” الذي تعرض فيه بتفصيلٍ لمسألة “الموروث والوافد” والعلاقة بينهما في ظل “المعاصرة”، إلى جانب عرضه وتحليله للتيارات الفكرية السائدة: “الاشتراكية، القومية، الديمقراطية”؛ إلَّا أننا سنتعرض لمسألة جدلية الموروث والوافد فحسب في هذه الورقة لاتصالها الوثيق بما سبق ذكره من سياقاتٍ وتطورات.
في رأي الباحث، يُعد التعرض لهذا الكتاب ضرورة ملحة في هذا الظرف التاريخي الذي ربما يُشكل بدايًة حقيقية لعملية تغيير حضاري واسعة؛ وذلك لأن المسائل التي طرحها الكتاب ما تزال محل نقاشٍ وجدلٍ حتى اللحظة بالرغم من أن المستشار البشري قد قدّم ما يمكن أن نُطلق عليه “الخيط الناظم لحركة التغيير الحضاري” التي من الممكن أن تبدأ بها الأمة مشوارها نحو عملية التغيير تلك، بما يُناسب واقعها المعيش وأولوياتها الملحة.
- أبرز أفكار الكتاب:
“فأنا لا أعرض لموضوع العصرية والمعاصرة، وإنما أعرض للقيمة والمفهوم المتعلق بهذا الموضوع. وأنا لم أنظر في الموضوع إنما نظرت في الذات، لم أتكلم عن المرئي إنما تكلمت عن العين التي ترى، حديثي لم يكن عن “الشيء” إنما عن “الوعي بالشيء”، ليس عن الأمر المدرَك، ولكن عن الإدراك ذاته”[8]، من خلال هذه الكلمات نستطيع أن نستنبط الخيط الناظم الذي يجمع أفكار البشري جميعها في هذا الكتاب؛ حيث إنه يُركز بشكلٍ كبير على ما يمكن أن نطلق عليه “قوة التصور” أو “الرابطة التصورية” التي يُحدد من خلالها مدى تحقق فكرة أو توغلها في المجتمع الإسلامي من عدمه.
فعندما يُحلل البشري مفهومًا مثل “المعاصرة” أو “حركة الإصلاح الديني”، أو عندما يتعرض لأيديولوجيا مثل الاشتراكية أو القومية، نجده يتحدث عن تصور الفكرة وتجلياتها في أذهان مريديها، ومدى تأثيرها وفقًا للجهة المتلقية أو الـمُلقية في وقتها؛ وفقًا لسياقها وأهميتها فيه، هذا فضلا عن تداعياتها فيما بعد على الأمة ككل لا على الدولة التي نشأت فيها فحسب.
وفي أثناء تعرضنا للأفكار الرئيسة في الكتاب وتحليلها، سيعتمد الباحث على ما يمكن تسميته “ميكانزمات الفكرة” التي يتعرض لها، وتشمل هذه الميكانزمات: السياق الذي نشأت فيه الفكرة، هل تُعد فِعلًا أم رد فعل؟، دخولها في الوعي (الرابطة التصورية)، المسلمات التي تعتنقها، مدى تداخلها مع التيارات المختلفة، تصورها عن الوقت والزمان، واللغة المستخدمة في التعبير عنها. وذلك لتكوين رؤية أكثر شمولًا وتحليليةً للفكرة، وهو ما يُسهِّل عملية فهمها وتطويرها بما يتناسب واللحظة الحالية، ودافع الباحث لاختيار هذا التصنيف هو قول البشري نفسه:
“وأعترف بأن هذه الدراسات بالتحديد كانت تحمل بالنسبة لي شخصيًّا بُعدًا مهمًّا جدًّا، بمعنى أنني كنت أكتشف نفسي وأنا أعد كلا منها. ولولا أني لا أريد أن أُثقل على القارئ لاستطردت في هذا الأمر أحكي كيف كنت أحتشد لكل دراسة منها، وأقرأ، وأُطيل التفكير، وأجد عناصر في تفكيري السابق تذوي وتتحلَّل وأخرى تبدو، ويستدرجني النسق الداخلي للأفكار المختلفة فأعيش منطقها الذاتي، ثم أتكشف ما لم أكن كشفته، ثم أكتب وأقرأ ما أكتب، فإذا به يجري على غير مألوف ما كنت أصنع من قبل، وإذا بتداعي المعاني يُدهشني، فأبقيه زمانًا ثم أعاود النظر فيه تشذيبًا وتنقيحًا، ومن خلال هذا الجهد وهذه العملية حدث عندي الإحلال الفكري بين ما ذوى وتحلَّل من أصولٍ فكرية كانت تشدُّني، وبين ما قام واستقام من أصولٍ فكرية أخرى أجري على دربها اليوم”[9].
وهو ما يؤكد أن ما سبق من عناصر يلعب دورًا مهمًا في عمليتي التحليل والفهم، كما أن القراءة في فكر البشري لا تعد فقط قراءة أو دراسة بل عملية مستمرة من الوصل والقطع والبناء والهدم، وهو ما يجعل الباحث لديه قدرة على الحركة في ثنايا الفكرة وأكثر مقدرةً على فكها وتركيبها بما يخدم السياق الحالي له، كما سبقت الإشارة.
ولا يفوتنا أن نُشير إلى البُعدين الحاكمين لكل ما يرد من أفكار في سلسلة “في المسألة الإسلامية المعاصرة”، وهما: تشخيص الانقسام والازدواجية في المجتمع الإسلامي (الصدع)، وكيفية رأب هذا الصدع وإصلاح الخلل[10]. حيث إن هذين العاملين يتضافران معًا كجديلتي شعرٍ لا يستقيم أحدهما دون الآخر. وهو ما يُبرز إدراك البشري لأهمية الشق العملي والتنفيذي في أطروحته، متلافيًا بهذا الإشكالية التي يتعرض لها أغلب المفكرين والمنظرين الذين يطرحون توصيفًا للمشكلة دون توضيح طريقة علاجها، ويمكن رد هذا لخلفية البشري التنفيذية والمؤسسية لعمله في أجهزة الدولة، ووضع يده على جوانب الخلل من خلال الممارسة العملية لا النظرية فحسب.
- جدلية الموروث والوافــد
قبل الدخول في قلب الفكرة التي يطرحها البشري، كان لزامًا علينا أن نُوضح الأداة أو المنهج التحليلي الذي سنتعرض لهذه الفكرة من خلاله، ألا وهو ما ورد في مقدمة ابن خلدون: “في أن المغلوب مولعٌ أبدًا بتقليد الغالب”؛ ومرد ذلك أن فكرة الانسلاخ عن المرجعية الإسلامية والتوجه نحو المرجعية الغربية جاء من اعتقاد مفاده أن الغرب تقدم لسمو الأفكار التي يعمل بها والرؤية الحضارية التي يتبناها، وبناءً على هذا، فإنه يجب على كل من هم ليسوا بـ”غرب” أن يحذوا حذو الغرب لكي يتقدموا مثله وهو ما يُنتج حالة الانقسام أو الازدواجية بين ما يمثل المرجعية الرئيسية لهذه الحضارة -التراث في حالتنا- والمرجعية الوافدة عليها.
والحقيقة أن عملية التبعية تلك تستند إلى أساسٍ نفسي لا عقلي؛ حيث إن هذه العملية -في رأي الباحث- تماثل مفهوم الهيمنة باعتبارها سيطرة مجموعة على أخرى من خلال معايير وأفكار شرعية تدعمها، أي أنها عملية اختيارية بالرغم من كون فكرة “الغلب” نفسها ترتبط بعلاقات القوة بين الغالب والمغلوب وما تحمله من تفاعلات بين ما هو داخلي وأممي من ناحية موازين القوى، كما أن عملية “التقليد” تلك تمثل عملية اقتداء تدريجي يقوم بها الطرف المغلوب وتحدث على خطوتين: الأولى تكون باعتبارها وسيلة لمكافأة قوة الغالب فنجد المغلوب يستورد منه ما يجد فيه أسباب غلبته كالمنظومة العسكرية التي كانت أولى المؤسسات التي استوردها حكام العالم الإسلامي، ونلاحظ أن هذه العملية تتم بشكلٍ سطحي -لا تصل للجوهر: تقليد الشعار والزي والنِحلة، وتشرب المسلمات الفكرية والأيديولوجية للآخر، ثم تنتقل عملية التقليد من مجالٍ لآخر[11].
ولسرعة الوتيرة التي تتم بها هذه العملية، فإنها تتحول من اقتداءٍ لولعٍ بالتقليد؛ وهو ما ينقلنا للخطوة الثانية وهي “الفناء في الغالب”، حيث يقوم المغلوب بافتراض غَلبة الغالب لكماله ورد الهزيمة لهذا السبب لنزع المسؤولية عن نفسه وإعفائها من المحاسبة والمراجعة تحاشيًا للشعور بالذنب[12]. والحقيقة أن صدمة الهزيمة أصابت المجتمع الإسلامي بارتباكٍ حقيقي جعله يخلط بين أسباب القوة ومظاهرها، وهو ما يبرر اتساع عملية التقليد تلك وتعميق علاقة التبعية بين الغالب والمغلوب حد الفناء والابتلاع الكامل. وفي حالة مناقشتنا لفكرة الموروث والوافد عند البشري نلحظ هذا واضحًا في ذهنه، وإن لم يُشر له بصريح العبارة، حيث قال:
“إن السؤال الكبير الذي ينطرح الآن، يتعلق بما نأخذ وما ندع من الموروث ومن الوافد. لقد انطرح هذا السؤال طوال الأعوام المائة الأخيرة. ولكن يمكنني الزعم بأن “التخيير” الذي يعرضه هذا السؤال قد اختلفت موازينه الآن عمّا كانت منذ مائة عام. كنا في الماضي نقف على أرض الموروث، ونتحاور فيما يصلح لها من حضارة الغرب وأدواته لندخله عندنا. ثم صرنا -أو صارت كثرتنا- نقف على أرض الوافد أو أرضٍ خليط، ونتحدث عن التراث بضمير الغائب، ونتحاور فيما نستحضره منه. ونحن نتساءل الآن عما نستدعي من “التراث” بعد أن كان آباؤنا يتساءلون عمّا يأخدون من الوافد!”. وهو ما يؤكد إدراك البشري لفكرة ابتلاع العقل المسلم في إطار المنظومة الغربية الحداثية، وفنائه فيها حد التملص التام من تراثه ومرجعيته الأصلية.
ونستطيع أن نلحظ أيضًا ما سبق وأشرنا له عن إدراك البشري لمسألة “وضوح وقوة الرابطة التصورية” في الذهن في تناوله لهذه المسألة؛ حيث أشار إلى أن لفظة “التراث” لم تكن ترد على ألسنة الكتاب وأقلامهم في الأجيال السابقة كما لا ترد على ألسنة من يصنفون أنفسهم باعتبارهم “تراثيين” ولا في كتاباتهم بالشكل الكبير ويستخدمون عوضًا عنها لفظ “الإسلام”، بينما لفظة “التراث” تتكرر على ألسنة وأقلام “الجمهرة من أبناء الفكر الوافد”؛ وقد وصف هذا بأنه “مفارقة” لأنها لا تتعلق فقط باختلافهم في التعبير عن مسمى واحد، بل لأن كلا الطرفين ينطلقان من رؤية متباينة لذات الظرف التاريخي والسياق. وهو ما يمكن ردُّه لافتراض د.عبد الوهاب المسيري حول أن كل فريق تحكمه خريطة إدراكية تتكون وفقًا لبنية متكاملة توجد في سياق أفكارٍ متعددة وفي سياق الممارسات التي يقوم بها حاملو هذا الفكر، وتكون هذه الخريطة وما تنتجه من أفكار وممارسات مماثلة لبنى اجتماعية واقتصادية وأخلاقية توجد في المجتمع[13].
وعليه، فالسؤال حول “ماذا نأخذ من التراث؟” يحمل دلالًة أكبر تتعلق بإشكالية العلاقة بين الذات والآخر وسؤال الهُوية؛ حيث إن عملية التحديث أو التغريب التي حدثت للمجتمع لم تُحدث شرخًا فحسب بل خلقت مجتمعين متمايزين يقف كلٌ منهما على أرضية مختلفة لأن فكرة “التخيير” بين الموروث والوافد تُفيد تحررًا للذات عن تراثها وإحداث قطيعة معه لكونه ماضٍ غابر وعائق للتنمية.
وأوضح البشري أن الأزمة في أصلها أزمة تصور؛ فالفئة الأولى ترى الإسلام (التراث) كيانًا ينهض ويناهض وعلاقته بالوافد علاقة تحدٍ ومواجهة، والفئة الثانية تتحرر منه وتنظر له نظرة الغريب الغابر.
- مفهوم العصر، العصرية، ووحدة العصر
ولتفنيد مصدر التصورات السائدة في هذا الصدد يعمد المستشار البشري إلى التعرض للسياق التاريخي الذي وفدت فيه الأفكار الغربية على المجتمع الإسلامي وبعض المعايير التأسيسية؛ فيوضح أن العقيدة الإسلامية تُشكل الأصل والميزان لا الموزون، حيث إن الإسلام يتجاوز كونه دينًا عباديا فحسب، بل يُشكل رباطًا سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا كوَّن كيانًا حضاريًا ينتمي له المسلمون كأمةٍ واحدة كجماعة ممتدة عبر التاريخ، وهو بهذا “الميزان لا الموزون”؛ أي الأصل. كما أن العدول عن هذا الكيان الحضاري يُفيد فقد الهوية، والتخلي عن جزءٍ منه يخلخلها، وأن النظر في إصلاحه يكون بمادته العقيدية الحضارية من خلال التطوير والتعديل وإعادة التركيب، لا عبر الانخلاع والانسلاخ عنه. وأن عملية “إضافة” أيٍّ من عناصر الوافد إنما يكون بما يخدم صالح الجماعة ولا يخل بالتجانس العقدي -الحضاري لها. ويوضح البشري أن النظم الغربية وفدت إلينا تحت عنوان “المعاصرة” و”العصرية”، وأن هذا الاسم وما يحمله من دلالة تفيد التنافي بينه وبين الموروث الحضاري الذي يُحمَّل دلالة تفيد التخلف والرجعية.
ولهذا نجده يُحرر مفهوم العصر والعصرية، فيوضح أنه إذا ما نظرنا للعصر باعتباره “جملة الظروف والأوضاع التاريخية، والحضارية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية في وقتٍ ما”، فإننا نستطيع أن ننقد مفهوم “العصرية والمعاصرة” الذي جلبته الحضارة الغربية؛ حيث إن الظروف التي مر بها المجتمع الأوروبي قد أفرزت المنظومة الحداثية كنتيجة لها وحل لأزماته ومشكلاته، ولأنها أتت كاستجابة لهذه الظروف تحديدًا فقد آتت بثمارها في المجتمع الأوروبي وأدت لتقدمه، على العكس من المجتمع الإسلامي الذي جاءت فيه المنظومة الحداثية كعنصرٍ دخيل على الوضع الداخلي والمنظومة القيمية والعقدية له ما أدى لفرضها عليه جبرًا من قِبل الوفود العسكري والاقتصادي والسياسي، وهو ما خلق مجتمعين متمايزين وأنماطًا متغايرة في الفكر والنشاط والسلوك. ونجده ينقد -في ظل هذا- فكرة “وحدة العصر” التي رآها أداةً لخدمة المصالح الاستعمارية للدول الغربية التي كانت تسعى لخلق فكرة جامعة (رابطة تصورية) تجمعها والمستَعمَرين لتسويغ حكمها وتقديم نوع من الوحدة بينهما ولعزل المجتمع التقليدي ودوائره الفكرية.
ويُوضح البشري أن فكرة الوحدة الزمنية بين الغرب والشرق هي ما تفصل بينهما في الأساس؛ باعتبار أنها تفترض وحدة الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تمر بها الأمم على اختلافها وتباينها. ويتعجب من كيفية نفاذ هذا التصور للذهن في المجتمع المسلم خصوصًا وأنه يقسمه لشطرين، شطر يرى نفسه محمولًا مع المستقبل وآخر يرى نفسه مطرودًا مع نفايات التاريخ؛ حيث تحول مفهوم “العصر” من عنصر ثقافي إلى قيمة ثقافية حضارية يتبلور مفهوم الأمة وفقًا لها، وهو ما يفترض وحدة التاريخ والجماعة باعتبار التاريخ في جوهره صيرورة جماعة ما تتحرك في الزمان. وهو ما يعبر عنه “جورج أورويل” في عبارته البليغة: “من يملك الحاضر يُسيطر على الماضي”.
ذلك علمًا أن عملية الانخلاع الزماني واستخدام التحقيب الزماني الغربي أدى لتكريس علاقة التبعية بين المستعمر والمستعمَر وتعميقها؛ فنجد أن العلاقة بينهما لا تقوم على أساس تبادل السببية الذي يفترض فك الاشتباك بينهما بل على أساس تقويض الذات وخصوصيتها باعتبارها عائقًا لاستكمال عملية التنمية للحاق بركب الحضارة والدول المتقدمة، وهو ما أدى للإفساد من حيث أراد المسلمون الإصلاح. ويُطلق البشري على العصر الذي يحياه العالم الإسلامي في المئتي سنة الأخيرة “عصر التبعية ومقاومتها”، حيث إن العالم الإسلامي يعيش في حالة فِصام بين ما يريده وما يُفرض عليه، وفي حالة من التقسيم والتجزيء المستمر لأقطاره من خلال تشويه تصوره عن مفهوم “الأمة” وتكريس فكرة “الدولة القومية” كبديل لها.
- التشوه المجتمعي، علمنة النخب والدولة، وعملية الإصلاح
يوضح البشري أن حالة الفِصام تلك لم تؤد فقط لوجود صدعٍ في المجتمع؛ بل أدت لوجود تصور مشوه عن فكرة “الإصلاح” وطريقة رتق هذا الصدع، خصوصًا وأن الازدواجية الثقافية بين التيارين تتجاوز المجال الفكري لتصل للمجالات المادية الواقعية والسلوكيات، حيث إن الوافد الأجنبي لم يرد “كفكر” فقط بل كمنهج حياة له أدوات ومكتشفات مادية -كالتطور التكنولوجي مثلًا- محققة على أرض الواقع حد التغيير في البيئة قبل إدخاله كفكر.
ويجادل البشري بأن علمنة النخب في المجتمع المسلم، بل وعلمنة الدولة نفسها، أدت لتوليد الاستبداد في العالم الإسلامي وتكريسه -بالرغم من أنها في السياق الغربي أدت لتوليد دولة ديمقراطية- وذلك لأنها لم تنبثق عن الجماهير ولا ترتبط في ذهنها بإطارٍ إيماني تتبناه وتحرسه -باعتبار أن الثقافة السائدة في المجتمع الإسلامي هي ثقافة تستند للمرجعية الإسلامية- وهو ما جعل التنظيمات النيابية جوفاء بغير مضمون يتعلق بمجمل الحقوق والواجبات الملتزم بها، وصارت الشرعية في أحسن الحالات شرعية إجرائية فحسب:
“ومن هنا فالحكومات تتمسك بالعلمانية.. لا إيمانًا بوصفها فلسفة.. بل إطلاقًا لممارستها من أي قيدٍ حقوقي يرد من خارجها، فهي لم تعد فقط ذات قرارات شرعية بل صارت هي الشرعية ذاتها وهي القوامة على مصدر الشرعية وهي راسمة الإطار المرجعي.. وموقف الدولة من المرجعية الوضعية موقف ذرائعي وليس موقفًا عقيديًا.. كذلك شأن النخب السياسية والاقتصادية التي تنشط في إطار النظام السياسي والاجتماعي الذي تقوم عليه الدولة وتسمح به.. والنخبة الفكرية.. يغلب عليها الطابع العلماني بوصفه فكرًا تتبناه وتدافع عنه.. وتستهدف أن يسود في المجتمع، ومنها يصدر كل هذه المعارك الفكرية وصخبها.. وفكرها له ثبات واستمرار لأنه تقوم على تدريسه كليات العلوم الإنسانية بالجامعات الحديثة.. ولكنه فكر لا يذيع بين الجماهير.. وأن مشكلة النخب الثقافية التي يغلب عليها الطابع العلماني إن منهم من يغفل عن حقيقة أن نسقًا فكريًا إذا ما انتُزع من سياقه الاجتماعي الثقافي التاريخي، وزُرع في سياقٍ مغاير.. قد يقوم بأداء وظيفي عكس ما يقوم به في السياق المأخوذ منه”.
وهو ما يظهر واضحًا جليًا في تصور الإصلاح الراديكالي الذي يفترض القضاء على نظام وإحلال نظام آخر محله في العالم الإسلامي؛ حيث نفترض أنه تم القضاء على نظامٍ ما تمامًا من خلال القضاء على رأسه فحسب، ولكن الواقع المعاش يُثبت خطأ هذا الافتراض باعتبار أن النظام يشكل شبكة من العلاقات والمعتقدات والتصورات التي ترسخت في العقل الجمعي للجماعة بالتوازي مع المؤسسات الحاكمة، وأن عمليات “الإصلاح” في العالم الإسلامي لا تُعدَّل هذه التصورات في مرحلة انتقالية وإنما تدخل في عمليات من الهدم والبتر والإقصاء، دون الدخول في النسق العقدي والفكري لهذه النظم ومحاولة تفكيكها، وهو ما ينتج عنه دول هجينة ومشوهة.
خاتمة:
في تصوّره للحل، فإن المستشار البشري يُحرر مفهوم “التجدُّد الحضاري” باعتباره لا يعني طرح الحضارة الأصل وإيجاد حضارة بديلة، بل هو إدخال تعديلات في تكويناتها الفرعية وفي علاقات عناصرها ببعض، واستيعاب بعض المستجدات الجزئية في إطارها الكلي؛ لتتلاءم مع الأوضاع الطارئة بما يدفع عنها الخطر المحدق بالجماعة. حيث إن هذا التجدد مشروط بألَّا يفسد أو يشوِّه التكوين العام للجماعة، بل أن يقوي من وحدتها وتماسكها لا أن يقسمها لمجتمعين متمايزين كما هو حادث.
إن هذا الأخذ من الوافد الذي يتم من خلال النماذج التنظيمية كعلوم الصنائع وفنونها، وعلوم الإدارة، ومبدأ التمثيل الانتخابي وتكوين المجالس النيابية وغيرها من الأساليب الديمقراطية، لا بد أن يستند إلى الإرادة الجماهيرية المؤمنة بالمرجعية الإسلامية كحاكم لها كي تشارك الجماهير في العملية السياسية وتحرسها. ونستطيع أن نلحظ الجانب التوفيقي لفكر البشري؛ حيث إنه نفى وجود علاقة ارتباطية أو إلزامية للأخذ بالنظام الديمقراطي وأساليبه مرفقًا بالمرجعية العلمانية والوضعية للنموذج الغربي؛ فمن الممكن أن نأخذ بالنموذج الديمقراطي باعتباره نموذجًا تنظيميًا إجرائيًا -أو إداريًا- يمكن صبه في إطار المرجعية الإسلامية ليقوم على أسسها وعقائدها. هذا لأن الإسلام قد أباح الاجتهاد في الفروع -التي تُعد الآليات التنظيمية جزءًا منها- وفقًا للمصالح المرسلة للجماعة.
________
هوامش
مراجعة وتحرير: شيماء بهاء**
* طارق البشري، ماهية المعاصرة، سلسلة في المسألة الإسلامية المعاصرة، (القاهرة: دار الشروق، 2007).
* طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
** باحثة بمركز الحضارة للدراسات والبحوث.
* هذا العرض لكتاب “ماهية المعاصرة” هو أحد تكليفات “مدرسة التأسيس في المنظور الحضاري” التي نظمها مركز الحضارة للدِّراسات والبحوث في الفترة سبتمبر – ديسمبر 2024.
[1] طارق البشري، الديمقراطية ونظام 23 يوليو (1952- 1970)، (القاهرة: دار الشروق، 2013).
[2] طارق البشري، الجزيرة نت، 28 سبتمبر2014، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/0hMaXGa2
[3] المرجع السابق.
[4] أحمد عبد الرحمن خليفة، تحول البشري من العلمانية إلى الإسلامية: قراءة في كتاب “الحنين إلى السماء: دراسة في التحول نحو التوجه الإسلامي في مصر في النصف الثاني من القرن العشرين” (تأليف: هاني نسيرة)، موقع مركز الحضارة للدراسات والبحوث، 1 مارس 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3X2YVuS
[5] د. نادية مصطفى، البناء الفكري لطارق البشري: قراءة في المسألة الإسلامية المعاصرة، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، 29 إبريل 2016، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/4jYx4FP
[6] طارق البشري، تفسير التاريخ ومفهوم المعاصرة، محاضرة تم القاؤها في يناير 2000، نُشرت على موقع يوتيوب بتاريخ 23 يونيو 2021، متاحة على الرابط التالي: https://2u.pw/z0j59q3x
[7] د. نادية مصطفى، مرجع سبق ذكره.
[8] طارق البشري، ماهية المعاصرة، مرجع سابق، ص71.
[9] طارق البشري، الحركة السياسية في مصر، (القاهرة: دار الشروق، الطبعة الثانية، 2002)، ص11.
[10] د. نادية مصطفى، مرجع سبق ذكره.
[11] د. محمد صفار، محاضرة لمقرر نظرية سياسية 1 (وهي في إطار محاضرات غير منشورة حضرتها الباحثة)، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2023.
[12] المرجع السابق.
[13] د. عبد الوهاب المسيري، دفاع عن الإنسان: دراسات نظرية وتطبيقية في النماذج المركبة، (القاهرة: دار الشروق، الطبعة الثانية، 2006)، ص ص 296-297.