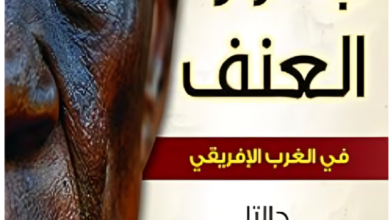عندما يقتل السلام السياسة

مقدمة:
مع انقلاب عام 1989 صعد البشير عبر تحالف إسلامي إلى السلطة في السودان، من أجل إنقاذ البلاد من الحرب الأهلية التي لم تنته في الجنوب؛ إلا أن البشير قام بإبعاد الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، وفرض مشروع إعادة هندسة اجتماعية جذرية، وذلك في لحظةٍ تاريخية من تطور النظام الدولي ألا وهي التدفق الجيوسياسي في نهاية الحرب الباردة، والتي كان من نتائجها أن السودان أصبح ذا أولوية أكبر في السياسة الخارجية بالنسبة للقوة المهيمنة الجديدة، الولايات المتحدة.
ولقد اشتدت الحرب الأهلية في الجنوب ولم تقل وتيرتها بأي شكلٍ من الأشكال؛ حيث اتسمت تلك الحرب بانتشار المجاعات، والإبادة الجماعية، والتهجير القسري، والاعتقال والعمل القسري، والاغتصاب الممنهج، والنهب على نطاقٍ واسع. ذلك مع تقديراتٍ تشير إلى مقتل ما بين مليون إلى مليوني شخص بسبب الحرب، ونزوح 4 ملايين شخص داخليًا وكلاجئين في دولٍ أخرى، وقد احتاج السودان خلال تلك المرحلة إلى أكبر جهد إغاثي إنساني في العالم.
-
منهجية الكتاب:
تعرض تلك الورقة لكتاب “عندما يقتل السلام السياسية: التدخل الدولي والحروب التي لا نهاية لها في السودان[1]“، ويُركز الكتاب على مخاطر صنع السلام من خلال التدخل الخارجي؛ سواء كان من قبل القوى الدولية أو المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة. علمًا أن من المعروف أن من وجه أنظار العالم للحروب في السودان كانت المنظمات الدولية والإغاثية.
فمع بداية الألفية الجديدة، كانت السودان تُعاني حربين أهليتين على أرضها: أولاهما في الجنوب ومستمرة منذ عقود، بينما الثانية الحرب التي اشتعلت في دارفور في 2003، وكانت عملية صنع السلام هي المحرك الأساسي للحركة في السودان وفي الإقليم وعلى المستوى الدولي، فمنذ أواخر التسعينيات وحتى الوقت الحاضر في العقد الثالث من الألفية، يمكن إحصاء أكثر من اثنتا عشرة مبادرة سلام تعالج صراعات تضم عشرات الجماعات المسلحة في السودان. ومع ذلك، فقد فشلت معظم جهود صنع السلام الخارجية لإنهاء الحرب وطرح سياسة مدنية جديدة داخل البلاد، وكان من الصعب التوصل إلى اتفاقات السلام أكثر عمقًا، سواء كانت صفقات إصلاح سريعة أو تسويات نخبوية معقدة واتفاقات مؤسسية، أما مبادرات السلام التي نجحت فغالبًا ما تتفكك بسرعة أو تتحول إلى صراعٍ أكثر عنفًا مما قبل -كما سيأتي التناول.
يتطرق هذا الكتاب إلى العلاقات العميقة بين الصراعات المختلفة ومبادرات صنع السلام المتنوعة في السودان، ومن ثم يدرس أيضًا استراتيجيات وسلوكيات الجهات السياسية المحلية وتدخلات القوى الدولية تجاه صنع السلام، باعتبار تلك الأمور جزء من منطق الحروب التي لا تنتهي في المنطقة. وعليه، ينقسم هذا الكتاب إلى تسعة فصول حول الحرب في كلٍ من جنوب السودان ودارفور، وفيما يأتي مزيد من التفصيل في هذا الشأن.
-
محتوى الكتاب:
1- إعادة التفكير في عملية صنع السلام:
يطرح هذا الفصل السؤال التالي: هل التدخل الدولي من أجل صنع السلام كان ناجحًا؟ يؤكد الفصل أنه في بداية الألفية الجديدة كان الذائع أن التدخلات الدولية في الصراعات المسلحة قادرة على إنهائها، وفرض السلام من خلال المفاوضات والاتفاقيات. إلا أن السودان تطرح نموذجًا مختلفًا عن تلك الفرضية، فالسودان وبعض من الدول الأخرى تطرح فرضية حرب- سلام -حرب في دائرة مغلقة لا تنتهي.
يُركز هذا الفصل على الأسباب التي تجعل التدخلات الخارجية لصنع السلام في الحروب الأهلية عُرضةً للفشل، خاصةً في حالتي السودان وجنوب السودان، وذلك من خلال تحليل “اتفاقية السلام الشامل” في السودان وتفسيرات فشلها، ثم ينصب تركيز الفصل على تقديم طريقة مختلفة لفهم العلاقة المضطربة بين صنع السلام، ومنطق العنف، والعمل السياسي المدني من خلال عدسة حنا أرندت في تحليلها للمفاهيم الثلاثة.
2- الصنع: المبادرات المتنافسة لصنع السلام في السودان
يشرح هذا الفصل كيف ولماذا تفوقت جهود صنع السلام الإقليمية المدعومة من الغرب على العديد من المبادرات المتنافسة في السودان، مع ما يترتب على ذلك من عواقب معقدة للغاية على ما يمكن أن يعنيه السلام. فمن جانب، يركز هذا الفصل على دوافع التدخلات الأجنبية المتصارعة في عملية صنع السلام، خاصةً مع تزايد المبادرات في هذا الصدد، ومن جانب آخر يبحث كيف يمكن أن يؤثر هذا الأمر على طول أمد الصراع مما يخلق ما يمكن تسميته “أمراض السلام” نتيجة تضارب وتعدد الدوافع والأهداف.
ويمضي الفصل ليبين أن “بناء” أي نوع من السلام يعتمد على وسائل تهدف إلى تقليل واحتواء التعقيد. وتنقسم وسائل تحقيق غايات السلام إلى نوعين أساسيين: التصميم، والإكراه. يعتمد التصميم على القدرة على التأثير على واقع سياسي معقد بخطة لتحقيق نتيجة السلام، وينطوي ذلك على مكونات، مثل الحد من ولاية ونطاق الوساطات الأخرى، ووضع تصور فعال للصراع “مشكلة-حل”. أما الإكراه، فهو يؤثر باتجاه التمكين من فرض المبادرة المفضلة للسلام، وقد يُستخدم في هذا السياق الموارد المالية والقوة الجيوسياسية لمنح مبادرة ميزة على غيرها.
3- التبسيط: وسائل صنع السلام بين الشمال والجنوب:
إن حروب السودان الأهلية متشابكة وفي غاية التعقيد، ومن أجل صنع السلام فلابد من تبسيط ذلك التعقيد. وكانت ثنائية شمال وجنوب أو التقسيم حسب الفاعل المحارب طريقة لتبسيط الحرب الأهلية، إلا أن ذلك عقد القضية من جانب آخر، وعليه، يتناول هذا الفصل دور التبسيط كوسيلة في صنع السلام في السودان من خلال حلقتين مترابطتين بشكلٍ وثيق من مفاوضات اتفاق السلام الشامل. تتعلق الحلقة الأولى بالتبسيط الذي حدث في الفترة التي سبقت -وأثناء- مفاوضات مشاكوس عام 2002. ويدرس الكتاب كيف أدى التبسيط والاختزال إلى إعادة بناء هوية الحركة الشعبية لتحرير السودان وهدفها، وعضويتها التأسيسية، ومواقع تواجدها؛ حيث التحول من المطالبة بحكمٍ ذاتي إلى الإصرار على الانفصال.
تركز الحلقة الثانية على تبسيط الصراع ليكون صراعًا ثنائيًا بين الشمال والجنوب، وفصل النزاع في منطقة جبال النوبة -المتنازع عليها في ذلك الوقت- عن الحرب الدائرة في الجنوب، من أجل تيسير نجاح مفاوضات “الإيجاد” وتحقيق اتفاقية السلام الشامل، وهو ما تم بالفعل. لكن ذلك التبسيط لم يحل مشكلة الجنوب أو مشكلة السودان ككل، بل جعلها مجموعة نزاعات متفرقة، وعليه فقد دخلت السودان تلك الدائرة المفرغة من الحرب /السلام /الحرب، لأن تلك السياسات نتج عنها مزيد من التعقيد للأزمة في السودان.
4- مقاومة “السلام” في السودان عن طريق الحرب في دارفور:
يركز هذا الفصل على التصاعد الذي شهدته أزمة دارفور بالتزامن مع قرب التوصل لاتفاق حول أزمة الجنوب، وكيف ساهم طرفا الصراع في تأجيج الصراع في دارفور لخدمة مصالحهما في الجنوب، خاصةً الحركة الشعبية لتحرير السودان. وعليه، فقد تناول الفصل الكيفية التي تطورت بها الحرب في دارفور بطرقٍ مدمرة، بشكلٍ خاص كما حدث بين عامي 2001 و2004، وتفاعلها مع عملية صنع السلام في الجنوب.
لا شك أنه من غير المنطقي عند الحديث عن الصراع في دارفور الاقتصار على أن “سببه” صنع السلام؛ فهي أزمة لها جذورها التاريخية الخاصة وقد تم تشكيلها من خلال سياسات محددة، إلا أن ذلك لا ينفى أن للحركة الشعبية لتحرير السودان لعبت دورًا حاسمًا في تأجيج الحرب في دارفور، ولا سيما من خلال المساعدة في تحويل جبهة تحرير دارفور الضيقة عديمة الخبرة إلى حركة تحرير السودان، وتزويدها بالأسلحة، والتدريب، والمشورة الاستراتيجية، والحلفاء الدوليين. والأكثر أهمية هو كيف تم استخدام الحرب في دارفور كأداة في سياق مقاومة عملية صنع السلام بين الشمال والجنوب.
5- الكذب والازدواجية والتواطؤ الدولي في دارفور:
كان تبسيط الأزمة في السودان أحد أدوات صنع السلام، كما سبق الذكر، وكان الفصل بين ما يحدث في الجنوب عن الغرب في السودان أداة مهمة لخروج اتفاقية السلام الشامل إلى النور، ويتناول هذا الفصل كيف تمكن صانعو السلام -وخاصةً الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين البريطانيين والأمريكيين، وكذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة- أن يتوصلوا إلى اتفاق، من خلال تخفيف حدة الأحداث في دارفور، وذلك على ثلاثة مستويات: أولاً، داخل السودان نفسه، حيث تجنب صانعو السلام الاعتراف علنًا بالحركات المسلحة الجديدة حتى أواخر عام 2003؛ ثانيًا، في نطاق محادثات السلام، حيث تجنبوا أي روابط واضحة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والتمرد في دارفور؛ وثالثًا، بين الجماهير العالمية والمحلية، من خلال إخفاء الحقائق والكذب حول ما يحدث في دارفور، واعتباره نزاع قبلي حتى الانتهاء من صياغة مشروع السلام الشامل.
يُظهر هذا الفصل أن التبسيط أدي إلى الكذب والتواطؤ، ومن ثم استمرار الحرب، فتجاهل ما يحدث في دارفور من أجل نجاح المفاوضات المتعلقة في الجنوب، والكذب بشأن دور كلٍ من الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، والتواطؤ ضد السكان من خلال تجاهل معاناتهم عالميًا وإقليميًا ومحليًا، كل تلك العوامل أدت إلى استفحال كارثة دارفور وتحول الاضطرابات إلى حربٍ أهلية أخرى سقطت فيها السودان.
6- تفريغ السياسة السودانية بعد السلام:
ومع مولد دولتين جديدتين في 2011، السودان الذي خسر خمس مساحة أراضيه وسكانه، ودولة جنوب السودان الوليدة، إلا أن السلام المزمع والمأمول لم يتحقق، فالسودان واجه عنف واضطرابات وحروب في دارفور، وفي مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق، وفي أبيي وعبر الحدود الجديدة مع جنوب السودان، أما دولة جنوب السودان فواجهت أيضًا حربًا أهلية بين قطاعاتها للأسباب نفسها التي أدت إلى الانفصال بداية.
ذلك أنه كانت من تداعيات اتفاقية السلام الشامل اختفاء السياسة بمعناها الشامل؛ حيث كان التركيز على عملية المفاوضات الطويلة التي أدت إلى الاتفاق والانقسام، ففي السودان كانت السياسة الأمنية من قبل البشير هي المسيطرة على التعامل مع أزمات البلاد دون الأخذ في الاعتبار درس الجنوب، أما في الجنوب فلم تكن البداية الجديدة قادرة على تجاوز الاختلالات الهيكلية في نشأة الدولة والمُقوضة لها.
7- كشف النقاب عن العنف في السياسة الفاشلة في السودان:
يتناول الفصل أحد الأسباب التي ساهمت في تأزيم وضع السودان، وهي قبول القوى الإقليمية والدولية بنشأة ميليشيا مسلحة تطالب بالانفصال في دولة مستقلة. فعلى الرغم من وجود مظالم تاريخية في الجنوب، وسوء الإدارة من الشمال في إدارة تنوع السكان، وأزمة النخب السودانية غير القادرة على إدارة خلافاتها واختلافاتها، وعدم عدالة توزيع الموارد، إلا أن ذلك القبول أعطي رسالة مفادها السماح برفع السلاح لحل المشاكل الهيكلية في السودان، بل والدفع بانفصال الجنوب وليس حل مشكلاته.
فهدف التوصل إلى اتفاق بصرف النظر عن أي شيءٍ أخر، لم ينتج عنه إنهاء حروب السودان وأزماتها، بينما كان من المفترض أن يكون الهدف هو حل تلك الإشكاليات والاختلالات وليس الدفع نحو اتفاقية بين حكومة مركزية وميليشيا باعتبار أنه الحل الناجع الوحيد، الأمر الذي نتج عنه القبول فيما بعد بدائرة أوسع من العنف سواء في السودان أو في جنوب السودان.
8- حلقات مفرغة من الحرب والتدخل وصنع السلام:
كانت سياسة صنع السلام في السودان هي المهيمنة على باقي السياسات، فبعد اتفاق الجنوب، ظهر اتفاق الغرب (دارفور)، ثم اتفاق الشرق (جبال النوبة)، والآن الحرب الدائرة في الخرطوم، ثم سيظهر اتفاق الوسط. فالسياسة في السودان تدور حول اتفاقات سلام وحرب ثم اتفاقات سلام، لا شيء أكثر، لا أسئلة حول دور الجيش في السياسة، لا حلول للإشكاليات والاختلالات الهيكلية، لا تطور في أداء النخب.
فالفصل يؤكد على أن عملية صنع السلام بتلك الكيفية المختزلة لا ينتج عنها إلا مزيد من الحروب، وليس حل لكل مشكلة على حده أو حل المظالم الاجتماعية لكل فريق. وإن السؤال الواجب طرحه بهذا الشأن: لماذا يتم التجاوز عن تلك الحلقة المفرغة؟ ولماذا لا توجد حلول لها؟ هل هو تواطؤ داخلي -خارجي على استمرار الحروب وتحقيق المصالح عبرها، بصرف النظر عن حياة الشعوب ومطالبها؟
10- ما بعد ثورة السودان 2019، البداية من جديد:
طرح الحراك في 2019 تساؤلات حول بداية جديدة مختلفة، يمكن من خلالها حل إشكاليات السودان المتفاقمة المعقدة منذ نشأتها، خاصةً وعي النخب بحجم المشكلة ومتطلبات الحل، عند تلك اللحظة يقف هذا الكتاب، ولكن مع النظر لوضع السودان في 2024 نجد -كما طرح الكتاب من قبل- دخول السودان في حلقةٍ أخرى من حلقات الحروب الأهلية التي تعيشها البلاد منذ خمسينيات القرن الماضي، لتقف السودان مرةً أخرى في صراع بين حكومةٍ مركزية (خاصةً الجيش) وميليشيا نشأت وتطور دورها نتيجةً لسياسات تغافلت عن الأسباب الحقيقية للأزمات، وما يمكن طرحه من سياسات مضادة لحل إشكالياتها. فتقف السودان على أعتاب تقسيم المقسم، لتدور السياسة في السودان، وبين القوى الإقليمية والدولية، حول اتفاق سلام لمرةٍ أخرى ومبادرات لوقف الحرب الدائرة بين مكونات الجيش السوداني، حيث يساعد كل طرف فصيل مدني وقوى إقليمية ودولية.
خاتمة:
يركز هذا الكتاب على الكيفية التي تؤدي بها عمليات صنع السلام الخارجية -كالتي تجري في السودان- إلى تعزيز العنف والصراع في البلدان التي تجتاحها حروب أهلية. فتلك العملية المدعومة خارجيًا تضعف السياسات الداخلية القادرة على إنتاج وسائلها من رحم إشكالياتها، ففرض الحلول والمفاوضات والمبادرات الخارجية يفرض تأثيره على سير ومسار تلك العملية، هذا من جانب، ومن جانبٍ آخر، فإن القبول بهذا النمط من الصراعات والتدخل لصالح طرف ضد الآخر -حتى وإن تم التظاهر بغير ذلك- يزيد من اعتياد العنف والاضطراب نتيجة ذلك القبول الإقليمي والدولي.
يؤكد الكتاب على أن تلك الاستمرارية للحروب الأهلية في السودان لا تنتج بالضرورة من نوايا القوى الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق مصالحها على حساب مصلحة البلاد، ففي أحيان كثيرة تكون النوايا جيدة. ولكن هنا تكمن الإشكالية في طرح الكتاب، فخبرات الواقع تثبت أن عادةً ما يتم التدخل من أجل تحقيق مصالح القوى المتدخلة، وعادةً ما يتبع ذلك التدخل المزيد من تأجيج الصراعات، وذلك على مدار تاريخ السودان الحديث. ويمكن الاتفاق مع طرح الكتاب، من أن عملية السلام الخارجية في ظل القبول بالميليشيات ودفع المفاوضات لتحقيق اتفاقات سلام دون حل المشكلات الجذرية المؤسسة للمظالم التاريخية، فإن ذلك يدفع إلى إعادة إنتاج الحروب الأهلية في مناطق مختلفة وحتى في المناطق التي وقعت اتفاقيات سلام، ويؤكد على هذا الطرح ما شهدته وتشهده كل من السودان وجنوب السودان.
________________
هوامش
⁕ باحثة في مركز الحضارة للدراسات والبحوث.
[1] Sharath Srinivasan, When Peace Kills Politics: International Intervention and Unending Wars in the Sudans, (London: Hurst Publishers, 2021).
- نُشر التقرير في: فصلية قضايا ونظرات- العدد الرابع والثلاثون- يوليو 2024.