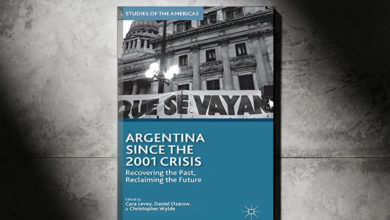تطورات الأزمة السياسية والدور الخارجي في السودان*

مقدمة:
تتسم نماذج الأزمة السياسية في القارة الإفريقية بعدد من السمات المشتركة: تعدُّد القوى المنخرطة في الأزمة، تراكب مستويات الأزمة وتداخل مجالاتها، التشابك بين الداخلي والخارجي في مجريات الأزمة، امتداد الأزمة زمانيا ومكانيا. وتعد الأزمة السياسية في السودان نموذجًا شارحًا للعديد من أنماط تلك الأزمات السياسية في القارة الإفريقية.
وعقب مسيرة ثلاثيـن عامًا (30 يونيو 1989-11 أبريل 2019) من الحكم العسكري ذي الخلفية الإسلامية بقيادة حزب المؤتمر الوطني وبزعامة عمر البشير على إثر انقلاب 1989؛ لم تعبر هذه المسيرة عن أي نهوض حضاري استراتيجي أو تقدم اقتصادي ولا شهدت حراكًا سياسيًّا رشيدًا ومنظَّمًا، بل تكلَّلت بإكليلِ شوكٍ تمثـّـل في انفصال جنوب السودان عام 2011؛ ليفقد السودان “المتبقِّي” أكثر من 60٪ من مصادر دخله المتحصّلة من عوائد البترول التي أضحت من نصيب حكومة جنوب السودان، كما ختمت العقود الثلاثة بالعديد من الأزمات الداخلية المتتالية فأزمة الخبز والوقود والنقود التي اندلعت بسببها انتفاضة شعبية في 19 ديسمبر 2018، أطيح على إثرها بنظام البشير في 11 أبريل 2019 على يد نخبته العسكرية؛ عقب حراك ضاغط من قوى متنوعة فكريا وتنظيميا معارضة لنظامه، قادها تحالف باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، وفي اتصال وثيق بتدخلات خارجية من أطراف مختلفة ومتنافسة. ثم شهدت السنوات الثلاث التالية 2019-2022 تطورات دالة في نموذج الأزماة السياسية الإفريقية العامة.
في هذا التقرير الموجز نحاول تسليط الضوء على مآلات الأزمة السودانية منذ الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل 2019، وحتى الإطاحة بحكومة “عبد الله حمدوك”[1] في 25 أكتوبر 2021، ودخول الأوضاع السياسية في السودان في منعطف جديد؛ ضمن إطار نموذج الأزمة السياسية الإفريقية المشار إليه. ومن ثم يدور سؤال هذا التقرير حول: كيف تطورت الأزمة السياسية في السودان بين تحولات وتدافعات الداخل وتدخلات وتنافسات الخارج؟ ويمكن تقسيم التقرير إلى: أولًا – تطورات الأزمة من بعد نظام البشير إلى ما بعد حكومة حمدوك. ثانيًا – دور الخارج في الأزمة السودانية وتحليل العلاقات والتفاعلات بين أطرافها. ثالثًا – أهم قضايا الصراع السياسي السوداني الكاشفة عن نموذج الأزمة.
أولًا – تطورات الأزمة من بعد نظام البشير إلى ما بعد حكومة حمدوك:
شهدت الأشهر الأولى ما بعد إسقاط نظام البشير مسارين أساسيين:
أولهما – مسار تفكيك النظام السابق وإزاحة رموزه وأتباعه من مؤسسات الدولة، وقد نتج عنه عددٌ من القرارات والفاعليات المتتالية والمباشرة؛ فقد صدر قانون تفكيك نظام البشير وإزالة التمكين في 28 نوفمبر 2019، بالإضافة إلى إيقاف معظم القيادات العليا للنظام؛ وعلى رأسهم الرئيس السابق نفسه، ثم العمل على تغيير قيادات المؤسسة العسكرية والأمنية والقضائية والإدارية لإخراج أنصار النظام منها. وقد أظهر بعض رموز النظام السابق نوعًا من المقاومة والرفض ولو خطابيًّا، وتأثر هذا المسار بالصراعات والتجاذبات بين عنصري السلطة الجديدة: المكون العسكري متمثلاً في المجلس العسكري الانتقالي، والمكون المدني متمثلاً في قوى الحرية والتغيير.
وثانيهما – تنظيم المرحلة الانتقالية لبناء وتشكيل نظام جديد بديل من خلال التفاعل والتفاوض بين القوى المدنية والقوى العسكرية، وما يحيط بها من قوى قبلية وحركات انفصالية، بالإضافة إلى الضغوط الخارجية. وقد حدد اتفاق “الوثيقة الدستورية” في 21 أغسطس 2019 خطوات هذا المسار من حيث تقاسم السلطة والصلاحيات وتصور إنهاء المرحلة الانتقالية.
وقد مر كلا المسارين بعدة مراحل وتطورات، كثرت فيها الأزمات والصراعات بين كافة المكونات؛ محدِثةً انقلابًا ونكوصًا عن المستهدف منهما؛ بسبب العثرات الأساسية للمسار العام والتناقضات المستبطنة في المشهد السياسي إبان مرحلة الثورة وعقب إزالة نظام حكم البشير، بالإضافة للحضور الإقليمي والدولي المتنامي في مجريات الأحداث، بصور غير متناسقة.
- اتفاق ما بعد نظام البشير
بعد مرور أربعة أشهر على سقوط نظام البشير، توصلت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي قادت الحراك الثوري، إلى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى مسئولية الحكم بعد إطاحة البشير، حول “وثيقة دستورية” لإدارة المرحلة الانتقالية. وبناءً عليه، تشكل في 21 أغسطس 2019 “مجلس السيادة” الذي أسندت إليه مسئولية إدارة البلاد لمدة تسعة وثلاثين (39) شهرًا بالتشارك بين المدنيين والعسكريين[2]؛ بواقع خمسة أعضاءٍ لكل فريق، إضافةً إلى شخصيةٍ وطنيةٍ، يتم التوافق عليها. كما جرى الاتفاق على أن ترؤس شخصيةٍ عسكريةٍ المجلسَ في الفترة الأولى، ومدتها واحد وعشرون شهرًا، في حين يتولى المدنيون رئاسة الثمانية عشر شهرًا المتبقية؛ بناءً على نص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، المصدّق عليها من مجلسَ السيادة والوزراء في 12 أكتوبر 2020. وبعد توقيع الحكومة السودانية اتفاقًا للسلام يُنهي الصراعات المسلّحة في إقليم دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، مُدِّدت الفترة الانتقالية لتستمر 53 شهرًا على أن تنتهي بإجراء انتخابات عامة في مطلع عام 2024، على أن يتسلم المكوِّنُ المدني السلطةَ في أبريل 2022.
كذلك، نصّت الوثيقة الدستورية على تشكيل مجلس للوزراء، وسُمِّي عبد الله حمدوك للمنصب. وشملت مهمات مجلس الوزراء كل الصلاحيات التنفيذية، إضافةً إلى صلاحيات مشتركة مع مجلس السيادة؛ بما فيها صلاحية التشريع. ونصَّت الوثيقة أيضًا على تشكيل مجلسٍ تشريعيٍّ تحظى قوى “إعلان الحرية والتغيير” بنسبة 67٪ من أعضائه (الأعلى من الثلثين)، في حين تحوز القوى الأخرى النسبةَ المتبقية[3].
- حكومة حمدوك الأولى … من التشكل إلى الانقلاب
جاءت حكومة عبد الله حمدوك التي تشكلت تتويجًا للتفاوض والاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان؛ لكي تعبر عن قوة دفع المرحلة الانتقالية وتناقضاتها. وتولى حمدوك مهامه في أغسطس 2019، وأعلن في 8 فبراير 2021 اكتمال تشكيل حكومته الجديدة، وكان على رأس ملفات اهتمامها: الأزمة الاقتصادية، والتي كانت سببًا مباشرًا في التظاهر ضد البشير؛ فضلا عن الملفات المتعلقة بالسلام والتحول الديمقراطي. وعُلِّقت آمال قوى التغيير على حكومة حمدوك لإتمام عملية الانتقال الديمقراطي، وإخراج الاقتصاد السوداني من أزمته. ولكن حتى خروج حمدوك من السلطة، فيمكن القول إن أهم ما أنجزته حكومته يتمثل في: رفع اسم السودان رسميًّا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وذلك في 14 ديسمبر 2020، بالإضافة لاتفاقية السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان (فرع الشمال) في 28 مارس 2021 في جوبا (عاصمة جنوب السودان) لتشكل الاتفاقية إطار المفاوضات السياسية مع الحركات المسلحة في سياق إنهاء الصراعات المسلحة في البلد. إلا أن الحكومة أخفقت تحقق الأهداف الاستراتيجية للمرحلة الانتقالية؛ بسبب الخلافات بين مكونات المشهد السياسي، وافتقاد تصور متكامل وقابل للتطبيق لإدارة المرحلة الانتقالية. واتضح أنه منذ مجيء حمدوك وهو يراهن بصفة أساسية على حشد التأييد الدولي لدعم السودان للخروج من الأزمة الاقتصادية؛ فقام في نهاية 2019 بعدة زيارات دبلوماسية إلى واشنطن والعواصم الأوروبية لجلب الدعم للسودان، وانخرط في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض ومساعدات؛ بيد أن الدعم جاء ضعيفًا، بجانب عجز حمدوك عن اتخاذ قرارات مصيرية في ظل عدم امتلاكه لأدوات قوة في مواجهة المكون العسكري[4].
فعلى سبيل المثال: في ظل مساعي حمدوك لتعزيز السيطرة الحكومية على مجريات الأمور، برزت خلافات حادة بينه وبين رئيس المجلس السيادي “البرهان”، كان أولها بعد لقاء البرهان ونتنياهو في فبراير، واعتراض مجلس الوزراء بسبب عدم معرفته باللقاء. فقد نصّت الوثيقة الدستورية على أن العلاقات الخارجية هي اختصاص السلطة التنفيذية، وليس المكون العسكري. وبرزت آخر تلك الخلافات خلال تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي رفضه مجلس الوزراء من ناحية الاختصاصات والصلاحيات؛ حيث اعتبرت الحكومة أن المجلس -بصيغته المطروحة- يمثل التفافًا على الثورة، ومسعىً لتعزيز تمركز المكون العسكري في قلب السلطة. ومن الناحية الاقتصادية، استمرت مطالبات الحكومة -ومحاولات الضغط من قبل حلفائها الخارجيين- بضرورة سيطرتها على أموال وأصول الأجهزة الأمنية، ويدخل في ذلك الشركات العسكرية وملحقاتها. فقد طالبت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير بضرورة سيطرة وزارة المالية الكاملة على المال العام، وتجريم التجنيب، وضم الشركات العسكرية والأمنية و”الرمادية” لولاية المال العام، وفرض الضريبة النوعية والتصاعدية، وتعديل ضريبة شركات الاتصالات إلى 60٪ من أرباح الأعمال، وكذلك بضرورة سيطرة الحكومة على: صادرات الذهب، أموال الطيران المدني، إدارة البورصات، وإرجاع شركات المساهمة العامة، إضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي الاستهلاكي[5].
وفي 22 يونيو 2021، تقدم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بمبادرة تحت عنوان “الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال– الطريق إلى الأمام“؛ بهدف وضع أسس تسوية سياسية شاملة، تشمل توحيد الجبهة المدنية والعسكريين، وإيجاد رؤية مشتركة بينهما للتوجُّه صوب إنجاح المرحلة، كما تناولت المبادرة: إصلاح القطاع الأمني والعسكري، قضايا العدالة، قضايا الاقتصاد، ملف السلام، تفكيك نظام 30 يونيو، محاربة الفساد، والمجلس التشريعي الانتقالي. ويأتي على رأس القضايا التي قدمها حمدوك في المبادرة: قضية إصلاح القطاع الأمني والعسكري، وقد أكد أنها يجب ألا تقتصر على العسكريين، ويجب مشاركة المجتمع السياسي والمدني في رؤية الإصلاح. وقد لاقت المبادرة ترحيبـًا من كيانات عديدة كـالجبهة الثورية، حزب الأمة القومي، وتحالف الحرية والتغيير، إلا أن المكسب الأهم لـحمدوك بدا في التأييد الدولي للمبادرة من خلال الأمم المتحدة وواشنطن؛ وهو ما دفع الجيش ورئاسة قوات الدعم السريع للتوحد -ولو مؤقتًا- للوقوف أمام هذه المبادرة. هذا بينما تمسك “حزب البعث السوداني” بمبادرة اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير، وأعلن “نداءُ السودان” تكوينَ لجنةٍ لدراسة جميع المبادرات المطروحة على الساحة السياسية؛ بما فيها مبادرة رئيس الوزراء[6].
- حكومة حمدوك الثانية … من الانقلاب إلى الاستقالة
في 21 سبتمبر 2021؛ أعلنت السلطات السودانية أنها أحبطت محاولة انقلاب، وقد تصاعد على إثرها التوتر بين المكونيْن العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة الانقلاب هذه. ويؤكد القادة المدنيون أن الحادث هو مجردُ مثالٍ آخر على الحاجة الملحَّة لإصلاح قطاع الأمن. في حين أشار القادة العسكريون (البرهان وحميدتي) إلى أن انشغال القوى السياسية بالصراع على السلطة والمناصب، وسوء الإدارة المدنية للاقتصاد يوفر أرضًا خصبة لمحاولات الإطاحة بالحكومة. في الوقت نفسه، يوفر بعض الجوار الإقليمي المضطرب في السودان فرصة كبيرة للجيش للإصرار على أن التهديدات الوشيكة تتطلب منهُ البقاءُ في قلب الدولة[7].
وبدا من تلك الانتقادات والسجالات بين المكوِّنيْن العسكري والسياسي أن هناك مساعيَ إلى تغيير المعادلة السياسية من قِبل العسكريين؛ فخلال أكتوبر 2021؛ ارتفعت نبرة التصعيد لدى العسكريين حيال الأزمة؛ إذ أكّد البرهان -في لقاءاته مع الوحدات العسكرية- موقفه القاطعَ بضرورة حلِّ الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة فيها. وكان قد بدأ باتخاذ خطوات تصعيدية؛ إذ أصدر عدة قرارات في 12 أكتوبر 2021، كرّست سلطة المكون العسكري، وكشفت عن أنه الحاكم الفعلي للبلاد. وشملت الإجراءات: حظر سفر مسئولي لجنة إزالة التمكين؛ ومن بينهم نائب رئيس اللجنة وعضو مجلس السيادة محمد الفكِّي سليمان. وأشارت تقارير أخرى إلى منع خالد عمر يوسف- وزير شئون مجلس الوزراء من دخول مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة عندما كان بصحبة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كما وُضعت قنوات التلفزيون السودانية والقنوات التابعة للولايات يوم 13 أكتوبر 2021 تحت حراسة القوات المسلحة[8].
وما كان سجالاتٍ وتلويحا استحال انقلابًا كاملاً من قِبل قادة الجيش؛ ففي الــ25 من أكتوبر 2021؛ قرر البرهانُ تجميدَ كلِّ بنود الوثيقة الدستورية ذات الصلة بالشراكة بين العسكر والمدنيين، كما فرض البرهانُ وقتَها حالةَ الطوارئ، ووضع وزراء ومسئولين قيد الاحتجاز؛ بمن فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في خطوة وُصفت على نطاق واسع بأنها “انقلاب”، في حين برَّرها البرهان حينَها بالحاجة لـ”إجراءات تصحيحية” تُنهي سيطرة أحزاب بعينها على السلطة، وتوسّع دائرة المشاركة السياسية. وتعهَّد البرهانُ حينَها بتشكيل حكومةِ كفاءاتٍ مستقلةٍ، وتحقيق متطلبات العدالة والانتقال، وتشكيل مفوضية لوضع الدستور، وأخرى للانتخابات، ومجلس للقضاء العالي، ومحكمة دستورية، ومجلس نيابي، وحدد لإنجاز ذلك كله شهرًا واحدًا[9].
وبناء على تلك الإجراءات، ومنذ 30 أكتوبر شهدت شوارع السودان مظاهراتٍ حاشدةً خرح فيها آلاف السودانيين من غير انقطاع؛ تعبيرًا عن رفض قطاعاتٍ واسعةٍ من السودانيين انقلاب البرهان، رغم تصدي أجهزة الأمن لها وسقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين، وفقا لإحصائيات لجانٍ طبية؛ حيث عبّر كلٌّ من المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي، وتجمّع المهنيين (جناح الأصم) في بيانات متفرقة عن رفضهم القاطع للانقلاب العسكري وما تمخّض عنه من إجراءات، وطالبوا بعودة المؤسسات التي جرى حلهّا، وإطلاق سراح المعتقلين، ومحاكمة الانقلابيين، وإعلان العصيان المدني. وبخلاف تلك المواقف أعلنت قوى الحرية والتغيير (مجموعة الميثاق الوطني) عن دعمها ما قام به البرهان، فيما أعلن الحزب الشيوعي -الذي انسحب من قوى الحرية والتغيير- رفضه الانقلاب ودعا إلى مقاومته، فتشرذمت المواقف بين أكثر من اتجاه.
ومع تتابع الضغوط والوساطات المحلية والدولية توصلت القوى المتصارعة إلى اتفاق بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المقال حمدوك يوم 21 نوفمبر 2021، واشتمل الاتفاق على نحو 14 بندًا؛ أهمها: التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 وتعديل 2020 هما المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية، مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان، وتعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يضمن مشاركة سياسية شاملة، والتأكيد على الشراكة القائمة بين المدنيين والعسكريين، وتشكيل حكومة كفاءات، وأن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفًا على تنفيذ مهمات الفترة الانتقالية وإدارتها بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين: القوى السياسية والمدنية، والمكون العسكري، والإدارة الأهلية، ولجان المقاومة، والشباب، والمرأة، والطرق الصوفية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والإسراع في تكوين مؤسسات الحكم الانتقالي، وإطلاق حوار موسّع من أجل قيام المؤتمر الدستوري، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الرئيس البشير ومراجعة عملها، والعمل على بناء جيش قومي موحّد[10].
ومع أن الاتفاق يُعيد رئيس الحكومة المقال إلى السلطة، كما أنه يستأنف خيار الشراكة بين العسكريين والقوى المدنية، إلا أنه يستجيب لأهم مطالب المجلس العسكري، ويكرِّس إلغاء الدور المحوري لقوى إعلان الحرية والتغيير في إدارة المرحلة الانتقالية. ففضلاً عن كون الاتفاق نصَّ على استبدال التمثيل السياسي في الحكومة بالتمثيل التكنوقراطي، فإنه يكرس استمرار رئاسة العسكريين للمجلس السيادي بدل تمرير الرئاسة للقوى المدنية كما كان مقرراً في 19 نوفمبر 2021. ومن الواضح أن عددًا من المواد الأساسية في الوثيقة الدستورية لسنة 2019 قد أُلغيت؛ وهي في عمومها تتعلق بحصة قوى إعلان الحرية والتغيير في المؤسسات الانتقالية[11].
وقد شكّل الاتفاق مفاجأة لبعض قوى الثورة والمتظاهرين الذين كانوا يساندون حمدوك، ويهتفون له ضد الانقلاب الذي أطاح حكومته، وعدّه بعضهم “خيانة”. أما ردود أفعال القوى السياسية، فقد جاءت متباينة إزاء الاتفاق ما بين معارض ومؤيد. ويمكن تصنيف المعارضين في ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى- رفضت الاتفاق جملة وتفصيلًا ودانته، ورفضت التعامل مع أطرافه. ويبرز هنا عدد من القوى السياسية في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير؛ خاصة أحزاب المؤتمر السوداني، والتجمّع الاتحادي، وحزب البعث العربي-الأصل؛ وهي قوى كانت مشاركة في حكومة حمدوك المقالة، إلى جانب تجمُّع المهنيين بجناحيه. وطالبت هذه المجموعة بمحاكمة “الانقلابيين”. لا ترفض أحزاب هذه المجموعة الوثيقة الدستورية، ولا ترفض أيضًا مشاركة العسكريين في العملية الانتقالية، ولكنها لا تقبل بالاتفاق الأخير وبالأخص لا تولي ثقة بالشخصيات التي قادت الانقلاب.
المجموعة الثانية- يمثلها “حزب الأمة القومي” الذي عبر أعضاؤه عن آراء متباينة، عكست وجود تيارات مختلفة داخله. فقد شاركت قيادات من الحزب ممثلةً في رئيس الحزب وأمينه العام في لجنة الوساطة التي توصلت إلى الاتفاق، لكنّ قيادة الحزب اضطرت إلى الانسحاب من حفل التوقيع على الاتفاق؛ بسبب المعارضة القوية له في صفوف الحزب.
المجموعة الثالثة- ترفض الاتفاق، والوثيقة الدستورية، والحكومة التي سيشكلها حمدوك. ويمثل هذه المجموعة “الحزب الشيوعي”. ويقف مع هذا الخط السياسي جناحٌ في تجمع المهنيين يتماهى مع مواقف الحزب الشيوعي. وترفض هذه المجموعة مشاركة العسكريين في السلطة تمامًا، وتصر على نقل الحكم للمدنيين.
أما في جانب المؤيدين للاتفاق، فتبرز الحركات المسلَّحة الموقِّعة على اتفاق جوبا للسلام. وقد أكد الاتفاقُ على تنفيذ اتفاقية جوبا وضمان حصص هذه الحركات في مجلسَ السيادة والوزراء. وأيّدته أيضًا أحزابٌ من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وعدّته خطوةً مهمة؛ مثل: الحزب الوطني الاتحادي الذي يرأسه يوسف محمد زين؛ والحزب الناصري-تيار العدالة الاجتماعية ويرأسه ساطع الحاج، وحركة “حق” برئاسة أحمد شاكر، وكذلك قيادات من الإدارات الأهلية وزعماء طرق صوفية[12].
أسَّس الاتفاق لمرحلة جديدة لم تعُد فيها قوى إعلان الحرية والتغيير الشريكَ الأوحد للعسكريين. ومن هنا أتى رفض الحكومة المدنية السابقة للاتفاق؛ بما عكسته استقالة 12 من أبرز عناصرها، وكذا الانتفاضة الاحتجاجية المستمرة في الشارع التي ذهب ضحيتها قتلى وجرحى كما سبق ذكره. ومع أن حمدوك حاول استعادة ثقة قيادات قوى الحرية والتغيير، إلا أنها رفضت الحوار معه، رافعةً شعار “لا تفاوض، ولا مساومة، ولا شراكة مع الانقلابيين”[13].
ومع استمرار تصاعد الاحتجاجات من قبل قوي المعارضة الذين اتهموا حمدوك بخيانة الثورة بقبول اتفاقٍ معيبٍ، كما واصلت قوات الأمن اعتقال النشطاء واستخدام العنف الوحشيّ لتفريق الاحتجاجات، وقتلت أعدادا من المتظاهرين منذ عودة حمدوك إلى الحكومة، بالإضافة لرفض الجيش تعيينه مسئولين رئيسيين في الوزارات الحكومية، أعلن عبد الله حمدوك في 2 يناير 2022 استقالته من رئاسة الوزراء، في خطاب بمناسبة عيد استقلال البلاد؛ مشيراً إلى فشل جهوده لإحداث إجماع سياسي وطني، نتيجةً لإعاقة جهوده الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة، ومحاولة المكوّن العسكري لجم صلاحياته؛ خرقًا للالتزام الذي قطعه البرهان على نفسه بموجب اتفاق الإطار المعقود في 20 نوفمبر 2021.
خسر حمدوك قسطًا مهمًا من مصداقيته في أوساط المعسكر المتنوّع المؤيد للديمقراطية، والمنقسم على نفسه في أحيان كثيرة؛ بسبب قبوله شروط البرهان للعودة إلى تولّي رئاسة الوزراء؛ ما بدا وكأنه يضفي شرعية على الانقلاب. بيد أن تلك الاستقالة حملت العسكريين -البرهان وحلفاءه- المسئولية الكاملة عن إدارة البلاد. ومع ذلك، يبدو البرهان مصممًا على خلق واجهة مدنية، يأمل منها أن تيسّر له إضفاء الشرعية على الحكم العسكري محليًا وعلى تأمين عودة تدفّق المعونات والائتمانات الدولية[14].
- الفراغ السياسي عقب استقالة حمدوك
مع استقالة حمدوك من رئاسة الوزراء، دخل المشهد السوداني في حالة فراغ سياسي فشلت معه عديد من مساعي الوسطاء الدوليين والمحليين لرأب الصدع بين العسكر والمدنيين وعلى رأسهم ائتلاف الحرية والتغيير. وبرز في هذا الفراغ عدد من المسارات والتفاعلات بين أطراف الأزمة في الداخل، بالإضافة لتفاعلات وتدخلات الخارج وتعاطيه مع الأزمة وأطرافها، إلا أن الصورة الكاملة لهذا الفراغ أعادت عملية الانتقال الديمقراطي والأزمة السياسية السودانية إلى المربع الأول، فنجد أن:
- تجمع قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين تمسكا بخيار الرفض التام للحكم العسكري، ورفعا سقف مطالبهم بالدعوة لرحيل العسكر من السلطة وتسليمها كاملة للمدنيين، طارحيْن رؤية متكاملة؛ أساسها: “إنهاء الانقلاب” وفق إجراءات وترتيبات محددة، معتمدين على التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية وفق جدول تصعيدي منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 -وحتى الآن- بوصفها أداةَ ضغطٍ، كما دعت إلى عصيانٍ مدنيٍّ إلا أنه لم يلقَ تأييدًا كبيرًا[15]، وظلت في سجال وتردد حول المشاركة في مسارات التفاوض لحل الأزمة برعاية أممية ودولية.
- أما القادة العسكريون: فقد أكد البرهان أنهم لن يسلموا الحكم إلا لحكومة توافق موسعة تحظى بإجماعٍ شعبيٍّ واسعٍ وسلطةٍ منتخبةٍ؛ وهو ما يبدو بعيد المنال حتى اللحظة، كما أن الوعود التي برر بها البرهان انقلابه في 25 أكتوبر 2021 لم تتحقق بشكلٍ فعليٍّ، واستمرت البلاد بدون حكومة تنفيذية (حتى وقت كتابة هذا التقرير)، كما لم يظهر مؤشر للسعي إلى تحقيق العدالة الانتقالية، بل زادت الانتهاكات ضد المحتجين السلميين، في حين لا تزال المؤسسات العدلية والنيابية معطلة. علاوة على ذلك كله، ازدادت الأحوال العامة سوءًا، وتشير كافة المؤشرات إلى تراجع في الأحوال المعيشية مع استمرار موجات الغلاء وتنامي الانفلاتات الأمنية؛ لا سيما في أقاليم دارفور والنيل الأزرق وشرق البلاد. كما تتابعت تصريحات كلٍّ من البرهان وحميدتي التي تُظهر زُهد العسكريين في السلطة وأنهم سيسلمونها حال حدوث توافق سياسي أو عُقدت انتخابات[16]. وفي خطاب للبرهان في 4 يوليو الماضي (2022) أعلن عدم مشاركة الجيش في الحوار الوطني الذي نظمته الآلية الثلاثية (التي نتجت عن توحد ثلاث مبادرات أممية ودولية) لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية، وأنه بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع. وفي سياق آخر صرح حميدتي بأن ما قام به البرهان (25 أكتوبر 2021) لم يفشل في إحداث التغيير، وأنه إذا كان خروج القوات النظامية من المشهد السياسي سيتسبب في نهضة السودان فإنهم ملتزمون بذلك[17]. وكان البرهان قد أعفى جميع الأعضاء المدنـيـين من مناصبهم في المجلس لحين تشكيل الحكومة التنفيذية[18].
- وفي أحد جوانب المشهد المتأزم منذ الانقلاب قرر البرهان تجميد عمل لجنة تفكيك نظام البشير، كما أطلق سراح عدد من رموز نظام البشير، كما تدخلت أطراف عدة محلية ودولية وأممية لحل الأزمة السياسية السودانية بتقديم مبادرات ومسارات تفاوض وتسوية، إلا أنها -وحتى كتابة هذا التقرير- لم تُفضِ إلى جديد في الساحة السودانية.
- مبادرات التفاوض والتسوية
مع تصاعد الأزمة السياسية السودانية منذ إجراءات 25 أكتوبر 2021 ثم استقالة حمدوك في 2 يناير 2022؛ دخل المشهد السياسي السوداني في نفق من الاضطرابات والصراعات وانسداد في الأفق السياسي بين قوى انتفاضة 19 ديسمبر والعسكريين، وحاولت عدة أطراف محلية ودولية وأممية إنهاء الأزمة والعودة إلى مسار الحكم المدني الديمقراطي والوصول لصيغة لتحريك الأزمة السودانية من مأزقها عبر عدد من المشاورات والمبادرات والمواثيق والمشاريع الدستورية:
- مشاورات الآلية الثلاثية: أجرت بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان “يونتاميس” مشاورات أولية مع أطراف الأزمة السودانية بين 8 يناير و10 فبراير الماضيين (2022)؛ بهدف إطلاق عملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد، مع مختلف الفاعلين السياسيين السودانيين. وأجرت البعثة لقاءات مع “قوى إعلان الحرية والتغيير” و”الحزب الشيوعي” و”حزب المؤتمر السوداني” و”تنسيقية لجان المقاومة” (مجموعات شعبية منظمة للاحتجاجات)، ومجموعات نسائية، وقوى المجتمع المدني[19]، وفي 12 أبريل الماضي، طرحت الآلية الثلاثية (للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بدول شرقي أفريقيا “إيغاد”) أربعة محاور أساسية لحل الأزمة بالسودان؛ عبارة عن: “ترتيبات دستورية، وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء، وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين، وصياغة خطة محكمة ودقيقة زمنيًّا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة”. وبحثت “الآلية الثلاثية” مع المكون العسكري في السلطة السودانية، دفع عملية الحوار السياسي لإخراج البلاد من أزمتها؛ لينتج عن هذا لجنة عسكرية للحوار الوطني مؤلفة من ثلاثة أعضاء. تضم اللجنة الثلاثية العسكرية للحوار الوطني إلى جانب “حميدتي” عضوي مجلس السيادة: شمس الدين كباشي، وإبراهيم جابر، كما اتخذ البرهان -لاحقًا- عددا من الإجراءات بهدف بناء الثقة والتهدئة، وتهيئة المناخ للحوار بين الأطراف السودانية إبان الذكري الثالثة للانقلاب على نظام البشير في إبريل 2019. فقد أطلقت السلطات سراح عشرات المعتقلين السياسيين من أحد السجون الموجودة في العاصمة الخرطوم في أبريل 2022[20]. إلا أن بقاء العسكريين في هذه المفاوضات أو الحوارات لم يدم طويلا، فقد أعلن البرهان في 6 يوليو 2022 عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في مفاوضات الحوار الوطني الجارية؛ لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية، وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال متطلبات الفترة الانتقالية.
- مبادرة مجلس حكماء السودان: تم توحيد جهود 35 مبادرة لحل الأزمة الراهنة، في “وثيقة السودان الدستورية 2022″؛ بهدف التوصل إلى إعادة صياغة الوثيقة الدستورية، والترتيب لعقد مؤتمر للتوقيع عليها بعد مشاورات مع الاتحاد الأفريقي، وقوى سياسية وأربعة تحالفات ضمت أكثر من (200) جهة حزبية وطريقة صوفية[21].
- مبادرة “نداء أهل السودان”: وهي مبادرة أطلقها الشيخ الطيب الجدّ وإحدى المبادرات الأهلية، ويعتبرها أنصار النظام السابق مخرجًا لأزمات السودان. وقد حشد لها الكثير من الطرق الصوفية والإدارات القبلية لأواسط وشمال السودان ومؤيدي المجلس الانتقالي. وتمثل كيانات سياسية وحركات مسلحة تدعو إلى الحوار والوفاق حول القضايا الوطنية، وتدعم بقوة مبادرة الشيخ الطيب الجد لقطع الطريق على قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي ولجان المقاومة، والقوى الثورية المدنية التي تسعى لإعلان دستور انتقالي وإعلان حكومة مدنية من طرف واحد وتجد نوعًا من تأييد إقليمي ودولي؛ ويصفها معارضون بأنها جاءت لقطع الطريق على مبادرة ممثل الأمم المتحدة فوكلر، التي توقفت عقب انسحاب المجلس العسكري منها، ويعتبرونها تدويرا للنظام القديم[22]. وتتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير- مجموعة التوافق الوطني” مع المكوّن العسكري في السودان وتدعم قرارات البرهان.
أما من جهة معارضي الحكم العسكري؛ فقد قدم عدد من القوى المناهضة للحكم العسكري من قوى 19 ديسمبر عددًا من المبادرات لحل الأزمة أو رسم مسار انتقالي جديد:
- في 27 مارس الماضي، أعلنت “الجبهة الثورية”، مبادرة لحل الأزمة السياسية، تشمل مرحلتين: الأولى- تشكيل حكومة تدير الفترة الانتقالية، والثانية- حوار بين الفرقاء السياسيين حول نظام الحكم والدستور والانتخابات[23].
- أطلقت لجان المقاومة الشعبية ميثاقًا سياسيًّا يهدف إلى “محاسبة الضالعين في انقلاب 25 أكتوبر من المدنيين والعسكريين، وإلغاء الوثيقة الدستورية، ومراجعة الاتفاقيات المبرمة والمراسيم الصادرة منذ الحادي عشر من نيسان/ أبريل 2019[24].
- كما أصدرت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين مشروع دستور أعدته ونشرته، وكان من بنود الوثيقة التأكيد على ضرورة إسقاط الانقلاب العسكري، والقضاء بشكل تام على الانقلابات العسكرية وحكم القائد الفرد وعنف الدولة. واستلهم معدُّو الوثيقة مشروعهم من جميع مبادرات قوى الثورة ومواثيق لجان المقاومة الشعبية، مؤكِّدين أن المواطنة أساس للحقوق والواجبات، وأن ذلك يشرعن الحكم المدني الديمقراطي، مع الالتزام بتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير. ورحبت جهات عدة بمشروع الدستور الذي تقدمت به النقابة؛ حيث وجدت الوثيقة ترحيبًا من قبل نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وكان ترحيبه أول رد فعل من المكون العسكري. كذلك رحبت بالوثيقة الدول التسع التي وجهت دعوات للحوار بين الفرقاء، واعتبرت أن “أي اتفاق سياسي لن يحمل أي مصداقية إن لم يكن شاملا أو يلقى ترحيبا وتأييدا من قاعدة شعبية واسعة”. مدنيا -ووفقا لوسائل إعلام سودانية- رحبت قوى سياسية بالمشروع الدستوري الجديد، وخاصة الأحزاب الرافضة لمشاركة الجيش في الحكم؛ حيث دعت قوى الحرية والتغيير جميع القوى السياسية للمشاركة في النقاش حول الوثيقة[25].
ثانيًا – دور الخارج في الأزمة السودانية وتحليل علاقات وتفاعلات أطرافها:
على الرغم مما يظهر من الأزمة السودانية في بروز عامل الصراعات الداخلية بين أطراف الأزمة سببًا رئيسيًّا في استمرارها، إلا أن هذا التنازع الداخلي يأتي في خلفيته التأثر بالعامل الخارجي منذ بداية الأزمة، والذي وجد وضعًا داخليًّا هشًّا سياسيًّا واقتصاديــًّا وأمنيًّا، فاخترقه وحل بداخله. وعند تتبع دور الفاعل الإقليمي والدولي في مجريات الأزمة السودانية منذ أواخر أيام نظام البشير (أبريل 2019) وإلى الوقت الحاضر (سبتمبر 2022)؛ نجد أن دور الخارج بتنوعاته ومستوياته المختلفة بارزًا بقوة في الأزمة السودانية؛ إما بفرض نفسه ورؤاه المرتبطة بمصالحه هو على أطراف الأزمة، أو من خلال استقواء أحد الأطراف به لترجيح كفته في الداخل. ومن ثم ينبغي قبل تحليل العلاقات والتفاعلات بين فواعل الأزمة السةدانية الإطلال على دور الخارج فيها.
أ) دور الخارج في الأزمة: بين التدخل والاستدعاء والاستعداء:
من خلال عدد من المواقف الدولية والإقليمية يتضح مستويات ذلك التدخل وفواعله:
أواخر أيام حكم البشير؛ مع محاولات البشير لإخراج السودان من قائمة العقوبات الأمريكية ودخول الاقتصاد السوداني في عملية انفتاح، وانتهاجه سياسات رفع الدعم عن بعض السلع، وبحلول أكتوبر 2018 كان السودان ينزلق إلى أزمة اقتصادية؛ إذ قلت كميات الخبز والوقود وسيولة العملة الصعبة، ووجد البشير نفسه في أزمة أمام قطاع عريض من الطبقة الوسطي، وكانت دول الخليج ملاذه في توفير مساعدات لحل أزمة السودان، إلا أن مساعي البشير لم تكلل بالنجاح عقب جولة خليجية له؛ إذ قررت كلٌّ من السعودية والإمارات التوقف عن تقديم يد المساعدة للسودان. فقد أوقفت الإمارات في ديسمبر 2018 إمدادات الوقود للسودان لاستيائها من عدم تنفيذ البشير لالتزاماته في الاتفاق الخاص بالتخلص من الإسلاميين بناء على تفاهمات سابقة بين بن زايد والبشير وفي فبراير 2019. عندما كانت الاحتجاجات تنتشر في البلاد على ارتفاع أسعار الخبز؛ أعلن البشير انتماءه للحركة الإسلامية وافتخاره بذلك. كان من الواضح أن البشير لن ينقلب على الإسلاميين، كما أنه لما نشبت أزمة حصار قطر، حاولت دول المحور (السعودي، الإماراتي، المصري) استمالة السودان إليها، لكن البشير لم يستجب للضغوط، بل حاول أن يلعب على كل الأطراف؛ لإنقاذ واقعه السياسي والاقتصادي المأزوم؛ إذ ظهرت محاولاته لاستثمار علاقاته مع كل الأطراف عندما زار الإمارات؛ للحصول على الدعم المالي اللازم لمواجهة الاحتجاجات في السودان، وعندما شعر بعدم تعاطف الإمارات معه، توجّه إلى قطر، ثم إلى مصر. لكن جميع هذه الزيارات كانت مُخفِقة، ولم تلبِّ طموحات البشير[26].
وفي أعقاب سقوط نظام البشير؛ جددت الدول العربية الثلاث خطاب التخويف من الفوضى وعدم الاستقرار في السودان، وأظهرت دول الترويكا العربية (السعودية، والإمارات، ومصر) مساندة صريحة للمجلس العسكري الذي أعلن، بعد بضعة أيام من استلام السلطة، استمرار التحالف مع السعودية، وإبقاء القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي في حرب اليمن، إلى أن “يحقق التحالف أهدافه”[27].
أما الموقف الأمريكي؛ فقد كان ضبابيًا في بداية الاحتجاجات ضد نظام البشير. وبعد إزاحة البشير أعلنت الولايات المتحدة في استحياء دعمها لعملية الانتقال الديمقراطي، وكذلك في البيان المشترك الذي أصدرته دول “الترويكا” الغربية (الولايات المتحدة، والنرويج، وبريطانيا)، أكدت فيه حاجة “السودان إلى انتقال منظم إلى حكم مدني. لكن بعد أحداث فض اعتصام القيادة العامة غيرت الولايات المتحدة موقفها، وحذرت من أن انهيار النظام في السودان ربما يؤدي إلى نشوب حرب أهلية، وإحداث فوضى في الإقليم بكامله؛ لذلك أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعيين دونالد بوث مبعوثًا خاصًا إلى السودان في 12 يونيو 2019[28].
أما كل من الموقف الصيني الروسي؛ فكان موقفًا محايدًا، إلى حد ما، طوال مدة الاحتجاجات ضد نظام البشير، وبعد سقوط النظام؛ حيث أكدت الصين أنها تلتزم دائمًا بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وتعتقد أن السودان قادر على معالجة شئونه الداخلية وحماية السلام والاستقرار في السوادن. ويشبه الموقف الصيني هذا، نظيره الروسي الذي اعتبر الاحتجاجات في السودان شأنًا داخليًّا. ولكن الدولتين عطَّلتا معًا إصدار مشروع قرار في مجلس الأمن يدين استخدام الحكومة السودانية العنف المفرط ضد التظاهرات السلمية[29].
ومن جهته، كان الاتحاد الإفريقي قد أمهل المجلس العسكري ستين يومًا لتسليم الحكم للمدنيين، ولوّح بتعليق عضوية السودان إنْ لم يتمّ ذلك. وعلى إثر مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو 2019، ردَّ الاتحاد الإفريقي على عملية فض الاعتصام بإعلان التعليق؛ ما مثَّل ضربةً قوية للمجلس العسكري[30].
- الموقف الإقليمي والدولي إبان حكومة حمدوك الأولى:
حظيت حكومة حمدوك بدعم وتأييد دوليين واسعين، واعتبرت خطوة مهمة في سيبل تحقيق الانتقال الديمقراطي وانتشال الواقع السوداني من أزماته الاقتصادية. وفي سبيل تأمين دعم خارجي لرئاسته للوزراء في المرحلة الانتقالية، كما أشرنا، تحرك حمدوك دوليًّا منذ 27 يناير 2020، وقام بإرسال خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، من دون التنسيق مع المكون العسكري، يطلب فيه إرسال بعثة أممية تحت البند السادس من الميثاق، لمساعدة السلطة الانتقالية في السودان في: دفع عملية السلام، وإعادة بناء قدرات قوات الشرطة، وإعادة توطين النازحين، ونزع السلاح، بعد توقيع اتفاق السلام مع الجماعات المسلحة، على أن تشمل ولاية هذه السلطة الانتقالية كامل أراضي السودان. وقد فُسِّرت هذه الخطوة حينها بأنها التفاف على مجلس السيادة الذي عدَّ الطلب استقواءً بالأمم المتحدة والخارج. وفي إثر ذلك، عقد مجلس الأمن والدفاع اجتماعًا طارئًا لبحث رسالة حمدوك، تمخض عنه تكليف رئيس الوزراء، بكتابة خطاب جديد إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أُرسل في 27 فبراير 2020، وركّز الطلب المعدّل على أن تشمل مهمة البعثة الأممية: تحقيق السلام، ودعم الاقتصاد، وعودة النازحين، والإعداد للانتخابات القادمة. وقد أقرَّ مجلس الأمن الدولي، في أبريل 2020 الرسالة الثانية المقدمة من حمدوك؛ مؤكدًا ضرورة حماية المكاسب الديمقراطية وتجنب العودة إلى الحرب[31]، وفي يونيو 2020، أصدر مجلس الأمن، قرارًا بإنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان “يونتامس”؛ استجابة لطلب حكومة حمدوك[32].
أما الحدث الثاني الكاشف عن العلاقة بين الداخل والخارج إبان هذه الفترة، فكان إجازة الكونجرس الأمريكي “قانون الانتقال الديمقراطي والمساءلة والشفافية المالية بالسودان” في ديسمبر 2020؛ الذي نص فيه على: “إنهاء أي تدخل الأجهزة العسكرية والأمنية في قطاع التنقيب والموارد المعدنية؛ بما في ذلك النفط والذهب”. وقد جاء القانون، الذي وقف خلفه ناشطون سودانيون، داعمًا للمدنيين؛ مُلوّحًا بفرض عقوبات إذا لم يسلّم العسكريون رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين بعد انقضاء دورتهم وفقًا للوثيقة الدستورية[33].
وعلى الجانب الآخر، اتجه البرهان وحميدتي لتعزيز علاقة المكون العسكري بمحور (الإمارات والسعودية ومصر)، والدخول في عملية تطبيع للعلاقات مع الكيان الصهيوني بدعم من الإمارات، وبدون علم أو مشاورة حكومة حمدوك؛ بالإضافة لتنويع العلاقات الخارجية؛ بتعزيز العلاقات مع الجانب الروسي بعدد من الزيارات من جانب كلٍّ من البرهان وحميدتي، وربما كانت زيارة كلٍّ منها لأسباب مختلفة، أو بغير تنسيق، إلا أنها -في مجملها- تؤشر على بحثٍ حثيثٍ عن حلفاء إقليميين ودوليين لتقوية موقفهم في الداخل والخارج.
وأمام المحاولة الانقلابية الفاشلة يوم 21 سبتمبر 2021، قام المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، بزيارة للخرطوم بعد أيام من الإعلان عن هذه المحاولة؛ للتعبير عن دعم الإدارة الأمريكية للحكومة المدنية في السودان. وقد اجتمع فيلتمان برئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعرب له عن إدانة الإدارة الأمريكية والكونجرس المحاولةَ الانقلابية، ودعا شركاء الفترة الانتقالية إلى العمل على إنجاح الانتقال الديمقراطي. وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قد ألـمح إلى استخدام العقوبات في حال انتكاس عملية الانتقال في السودان؛ إذ قال: “إن الانحراف عن هذا المسار والفشل في تلبية المعايير الرئيسة سيعرض علاقة السودان الثنائية مع الولايات المتحدة للخطر، بما في ذلك المساعدة الأمريكية الكبيرة التي يتلقاها السودان، فضلاً عن آفاق التعاون الأمني لتحديث القوات المسلحة السودانية والدعم الأمريكي في المؤسسات المالية الدولية وتخفيف الديون“. وأهم ما أشار إليه فيلتمان في زيارته هو الحاجة إلى تطوير رؤية جديدة للأمن القومي السوداني؛ مرتكزة على إصلاح قطاع الأمن تحت سلطة مدنية. وفي الفترة نفسها كان وفدٌ أمريكيٌّ آخر في زيارة للبلاد، برئاسة مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة براين هانت، وقد قابل عضوَيْ مجلس السيادة محمد الفكي سليمان ومحمد حسن التعايشي، وأكّد المسئول الأمريكي استمرارَ الشراكةِ ودعم الولايات المتحدة لعملية التحول الديمقراطي[34].
أما بخصوص الموقف الإقليمي والدولي من الانقلاب على حكومة حمدوك الأولى؛ فقد اتبعت الإدارة الأمريكية نهج التصعيد التدريجي ضد بيان 25 أكتوبر؛ بهدف ضبط سلوك القيادات العسكرية، ودفعهم نحو عدم الاستئثار بإدارة العملية الانتقالية. واعتمدت الإدارة الأمريكية في هذا الإطار على استخدام بعض الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية، وسارعت إلى الإعلان عن إيقاف مساعدات اقتصادية للسودان بقيمة 700 مليون دولار؛ ما يعد خطوة أولى في طريق إيقاف سياسة التحفيز الاقتصادي، والتي توقع مراقبون أنها قد تمتد إلى إيقاف دعم مؤسسات التمويل الدولية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا للاقتصاد السوداني، لاسيما بعد إعلان هذه الدول مواقف قريبةً من موقف الإدارة الأمريكية. بالتوازي مع الضغوط الاقتصادية، حاولت الإدارة الأمريكية إشراك الأطراف الإقليمية في البحث عن مخرج للأزمة السودانية، وقام المسئولون الأمريكيون بإجراء اتصالات ببعض دول الخليج ومصر، بيد أن خلافًا غربيًّا-روسيًّا قاد إلى فشل جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي في 26 أكتوبر 2021، وعجز أعضاء المجلس عن إصدار بيانٍ مشتركٍ في ظل انحياز الجانب الروسي إلى مواقف المكوِّن العسكري، ورَفْضِه توصيفَ بيان 25 أكتوبر بـ”الانقلاب”؛ داعياً إلى إطلاق حوار بين الفرقاء السودانيين لحلحلة الأزمة، في وقت تجنَّبت الصينُ إصدار أي تصريحاتٍ رسميةٍ؛ إبعادًا لمصالحها الاقتصادية عن التجاذبات السياسية بالسودان[35].
أما الموقف من اتفاق الإطار بين البرهان وحمدوك في نوفمبر 2021؛ فقد جاءت أغلب المواقف مرحبةً بالاتفاق، وبرز خصوصًا موقف مصر التي امتنعت عن إبداء موقف علنيٍّ من إجراءات 25 أكتوبر 2021، لكنها أعربت عن ترحيبها باتفاق 21 نوفمبر 2021. ووفقًا لنشرة “أفريكا انتلجنس”، فقد شكلت المخابرات المصرية غرفة عمليات لمتابعة تطورات الأوضاع في السودان، بعد هذا التاريخ، وأرسلت فريقًا إلى الخرطوم للتوسط بين الطرفين والتأكد من أن أي اتفاق سيكون لصالح المكون العسكري. وقد قابل الوفدُ حمدوك حينما كان قيد الإقامة الجبرية، وقابل أعضاءَ من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. وقد رحبت المملكة العربية السعودية وقطر بالاتفاق، وكذلك فعلت دول الترويكا الغربية (الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والنرويج)؛ إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، وبعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي[36].
وعقب استقالة حمدوك، التقى البرهانَ وفدٌ أمريكيٌّ في 21 يناير 2022؛ ونتج عنه اتفاقٌ ينصُّ على تشكيل حكومةِ كفاءاتٍ وطنيةٍ مستقلةٍ وإقامةِ حوارٍ وطني شامل لحل الأزمة السياسية الراهنة، وتعهد القادة العسكريون بالالتزام بالحوار وإنشاء بيئة سلمية للسماح للعملية السياسية بالمضي قُدُمـًا. ولكن مع تواصل القمع والانتهاكات، أصبح الموقف الأمريكي أكثر تشدُّدًا تجاه القادة العسكريين؛ لتعلن واشنطن إيقاف مساعداتها الاقتصادية للسودان حتى وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون[37].
وضمن سياق الأجواء المتوترة بين المكون العسكري والخارج؛ هدَّد البرهان بطرد الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس؛ بسبب “التدخل” في شئون البلاد وعدم التزام الحياد. وطالب البرهانُ المبعوثَ الأممي، بأن “يكف عن التمادي في تجاوز تفويض البعثة الأممية والتدخل السافر في الشأن السوداني، وإن ذلك سيؤدي إلى طرده من البلاد”. وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تقديم بيرتس تقريرًا لمجلس الأمن عن الجهود المبذولة في السودان؛ حيث علق على الاضطرابات الاقتصادية في البلاد، والعنف ضد المحتجين، وأولويات الانتقال إلى إجراء انتخابات، وقال بيرتس، في خطاب أمام مجلس الأمن الدولي: إن السودان يتجه نحو “انهيار اقتصادي وأمني ومعاناة إنسانية كبيرة”، ما لم تُستأنف الفترة الانتقالية بقيادة المدنيين الذين أطاح بهم البرهانُ في انقلاب عسكري العام الماضي[38].
وفي 11 سبتمبر 2022، وجهت تسع دول غربية دعوة لجميع الأطراف السودانية، طالبتهم فيها بضرورة الدخول في عملية سياسية لاستعادة الانتقال الديمقراطي تحت قيادة مدنية وبمشاركة الجميع؛ بمن فيهم الجيش. وأشارت إلى “أنها تدعم جهود الآلية الثلاثية للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)؛ للمساعدة في سدِّ الخلافات بين الأطراف، وتيسير استعادة الانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية”[39].
ب) تحليل علاقات وتفاعلات فواعل الأزمة:
من معطيات الأحداث والتفاعلات بين أطراف الأزمة السودانية في الداخل والخارج؛ تظهر سمةٌ عامةٌ تكاد تكون متطابقة لأزمات الدول العربية ما بعد الربيع العربي؛ من حيث نمط التفاعلات والصراعات، وتصاعد مستويات التداخل بين ما هو داخلي وما هو خارجي، ومن المهم مع تحليل التفاعلات الوقوف على تشريح أطراف الداخل منذ عزل البشير؛ هم:
- المكون العسكري: ويقوده عبد الفتاح البرهان- رئيس مجلس السيادة ونائبه حميدتي، وقد تغول المكون العسكري على المكونات الأخرى عبر قيادته للمشهد والانقسامات الداخلية بين مراكز القوة فيه. لقد بلغت غنيمةُ المكونِ العسكريِّ –إذا جاز التعبير- من حكمِ السودان بلغت أربعة أخماس عُمْـر الدولة ما قبل الاستقلال وإلى اليوم؛ ومن ثم فإن ما يثار اليوم عن إخراج هذا المكون من الحكم بالكلية يعد مخالفة للمسار التاريخي، ومعاكسة لتياره، لكن في الوقت ذاته لا يمكن الفصل بين هذه الحقيقة وحقيقة التدهور الدائم والمتزايد في أوضاع السودان. وقد سعى العسكريون في مجلس السيادة الحاكم في السودان، إلى تكوين حاضنة مدنية جديدة بعد بقائهم من دون حاضنة منذ الإطاحة بتحالف قوى الحرية والتغيير، في 25 أكتوبر 2021. ويطمح العسكريون لتحقيق ذلك عبر حوار شامل مع قوى متعددة للوصول إلى رؤية موحدة لاستكمال الفترة الانتقالية؛ وصولاً إلى إجراء الانتخابات. كما يحاولُ الجيشُ الحفاظَ على السلطة بالتحالف مع أطراف اتفاق جوبا وكتلة من نظام البشير وزعماء طرق صوفية وعشائر. ويبدو أن الجيش يريد من التحالف الجديد تعيين رئيس وزراء جديد لفكِّ حالة تجميد المساعدات الخارجية، وأن يبعث برسالة مفادها أن هذه حكومة مدنية بتوافق وطني عريض، مع تطبيع وضع سياسي جديد يحافظ به على السلطة. وأبرز التحديات أمام هذه التحالفات هي: “استمرار التظاهرات المقاوِمة، والوضع الاقتصادي، و(حزب) المؤتمر الوطني (الحاكم السابق)، والصراع بين الجيش والدعم السريع على احتكار السلطة”[40]. كما أنه برزت خلافات داخل المكوِّن العسكري بدت من تصريحات حميدتي ربما تمثل “مناورة سياسية تجاه البرهان”؛ لأن الخلاف بينهما خلافُ مؤسسات؛ فقادة الجيش يمارسون ضغوطًا على قائد الجيش لإبعاد قوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي وتحجيم دورها، في حين يحاول الأخير توسيع نفوذه على صُعُدٍ أهليةٍ ودينيةٍ وجهويةٍ. ويبدو أن كلاهما -حميدتي والبرهان- أيقن أن الانقلاب العسكري فشلَ أمنيًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، وكلفَ البلادُ خسارةً اقتصاديةً كبيرةً، وأضاع مكاسبَ إقليميةً ودوليةً، وفتح الباب للتدخلات الدولية؛ وهو أمر يحاولان بجهد الخروج منه لكن بطريقتينِ مختلفتينِ؛ فالبرُهان يستعيـن بأجهزته وفلول النظام البائد، وحميدتي يتخندق خلفَ كياناتٍ قبليةٍ ودينيةٍ وبعض القيادات السياسية[41].
- المكوِّن المدني: المشكِّل من تحالفِ قوى الحرية والتغيير (قحت) وعدد من المكونات المهنية والنقابية والمقاومة الميدانية والتكتلات الحزبية الأخرى، وشهِد تحالفُ الحرية والتغيير انقساماتٍ وتفككًا في جبهته الداخلية؛ مما أضعف دوره في المشهد بوصفه مكونًا رئيسيًّا، بالإضافة للتباين الكبير بين القوى المشاركة في الثورة على نظام البشير بشكل عام.
- الحركات المسلحة: أبرزها “تحالف الجبهة الثورية”؛ وهو تحالف عريض يضم عددًا من القوى السياسية والفصائل المسلحة، ويبدو أنَّ الجناح العسكري لا يتّجه نحو الانتقال الديمقراطيّ، بل يسعى بقوة للتحوّل من “المرحلة الثورية” وما تولَّـد منها من مواثيق إلى مرحلة جديدة يحتضن فيها الحركات المسلّحة، ويتقاسم معها السلطة والثروة أطول فترة زمنية ممكِنة، بمحاولات حلحلة الصراع مع الحركات المسلحة؛ لِتوقِّع الحكومة والجبهة الثورية اتفاقًا للسلام في أول سبتمبر 2020، ودُعيَ قادةُ الجبهة للعودة إلى الخرطوم للمشاركة في إدارة الفترة الانتقالية، على أن تشارك الأطراف الموقِّعة في السلطة بثلاثة مقاعد في مجلس السيادة.
أما عن التفاعلات بين الفاعلين في الداخل والقوى الخارجية؛ فإنها تتراوح بين الدعم والضغط، والاستدعاء والاستعداء والتوظيف؛ لتنتج حالةً من التشابك بين الفواعل في الخارج والفواعل في الداخل:
- هناك حرصٌ جليٌّ من القادة العسكريين على تنويع علاقتهم الخارجية ومحاولة كسب دعم خارجي وتعزيز شراكتهم الإقليمية؛ لكي يخفِّف من عملية الضغوط التي تمارس عليهم من الدول والمؤسسات الغربية بتعزيز علاقتهم مع روسيا والصين[42]، والمحور الثلاثي العربي (الإمارات والسعودية ومصر)؛ حيث اتفق البرهان على إقامة شراكات اقتصادية استراتيجية في مجالات الطرق والموانئ والسكك الحديدية، والتعاون عسكريًّا[43]، ومحاولة توظيف عملية التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني في تعزيز موقفهم الإقليمي والدولي.
- تسعى العديد من الدول الفاعلة في المشهد السوداني إلى تنويع علاقاتها بالأطراف الداخلية؛ فنجد أن دول الترويكا العربية بالإضافة للعلاقات الكبيرة التي تجمعها مع القادة العسكريين؛ فإنها تفتح قنوات تواصل مع الأطراف السودانية الأخرى. فقد أعلن “حزب المؤتمر الشعبي” بالسودان، عن إجراء أمينه العام محمد بدر الدين صباح مباحثات مع وفدٍ مصريّ بالعاصمة الخرطوم؛ حول قضايا مشتركة بين البلدين. وأكَّد مصدرٌ من “حزب الأمة” أن اللقاء “تم مع وفد من المخابرات المصرية يزور الخرطوم حاليًا للقاء قيادات أمنية وعسكرية سودانية”. وقالت صحيفة “السوداني” الخاصة: إن الوفد المصري الذي يزور البلاد حاليا مكون “من مسئولين كبار بوزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة”، دون تفاصيل أكثر[44].
- إنّ إعادة فتح “الملف الإسرائيلي” لم تكن وليدة طبيعية للعقل العسكري في حكومة السودان الائتلافية، بقدر ما كانت وليدة ضغطٍ وإلحاحٍ من دول التحالف العربي (الإمارات والسعودية)، فضلا عن الغرب. فكما ضغطت هذه الدول من قَبلُ على البرهان وحميدتي للانخراط معها في حرب اليمن، ضغطت عليهما أيضًا لاحقًا للانخراط في “السلام الإبراهيمي” الذي يسعى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، والذي تتزعمه دولة الإمارات[45].
أما العناصر الأساسية التي تحكم تفاعلات وعلاقات تلك المكونات مع بعضها البعض فيمكن إيجازها في التالي:
- يهيمن على المشهد السوداني “حالة عامة ضد الديموقراطية” يمارسها كافة الأطراف؛ من خلال البحث عن مصالحهم الخاصة، وممارستهم الإقصاء، واتباع نهج التصعيد والصراع؛ بحثــًا عن المصالح الضيقة. فمن جهةٍ، يسعى القادة العسكريون للحفاظ على مصالحهم ونفوذهم في حكم البلاد؛ فيعقدون شبكة من التحالفات الداخلية والخارجية لضمان بقائهم بالسلطة؛ لذلك لا يحبّذون الانتخابات؛ لأنها تعني خروج مجموعتهم الحاكمة بصورة كاملة من العملية السياسية، مع ما يترتّب على ذلك من إرباكٍ شديدٍ لمجمل التعهّدات والاتفاقات التي أبرموها مع القوى الإقليمية الدّاعمة لهم، ولا سيما الإمارات والسعوديّة ومصر، فضلًا عمَّا قد يترتّب على الانتخابات من أضرارٍ مباشرة تلحق بالقيادات العسكرية؛ سواء من ناحية الـمُساءلة القانونية، أو الضرر الاقتصادي؛ ولذلك فإنّ أجندة الجناح العسكري لا تتضمّن الرجوع إلى الانتخابات، بل تسعى من خلال طرق شتّى لإطالة الفترة الانتقالية. ومن الجانب الآخر تخشى الأحزاب اليسارية -التي كانت شريكة للعسكريين في السلطة إبان حكومة حمدوك- أن أيَّ عملية انتخابية ستفتح نافذة تلِجُ منها القوى السياسية غير المرغوب فيها؛ ولا سيما حزب الأمة والحزب الاتحادي أو القوى الإسلامية التي كان يعتمد عليها النظام السابق وبعض القوى الاجتماعية التقليدية؛ إذ إن أغلب هذه الأحزاب الصغيرة التي تسيطر على المشهد السياسي في الوقت الرّاهن، خاصّة حزب البعث السوداني، والحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري، والحزب الشيوعي السوداني، ستتضاءل أو تفقد وجودها كليًّا في حال قيام انتخابات حرة. الواضح أن أيًّا من المكوّنين العسكري والمدني لا يرغب في الانتقال إلى الديمقراطية، ولا يتبقّى في هذه الحالة إلّا العوامل الخارجية[46].
- تستشري حالة من التفكك والصراع بين أعضاء المكوِّن الواحد ضمن مسار الصراع على المصالح والمكتسبات، فهناك تنوعٌ وتباينٌ شديدان بين قوى ثورة 19 ديسمبر؛ بين المكونات الحزبية والنقابية والحركات المسلحة، والتي لا تجتمع على مشروع سياسي جامع موحَّد، إلا أنها اجتمعت فقط على إسقاط نظام حكم البشير وحزب الإنقاذ. لقد بدا واضحًا أن الحركات السياسية غير متوافقة على مرحلة انتقالية واضحة المعالم، تقود إلى نظام حكم ديمقراطي بعد البشير، وأن بعضها يعتبر “حصته” في الثورة أكبر من حصة غيره. لكن لديها موقفًا مشتركًا من دور الجيش الذي انتزع زمام المبادرة بالانقلاب على البشير، بدعم من قوى إقليمية.
- غياب القضايا الداخلية الأساسية المتأزمة كالتحول الديمقراطي والأزمة الاقتصادية والمعيشية والصحية والفساد والنزاع القبلي من قائمة الأهداف الاستراتيجية للأطراف الفاعلة في المشهد السوداني. فمن الملاحظ أن الجماعات المؤيِّدة للديمقراطية لا تستجيب فقط لضغوط المجتمع الدولي، بل للظروف الحياتية في البلاد؛ حيث إن ضغط أزمة المعيشة، وتأثير عشرة أشهر بدون حكومة، يؤديان إلى اضطرابات وإضرابات في مختلف القطاعات العامة، وهذا يعني أن هناك ضغطًا داخليًّا كبيرًا على الفاعلين السياسيين؛ المؤيدين للانقلاب والمعارضين؛ لتلبية الاحتياجات الشعبية. وبالرغم من أن المبادرات بشكل عام مستمرة، لكن ضغوط الظروف المعيشية الناجمة عن تأثيرات الانقلاب على الحياة اليومية، دفعت الجهات السياسية إلى التحرك[47]. ثبت للأحزاب اليسارية والمجلس العسكري أنّ هناك واقعًا اقتصاديًّا مترديًا لا يمكن تجاوزه، وأنّ تغييره يحتاج إلى إرادة سياسية قوية تستطيع أن تتّخذ القرارات الصعبة وتتحمّل المسئولية الكاملة عن نتائجها.
- رغبة المكوِّن العسكري في تطويل بقائه في السلطة: وتشير العديد من السياسات التي اتخذها إلى هذا السبب وإلى تنويع مصادر قوته؛ وذلك بتوظيف شبكة العلاقات والتحالفات مع الداخل والخارج في الصراع السياسي والبحث عن حلفاء بالدخل والخارج ويبدو جليًّا أنه قد نجح في ذلك، واستطاع الانخراط في التحالف الإقليمي الذي تقوده الإمارات والسعودية ومصر. ويبدو من الواضح أيضًا أن قائد المكوّن العسكري، الفريق البرهان، استطاع أن يبرهن لحلفائه في الإقليم على أنّه “الرجل القويّ” الذي لا غنى لهم عنه في المحافظة على مصالحهم، وفي السياق نفسه، جاء إيقاف عملية التخلص من نظام البشير والتلاعب بها بالتنشيط والتجميد لـــــ”لجنة التفكيك”، ومحاكمة رموزه بحسب اتجاهات المكوِّن العسكري وتجاوبه مع المعارضة والموقف الشعبي، وكان آخرُها عددًا من الإفراجات القضائية لرموز نظام البشير.
ثالثا – أهم قضايا الأزمة السودانية ودلالاتها:
تتجلى الأزمة السياسية السودانية في عدد من القضايا المركزية التي تكشف عن واقع الأزمة من جهة، وعن طبيعة سياسات مواجهتها؛ بيـن: البحث عن حلول لها، وعمليات التأزيم من قبل قوى داخلية وخارجية. ولعل أهم هذه القضايا تتجسد في: أزمة الانتقال الديمقراطي، الأزمة الاقتصادية، الأزمة الأمنية.
- أزمة الانتقال الديمقراطي:
لا تزال قضية التحول الديمقراطي أزمةً متكررةً في معظم دول أفريقيا؛ وعلى رأسها الدول العربية التي وصلتها موجات ثورات الربيع العربي، ولم يكن السودان استثناء في ذلك، فعلى مدى ثلاثة أعوام ونصف عام؛ هي عُمر الفترة الانتقالية، مرَّت أزمة السودان بتعقيدات وعقبات بسبب الصراع بين مكوناتها كافة: الصراع بين المكونين العسكري والمدني من جهة، وبين عناصر المكون المدني نفسه، وكذلك بين المكون المدني وبعض مجموعات التمرد (قوى الكفاح المسلح) التي انضمت إلى أجهزة الحكم الانتقالي، من جهة ثانية. كما استمر إقصاء قوى ومكونات أخرى خارج هذه المجموعات؛ وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى إنهاء العملية الانتقالية عقب الانقلاب الذي قام به قائد الجيش في 25 أكتوبر لإقصاء شركائه في المكون المدني؛ وهي توضح بشكل عام أن مثل هذه الأزمات تواجه تحدي العلاقات (العسكرية/المدنية)، وفي حالة السودان فإنه يضاف إليها العلاقات (العسكرية/العسكرية) بحكم الشقاق الذي يظهر من حينٍ لآخر بين قادة الجيش وقائد قوات الدعم السريع حميدتي؛ بالإضافة للنزاع مع الحركات المسلحة، والذي حُلَّ مؤقتا باتفاق جوبا، بالإضافة إلى ذلك: النزاعات (المدنية/المدنية) بين المدنيين من قوى 19 ديسمبر الذين ظهر الشقاق وحالة التشظي بينهم مبكرًا منذ الانقلاب الأول الذي نفذه قادة الجيش على نظام البشير، وبين الإسلاميين والعلمانيين.
إن هذه الصراعات القاتلة قد صرفت الأنظار عن مهام العملية الانتقالية برمتها، لاسيما إعادة بناء مؤسسات حكم فعالة والتمهيد لإجراء انتخابات عامة تفرز قوى ذات قدرة تمثيلية حقيقية، والتأسيس لشرعية دستورية جديدة بالبلاد، بجانب وضع البلاد على طريق المسار الديمقراطي. ذلك أنه، وبشكل عام، فإن ترتيبات الحكم المؤقتة، وفقًا لدراسة لروبرت فوستر بعنوان “ترتيبات الحكم المؤقتة في البيئات الهشة وبيئات ما بعد الصراع“: “هي إطار مؤسسي أُرسي من أجل تمكين بلد يحكمه نظام سلطوي غالبًا؛ ليشكِّل “جسرًا” لتجاوز أزمة سياسية أو عنيفة، وبداية عهد جديد يحكمه نظام أكثر ديمقراطية لا يفرِّق بين مواطنيه ومكوناته”؛ بهدف الوصول إلى ترتيبات انتقالية أكثر استقرارًا، عبر مكونات ثلاثة لهذه الترتيبات المؤقتة؛ تتمثل في: تشكيل حكومة يتقاسم مختلف الأطراف فيها الأعباء خلال مراحل الانتقال، والتعهُّد بوقف العدائيات؛ وإيجاد آلية تسمح بنقل السلطة إلى حكومةٍ منتخَبةٍ في الغالب. كما تندرج هذه الترتيبات في أربعة مسارات: سياسي، ودستوري، وأمني، واقتصادي. بالتطبيق على حالة السودان، نجد أنه قد حصل العكسُ من ذلك تمامًا؛ فبدلًا من العكوف على بناءِ مؤسساتٍ انتقاليةٍ قويةٍ وفعَّــالةٍ انتهى الأمر بمحاصصات بين قوى حزبيةٍ تكمن مصالحها الظرفية والضيقة في وراثة النظام السابق فحسب، وليس إنجاز متطلبات التحوُّل الديمقراطيّ. ليس هذا فحسب، وإنما عمدت هذه القوى أيضًا إلى تصفية حساباتها السياسية مع خصومها، وتمكين عناصرها من الحلول في مختلف المواقع والمناصب في أجهزة الدولة المختلفة، رغم أنها زعمت أنها تعمل على إنهاء “دولة التمكين[48].
وبما أن الكلمة الحاسمة في إنهاء حكم البشير كانت –ولا زالت- لقادة الجيش وانتهازهم فرصة الاضطراب الذي أحدثه حراك 19 ديسمبر؛ فإن جزءا كبيرا من الاضطرابات الحالية سببه محاولة الجيش الحفاظ على الوضع الراهن، ومنع عملية التحول الديمقراطي التي ستؤدي لخسارته وضعه الخاص. فالسودان يواجه مأزقــًا معروفــًا، ويعيش تحت رغبات النظام العسكري بعد الانقلاب. وفي القارة الحافلة بالسجل السيء لتحركات العسكريين، فالسودان يحتفظ بمرتبته الخاصة: ستة انقلابات ناجحة، وعشر محاولات فاشلة منذ الاستقلال في 1956. لكن حالة عدم الاستقرار تسارعت منذ الإطاحة بنظام عمر البشير، وردّ الجيش على التظاهرات التي طالبت بتخليه عن السلطة بالقوة وقتل أعداد من المتظاهرين. وبعد سلسلة من المفاوضات حصل نوعٌ من التحالف غير المريح بين الجنرالات والتكنوقراط بقيادة حمدوك الذي شكل حكومة في أغسطس 2019، وظلت في مكانها حتى انقلاب أكتوبر 2021. فالنخبة العربية العسكرية حكمت السودان، وسيطرت على ثرواته منذ الاستقلال، وغلفت حكمها بإطار قومي أو إسلامي أو اشتراكي أو غيره. وكانت النتيجة اندلاع الحروب بين المركز والمناطق المهمشة. ويهدد الحكم المدني الذي يجلب معه الشفافية والديمقراطية المصالح المالية للجيش. وحاول حمدوك الذي رحب الغرب به وقدم الدعم له تعريض المجموعة العسكرية-الصناعية الضخمة للرقابة؛ وهو ما دفع النخبة العسكرية للرد عليه[49]. لذا فإن الانقلاب على حكومة حمدوك في أكتوبر 2021 لم يمثل تحولاً جوهريــًّا في ديناميات السلطة؛ لأن الجيش كان هو المسئول على أي حال، وأن الانقلاب أكد على أن أولويات الجيش عدم فقدان مصالحهم الاقتصادية المربحة، وألا يُحاسَبوا على انتهاكاتهم قبل أو أثناء الفترة الانتقالية.
أما عن معيقات التحول الديمقراطي في السودان فتتمثل في أن الديمقراطية، في أبسط تعريفاتها، لا تعدو أن تكون “منهجًا للحُكم” يستطيع الشعب من خلاله أن يختار قيادة تُوكَل إليها أمور التشريع وإصدار القوانين الملزمة في شئون المجتمع العامة. لكنّ مثل هذا التعريف يمثّل إشكالات عديدة لشركاء الحكومة الانتقالية، ويجعل كلّ فريق منهم يتردّد في مسألة الانتقال إلى الديمقراطية. وأوّل هذه الإشكالات أنّ الانتقال إلى الديمقراطية سيعني -في أدنى مستوياته- الرجوع إلى الشعب ليختار قيادة للحكومة، ولا توجد وسيلة لذلك إلا عن طريق الاستفتاء أو الانتخاب. لكنّ أيًّا من هاتين الوسيلتين ستقود إلى نتائج لا تَصبّ في صالح الائتلاف العسكري-المدنيّ الحاكم. فالعسكريون لا يحبّذون الانتخابات؛ لأنها تعني خروج مجموعتهم الحاكمة بصورة كاملة من العملية السياسية، مع ما يترتّب على ذلك من إرباك شديد لمجمل التعهّدات والاتفاقات التي أبرموها مع القوى الإقليمية الدّاعمة لهم، ولا سيما الإمارات والسعوديّة ومصر، فضلاً عمَّا قد يترتّب على الانتخابات من أضرار مباشرة تلحق بالقيادات العسكرية؛ سواء من ناحية المساءلة القانونية، أو الضرر الاقتصادي؛ ولذلك فإنّ أجندة الجناح العسكري لا تتضمّن الرجوع إلى الانتخابات، بل تسعى من خلال طرق شتّى لإطالة الفترة الانتقالية. ولكي يتحقّق له ذلك، حاول الاستفادة من ثلاثة ملفّات أساسية آلت إليه، وصار يأمل من خلالها أن يبقى في السلطة أطول مدّة مُـمكِنة. يتعلَّق الملفُ الأول بتحقيق السّلام الداخلي مع الحركات المسلّحة، ويتعلّق الثاني بتطبيع العلاقة الخارجية مع إسرائيل في تـماهٍ كاملٍ مع المحور الإماراتي-السعودي. أمّا الملف الثالث فيتعلّق بترتيب العلاقة مع المنظومة العسكرية المصرية في نزاعها مع الحكومة الإثيوبية حول سدّ النهضة. وسيؤدّي أيّ ملفٍّ من هذه الملفّات (في نظر المكوِّن العسكري) إلى تعزيز موقف الجناح العسكري في السلطة، فيكون بمنزلة حكومة أمرٍ واقعٍ لا يمكن لأيّ طرفٍ من الأطراف الاستغناء عنها[50].
بـِما أن الشريك المدني في الحكومة الانتقالية يضم تنظيمات سياسية متعدّدة، ويسعى كلّ منها نحو أهداف خاصة به، فلا مجال للحكم عليه بوصفه جسمًا سياسيًّا واحدًا. لكنّ هذا لا يمنع القول إنّ هناك أسبابًا أيديولوجية وعملية تجعل هذه التنظيمات ترغب في تمديد الفترة الانتقالية وعدم الرغبة في إجراء انتخابات عامة، متّـفقة في ذلك مع المكوّن العسكري في الحكومة الانتقالية. ورأس هذه الأسباب أنّ بعض هذه التنظيمات ذو توجّه أيديولوجي لا يتّسق مع الديمقراطية، كحزب البعث والحزب الشيوعي، أما السبب العملي الذي يجعل هذه التنظيمات تتجنّب الانتخابات، فهو أن أي عملية انتخابية ستفتح نافذة تلِجُ منها القوى السياسية غير المرغوب فيها، ولا سيما حزب الأمة والحزب الاتحادي أو القوى الإسلامية التي كان يعتمد عليها النظام السابق وبعض القوى الاجتماعية التقليدية؛ إذ إن أغلب هذه الأحزاب الصغيرة التي تسيطر على المشهد السياسي في الوقت الرّاهن، خاصّة حزب البعث السوداني والحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري والحزب الشيوعي السوداني، ستتضاءل أو تفقد وجودها كليًّا في حال قيام انتخابات حرة؛ وذلك ما جعل الصادق المهدي، رئيس حزب الأمّة، يهدّدها بــ”ورقة الانتخابات”[51].
أغلب عمليات الانتقال إلى الديمقراطية كانت منذ الستينيّات من القرن الماضي، وستظل في المستقبل المنظور عملياتٍ تؤدّي فيها القوى الاجتماعية والسياسية الداخلية دورًا أساسيًّا، ولن يكون للقوى العسكرية والخارجية دورٌ في ذلك الانتقال، غير أنه يقدّر أنّ القوى العالمية والاقتصادية والتكتلات السياسية ستظل تؤدّي دورًا مهمّا، ومتضاربًا بين مساعي الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لدعم الانتقال إلى الديمقراطية في السودان وتأمين الدعم الاقتصادي لتلك العملية، وبين الأطراف الدولية التي تصطف بجانب العسكريين كروسيا والصين والمحور الثلاثي العربي المناهض للثورات، والتي ترى مصالحها في استقرار الحكم العسكري خاصة أن مصالحها الاقتصادية مرتبطة بشبكة المصالح الاقتصادية للعسكريين. وظهر ذلك من موقف روسيا والصين ومصر من إدانة الانقلاب[52]؛ لذا فإن تأثير العامل الخارجي في عملية الانتقال الديمقراطي متشابك، ويدرك العسكريون ذلك، وهم في إداراتهم لسياستهم الخارجية وعلاقتهم يتحركون خلال تلك التناقضات والثغرات، لكن يظل ملف العقوبات الدولية التي تستهدف المسئولين العسكريين ذوي المصالح التجارية إحدى الأوراق المهمة بيد الولايات المتحدة وحلفائها، كلما طال انتظار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لخلق عواقب لأفعال الحكام العسكريين، زاد النظام من تعزيز سلطته الاقتصادية والسياسية، لكن من المحتمل ألا تنجح مثل هذه العقوبات ضد البرهان وشركاه كما فشلت لسنوات عديدة في إزاحة البشير.
مع فشل العملية الانتقالية واحتدام الصراع على السلطة، وتضاؤل الأمل في تحقيق الانتقال إلى نظام ديمقراطي، وعدم توصل كافة مبادرات ومشاورات التسوية السياسة لحل للأزمة، تبرز هنا جملة من السيناريوهات يمكن أن نجملها في التالي[53]:
السيناريو الأول- عدم الاستقرار السياسي، واستمرار الاضطرابات وتعثر الانتقال السياسي، في ظل غياب الإجماع والتوافق الوطني، بشكل لا يساعد على تأسيس نظام تمثيلي يعكس الأوزان الحقيقية للقوى الحزبية والسياسية بالبلاد ويساعد على قيام نظام سياسي مستقر يجمع بين الشرعيتين: الدستورية والشعبية؛ وهو مرجح في ظل المعطيات الراهنة بالبلاد.
السيناريو الثاني- وهو الأقرب إلى التحقُّق أيضًا؛ وهو قيام نظام هجين يسيطر عليه المكوِّن العسكري، ويتم تدجين هذا النظام، ولكن مع معارضة قوية متصاعدة، خاصة من المكونات التي جرى إقصاؤها عبر الانقلاب الأخير، أو مجموعات أخرى لم تستوعبها التسوية السياسية التي سيقوم عليها هذا النظام الحالي، أو تلك التي تبدو ساخطة على الوضع الراهن.
السيناريو الثالث- حراكٌ جماهيريٌّ سيكون مستمرًّا، وسيكون هذا السيناريو أكثر ترجيحًا في المدى المنظور؛ إذ إن اللجوء إلى تحريك الشارع سيكون السلاحَ الوحيدَ في يد بعض القوى السياسية وكذلك المكون العسكري؛ وبالتالي الشارع، والشارع المضاد، لكن من دون ترجمتها في عملية انتخابية حقيقية تعكس إرادة الشعب، أو تفرز قوى حزبية منتخبة. كما سينتقل توظيف الشارع إلى دولاب الدولة من خلال محاولات توظيف العصيان المدني والإضرابات.
السيناريو الرابع: إكمال الفترة الانتقالية بتجاذبات هنا وهناك، أو التوصل إلى ترتيبات سياسية جديدة، يمكن أن يتبعها إجراء انتخابات عامة ذات مصداقية بحيث تفرز قوى سياسية ذات أوزان تؤسس بدورها لشرعية دستورية تؤدي إلى استقرار البلاد. ولكن هذا السيناريو مستبعد لطموح الجيش في السلطة، وغياب قوى مؤمنة بالديمقراطية وتناضل من أجلها.
- معالجة الوضع الاقتصادي:
كما تقدم، يمثل الوضع الاقتصادي السوداني المتدهور السبب الرئيسي في اندلاع الشرارة الأولى لانتفاضة 19 ديسمبر 2018؛ وتحديدا الزيادة الكبيرة في أسعار السلع الأساسية. فكان تعثّر الاقتصاد في قلب الأزمة الحالية. ومع ذلك، فإن العامل الرئيسي لم يتمثل في المشكلات الاقتصادية بشكل عام، بل كان هو طبيعة الطبقات الاجتماعية التي لحق بها الأذى جرّاء التحديات الاقتصادية الحالية. إذ شعرت طبقة المهنيين الشباب التي تعيش في المراكز الحضرية الرئيسية بالسودان -مثل الخرطوم وأم درمان- بضغط كبير بسبب التضخم السريع في الأسعار، والإحباط إزاء الزبائنية، والفساد الأوسع الذي ينخر في عظام النظام؛ حيث كانت قد اعتادت هذه الطبقة على الإعانات والدعم المقدَّم على السلع الأساسية في ظل النظام الاقتصادي الرعوي الذي استخدمه نظام البشير وسيلةً للحفاظ على شعبيته أو القبول الضمني من قبل المجتمعات السياسية الرئيسية في البلاد[54].
وبلغ التدهور الاقتصادي ذروته عام 2018، بانهيار قيمة الجنيه السودانيّ؛ إذ انخفض سعره الرسميّ ثلاث مرات مقابل الدولار الأمريكي: 18، 29، 47.5 جنيها سودانيًّا مقابل دولار واحد. أما أسعار الدولار في السوق الموازيّة (أو ما يُعرف بالسوق السوداء) فقد قفزت من 20 جنيهًا في أوائل 2018 إلى أكثر من 60 جنيهًا في أواخره. وبذلك ارتفعت معدلات التضخم إلى 68.94 في المئة في نوفمبر 2018. وبذلك سجل السودان ثالث أعلى معدل تضخم في العالم. ونتج عن ذلك ظهور أزمة حادة في المواد البترولية والنقد الأجنبي؛ نتيجة عجز الحكومة عن توفير 120 مليون دولار لصيانة مصفاة الجيلي لتكرير المواد البترولية[55].
وكان الملف الاقتصادي أحد المستهدفات والتحديات الرئيسية التي وضعت أمام حكومة حمدوك؛ إذ دخلت حكومته في عديد من المفاوضات بهدف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب؛ ما يمنحا فرصة لتحصل على منح وقروض من الدول الكبرى والمؤسسات الدولية، بالإضافة لما يعززه ذلك من فتح المجال أمام زيادة الاستثمارات الخارجية دون مخاوف من عقوبات المؤسسات الدولية. وكان البشير في أواخر سنواته قد دخل في مفاوضات مع الإدارة الأمريكية من أجل نفس الهدف، إلا أن ذلك تكلل بالنجاح في ظل حكومة حمدوك، غير أن الاقتصاد تحول في عهد الثورة من الاقتصاد الريعي إلى القائم على المنح والمعونات والقروض.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية مستفحلة لا تزال آثارها ممتدة بعد انتفاضة 19 ديسمبر، ففي أغسطس 2018 بلغ معدل التضخم 66.82٪ ولكنه تجاوز 400٪ بعد الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ تطبيقها مطلع 2021، ليبدأ في التراجع إلى أن وصل في أغسطس 2021 إلى 387.56٪. وبلغ سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي في مارس 2019 في السوق الموازي 71 جنيها، وحسب سعر بنك السودان 47.5 جنيها، ويبلغ صرفه اليوم 437 جنيها في البنك المركزي و450 في السوق الموازي[56]. إلا أن تلك الجهود قد تأثرت بعملية الانتعاش الاقتصادية والاجتماعية في السودان بعد الانقلاب على حكومة حمدوك بالإضافة لما أحدثته استقالته من فراغ سياسي وفشل عملية التحول نحو الحكم المدني، رغم نجاحه في رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ليشهد السودان ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الخبز والوقود عقب إجراءات اتخذتها الحكومة، في 7 مارس 2022، بتحريرٍ كامل لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار؛ حيث وصل سعر الجنيه في البنوك إلى 600 جنيه للدولار الواحد، مقابل 445 جنيها قبيل هذه الإجراءات.
وترتبط الأسباب الهيكلية للأزمة الاقتصادية التي شكلت نقطة انطلاق لانتفاضة 19 ديسمبر بثلاثة عوامل رئيسة ذات طبيعة اجتماعية سياسية؛ هي[57]:
- النزعة القبلية: التي عُززت نتيجة سياسة التهميش الاقتصادي والاجتماعي، والتنمية غير المتوازنة ونتج منها ظهور حركات احتجاجية مطلبية ذات وجهات قبلية وجهوية. وقد أدت هذه السياسة الى تدهور أداء مؤسسات الدولة الخدمية، وزيادة مصروفات العاملين في الدولة في الموازنات السنوية؛ نتيجة المحاباة في التوظيف في القطاع العام، كذلك أسهمت تلك السياسية التفكيكية في تأجيج الحروب الأهلية في جنوبي السودان، قبل انفصاله عام 2011، وفي دارفور، وشرقي السودان، وجنوبي كردفان، والنيل الأزرق؛ لأن التعيين في كثير من وظائف الدولة الخدمية والسيادية كان لا يقوم على معيار الكفاية، بل على الـمَحسوبيّة والسعي لإرضاء أكبر عدد من الزعماء القبليين وقادة الحركات المسلحة. ولم تُعالج جذور هذه المشكلات حتى في اتفاقية السلام عام 2005؛ إذ مالت إلى إرضاء الكيانات الجهوية والقبلية؛ وهو ما أسهم في تغذيّة النزعة القبليّة وتحويلها إلى هويّة سياسيّة.
- السياسات الاقتصادية الريعية والزبائنية: التي أضحت سمةً عامةً من سمات الاقتصاد السوداني. وبعد انقلاب الجبهة الإسلامية القومية (حكومة الإنقاذ)، في يونيو 1989، برز خطاب “التمكين” السياسي والعسكري الذي سمح بتدخل الحزب والمؤسسة العسكريّة في المجالات الاقتصاديّة؛ عن طريق سياسات التحرير والخصخصة. ففي المرحلة الأولى صفيت 273 مؤسسة حكومية رابحة، آلت ملكية معظمها إلى أفراد مرتبطين بالنظام الحاكم، ونشأت في الوقت نفسه نحو 600 شركة تجارية عامة، تتبع الوزارات الاتحاديّة والأجهزة الأمنيّة العسكرية، وكانت تلك الشركات تتمتع بحرية الصرف خارج الموازنة الرسميّة للدولة، ولا تخضع لمراقبة المراجع العام. وكان لهذا النموذج الاقتصادي آثار سلبيّة على الأوضاع الاقتصاديّة، وعدالة توزيع الثروة والدخل القومي بين الأفراد، من جهة، وبين المناطق الحضريّة والريفيّة من جهة أخرى، وأدى هذا على المدى الطويل إلى تآكل الطبقة الوسطى، وأدت عمليات خصخصة قطاع النقل والزراعة والصناعة والتعليم إلى إضعاف النقابات المهنية والعُماليّة في تلك القطاعات أيضًا، وخلق نقابات موالية للنظام.
- السياسات الاقصائية: التي كانت حاضرة منذ السنوات الأُوَل لحكم الإنقاذ؛ إذ أُنهيت خدمات 140,375 موظفًا حكوميًا، وأُبدلوا بموظفين أقل كفاية، من ذوي الولاء السياسي للحزب الحاكم. ولحق ذلك بالإسلاميين أنفسهم بعد الخلاف الذي حدث بين “البشير والترابي “عام 1999، إذ استُبعد معظم الموظفين والعسكريين الذي أعلنوا ولاءهم لحزب المؤتمر الشعبي الذي كان يتزعمه حسن الترابي، ولاحقًا استُبعد كل الذين كانوا ينادون بإصلاح حزب المؤتمر الوطني من الداخل، أو عارضوا سياسات البشير صراحةً؛ بمن فيهم غازي صلاح الدين- الأمين العام السابق لحزب المؤتمر الوطني.
كان لكافة تلك العوامل تجليات على الوضع الاقتصادي؛ حيث بدأت الآثار السلبيّة لهذه العوامل الثلاثة: القبليّة والسياسات الريعية-الزبائنية وعسكرة الاقتصاد ومؤسسات الدولة، تظهر بوضوح بعد انفصال جنوبي السودان في يناير 2011، وفقدان أكثر من 50 في المئة من إيرادات الخزينة العامة، و95 في المئة من الصادرات. ويُعزى تفاقم الأزمة في هذه المرحلة إلى سوء استخدام الحكومة السودانية لعوائد النفط في بناء اقتصاد قوي ومُتنوع، وإخفاقها في إحكام السيطرة على صادرات الذهب التي أضحى نصفها يُهرَّب إلى الدول المجاورة، والباقي يُشترى بطباعة العملة المحلية من دون غطاء، وهذا ما ضاعف حجم التضخم. وفوق هذا وذاك، لم تفلح الحكومة السودانية في جذب الاستثمارات الأجنبيّة؛ بسبب ضعف البيئة الاستثماريّة، وتأثير العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان منذ عام 1993؛ بتهمة دعم الإرهاب. وقد أثــر هذا الوضع سلبيًا في التنمية الاقتصادية والبشرية عامة، والمؤسسات الخدمية (الصحة والتعليم) خاصة. والدليل على ذلك أن نسبة الموازنة المرصودة للمشروعات التنموية كانت أقل من 10 في المئة حتى في فترة الانتعاش النفطي (1999–2011). كل هذه الممارسة الاقتصادية والإدارية الفاشلة وضعت مؤشر قياس التنمية البشرية في السودان في المرتبة 167 من أصل 189 دولة[58].
أما عن التحديات الاقتصادية التي تقف عائقا أمام حل الأزمة الاقتصادية تتمثل فيما أفرزته فترة حكم الإنقاذ (1989 – 2019) من جملة من التحديات الاقتصادية التي خرج من رحمها الأزمة السودانية بشقها السياسي والاقتصادي، وهي[59]:
- السيطرة على صادرات الذهب: تسيطر قوات الدعم السريع التي يرأسها الفريق أول حميدتي، عضو مجلس الرئاسة الانتقالي، على منطقة “جبل عامر” في دارفور، وتعتبر من أهم مناطق تعدين الذهب في السودان، علمًا أن إنتاجية الذهب في السودان بلغت 90 طنًّا عام 2017؛ أي ما يفوق 3.5 مليارات دولار، أو يعادل 57٪ من قيمة صادرات السودان. وفي عام 2017، أسس الفريق حميدتي شركة تجارية باسم “شركة الجنيد”؛ لإدارة عمليات التعدين والبيع والاستثمار في الذهب، مع عدد من القطاعات التجارية داخل السودان وخارجه. ويمثل الذهب المورد الرئيس الذي يمول من خلاله حميدتي قواته العسكرية وقاعدة دعمه السياسية. إلى جانب ذلك، لا تسيطر الحكومة على كميات كبيرة من الذهب الذي يجري تهريبه الى الخارج. وكان وزير الثروة المعدنيّة في حكومة البشير السابقة قدّر أن يصل إنتاج الذهب في الربع الأول من عام 2018 إلى 36.5 طنًا، بينما أكد بنك السودان المركزيّ أن كمية الصادر الرسميّ لم تتجاوز 4.8 أطنان، أي: إن نسبة التهريب من منتجات الذهب تجاوزت 85٪ في الربع الأول من السنة المالية 2018. سيترتب على الحكومة الانتقالية إعادة هذا المورد الحيوي إلى سيطرتها، إذا كان لها أن تنهض بالاقتصاد الوطني؛ وهو أمر لن يكون سهلاً؛ آخذين في الاعتبار شبكة المصالح المرتبطة به.
- الاقتصاد الرمادي: في ظل سياسات التحرير الاقتصاديّ سمحت حكومة الإنقاذ، بل شجعت المؤسسات العسكرية والأمنية، على إنشاء كثير من الشركات التي تعتمد في تمويلها على الخزينة العامة، وتملُّكها. وقد أشارت تقارير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2018 إلى أن المؤسسات العسكرية والأمنية السودانية تمتلك ما لا يقل عن 160 شركة مسجلة خاضعة لسيطرتها (تذكر تقارير أخرى أن العدد يفوق 500)، وتستند في ذلك إلى المادة 49 من القانون العسكري الذي يسمح للقوات المسلحة بإنشاء “أي مشاريع اقتصادية أو استثمارية” تراها ملائمة، وتكون خاضعة مباشرة لوزير الدفاع. ولا تخضع هذه الشركات لرقابة المراجع العام، أو السلطات الضريبيّة التابعة لوزارة المالية، بل تزاحم القطاع الخاص والشركات العامة في مجالات عملها، في أجواءِ تنافُس غير متكافئة؛ لذلك فإن إعادة هيكلة مثل هذه الشركات وتبعيتها إلى وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة سيدخل الحكومة الانتقالية في صراع مباشر مع المؤسسة العسكرية والأمنية التي أضحت هذه الشركات تمثل موردًا مهمًّا من مواردها الذاتية.
- ضعف قدرات مؤسسات الدولة الاقتصاديّة: تعرضت المؤسسات الاقتصاديّة الأساسيّة، ولا سيما بنك السودان المركزي ووزارة الماليّة، في عهد النظام السابق، لنزيف شديد؛ نتيجة لسياسات الفصل والتمكين التي لا تلتزم بمعايير الكفاية العلمية والخبرة العملية. بل إن عملية تسييس إجراءات التوظيف في هذه المؤسسات أخذت مَنحىً قانونيًا، بإجراء تعديلات خطِرة على قوانين بنك السودان المركزيّ ولوائحه، أضرت باستقلاليته، وجعلته خاضعًا لسيطرة وزارة المالية. ومن أبرز التعديلات التي أجريت في هذا الشأن تعديل المادة (2-48) من لوائح بنك السودان التي سمحت لوزارة الماليّة بجدولة متأخرات ديونها إلى مئة عام، علمًا بأن المادة المعدلة كانت تسمح بالجدولة للنصف الأول من السنة المالية التالية فحسب (وهو أمر مهمٌّ لضبط التوسع النقديّ). وبعد هذا التعديل فقد البنك المركزيّ قدرته على ضبط السيولة؛ الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة مضطردة في حجم الكتلة النقديّة؛ فأثر سلبيًا في ارتفاع نسب التضخم، من 15 في المئة عام 2010، إلى 46٪ في 2014. ولم تكن وزارة الماليّة بأحسن حالاً من البنك المركزيّ، فقد أصبحت القرارات الإدارية المهمة التي تصدرها متمركزةً في يد الوزير الذي يُعيّن بمواصفات سياسيّة، من دون النظر في مؤهلاته العلمية وخبرته العملية؛ فانعكس ذلك على إضعاف ولاية الوزارة على الموارد الماليّة للدولة، وظهرت الإعفاءات غير المسوغة، والاعتداءات المكررة على المال العام.
- أزمة الديْن الخارجي وإزالة السودان من قائمة الإرهاب: لا يزال السودان من الدول الـمُثقلة بالديون الخارجية، والدليل على ذلك أن البنك الدولي صنَّف السودان في قائمة الدول المحظورة من الاقتراض Non-accrual منذ عام 1994؛ وذلك بسبب العجز عن السداد، وتصاعد فوائد الديون وغراماتها التي بلغت 49.7 مليار دولار عام 2015، و52.4 مليار دولار (أي: ما يعادل 111 في المئة من الناتج الإجمالي المحليّ) عام 2016، و56.5 مليار دولار قبل سقوط البشير. لذلك لا يستطيع السودان أن يقترض مُجددًا إلا عن طريقين: أحدهما ما يعرف بـ”تخفيف عبء الديون” Debt Relief؛ عبر ما يعرف بـ”مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون The Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative؛ وثانيهما- ما يُعرف بالإنقاذ الكامل Full Bailout؛ ويشرف عليها البنك الدوليّ وصندوق النقد الدولي. لكن الطريقين كليهما لم يكونا متاحين للحكومة السودانيّة إذ كانت مدرجة في قائمة الدول المتهمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية برعاية الإرهاب، فكانت العقوبات الأمريكية الاقتصاديةّ تؤثر تأثيرًا سلبياً ومباشرًا في قدرة السودان في جذب الاستثمارات الأجنبيّة؛ لأن الدول أو الشركات لا ترغب في أن تدخل في مواجهات مع الولايات المتحدة. لذلك يعد من أكبر إنجاز حكومة حمدوك هو كسر العزلة الدولية وإخراج السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. إن هذا فتح الباب أمام السودان للاستفادة من مبادرة “هيبيك” (أطلقها البنك الدولي لتخفيف ديون الدول الفقيرة عام 1996)، والحصول على وعد بإعفاء الخرطوم من 25 مليار دولار من الديون المتراكمة، واستعادة عضويتها في صندوق النقد الدولي، وتأهيلها للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية وإمكانية جذب الاسثمارات الأجنبية[60].
كل تلك العوامل والتحديات تقدم صورة قاتمة عن عمق الأزمة الاقتصادية المركبة؛ ويتمثل ضلعها الأول في ضرورة تحسين الأحوال المعيشية للإنسان السوداني الذي يعاني ارتفاع أسعار السلع الضرورية، وندرة بعضها في الأسواق المحلية. ويتمثل التحدي الثاني في ديون السودان الخارجية التي بلغت نحو 54 مليار دولار أمريكي، في آخر إحصاء رسمي، وأن السودان لم يسدد أكثر من 80 في المئة من المتأخرات المستحقة للدائنين؛ لذلك رفضت المؤسسات والصناديق المالية إقراض السودان قبل سداد الديون المستحقة؛ علمًا بأن أصل هذه الديون بلغ 17 مليار دولار، وفوائدها وغراماتها الجزائية الناتجة من تأخير السداد تبلغ 37 مليارًا.
والأمر الذي يزيد الوضع تعقيدًا أن موازنة السودان، منذ استقلال جنوبي السودان عام 2011، قد أضحت تعاني عجزًا ماليًا كبيرًا، والدليل على ذلك أن قدر العجز ارتفع من 13 مليار دولار أمريكي، عام 2017، إلى 25 مليار دولار أمريكي عام 2018؛ بمعنى أن الحكومة السودانية لا تستطيع تدبير ديونها الخارجية، إلا بإعفائها من هذه الديون، أو إعادة جدولتها، ثم السماح لها بالاقتراض من المؤسسات النقدية العالمية. وقد أسهمت هذه الأزمة المركبة إسهامًا مباشرًا في زيادة التضخم بمتوالية هندسية، وترتب على ذلك تدني سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وفقدان الثقة في البنوك المحلية والعمل الصيرفي.
ومما يزيدُ الوضعَ الاقتصاديَّ سُوءًا: استشراء الفساد في دواوين الحكومة، ومؤسسات القطاعين العام والخاص، وانعكس ذلك، على سبيل المثال، في العقود الـمُبرَمة مع بعض الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب، فضلاً عن تهريب الذهب بكميات كبيرة إلى خارج السودان؛ الأمر الذي أفقد الخزينة السودانية العامة أموالاً طائلة[61]، وسيكون الملف الاقتصادي مؤشر أداء مهم في تحديد نجاح أي حكومة انتقالية أو إخفاقها، خاصة مع تعثر العلمية الانتقالية منذ انقلاب 25 أكتوبر على حكومة حمدوك، ومن بعدها استقالة حمدوك بعد اتفاق الإطار بينه وبين العسكريين، وإيقاف الولايات المتحدة ومؤسسات نقدية دولية أخري ما عرضته من قروض وتسهيلات حتى عودة حكومة مدنية على رأس السلطة في السودان وإتمام عملية الانتقال الديمقراطي.
- الاضطراب الأمني والصراعات المسلحة (القبلية والانفصالية):
تشغل الصراعات المسلَّحة حيّـزًا كبيرًا من تاريخ المشهد السوداني، تارة يكون أحد أطرافها حركات التحرير المسلحة مع القوات الحكومية، وتارة في النزاعات بين القبائل؛ وذلك يتسبب في اضطراب أمني كبير يعقد المشهد السوداني المضطرب بحكم الصراع السياسي ما بعد نظام البشير بين العسكريين والمدنيين. وقد نجح العسكريون في تسكين أحد أطراف تلك الصراعات المسلحة بتوقيع اتفاقية جوبا للسلام في 21 أغسطس 2020 مع “تحالف الجبهة الثورية”؛ وهو تحالف عريض يضم عددًا من القوى السياسية والفصائل المسلحة؟ اتفقت الأطراف على إنشاء خمسة مسارات جهوية للتفاوض المنفرد، مراعاةً لخصوصية كل مسار ومشكلاته. وتشمل المسارات الخمسة مسار دارفور (حركة العدل والمساواة، وجيش تحرير السُّودان، وتحرير السُّودان-المجلس الانتقالي، وتجمع قوى تحرير السُّودان)، ومسار الشرق (مؤتمر البجة المعارض)، ومسار الشمال (كيان الشمال وحركة تحرير كوش السُّودانية)، ومسار الوسط (الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض)، ومسار النيل الأزرق وجنوب كردفان (الحركة الشعبية لتحرير السُّودان–شمال)، إلا أنها لم تشمل كل حركات الكفاح المسلحة، وأهمها: الحركة الشعبية لتحرير السُّودان/شمال جناح عبد العزيز آدم الحلو، وحركة تحرير السُّودان/ جناح عبد الواحد محمد نور[62]، وهو ما عزز موقف العسكريين في السلطة حتى بعد انقلاب 25 أكتوبر، ليشكلوا حليفًا مهمًّا في ظل تعقد المرحلة الانتقالية وعدم التوصل لتسوية مناسبة للصراع السياسي السوداني.
أما الجانب الآخر المتمثل في الصراعات القبلية؛ ضمن الصراعات القائمة على الموارد والمياه ومسارات الرعي ومساحات الأرض، فقد شهدت مناطق عديدة في دارفور من حينٍ إلى آخر اشتباكات دموية بين القبائل العربية والأفريقية. إن التقديرات تشير إلى مقتل 100 شخص، تم إحراق قرى عدة ونزوح حوالي 500 شخص إلى قاعدة عسكرية للجيش السوداني بالقرب من بلدة قريضة (جنوب غرب) طلبـًا للحماية؛ في نزاع قبلي بولاية جنوب دارفور، غربي السودان، بعدما اندلعت معارك عنيفة في 11 قرية بولاية جنوب دارفور؛ جراء مقتل جندي من إحدى القبائل على يد مجهولين من قبيلة أخرى في 26 مارس 2022[63]. وفي السياق نفسه، شهدت ولاية النيل الأزرق اشتباكات قبلية، أسفرت عن مقتل 109 أشخاص، ووقعت الاشتباكات القبلية إثر دعوات من قبيلة “الهمج” لطرد قبيلة “الهوسا” من الولاية السودانية؛ باعتبارهم “سكانـًا غير أصليين” فيها. وتعدُّ الهوسا واحدة من أهم قبائل أفريقيا، وتضم عشرات الملايين من سكان مناطق تمتد من السنغال إلى السودان، ويبلغ عدد أفرادها في السودان حوالي ثلاثة ملايين؛ وهم مسلمون يتحدثون لغة خاصة بهم. عدد النازحين في مدينة الدمازين -مركز ولاية النيل الأزرق- يقدر بحوالي 12 ألفا و600 شخص، فيما وصل 12 ألفًا و800 إلى ولاية سنار (جنوب شرق البلاد)، و4 آلاف و500 إلى ولاية النيل الأبيض (جنوبا)، ووصل ألف و220 نازحًا إلى ولاية الجزيرة (وسط البلاد)[64].
كان تعامل العسكريين مع كلا النزاعين دون مستوى منع تكرارهما؛ إذ اكتفوا بدفع تعزيزات في مناطق الصراع وتأكيدهم أنهم مستمرون في بذل المزيد من الجهد لفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون؛ لإيقاف نزيف الدم ونشر السلام، ولكن دون سياسات واضحة لإيقاف ذلك أو منع تكراره. لذا من المرجح أن يكون اشتباك العسكريين مع تلك الصراعات القبلية ضعيفًا؛ نظرا لانشغالهم بالأزمة السياسية السودانية من جانب، ومن الجانب الآخر فإن هذه الأزمات مما يعزز الحاجة لوجودهم في السلطة في ظل حالة الفراغ السياسي القائمة.
خاتمة:
تمثل الأزمة السياسية السودانية في صورتها الشاملة نمطًا متكرِّرا للأزمات العربية والإفريقية التي تواجه تحديات مشتركة في معظم أزمات المنطقة؛ من جهة أنها تعاني من معضلة التحول الديمقراطي وإدارة عملية الصراع على السلطة والمكتسبات؛ وعلى رأسها إدارة العلاقات المدنية-العسكرية والمدنية-المدنية. بيد أن الحالة السودانية تبرز فيها قضية الشقاق الظاهر والانشطار الكبير في المكون الواحد، كما يبرز فيها غياب الإرداة الباحثة بين أطراف الأزمة عن مشروع وطني جامع ينتشل السودان من واقع أزمتها السياسية والاقتصادية والبنيوية، وفوق ذلك فإنها ضمن تصنيف الدول المتأخرة اقتصاديا، والدولة الهشة في بنيتها وتركيبة السلطة ونظام الحكم فيها، ما يجعلها عرضة لتكرار الأزمات والاضطرابات دون الوصول لتسوية سياسية أو اجماع وطني على الأهداف والمصالح والمسارات. وتتجلي مظاهر ذلك في تعقد الأزمة السياسية الحالية وانفراد العسكريين بالسلطة من جانب، ورفض المكون المدني لمسار الانتخابات؛ خاصة مع تفككه لعدة جبهات، وتمسكه بإتمام عملية التفكيك لــــ”سياسات التمكين” للنظام السابق. ووصلت كافة مسارات التفاوض الدولية والأممية والمحلية إلى آفاق ضبابية دون آليات أو أدوات تلزم أطراف الأزمة بالتوصل لاتفاق شامل لإنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق عملية التداول السلمي للسلطة. لذا فإن المشهد السوداني يهمين عليه “حالة ضد الديمقراطية” تُفاقِم من أزمات رئيسية كانت سببًا في الانتفاضة الشعبية التي أطاح الجيش بالبشير على إثرها؛ ويأتي على رأسها الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها السودان جراء عقود من سياسات الحصار والعقوبات، فضلا عن السياسات الاقصائية وسياسة التهميش الاقتصادي والاجتماعي، والتنمية غير المتوازنة، والـمَحسوبيّة والسعي لإرضاء أكبر عدد من الزعماء القبليين وقادة الحركات المسلحة، والسياسات الاقتصادية الريعية والزبائنية التي أضحت سمةً عامةً من سمات الاقتصاد السوداني بعد انقلاب الجبهة الإسلامية القومية (حكومة الإنقاذ)، في يونيو 1989.
ومنذ الانقلاب الذي نفذه البرهان على حكومة حمدوك في 25 أكتوبر 2021، ظهر بوضح أن العلاقة بين المكونين المدني والعسكري تمرُّ بمنعطف كبير، وتحمل العسكريين المسئولية الكاملة عن إدارة أزمات البلاد؛ بما فيها أزمة شرق السودان، والأزمة الاقتصادية، فضلاً عن المقاومة التي تبديها القوى المدنية. وتلعب الضغوط الخارجية، الأميركية خصوصًا، دورًا أساسيا في تفاقم الأزمة. قد تدفع هذه المتغيرات كلّها في اتجاه تسوية يُعاد من خلالها تشكيل الحكومة المدنية على أساس توسيع قاعدة المشاركة؛ وذلك عبر مسارات تفاوض وتسوية لم يظهر منها أي بوادر تؤشر على اقتراب حل الأزمة العالقة منذ الانقلاب على حمدوك.
بالاضاقة للبُعد الداخلي للأزمة؛ يأتي البُعد الخارجي وتدخلاته وتأثيره على المشهد السوداني وأطراف الأزمة، وتشابكه مع مواقف قوى الداخل؛ بين دول داعمة للمكون العسكري تعمل بشكل أساسي على مسألة الاستقرار وضمان مصالحها دون الالتفات إلى مسألة التحول الديمقراطي والانتقال السلمي للسلطة، ودون مراجعة لقضايا الداخل السياسي المتأزم، ويمثل ذلك الاتجاه كلٌّ من روسيا والصين ومصر والإمارات والسعودية، وبين داعم للمكون المدني ولعملية الانتقال الديمقراطي دون آليات واضحة للدفع نحو ذلك، مع مخاوف من تعقد المشهد العام المضطرب بفعل الصراع والأزمات مع الحركات المسلحة والنزاعات القبلية المتجددة، ويتمثل بالأساس في القوى الغربية. هذا، بالإضافة إلى توظيف أطراف الأزمة علاقاتهم مع الخارج في الصراع السياسي الداخلي.
لذا، فإنه من الصعب الحسم بشأن الاتجاه الذي ستسلكه الأزمة السودانية خلال الفترة القريبة القادمة؛ بسبب وجود متغيرات عديدة داخلية وخارجية. لكن يمكن -في المجمل- القول إن سيناريوهات تطور الأزمة في المرحلة الراهنة من الاستقطاب السياسي وحالة الاحتقان، هر رهينة التعاطي معها من قبل المدنيين والعسكريين. فبينما يحاول العسكريون فرض معادلة شارع مقابل شارع التي فرضتها الثورات المضادة على المسار الديمقراطي في دولٍ عربية أخرى، فإن القوى المدنية إما أن تتراجع إيثار للتهدئة والسلام الوطني أو تتجه إلى مواجهة وصدام أكثر حدة؛ ما يعرّض مستقبل البلاد لمخاطرَ سياسية وأمنية جسيمة. وسيعتمد رجحان أحد هذا الاحتمال على نتاج التفاعل بين العوامل الداخلية والخارجية، وعلى قدرة الوسطاء على تحقيق تسوية تمنع انزلاق البلاد نحو انهيار سياسي أشد خطورة وتعقيدًا.
________________________________
الهوامش
إشراف: مدحت ماهر (*)
[1] كانت قد تشكلت وفقا لمخرجات الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوي إعلان الحرية والتغيير في 17 يوليو 2019.
[2] تم تعديل الوثيقة الدستورية لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، بعد تصديق مجلسي السيادة والوزراء في 12 أكتوبر 2020، وشملت أبرز البنود المعدلة في الوثيقة، تمديد الفترة الانتقالية ليبدأ حساب مدتها (39 شهرا)، من تاريخ توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان في أكتوبر الماضي، بعد أن كان حسابها بنفس المدة منذ أغسطس/آب 2019. كما تضمن التعديل تشكيل مجلس السيادة من 14 عضوا، بينهم 5 أعضاء مدنيين تختارهم “قوى الحرية والتغيير”، و5 أعضاء يختارهم المكون العسكري، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق، و3 أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان (3 أكتوبر 2020)، المصدر: عادل عبد الرحيم، السودان.. تمديد المرحلة الانتقالية 14 شهرا، وكالة الأناضول، 3 نوفمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/bU4br
[3] مستقبل العلاقة بين المدنيين والعسكريين وتحديات المرحلة الانتقالية في السودان، تقدير موقف، المركز العربي للدراسات وأبحاث السياسات، 19 أكتوبر 2021، ص 1.
[4] إسلام خليفة، السودان ما بعد البشير: خرائط الفواعل الداخلية، المعهد المصري للدراسات، 6 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/BWWtT
[5] المصدر السابق.
[6] نص مبادرة رئيس الوزراء: (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال-الطريق للأمام)، سونا، تاريخ النشر 22 يونيو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/TKf5R
[7] Michelle Gavi, Thwarted Coup Signals Dangerous Times for Sudan’s Transition, CFR, September 27, 2021, Accessed:8 October 2022, available at: https://on.cfr.org/3xStiax
[8] مستقبل العلاقة بين المدنيين والعسكريين وتحديات المرحلة الانتقالية في السودان، مصدر سابق، ص: 4.
[9] مزدلفة عثمان، حميدتي يثير الغبار.. اعتراف صريح بفشل “الانقلاب” فهل تتعقد الأوضاع في السودان؟، الجزيرة نت، 2 أغسطس 2022، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3r3AGMm
[10] المشهد السياسي في السودان بعد اتفاق نوفمبر، المركز العربي للدراسات وأبحاث السياسات، 7 ديسمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي:https://bit.ly/3MxosWB
[11] مستقبل الوضع السياسي في السودان، مركز الإمارات للسياسات، 8 ديسمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3C3rMnx
[12] المشهد السياسي في السودان بعد اتفاق نوفمبر، مصدر سابق.
[13] مستقبل الوضع السياسي في السودان، مركز الإمارات للسياسات، مصدر سابق.
[14] يزيد الصايغ، استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مركز مالكوم-كير كارنيجي للشرق الأوسط، 10 يناير 2022، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3BHLiWb
[15] أسواق الخرطوم تتجاهل دعوات العصيان على خلفية قمع المظاهرات، عربي 21، 20 يناير 2022، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3CqJDpx
[16] البرهان: لا أريد حكم السودان.. ويدافع عن التطبيع مع الاحتلال، عربي 21، 12 فبراير 2022، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3CfeAx3
[17] حميدتي: لم ننجح في التغيير وأصبحنا في وضع أسوأ، عربي 21، 2 أغسطس 2022، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3C4XGzK
[18] البرهان يعفي جميع الأعضاء المدنيين بمجلس السيادة السوداني، عربي 21، 6 يوليو 2022، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3fECXev
[19] “المائدة المستديرة” بالسودان يوصي باستكمال الفترة الانتقالية، عربي 21، 14 أغسطس 2022، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3ym4Pef
[20] السودان يطلق سراح عشرات المعتقلين السياسيين.. ما الهدف؟، عربي 21، 22 أبريل 2022، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3dOYlNB
[21] قوى سودانية ترحب بخطوة البرهان نحو الحوار، عربي 21، 16 أبريل 2022، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3UJ7h7S
[22] إدريس فريتاي، مبادرة نداء أهل السودان بين سندان لجان المقاومة ومطرقة قوى الحرية والتغيير، عربي 21، 19 أغسطس 2022، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3LY5Pe1
[23] مجلس السيادة السوداني يسعى لتشكيل حاضنة مدنية.. هل ينجح؟، عربي 21، 22 أبريل 2022، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3ftvuiF
[24] ميثاق سياسي جديد بالسودان.. والجيش ينفي تغييرات بالقيادة، عربي 21، 26 فبراير 2022، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3dNPdZL
[25] قدامة خالد، وثيقة دستورية في السودان بدعم غربي.. هل تلقى استجابة؟، عربي 21، 14 سبتمبر 2022، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3dQqIv2
[26] خالد عبد العزيز ومايكل جورجي ومها الدهان، سقوط البشير كان محتوما بعد تخلي الإمارات عنه، رويترز، 3 يونيو 2019، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://reut.rs/3UI9PDn
[27] ثورة ديسمبر: السياقات والفاعلون وتحديات الانتقال الديمقراطي في السودان، المركز العربي للدراسات وأبحاث السياسات، وحدة الدراسات السياسية، سلسلة تقارير: 3، 2 يونيو 2020، ص: 25.
[28] المصدر السابق، ص: 29.
[29] المصدر السابق، ص: 27.
[30] مستقبل العلاقة بين المدنيين والعسكريين وتحديات المرحلة الانتقالية في السودان، مصدر سابق.
[31] المصدر السابق.
[32] السودان ينفي التقدم بطلب لإنهاء تفويض بعثة “يونيتامس”، عربي 21، 25 أبريل 2022، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3rd4YMQ
[33] إسلام خليفة، السودان ما بعد البشير: خرائط الفواعل الداخلية، مصدر سابق.
[34] مستقبل العلاقة بين المدنيين والعسكريين وتحديات المرحلة الانتقالية في السودان، مصدر سابق.
[35] سمير رمزي، ردود الأفعال المحلية والدولية على تطورات أزمة السودان ودلالاتها، مركز الإمارات للسياسات، 26 أكتوبر 2021، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3r8DhoA
[36] المشهد السياسي في السودان بعد اتفاق نوفمبر، مصدر سابق، ص: 2.
[37] انظر التالي:
- محمد الخضيري، السودان: البرهان يعلن عن تشكيل حكومة جديدة تضم 15 وزيرا وواشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية، فرانس 24، 21 يناير 2022، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3Skbj5b
- أمريكا تلوح بفرض عقوبات على القادة العسكريين بالسودان، عربي 21، 1 فبراير 2022، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3rbiAIr
[38] البرهان يهدد المبعوث الأممي للسودان بالطرد، عربي 21، 2 أبريل 2022، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3LKwjiR
[39] على رأسها الولايات المتحدة … 9 دول غربية تدعو جميع الأطراف السودانية لإطلاق عملية سياسية لاستعادة الحكم المدني، الجزيرة نت، 12 سبتمبر 2022، تاريخ الاطلاع: 4 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3REvI3N
[40] مجلس السيادة السوداني يسعى لتشكيل حاضنة مدنية.. هل ينجح؟، مصدر سابق.
[41] مزدلفة عثمان، حميدتي يثير الغبار.. اعتراف صريح بفشل “الانقلاب” فهل تتعقد الأوضاع في السودان؟، مصدر سابق.
[42] تصريحات سودانية بشأن القاعدة الروسية تثير قلق واشنطن، عربي 21، 4 مارس 2022، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3ftRzxy
[43] اتفاقيات عسكرية واقتصادية “ضخمة” بين السودان والإمارات، عربي 21، 13 مارس 2022، تاريخ الاطلاع: 28 سبتمبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3e0AdI5
[44] وفد دبلوماسي ومخابراتي مصري بالسودان … ومباحثات مع أحزاب، عربي 21، 17 فبراير 2022، تاريخ الاطلاع: 28 سبتمبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3UKKKYA
[45] التجاني عبد القادر حامد، الثورة السودانية وآفاق الانتقال الديموقراطي، سياسات عربية، المركز العربي للدارسات وأبحاث السياسات، العدد 54، ص: 54.
[46] المصدر السابق.
[47] وثيقة دستورية في السودان بدعم غربي… هل تلقى استجابة؟، عربي 21، 14 سبتمبر 2022، تاريخ الاطلاع: 29 سبتمبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3dQqIv2
[48] عباس محمد صالح، عسكرة السياسة: قراءة في انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول في السودان، مركز الجزيرة للدراسات، 15 نوفمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 1 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3e0ejov
[49] بلال ياسين، إيكونوميست: سبب أزمة السودان هو حرص الجيش على مصالحه، عربي 21، 5 يناير 2022، تاريخ الاطلاع: 28 سبتمبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3LYRpKz
[50] التجاني عبد القادر حامد، مرجع سابق، ص 54.
[51] المصدر السابق، ص 56.
[52] انظر:
- مآلات الانتقال السياسي في السودان بعد انفاد المكون العسكري بالسلطة، المركز العربي للدراسات وأبحث السياسات، 8 نوفمبر 2021، ص: 2-3.
- CNN: مخطط لتهريب ذهب السودان إلى روسيا بالتعاون مع العسكر، عربي 21، 30 يوليو 2022، تاريخ الاطلاع: 1 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3CvEDjC
[53] عباس محمد صالح، عسكرة السياسة: قراءة في انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول في السودان، مصدر سابق.
[54] القصة الكاملة لسقوط البشير.. ثورة حقيقية أم مجرد تغيير في الوجوه؟، الجزيرة نت، 5 مايو 2019، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3MxoT3b
[55] ثورة ديسمبر: السياقات والفاعلون وتحديات الانتقال الديمقراطي في السودان، مصدر سابق، ص: 13.
[56] أمير با بكر، 3 أعوام على الثورة السودانية … ما الذي تغير عن حكم البشير؟، الجزيرة نت، 20 ديسمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 28 سبتمبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3RmwHoS
[57] ثورة ديسمبر: السياقات والفاعلون وتحديات الانتقال الديمقراطي في السودان، مصدر سابق، ص11 -12.
[58] المصدر السابق، ص 13.
[59] المصدر السابق، ص ص 14 -16.
[60] أمير با بكر، 3 أعوام على الثورة السودانية … ما الذي تغير عن حكم البشير؟، مصدر سابق.
[61] ثورة ديسمبر: السياقات والفاعلون وتحديات الانتقال الديمقراطي في السودان، مصدر سابق، ص 32.
[62] اتفاق جوبا للسلام في السُّودان: تحدياته وفرص نجاحه، تقدير موقف، المركز العربي للدراسات وأبحاث السياسات، 10 سبتمبر 2020، ص 1.
[63] عضو بالسيادي السوداني: اتفاق وشيك لحل الأزمة السياسية، عربي 21، 9 أبريل 2022، تاريخ الاطلاع: 3 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3ffBHhL
[64] انظر التالي:
- تظاهرات في الخرطوم رفضا لأعمال العنف العرقية بالبلاد، عربي 21، 26 يوليو 2022، تاريخ الاطلاع 3 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3Cgk8Hx
- نزوح الآلاف من جنوب السودان نتيجة الاشتباكات القبلية، عربي 21، 25 يوليو 2022، تاريخ الاطلاع: 3 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3BPA4z2
فصلية قضايا ونظرات- العدد السابع والعشرون ـ أكتوبر 2022