الأبعاد الدينية والثقافية في تحولات المجتمعات والسياسات والتوازنات العربية (2011- 2018)
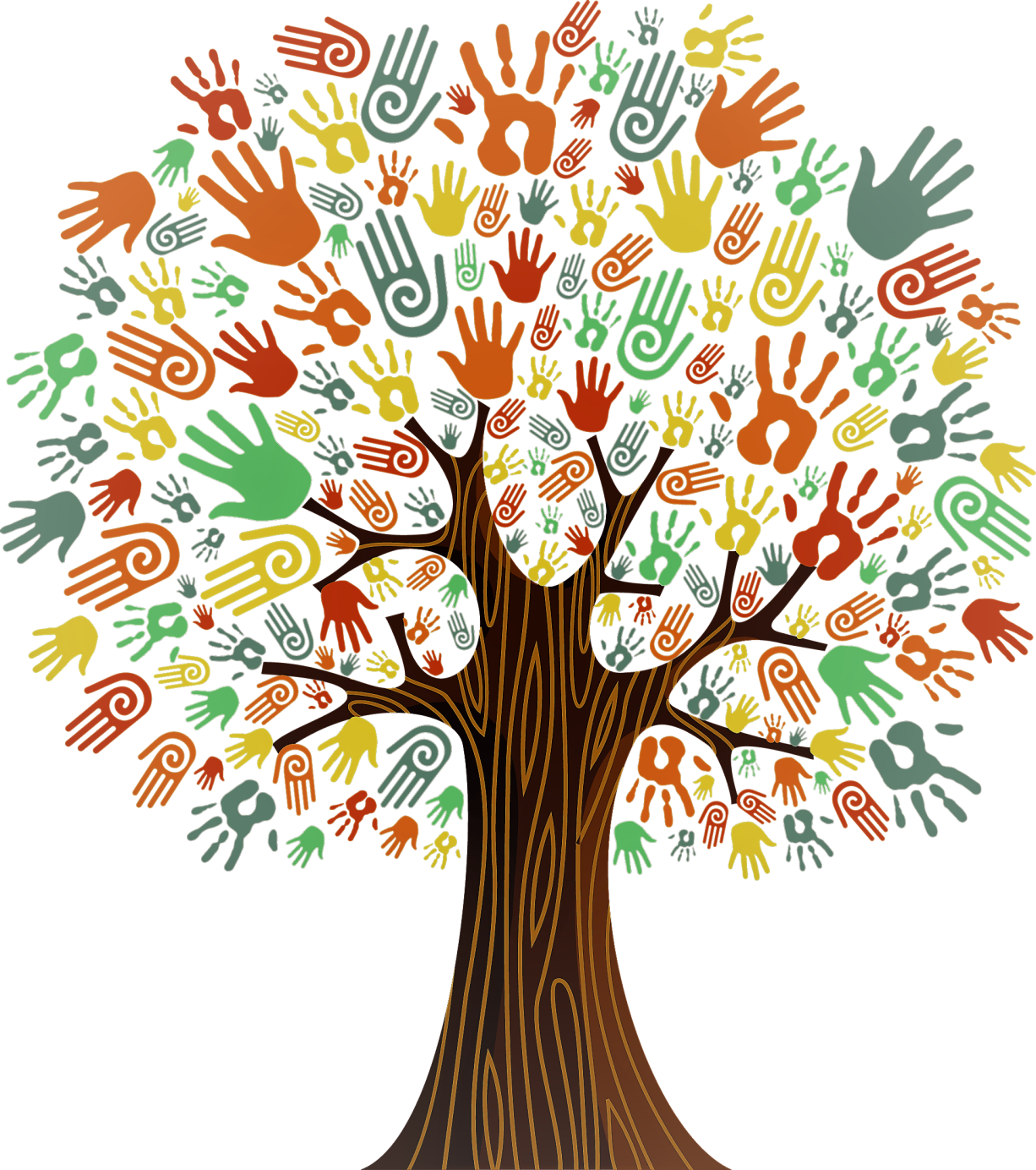
مقدمة:
حين انطلقت “نبوءة” هانتجتون عن “صراع الحضارات” بعد نهاية الحرب الباردة، لم تهدأ الجدالات حول موضع الديني –الثقافي الحضاري سواء من علم السياسة وعلم العلاقات الدولية أو سواء من واقع العلاقات الدولية.
ولقد تزامنت هذه النبوءة مع “حمّى” جدالات العولمة والنظام العالمي الجديد، وفي قلبها جميعًا أيضًا الجدالات حول موضع الثقافي والديني من السياسي: نعم أطلق هانتجتون “نبوءة” ولم يقدم “نظرية” تكتشف جديدًا في علم أو عالم السياسة؛ نبوءة تحذّر وتنبه الغرب أنه بعد نهاية الصراع الأيديولوجي مع “الشرق” بتفكك الاتحاد السوفيتي ومؤسسات إدارة علاقاته مع حلفائه، فإن الغرب ليس بمأمن من أعداء جدد.
ولكنه لم يكن تحذيرًا وتنبيهًا بريئًا بقدر ما كان دعوة لاستراتيجية تجدد وتنفخ الروح في دعاوى وأسس “الثقافي-الديني” التي حلت قائمة رغم تراجعها الظاهر في لغة العلم العلماني والحداثي.
فلقد كانت دعوة هانتجتون استنفارية وتحفيزية وليس دفاعية، لا تعترف بأهمية شيء جديد بقدر ما تعيده إلى الأذهان وتستدعيه إلى الصدارة من جديد في الخطابات والسياسات الرسمية الغربية التي لم تسقط أبدًا من حساباتها وأدواتها هذه العوامل.
ولقد أعطت حالة العالم، منذ 1991، مع انفجار صراعات ذات أبعاد دينية–ثقافية مصداقية لهذه النبوءة، إلا أنه كان لتداعيات هذه النبوءة دورها في هذه الانفجارات، وخاصة في الدائرة الحضارية العربية الإسلامية؛ لأن “العدو الجديد” الذي استدعته النبوءة كان “الحضارة الإسلامية” بالأساس. وهو الأمر الذي أثر على مواقف الغرب واستنفاره أدواتٍ وخطاباتٍ ثقافية في إدارة هذه الصراعات كوسائل لحماية مصالح استراتيجية كبرى وبأدوات عسكرية.
وإذا كانت الدراسات السياسية والدولية المعاصرة لتفاعلات هذه الدائرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اندلاع الثورة الإيرانية على الأقل، لم تعط للأبعاد الدينية الثقافية الحضارية الأولوية مقارنة بالأبعاد الايديولوجية والسياسية التقليدية، إلا أن فهم ودراسة تاريخ العلاقات الدولية بصفة عامة وتاريخ الدائرة الحضارية العربية الإسلامية بصفة خاصة، لا يستقيم ولم يستقم بدون استدعاء الأبعاد الدينية والثقافية والحضارية لفهم التفاعلات الداخلية والاقليمية والعالمية على حد سواء. وكانت أدبيات الاستشراق التقليدي والحديث خير معبرِّ عن هذا التوجه؛ فهي لا تفصل، بموضوعية أو تحيز، بين “الإسلام” وبين هذه التفاعلات، قديمًا وحديثًا. إن دراسة تاريخ هذه الدائرة على الأقل منذ القرون الثلاثة الأخيرة، تبين أن الهجمة الأوروبية الحديثة على هذه الدائرة لم تسقط أبدًا من حساباتها الدوافع والأهداف والأدوات ذات الأبعاد الدينية الثقافية للسياسات التدخلية الاستعمارية. فإن المفاصل الزمنية الكبرى التي شهدت الانتقال من قرن إلى قرن (الثامن عشر، التاسع عشر، العشرين) لم تخلُ أحداثها الكبرى أبدًا من تأثيرات ودلالات هذه الأبعاد الثقافية والحضارية، الظاهرة بضراوة في قلب الأدوات أو الخافية والمستترة وراء العديد من الدوافع المعلنة من: الأرض والثروة والمكانة والسلام والاستقرار، وتوازن القوة، والمصلحة.
وهذه الأبعاد لعبت دورها، على الأصعدة الداخلية والإقليمية والعالمية، وليست النماذج التالية إلا أمثلة على ذلك، الثورات الفرنسية، والأمريكية، والبلشفية، والصينية، والإيرانية، ثورات كبرى أحدثت تغييرات جذرية داخلية أو إقليمية وعالمية، في ظل تدافع وتفاعل بين مجموعتين من العوامل: المادية، والمعنوية. وإذا كانت بعض التفسيرات والرؤى تُعلي دائمًا من إحداها على حساب الأخرى في استقطاب ثنائي، فإن التحليل العلمي من رؤية حضارية إسلامية ينطلق من التفاعل والتدافع بينها، برفض هذه الاستقطابية الثنائية ويبحث عن نمط التفاعل، ولماذا تعلو إحداها عن الأخرى في مرحلة ما وتخبو في مرحلة أخرى.
(1)
وعبر المفصل التاريخي الراهن بين القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين (1991- 2018) شهد العالم حربًا عالمية ثالثة من نوع جديد، تراكمت حلقاتها، وامتدت في أرجاء العالم (القديم) عبر ثلاثة عقود (1991- 2001)، (2001- 2011)، (2011- 2018). فكانت نهاية الحرب الباردة؛ وأحداث الحادي عشر من سبتمبر، والثورات العربية، أحداثًا كبرى انتظمت حولها ونتيجةً لها أزمات وصراعات ساخنة في دوائر حضارية عدة، وعلى رأسها الدائرة العربية الإسلامية.
فإذا كان تفكك الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة والقطبية الثنائية، قُرب نهاية القرن الـعشرين، قد تمّت دون حرب مفتوحة كبرى، إلا أن النظام العالمي في القرن الحادي والعشرين يجري تشكيل توازناته عبر حرب عالمية ثالثة، بالقطعة، وعلى التوالي وليس التزامن، وفي أقاليم العالم ودوائره الحضارية غير الغربية؛ حيث يبدو أن الغرب يقود هذه الحرب حفاظًا على/ ودعمًا لهيمنته “المهددة” المتآكلة عبر العالم في عصر تتعدد فيه الأقطاب ولو الإقليمية، وتتراكم التحديات أمام الأحادية الأمريكية وأمام النموذج الحضاري الغربي (الرأسمالي الليبرالي) من خارجه ومن داخله على حد سواء. ومن ثم فإن نقل أزمات الغرب الداخلية وفيما بين أعضائه إلى الخارج، وبأدوات جديدة في عصر العولمة، أضحى معطاة أساسية في مهمة النظام العالمي وانعكاساته على دائرتنا الحضارية العربية الإسلامية بصفة خاصة، ناهيك عن الدوائر الآسيوية والأفريقية، واللاتينية، بل والأوروبية ذاتها. وكل له خصوصياته الدينية والثقافية والحضارية التي ليست بمنأى عن السياسة والاقتصاد تأثيرًا وتأثرًا.
فبعد عقدين من نهاية حرب باردة (1991- 2011) احتدمت فيهما الحروب الأهلية في البلقان ووسط أفريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث انفجرت قضايا ومشاكل ذات جذور تاريخية وأبعاد دينية وثقافية أثرت وتأثرت بالأبعاد السياسية والعسكرية لهذه الحروب، وبعد تدشين وتفعيل الاستراتيجية الأمريكية العالمية للحرب على الإرهاب، جاء الدور على المنطقة العربية وبعد أزمات وحروب غير متزامنه: أزمة وحرب الخليج (1990- 1991) وحصار العراق حتى 2001، الحرب الأهلية في السودان وانفصال جنوب السودان، والعدوان على أفغانستان 2001، العدوان الأمريكي على العراق 2003، الحروب الإسرائيلية وفلسطين المحتلة 2006-2009، وعقب موجه من الثورات الشعبية السلمية من أجل الحرية والكرامة والعدالة، شهدت المنطقة منذ 2012 سلسلة حروب أهلية متزامنة، شديدة الدموية والطائفية في الشام واليمن وليبيا، وإن لم تشهد مصر مثل هذه الحروب، إلا إنها لم تكن بمنأى عن تأثيراتها وتداعياتها في إطار رفع النظام راية “الحرب على الإرهاب” نيابة عن العالم. فبدلاً من أن تُدخل هذه الثورات دول المنطقة مرحلة من التحرير والتحول الديموقراطي، سبق وشهدتها مناطق شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا بل ودول أفريقية، فإذا بالثورات المضادة تنقلب على هذه الثورات باسم الحرب على الإرهاب وحماية الدول القائمة من الانهيار. وكان من أهم العوامل التي مكنت لهذه الانقلابات: الأوضاع الداخلية والإقليمية وتأثيرات التكوينات القومية والمذهبية والدينية التي أينعت على شكل سلبي وتنامت تدريجيًا منذ1991وبرعاية خارجية.
وقبل رسم خرائط الأدوات والمجالات والنماذج الخاصة بتأثيرات هذه الأبعاد وتداعياتها على المجتمعات العربية، يجدر ابتداء تقديم توضيح بشأن المقصود بها في هذه المرحلة (2012- 2018).
إنها ليست أدوات تدخل خارجية في نطاق مؤامرة على الأوطانّ ولكنها تمثل تربة داخلية تحولت فيها التعددية والتنوع الرشيد، الذي ازدهرت في ظله الحضارة الإسلامية ووصلت إلى ازهى عصورها، إلى ثنائيات استقطابية صراعية مدمرة (لأسباب عديدة داخلية بالأساس؛ على رأسها: تراكم الفهم المشوهّ للإسلام بفعل الجهل والفقر، وأدوات الاستبداد بالعقول والتضيق على الحريات باسم الدين خدمة للحكام،…)؛ وهي التربة التي سهلت، عبر التاريخ الحديث للأمة، ظهورَ وتناميَ وتعمقَ واتساع التدخل الخارجي والتداعي على الأمة باستخدام هذه الأدوات الثقافية وغيرها، على نحو أسرعَ بوتيرة الضعف والانحدار والانقسام والاستعمار والتبعية. ولقد أضحت هذه التربة الآن تنضح بفجاجة بما وصلت إليه العداءات المفتوحة داخل الأوطان بين المذاهب والقوميات والأديان: فماذا فعلنا بأنفسنا لأغراض سياسية (مواطنين، وحكامًا ونخبًا وحركات) خلال الثورات المضادة ؟
ومن ناحية أخرى: صراعات القوى السياسية الداخلية المتحاضنة بقوة الآن مع قوى التدخلات الخارجية في شكل تحالفات وتحالفات مضادة أضحت ذات آثار دينية وثقافية واجتماعية خطيرة تتغذى من أمراض التربة القائمة لدرجة لا تهدد أنظمة ودولًا فقط، ولكن تهدد الأوطان أيضًا بل وجودَ الأمة برمتها في قلب العالم.
(2)
تحاضن الثورات المضادة من الداخل والخارج: مجالات وأدوات انفجار العصبيات والطائفية: ورغم أن الثورات لابد أن تستثير الأبعاد الثقافية، سواء على مستوى الدوافع أو الأهداف أو الأدوات والنتائج، وعلى نحو يتجلى أيضًا في شكل الصراع بين قوى الثورة والقوى المعادية لها، إلا أن الثورات الشعبية العربية شهدت عند انطلاقها (2011) التحام القوى السياسية مختلفة التوجهات الفكرية والأيديولوجية من أجل “الحرية والعدالة”؛ ولكن سرعان ما وجدت الثورات المضادة كعادتها –ضالتها- في هشاشة الصفوف الداخلية لقوى هذه الثورات واختلافاتها الدينية والثقافية والعسكرية والسياسية، وكما يقول لنا التاريخ ويعلمنا –من واقع خبرة ثلاثة قرون سابقة- فإن القوى المضادة للثورات لا تتمكن من الداخل إلا بقدر سماح هذا الداخل.
ومن ناحية أخرى، بقدر ما تكون حالة الداخل محدّدًا لقدر وطبيعة تأثير القوى المضادة، بقدر ما يتأثر هذا الداخل أيضًا وبدوره من التغذية المرتدة، متدخلات هذه القوى على كافة المستويات، وخاصة الثقافية والمجتمعية.
إلا أن الأمر في المرحلة الراهنة كان أكثر خطورة على كافة النماذج العربية لاعتبارين:
1- التحالف الاستراتيجي الفجّ والظاهر علينا وبفجاجة غير معهودة بين قوى الثورة المضادة في الداخل والخارج ضد الشعوب وتطلعاتها، فلقد أضحى بقاء النظم متآكلة الشرعية رهنًا بالمساندة الخارجية.
2- انفجار حروب دموية متزامنة عبر طول المنطقة وعرضها، بأيدي أهل الدول؛ أو بمعنى أصح أهل الطوائف والمذاهب والقوميات والفصائل المتناحرة، وفي ظل رعاية ومباركة من النظم المتكلسة -الملكية منها أو العسكرية- المتهافتة على الحماية من الخارج. ولم يعد هذا الخارج هو القوى الأوروبية أو الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين فقط، ولكن أضحت إسرائيلُ في صدارة هذه القوى التي تتهافت على طلب مساندتها النظم المتهاوية أمام ثورات شعوبها –السلمية منها أو المسلحة- ولذا اكتسبت هذه النظم إلى جانب صفة الاستبداد والظلم صفة الخيانة والتصهين وبجلاء غير مخفّي أو مستتر.
بعبارة أخرى، أضحى المستهدف، في هذه المرحلة سواء من جانب الثورة المضادة من الداخل أو الخارج، هو “الشعوب” وليس النظم أو النخب السياسية المتصارعة، الشعوب بجمعياتها وحركاتها وتنظيماتها المعبرة عن ذاتها الحضارية الإسلامية (بتنويعاتها المذهبية والقومية والدينية)، والتي تستند إليها حمايةً لهذه الذات وبحثًا عن تجديدها وتفعيلها من أجل النهوض الحضاري من جديد. وليس هناك أخطر من الهجوم على الشعوب وقت الحروب، وفي مراحل الانتقال، حين تتدافع القوى من أجل المكاسب السياسية الضيقة بذريعة حماية المصلحة والأمن القومي وحماية الدولة.
وانعكست طبيعة هذه المرحلة الراهنة على تشابك وامتزاج وتداخل وتقاطع مجالات وأدوات الثورة المضادة من الداخل مع نظائرها التدخلية الخارجية، وجميعها موجهة للشعوب بالدرجة الأولى، وجميعها ذات أبعاد دينية وثقافية تلتحف بها أو تتجمل المصالح السياسية للنظم وحلفاءهم من الخارج. ذلك لأن خبرة التواريخ الاجتماعية والسياسية لهذه الشعوب تبين أهمية مرجعية الدين لدى هذه الشعوب، ولذلك تكونت تحالفات بين نخب علمانية وعلماء سلطان، وأذرع إعلامية ورجال أعمال، وبين رأس النظم من العسكر؛ خدمة لمصالح هذه النظم في البقاء ولو بمساندة خارجية.
وكان قلب هذه العملية توظيف الدين ودعوات تجديد الخطاب الديني لإعادة تشكيل الصورة الذهنية للناس عن الإسلام وعلاقته بالحياة وعمن يمثل الإسلام دون غيره (الإسلام الرسمي)، وذلك خدمة لأهداف سياسية تتصل بالصراع على السلطة مع الحركات المعارضة بصفة عامة (وصم العلمانية بالإلحاد) ومع الحركات السياسية الإسلامية بصفة خاصة (وصمها بالإرهاب والخيانة واللعب بالإسلام لإسقاط الدول…). فرغم أن الثورات الشعبية السلمية كانت وطنية جامعة وحاضنة لكافة التيارات إلا أن مسار هذه الثورات بيَّن استقطابًا حادًا إسلاميًا- علمانيًا اتخذ أشكالاً مختلفة من وطن إلى آخر. وازداد هذا الاستقطاب حين كشفت مسارات الثورات-سواء السلمية أو المسلحة– عن صعود الحركات السياسية الإسلامية بالانتخابات أو الحركات المسلحة (التكفيرية أو غيرها). ومن هنا أضحى التساؤل الكبير هو: هل الثورات المضادة ضد الديموقراطية أم ضد الإسلامية؟ أم ضد ديموقراطية تأتي بالإسلاميين؟ أم ضد ديمقراطية وإسلامية تعصف بالعسكر ومراكز القوى المالية والسياسية التقليدية؟
ولقد تعددت مجالات وأدوات إدارة الساحة بتوظيف الدين، ومنها:
· شيطنة الحركات السياسية الإسلامية التي صعدت بالانتخابات ووصمها بالخيانة وعدم الوطنية والإرهاب والخطورة على الإسلام؛ لأنها توظفه في السياسة، وللوصول إلى السلطة، سلميًا أو عسكريًا، لتكوين دولة دينية تعصف بالدولة القومية.
· تزكية الفرقة والانقسام بل والصراع بين روافد التيار الإسلامي (الصوفية، السلفية، الإخوان، الجهاديين) وذلك بدعم تيار في مواجهة آخر على نحو جسَّدَ الصورة المتشرذمة عن الإسلامية.
· السكوت عن صعود حركات إسلامية مسلحة شيعية (الحوثيين) مناوئة لحركات إسلامية سلمية سُنية (حركة الإصلاح في اليمن)، وبالمثل السكوت عن صعود حركة إسلامية سُنية مسلحة في العراق (دولة إسلامية في العراق) مناوئة لدور الشيعة المتصاعد والتدخل الإيراني في العراق.
· تعبئة فتاوي علماء السلطان، لدرجة قد تصل (كما حدث في السعودية) إلى انقلابات في الفتاوي لتبرير مسار سياسي داخلي وخارجي، وكذلك تبرير التغيرات المجتمعية المفروضة من أعلى وفجأة.
· عسكرة الثورات بذريعة محاربة الإرهاب والتصدي للنفوذ الإيراني، وذلك بتمويل جماعات إسلامية مسلحة جرى توصيفها بكونها متشددة ثم إرهابية (حالة سوريا) أو يشن حرب مفتوحة تحت مظلة تحالف دولي عربي على اليمن.
· مراقبة هجمة قوى علمانية على “الإسلامية” بصفة عامة وليس الحركات السياسية الإسلامية فقط، والسكوت عنها أحيانًا وضبطتها أحيانًا أخرى: (الهجوم على الأزهر، الجمعيات الإسلامية، مهاجمة مظاهر التدين ولو الشكلية وخاصة الحجاب، التطاول الجاهل على التراث..). فعلى سبيل المثال حين تجد حالة تحالف معلنة بين قوى علمانية والنظام العسكري (مصر) نجد تحالفًا ظاهرًا وجلَّيًا بين رئاسة الدولة المدنية والتيار العلماني (تونس).
· سياسة الإلهاء للناس، من خلال الأزمات المفتعلة على رسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الأذرع الإعلامية. فبقدر ما يمثل الناس ضحايا “الحروب المسلحة” بقدر ما يقعون أيضًا فريسة حروب الجيل الرابع التي تقودها النظم في داخل دولها بنفسها وضد مواطنيها رغم ادعاء هذه النظم أن دولها تتعرض -بفعل مؤامرات خارجية – لحروب الجيل الرابع.
ومن أهم مجالات وأدوات قوى الثورة المضادة من الخارج ذات التأثير على الأبعاد المجتمعية وتأثرًا بها:
– المراقبة وإعطاء الضوء الأخضر للانقلابات العسكرية ضد الثورات والسكوت عنها إن لم يكن دعمها علانيةً وسرًا، والموافقة على ذريعة النظم المعلنة لإجهاض الثورات السلمية والمسلحة على حد سواء، وهي: محاربة الإرهاب والحفاظ على الدول وحماية أمن واستقرار العالم.
– التلاعب بالجماعات والكيانات القومية (ترك، كرد، عرب) أو المذهبية (سنة وشيعة) ضد بعضها البعض، على سبيل المثال: مساندة الولايات المتحدة الأمريكية للشيعة في العراق على حساب السُّنة معارضي الاحتلال الأمريكي، السكوت على نمو الحوثيين في اليمن لمواجهة القاعدة من ناحية والإصلاح من ناحية أخرى. اللعب الأمريكي بورقة أكراد سوريا في مواجهة تركيا، التنسيق الروسي الأمريكي حول أدوار تركيا وإيران رغم ما يعلناه من مواجهة بينهما على مستقبل نظام الأسد.
فمن وراء داعش، ظهورًا واستمرارًا؟ من وراء تمويلها وتسليحها وامتداداتها خارج العراق ثم خارج سوريا إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا؟؟!
– منظومات بيع السلاح: لمن؟ وإلى أين؟ في مقابل إعلان عدم التدخل العسكري المباشر (عدا روسيا طبعًا) وعدم القيام بالضغوط السياسية اللازمة لوقف الحروب؛ وذلك لأن حسابات المصالح والمكاسب والخسائر تقتضي -وفق منطق القوى الكبرى- أن يتم حسم المعارك عسكريًا أولاً قبل أن تبدأ التسويات السياسية.
– الضغوط على الأنظمة الحليفة بأوراق المعارضة ضدها، سواء الحركات المسلحة أو غيرها، سواء من أجل تحقيق مكاسب مباشرة أو فرض تغييرات داخلية على بعض الدول، فمثلاً: رفض أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إعلان الإخوان جماعة إرهابية، على عكس روسيا، ضغوط روسيا على إيران بشأن تقييد وجودها ودورها العسكري في جنوب غرب سوريا امتثالاً لإسرائيل وللتنسيق الروسي الأمريكي، الحملة الدولية –الرسمية وغير الرسمية- ضد انتهاكات القوات السعودية والإماراتية في اليمن، رغم استمرار الدعم الأمريكي للدولتين في المواجهة مع إيران، وفي المقابل تمثل ورقة المساندة في وجه التهديد الإيراني للسعودية ورقة أمريكية رابحة، استنزفت بمقتضاها المليارات السعودية (والخليجية) لشراء السلاح أو أصول أمريكية، ناهيك عن المبادرة بإعلان سريع ومفاجئ لتغييرات داخلية مجتمعية وسياسية ترضى عنها وتطلبها منذ زمن “الولايات المتحدة الأمريكية”.
– تغذية الانقسامات فيما بين الدول العربية وبينها وبين دول جوارها الحضاري، حول سبل التعامل مع الثورات والثورات المضادة، وأبرز مثال: ما يسمى “حصار قطر” منذ يونيه 2017، الاختلافات بين مصر والسعودية والإمارات وبين دول شمال أفريقيا حول سبل حل الأزمة في ليبيا، وفي حين تأخذ إيران جانب نظام الأسد والانقلاب الحوثي على الثورة في اليمن إلا أنها ترفض حصار قطر، وفي حين ترفض قطر وتركيا حصار إيران فهما يرفضان أيضًا سياسات مصر والخليج تجاه ليبيا والقرن الأفريقي وبالطبع سوريا… وهكذا دواليك.
وتمتد آثار مجمل هذه السياسات إلى قلب المجتمعات ونبض شعوبهم فهم وقود الحرب ووقود التسويات، بقدر ما يمثل نخبهم وساساتهم، في أعلى هرم السلطة، لوردات الحروب ومحصلي المكاسب تحت الذريعة المتهالكة؛ وهي حماية الدول وحماية الأمن والمصلحة القومية، التي تتطابق مع بقاء ومصلحة رأس النظام.
(3)
تكشف السنوات التالية على اندلاع الثورات عن مجموعة من النماذج المجتمعية التي تجسد تداعيات أدوات الثورات المضادة ومجالاتها ذات الأبعاد الدينية والثقافية، فبقدر ما كانت تربة هذه المجتمعات بانقساماتها السياسية والمذهبية والدينية والقومية، تربة خصبة لهذه الأدوات التدخلية الإجهاضية للتغيير بقدر ما ترتب عليها تداعيات زادت من حال هذه المجتمعات سوءًا على سوء وعلى النحو الذي أفرز الصيحة التالية:
إلى أين المآل بهذه المجتمعات؟
· نموذج المجتمعات المتشرذمة المنهكة المنتهكة بفعل الحروب الدامية التي يحارب فيها الجميع ضد الجميع في ظل ضبابية العدو والتهديد، وتداعيات هذا النمط من الحروب على تماسك الأسر، ومستقبل جيل كامل بدون تعليم وصحة وأمن، الاستقطابات العدائية، أزمة الهوية، وأزمة الانتماء لوطن أو لأمة بل وللإنسانية.
· نموذج الإفقار، فحتى في المجتمعات التي لم تدمرها الحروب المفتوحة، تتآكل قدرات أفرادها ومجموعاتها، بسياسات الإفقار، وهي نمطان: نمط مفروض من الخارج “روشته صندوق النقد الدولي” اللازم تنفيذها ليتم إقراض النظام وعدم إعلان افلاسه، وهي روشتة متحيزة ضد محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة ناهيك عن الفقراء بالفعل. النمط الثاني من سياسات الإفقار، مرده انعدام الرؤية الاستراتيجية عن التنمية الفاعلة الرشيدة التي تصب في عافية كل قطاعات الاقتصاد والمال وتعم نتائجها على كافة الناس، ولا تظل قاصرة على القطاعات الريعية الخدمية للطبقة الرأسمالية الطفيلية (وليس الصناعية أو الزراعية).
· نموذج إحكام العسكرة للسياسة والاقتصاد وللمجتمعات والدولة، وأدًا للحركات الشعبية أو السياسية المدنية أو الإسلامية، التي انتظمت من أجل الحريات والمدنية وضد الفساد والتبعية؛ وذلك بذريعة محاربة الإرهاب من ناحية، والحفاظ على الدول من الانهيار من ناحية أخرى، وبمبرر أن الشعوب لا تقدر بعد على أعباء الاختيار الحر في ظل ديموقراطيات مباشرة تعددية تنافسية.
· نموذج العلمانية الفجة، أو العلمانية المتحولة، نموذج الإسلام العلماني أو المدني أو الحداثي (كما يصفه العلمانيون) بقيادة علماء السلطان الذين يحبسونه من ناحية في نطاق شعائري محدود بين جدران المساجد في ساعات محددة وعبر أبواق إعلام علماء السلطان، وينزعون عنه -من ناحية أخرى- خصائصه الشاملة كنظام للحياة، ودافع لمقاومة الظلم، ومحفز على الجهاد ضد الأعداء دفاعًا عن الأرض والعرض والكرامة والدين، ومناطًا للقيم والأخلاق الفردية والجماعية والإنسانية، ويجردونه من ناحية ثالثة من إجماع أهل السنة والجماعة حتى ولو فيما هو معروف من الدين بالضرورة ووقرت عليه تقاليد الأمة أو جاء في أحكام قطعية، مثل( الحجاب، المواريث، الحريات، علاقات المرأة والرجل خارج الزواج وفي اطاره، الأخلاق والقيم، العدالة).
· نموذج التصهين الكامن: المتمثل في عدم الانتفاض ضد تصفية القضية الفلسطينية متمثلة بالأساس في تهويد القدس والأقصى، وإعلان إسرائيل دولة يهودية، وعدم الاعتراض على سياسات التحالفات الجارية بين النظم العربية وإسرائيل، بل والسكوت المخذي على التداعيات اللإنسانية لحصار غزة المستمر، بذريعة إرهاب حماس وبتهديدها أمن سيناء وتحالفها مع إيران.
· نموذج اللامبالاة أو الاستكانة أو الخوف، أو اليأس والإحباط؛ التي تحول دون حراك شعبي ضد كل النماذج السابقة من الطائفية، العسكرة، الرأسمالية المتوحشة، التصهين، والتي ترجع جميعها إلى اغتصاب كرامة “المجتمع” ونزع قدراته وإمكانياته التنظيمية والتجميعية، وتجفيف موارد العمل الأهلي والإغاثي الحر والفاعل، لم يعد الأمر مجرد عدم تمكين المجتمع كما يجب لرقابة السلطة العليا في الدولة وترشيدها من خلال معارضة سلمية مدنية حرة، ولكن وصل الأمر إلى خنق المجتمع وإسكاته بعد “موت السياسة” أو وطأة الحروب الدامية أو وطأة تآمر النظم مع اعداء الأوطان والأمة.
وفي خاتمة القول يجدر التوقف عند الأمرين التاليين:
1- بالنظر إلى النماذج السابقة من التداعيات المجتمعية، يجدر القول إنها لا تعكس قضايا فجائية أو تحولية بقدر ما تمثل مسائل جديدة لنفس القضايا الممتدة، تختلف بالطبع، مقارنة بما سبقها من مسائل، من حيث الدرجة والعمق والاتساع، ناهيك بالطبع عن اختلاف السياقات الزمانية وتأثيراتها.
2- لا تمثل هذه النماذج إلا وجه العملة “السلبي”، وإن كان الأكثر تروجًيا إلا أنه للعملة وجهًا آخر أقل لمعانًا وأقل ظهورًا، أنه الأقوى والأكثر تعبيرًا عن الأمل في مستقبل التغيير وضرورة التفاءل بإمكانية حدوثه، ولكن انطلاقًا من تجديد في الفكر والثقافة والسلوك، وففي قلبهم “فهم الإسلام”، ابتداء بالفرد والسرة والجماعات، نواة لمجتمعات متمكنة رشيدة تقدر على “التغيير الحضاري”: ابتداء من أعلى رأس السلطة أو بالإصلاح التدريجي وصولًا إلى قمة هرم هذه السلطة.
*****
(*) أستاذ العلاقات الدولية المتفرغ، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ومدير مركز الحضارة للدراسات والبحوث.






