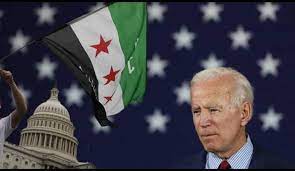سؤال الطوفان وانقسام حركة التحرير: هل من سبيل إلى التئام فلسطيني قادم؟

سؤال هذه الورقة عن: الأثر المتبادل بين مجريات الطوفان منذ 7 أكتوبر 2023 وبين حالة الانقسام الوطني الفلسطيني، وإمكان طرح رؤية للانتقال من الانقسام إلى الالتئام. ومنهجية الطرح وصفية تاريخية قبل أن تقف أمام المشهد الراهن ومشاهده المعبرة بمنظور حضاري ذي تركيز سياسي. تهدف الورقة إلى الوصول لرؤية تستوعب واقع الانقسام والصراع الفلسطيني المؤسف قدر الإمكان؛ بتحدياته الداخلية والخارجية، كي تتجاوزه ولو بخطوة قصيرة نحو مستقبل أفضل نسبيًّا.
أولا- ذاكرة الانقسام وتفسير فشل الالتئام
إذا كان مشروع التحرر الوطني الفلسطيني قد نيط بمنظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي (الوحيد) للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، فقد تعرضت هذه المنظمة لأزمات داخلية وخارجية تقريبا منذ نشأتها 1964، وطردها من الأردن نهاية الستينيات، ثم انسحابها من لبنان منتصف السبعينيات، ثم مطاردتها دوليا باسم الإرهاب الدولي الفلسطيني عبر الثمانينيات، وصولا إلى انبثاق حركات خارجة عنها (حركة الجهاد في فلسطين 1981 تأثرًا بالثورة الإيرانية، وحركة المقاومة الإسلامية حماس المنتمية لتيار الإخوان انبثاقًا من الانتفاضة الأولى 1987)، ثم تحوُّل المنظمة الاستراتيجي للاعتراف بدولة إسرائيل والمطالبة بدولة على حدود 1967 في إعلان الجزائر 1988؛ ما فتح الطريق نحو مدريد 1991 ثم أوسلو 1993. وارتبط ذلك بتحولات السياق العربي من سياق حاضن إلى سياق طارد، ثم تراوحه بين عدم المبالاة بالقضية والتقارب مع دولة الاحتلال.
والآن: كيف تواجه حركة التحرر الفلسطينية بفصائلها هذه معضلة توحُّد عدوها وتترُّسه بحلفاء يتزايدون، بينما صفوفها هي متفرقة وحلفاؤها ينقصون وينفضُّون عنها؟
أ) الانقسام والصراع داخل قوة التحرير الفلسطينية
يرى بسام الزبيدي أن الخلاف السياسي الفلسطيني مثله مثل غيره من أشباهه في غير فلسطين، طبيعي ومشتمل على تنوعات. ويعود سبب تحوُّل مثل هذه الخلافات إلى انقسامات فصراعات إلى استفحالها دون معالجتها المعالجة الفعالة. وهذا ماثل منذ بداية الصدام بالمشروع الصهيوني، يتم ضبطه تارة، وينفلت ويتحول إلى صراعات وانقسامات تارة أخرى. ثم إنه لا يحسن فهم الانقسام ولا معالجته دون مَوْضَعَتِهِ في إطار اتفاق أوسلو وما تلاه. “فذلك الاتفاق يجوز وصفه بالانقسام الأكبر في الساحة الفلسطينية، بحكم أنه وفَّر منذ لحظته الأولى أسبابًا بنيوية عميقة للتنافر والتشرذم؛ ومن ثم لمزيد من الانقسام والاقتتال بين الفلسطينيين، كما جرى في صيف 2007”. بناء عليه فإن مبادرات إنهاء الانقسام بصيغها المختلفة، بدت -وفقًا للزبيدي- كأنها تعيد إنتاج الانقسام عبر تقاسم السيطرة والنفوذ بين حركتي فتح وحماس. ومن ثم يرى أن إنهاء هذا الانقسام “يقتضي الاحتكام إلى قواعد مختلفة تستند إلى تعاقد اجتماعي-سياسي، ينبثق منه توافق وطني على أساسيات المسألة الوطنية وخطوطها العريضة. لتحقيق هذا العقد، لا بدَّ من ولوج كل طرف بمصالحتين: الأولى مع المشروع الوطني بغرض ترميم علاقته به؛ لاستعادة ثقة الناس به، ومصالحة أخرى مع الذات لتطهيرها مما تضمره من نزعات إقصائية فكرًا وسلوكًا ضد الآخرين”[1].
إذن، رغم الخلافات السابقة، فإن الخلاف حول أوسلو هو أساس الانقسام القائم. فرغم أن ياسر عرفات نجح في توقيع الاتفاق مع رئيس الوزراء الصهيوني إسحاق رابين باسم إعلان المبادئ 1994، إلا أنه يمكن القول إنه أعلن عن وفاتها قبيل وفاته بأربع سنين، عندما تضامن مع انتفاضة الأقصى 2000. فوفق أوسلو فإن الطريق الوحيد للتسوية هو المفاوضات، وسوف تقيم سلطة ذاتية محدودة في جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية، لم يحدِّد ما بعدها وترك لمفاوضات تالية. واتَّسعت أوسلو للتأويل المستمر بل للتغيير عمليًّا وإملاء الشروط من قبل إسرائيل، والتنصُّل مما لا تريده في تلك الاتفاقية. ورغم اعتماد قراري مجلس الأمن 242 و338 غاية للتسوية الدائمة المؤسسة على أوسلو، فإن الأمور مَضَتْ في الاتجاه العكسي: مزيدًا من الاستيطان، ومن الاعتداءات، ومن التضييق وتجميد القضية. ترتَّب على ذلك تعارضٌ سياسيٌّ عميقٌ في صفوف الفلسطينيين بين مؤيِّد ومعارض.
في الفترة من 2004 حين توفي عرفات وتولَّى محمود عباس محله، إلى 2006، انشغل الفلسطينيون بما يمكن تسميته نظامهم السياسي. ومن ثم جرت انتخابات 2006، وكانت المفاجأة فوز حركة حماس فيها برلمانيًّا ومن ثم حقها في تولِّي رئاسة الحكومة في الضفة وغزة. لكن الأمر لم يكتمل، واعترضت فتح في الضفة، فثارت حماس وفرضت حكمها على غزة 2007. واتضح أن الانتخابات التي نَصَّتْ عليها أوسلو كانت مشروطة عمليًّا بأن تأتي بشريك سلام “أوسلوي” لا بمعارض لأوسلو؛ بحيث لا تتعارض شرعيته الداخلية مع شرعيته الخارجية (الأوسلوية). “هذا الحال.. قسم الفلسطينيين إلى أخيار منخرطين بعملية السلام، يؤسسون لدولة ينبغي دعمهم وحمايتهم، وأشرار معارضين لا بد من محاصرتهم؛ ما جعل الفريق الأول يوغل بالقمع والاعتقال والتنكيل والتعذيب بحق المعارضين”[2].
يقول يوني بن مناحيم: “إن البند الأكثر أهمية في اتفاق أوسلو، من وجهة نظر “إسرائيل”، تم الحفاظ عليه بعناية. يتعلق الأمر بالتنسيق الأمني بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية، والذي يستفيد منه الطرفان. وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عدة مرات في السنوات الأخيرة عن تجميد التنسيق الأمني، لكنه لم ينفذ القرار قط، وهو يفهم جيدًا أن هذا “خط أحمر” بالنسبة لـ”إسرائيل” لا يجوز تجاوزه”[3].
وقد شهدت الفترة 2007-2023 صراعات بين طرفي الانقسام: فتح وحماس، وأيضًا بين فتح وفصائل وقطاعات شعبية أخرى. هذه الصراعات أخذت أشكالا من المهم تذكُّرها: توسعة حماس وفصائل المقاومة وجودها في مدن شمال الضفة، وفي المقابل دأبت السلطة على حملات اعتقال لمقاومين. ثم ظهرت بالتدريج معارضة مدنية للسلطة تعارض ممارساتها القمعية في حق ناشطين حقوقيين أو وطنيين، فواجهتهم السلطة بشيء من القوة. وظلت أكثر صور الصراع خطابية ودعائية متبادلة؛ حيث تدين المقاومة السلطة باختطاف منظمة التحرير الفلسطينية والقرار الوطني، والخضوع للتنسيق الأمني مع العدو ضد الصديق والأخ، بينما ركبت السلطة موجة تشويه المقاومة خاصة في ظل ارتباط حماس بالحركة الإسلامية التي حوربت إقليميًّا في العقد الأخير.
في العقد الأخير، تحوَّل المشهد الفلسطيني من قوة داخلية مدعومة إقليميًّا، ومشايعة عبر أقاليم العالم عدا شماله الغربي، إلى انقسام وصراع داخلي، يعاديه النطاق الإقليمي أو يتخلى عنه، وينصرف عنه البقية عبر العالم. بينما العدو الصهيوني -في المقابل- يتحرك من بؤرة مواجهة، ومحاصرة إقليمية سلبية على الأقل، وعلاقات عالمية غير راسخة، إلى توسع استيطاني متزايد، وتهويد للأرض ومعالمها في فلسطين مستمر، واختراق للإقليم وإقامة علاقات علنية اقتصادية وسياسية مع أقطاب عربية، فضلا عن بروز لعلاقات عالمية كثيفة وعميقة. ومن ثم أصبح الانقسام الفلسطيني تقسيمًا متعمَّدًا من السياقين الإقليمي والعالمي، تقوده دولة الاحتلال، وأصبحت جهود المصالحة أصعب وأبعد عن التحقُّق.
وقد تعدَّدت جهود المصالحة عبر نحو عقدين؛ بدءًا من وثيقة الأسرى، فإعلان القاهرة ٢٠٠٥، فـاتفاق مكة ۲۰۰٦، وإعلان صنعاء ۲۰۰۸، فالحوار الوطني الثنائي الشامل برعاية مصرية، والذي استمر فترة وانتهى بالورقة المصرية أو ما عرف باتفاق القاهرة ۲۰۱۱ ؛ ثم لم يترتب عليه أي جديد، ولحق به اتفاق الدوحة ۲۰۱۲، الذي وقعه محمود عباس رئيس السلطة بنفسه وخالد مشعل رئيس حركة حماس، ولم يتم تطبيقه، لينضم إليه “اتفاق القاهرة الثاني ۲۰۱۲”. في أبريل ۲۰۱٤ قام الفلسطينيون وحدهم دون رعاية من أحد بتوقيع “اتفاق الشاطئ” في غزة، لإعادة حكومة غزة إلى السلطة وتشكيل حكومة توافق وطني، لكن أيضًا دون جدوى حقيقية؛ حيث أعلنت حركة حماس في مارس ۲۰۱۷ عن لجنة إدارية بديلة عن حكومة الوفاق لإدارة القطاع، وطالب محمود عباس بحلها، ولم تستجب حماس، فردَّت السلطة بإجراءات عقابية غير مسبوقة تجاه حركة حماس، ما عقَّد الأمور في قطاع غزة[4]. وعلى مدى سنوات طويلة عقدت لقاءات عدة بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وكان آخرها اجتماعات الجزائر في أكتوبر 2022 ولقاء بمدينة العلمين المصرية في 30 يوليو 2023، دون أن تُسْفِرَ عن خطوات عملية جادَّة تحقِّق هدفَها.
لا شكَّ أن العدو الصهيوني وحلفاءه -خاصة الولايات المتحدة- قد عملوا على استغلال وتوظيف هذه الانقسام لصالحهم من كل طريق؛ وعملت إدارة ترامب والقوى الإقليمية المتصهينة في العقد الأخير على تعميق هذا الانقسام، خاصة بالهجوم المستمر على حركتي حماس والجهاد ودمغهما بالإرهاب، بل العمل على التفريق بينهما هما أيضًا. ومن ذلك ما بدا في السنوات الست الأخيرة ضمن “صفقة القرن”. فقد قطعت إدارة ترامب مساعداتها عامةً، وتمويلها لمستشفيات القدس، ولوكالة (الأونروا)؛ ما دفع منظمة الأمم المتحدة لتجميد عدد كبير من مشاريعها، وإنهاء توظيف مئات العمال والموظفين الفلسطينيين المحتاجين في قطاع غزة.
زِدْ على هذا تعقُّد أزمة الحكم والإدارة ورعاية الفلسطينيين ومعايشهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا بفعل الانقسام وتداعياته. فلقد واجهت المؤسسة الرسمية الفلسطينية في ظل هذه الأوضاع، “تحدِّي إقامة نظام سياسي يحتكم إلى القانون، ويرتكز على الأطر الدستورية والبناء المؤسسي، ويُعزِّز الحكم الرشيد، لتمثيل الشعب الفلسطيني وإدارة شؤونه في مناطق السلطة الفلسطينية، خاصة مع تدهور مجمل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بفعل الإجراءات التي اتخذتها الحكومتان في الضفة وغزة، والتي تزامنت مع سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المستمرة في المنطقتين”[5]؛ ومنها ما أشرنا إليها من الاستيطان الإحلالي في الضفة، وعمليات تهويد القدس وطرد سكانها (تذكَّر أزمة حي الشيخ جراح)، ومن ثم القضاء العملي التام على مبدأ “حل الدولتين”، مع تشديد الحصار على غزة وفرض العقوبات الجماعية، ما كرَّس خنقًا اجتماعيًّا واقتصاديًا شاملاً؛ على الشعب كله لنحو عقدين.
ب) لماذا تفشل جهود المصالحة؟
جزء من إجابة هذا السؤال وردت في طيات السرد المتقدم. لكن الكثير من الدراسات ذكرت عددًا كبيرًا من الأسباب؛ بعضها يتعلَّق بأحد طرفي الانقسام، والبعض الآخر يتعلَّق بسياسات العدو وبالقوى المحيطة وتفاعلاتها مع القضية ومع الانقسام نفسه، كما أشرنا أعلاه. لكن يمكن إيجاز أهم أسباب فشل جهود المصالحة الفلسطينية في: الموقف من أوسلو بين القناعة بالتسوية السلمية والقناعة بالمقاومة العسكرية، ثم الصراع على السلطة، والصراع الأيديولوجي، فصراع الارتباطات الإقليمية، وصراع المواقف الدولية. وقد أدَّت السياقات منذ 2007 إلى توسعة الشُّقَّةِ بين الجانبين، وتأجيج الصراع؛ ومن ثم إفشال محاولات المصالحة التي أُشير إليها.
ويمكن عزوُ فشل جهود المصالحة إلى عدد من العوامل الأساسية بحسْب ترتيب أهميتها من وجهة نظر الباحث، ومن خلال عدد من الدراسات التقييمية[6]:
- الافتقاد إلى مشروع التحرير الوطني الجامع؛ أي الذي يجمع بين المقاومة المسلحة والتسوية السلمية. فحماس ورفيقاتها من الفصائل تفتقد إلى أدوات وإمكانيات العمل السياسي (خاصة الإقليمي والدولي)، وتقصر عملها على المقاومة المسلحة، بينما تعتمد فتح على المفاوضات والعمل الدبلوماسي فقط، بعدما ودَّعت في أوسلو العمل العسكري، وأكدت ذلك في الانتفاضة الثانية عام 2000. ومن ثم فإن مقترحات المصالحة التي لا تفرض على الطرفين هذه الجامعية تبوء بالفشل من أول يوم. وتعمل هذه الجهود على بناء الثقة أولا وكأن التباين بين الطرفين ذاتي وحسْب، وهو في الحقيقة مرتبط بِلُبِّ القضية: استراتيجية تحرير فلسطين.
- الافتقاد إلى الثقة المتبادلة: فمفاوضات المصالحة ومقترحاتها لا تسبقها ممارسات من أي من الطرفين لبناء الثقة لدى الطرف الآخر، أو إبداء حسن النية. وتكتفي لقاءات الحوار والمصالحة على عبارات إنشائية، ومناشدات تقارب عامة، دون أية خطوات حقيقية لهذا التقارب، أو إعلان مبادئ تحقِّقه الأطراف فعلا. وبالعكس تشغل الدعاية السوداء المتبادلة المسافة بين كل مبادرتين للمصالحة. وقد تعاظم اتهام فتح لحماس بأنها حركة ذات ارتباطات غير وطنية وتنتمي إلى ما يسمى بالإسلام السياسي، بينما تعتبر ذاتها حركة وطنية محضة، خاصة في ظل تراجع المساندة القومية العربية لها. وتسمي السلطة 2007 انقلابًا على الشرعية. هذا بينما تلح حماس على عدم شرعية مؤسسات السلطة خاصة بعد انتهاء ولاية عباس وعدم تجديدها انتخابيًّا، وتذرُّع السلطة بالمعوقات التي تضعها دولة الاحتلال في عدم إجراء انتخابات جديدة.
- أثر الارتباطات الإقليمية والدولية: خاصة منذ اندلاع الثورات العربية 2011، ثم تراجعها بدءًا من 2013؛ حيث دخل الانقسام الفلسطيني على محكِّ استقطابات الثورات والثورات المضادَّة، والشعوب والأنظمة العربية، والإسلاميين والعلمانيين، والتصعيد ضد إسرائيل والتهدئة معها. وقد استفحل الأمر وبلغ ذروته حين تبنَّت السلطة الفلسطينية الدعاية العربية ضدَّ الحركات الإسلامية في مواجهة حماس والجهاد، واصفةً موقفَها بالشرعية والتمثيل الوطني المعترف به دوليًّا، بينما تربط قوى المقاومة المسلحة بين السلطة وصفقة القرن ومحور التصهين العربي المتصاعد، وتعتبر التنسيق الأمني خيانة علنية وانضمامًا إلى صف العدو. ومع هذا تلتحف السلطة بالأنظمة العربية التي لا تؤازرها بالدرجة التي تريدها، اللهم إلا في مواجهة التيار الفلسطيني المقابل.
- افتقاد الآلية الحاسمة للخلاف: وخاصة الآلية الديمقراطية التي صادرت عليها السلطة وحركة فتح منذ بدت في غير صالحها عام 2006، بينما تستغلها حركة حماس -فيما يبدو لدى بعض المراقبين- للهيمنة على المشروع الفلسطيني، وفرض رؤيتها لاستراتيجية التحرير والتغيير (الأسلمة). وقد واجهت الآلية الديمقراطية في الشأن الفلسطيني ما تواجه في الشأن العربي والإسلامي برمَّته؛ إذ إن نتائجها مشروطة داخليًّا وإقليميًّا ودوليًّا؛ بألا تأتي بطرف مقابل للسلطة الفلسطينية ولا مرفوض إقليميًّا (إسرائيليًّا) أو دوليًّا (أمريكيًّا). ودعا بعض المعنيِّين إلى اعتماد الآلية الديمقراطية من أجل الوصول إلى تجديد مشروع التحرر الوطني، بل تجديد منظمة التحرير ذاتها من الداخل. وقد أثبتت الاتفاقات العديدة التي وقع عليها الطرفان (فتح وحماس) من أجل المصالحة أن هذه الآلية التوافقية غير مجدية، وأن الانقسام أعمق منها.
- أثر الانفصال المكاني بين الضفة وغزة؛ مما يصعب التواصل والالتقاء المباشر، ويسهل مواصلة الانقسام وتعزيز كل طرف لوجوده ومكانته في مكانه. وقد حرص المحتل على الحفاظ على هذا الانفصال عبر تحكمه في المعابر وحصاره لكل من القطاع والضفة بأشكال مختلفة. واليوم لم يعد متخيلا أن تعود السلطة للهيمنة على غزة في وجود القوة الحمساوية، وبالطبع العكس صحيح؛ فلن تسمح فتح بزيادة قوة وحضور حماس في الضفة الغربية، وهي تواجه ذلك بكل حسم وشدة. ضم إلى ذلك الانفصال البشري بين مواطني الجزءين.
وإجمالًا، يمكن الإشارة إلى الروايتين المتقابلتين للانقسام عبر رأي ممثلين لطرفيه الرئيسيين. يقول عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح في مقابلة 22 فبراير 2018: “منذ انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة بقيادة حركة فتح عام 1965، ترافقت مع تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية بقرار قمة عربية عام 1964، لتصبح فيما بعد، بقرار قمة عربية في الرباط، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وأصبحت تضم كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني من مختلف التيارات السياسية، باستثناء حركة الإخوان المسلمين. فقد رفضت الانخراط في العمل الوطني الفلسطيني، رغم المحاولات المتواصلة التي بذلتها القيادة الفلسطينية، إلى أن تأسَّست حركة حماس كامتداد فلسطيني لحركة الإخوان المسلمين عام 1987، بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية بشهرين. وبدل أن تلتحق بالعمل الوطني الفلسطيني الموحد داخل الوطن المحتل امتدادًا لـ”م. ت. ف.” في إطار القيادة الوطنية الموحدة التي قادت الانتفاضة وضمت كل الفصائل والشخصيات المستقلة، اختارت حركة حماس أن تعمل منفردة وكأنها تؤكِّد من خلال أدبياتها وممارساتها أنها تطرح نفسها بديلا عن م. ت. ف. الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ولقيت رعاية مباشرة وغير مباشرة من أطراف عربية وإقليمية (… البحث)، ورافق ذلك الكثير من الاحتكاكات السلبية، بكل ما تركه ذلك من أثر في مواجهة الاحتلال، وإضعاف للانتفاضة. وعندما تم الاتفاق على إعلان أوسلو وقيام السلطة الوطنية، برزت حركة حماس لتعبر عن معارضتها للاتفاق، من خلال بياناتها، ومن خلال عمليات عسكرية ذات طبيعة إعلامية صاخبة، لعل أبرزها العملية التي قامت بها في اليوم المحدد لافتتاح الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، تنفيذًا لاتفاق أوسلو. ورفضت حماس المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي الأول بداية العام 1996؛ باعتبار ذلك وليد اتفاق أوسلو، وكذلك عدد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، رفضت أيضًا المشاركة بتلك الانتخابات للسبب نفسه، غير أن حركة حماس بدأت تنمو وتزداد قوة في قطاع غزة. وسرعان ما تراجعت وشاركت في انتخابات المجلس التشريعي الثانية عام 2006، وأظهر ذلك وكأن هناك نزاعًا على السلطة بين حركتي فتح وحماس، ولم تمض سنة على تلك الانتخابات، في ظلِّ حكومة فلسطينية انفردتْ حماسُ بتشكيلها، رغم أن النظام السياسي في فلسطين رئاسي وليس برلمانيًّا”[7].
ويقول عن اتفاق 2017: “حول فرص تنفيذ اتفاق القاهرة 2017 بكل صراحة ووضوح، فإن اتفاق 12 أكتوبر 2017 انحصر بمسألة تمكين حكومة الوفاق الوطني التي شكِّلت بالاتفاق مع حماس عام 2014 لإنهاء الانقسام، وفق اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة بتاريخ 4 مايو 2011، وإفساح المجال للحكومة ببسط سلطتها الكاملة في إدارة قطاع غزة، كما هو في الضفة الغربية، وفق القانون الأساسي والأنظمة المعمول بها في السلطة الفلسطينية. لكن، منذ اللحظة الأولى لوصول الحكومة إلى غزة، ظهر أن حماس تريد إدارة الانقسام وليس إنهاء الانقسام. وليس هناك توافق داخل حماس على إنهاء الانقسام، والقوى الإقليمية التي موَّلت وعملت على التخطيط للانقسام واستمراره ما زالت على مواقفها، وكذلك موقف القيادة الدولية لحركة الإخوان المسلمين، ولم تمكن حماس الوزراء من ممارسة صلاحياتهم وفق الاتفاق، ورفضت تسليم الحكومة قضية إيرادات الحكومة من ضرائب ورسوم وغيرها، بل وصل ذلك حد التهديد واستخراج السلاح لطرد موظفين من عملهم في وزارة الثقافة، كما أعادت حماس نصب حاجزين؛ أحدهما لتفتيش الشاحنات القادمة من معبر كرم أبو سالم وفرض جباية غير قانونية وخارج إطار وزارة المالية، وآخر للتفتيش على القادمين من معبر بيت حانون للغرض نفسه. كما أن معبر رفح للركاب يعمل عندما يفتح بالطريقة نفسها التي عمل بها منذ الانقسام دون أي سلطة فعلية لهيئة المعابر الشرعية، وهكذا أيضًا، في عمل الوزارات كافة، علمًا أن تمكين الحكومة يعني إدارة الوزارات من الوزراء دون تدخل أحد، وكذلك عمل المعابر بإشراف حكومة التوافق وإدارتها والجباية، فماذا بقي لعمل الحكومة؟ وقد طلبت حركة فتح من القيادة المصرية التي تتابع ملف المصالحة أن تمارس دور الوسيط والحكم، وتحديد المسؤوليات وإغلاق الأنفاق غير الشرعية، وخاصة التي أصبح لها طابع تجاري غير شرعي، كما أن حماس تمارس الخداع والتضليل في بياناتها وتصريحات بعض الناطقين باسمها، وإيهام الرأي العام أنها قامت بما عليها، وأنها لم تعد طرفًا في الانقسام، فأي منطق هذا؟ لقد وصل الأمر ببعض المسؤولين في حماس أن يعلنوا بصراحة أنهم يستعدُّون لما بعد الرئيس أبو مازن معتقدين أن إعلان ترامب حول القدس ووقف المساعدات وتقليص دعم الأونروا سيؤدي إلى تصفية السلطة وانهيار منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح والرئيس أبو مازن، وأنهم البديل الجاهز… فهل هذا التزام بالاتفاق لإنهاء الانقسام وبالتفاهمات اللاحقة منذ عام 2009 والذي وقعت فيه حركة فتح على اتفاق المصالحة بتاريخ 15 أكتوبر 2009، رغم التهديد الأميركي المباشر للرئيس أبو مازن،…”[8].
هذا بينما يصور د. موسى أبو مرزوق الموقف في مقابلة في التوقيت نفسه تقريبًا بما يلي: “إن أحد أهم معيقات تنفيذ المصالحة الفلسطينية هو غياب الإرادة لدى حركة فتح، ووجود مركزية تامة في قرارات الحركة، بحيث تلغي أي رأي آخر مخالف لرأي الرئيس عباس. كما أن أولوية الصراع عند فتح والسلطة الفلسطينية متبلورة في إنهاء حكم حماس وقوتها في غزة، والدفاع عن الشرعية الفلسطينية بصورتها الراهنة، وسياساتها، وعدم الرغبة في التجديد، والسعي للتغيير بما يقتضيه الصراع، والمستجدات الحالية، وهذا يؤدِّي بالضرورة إلى زيادة الفوضى في البيت الفلسطيني، بالرغم من أن حركة حماس قدَّمت كلَّ مستلزمات إنهاء الانقسام، ومنذ اليوم الأول وحتى اللحظة، وحماس تبادر لتذليل كل ما يعترض المصالحة، ومن أجل إنهاء الانقسام، وقدمت تنازلات تتجاوز سقف اتفاق القاهرة مايو 2011، ومع ذلك واجهت حركةُ فتح كلَّ ذلك بالتعنت؛ ولعل ذلك للأسباب التالية: 1- فتح ترى أن حماس جاءت مهزومة، ولا داعي لإنقاذها، وبالتالي ترهقها بالمطالب وتغرقها بالذرائع. 2- فتح متشكِّكة في نوايا حماس نحو المصالحة، ولذلك هي غير مستعجلة (واللي عند أهله يا مهله). 3- فتح ترى أن الورقة الحقيقية التي تريدها هي الأمن، وقرار وسياسة المقاومة، وحماس حتى اللحظة لم تعط هذه الورقة. 4- فتح فقدت قاعدتها الجماهيرية الحاضنة في غزة، وهناك ترهُّل وانقسام في جسمها التنظيمي وهي متشكِّكة في قدرتها على إدارة القطاع. 5- لا تريد فتح مشاركة حماس، حتى لا تدفع الثمن من جانب الأمريكيين والاحتلال. وهناك أسباب أخرى، أبرزها الضغط الأمريكي الصهيوني، والتزامات أوسلو، والتوجُّه العربي في الصراع، واستفراد سياسات عالمية نحو المنطقة، منها نبذ العنف، والحل السياسي، وقبول الأمر الواقع، وثقل المنظمات الدولية، وهيمنة الولايات المتحدة عليها”[9].
بالطبع عمل العدو الصهيوني على تعميق هذا الانقسام واستغلاله في الوقت نفسه. يقول د. صائب عريقات (توفي في نوفمبر 2020)، والذي كان كبير المفاوضين الفلسطينيين، في مقابلة 25 مارس 2018: “تعمدت سلطة الاحتلال إلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني في جميع جلسات التفاوض قبل الانقسام وبعده، وبخصوص ما بعد الانقسام، فقد تحولت الذريعة التي كان يستخدمها الإسرائيليون -عندما تولَّت حركة حماس الحكم بعد انتخابات 2006- وهي أنه علينا الاختيار بين السلام أو الشراكة مع حركة حماس، إلى نقطة جديدة؛ وهي أننا منقسمون؛ وذلك يشكِّل عقبة رئيسية في عدم إمكانيَّتنا الحكم أو اتخاذ القرارات في ظلِّ الوضع الراهن من الانقسام”[10].
أدَّت هذه العوامل مجتمعة -وغيرها- إلى إجهاض كل اتفاق مصالحة ربما قبل أن يجف حبره الذي كتب ووُقِّع به. ومن ثم بدت المصالحة الفلسطينية أشبه بالمستحيلة لدى كثير من المراقبين، وتنتظر معجزة من السماء، حتى تخرج من المساحة الرمادية التي تهيمن عليها منذ عقد ونصف[11]. فهل كانت هذه المعجزة هي الطوفان الذي كسر هيبة العدو، وتداعياته التي دمَّرت معظم قطاع غزة وأعملت فيه إبادة جماعية بشعة غير مسبوقة؟
ثانيًا- أثر الطوفان على الانقسام وفشل المصالحات
تباينت مواقف فتح والفصائل الموالية لها من عملية طوفان الأقصى إبان انطلاقها؛ وإن غلب عليها تبريرها بواقع الاحتلال واستفحال اعتداءاته وغلقه لمسار التفاوض والحل السلمي. بل أشار بعض متحدِّثي فتح إلى انضمام بعض مجموعات ومقاتلي فتح -ممن أتيح لها أن تكون مسلحة في غزة- في العملية، وذلك ما بعد مرحلة الاقتحام الأولى للغلاف[12].
ومبكِّرًا فتح ملف المصالحة على ضفاف الهجوم البربري من الصهاينة على غزة إثر الطوفان. يقول عبد الفتاح الدولة أحد متحدِّثي فتح في الأسبوع الأول للمعركة: “الاحتلال وضع الشعب الفلسطيني أمام ثلاثة خيارات: إما الخضوع، أو الرحيل، أو الموت، وذهب لارتكاب عديد من المجازر بحق شعبنا في الضفة الفلسطينية. ولذلك؛ تنبَّهت القيادة الفلسطينية لأهمية وحدة الصف والموقف والقرار الفلسطيني في مواجهة هذه التحديات والجرائم التي من شأنها تفجير الأوضاع وأخذ الساحة لمواجهة حتمية. وكان لا بد من التقاء الفصائل على طاولة الوحدة… إنه برغم أن آخر لقاء للأمناء العامين للفصائل في العلمين لم يسفر عن كل النتائج المرجوة، إلا أن الأمور كانت إيجابية وأقل حدَّة ما بين فتح وحماس؛ ما يُعَدُّ تمهيدًا للبناء على خطوات عملية أكثر جدِّية تقود إلى ذلك. وربما تحمل الأيام القادمة تطورات على صعيد الوحدة الوطنية؛ لأن المصلحة اليوم تقتضي أن تتحرَّك فتح مع الكلِّ الفصائلي والوطني لمواجهة الخطر الذي يواجهنا جميعًا. المطلوب اليوم -في ظل هذه الأيام الدامية التي تواجه شعبَنا- وحدة وطنية حقيقية تواجه هذا العدوان وتحمي شعبنا ومستقبل قضيتنا”[13].
لقد دفعت وحشية المجازر الصهيونية في غزة متحدِّثي السلطة -بمن فيهم أبو مازن- إلى تصعيد الموقف، حتى تم إلغاء لقاء مع الرئيس الأمريكي عقب مجزرة المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) 17 أكتوبر 2023، في الأسبوع الثاني للعدوان. ومع هذا، واصل النهج الفتحاوي الدفاع عن اسراتيجيته الدبلوماسية في التعامل مع الاحتلال واعتماده على الضغوط السلمية للحفاظ على مكتسبات أوسلو، مع التأكيد المستمر على أن “السلطة” هي الممثل الوحيد الشرعي للشعب الفلسطيني. وحرص متحدثو فتح ومنظمة التحرير في البداية على عدم لوم حماس والفصائل في غزة على عملية الطوفان. وبعد فترة من التحفُّظ، سرعان ما عادت المناوشات الإعلامية التي قادها إعلام تحريشي تحريضي؛ إما صهيوني أو متصهين، وجرى تأويل وتداول مقولات لمثل الوزير حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية (للتنسيق مع الاحتلال) بمحاسبة الجميع بأنها دعوة لمحاسبة لحماس ولوم أو إدانة للمقاومة[14]؛ حين قال: “إن سقوط هذا العدد من القتلى في غزة يستحقُّ تقييمًا جادًّا وصادقًا ومسؤولًا لنحمي شعبنا، ونحمي قضيتنا، فلا أحد يجب أن يعتقد أنه فوق المحاسبة والمساءلة والنقد”[15].
لكن الشيخ افتتح منذ ديسمبر فكرة أن السلطة على استعداد لتولي إدارة غزة ضمن ترتيبات ما سُمِّيَ باليوم التالي للحرب، واضطربت تصريحاته -مثل آخرين- ما بين الدفاع عن أوسلو (نجحت جزئيًّا) والإعلان عن نهايتها (ماتت ودفنت تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية، وما يحدث في غزة عدوان إسرائيلي شامل)، وما بين رفض آثار الطوفان فيما يشبه النعي على من أطلقوه والاعتذار بأن السلطة لا قوة لها لتقاوم أو تشارك في المقاومة (السلطة لا تملك مليون جندي لمواجهة الحكومة الإسرائيلية). ومن ثم كشفت العديد من تصريحات ممثلي فتح والمنظمة أن فكرة المقاومة المسلحة لم تَعُدْ في حساباتهم، وأن “تعييش” الشعب والتخفيف من معاناته الاجتماعية والاقتصادية، ومواصلة الوجود في الأرض، مع الضغط الدبلوماسي، هو السبيل الوحيد المتاح أمامهم[16].
ومع انشغال قوى المقاومة بمعركتها في غزة، ونسبيًّا الضفة الغربية وحواف فلسطين، ظلَّت فتح أو السلطة الفلسطينية تراوح مكانها هذا الذي وصفناه، ما يمكن ملاحظته في عدة مشاهد أساسية عبر الشهرين الأخيرين.
أ) فقد احتفلت فتح وفصائل المنظمة في أول العام الجديد 2024 بالذكرى التاسعة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية؛ لتؤكد حضورها ونهجها وتكرر خطابها. وحتى اليوم الأخير من الشهر نفسه، لم تتقدَّم فتح خطوة في ترديد خطابها ذاته بحذافيره؛ ففي مساء الأربعاء 31 يناير 2024 عقدت فتح اجتماعًا برئاسة محمود عباس، رئيس الحركة، ضم أعضاء اللجنة المركزية، وعددًا من أعضاء المجلس الثوري، وأمانة سر المجلس الاستشاري، وأمناء سر أقاليم الحركة في المحافظات الشمالية؛ ليلقي فيها عباس كلمة مطولة جمعت مجمل خطاب فتح وكررته. ودار الخطاب حول “الموقف السياسي الفلسطيني الواضح المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، والإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنع تهجير أي فلسطيني من أرضه مهما كانت التضحيات… نبذل جهودًا متواصلة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء، لوقف هذا العدوان، وتقديم أشكال المساعدة كافة التي يحتاجها شعبنا في قطاع غزة، ليعودوا إلى أماكن سكناهم التي دمَّرها الاحتلال، وأن احتجاز أموال المقاصة لن يُثنينا عن أداء المهام الملقاة على عاتقنا، خاصة تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة”. وبالنسبة للمصالحة أشار عباس إلى أهمية توحيد البيت الفلسطيني تحت مظلَّة منظمة التحرير الفلسطينية حامية المشروع الوطني ومكتسباته، على قاعدة إنهاء إفرازات الانقسام الذي جرى في عام 2007، والالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًّا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، والحل السياسي القائم على الشرعية الدولية، وذلك من أجل تعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية، ومواجهة المخاطر المحدقة بقضيَّتنا الوطنية”[17].
وقال عباس: “قلنا للعالم، إنه بعد وقف حرب الإبادة والتهجير التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، يجب أن يكون هناك مسار سياسي واضح قائم على أسس الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية والقانون الدولي، يشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يبدأ بالاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد مؤتمر دولي للسلام، ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، ويجسِّد استقلالها على كامل ترابها الوطني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”[18].
ب) المشهد الثاني تمثل في التغيير الحكومي الذي قام به رئيس السلطة محمود عباس؛ حيث قدم محمد اشتية استقالة حكومته إلى الرئيس الفلسطيني في 26 فبراير 2024، وهو يقول: “سنبقى في مواجهة مع إسرائيل حتى إقامة الدولة الفلسطينية.. إن المرحلة القادمة تحتاج لترتيبات حكومية وسياسية جديدة.. وتحتاج لإدارة السلطة لكافة الأراضي الفلسطينية”، وربطت مصادر بين هذه الخطوة والإعداد لليوم التالي للحرب، بحكومة تكنوقراطية لا سياسية[19]. وفي الخميس 14 مارس كلَّف عباس مستشاره الاقتصادي -رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار- الدكتور محمد مصطفى، بتشكيل حكومة “تكنوقراط” استعدادًا للقيام بمهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وإجراء إصلاحات في النظم الحكومية. وذُكِرَ أن نحو سبعة أو ثمانية وزراء في الحكومة الجديدة سيكونون من قطاع غزة، وأن مصطفى أَعَدَّ خطةً لإعادة إعمار القطاع تقوم على تأسيس هيئة مستقلَّة تُشرف عليها لجنة استشارية دولية، وتخضع حساباتها لمراقبة البنك الدولي، وأن ثلثي أعضاء هيئة إعادة الإعمار سيكونون من أبناء قطاع غزة، وأن اللجنة الاستشارية الدولية ستضم خبراء وشخصيات دولية معروفة[20].
ومن ثم جاء رد حركة حماس والفصائل المقرَّبة منها رافضًا لهذه الخطوة ومقلِّلًا من أهميتها. فأعلن بيان لفصائل فلسطينية ضَمَّتْ حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية- أن “اتخاذ قرارات فردية، كتشكيل حكومة جديدة من دون توافق وطني، يُعَدُّ تعزيزًا لسياسة التفرُّد وتعميقًا للانقسام في لحظة تاريخية يحتاج فيها الشعب الفلسطيني إلى الوحدة”، وفيه دلالة على “أزمة قيادة السلطة والفجوة بينها وبين الشعب الفلسطيني وتطلُّعاته”. وقال البيان إن الأولوية الوطنية هي حاليًّا “لمواجهة العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة والتجويع”، التي يشنُّها الاحتلال ضدَّ قطاع غزة، وأن “من حق الشعب الفلسطيني أن يتساءل عن جدوى استبدال حكومة بأخرى، ورئيس وزراء بآخر، من البيئة السياسية والحزبية ذاتها”[21].
ج) في طيات هذا المشهد مَرَّتْ لحظةٌ مهمَّةٌ بالنسبة إلى ملف المصالحة أو الالتئام في ظلِّ الطوفان والعدوان، لكن فيما يبدو أنها لحظة مَرَّتْ مرورَ الكرام. فقد أعلنت روسيا في 16 فبراير الماضي 2024 دعوتها قادة الفصائل الفلسطينية إلى محادثات في موسكو، وعقدت بالفعل يوم 29 من الشهر نفسه. وقبل اللقاء كانت الاشتراطات المتبادلة ولعبة نقل الكرة بين الطرفين واضحة. فقد صرَّح الناطق باسم حركة فتح حسين حمايل بخصوص التوقعات أن “الموضوع متروك عند حركة حماس، نحن كفتح جاهزون، وعندنا استعداد للمرونة إلى أبعد الحدود بشرطين: استقلالية القرار الفلسطيني، والثوابت الوطنية”، وأن من ضمن الثوابت التي “لا يمكن قبول المساس بها”: منظمة التحرير، والتزام من ينضوي تحتها بالشرعية الدولية، وذلك “من أجل القدرة على العمل لاحقًا، نظرًا للهمِّ الكبير الذي ينتظرنا ويتطلَّب حكومةً قادرةً على العمل، خاصة إعادة إعمار غزة وغيرها”، وأن “المطلوب من حماس أن توافق على المضي قُدُمًا في المصالحة دون أي مناورة، والالتزام باتفاقيات منظمة التحرير وميثاقها، نحن لسنا بصدد قضية حزبية بقدر ما هي مصالح وطنية عُليا للشعب الفلسطيني”[22].
في المقابل صرَّح النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي المحلول أيمن ضراغمة أن “نجاح الحوار يتطلَّب التراجع عن الشروط التي وضعها الرئيس أبو مازن، ومنها الاعتراف بالشرعية الدولية لدخول منظمة التحرير”، وأن “الأصل أن يتم التراجع عنها (الشروط)، وأن يتم الذهاب إلى موسكو بنوايا طيبة، لتشكيل موقف ضاغط على المجتمع الدولي والعربي لوقف العدوان على غزة”؛ فإن وجود شروط على حركتي حماس والجهاد الإسلامي “لن يساعد” في تحرك عجلة المصالحة، مضيفًا: “الحركتان مطالبتان بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير، ولا أحد يعرف برنامج المنظمة، حتى المقاومة الشعبية التي تتبنَّاها غير موجودة”، إنه “لا رؤية لدى حركة فتح إلا التمسُّك ببرنامج المنظمة، هذه الأشياء يجب أن تكون لاغية، ولا حاجة للشروط”، وأن “الفصائل التي لها الوزن الأكبر -ويمكن معرفة ذلك بنتائج استطلاع للرأي أجري مؤخَّرًا- يجب أن تكون لها حصة في الرأي حول البرنامج، أو نتوجَّه إلى الشارع الفلسطيني لإجراء الانتخابات، إذا كانت هناك جدية في الحوار فالأصل أن تكون قيادة موحَّدة تتكوَّن من الأمناء العاملين للفصائل يرأسها الرئيس باعتباره رئيس اللجنة التنفيذية ويقودون برنامج العمل السياسي وتشكل حكومة متوافق عليها، هذا المقبول حاليًّا”[23].
ومن ثم صدر البيان الختامي للقاء موسكو أول مارس 2024 من عشرة بنود لا جديد فيها، اللهم بعض الشيء في الإشارة إلى عبارة “المقاومة الباسلة” طي البند السادس: “دعم وإسناد الصمود البطولي لشعبنا المناضل ومقاومته في فلسطين وحرصها على إسناد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية وخصوصًا في القدس، ومقاومته الباسلة، لتجاوز الجراح والدمار الذي سببه العدوان الإجرامي، وإعمار ما دَمَّرَهُ الاحتلال، ودعم عائلات الشهداء والجرحى وكل من فقد بيته وممتلكاته ومصادر رزقه”[24].
يذكِّرنا ذلك اللقاء في موسكو بلقاء موسكو أيضًا سنة 2019 حيث التقى ممثلو 12 فصيلًا فلسطينيًّا في موسكو لبحث الأوضاع الداخلية، بما فيها ملف المصالحة، والتحديات أمام القضية الفلسطينية، بدعوة من “مركز الدراسات الشرقية”، التابع لوزارة الخارجية الروسية، واختتمت هذه الفصائل اجتماعاتها في موسكو بالتأكيد على ضرورة مواجهة خطة التسوية الأمريكية، المعروفة باسم “صفقة القرن” الأمريكية، وإنهاء الانقسام الفلسطيني، ورفض إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، أو بدون مدينة القدس… إلخ، ثم ذهبت الآمال مع الريح الروسية الباردة.
د) ثمة لقطة أخرى معبرة عن الخطاب العاطفي الجميل لكن المغاير للواقع، ترجع إلى مطلع مارس الماضي 2024 حين صرَّح اللواء جبريل الرجوب أمين سر حركة فتح بتصريحات في غاية الإيجابية. فأكَّد أن تقييم حركة فتح منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلى، هو أن ما حصل فى السابع من أكتوبر كان “صرخة بكل المعانى لتذكير العالم، بمأساة الشعب الفلسطينى، وأيضا لتعرية الاحتلال”. وصرح بأن عملية طوفان الأقصى كانت جزءًا من “حرب دفاعية”، يتحمل مسؤوليتها بالأساس الاحتلال، وأن حركة فتح -ومن أسماهم بـ”العقلاء فى الإسلام السياسى”- لم يستهدفوا مدنيين قتلًا أو خطفًا فى تلك العملية، وأن هذا هو ما عبَّر عنه بعض قيادات حماس، وأن محاكمة الحدث بجزئية، وتجاهل ما يحدث منذ عام 1948 إلى الآن، وتجاهل قتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين هو ظلم للقضية[25].
وبروح تصالحية ظاهرة يقول الرجوب، وفيما يشبه الرد على جدل حسين الشيخ: “أى حديث بشأن محاسبة حماس على ما حدث فى السابع من أكتوبر لا يمثل الموقف الرسمى للحركة، وإنما يمثل قائله فقط”، موضحًا: “نحن فى فتح نؤمن بالمطلق بأن حماس كانت جزءًا من النسيج النضالى الاجتماعي للشعب الفلسطينى وما زالوا وسيبقون، وأن فتح لن تعمل على نتائج أو إفرازات العدوان على الشعب الفلسطينى سواء كان في غزة أو أي مكان آخر”، متابعًا: “حركة فتح هى حركة تحرر وطنى ولسنا حركة انتهازية”. ومن ثم يدعو الرجوب حركة حماس للمبادرة بخطوة نحو رأب الصدع الفلسطينى، قائلا: “نحن نتطلع من إخواننا فى حماس أن يبادروا ذاتيًّا ويقدموا مقاربة سياسية ونضالية وتنظيمية تؤسس لأرضية مشتركة”، مؤكدًا “أنه لا يمكن فى الماضي أو الحاضر أو المستقبل أن نتبنَّى الموقف الإسرائيلى أو الموقف المعادِي لقضيَّتنا بما فى ذلك موقف الإدارة الأمريكية، وموقف بعض الأطراف الغربية، التى تتصرَّف وكأن الصراع بدأ يوم السابع من أكتوبر فقط، وتناسوا المجازر التى ارتُكبت فى 1948 وتحوُّل تلك المجازر إلى سياسة ممنهجة بحق الفلسطينيين”[26].
لكن يعود الكلام المكرور المغلَّف بروح تصالحية ليشرح هذه المقاربات الثلاث: “المقاربة السياسية المقصودة هنا لها علاقة بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وقرارات الأمم المتحدة سواء فى موضوع دولة بسيادة أو موضوع حل مشكلة اللاجئين”، و”أما المقاربة النضالية.. فنحن في فتح نعتقد أن المرحلة القادمة وللحفاظ على الزخم والإجماع الدولي، فلا بد من التمسُّك بالمقاومة الشعبية الشاملة، لتكون خيارًا استراتيجيًّا للشعب الفلسطينى، كي نعزِّز الحاضنة الوطنية أولًا، والحاضنة الإقليمية ثانيًا، والحاضنة أو الفضاء الدولي ثالثًا”، بينما “المقاربة التنظيمية هى إقرارنا جميعًا -بما في ذلك إخواننا في حماس- بالتزامات منظمة التحرير؛ سواء الوطنية والإقليمية والدولية، ونحن في فتح نرى أن ذلك يجب أن يأتي من إخواننا في حماس، ويكون عن قناعة”[27].
ه) المشهد الأخير -في نطاق هذه الوقة- الدال على ابتعادنا عن طريق المصالحة، واستمرارنا في طريق المناطحة، رغم كل الأهوال التي تداعت إثر الطوفان، وأزهقت منا أكثر من ثلاثين ألف نفس، وأصابت ما يقارب الثمانين ألفا، وهدمت البيوت والمرافق وساوتها بالأرض، يتمثل في قصة ما عرف بعملية اللواء ماجد فرج رئيس جهاز الاستخبارات العامة التابع للسلطة الفلسطينية؛ سواء صحت أو لم تصح. فقد أعلنت وزارة الداخلية بغزة (التابعة لحركة حماس) عن تسلل ضباط وجنود يتبعون لجهاز المخابرات العامة في رام الله في مهمة رسمية بأوامر مباشرة من اللواء ماجد فرج، فيما وصفتها بعملية استخباراتية جرت ليلة السبت 30 مارس 2024. وبعدها، أعلنت الأجهزة الأمنية في غزة أنها تعاملت مع العناصر التي تسللت إلى القطاع، واعتقلت عشرة منهم، وأفشلت المخطط الذي جاؤوا من أجله. وقالت إن هدف هؤلاء كان إحداث حالة من البلبلة والفوضى في صفوف الجبهة الداخلية، وإنهم تسللوا بتأمين من جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي بعد اتفاق تم بين الطرفين في اجتماع لهما بإحدى العواصم العربية الأسبوع الماضي. وقد أثار هذا الإعلان لغطًا كبيرًا؛ حيث نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الإثنين الأول من أبريل عن مصدر رسمي فلسطيني قوله: “إن بيان ما تسمى داخلية حماس بشأن دخول المساعدات إلى غزة أمس لا أساس له من الصحة”، وأضاف: “إننا سنستمر في تقديم كل ما يلزم لإغاثة شعبنا، ولن ننجرَّ خلف حملات إعلامية مسعورة تغطي على معاناة شعبنا في قطاع غزة وما يتعرَّض له من قتل وتهجير وتجويع”[28].
زاد الطين بلة أن تعلن مصادر أن القوة الأمنية التي اعتقلتها حركة حماس بعد مرافقتها شاحنات مساعدات من الهلال الأحمر المصري، تشكَّلت بعد اجتماع أمني إسرائيلي مع رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج، مطلع مارس الماضي في إحدى العواصم العربية، وبحضور رئيس مخابراتها. وصرَّح المصدر نفسه أنه تمَّ تكليف اللواء ماجد فرج بإدارة فرق لمرافقة شاحنات المساعدات إلى غزة، وذلك في إطار التمهيد لإيجاد بديل عن حركة حماس بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، وبغطاء من بعض الدول العربية، وأن فرج قدَّم قائمة بمئات الأشخاص المقيمين في غزة للقيام بهذا الدور، على أن تتولَّى الدولة العربية المعنيَّة تنسيق دور الفرق المشكَّلة لمرافقة المساعدات وتوزيعها. ومما يزيد الأمر اشتعالا ويصبُّ الزيت على النار المشتعلة، استغلال إعلام العدو للأمر؛ فقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) -في مارس الماضي- أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اقترح تولي رئيس مخابرات السلطة الفلسطينية ماجد فرج إدارة قطاع غزة مؤقتًا بعد انتهاء الحرب. وقالت الهيئة إن إسرائيل تدرس أن تساعد فرج شخصيات مختلفة في تولِّي حكم القطاع، على ألا يكون من هذه الشخصيات أي عضو في حركة حماس[29].
هكذا، تدلُّ التطورات على أن الطوفان ما زاد الانقسام إلا تأكيدًا، وأن الانقسام ما قدَّم للبلاء الفلسطيني إلا مزيدًا. ويظل تفسير هذه الحالة سجالًا بين المنظورات المختلفة، التي تذكُر أكثرُها أسبابًا ظاهرة ومباشرة، وبعضها يسترجع الذاكرة التاريخية لذلك وفق قراءة سياسية محضة. لذا، في ختام هذه الأسطر نحاول أن نُطِلَّ على هذه المعضلة من منظور حضاري يضمُّ هذه الجزئيات إلى كلية مشروع التحرُّر الفلسطيني.
خـاتـمة: عودة إلى فكر التحرير وجامعيته
إن حركة التحرير هي رد فعل على تحدِّي الاحتلال، وهي واقعة طالما هو واقع؛ وفقًا للسُّنن الإلهية القدرية والشرعية: (وجزاء سيئة سيئة مثلها)-الآية. وتأخذ حركة التحرير الشكل والجوهر المقابل للاحتلال؛ إذ هي قائمة على نقض جوهره ومحو صورته. بَيْدَ أنه في الحالة الفلسطينية ثمة فارق جوهري؛ يتعلَّق بالأساس الحضاري لكلٍّ من طرفي الصراع؛ ما بين الأساس الغربي المادي الوضعي للمحتل، والأساس الإسلامي السلامي الإنساني لحركة التحرير. وقد كشفت جولات الالتقاء والصراع عن هذه الرؤية، وأكدتها مجريات طوفان الأقصى الهادر إلى يومنا هذا. وقد أكدت الدراسات المعرفيَّة والمعنيَّة بالتصورات الكليَّة للصراع العربي-الصهيوني، ثم الفلسطيني-الصهيوني، هذا التصوير.
هذا الاحتلال -كما تبيَّن عبر قرن ويزيد- وُجودي، مركَّب، ثقيل، متطوِّر. فاليهود القادمون من أوروبا بهوية دينية وقومية، ومعرفة حضارية مادية صراعية، قَدِمُوا مندفعين وراء نبوءات معاصرة متَّصلة بأساطير قديمة؛ تتعلَّق بوعدٍ إلهيٍّ يخصُّهم من دون البشر؛ مفادُه أن أرض فلسطين هي أرضٌ وعدَهم الله تعالى بها، وأنها أرض ميعادهم مع مخلِّصهم عندما يكتمل اجتماعُهم فيها. لكن هذه الأرض -في الحقيقة التاريخية المشهودة- هي أرض القدس المقدَّسة عند المسلمين (والمسيحيين)، وفيها المسجد الأقصى ثالث المساجد العظمى عند المسلمين. لذا، فالمعركة ضد الصهيونية في فلسطين معركة وجود حضاري لا معركة حدود سياسية وحسْب.
كذلك اتَّسمت حركةُ التحرير بالتركُّب في هُويتها وتكْوينها وجمعها بين السلمية وحمل السلاح، أو بين السياسي والاجتماعي والإنساني وبين العسكري؛ أثرًا عن لعب الاحتلال الصهيوني بالسياسة والسلاح. وكذلك استمرَّت حركة التحرير باستمرار الاحتلال، ولم تنقطع مهما ضعفت أو حُوصرت، بل تطوَّرت بتطوُّرات الاحتلال: سلبية كانت أو إيجابية؛ تطوَّرت في أهدافها وخططها ووسائلها وأوضاعها. وعلى قدرِ قسْوة الاحتلال وثقل وطْأته بما معه من تحالف غربي ثقيل، فقد قدَّمت حركة التحرير العربية والفلسطينية آيات من البسالة والصمود والتضحيات غير المتكرِّرة كثيرًا في التاريخ الحديث، ولا تزال.
مع هذا، تأتي المفارقة الحقيقية في المقارنة بين الطرفين في قضية التوحُّد والتفرُّق. الصهاينة في أصولهم متفرقون، وفي مذاهبهم الدينية، وهوياتهم القومية التي قدموا منها، وفي طبقيَّتهم الداخلية، وكذلك في طبيعة علاقاتهم مع حلفائهم، ثمة تباينات ضخمة (تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتَّى)-الآية. ومع هذا نجح الصهاينة في بناء معادلات تشابك وتماسك، وإدارة اختلافاتهم، نجاحًا كبيرًا، وخاصة في صراعهم من أجل الوجود والتوسُّع في فلسطين ومحيطها. أمَّا العرب والمسلمون المتَّحدون أصلًا في هُويتهم الدينية، المتشابهون المتشابكون في مساراتهم التاريخية وقيمهم ومفاهيمهم، فهم يثبتون كل يوم فشلًا ذريعًا في إدارة اختلافاتهم، ويُحيلونها خلافات وصراعات وتفرقة واسعة. وقد بلغ ذلك أشُده في الانقسام والصراع الفلسطيني-الفلسطيني، خاصة منذ العام 2007.
ومن ناحية أخرى، فإن تعامل المسلمين مع قضية فلسطين فيه مفارقات في الوعي والسعي. فقد تدرجت القضية الفلسطينية على مساري العدوان والمقاومة، وتموجت بأمواج السياقين الفكري والواقعي؛ العربي الإسلامي، والغربي الصهيوني المسيهودي. ففي البداية وحتى أحداث البراق 1929 كان الوعي العربي والإسلامي والسعي للحفاظ على فلسطين عند أدنى حدودهما، مقارنة بنظيريهما -الوعي والسعي- لدى الغرب المسيحي واليهودي المتصهين، يشير إلى ذلك مراتٍ الأميرُ شكيب أرسلان في كتابه الأشهر (لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟)، يقول:
“عندنا مثال حديث العهد هو مسألة فلسطين: حدثت وقائع دموية بين العرب واليهود في فلسطين [وأشار إلى أنها أحداث 1929]، فأصيب به أناس من الفريقين، فأخذ اليهود في جميع أقطار الدنيا يساعدون المصابين من يهود فلسطين، وأراد العالم الإسلامي أن يساعد عرب فلسطين كما هو طبيعي، فبلغت تبرُّعات اليهود لأبناء ملَّتهم من فلسطين مليون جنيه، وبلغت تبرُّعات المسلمين كلها 13 ألف جنيه أي نحو جزء من مئة“، واليهود ساعتها 20 مليونا والمسلمون نحو من 400 مليون،.. وراح أرسلان يقارن الأعداد ونسب البذل ليُبَيِّنَ إلى أيِّ حضيض نزلنا. ولكنه سرعان ما يُضيف هامشًا بأن المسلمين والعرب سرعان ما أفاقوا بثورة صلبة قاومت الإنجليز واليهود والخائنين من العرب أنفسهم، وكانت لها نتائجها الملموسة (يقصد ثورة 1936)[30].
ومن ثم فإن المحكَّ الأساسي لقوى التحرير والمقاومة لا يتعلَّق بتكْويناتها الفصائليَّة المفردة، ولا بصورتها المنفرطة، إنما بالمشروع الوطني الجامع، وموقع كل منها فيه. وقد أدَّى الانقسام الفلسطيني بين جناحي منظمة التحرير بقيادة حركة فتح (ومعها ست فصائل أخرى: حزب فدا – حزب الشعب الفلسطيني – جبهة التحرير الفلسطينية – جبهة التحرير العربية – منظمة الصاعقة – جبهة النضال الشعبي الفلسطيني)، والغرفة المشتركة بقيادة حركة حماس (ومعها خمس فصائل أخرى: حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – لجان المقاومة الشعبية – حركة الأحرار الفلسطينية – كتائب المجاهدين – الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “القيادة العامة”)، فضلا عن كل من الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بوصفهما فصيلين مشتركين بين الجانبين، أدى ذلك إلى تشرذم قوة التحرير بين نهجين: فتحاوي وحمساوي، وبينهما تاهت الكلمة الجامعة الأخيرة: فلسطين.
في سياق الطوفان، اتضح النهج الفتحاوي أكثر في التعامل مع الاعتداءات الصهيونية المتصاعدة في الضفة ومدنها، وحول رام الله حيث رئيس السلطة محمود عباس، وفي سائر المدن الكبيرة والقرى الصغيرة؛ حيث لا يظهر أي نوع من الاعتراض العملي أو الممانعة لهذه الاعتداءات بقدر ما تبرز قوة الشرطة الفلسطينية في الضفة في مواجهة التظاهرات أو التجمعات بنوع من القمع والشدة، واعتقال بعض المنظمين لها. إن الضعف صار مبرَّرا ومبرِّرا لدى المنظمة لمواقفها شبه الثابتة، وأضحت تكرر ذاتها، ولا تقوم إلا بمواقف خطابية، بينما تنعى على المقاومة ما تجره أفعالها من ويلات على الشعب في غزة والضفة، ليظل السؤال المطروح أمامها: ثم ماذا بعد؟ وماذا ستفعل السلطة حال تولت -افتراضًا وبأي شكل من الأشكال- إدارة غزة؟ ماذا ستفعل بالمقاومة ورجالها وسلاحها؟ هل ستدافع عنهم وتضحي بالتنسيق الأمني خاصة أنها تأتي غزة على طريق يرسمه الاحتلال وحلفاؤه الدوليون والإقليميون؟ أم ستحارب المقاومة وتعمل على تحييد رجالها ونزع سلاحها؟ هذا هو السؤال بالنسبة لهذا الطرف الأول.
في المقابل، وفي سياق الطوفان ومن قبله، فإن حماس وفصائل المقاومة لم تكمل طريق وثيقة مايو 2017؛ بالدفع نحو مفاوضات محمية بقوة السلاح. لقد تكلست داخل ثوبها الأيديولوجي، دون ممارسة للعبة السياسية عبر روافد براجماتية تساعدها في حلحلة وضعيتها المأزومة خاصة بعد فشل موجة الربيع العربي، وعبر عقد كامل من العداء الإقليمي (العربي) لها. ومن ثم هل تريد للقضية أن تتحمل أعباء اختيارها الأيديولوجي صُعُدا؟ وهل تريد من فتح وفصائل المنظمة أن تدخل تحت هذه العباءة هكذا بمجرد تمسكها هي بها؟ وهل ترى أفقًا لوثيقة مايو 2017 بالأداء ذاته الذي سبقها؟ أو بعبارة أخرى: هل يكفي إصدار الوثيقة دون تغيير في النَّهج السياسي، مع الإصرار على النهج العسكري؟ إنها المعادلة المفقودة لدى هذا الطرف أيضًا.
وكذلك موقف السلطة وحركة فتح ومنظمة التحرير من تطورات الموقف الإسرائيلي باتجاه رفض حل الدولتين، وتصاعد اليمين الديني، وظهور التأييد الرسمي الغربي الفاضح للكيان مهما توحَّش أو تجاوز، واستعدادها لمؤازرته في عدوانه باسم الدفاع عن نفسه…. كيف ستواجه قوى التحرير الفلسطيني هذه الحالة المركبة؟ إن أوسلو وحدها لم تعد تكفي من زمن بعيد، وإصرار فتح عليها بعناوين متلوِّنة لعب بالقضية. وكذلك النموذج الحمساوي -على ما فيه من بسالة وبأس نسبي مقدَّر- لا تكْفي لمجابهة الحالة التي آلَتْ إليها القضية.
إن الرؤية الفلسطينية العامة تحتاج إلى حسْم بعض النقاط الأساسية قبل أن تؤسِّس لمصالحة، فضلًا عن وحدة وطنية حقيقية. ونُشير في هذا المقام الضيِّق إلى فكرتي توازن بين: التمييز من غير تفريق، والجمع من غير سحق للتعدُّدية والاختلافات البنَّاءَة.
- فمثلا: كيف نميز بين عناصر الثلاثيتين اللتين تحكمان واقع طرفي الانقسام الفلسطيني الآن: (فتح ومنظمة التحرير والشعب)، كما نربط بينها، و(حماس والمقاومة والشعب) كما نربط بينها أيضًا؟ هذه المعضلة ناقش بعض جذورها مالك بن نبي في مشكلات حضارتنا، في العلاقة بين الأفكار المجردة والأشخاص أو الكيانات المشخصة. فمن آفاتنا الحضارية المعاصرة الخلط بين الفكرة والصورة التي تظهر بها، وبين الفكرة والحاملين لها. إن التحرير ليس رهينًا بقواه القائمة به، إنما بفكرته، بل هذه القوة المشخصة هي التي يجب أن تكون رهينة فكرة الغاية أو بالأحرى مستهدية بها. لا يصح أن يُعرَّف تحرير فلسطين بميثاق المنظمة ولا رؤية حماس، بل العكس هو الصحيح: أن تُعَرَّفَ مسيرةُ كلٍّ منهما بناء على وضوح فكرة “تحرير فلسطين”، وسبل تحقيقها الناجعة لا الجامدة. يقول مالك بن نبي: “لكن طغيان الشخص يؤدِّي إلى نتائج في الإطار السياسي والاجتماعي تهدم بنيان الفكرة حينما تتجسَّد فيه. وكثيرًا ما تعمد مراصد الرقابة في حركة العالم الثالث إلى دفع هذا الاتجاه المرضي إلى نهايته في عقول الجماهير لتحطِّم الفكرة البنَّاءة من وراء سقوط الأشخاص الذين يمثلونها في النهاية، وتدفع الجماهير للبحث عن بديل للفكرة الأصيلة من الشرق والغرب عبر بطل جديد. فعدم التوازن بين العناصر الثلاثة (الأفكار، والأشخاص، والأشياء) يفضي إلى انهيار المجتمع. والمجتمع الإسلامي يُعاني في الوقت الحاضر بصورة خاصة من هذه الاتجاهات؛ لأن نهضته لم يُخَطَّطْ لها، ولم يفكر بها بطريقة تأخذ باعتبارها عوامل التبديد والتعويق؛ فمثقفو المجتمع الإسلامي لم يُنشئوا في ثقافتهم جهازًا للتحليل والنقد، إلا ما كان ذا اتجاه تمجيدي يهدف إلى إعلاء قيمة الإسلام. والمجتمع الإسلامي لا يدرك بالتالي حركتَه وأصالة مصادره. فهو لذلك يعيش في حالة نفسية تخلط بين الأصالة والفعالية؛ ذلك أن العالم الصناعي الغربي اليوم فعَّال وتمتد فعاليته لتحتوي العالم بأسره، لكنه ليس أصيلًا؛ أي إنه لا يرتكز إلى مبادئ صحيحة موضوعيًّا. وهذا سِرُّ أزمته في العالم المعاصر”[31].
- نبذ الجهوية معيارًا للحكم على السياسات والقرارات والمواقف والممارسات. يقول المناضل الفلسطيني خالد الحسن (توفي 1994) في وضع النقاط على الحروف: “لمن يوصفون باليسارية أو بالماركسية أو بالشيوعية أن يفهموا، أنه لا يمكن الموافقة على كل ما يأتي من موسكو لمجرد أنه من موسكو، وكذلك لا يجوز أن يرفض كل ما يأتي من الرياض لأنه من الرياض: إن مثل هذا المقياس في القبول والرفض، هو عبث طفولي بالغ التدمير والإرباك بالنسبة لكوادر الثورة وشعبها وجماهيرها على امتداد الوطن العربي وأصدقائها على امتداد العالم… إن مقياس الموافقة أو الرفض هو مصلحة قضيتنا ونضالنا في سبيلها وفق المبادئ التي أوردها ميثاقنا الوطني. إن المناورة في معسكر الخصوم مطلوبة، ولكنها لا يمكن أن تتحقَّق إلا على قاعدة الصدق والوضوح والالتزام مع أنفسنا وشعبنا وجماهير أمَّتنا وأصدقائنا”[32]. ويقول في موضع آخر أكثر مباشرةً: “إن منظمة التحرير مطلوب منها استعادة السيادة وليس ممارستها؛ لأن السيادة هي من حق الشعب بمؤسساته البرلمانية والحكومية القائمة فوق أرضه ومع شعبه بشكلٍ حُرٍّ مستقلٍّ أي من خلال قيام الدولة وليس قبلها… فمن لا يملك الحق لا يستطيع ممارسته، فإذا مارسه أصبحت ممارسته غير شرعية، ومن حق الشعب أن يرفضها، ولا يترتب عليها أي التزام قانوني”… “إن صحة الفعل أو صوابه ليس في من ينادي به أو يفعله، وإنما بالدافع الكامن وراء قرار القيام بالفعل، والهدف المتحقق من جراء تنفيذ الفعل…”. “إن قضيتنا وصلت إلى مرحلة من الدقة، لا تستقيم مع مصلحتها المواقف الانفرادية سواء كانت مواقف نزيهة أو انتهازية، مستقلة، أو تنفيذًا لطلبات حلفاء أو أصدقاء عرب أو غير عرب”[33].
- ويرتبط بذلك أن نخرج العاطفة والتحيزات النفسية من الحسابات الدقيقة للصراع السياسي. فالعاطفة تجاه التاريخ النضالي الفتحاوي واضحة، وكذلك العاطفة تجاه الدماء القريبة التي تبذلها قوى المقاومة منذ الانتفاضة الثانية على الأقل. هذه العاطفة تتجلَّى عندما يحتدم نقاش المصالحة والوحدة في صورة دفاعات خفية عن النفس الصغيرة على حساب النفس الكبيرة. ينبغي تحجيم العاطفة. وينبغي العناية بالأبعاد المادية الاجتماعية والاقتصادية التي رغم بروزها ترجع لتتخفى وراء إدارة الضفة وغزة. إن حماس تعمل على توفير العيش لأهل غزة وسط حصار لا إنساني خانق، حتى من الأهل. وكذلك حركة فتح ذاقت وأذاقت شعبها في الضفة طعم العيش ودرجة من الحرية، لكن ذلك ينقطع مع الوقت عن مشروع التحرير الكبير، حتى ليبدو بديلًا عنه، أو يبدو الحفاظ عليه شرطًا لتكميل مشروع التحرير؛ ومن ثم مانعًا منه. ينبغي مراجعة هذه السياسات قبل أن تتحوَّل إلى سياسات معتادة نتبعها تبعيَّة الثور الهائج للخرقة الحمراء في المسابقات الإسبانية.
يقول مالك: “إن الاستعمار يحسب حسابًا لكلِّ أعماله، وأقواله، حتى لا ينفكَّ الاتصال بين مصالح مركب الأفراد (الكيان الجماعي)، وبين انفعالات الشعب؛ أي بين شهوات البطون المؤثرة وبين الأوضاع العاطفية الواقعة تحت تأثيرها. والمحافظة على هذا الاتصال هو الشرط الأساسي في خطة الاستعمار الاستراتيجية، التي تقتضي في حالة التطبيق: أولا- أن يضرب الاستعمار كلَّ قوة مناهضة له، تحت أيِّ راية تجمَّعت. ثانيًا- أن يحول، في كلِّ الظروف بينها وبين أن تتجمَّع تحت راية أكثر فعالية. وهذان الشرطان يحدِّدان استراتيجية الاستعمار في الصراع الفكري في البلاد المستعمرة: إنه يحول بين الفكر والعمل السياسي حتى يبقى الأول غير مثمر، والثاني أعمى. وهو من أجل هذا، يطبق طريقة التجميد، التي تطبق في جبهة القتال لتجميد قوات العدو عند نقطة معيَّنة. فالاستعمار يتبع في ذلك طريقة تطبَّق في بعض الألعاب الإسبانية: إنهم يلوِّحون بقطعة قماش أحمر أمام ثور هائج في حلبة الصراع، فيزداد هيجانه بذلك. فبدلا من أن يهجم على المصارع يستمر في الهجوم على المنديل الأحمر الذي يلوح به حتى تنهك قواه… فالاستعمار يلوح في مناسبات معيَّنة، بشيء يستفزُّ به الشعبَ المستعمر حتى يُثير غضبه، ويغرقه في حالة شبيهة بالحالة التنويمية؛ حيث يفقد شعوره، ويصبح عاجزًا عن إدراك موقفه، وعن الحكم عليه حكمًا صحيحًا، فيوجه ضرباته وإمكانياته توجيها أعمى، ويسرف من قواه دون أن يصيب بضربة صادقة المصارع الذي يلوح بالمنديل الأحمر… الاستعمار بطل الألعاب الإسبانية… في المجال السياسي. ويمضي الشعب الباسل في هذا الوضع الدرامي، كأنما تضحياته ذاتها من النفس والنفيس جمدته وقضت عليه بالبقاء فيما هو فيه. وهكذا نصل إلى استنتاج جِدِّ غريبٍ في السيكولوجية السياسية، وهو أن السياسة العاطفية لا تجد مبرِّراتها في كسْبها ولكن في خسارتها: فكلَّما تقطَّعت أنفاس الثوْر، ونزفَ دمُه في حلبة الصراع، يزداد هجومه على المنديل الأحمر…”[34].
- ثم أخيرًا ضرورة الجمع الضروري بين السلام والسلاح أو بين السياسة والحرب. والتحرير رهين هذه الجامعيَّة. والحالة الفلسطينية تشهد اليوم حربًا من غير سياسة (حتى ولو كانت بفعل رفض السياق للتعامل السياسي مع المقاومة)؛ وهذا ما تنتقده فتح وتشترطه على حماس، كما يشهد سياسة من غير قوة تحميها؛ وهو ما ترفضه حماس وفصائل المقاومة في حالة فتح وفصائل المنظمة من بعد أوسلو. وقد كان في سنوات عرفات الأخيرة 2000-2004 عبرة لمن بعده، لكن الكثيرين لم يعتبروا. وقد كان الفكر السياسي الفلسطيني -وفي قلبه فكر فتح- يؤمن بهذه الجامعية، وعاش الحالة الحمساوية فترة طويلة، لكن مهارة عرفات كانت تخلق فعاليات سياسية بين-عربية ودولية، تفتقد إليها السياسة الفلسطينية الحالية بين أبي مازن وقيادات حماس والجهاد والجبهتين وغيرهما. وبدل أن نحصرها في إشكالية قيادة جامعة في النظر والحركة، نحيلها إلى ضرورة الرؤية الجامعة التي تجعل من الطرفين ركنيها، بدلًا من أن يدَّعي أحدُهما أنه شرط الآخر لكي يوسِّع له الطريق ليُسهم في معركة التحرير.
ويمكن أن يتجلَّى هذا فيما كتبه خالد الحسن بعنوان (حرب رمضان شاهد على إمكانية التحرير) حيث رسم خطَّين استراتيجيَّيْن لتحرير فلسطين: مباشر عسكري تصاحبه استراتيجية بناء قوة عسكرية هجومية عربية وتضامن عربي واستعمال لسلاح الاقتصاد ودوليًّا. “وهذا يتطلب كما أشرنا إمَّا تغييرًا في عقلية الأنظمة العربية، أو تغييرًا شاملًا على مستوى الأمة العربية، وأخرى استراتيجية غير مباشرة تتبنى “منهج البرامج المرحلية” بدايتها إقامة الدولة على ما يتحرَّر من أرض فلسطين ثم “البقية تأتي”[35].
إن رؤية استراتيجية لجمع الكلمة لا يمكن أن تخرج من فصائل السياسة والمقاومة وحدها. إن منبعها الأساس هو أهل الفكر الاستراتيجي الحضاري، القادرون على تجديد الإلهام بفكرة التحرير، ومفاهيم السياسة والمقاومة الحضارية، الجامعة في أهدافها ووسائلها، وقواها وقياداتها.
_________________
هوامش
[1] باسم الزبيدي، الانقسام الفلسطيني: جذور التشظي ومتطلبات التخطي، مجلة المستقبل العربي، المجلد 38، العدد 446، أبريل 2016، ص ص 77-90.
[2] المرجع السابق.
[3] يوني بن مناحيم، السلطة الفلسطينية باقية رغم فشل اتفاق أوسلو، موقع نيوز “1”، ترجمة موقع: حضارات للدراسات السياسية والاستراتيجية؛ آخر تحديث: 30 أغسطس 2023 – 4:25 م: متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3Q6jYZI
[4] إكرام محمد ذياب، في عامه العاشر: الانقسام الفلسطيني ومعوقات الوحدة، المعهد العربي للبحوث والسياسات (نواة)، 2018، متاح عبر الرابط التالي: https://www.nawatinstitute.org/6943.html
[5] عزام شعث، الانقسام السياسي وتحديات الحكم: قراءة في التجربة الفلسطينية خلال الفترة من 2007: 2021، آفاق عربية وإقليمية، العدد التاسع، 2021، ص 141.
[6] منها المراجع السابقة: باسم الزبيدي، الانقسام الفلسطيني: جذور التشظي ومتطلبات التخطي، مجلة المستقبل العربي،…. إكرام محمد ذياب، في عامه العاشر: الانقسام الفلسطيني ومعوقات الوحدة، المعهد العربي للبحوث والسياسات (نواة)، 2018، عزام شعث، الانقسام السياسي وتحديات الحكم: قراءة في التجربة الفلسطينية خلال الفترة من 2007: 2021، آفاق عربية وإقليمية، العدد التاسع، 2021.
ومنها رسالة: معاذ أحمد العطشان، واقع العمل الوطني الفلسطيني بين اللانقسام والوحدة 2006-2017، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، إشراف د. محمد بني عيسى، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، عمان – الأردن، مايو 2018. وقد ضمَّ العطشان إلى رسالته هذه ملحقًا بآراء اثنتي عشرة شخصية قيادية فلسطينية حاورها شخصيًّا مباشرةً أو هاتفيًّا، حول: واقع العمل الفلسطيني في ظل الانقسام، ومقدرات المصالحة وأسباب فشلها، والمستقبل المتوقع بناء على هذا؛ وهم بالترتيب الأبجدي: أحمد عساف، أيمن عودة، بلال قاسم، ذياب اللوح، رامي الحمد الله، سليم الزعنون، صائب عريقات، عزام الأحمد، عمران الخطيب، غازي حمد، محمود خليفة، موسى أبو مرزوق، ص ص 116-177.
[7] معاذ أحمد العطشان، واقع العمل الوطني الفلسطيني بين الانقسام والوحدة 2006-2017، مرجع سابق، ص 146.
[8] المرجع السابق، ص ص 152-154.
[9] المرجع السابق، ص ص 176-177.
[10] المرجع السابق، ص 143.
[11] المرجع السابق، ص ص 165-167.
[12] عبد الفتاح الدولة، المتحدث باسم «فتح» لـ«المصري اليوم»: طوفان الأقصى عمل بطولي سنخسر جميعًا لو لم نستغله، «الدولة»: نعيش أيامًا دامية تتطلب الوحدة.. ومستعدون للعمل مع حماس والجهاد وفق أجندة فلسطينية خالصة، حوار كتبته: إنجي عبد الوهاب، جريدة المصري اليوم، مصر، الخميس 12 أكتوبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://www.almasryalyoum.com/news/details/3004378
[13] المرجع السابق.
[14] راجع تصريحاته في رويترز وتوضيحاته وتصحيحاته على قناة الجزيرة.
[15] عبد الباري عطوان، هذا هو ردنا على تصريحات حسين الشيخ الأصلية والمعدلة، رأي اليوم، 21 ديسمبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/443meH4
[16] المرجع السابق، وبالطبع يعبر عبد الباري عطوان عن وجهة النظر المقابلة التي تنطلق من إدانة أوسلو ومن وقعوها، والتنسيق الأمني مع العدو، والاعتراف بدولة الاحتلال، وعبثية خط المفاوضات، والطعن في فتح بالتواطؤ مع الاحتلال وحماية مستوطنيه، واغتيال المقاومين والتجسس عليهم، ومن ثم القول المبدئي المقابل: إن المقاومة هي الممثل الشرعي والفعلي للشعب الفلسطيني ولمشروع التحرر.
[17] حركة فتح تعقد اجتماعا قياديا موسعا برئاسة الرئيس محمود عباس، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، تاريخ النشر: 31 يناير 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://www.wafa.ps/Pages/Details/89226
[18] المرجع السابق.
[19] الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها للرئيس عباس، سكاي نيوز، 26 فبراير 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3vWziRT
[20] عباس يكلف مستشاره الاقتصادي محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.. حكومة “تكنوقراط” في فلسطين استعدادًا لإعادة إعمار غزة وإصلاح النظم الإدارية، الشرق نيوز،14 مارس 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3Jlr4G3
[21] حماس وفصائل فلسطينية ترفض تشكيل حكومة “دون توافق وطني”، الجزيرة نت، 15 مارس 2024؛ متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/49GpWHU
[22] حوار موسكو.. هل يُحدث اختراقا في جدار الانقسام الفلسطيني؟ عوض الرجوب، الجزيرة نت، 26 فبراير 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/4aXk3ao
[23] المرجع السابق.
[24] ملف اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو، موقع كنعان، 1 مارس 2024؛ متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/43ZPTAY
وبيان صادر عن اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو، الموقع الرسمي لعضو اللجنة التنفيذية صالح رأفت – الدائرة العسكرية والأمنية “م.ت.ف”، 1 مارس 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://www.msad.ps/2024/03/7-4374.html
[25] محمد خيال، جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح: طوفان الأقصى صرخة لتذكير العالم بمأساة الشعب الفلسطيني، بوابة الشروق، 3 مارس 2024 متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/4azkpUB
[26] المرجع السابق.
[27] المرجع السابق.
[28] صدام الروايات.. لماذا تشتعل قضية اعتقال عناصر مخابرات لرام الله في غزة؟ الجزيرة نت، 4 أبريل 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://www.ajnet.me/news/2024/4/4/1279
[29] المرجع السابق.
[30] شكيب أرسلان، لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟، (القاهرة: عصير الكتب للنشر والتوزيع، 2019)، ص ص 36-39.
[31] مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ترجمة: بسام بركة، أحمد شعبو، (دمشق: دار الفكر، ط1، 1988، إعادة طباعة: 1423هـ/ 2002)، ص ص 10-11.
[32] خالد الحسن، نقاط فوق الحروف: مناقشة لردود الفعل تجاه مبادرتي الأمير فهد و بريجينيف، (عمان: دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطيني، 1985)، ص 45.
[33] المرجع السابق، ص ص 47-48.
[34] مالك بن نبي، الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، (دمشق: دار الفكر، 1401هـ/1981م)، ص ص 29-30.
[35] خالد الحسن، نقاط فوق الحروف، مرجع سابق، ص ص42-43.
- نُشر التقرير في فصلية قضايا ونظرات- العدد الثالث والثلاثون- أبريل 2024