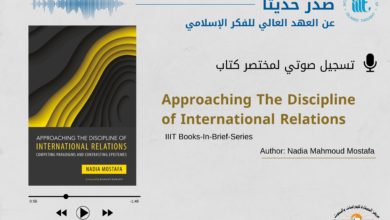البناء الفكري لطارق البشري.. قراءة في المسألة الإسلامية المعاصرة
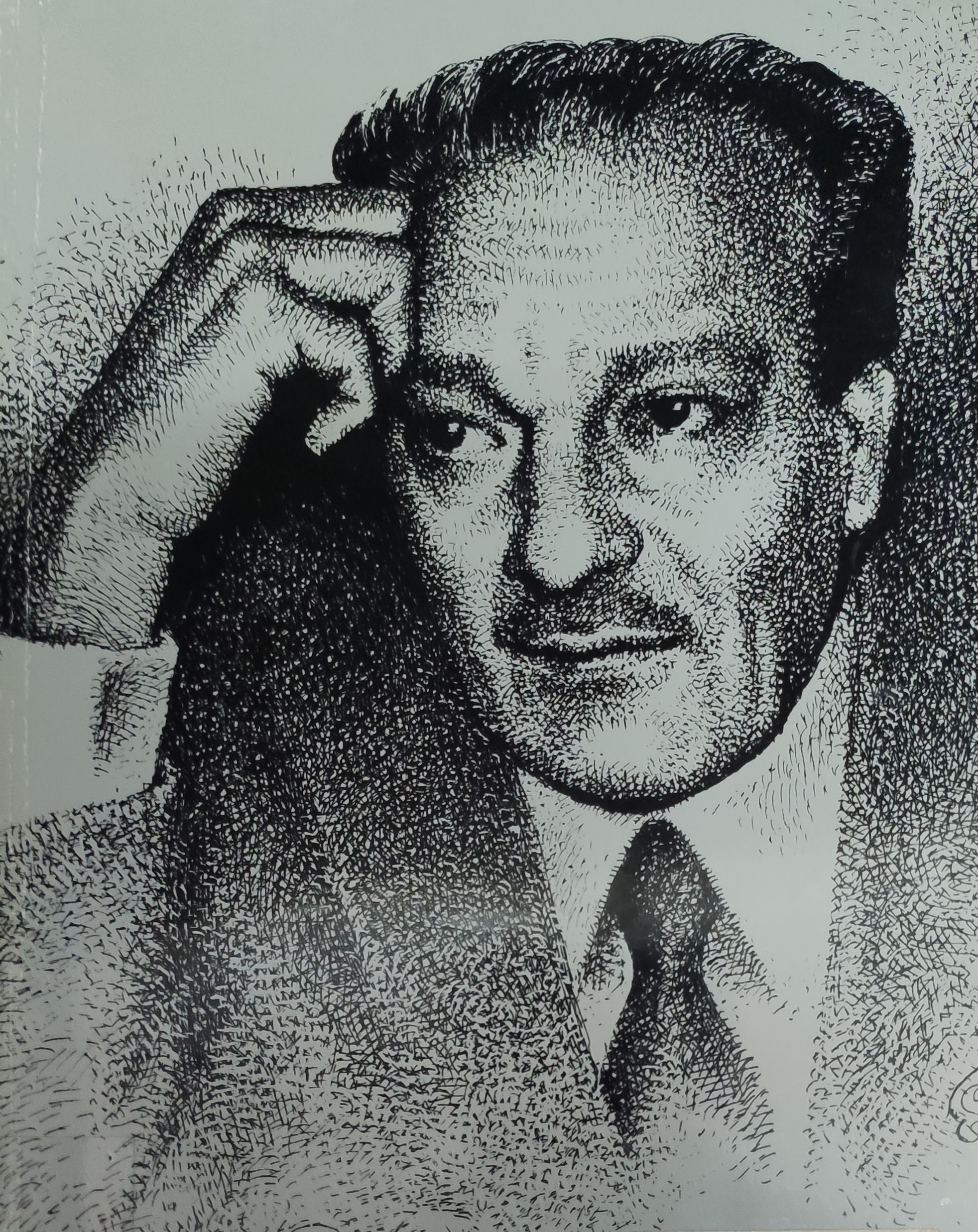
مقدمة:
حين عرفت في نهاية يونيو 1998 بالإعداد الاحتفاء بالمستشار طارق البشري[1] لم أتردد في اقتراح المشاركة وذلك بإعداد موضوع هذه الورقة، أي تقديم قراءة في مجموعته الأخيرة “في المسألة الإسلامية المعاصرة”[2].
وشعرت أن مبادرتي هذه ليست بالمهمة اليسيرة، ولكنني كنت مدفوعة بعدة اعتبارات شكلت قناعتي وإيماني بضرورة المهمة من ناحية كما استوجبت من ناحية أخرى الانتباه لحقيقة العملية المنهاجية اللازمة لتنفيذ هذه المهمة.
ولهذا فإن هذه الورقة تبدأ بمجموعة ملاحظات أحسبها أساسية ويستلزمها قدر المحتفى به وفكره، فهي فهي تشرح هذه الاعتبارات وتصف هذه العملية المنهاجية قبل الانتقال إلى عرض نتائج القراءة.
1- ويمكن أن أوجز أهم الاعتبارات التي رسَّخت إيماني بهذه المهمة في الاعتبارين التاليين:
أولهما: اعتبار عام يتصل بأصل الفكرة – وهي ضرورة القراءة المقارنة التراكمية في أعمال كل من أعلام الفكر الإسلامي المعاصرين. وبحيث لا يصبح الاحتفاء بعلم منهم احتفاءً بشخصه ولكن احتفاء برمز، وبفكر، وبمعنى وذلك في وقت يتكاثف فيه الضباب أمام عيون شبابنا وحول عقولهم وعلى نحو يستوجب استدعاء الرموز والمعاني والأفكار.
ولذا لا بد وأن يصبح الاحتفاء بطارق البشري على النحو الذي جرى عليه بداية تستتبعها حلقات أخرى مكملة تمتد لأعمال وأفكار أعلام آخرين فهذا التقليد الذي يتوافر لدى غيرنا – تفتقده الجماعة البحثية والجماعة الفكرية الإسلامية ومن ثم فهو حاجة لإرساء ولتدعيم ولاستمرارية.
ثاني هذه الاعتبارات: خاص بالمستشار طارق البشري، وهنا تتفرع الاعتبارات عن الأصل الواحد فإذا كانت أعمال الفقيه القاضي وأفكاره في هذا المجال قد تبدت في مصادر بعينها فإن فكره الاجتماعي السياسي القانوني يتبدى في عدة مجموعات من المصادر، إحداها تلك المجموعة التي تتصدى لها في هذه الورقة أي المجموعة التي تحت عنوان “في المسألة الإسلامية المعاصرة” وكان للقراءة في هذه المجموعة بصورة منتظمة تراكمية جاذبية خاصة وأساسية يحكمها أمران محددان؟
فلقد اقترنت مبادرتي باقتراح تقديم هذه الورقة بسؤال كبير كان يتردد في ذهني إذا كانت قراءات لي سابقة ولكن متناثرة في أعمال البشري، وإذا كان الاستماع إليه في عدة مناسبات متنوعة قد أرسى في ذهني أن محور اهتمامه هو دراسة خبرة القرنين التاسع عشر والعشرين عن الإصلاح والتجديد في المجتمعات الإسلامية في ظل تطور التدخل الخارجي في إطار رؤية كلية للتاريخ الإسلامي تجمع بين تحليل الفكر وتحليل الواقعة أو الظرف، فما الجديد الذي سأخرج به من القراءة المنظمة لهذه المجموعة؟
ولذا فعند الاقتراب من هذه القراءة المنظمة في مجموعة الكتب الخمسة توالت الأسئلة: ما هو جوهر هذه المجموعة من الكتب؟ ما الذي شغل البشري عبر هذا العدد من الدراسات التي تم إعدادها وعرضها في مناسبات عدة طوال الثمانينيات وحتى منتصف التسعينيات والتي انقسمت بين الكتب الخمسة؟ ما القاسم المشترك بينها والذي جعل البشري يختار أن ينشرها في كتب خمس كل يحمل عنوان ولكن تحت هذا العنوان الجامع “في المسألة الإسلامية المعاصرة”؟
وكانت أهمية الإجابة بقدر أهمية مغزى هذه المجموعة من الدراسات التي تعبر عن فكر البشري في مرحلة مهمة من مراحل تطوره الفكري. وهذا يقودني إلى الجزئية التالية:
وهي عن طبيعة الخبرة التي يمثلها طارق البشري: وكان منطقي بهذا الصدد هو مايلي: إذا كنا نعرف أن البشري قد مر -مثل آخرين من معاصريه- بتجربة تحول في نسقه الفكري، إلا أن ما سيتوجب المعرفة حقيقة هو كيف انعكست هذه الخبرة ي هذه المجموعة من الأعمال ولم يكن سؤالي هذا نابعًا من فراغ ولكن مدفوعًا بخبرة عملي في مشروع العلاقات الدولية في الإسلام منذ 1987. وكان فكر طارق البشري من العلامات التي أنارت لي الطريق في العديد من مفارق الطرق الوعرة التي كنت أخوض فيها عبر عملية الانتقال من الدراسة والبحث في نطاق المنظور الغربي فقط إلى إطار أكثر رحابة ومقارنة. ولذا فإن لخبرة البشري ولفكره مغزى لدى جيل كامل من تلاميذه الذين عايشوا ويعايشون كل معضلات الوضع الفكري والسياسي المعاصر والذي يجسده بأبسط الطرق ذيوع كلمتي نحن والآخر.
إن هذا الفكر وهذه الخبرة الذي يطرحهما نموذج طارق البشري يستوجب التوقف لذاتيتهما وذلك لاستكشاف الملامح الرئيسية والسمات الكلية ولعل من أندر الفقرات – بل لعلها الوحيدة بين صفحات الكتب الخمسة – تعبيرا عن هذه الخبرة التحولية تلك الفقرة التالية (ك: 1، ص 11)، التي يقول فيها: “وأعترف بأن هذه الدراسات بالتحديد كانت تحمل بالنسبة لي شخصيًّا بُعدًا مهمًّا جدًّا، بمعنى أنني كنت أكتشف نفسي وأنا أعد كلا منها. ولولا أني لا أريد أن أثقل على القارئ لاستطردت في هذا الأمر أحكي كيف كنت أحتشد لكل دراسة منها، وأقرأ، وأطيل التفكير، وأجد عناصر في تفكيري السابق تذوي وتتحلَّل وأخرى تبدو، ويستدرجني النسق الداخلي للأفكار المختلفة فأعيش منطقها الذاتي، ثم أتكشف ما لم أكن كشفته، ثم أكتب وأقرأ ما أكتب، فإذا به يجري على غير مألوف ما كنت أصنع من قبل، وإذا بتداعي المعاني يدهشني، فأبقيه زمانًا ثم أعاود النظر فيه تشذيبًا وتنقيحًا، ومن خلال هذا الجهد وهذه العملية حدث عندي الإحلال الفكري بين ما ذوى وتحلَّل من أصول فكرية كانت تشدُّني، وبين ما قام واستقام من أصول فكرية أخرى أجري على دربها اليوم”.
2- ويتوجب على كل من قدر طارق البشري في حد ذاته وقدر أعماله في حد ذاتها أن أحدد منهاجية التعامل معها والتي قادتني إلى نتائج القراءة التي سترد لاحقا، وكانت هذه الورق فرصة فريدة في خبرتي البحثية والفكرية. فهي ليست تعقيبا على دراسة في مؤتمر وليست عرضا نقديا لكتاب أو عرضا مقارنا لكتابين ولكنها كانت بالنسبة لي عملية منهاجية أكثر عمقا ومن ثم أكثر تحديا ويجدر التوقف عند بعض الملاحظات حول أهم إشكالياتها وحول خطواتها وضوابطها
أ- ولقد تمثلت أهم إشكاليات القراءة في إن المجموعة لا تمثل سلسلة متوالية في الصدور ولكنها صدرت أربعة كتب في 1996 وصدر الخامس في 1998. ولم تتضمن تقديما لكم منهم – باستثناء – الحوار بين الإسلام والعروبة الذي نشر 1998؛ ومن ثم كان السؤال الأساسي الذي لا بد وأن أجد الإجابة عليه هو كيف يمكن ترتيب قراءة هذه الكتب الخمسة؟ وبنظرة إجمالية أولى وتنفيذا لمهام القراءة الأولى (قبل الندوة) أقدمت على القراءة المنظمة بالترتيب التالي ماهية المعاصرة، الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي، الوضع القانوني المعاصر، الحوار الإسلامي العلماني بين الإسلام والعروبة وكان معياري في الترتيب هو ما اعتقدت أنه انتقال بين العام إلى الخاص ومن واقع هذه القراءة تمت صياغة الإطار الكلي الذي تم تقديمه في العرض الشفوي في الندوة
ب- ولم اقترب من القراءة باستخدام منهاجية محددة لتحليل الخطاب أو تحليل النصوص ولكن أقدمت عليها بتفاعل حي مع هذه النصوص أبحث عن ما أسميته الملامح العامة للبناء الفكري والمنهاجي في هذه المجموعة من الكتب الخمسة. فكان هذا هو هدفي.
بعبارة أخرى لم تكن القراءة بغرض التوقف عند قضايا محددة لعرضها أو مناقشتها أو نقد الموقف الفكري تجاهها ولكن الغاية كانت أرحب وأوسع من ذلك. ولقد تمكنت من واقع القراءة الأولى من تحقيق الأركان الأساسية لهذا الغاية، والتي تضمنها العرض الشفوي في الندوة.
ج- ثم شعرت أن قبل هذه القراءة ومثل هذا التعامل مع هذه المجموعة لا يمكن أن تكون منذ المحاولة الأولى عملية محكمة جامعة مانعة شاملة، شعرت أنها لا يمكن أن تكون نظام مغلق ولكنها نظام مفتوح يستمر فيه التفاعل بين القارئ وبين والسطور والأوراق فهذا هو الحال مع الفكر الحي لبعض أعلامنا وأساتذتنا وعلى رأسهم البشري – فهو ليس إلا موردًا من موارد المياه يتكرر الورود إليه فلا ينضب ولا يكتمل ارتواء الوارد مهما تعددت مرات الورود ففي كل مرة يتحقق الارتواء بطريقة جديدة وبمذاق متجدد والمورد دائما واحد
د- ومن أجل إعداد الصياغة الكاملة للنشر،وخلال عملية القراءة الثانية التي ركزت على تفاصيل بعض القضايا على استخلاص بعض المقولات والتدبر في معانيها لاحظت أنه يمكن إعادة ترتيب قراءة الكتب على نحو يستدعي في البداية كتاب بين الإسلام والعروبة فبالرغم من نشره في 1998 إلا أن مقالاته قد كتبت في 1980-1981 في حين أن تواريخ الدراسات في الكتب الأخرى قد انتشرت عبر الثمانينيات والنصف الأول من التسعينيات ولهذا أعدت ترتيب الكتب في القراءة الثانية على النحو الموضح في القائمة المرفقة ويبدو من هذا الترتيب معياره السابق قد انعكس ليصبح الانتقال وفق للعناوين من الخاص إلى العام ولم يكن إعادة ترتيب قائمة الكتب على هذا النحو مغزى إلا في حالة واحدة وهي الكشف عن الخط العام لتطور فكر طارق البشري خلال العقدين الماضيين. ولم يكن هذا الهدف يقع من بين أهدافي منذ بداية القراءة الأولى. وبعد القراءة الثانية لم يتم تعديل هذه الأهداف أو الإطار الكلي للعرض الذي صغته بعد القراءة الأولى. ذلك لأن هذه القراءة الثانية – وفق الترتيب الثاني لم تقدني إلى استكشاف تطور في فكر البشري. وأقصد بالتطور هنا أمرًا محددًا وهو ظهور توجهات كبرى في مرحلة لم تكن قائمة من قبل أو عكست تغيرا في توجهات سابقة. بل على العكس تأكدت أن مضمون الكتب الخمس يمثل كلا متكاملا ويشكل بناءً تراكميًا فلقد سلك كل منها الضوء على نفس المسار ولكن من زوايا مختلفة -كما سنرى لاحقًا- ولذا فهي تعكس عملية تعميق وتأصيل لنفس مسار فكر طارق البشري الذي خرج من رحم الوطنية المصرية (كما يتضح من كتاب بين الإسلام والعروبة) إلى عالم أحب هو عالم الوطنية الإسلامية حاملًا معه الثمرات التي أخرجتها البذور التي ألقاها البشري بداية الثمانينيات والتي ارتوت تدريجيا واحتضنها فكره فنمت وأثمرت.
وبذا، فإن النتائج الأساسية لعمليتي القراءة كانت استكشاف المكونات العامة والكلية للبناء الفكري حول المسألة الإسلامية المعاصرة وهو البناء الذي وإن ألقى البشري أساسه في بداية دراسات 80 واكتملت أركانه طوال عقدين إلا أن عملية الإعداد له لا بد وأن تكون قد استغرقت معاناة ممتدة سابقة.
مكونات البناء الفكري للبشري
يمكنني عرض نتاج قراءتي الكتب الخمسة في عدة مجموعات من الأفكار تلخص كل منها مكون هام من مكونات هذا البناء: المضمونية منها والمنهاجية، الكلية منها والجزئية، الأصلية منها والفرعية القائمة منها أو المرجو استكمالها.
هذا وكان مصطلح “البناء” هو أول ما تبادر إلى ذهني عند بداية الإعداد للورقة. ثم ترددت كثيرًا في استخدامه نهائيا لما قد تعبر عنه “الأعمدة أو الأحجار” من جمود، في حين أن فكر البشري يموج بتيارات الحياة الفكرية والمجتمعية المتدفقة في كل الاتجاهات. ولكني لم أجد أكر من تعبيرًا عن معان أصيلة تسربت إلي عما يتصف به فكر البشري في هذه الكتب وهي: التماسك، والتكامل، والاستمرارية والتصاعد من نقطة بداية إلى هدف مرجو وفي إطار يتسم بوضوح الملامح والقسمات يعكس طرازًا متميزًا وشعرت أن “البناء” ليس مجرد مصطلح ولكن أضحى – بالنسبة لي “مفهومًا” ذا دلالة محددة.
وتدور المجموعة الأولى من نتائجي حول الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها البناء الفكري الذي تجسده هذه الأعمال، أما المجموعة الثانية فتتصل بالأحجار الأساسية التي تحمل أعمدة هذا البناء.
أما القضايا التي تثور عبر جنبات عملية التشييد فتعطي للبناء مضمونه المتميز فتتضمنها المجموعة الثالثة من نتائجي، وتنتقل المجموعة الرابعة إلى بعض ملامح المنهاجية التي أخرجت البناء على هذا النوح وأخيرًا كانت هناك بعض الأمور “الغائبة” والتي آمل أن يمتد إليها قلم البشري فيسطرها هي لابد قائمة في فكره لأنها تمثل الاستكمال والامتداد الطبيعي للبنيان في ظل مقتضيات نهاية القرن العشرين.
*أولا- الأعمدة الأساسية
يقوم البناء الفكري في هذه المجموعة من الأعمال على عمودين أساسيين:
العمود الأول:
توصيف وتشخيص وتفسير ما أسماه البشري آفة الآفات التي تعاني منها مجتمعات الأمة المسلمة أي “الصدع “، “الانقسام”، الازدواجية من الوافد والموروث نتيجة النقل عن الغرب سواء على صعيد الفكر أو الحركة أو المؤسسات والنظم. وهي الحالة التي تجذرت جذورها في خبرة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وأثمرت ثمار صافي القرن العشرين وذلك في ظل التنامي المتصاعد للتدخلات الخارجية درجة ونوعًا ومن أقوى التعبيرات عن شعور البشري بوطأة هذه الآفة قوله (ك: 4، ص 66-67) “نشكو من صدع هائل في حياتنا الفكرية ورؤانا الحضارية وهو صدع لا يشق المجتمع فقط ولكن يكاد أن يشق الفرد الواحد نصفين… وقد انشق الضمير نحن؟… نجد شقًا طوليًا يفصل المجتمع الواحد يقطع كأنه ضربة السكين في الجسم الحي…” وليست هذه المقولة إلا مثالا على ما لا يمكن. بعبارة أخرى هذا هو السهم الجوهري الذي شغل فكر البشري فتصدى له بأبعاده المختلفة: أسبابًا ومظاهرًا وعواقبًا وسبلًا للمواجهة.
ويدل على هذا إن ما من مقالة من المقالات التي احتوتها الكتب الخمسة إلا وتقترب من هذا السهم أو هذه الآفة أو هذه المعضلة. ولكن تختلف من كتاب لآخر مقدمات الاقتراب وزواياه كما تختلف درجات التفصيل فيها من ناحية أخرى فإذا كان البشري (في ك: 1) قد ركز على العلاقة بين الإسلام والعروبة وفي قلبها قضي وضع الأقباط في مصر بصفة خاصة إلا أن قضيته الصدع وجذوره كانت بمثابة الخلفية التي تواجدت (ص 38-47، ص 67-72، ص 76) و لو بدون تشريح تفصيلي كما حدث بعد ذلك في الدراسات التالية في الكتب الأربعة الأخرى.
هذا ومن ناحية أخرى تعددت زويا الاقتراب من هذه القضية بأبعادها المختلفة في هذه الكتب، فنجد أن البشري قد تعرض لها (في ك: 1) في معرض خطابه للعلماني وللقومي لبيان وضع الحركة الإسلامية في سياق التاريخ الحديث باعتبارها أصلا وليس وضعا طارئا، وفي معرض شرحه للعلاقة بين التيار الإسلامي وتيار الوحدة العربية. كذلك تعرض لها في معرض شرحه لكيفية حدوث الصدع بين النخبة الحاكمة والنخبة الفكرية الحديثة التي تكونت؟ وبين الجماهير وبينها وبين رجال الشرع والنخبة الفكرية والإسلامية وعلى النحو الذي يبن مدى تأثير الفكر الوافد الأوربي في القرن 19، والذي يكشف عن أحد أسباب الانقسام والازدواجية الثقافية والحضارية التي تأكدت في مسيرة تاريخ الشعب العربي من بعد وعلى نحو أثر على العلاقة بين الإسلام والقومية العربية نتيجة التأثير أبعد الأثر في المفاهيم الفكرية الأساسية: مفهوم الوطن، القومية والتدين، والتمدين والتطور والتقدم.
وفي الكتاب الثاني انطلق تناول البشري للعلاقة أو الحوار بين الإسلام والعلمانية من بيان كيفية وفود المنهج العلماني إلى بلادنا الإسلامية العربية في أوائل القرن 19 مع تعاظم النفوذ الغربي الأوروبي.
ولذا فإن تناوله لسياق العلاقة بين الإسلامية الموروثة والعلمانية الوافدة على مدى القرنين الأخيرين لم يكن إلا تحليلا لكيفية حدوث الصدع ومعالمه ونتائجه وأهمها العلمنة.
أما الزاوية الثالثة التي تطرق خلالها البشري في كتابه الثالث فهي الاضطراب الذي حدث في التيار التشريعي وهياكله واتساقه في أقطار الدولة العثمانية عامة منذ القرن التاسع عشر، وهو الاضطراب الذي تولد عن تفاعل ثلاثة عناصر هي جمود الوضع التشريعي الأخذ عن الشريعة الإسلامية، والحاجة الماسة لإصلاح الأوضاع والنظم وتجديدها وأخيرًا الغزو الأوربي السياسي الاقتصادي ثم العسكري المتصاعد، وهذا التفاعل هو الذي أفرز الانفصام الذي ولد الاضطراب التشريعي في ظل تغلغل التشريعات الغربية وجمود الاجتهاد الحديث خلال مرحلة الاستعمار وفي ظل طبيعة تقنيات ما بعد الاستقلال.
ولهذا فإن هذا الكتاب الثالث يتضمن دراسات عن الجديد في التشريع الإسلامي وحول تطبيق الشريعة الإسلامية وحول منهج النظر يف دراسة القانون مقارنا بالشريعة.
وفي الكتاب الرابع يتطرق البشري إلى نفس القضية أي الصدع، الانفصام، الانقسام، الازدواجية وذلك من زاوية عملية الإصلاح المؤسس والإصلاح الفكري التي جرت في الدولة العثمانية منذ نهاية القرن 18 وما آلت إليه من نتائج أفرزت مجتمعات مصدوعة على مستوى الفكر ومستوى المؤسسات والنظم. ومن ثم جاءت الاستجابة لهذا التحدي في محاولات للإصلاح والتجديد على مستوى الفكر ومستوى الحركة. ولذا فإن هذا الكتاب الرابع ووفقا لعنوانه يركز على تيارات هذا الفكر وهذه الحركة بأنماطها المختلفة (كما سنرى لاحقًا) في التصدي لهاذ الصدع طوال القرن 19 ومنتصف القرن العشرين.
وإذا كان الكتاب الرابع قد جعل محوره التيارات الفكرية بتعاقب ظهورها زمانا ومكانا فإن كتاب “ماهية المعاصرة” ينطلق أيضا من مناقشة “نحن.. بين الموروث والوافد” أي ينطلق أيضا من تحليل “الصدع” في سياقه التاريخي الحديث ولكن يتوقف عند علاقاته ومظاهره بمنهج آخر وهو منهج القضايا التي ظهرت لدى التيارات الفكرية والحركية المختلفة وما تعكسه من تصدعات وانقسامات وهذه القضايا هي: “النظام الديمقراطي، فكر الإصلاح الديني، حول الفكر القومي، حول الحركات الاشتراكية.
وأخيرًا يجدر القول بأن الكتب الأربعة وإن كانت مليئة بالفقرات والصفحات التي تبرز وضع “الصدع” في سياق فكر البشري فمن أكثرها شمولا وعمقا تلك التي يحملها الكتاب الخامس (ص 7) وكذلك الكتاب الثاني (ص 28) وننقل عن الأخير ما يلي: يقول البشري: “إن الوفود العلماني الذي بدأ صغيرً وأخذ ينتشر ليُزاحم واحدية الموروث الإسلامي ويحدث ما نسمِّيه الآن (الازدواج).. انشرخ معه قلب المواطن وعقله جميعًا، أي انفصمت نفسه في التعليم وفي القيم وفي أنماط السلوك والعادات. وانشطر المجتمع أشطرًا بين مؤسسات القضاءين الشرعي والوضعي، والقوانين الشرعية والوضعية الفرنسية، والمعاهد الديني والمدارس الحديثة، وأحياء المدن القديمة والإفرنجية، والنخب السياسية والاجتماعية ذات المنزع الأوروبي وجماهير شعبية ذات منزع إسلامي.. إلخ”.
أما العمود الثاني:
فهو التوأم الطبيعي أو المنطقي للعامود الأول أي رأب الصدع وإقامة جسور من أجل لم شمل الأمة وترميم ما انصدع من أبنيتها وهياكل مؤسساتها وأفكار أبنائها.
فبعد تحديد مكمن المرض وأسبابه في ظل طبيعة الظرف التاريخي وتحدياته في كل مرحلة يتبلور اهتمام طارق البشري مع نهاية (ك: 4) مناقشة الحل والمخرج وذلك من خلال طرح إشكاليات “المشروع الوطني ومتطلباته ومقتضياته (ص 60-93). ومن قلب هذا الطرح بكل تفاصيله يبرز تمسك فكر البشري بالذات الحضارية المستقلة ذات الجذور وضرورة الانطلاق منها لصالح الجماعة وليس لصالح الآخر وانطلاقا من قواعدنا وأسسنا، بعبارة أخرى يكمن في قلب المشروع الوطني لدى البشري غاية رأب الصدع والتي بدونها لا تقوم الذات الحضارية المستقلة.
هذا ويجدر الإشارة إلى أن طرح المشروع الوطني لم يبرز من فراغ فهو لم يكن إلا الوجه الثاني لعملة واحدة، وارتسم على الوجه الأول علامتان كان السبق الزمني في الطرح – وهما بين الإسلام والعروبة (ك: 1) والحوار الإسلامي العلماني (ك: 2) وفي مقدمته للكتاب الأول والتي كتبها البشري 1998 (وهي المقدمة الوحيدة حيث لم يصدر البشري الكتب الأربعة الأخرى بمقدمات) يتجلى فكر البشري عن الدوافع للحوار من ناحية وعن مقتضياته من ناحية أخرى وعن العقبات أمامه من ناحية ثالثة.
فهو من ناحية يقول “…أن من أخطر الانقسامات هو الانقسام من التيار الوطني العلماني وبين تيار الإسلام السياسي… صارت العلاقة بين التيارين تتجاوز حدود القطيعة وتصل إلى حد الغربة والوحشة … يصل بي الأمر أحيانا أن أسائل نفسي، هل اتسع الفتق على الراتق أم لم نعد قادرين أن نرى هذا الصدع الذي يهد من قوى التماسك لدى الجماعة السياسية …”
ثم يقول توضيحا لسبل رأب الصدع وغاياته أن الغرض ليس مجرد إيجاد صيغة للتعايش بين التيارين ولكن صيغة للتلاقي وإقامة الجسور بغية هدف أساسي يتعلق بتكوين التيار السياسي الحضاري الغالب في أمتنا وهو الأمر الذي يلزمه قيام درجة من التقبل الفكري العقيدي العام من كل من التيارات تجاه الأخرى وهذا الأمر لا يتحقق إلا بالجدل والحوار بين التيارات الفكرية ذات الغلة في المجتمع (ص 13-14) لنصل – كما يقول في موضع آخر (ك: 2 ص 7) إلى التقارب المنشود وإلى التخلل المحمود بإذن الله بين القوى الفكرية والسياسية الأساسية في مجتمعاتنا ولنحقق -إن شاء الله- ملامح التيار الأساسي في بلادنا بما يسع الجوهر الإيجابي لكل من المشاركين والمتخلِّلين له.
ويتكرر في أكثر من موضع لاحق (انظر على سبيل المثال ك: 2، ص 56) هذه الدعوة المؤمنة بضرورة بناء تيار سياسي غالب في المجتمع يمثل الأمة في عموميتها يستوعب القاسم المشترك الأعظم مما تنادي به كل القوى ذات الوجود الفاعل في المجتمع.
إذا كان الحوار الحقيقي الذي لا يتطلب -كما يقول البشري- مجرد التقارب المؤقت في بعض المواقف ولكن تلزمه درجة من التقبل، ينزع خواص التنامي به الاتجاهات الفكرية الغالبة – إذا كان هذا الحوار هو سبيل الوصول إلى هذا التيار السياسي الغالب في نظر البشري إلا أننا نجده مناخ الحوار منذ بداية الثمانينات بما أسماه الحروب الفكرية (ك: 1، ص 15-16، ك: 2، ص 43-56) التي تعددت أسبابه انطلاقًا من واقع الظرف التاريخي الإقليمي والعالمي في التماسك كما تعددت أساليبها وتنوعت مجالاتها. (المرأة، الفتنة الطائفية، مؤسسات توظيف الأموال).
وأخيرا يجد الإشارة إلى أنه بالرغم من حرص البشري على إبراز قيمة الحوار ودوافعه وغاياته إنه أفصح عن ضوابط لبدء الحوار من ناحية ولاستمراره من ناحية أخرى: فنجد خطاب البشري (ك: 1) خطاب للعلمانيين والقوميين أكثر منه خطاب الإسلاميين. وهو يقول أنه لا يناقش العلماني القومي في أسس تفكيره ولكنه يريد أن يبين له وضع الحركة الإسلامية بين غيرها من سياق التاريخ الحديث وهو الوضع الذي يبين أن الدعوة الإسلامية كتيار سياسي وحركات تنظيمية لم تكن تيارًا شاردًا ولا طارئًا ولا وصفًا يتجافى مع أصل آخر ومن ثم فإن العلماني القومي لا يحق أن يزعم لنفسه وجودًا أكثر شرعية وأكثر أصالة من غيره فإذا نظرنا إليه بمعيار الثابت والنابت فهو النابت وإذا نظرنا إليه …(ص 8) ويقول البشري إن هذا التوضيح السابق هو بداية لابد منها وهي أولى خطوات الطريق (ص 8).
وإذا كان خطاب البشري يتسم دائما بالأسباب وقوة الحجة ويروم إلى رأب الصدع ما يمكن لأنه فيه خير للأمة إلا أنه يظهر -في بعض الأحيان عدم القدرة على الحوار مع بعض النماذج لأن مثل هذا الحوار يصبح خروجًا عن ثوابت لا فصال فيها ولأن هذه النماذج لا تريد الرأب بقدر ما تريد مزيدًا من الانشقاق. فهم (أي العلمانيون الذين لا يجدي معهم الحوار أيضًا) كما يقول البشري (ك: 2، ص 55) “فئة تغرَّبت قلبًا وقالبًا وابتعدت عن جذور أمَّتها… ينأون بأنفسهم عن تاريخ بلادهم وقيمها وعقائدها وناسها ولا يكنُّون لأيٍّ من هذه الأمور احترامًا كبيرًا…” ولذا نجد البشري المعروف بهدوء مناقشاته ودماثته عند الاختلاف، نجده في أحد تعقيباته على دراسة في ندوة من الندوات (ك: 1، ص 75-84) وهو التعقيب الذي ناقش فيه بعض أهم ما تثيره مدرسة الفكر الوافد حول التاريخ العربي الإسلامي من مواقف، نجد البشري يصل إلى القول في خاتمة تعقيبه (ص 84-85)
“… إنني مغرم بالتفهم للسياق الداخلي للرأي المعارض، وقد حاولت جاهدًا أن أفعل في قراءتي لهذه الدراسة. ولكني مع قرب نهايتها جفلت خارجًا، لأنها تقف على أرض لا أستطيع أن آتي مواردها، وقد ضاقت بي فلم تقبل وجودي في ساحتها ولم ينفسح لي منها إلا أسطر محدودة لا تكفي لي متنفسًا، لأني من واد وهي من واد… فإذا ضربت علينا ألوان من الإنسانية تبنى على حساب وجودنا كجماعة حضارية وسياسية مستقلة ومتميزة، فلن نكون إنسانيِّين بهذا المعنى. وإذا كان التطور يرفضني كجماعة، فلست من أنصار التطور، وإذا كان التقدم ينفيني ويسحقني كجماعة، فإني إذا لمن الراجعين. ما حاجتي لأن أقدِّم نفسي وقومي ووطني وتاريخي وثقافتي، أقدِّم ذلك كله وقودًا يستدفئ به سادة العالم وتابعوهم ألا يكفيهم البترول مصدرًا للدفء؟”.
ثانيا- قواعد البناء الأساسية
يجمع بين الأعمدة الأساسية السبق توضيحها قاعدة كبرى وتتكرر هذه القاعدة في الطوابق المختلفة من البناء (الكتب الخمسة)، فيتحقق من خلالها التماسك والاتصال بين الأعمدة وبذا يكتمل للبناء طرازه الخاص الذي يميز فكر طارق البشري بالمقارنة بغيره حول نفس القضية.
ويمكن توصيف هذه القاعدة على النحو التالي:
التحديات المتتالية التي جابهت الأمة عبر القرنين التاسع عشر والعشرين وأنماط الاستجابات لها سواء على صعيد الفكر أو الحركة أو المؤسسات والتنظيمات ويقدم البشري باقتدار شديد وبتمكن ملحوظ للعملية التاريخية التي جمعت بين هذه التحديات وهذه الاستجابات منذ نهاية القرن الثامن عشر، ويتبين من هذا التفاعل الذي تم في ظل اقتحام الغرب وما مارسه من قهر وإكراه كيفية ظهور الصدع والانقسام والازدواجية ومحاولات رأبها على مستويات مختلفة، ولقد طرح البشري هذه الثنائية التحديات/الاستجابات في مرحلة تاريخية ومن زوايا عدة تناظر الزوايا التي اقترب من خلالها مهن المعضلة الأساسية التي تشغل فكره -كما سبق التوضيح ويجدر الإشارة منذ البداية أن هذا الطرح – على تعدد مستوياته كما سنرى لاحقا – يبرز أن أحد المنطلقات الفكرية التي يسعى البشري لتأكيدها هي أن الاستجابات المختلفة إنما تعكس طبيعة الظرف التاريخي: زمانا ومكانا حيث أن التحديات ذاتها تختلف باختلاف هذا الظرف ومن ثم فإن تقييم هذه الاستجابات لا يمكن أن ينفصل عن “فقه الواقع”. ولقد عبر البشري عن ذلك المعنى موضوع في مواضع متفرقة عديدة من كتبه الخمسة نذكر منها على سبيل المثال ما أورده في دراسته تحت عنوان بين الإسلام والعروبة (ك: 1، ص 19) في معرض اقترابه من المشترك بين العروبة والإسلام عبر التاريخ والذي تطمسه ظروف الواقع وملابساته، فهو يقول (ص 19): “… لقد كانت الحركات السياسية والمفكرون يستجيبون للتحدي المطروح على مجتمعاتهم في كل ظرف تاريخي خاص، وإن أمرنا مع هذه الجهود العملية والفكرية أن نفحصها ونتبين وظائفها في الظروف التاريخية الخاصة بكل منها. وبهذا يستقيم لنا النظر في أي من الدعوات والمذاهب، نقيس فاعليتها بمقدار قدرتها على الاستجابة للتحديات التي واجهت الجماعة في ظرف ما”.
كما يقول (ص 25-26): “تنقلنا هذه الملاحظة إلى نقطة تالية هي المقصودة ابتداءً من هذا الحديث، فإن أمرنا مع أي من الدعوات السياسية أو الفكرية هو أن نفحصها ونتبين وظائفها في الظروف التاريخية التي ظهرت فيها، وبهذا يستقيم لنا النظر فيها وقياس قدرتها على الاستجابة للتحديات التي واجهتها الجماعة في أي ظرف خاص، ومدى تلاؤمها مع ما يتطلبه وجود الجماعة واستمرارها من وظائف”.
“إن لنا عددًا كبيرًا من الخصائص الجمعية، وكل منها يصلح أن يكون معيارًا لتصنيف ما، وكل منها يتلاءم مع نوع من المواجهة المطلوبة لشكل معين في ظرف تاريخي أو اجتماعي خاص. وهناك خصائص عديدة تشكل مقوماتنا الفكرية والحضارية، وينمو بعضها إزاء بعض عندما يثور من الأمور ما يقتضي نمو الخصائص لمواجهة أمر ما. ونحن يتعين أن نولي لكل خصيصة القدر المعلوم من الاهتمام الذي تصلح به الجماعة ويصلح بها قيامها وبقاؤها”.
وإذا انتقلنا إلى بيان الزوايا التي طرح من خلالها البشري – في كتبه الخمسة – إشكالية التحديات / الاستجابات يمكن أن نوجز ما يلي:
في كتابه الأول “بين الإسلام والعروبة” وحتى يبرز المشترك بين العروبة والإسلام من وجهة التاريخ والجغرافية السياسية أو التكوين النفسي الثقافي فهو يقدم إطلالة تاريخية جغرافية قصد منها كما يقول (ص 22): “قصدت من هذه الإطلالة التاريخية الجغرافية، بيان أن الدعوة العربية تنوَّعت موارد نشوئها في البلاد العربية، وفقًا للموقف التاريخي الذي أحاط بكل من مناطقها الثلاث الكبرى : الشرق الشامي، والغربي الأفريقي، والجنوب العربي. وليس من الصواب -فيما يبدو لي- أن يتَّخذ النموذج الشامي كنموذج وحيد وفريد للفكرة العربية، لأن الفكرة العربية هناك -دعوة وحركة- قامت في أصل نشأتها بوظيفة انسلاخية عن الجامعة الإسلامية العثمانية، وحكمتها ظروف هذه النشأة، بينما تخلَّقت الفكرة العربية في أفريقيا في أصل نشأتها وفقًا للوظيفة التوحيدية التي كانت مطلوبة منها وهذا فارق هام يتعيَّن إثباته والاهتمام به عند تحديد وضع العروبة إزاء الجامع الإسلامي، وعلاقة كل من الجامعتين إحداهما بالأخرى”.
كما قصد منها أيضا في موضع آخر بيان أثر الظرف الهندي التاريخي على العلاقة بين الإسلام والقومية وهي علاقة انسلاخية. وعلى ضوء هذا المنطلق في دراسته الأولى يتابع البشري بقية دراسات كتابه الأول مناقشة أوجه التقارب وأوجه التنافي بين الإسلام والعروبة أو القومية العربية على مستويات مختلفة (النخبة، الجماهير، بداية الوجهة العربية لمصر في العصر الحديث بداية إسلامية، اختلاف نشأة الفكرة القومية العربية الحديثة في مصر والمغرب العربي عن نشأتها في بلاد المشرق) كما يتابع التحول إلى التوجه القومي في الإطار المصري ثم في الإطار العربي والذي جرى في الأساس كحركة وكنشاط أكثر ممَّا جرى كدعوة فكرية عن القومية، يتابع هذا التحول كإطار يقدم من خلاله موضوع الأقباط والوحدة العربية في ظل طبيعة تحديات واستجابات الإطار التاريخي الحديث.
أما الكتاب الثاني فيقدم البشري على صفحاته إشكالية التحدي / الاستجابة من زاوية أخرى وهي زاوية تطور “العلمنة مع الفكر الوافد” ويمكن -إجمالًا- أن نميز بين ثلاثة مراحل من المواجهة مع الغرب تختلف من حيث طبيعة أهدافها وآلياتها ونتائجها ولقد اختلفت في كل منها التحديات ومن ثم الاستجابات وأخيرًا النتائج المتتالية وصولا إلى ظواهر العلمنة المختلفة (بالتركيز على الحالة المصرية بصفة خاصة) التي أضحت تحديا في حد ذاته قائما في قلب المجتمعات الإسلامية تولدت عنه استجابة لازمة وهي الدعوة الإسلامية الحديثة والفاصل بين هذه المراحل – كما سنرى- هو درجة الاختراق الغربي ومن ثم درجة تأثيره على الأبنية الفكرية والمؤسسية خلال السعي لمحاولة إصلاحها.
وكان هذا يقتضي كما يقول البشري “..أن نستحضر قضية هذه المواجهة السياسية والعسكرية على مدى القرنين الماضيين.. إن هذه المواجهة..، قد شحذت همم المفكرين والقادة السياسيين العرب والمسلمين ليفتشوا عن مكامن قوة الغرب ويعملوا على نقلها ويفحصوا مكامن الضعف في أنفسهم، ويعملوا على تلافيها وجرى كل ذلك سواء في مجال الإنتاج والدفاع العسكري، أو في النظم والأساليب والأفكار والقيم. وكان من الطبيعي في مثل هذا السعي أن تتشعَّب وجوه النظر والمذاهب، وأن تختلف التيارات وتتنوع التجارب… ثم كان للقوة العسكرية والسياسية -المؤيدة بالتفوق العلمي والنظمي- ما اختلَّ به ميزان التقدير في أيدي مفكري العالم العربي والإسلامي وقادتهما من ناحية مدى قدرتهم على الاختيار فيما يأخذون من الغرب وما يدعون… ثم جاء الاقتحام العسكري والسيطرة السياسية التابعة بين الربع الأخير من القرن الماضي والربع الأول من القرن الجاري، فاضطربت تماما معايير الانتقاء لما يفيد العرب والمسلمين بين منجزات الغرب وشلت القدرة على التمييز بين النافع وغير النافع وانطمست الفروق بين التجديد والتقليد، وبين التغيير، وبين الإصلاح والإحلال …” (ص 8-9).
هكذا عبَّر البشري -بإيجاز- أولا عن تطور التحديات /الاستجابات في مرحلية تاريخية امتدت عبر ما يقرب من القرنين. ثم فصل بعد ذلك في دراسات هذا الكتاب حول هذه المراحل على النحو الذي يتبين منه المراحل التالية.
في المرحلة الأولى: مع بداية الأخذ عن الغرب لإصلاح مكامن الضعف (محمد علي، محمود الثاني) اقتصر الأمر على نقل العلوم العسكرية والطبيعية والنظم العسكرية “… ولكنها كانت واردة لتخدم كيانا سياسيا إسلاميا …ولذلك نجد أنه من غير الصواب الزعم بأن محمد علي أقام نظاما علمانيا أو أن تاريخ النظم العلمانية يبدأ بهذه الفترة …” ثم بدأت المحاكاة للغرب على عهد التنظيمات في الدولة العثمانية (1939-1876).
وهنا تبدأ المرحلة الثانية “… التي أخذ النفوذ الأوروبي يتغلغل خلالها في كل مجالات النشاط الاجتماعي السياسي والاقتصادية… حيث تدفق خلالها الوافد الأجنبي بشتى الطرق… وحيث ظهرت المحاكاة للغرب في وسائل… وحيث أضحت البعثات التعليمية تتجه إلى العلوم الإنسانية وبخاصة ما يتعلق بالآداب وما يتعلق بإعادة تربية الوجدان وصياغة العقول والرؤى الحضارية… (ولكن) في هذه الفترة كما نحاكي نماذج ولم نكن نحاكي فكرًا وعقائد. لذلك كانت المحاكاة (رغم علو موجتها) مدانة… لأن معايير الاحتكام السائدة في المجتمع والأطر المرجعية منه بقيت كما هي تصدر عن الأسلاف عقيدة وفكرًا وسلوكًا… كانت النهضة الوطنية الأساسي عن قاعدة إسلامية وكان الاستعمار وحلفاؤه المحليين متغربين في الأساس، وبقي الإسلام متصل الأواصر بنظام الحياة على مدى القرن التاسع عشر…”.
وتبدأ المرحلة الثالثة مع بدايات القرن العشرين حين بدأ الفكر الغربي يروج ممثلا في نظرياته السياسية والاجتماعية والفلسفية… أي أن الأمر صار أساسا نظريا وعقليا ووجدانيا متكاملا،صار صياغة جديدة غربية للعقل والوجدان، إعادة تركيب لماكينة التفكير والشعور… صرنا (بعد ذلك بعشرات السنين) ننتج (الأمر) إنشاء لأرض حضارية فكرية جديدة وغرسا جديدا ومعايير جديدة للتقويم والاحتكام.. قاعدة للشرعية ومناهج للفكر… (ولكن) لم تسر هذه الحركة بمعدل واحد في كل بلادنا الإسلامية والعربية… وجرى ذلك في نطاق الشرائح الاجتماعية والقوى السياسية ذات الاتصال بالمصالح الأوروبية، واستمرت الحركات والوطنية والرؤى الاجتماعية تصدر عن الأصول الإسلامية في السياسة وغيرها… بقيت التكوينات الفكرية والصياغات الوجدانية ورؤى المستقبل وتصورات المدينة الفاضلة للإنسان ومعايير التحاكم في السلوك والتعامل والتداول … استمرت كلها إسلامية (ص 8-20).
وبعد الحرب العالمية الأولى تدشنت مرحلة رابعة في تطور العلاقة بين الوافد والموروث أسماه البشري (الوطنية العلمانية) “…ففي العشرينيات من هذا القرن لم تعد العلمانية ولا نظريات الغرب محض شجيرات وافدة تعرس في أصص محمولة ولا محض أنشطة تفرضها إرادة الحاكم الأجنبي… لم تعد موظفة للصالح الأوربي لمعناه السياسي والاقتصادي، إنما آل قسم منها إلى مكافحة تلك المصالح وهذا ما أكسب هذا القسم شرعية الوجود في البيئة الإسلامية والعربية …” (ص 24).
وفي تلك المرحلة أيضًا وكاستجابة لهذا التحدِّي المتزايد الخطورة في هذه المرحلة “… بدأت الدعوة الإسلامية تتبلور في مناهج وأبنية تنظيمية لم يكن بقي من الأبنية السياسية القائمة ما يعبر عنها أو يمثلها… صار على هذه الدعوة أن تبني مناهجها وأنظمتها المستقلة بمؤسسات تؤكد على مقاومة الوفود وترسيخ الفكرية الإسلامية… ظهرت الحركة الإسلامية في ذلك الوقت كدعوة لاسترداد الأرض المفقودة أو الأرض المغزوة بالمعنى الفقهي والحضاري السياسي لذلك ظهرت كدعوة (لمطلق الإسلام) كنظام للحياة (ص 25-27)، وفي آخر حلقات التحليل المرحلي لظاهرة الوفود العلماني: كيف بدأ وكيف انتشر وكيف كانت جذور الأخذ عن الغرب استجابة لتحدي الضعف ثم تحولت -بتزايد الاتجاه العلماني- إلى تحدٍّ في حد ذاته احتاج بدوره لاستجابة جديدة. في آخر هذه المراحل انتقل البشري إلى دراسة القضايا التي تُبرز المواجهة بين تغلغل العلمانية من ناحية وأوجه القصور في الحركة الإسلامية من ناحية أخرى وتقع هذه القضايا في صميم التحدي الذي يواجه الفكر الإسلامي والحركة الإسلامية المعاصرة والتي تفترض الحوار الذي لم يصل إلى مراده بقدر ما تحول إلى حروب فكرية كما سبقت الإشارة.
وإذا كان موضوع الشريعة الإسلامية، والجامعة السياسية من أهم الموضوعات التي قال البشري في الكتاب الأول أنها أخطر ما يواجه البحث عن صيغة فكرية للعلاقة بين التيار الإسلامي وتيار الوحدة العربية (ص 11) وإذا كان قد تصدى إلى الجامعة السياسية في كتابة ذلك فإن الكتاب الثالث تصدى لموضوع الشريعة الإسلامية على النحو الذي يعرض زاوية أخرى من زوايا نظر البشري إلى إشكالية التحديات والاستجابة عبر قطاع طولي من التاريخ أيضًا.
وهذا العرض يبين كيف أنه منذ القرن 19 تفاعلت عبر مراحل تاريخية متتالية ثلاثة عناصر هي الجمود في الاجتهاد التشريعي، الحاجة إلى التجديد والإصلاح، الغزو الأوربي السياسي الاقتصادي والعسكري، على النحو الذي أدى إلى الاضطراب في البناء التشريعي وهياكله وأنساقه وهو الاضطراب الذي تبلور بدوره عبر عدة حلقات أو مراحل في ظل الغزو الاستعماري وخلال الاستعمار أو في عهد الاستقلال. وتحمل لنا هذه المراحل نفس ظلال المراحل التي استرضنا من خلالها زوايا النظر في الكتابين السابقين. وهي الظلال التي لو اجتمعت لسطرت الكلمات التالية: إن النقل والتقليد عن الغرب في التشريع ليس إلا طاقة مهدرة أفرزت كثير من السلبيات في مجال العلاقة بين القانون والمؤسسات (تفكيك النظم الوافدة -وللأواصر، وضربت ما يمكن أن نسميه الجامعية) وفي مجال العلاقة بين القانون والأخلاق وبين القانون والدين.
وإذا كان الجمود قد ساد قبل الغزو الاستعماري إلا أن موجات من حركات التجديد والإصلاح قد تعاقبت في النمو والظهور في أطراف الدولة العثمانية وليس في قلبها. ولقد تعاقبت في ظل ظروف مختلفة بحيث كانت كل منها – من حيث طبيعتها استجابة لطبيعة التحدي التي تجابه الأمة من جانب القوى الغربية (كما سنرى بالتفصيل لاحقا) (ص 5-32).
ولكن فيما يتصل بالتجديد الفقهي الشرعي بصفة خاصة فيتناول البشري في دراسة أخرى (43-44) مظاهر الضربات التي وجهت إلى تطبيق الشريعة الإسلامية منذ 1875 وكيف واجه الفقه الإسلامي تلك الضربة بانبعاث روح التجديد منه، لأنه فقه ينطوي على مادة عظيمة الخصوبة ودقة في الصياغة الفنية مدهشة وقابلية للتجاوب مع ظروف الزمن والمكان… ولكن يلاحظ بطء التجديد فيه عن حركة المجتمع”.
وهكذا يستمر البشري في بيان كيف تتوالى الاستجابات في مواجهة التحديات في مجال التشريع الإسلامي والتجديد فيه بمساراته ومناهجه المختلفة بصفة عامة أو في مصر بصفة خاصة (ص51-68).
ولعل أعظم النتائج التي تتبلور أمامي من مجمل تحليل البشري لهذا الموضوع وعلى مدار هذا العرض الطولي التاريخي هو ما يجيب عنه في دراسته تحت عنوان “هل غابت الشريعة بعد عهد الراشدين” (ص71-84)
فبالرغم من كل مشاكل الجمود وتحديات التجديد ومخاطر العلمنة فإن خلاصة هذه الدراسة تقول: لا لم تغب الشريعة بعد الراشدين وينبري البشري بقناعة شديدة وعمق شديد الأهمية لعلنا ننتبه إليها ونحن ننظر إلى أحوال الأمة بمقياس الشريعة/القانون الوضعي ولا أستطيع هنا أن أقتبس فقرات أو سطور من هذه الدراسة لتوضيح المشار إليه عاليا فالصفحات الخمسة عشرة التي تتكون منها الدراسة من بين أكثر الصفحات تكاملا بين دراسات البشري. ولا يمكن إلا الإحالة إليها فإن النقل منها لن يكون إلا افتئاتا عليها.
وإذا كان الكتابان الأولان قد ركزا على المواجهة بين الإسلام العروبة والإسلام والعلمانية وإذا كان الكتاب الثالث قد تمحور حول الشريعة الإسلامية والتشريع الإسلامي في مواجهة القوانين الغربية الوضعية فإن الكتابين الآخرين قد ركزا على موجات ودوائر الفكر الإسلامي المعاصر وعلى نحو يبرز أيضا إشكالية التحديات/الاستجابة.
وبالرغم من أن الكتب السابقة قد أشارت بإيجاز وفي مواطن متفرقة إلى بعض ملامح التجديد في الفكر الإسلامي في التاريخ المعاصر إلا أن الكتابين الآخرين أعطيا لهذا الموضوع درجة أكبر من التفصيل.
فنجد أن الكتاب الرابع تتصدره دراسة شاملة جامعة (ص5-30) تعرض باقتدار شديد للتطور في التحديات والتطور في الاستجابات الفكرية عبر عدة موجات من الفكر وعلى نحو يقدم – كما يقول البشري: “الملامح العامة لحركة تراكم الفكر السياسي الإسلامي في المرحلة التاريخية المعاصرة” ومن ثم إذا كانت قضية المجتمع المصدوع تسكن في خلفية هذه الدراسة باعتبارها أحد التحديات إلا أن الدراسة تنطلق من القاعدة الأساسية في فكر البشري والتي تعيد التذكرة بها من خلال العبارة التالية التي صدر بها البشري تحليله، يقول: “… نحن نختار هذا الطريق التاريخي لعرض مفردات الفكر السياسي الإسلامي في زماننا … لنوضح الظرف التاريخي الذي نبتت فيه أي ثمرة من ثمار هذا الفكر بالواقع من حيث الأعمال والمقاصد أي من حيث مدى احتياج جماعة المسلمين لفكرة حركية ملائمة في لحظة بعينها، ومن حيث توظيف هذه الفكرة لصالح الإسلام وجماعته في مرحلة ما. وهذا يوضح أيضا أن كثيرا مما نعتبره. خلافا في الرأي،..كان أساسه اختلاف الزمان والمكان. ولم يكن خلاف حجة وبرهان.. فإن ثمة حقائق إسلامية عليا ومصالح إسلامية عليا، ونحن كل في زمانه ومكانه -نتوسل إلى رعايتها وصيانتها وإعلائها بالعديد من المواقف الفكرية والحركية التي تتباين بتباين الظروف والأوضاع. ومن هنا ندرك أن كثيرا مما نسميه اختلافا هو إلى التنوع أقرب” (ص 11).
وهكذا ينتقل البشري في هذه الدراسة وكذلك في دراسة أخرى (ص 52-60) إلى استعراض عدة موجات متتالية من الفكر التي جاءت كل منها استجابة لتحديات ظرف تاريخي خاص.
الموجة الأولى شهدت حركة التجديد الفقهي والفكري من منتصف القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر، والتي صاحبتها موجة الإصلاح المؤسسي الأولى على نحو أفرز الانفصام بين الحركتين وإذا كانت الموجة الأولى بشقيها قد جاءت قبل الغزو الاستعماري وفي موجهة تحديات التقليد والجمود فإن الموجة الثانية بروافدها المختلفة منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين قد جاءت استجابة لمجموعة أخرى من التحديات وهي الغزو الأوروبي الذي أمسك بمنطقة القلب عن العالم الإسلامي (محور إسطنبول – الشام – القاهرة) وتراوح تغلغله من الاحتلال العسكري إلى الهيمنة السياسية والسيطرة الاقتصادية، إلى النفوذ الفكري والثقافي. وفي ظل هذه الظروف الجديدة جاءت الموجة التجديدية والثانية التي حملت وظائف جديدة تختلف عن وظائف الموجة الأولى. ولذا فإنه إذا كان فكر الأفغاني قد وضع اللبنات الأولى في فكرنا الإسلامي الحديث المقاوم للاستعمار فإن محمد عبده وضع اللبنات الأولى في الفكر المقاوم للقابلية للاستعمار والذي صار فكر محمد رشيد رضا امتدادًا له بعد وفاة محمد عبده. أما حسن البنا -في ظل تصاعد تحديات الفكر العلماني خلال عملية الكفاح الوطني ضد الاستعمار والتي ظهرت في هذه المرحلة في بداية العشرينات بصورة علمانية- فلقد كان مقدما لفكرة شمول الإسلام ولارتباط الفكر بالعمل، والدعوة التنظيم الحركي، والدين السياسية هو ما به تمثلت الاستجابة الإسلامية الصحيحة التي تطلبها الواقع عندما اتجهت حركة المجتمع إلى إضمار الإسلام وحصره وإقصائه عن أن يكون حاكما لنظام المجتمع وعلاقاته.
وعدا هذه الموجات الكبرى من الاستجابات المرحلية لتحديات متطورة ينتقل البشري -تدعيما لقناعته بأن كل فكر ما هو إلا إفراز لظرف تاريخي- إلى التمييز بين حالتين يواجه الإسلام في كل منهما حصرا وتضييقًا شديدين، ولكن يأتي رد الفعل في أحدهما عنيفًا وحادًّا (فكر أبي الأعلى المودودي وسيد قطب) في حين يأتي رد الفعل في الثاني في شكل الانتشار بالتسرُّب العقدي الهادئ (البعد عن الاحتكاك المباشر مع الخصوم ويبتعد عن السياسة وجوانب الإسلام الخاصة بنظم الحياة والشرائع، ويركز أعظم جهده على الجانب العقدي الإيماني والتعبدي، وغاية جهده أن يحفظ العقيدة والعبادة (سعيد النورسي في تركيا وجماعة التبليغ في الهند).
ويقول البشري في نهاية المطاف (ص30) “وهكذا كان الظرف التاريخي وأوضاع التحدي التي تقوم أمام الجماعة وأمام الإسلام، هي ما تولد أسلوب المواجهة للدفاع عن الإسلام بوصفه كيانا حيا، وهي التي تحدد وسائل الدفاع وأدواته”.
وفي الكتاب الخامس (ماهية المعاصرة) فإن فصوله وإن كانت تدور حول قضايا محدَّدة إلا أن ثناياها تعكس مرة أخرى ملامح إشكالية “التحدي / الاستجابة في ظل خصائص الظرف التاريخي” ولكن في إطار مختلف ولغاية مختلفة وهي “… اختيار مدى الملاءمة بين الصيغ العصرية الوافدة: للديمقراطية، الاشتراكية، القومية، الإصلاح الديني، وبين الواقع المعاصر وحركته في مجتمعاتنا… حيث نشأت جميعها وتعمل -فكرًا ونظمًا- في ظروف أوروبية غربية تغاير الظروف العربية الإسلامية التي تشمل مجتمعاتنا…” (ص 24).
ولهذا فحين يناقش البشري فكر الإصلاح الديني (ص 26-34) فهو يقسم تيارات الإصلاح التي تصدت لمشكلات البيئة الإسلامية إلى “ما هو ضال وفاسد، وما هو مستجيب للمشكلات الحقيقية والتحديات الأساسية للواقع الإسلامي”، ويضع البشري السيد أحمد خان السياسي الهندي في خانة ما يسميه “الوافد الضال..” لأنه كان يسعى لتذويب الشعوب في مستعمريهم.. ولأنه أخضع الإسلام والقرآن لما أسماه “العقل والعلم الحديث، وجعلهما محكومين بهذين الأمرين وليسا حاكمين لهما، فأبدل الموزون والميزان وجعل الميزان هو العقل الأوربي والعلم المعاصر، وجعل الموزون هو الإسلام والقرآن بدل أن يكون العكس… ووجه الضلال في هذا الإصلاح، أنه يتغافل عن أهم ما يهم من خصائص الدعوة الإسلامية الإصلاحية، وهو أن تكون استجابة لما يواجه الأمة من تحديات، وأن تكون استجابة متناسبة مع نوع التحدي المطلوب ومع حجم التحدي الذي يتهدد الجماعة..” كذلك يتبادل البشري كتاب “الإسلام وأصول الحكم” باعتباره نموذجًا آخر على الإصلاح الديني الضال، أما أوضاع الإصلاح الرشيد فيتناول البشري أمثلة لها ما يلي: “جمال الدين الأفغاني في مجال الإصلاح الديني، ومحمد إقبال على الصعيد الفكري الفلسفي، ابن عبد الوهاب في الجانب الفقهي ووجوه الإصلاح الرشيد فعالة لأنها صدرت عن الاستجابة الصائبة للتحديات الحقيقية التي كانت تواجه الجماعة الإسلامية… ربط الأفغاني بين الإسلام وحركة مقاومة الغزو الاستعماري… وقرر إقبال وأمثاله واحدية الدين وشؤون الدنيا، وواحدية الجماعة والفرد، وعمل على أن يجنِّب الجماعة الإسلامية تلك الثنائية التي تقيم التعارض وتقيم الصراع بين جوانب حياتنا المتعدِّدة، وقرَّر ابن عبد الوهاب وإقبال طريق تجديد الفقة الإسلامي، وطريق تحرير الإرادة الإنسانية للمسلم في إطار حاكمية الله والتوحيد الإسلامي الخالص…”.
وعلى صعيد تناول البشري لقضية الفكر القومي (ص 35-40) وانطلاقًا أيضًا من قوله عن “… قياس المفاهيم والدعوات السياسية بمقياس الصلاح والفساد يف مقارنة التحديات الأساسية والمشكلات التي تواجه الجماعة المعنية” نجد البشري يميز أيضا بين مجموعتين من الأفكار القومية التي ظهرت بين العرب وهما ضال وفاسد أو رشيد وحميد. ومثال النوع الأول في تقدير البشري هو نجيب عازوري لأنه ذو فكر تفتيتي انفصالي تابع ولذا يحذر البشري من وضع فكره ودعوته “… في إطار دعاوى القومية العربية التي تفترض أنها ترمي إلى تشكيل وطن عربي واحد، وأمة واحدة ناهضة مستقلة”.
أما المثال عن الفكر القومي الرشيد الحميد فيضرب البشري عليه المثل برفيق العظم. ففكره توحيديا تجميعيا يجمع بين الرابطتين الوطنية والدينية.
وفي نهاية التفكر في هذا الجانب أي الأعمدة الأساسية من فكر البشري، تجدر الإشارة إلى أن البشري قد قدَّم هذا العرض الطولي التاريخي لإشكالية التحديات/الاستجابة سواء من منظار العلاقة بين الإسلام والعروبة، أو الإسلام والعلمانية، أو التشريع الإسلامي، أو الملامح العامة للفكر السياسي المعاصر، وكان حريصًا في ذلك كله على التأكيد على أن هذه الاستجابات المرحلية هي في نطاق “المتغير” والذي لا ينفي “الثابت” في الإسلام بالرغم من تغيُّر العصور، ومن هنا كان “منهج وأصول النظر العقلي في إدراك العلاقة بين الثابت والمتغير” من أهم الجوانب المنهجية التي حرص البشري على إبرازها في أكثر من موضع في كتبه الأربعة (مثلا: دراسة الإسلام والعصر ك: 4، ص 47-52، ودراسة: شمولية الشريعة الإسلامية وعناصر الثبات والتغير ك: 3، ص 99-114). وهو الأمر الذي سنجدد الإشارة إليه في موضعه من المكون الرابع من مكونات بناء فكر البشري في هذه السلسلة، والخاص بالملامح المنهاجية.
ثالثًا- جدران البناء: المفاهيم والتعبيرات
تضمن التصميم الأول لهيكل الورقة أربعة مكونات للبناء. كان ثالثها يختص بما أسميته جدران البناء التي تصل بين القاعدة والأعمدة، كما تضمن المتن الأول لهذا التصميم الإحالة إلى الصفحات التي تحتوي النماذج التوضيحية لطبيعة أعمدة البنيان وقواعده الأساسية.
وحيث تبين أن مثل هذه الإحالات قد أفقدت الورقة الكثير من المضامين التي اعتملت في ذهني عند القراءة وعند الكتابة؛ لهذا جاءت الصياغة النهائية للورقة متضمنة –بقدر الإمكان- هذه النماذج التوضيحية في مواضعها من الأجزاء الأول والثاني والرابع. ومن ثم وجدت أن التوقف هنا في هذا الجزء من الورقة عند المكون الثالث للبناء –أي القضايا الأساسية في فكر البشري- لن يكون إلا تكرارًا لما ورد في النماذج التوضيحية. ولذا فكرت أن أقتصر هنا على بيان موضوعات الدراسات التي احتوتها الكتب الخمسة، والتي استقينا منها النماذج التوضيحية السابق وعرضها من ناحية. كما أتوقف من ناحية أخرى –انتقاءً وليس حصرًا- عند بعض التعبيرات التي تمثل جملة من المفاهيم المهمة ذات دلالة ولم يتطرق إليها العرض في الأجزاء الثلاثة الأخرى. وتكتسب هذه التعبيرات أهمية خاصة إذ تمثل حججًا عقلية ومنطقية بالغة الأهمية نحن في أمّس والحاجة إليها لتدعيم حالة الحوار مع الآخر، وقبل ذلك لتدعيم حالة الفهم للوضع الراهن للذات في مقابل هذا الآخر، ووجدتُ أن هذه التعبيرات التي انتقيتها والتي تتصل أساسًا بأوضاع الظرف الراهن الذي نعيشه بكل معضلاته وبكل إشكالياته المتداخلة. هي من التعدد والكثرة بحيث يصبح نقلها هنا في هذا الموضع –وعلى النحو الذي يحقق الغاية منه- بمثابة نقل جل محتوى الكتب الخمسة. ولذا فقد كان البديل الأمثل من وجهة نظري هو الدعوة لقراءة هذه الكتب، ليس فقط للتعرف على فكر البشري –بأعمدته وأساسه ومنهاجه الذي جرينا على استكشافهم في هذه الورقة- ولكن للاستزادة من الصياغات والتعبيرات العميقة الرصينة؛ فهي لا تشرح مفاهيم وقضايا شائكة بعبارات سهلة متماسكة فقط، ولكن البشري يقدمها في قوالب لغوية وأدبية عريقة وعميقة تدل على التمكن من ناصية اللغة. نجد أن البشري لا يكتب كلمات وإنما يرسم صورًا حية واضحة المعالم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذه القراءة المباشرة التي أدعو إليها إنما تبين لنا –ما أيقنته عند القراءة- لماذا يستحق البشري أن يوصف من البعض بالحكيم(*). فإن لغة خطابه لا تتسم بالعنف والمواجهة والرفض ولكن ينفسح فيها للآخر –مكانًا رحبًا للحوار معه؛ سعيًّا نحو رأب الصدع وتكوين التيار الأساسي للمشروع الوطني.
فبالرغم من اجتياح العلمانية –كما يشخص البشري- فإن الإسلام ما زال قائمًا والذود عن الأصول والثوابت عملية مستمرة لا تقف مهما قيل عن الجمود في الاجتهاد التشريعي.
وبالرغم مما يقال عن المواجهة بين الإسلام والعروبة إلا أن المشترك بينهما –كما يرى البشري- أكبر، ودواعي التآلف وعدم النفي المتبادل قائمة.
وبالرغم من الاضطراب التشريعي فإن الشريعة باقية، وبالرغم من ضغوط المعاصرة فمازال للذاتية وجود… وهكذا يصب في الرافد الأساسي لفكر البشري ثنائيات عديدة تعبر عن وسطيته. وهذه الوسطية –وهي من أهم المعالم المنهاجية التي تتبدى في لغة خطابه الذي تتشيد به جدران البناء.
رابعًا- بعض الملامح المنهاجية
ولقد شيَّد البشري البناء الفكري استنادا إلى منهاجية متميزة تناغم وطبيعة البناء بأعمدته وقواعده وأحجاره. وتعكس هذه المنهاجية التزاوج بين خبرة البشري كمؤرخ وخبرته كفقيه.
ويتلخص أهم هذه الملامح المنهاجية فيما يلي الأمة مستوى التحليل توظيف التاريخ وأساليبه، والربط بين الفكر والواقع القائم في ظل طرف تاريخي، التمييز بين الثابت والمتغير في الإسلام وأخيرا أساليب الصياغة والتعبيرات المحكمة؟ المفاهيم وفيما يلي قدر من التفصيل حول كل ملمح من هذه الملامح:
1- إذا اعتبرنا أن تحديد مستوى التحليل والمعالجة للقضية موضع الاهتمام أحد الملامح المنهاجية فيمكن القول أن تحليل البشري في هذه السلسلة إما تم على مستوى الأمة وليس دول بعينها يمتد إلى مستوى الشعوب والجماعات ولا يقتصر على النظم والحكومات فقط وإذا توق عند بعض الخبرات المحددة -وخاصة في الحالة المصرية – فذلك لا يكون بانقطاع عن السياق العام الذي تنتظم في نطاقه وتمثل أحد أجزائه. وإذا كانت التجربة المصرية – وفي قلبها قضية الأقباط هي بمثابة المنطلق لفكر البشري في هذه السلسلة (الكتاب الأول) فإن تحليلها لم ينفصل عن “الإسلامية” باعتبارها الإطار الأشمل للمصرية والعروبة. ثم انتقل البشري إلى ساحة أرحب وهي الأمة الإسلامية وإلى الفكر الإسلامي والشريعة الإسلامية والحركة الإسلامية في إمداداتها الجغرافية والمكانية عبر أرجاء الأمة لتتبلور رؤية مقارنة لقضايا وللتحديات والاستجابات المشتركة أو المختلفة على حد سواء.
بعبارة أخرى فإن اعتماد البشري لمستوى الأمة كمستوى أساسي للتحليل انعكس في تقديمه دائما أو في معظم الأحيان على الأقل لأطر مقارنة بين المناطق الكبرى العربية والإسلامية (حول الزوايا المختلفة للنظر السابق شرحها فيما يتصل بأعمدة البناء أو قواعده) ولقد أبرزت هذه المقارنة مغزى فقه الواقع، ومغزى الظرف التاريخي الزماني والمكاني على نحو يفسر حالة التنوع في نطاق الوحدة أو حالات الخلاف حول المتغيرات وليس الثوابت. ولسنا هنا في حاجة لطرح الأمثلة ولعل الرجوع إلى ما سبق عرضه في الأجزاء السابقة من الورقة من أمثلة يكفي لبيان ما قصدناه.
ومن ناحية أخرى هناك مؤشرات أخرى -عدا الإطار المقارن- يتبيَّن منها كيف أن الأمة هي التي تشغل فكر البشري ومن بينها على سبيل المثال وليس الحصر:
عدم إنكار الانتماء القومي والوطني ولكن يبرز أن الولاء للجماعة الأشمل استخدامه لمصطلح الجامعة الإسلامية والجامعة السياسية الأشمل، وأخيرا نتوقف عند تحليله الذي يبين كيف أن الشريعة مازالت حاكمة ولم تغب بعد الراشدين حيث يتبين في هذا التحليل كنه الرابطة بين الأمة فهو يقول: “… إن الشريعة ليست نظام حكم فقط، والعلاقات القانونية المستمدة من الشريعة، والتي كان الفقه الإسلامي يفرع التفاريع على أصولها، هذه العلاقات تغطي كل أنواع الأنشطة البشرية في المجتمع… وإذا كان الحاكم قد ابتعد عن التطبيق المثالي للشريعة، أو أنه غالى في الابتعاد… فهل هذا يكفي للقول بأن السياسة كانت معبرة عن الدين؟ أو هل السياسة ملك للحاكم وحده؟!… إننا هنا لا نتكلَّم عن سلطان بذاته أو دولة بعينها، ولكننا نتكلم عن مجتمعنا وشعبنا، عن أمتنا عبر مراحل تاريخية طويلة ممتدة… والشريعة الإسلامية لم تُفرض من عل إنما تمَّت مع شيوع الإسلام بين الناس وانتشاره في الأصقاع… إن من أسباب الخطأ في تجلية هذه الأمور، أن كتاب اليوم… يضمرون بذلك نظرة لا تفرِّق بين المجتمع والدولة… فنحن عندما نبحث عن الشيعة لا ينبغي أن نفتِّش عنها في دواليب الحكَّام وحدها ولكن يجب أن ننشرها في الأزقة والحواري والنجوع والدساكر والحصص والواحات” (ك: 3، ص 82-84).
ويقول في موضع آخر (ك: 1، ص 68) “… إن توحيد الشرائع على مستوى الوطن العربي لا يتصور في ظني إلا أن يكون آخذا من الشريعة الإسلامية. كما أن الاحتكام للشريعة الإسلامية كشريعة موحدة للوطن العربي، له وظيفة جامعة بالنسبة للأقليات القومية غير العربية في الوطن العربي”.
بعبارة أخرى فإن اهتمام البشري بموضع قيام الشريعة كشريعة حاكمة في التاريخ الإسلامي والتصدي لهؤلاء الذين يجوبون – كما يقول في منطقة بور هي التي يدور فيها النقاش حول: هل وجدت الشريعة في حياة المسلمين أم لم توجد؟- هذا التصدِّي من أبرز ملامح المنهجية البِشْرية التي تتحرَّك على مستوى الأمة، فهذه الشريعة هي الواسطة الأساسية بين أجزاء هذه الأمة مهما اختلفت وتنوَّعت الأبعاد الأخرى وينبثق عن هذا الملمح الأساسي المعني بالأمة ولا تنفصل عنه كل الملامح التالية وخاصة المتَّصلة بالتاريخ.
2- يتسم منهج البشري بتوظيف عميق ومتعدد الأبعاد للتاريخ:
أ- فهو من ناحية أخرى يقدِّم رؤية كلية لتاريخ العصر (القرنيين التاسع عشر والعشرين) في مراحله المتتالية ومجالاته المختلفة دون انفصال أو توازي أو انقطاع ولكن في ترابط وتواصل وتفاعل على نحو يبين مقولة “وحدة تاريخ الأمة” ومن ثم خطورة النظرة التجزيئية القطرية للتاريخ الإسلامي وخطورة إلحاق هذا التاريخ وتبعيته في ظلِّ مقولة وحدة التاريخ العالمي. ولعلَّ الأمثلة التي سبق عرضها في الأجزاء السابقة تعطي دلالة عن هذه الكيفية لتوظيف التاريخ في تحليلات البشري ونكتفي هنا بالإحالة إلى إحدى مقولاته (ك: 3، ص 90) حيث يقول: “إن أساس النظر عندي أن ثمة أصولا وإطارًا مرجعيًّا أرى وجوب الحفاظ عليها وهي إن نظرنا إليها على المستوى الفلسفي وجدناها ذات أساس إيماني، وإذا نظرنا إليها على المستوى الاجتماعي والحضاري وجدناها قوائم ارتكاز تتجمع عليها وجوه إدراك الهوية والشعور بالانتماء لدى الجماعة… إن تجريد مراحل التاريخ البَشري من تلك الخصائص الحضارية المميزة لكل من الشعوب يطمس ذاتيتها، ويفتح الطريق لحضارة الغرب الغالبة التي تَفِدُ بحسبانها تقدُّمًا وعصرية وحداثة، وبحسبان تاريخ الغرب هو معيار التاريخ البشري كله وبحسبان أن حاضره هو مستقبلنا وأن واقعه هو مدينتنا الفاضلة.
ب- ومن ناحية أخرى، يعيد البشري قراءة التاريخ ويعيد تفسير ما قدمته منظورات أخرى قومية أو ليبرالية في بعض القضايا المهمة الكلية والجزئية على حدٍّ سواء.
فعلى صعيد القضايا الكلية نجد أن الدولة العثمانية احتلَّت اهتمام البشري، وكذلك دولة محمد علي وعلاقتها بالدولة العثمانية. ولا يقدِّم البشري دفاعًا حماسيًّا عن الدولة العلية ولكن يدعو إلى تفهُّم وظيفتها التاريخية وأوضاعها ومشاكلها بصورة أكثر موضوعية، ولذا فهو يعتبر التاريخ العثماني مثالًا على ضرورة إعادة كتابة التاريخ من غير موقع التبعية الفكرية الذي هو حاث عند تناول كثير من أمور تاريخ هذه الدولة، ومع ملاحظة التمييز بين النظرة التحليلية التي تعاصر الحدث في سياقه التاريخي والاجتماعي والسياسي وبين النظرة البعدية للحدث والذي تراه من بعد فيما ترتَّب عليه من آثار لم يحدِّدها ولم يرسمها ولا قصد إليها صانعو الحدث، وإنما ترتَّبت نتيجة توظيفه في ظروف أخرى متغيِّرة.
ومن ثم يقدِّم البشري بناء على هذه الضوابط المنهاجية رؤية عن بعض الأمور الخاصة بالدولة العلية وكذلك دولة محمد علي. ونذكر منها على سبيل المثال ما يلي: فمن ناحية يناقض القوميين الذين يصبون الفكرة الإسلامية في وعاء الدولة العثمانية بغية تشخيص الفكرة ليسهل ضربها من خلال ضرب المشخص لها حيث ينسبون إلى هذه الدولة كل النقائص. ولذا فهو ينقض مقولة القوميين أن انهيار هذه الدولة قد حرَّرَ العرب. حقيقة اعترف البشري أن في هذه الدولة كثيرًا ممَّا يستحق الشجب، وخاصة أنها فشلت في الدفاع عن الحوزة الإسلامية في عهدها الأخير، وفتحت الباب للمصالح الاستعمارية إلا أنه رفض أن تكون دولة تشخص الإسلام وقيمه ومعتقداته، كما رفض أن يكون انهيارها قد حرَّر العرب؛ بل يقول إنه قد صحب هذا الانهيار تفتيت العرب وتناثرهم وسقوط الدولة العربية فريسة الاستعمار الأوروبي الغربي (ك: 1، ص 30-32).
وفي موضع آخر (ك: 3، ص 78-80) يشير البشري إلى الوظيفة التاريخية -عميقة الخطر- التي لعبتها الدولة العثمانية في مرحلة قوَّتها، وذلك في التصدِّي لخطر تطويق العالم الإسلامي من الجنوب والتصدِّي للزحف الأوروبي من الأندلس إلى شمال أفريقيا، كما يقول: “… لا أظن أن من الإنصاف، ولا أنه من العلم، الحكم عليها بمعايير زمان لاحق عليها ولا تعميم الحكم عليها وفقا للصورة التي آلت إليها في شيخوختها. وأي دولة لا تشيخ بعد كل هذه القرون الطوال؟.. وعندما يذكر أحدنا قوة هذه الدولة في عهد فتوتها، فليس من الإنصاف وصفه بالفاشية وتصويره كمن يصفق للقوة المعتدية الظالمة، لأننا نتكلَّم عن هذه القوة بوصفها جامعة حافظة للإسلام وجماعته ولشعوب هذه المنطقة ولغتهم وثقافتهم”.
وفي موضع ثالث (ك: 5، ص 15-25) يناقش البشري ما أسماه المثل العثماني للديمقراطية الضالة في عصر التنظيمات، ولقد اجتهد خلال هذه المناقشة -كما يقول- أن يصدم الرؤوس بأحداث بالغة الشذوذ والقسوة تتعلَّق بغايات نبيلة: إصلاح الجيش وحماية الحوزة، وتحقيق الديمقراطية في مواجهة الاستبداد. ولكنها جميعا لم تتحقَّق لأنها كانت أنماط من الإصلاح الضال الوافد والتي قادت إلى العكس، في حين أن “.. كثيرًا من الباحثين والمفكرين يقوِّمون هذه الأحداث بحسبانها من حركات الإصلاح والنهوض والتجديد… ويَصِمُون معارضيها بالتخلُّف والجمود والانحطاط.. (لأنهم) لا يبالون بأثر نقل النموذج في حالة اختلاف الإنسان وأثر اختلاف الوظيفة المؤدَّاة مع اختلاف الظروف”.
أما عن قراءة البشري لتاريخ مصر -دولة محمد علي- فنجد أن من أهم ما أعاد البشري مناقشته من مقولات شائعة مقولتين مرتبطتين وغير منفصلتين وهما تمثلان وجهي عملة واحدة، تلك المتصلة بطبيعة الدولة إسهامًا في العلمنة من ناحية وعلاقتها بالدولة العثمانية (الوطنية المصرية في مواجهة العثمانية الإسلامية). وهما مقولتان مرتبطتان.
فمن ناحية يبيِّن أنه إذا كانت تجربة محمد علي في الاستقلال بمصر شروعًا في إحياء الإمبراطورية العثمانية على يديه قد أدَّت به إلى تشكيل نخبة حكم من عناصر منفصلة نسبيًّا عن الجماهير، وإذا كانت صلة هذه التجربة بالغرب مبكرًا في إطار السعي للتحديث قد تولَّد عنها تدريجيا طوال القرن التاسع عشر ظاهرتا الازدواج والانفصام بين الوافد والقديم في ظل تسرُّب النفوذ السياسي والاجتماعي والثقافي (ك: 1، ص 40-50) إلا أنه يشرح في موضع آخر (ك: 2، ص 10-14) كيف أن محمد علي -وهو في ذلك يورد ما ذكره د. شفيق غربال في كتابه “محمد علي الكبير- بدأ وعاش وانتهى عثمانيًّا مسلمًا… لم يخلق محمد علي ثنائية في معاهد التعليم… ولم تعرف أيام محمد علي ثقافة عربية إسلامية في كل مكان… كانت بعثات محمد علي إلى أوروبا تتجه أساسا إلى ما يمكن تسميته بعلوم الصنائع وفنونها… اهتم الوالي في تدريب جنده بالجانب الديني والتأكيد على فكرة الجهاد في الدعوة بينهم… لذلك نجد أنه من غير الصواب الزعم بأن محمد علي أقام نظاما علمانيا أو أن تاريخ النظم العلمانية يبدأ بهذا الفترة…”.
ومن ناحية أخرى، وعن الجامعة السياسية المصرية بوصفها أنها تعتبر أوضح رموز العلمانية السياسية فيؤكِّد البشري أن ما تفتَّق عنه مشروع محمد علي من بدء تكوين الجماعة السياسية المصرية في أساسها العلماني لم يكن ذلك من صنع محمد علي ولا من قراراته السياسية ولا كان مما يستهدفه من تكوين جيشه من جنود مصريين، ولا كان ذلك مما يترتب -أو من شأنه أن يترتب حتمًا- على سياسات محمد علي في ظروف تقرير هذه السياسات. إنما نتج ما نتج بسبب تغير الوظيفة المؤدَّاة بتغيُّر الظروف… بل إن الجامعة السياسية القومية جرت على مدى القرن التاسع عشر بغير عراك مع العقيدة الإسلامية ولا يبدو أن المصرية ظهرت وقتها كدعوة للانفصال عن أية جامعة أشمل… كما لا يبدو أن الموقف الإسلامي ضاق بهذه الحركة” (ك: 2، ص 12-14).
بعبارة أخرى فإن البشري يرى أن وقائع تاريخ تجربة محمد علي تبين أن بغيته كانت دولة الخلافة ومؤسسة الحكم هناك وليس مجرد إقامة دولة مصرية أو عربية ولذا فإن مناقشة البشري للتلازم التاريخي بين بناء الدولة الحديثة على عهد محمد علي وبين بداية تكوين الوطنية المصرية في هذا العصر (ك: 1، ص 87-92) إنما يبرز أمرين يدعمان موقفه من أن دولة محمد علي لم تكن تريد الانفصال أو الاستقلال عن الدولة العثمانية ولذا فهو يقول “.. كان الإسلام هو الجامع الذي يربط دولة محمد علي بدولة الخلافة… وأن عملية التمصير التي بدأت في الجيش ثم الوظائف العامة كانت تجري في إطار من مفهوم الجامعة الإسلامية العثمانية… وأن المصرية -على مدى القرن التاسع عشر- لا يبدو أنها ظهرت كانفصال عن الجامعة الأشمل إمنا ضربت عليها العزلة ضربا من قبل الدول الكبرى وقتها مما ظهر في معاهده لندن 1840.
ولقد ظهر هذا التوجُّه أيضًا في فكر البشري عند مناقشته بعد ذلك (ص 92-100) نمو الاتجاه العربي لمصر منذ بداية القرن العشرين حيث إن الوعي المصري تفتق عن أن الحفاظ على المصرية لا تكفله الجامعة المصرية وحدها وأن درء الخطر عنها لا يكفله إلا الانتماء إلى جامعة سياسية أعم إسلامية كانت أو عربية.
أما بالنسبة للقضايا ذات الطابع الجزئي التي اهتم البشري بإعادة قراءة التاريخ حولها فيمكن أن نذكر المثالين التاليين:
الأول خاص بمغزى الحملة الفرنسية والثاني خاص بوضع أهل الذمة ثم عن وضع أقباط مصر.
وهو يقول بشأن حملة نابليون “… لا أظن أن بلادنا ينتظرها خير ما في ضوء نظرة تحسب الغازي هو ناقل الحضارة والمخرج لنا من الظلمات إلى النور. إن حملة نابليون حملة استعمارية واحتلالها مصر هو غزو مسلح كوفح بما يستحق وبما يجب أن يواجه به من شعوب حرة… والحملة الفرنسية هذه لم تستجب لمبادئ ثورتها الإنسانية عندما وضعت سليمان الحلبي على الخازوق وما صنعه أبناء الثورة الفرنسية في الجزائر معروف مشتهر” (ك: 1، ص 76).
أما المثال الثاني فهو الخاص “بأهل الذمة” وقد ورد في تعقيب للبشري على دراسة قدمت في الندوة عقدت 1980 تحت عنوان القومية العربية والإسلام، وهي الدراسة التي وردت تحت عنوان “الإسلام والمسيحية العربية والقومية العربية العلمانية” وفي هذا التعقيب رد على ما أثير في الدراسة عن وجود “عقلية الذمة في نفوس اليوم نتيجة ما ترسب عن ظروف المسيحيين العرب في عهود الحكم الإسلامي” يقول البشري: “… في النظر إلى التاريخ ينبغي الالتزام بالمنهج التاريخي بمراعاة ظروف الزمان والمكان في تقييم الوقائع والأحداث… والجانب الفكري في نظام الذمة يتعيَّن ألَّا يرد معزولا عن سياقه وتفاصيل أحكامه.. إننا لا نريد لأحداث وفكريات السلف أن تتحول في الأيدي إلى أشباح يفزع بها البعض بعضًا… ولن نتقدم قط ما استمر مسيحيونا يذكرون (اللباس الخاص) في بعض السنين، وما استمر مسلمونا يذكرون “الجنرال يعقوب” ومن غير الإنصاف أن يجري تعميم الأحداث العارضة في محاولة للترسيخ في ضمير المواطن المسلم أن في ماضيه ما يشين، وأنه لا مساواة ولا ضمان للمساواة إلا بأن يفقد المواطن المسلم إسلاميته. إن ذلك يستند إلى دلالة تاريخية مغلوطة، ويبني عليها مطلبًا غير عادل وغير عملي ولن ينجم عن ذلك إلا نمو الاستقطاب، فيفقد البعض هويته، ولدينه سهم في قيامها، ويستنفر البعض دفاعًا عن إسلاميته، والجميع يرى بالمعايشة سرعة ازدهار الحركات السياسية الإسلامية، والكل ينبغي أن يدرك ما تمليه موازين القوى البشرية” (ك: 1، ص 77 – 78).
ولذا ينتقد البشري من جانب آخر الدراسة لتقريرها الجازم بإيجابية المناخ الذي ساد في القرن التاسع عشر، ونصف القرن العشرين، وهي ذاتها مرحلة التوغل الغربي في وطننا، ولذا لا يستعجب أن تتسق الدراسة في هذا مع نظرتها إلى حملة نابليون الكبرى وإلى “الأثر الإيجابي” للضغط الأوروبي على الدولة العثمانية، وفي تقريرها مساواة المسيحيين بالمسلمين. ولقد كان تعقيب البشري على هذه الدراسة –كما ذكرنا في موضع سابق- من أهم النماذج على مناظرة البشري –من منظور إسلامي- مع المنظورات الأخرى القومية والليبرالية حول وضع الأقباط في مصر والدول العربية، وهي المناظرة التي وإن حرص عليها البشري إلا أنه لا يتخطى خلالها حدود الأصول والثوابت التي لا يمكن النكوص عنها.
ج- من ناحية ثالثة فإن توظيف البشري للتاريخ يهدف إلى تعميق فهم الحاضر. فإن إعادة القراءة للتاريخ أو الاستعراض الطولي المرحلي للتاريخ المعاصر (القرنين الثامن عشر والتاسع عشر) ليس غاية في حد ذاته لدى البشري بقدر ما هو وسيلة لفهم الحاضر. وبذا يتضح أن البشري على هذا النحو لا يبدو لنا مؤرخًا تقليديًّا، ولكنه مؤرخ سياسي واجتماعي؛ يسعى نحو أطر التحليل والتفسير والتقييم التي لا ينفصل فيها عن واقعه المعاش، ولكنها تستمد رحابتها وعمقها من مدلولات التاريخ وخبرته. إذن البشري يستدعي التاريخ لتدعيم الفهم للحاضر وتعميقه، ولقد نوه البشري إلى هذه الغاية في المواضع المتعددة التي لجأ فيها إلى العرض الطولي التاريخي. إنه عند مناقشته للعلاقة بين الإسلام والعروبة قد أكد على أهمية البحث عن سبل التلاقي والتقارب وليس التنافي والتنافر فهو يقول (ك: 1، ص 17): “… إن المجال المشترك في ظني عميق متسع، إذا نظرنا إليه من وجهة التاريخ أو الجغرافيا السياسية أو التكوين النفسي والثقافي… إن ما يريد أن ينبه إليه هذا المقال ليس جديدًا ولا مبتكرًا؛ إنه قديم قدم القرن التاسع عشر، جديد جدة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين. وتاريخنا في هذا الإطار يمدنا بوجوه عزيزة للتقارب والترابط، وما كان يظهر عراك بين الجامعتين في ظني لولا أن ظروف الواقع الحاضر وملابساته تعمل على طمر تلك الخبرة التاريخية وطمس دلالتها…”.
وفي موضع آخر (ك: 2) من منطلق اقترابه زمن الحوار الإسلامي العلماني، والذي قدَّم بصدده مراحل تطور الوفود العلماني قبل أن يتصدَّى لقضايا هذا الحوار الراهنة، نجد البشري يقول (ص 8): “إن الحديث عن مستقبل الحوار يعني الحديث عن علاقة الطرفين المتحاورين، من حيث هي صيرورة ومآل، وما دمنا في مجال الضرورة فلا بد من الحديث عن الماضي وعن أصل المشكلة، وما طرأ عليه من بعد”.
ومن منطلق تناوله أيضًا للتحديات التي تواجه الأمة في ظروفها الراهنة والاستجابات المطلوبة (ك: 5، ص: 7-14) يقول البشري: “… كل ذلك يستوجب الوقوف لتأمل التجارب والصيغ وحصيلتها. إن الوضع الفكري الراهن يمثل –في تصوري- وقفة تاريخية للمراجعة والتدبر… وإعادة الكشف عن المورد الفكري والحضاري للمقاومة ولمشروعات الاستقلال والنهوض” (ص 8).
وفي الكتاب الرابع ومنذ السطور الأولى منه يقول البشري: “… أتصور أنه لكي نتلمس رؤية المستقبل للحركة الإسلامية، يحسن بنا أن نطالع ملامح الوعاء الزمني الذي تعمل فيه هذه الحركة، والزمان المعاصر في تاريخنا يتكون من هذين القرنين الأخيرين، وقد شارف القرن الثاني منهما على نهايته، وصرنا على مشارف قرن ثالث، يبدأ معنا بالملامح عينها التي صبغت تاريخنا المعاصر منذ بداية القرن التاسع عشر” (ص 5).
ويقول في موضع آخر: “… ونحن نختار هذا الفكر السياسي الإسلامي في زماننا إنما نفعل ذلك وأعيننا على الحاضر، ولنوضح الظرف التاريخي الذي نبتت فيه أي ثمرة من ثمار هذا الفكر” (ص 11).
بعبارة أخرى لم يكن توظيف التاريخ لفهم الحاضر لينفصل لدى البشري عن توظيفه من أجل غاية أخرى وهي فهم الرابطة بين الفكر والواقع، وهذا يقودنا إلى الملمح الثالث من ملامح منهاجية البشري في هذه السلسة.
3- الرابطة بين الفكر والواقع (حركة أو حدثًا أو تنظيمًا…): تعد –هذه الرابطة- من أهم الملامح المنهاجية لدى البشري. فهو لا يتناول الأفكار –فقهية كانت أم فلسفية أم سياسية اجتماعية- مجردة ولكن في سياقها التاريخي زمانًا ومكانًا.
أ- وقد سبق أن أوردنا في مواضع مختلفة (وخاصة في الجزء الثاني الذي يقدم إشكالية التحديات / الاستجابات باعتبارها قاعدة البناء) نماذج توضيحية عن هذه العلاقة بمستوياتها المختلفة التي أحاط بها تحليل البشري. وهما أساسان مستويان:
المستوى الأول- ويلخصه البشري في كلمات جامعة في نهاية دراسته تحت عنوان “الإسلام والعصر: ملامح فكرية وتاريخية” (ك: 4، ص 47-61) وهو يقول: “1-… إن هذا الفكر –كما يتراءى لنا- هو حصيلة استجابات تاريخية للعصر الحاضر، ولهذه المرحلة من حياة الجماعة الإسلامية، وهو حصيلة تراكمت عناصرها واحدًا واحدًا عبر تنوع الأوضاع التاريخية والإقليمية في العصر الحاضر… 2- إن الخلافات بين الاتجاهات المختلفة التي ظهرت في هذه المرحلة، إنما هي في أساسها خلافات بين مواقف تفتقت عنها الحاجة التاريخية والاجتماعية فهي… خلاف فكري أساسه خلاف الزمان أو المكان، أو خلاف الرؤية السياسية والاجتماعية لجماعة الحركة… 3- إن الحاسم في الحكم لا يتعلق فقط باستخلاص الأحكام من النصوص واستنباطها من مصادرها الأولية، ولكنه يتعلق أيضًا بكيفية النظر للواقع الذي تحياه الأمة…” (ص 60-61).
أما المستوى الثاني- فلم يلخصه البشري بين المجموعة السابقة من النتائج، وهو المستوى الذي يبين كيف أن عملية نقل النماذج الفكرية أو التنظيمية التي نبتت في واقع غير واقع مجتمعاتنا وتم اختبارها على أرضه، لا يثمر نفس الثمار على أرضنا بل يمكن أن تحدث نتيجة عكسية. وكان هذا المستوى بدوره حاضرًا في تحليلات البشري، ولا أدلَّ على ذلك من عبارته الجامعة الملخصة لنتائج تحليله لمجموعات الفكر السياسي والحركات السياسية الغربية التي وفدت إلى بلادنا باعتبارها مقومات الإصلاح والتحديث؛ وهي التي تتعلق بالديمقراطية والإصلاح الديني، والقومية، والاشتراكية (ك:5، ص 47) فهو يقول: “والحاصل، أن حظنا من كل من هذه المجموعات الفكرية، كان حميدًا أو ضالًّا بقدر ما أمكننا، أو لم يمكنا توظيفه كأدوات للإصلاح لا كأهداف للإصلاح، وبقدر ما أمكننا أو لم يمكنا تحديد أهداف الإصلاح طبقًا لأوضاعنا العقدية والتاريخية في ظروفنا المعيشية، وبقدر ما استطعنا أن نستبقي مواريثنا الحضارية نقدر بها الصالح وغير الصالح مما نشربه من غيرنا. والحاصل أيضًا، أننا فشلنا كل الفشل في كل الظروف التي لم نراع فيها عينية الفروق بين السياق الاجتماعي التاريخي الذي ظهرت فيه أي من هذه المجموعات الفكرية، وبين السياق الاجتماعي التاريخي لدينا… ومن هنا تبدو أهمية موضع المعاصرة الذي أريد به أن يطمس الفروق بين أوضاع الغرب وأوضاعنا”.
وهكذا يصل بنا البشري إلى مفهوم محوري في فكره، يصب فيه –وعنده- مفاهيم وقضايا أخرى. وهذا المفهوم هو مفهوم المعاصرة، أو وحدة العصر، التي سنتوقف عندها لاحقًا في خاتمة العرض لبقية الملامح المنهاجية.
ب- ويمكن من ناحية أخرى الإشارة إلى البعض الآخر من النماذج التوضيحية للعلاقة بين الفكر والواقع لدى البشري، والتي تقدم لنا مدلولات إضافية ذات طبيعة منهاجية بصفة خاصة.
فنجد على سبيل المثال اهتمام البشري –الذي ظهر في السلسلة- بالعلاقة بين الإصلاح الفكري والإصلاح المؤسسي التنظيمي؛ انفصالًا واندماجًا، وما لذلك من آثار على حالة الأمة في مواجهة الفكر الوافد ومؤسساته وأنظمته في المراحل المختلفة من “العصر” أي القرنين التاسع عشر والعشرين.
وكذلك يمكن أن نشير إلى تمييز البشري –عند اقترابه من العلاقة بين الإسلام والعروبة- بين الحوار الذي يدور حول البعد الفكري النظري في القومية (أي المفهوم القومي النظري) والذي يثير أكثر الخلاف بين الإسلاميين والقوميين وبين الحركة والاحتياجات العملية التي تولد الروابط المشتركة بين الفكرين الإسلامي والقومي حول الاستقلال، والوحدة، والتنمية، في ظل مظلة انتماء أوسع وأشمل.
وعلى صعيد آخر –وعلى النحو الذي يقدم لنا البشري الفقيه القاضي- يتكلم البشري عن جانب هام من العلاقة، وهي العلاقة بين النصوص والوقائع في الفقه الإسلامي (ك:1، ص 68) فهو يقول: “ونفي العلمانية يعني في تصوري الأخذ بالشريعة الإسلامية… وقد قرأت في الشريعة وتعلمت القوانين الوضعية الآخذة عن الغرب. والشريعة بناء تشريعي فقهي عظيم… ونحن نعلم ما يقال فيها عن اختلاف الزمان والمكان واختلاف الحجة والبرهان… وتفسير النصوص… في صميمه (هو) تحريك للنص على الوقائع المتغيرة، وعلى الحالات المتنوعة. والمرونة سمة أصيلة من سمات الفقه الإسلامي”.
ولعل من أعظم الأمثلة التي ضربها البشري عن التفاعل بين الفكر وبين ضغوط الواقع ما قاله عن خبرة السنهوري باشا وتطور موقفه من العلاقة بين الشريعة والقوانين الوضعية. فبالرغم من اعتراف السنهوري في سنة 1934 بما ينطوي عليه فقه الشريعة من إمكانات كبيرة ومن مرونة وقابلية للتطور، إلا أنه عندما أعد القانون المصري لم يستغل الإمكانات المتاحة كلها، وأتى القانون غربيًّا خالصًا. وكان تفسيره لهذا الموقف أن الدراسات لم تنضج في حقل الشريعة بعد. ولذا يقول البشري إن السنهوري –الذي ظلت كتبه وأبحاثه في هذه المرحلة الأولى تدور في نطاق الثقافة القانونية الغربية- كانت الشريعة لا تزال لديه مجالًا للدعوة، ولم تشارف عنده مرحلة الممارسة العملية أو التشريعية… فليس من قرأ كمن صنع. ثم جاءت الفرصة بعد ذلك أمام السنهوري للصناعة، ولكن بالمزاوجة أولًا مع أحكام المجلة وفقه الشريعة عامة. ولقد خرج السنهوري من هذه المرحلة الثانية شديد الاعتراف بعراقة الفقه الإسلامي، وقال معبِّرًا عن مدى تأثره بخبرة ممارسته “… هذه هي عقيدتي في الفقه الإسلامي، تكوَّنت لا من العاطفة والشعور فحسب، بل تضافر في تكوينها الشعور والعقل، ومكن لها شيء من الدرس، … فأتاح لي اطلاعي على نصوص هذا الفقه الإسلامي… أن ألحظ مكانة هذا الفقه وحظه من الأصالة والإبداع، وما يكمن فيه من حيوية وقابلية للتطور”.
أما المرحلة الثالثة من تطور خبرة السنهوري باشا فيقول البشري إنه خاض فيها الممارسة الفقهية بكتابه المهم عن مصادر الحق في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقوانين الغربية.
ولذا؛ فإن السنهوري –وفقًا للبشري- لم ير المستقبل في واحدة من المرحلتين الأولى (مرحلة الأخذ عن الثقافة القانونية الغربية) أو الثانية (مرحلة الثقافة الغربية إلى جانب الفقه الإسلامي) بل في تفاعل المرحلتين تفاعلًا يفضي إلى تخطيهما معًا (ك: 3، ص 24- 25).
لقد توقَّفت عند هذا المثال العملي الحي من واقع خبرة أحد أبرز علمائنا المعاصرين؛ لما له من دلالة مهمة منهجية، أعتقد أن البشري قد مرَّ بها –ولو في إطار مختلف- ويحتاج شبابنا لتفهُّم مثل هذه الدلالة. فهي تساعد على حفز الإيمان وتشكيله وتدعيمه بأنه مهما كانت المشاكل والصعوبات، فهناك إمكانية بل وضرورة للخروج من إسار الفكر الغربي لرأب الانفصال عن التراث.
وتبقى أخيرًا الإشارة إلى النموذج الذي يوضح فهم البشري ما يجب أن يكون لتأثير الواقع على الفكر من حدود من ناحية، وشروط فاعلية الفكر من ناحية أخرى، فهو يقول (ك: 4، ص 12-13): “إن الفكر –كشأن أي كائن حي- لن نحميه بأن نضعه في المعازل، ولكن السبيل الأمثل للدفاع عن الوجود هو بالتجديد وبالتفاعل مع أوضاع الواقع المعيش… وهناك تصور خاطئ لفكرة التجديد، وهو أنها تعني بذلك الجهود لإسباغ بردة الإسلام على ما نشاهد ونمارس من أوضاع المعيشة في حياتنا الراهنة؛ وبخاصة ما طرأ عليها من أنماط السلوك والنظم الوافدة، حتى وإن كانت تخالف أصلًا من أصول الإسلام. وهذا موقف خاطئ لأنه يحيل الفكر الإسلامي إلى مجرد أنه تبرير وتسويغ للواقع المعيش وليس حاكمًا له… إن التجديد في الحقيقية يتأتي من وجهة أخرى. أنه يرد من كيفية استجابة الأحكام الشرعية ونظم الإسلام ودعوته للتحديات التي تواجه عقيدة المسلمين وديارهم”.
وتقودني هذه الكلمات إلى الانتقال إلى الملمح الرابع من الملامح المنهاجية.
4- “الأصل”، و”المرجع”، و”الثابت”، و”معيار الاحتكام”؛ جميعها مفاهيم ترددت في خطاب البشري وهي تعني الإسلام وتشير إليه.
فالإسلام لدى البشري هو أصل الشرعية ومعيار الاحتكام، وهو الإطار المرجوع إليه في النظم الاجتماعية والسياسية وأنماط السلوك. ومن ثم فمن الملامح المنهاجية الهامة والأساسية التي غلفت وأحاطت بالبناء كله؛ تلك المتصلة بالتمييز الواضح لدى البشري بين الثابت والمتغير، وبين الأصل والفرع، ومن ثم التمسك بأهمية الدفاع عن حوزة الأصول وعن أصل الشرعية وعن معيار الاحتكام مهما تغير الزمان والمكان.
ذاك هو الجوهر الدفين في بناء فكر البشري، والذي يفسر لنا فكره حول الأعمدة الأساسية وحول القاعدة الأساسية في بنائه الفكري: فإن الصدع لم يظهر إلا نتيجة الابتعاد عن أصل الشرعية ومعيار الاحتكام، والمشروع الوطني لن يتحقق بدون العودة لهما.
وإذا كانت كتابات البشري التي نتحدث عنها قد تضمنت دراسة تحت عنوان: “شمولية الشريعة الإسلامية عناصر الثبات والتغير” (ك: 3، ص 99-115). كما توقف البشري عند الموضوع ذاته طوال نصف دراسة أخرى تحت عنوان: “الإسلام والعصر.. ملامح فكرية وتاريخية” (ك: 4، ص 47-51)؛ التأكيد على هذا الأمر قد تلازم مع غالبية الدراسات واتخذ أشكالًا مختلفة ونجده في موضع آخر من كتابه (ك: 3، ص 35-36) تحت عنوان: “حول التجديد” يتوقف لينبه إلى ضرورة التفرقة بين الشريعة والفقه، وأن الشريعة هي الثابتة والفقه هو الذي يتغير.
“… إن التغير لا يعني تغيرًا لأصل الحكم المرجوع إليه، إنما يعني تغييرًا لدلالة الحكم مطبقًا على حالات متغيرة أو في ظروف مختلفة… لذلك؛ فإن النص وهو ثابت لا تتناهي تفسيراته لأنه ينطبق على واقع غير متناه. والاجتهاد هو سبيل التفسير المتجدِّد للنص الثابت على الوقائع المتغيرة. هذا الفارق بين الشريعة والفقه، يتعين أن يكون واضحًا لدى من يذودون عن الشريعة، فلا يسبغون وضعها الإلهي الثابت على آراء للفقهاء جرت في ظرف مغاير. كما يتعين أن يكون واضحًا لدى من ينقد آراءً قديمة في الفقه، ألا يبسط نقده على ما يسمى الأصل المرجعي الثابت في القرآن والسنة، أي الشريعة” (ص 35-36).
وربما يجد بعض المتخصصين أن هذا التنبيه من البشري لا يحمل جديدًا، ولكن الجديد هو أن فكر البشري يقدم ترجمة عملية لهذه القاعدة في مجالات عديدة وحول موضوعات متفرقة، وخاصة الاستجابات الفكرية المختلفة في مواجهة تحديات المراحل المتتالية في العصر.
ويتضح لنا ذلك الجديد من موضعين:
الموضع الأول من دراسة له تحت عنوان: “الإسلام والعصر: ملامح فكرية وتاريخية” (ك: 3) التي انقسمت إلى جزأين: جزء منهاجي يحدد فيه البشري منهج وأصول النظر العقلي في إدراك العلاقة بين الثابت والمتغير. ويلخص فكره في هذا الجزء عبارات هامة “… عندما يجري الحديث عن مشكلة تتعلق (بالإسلام والعصر)، فإن المقصود من ذلك الإشارة إلى ثبات الإسلام وتغير العصور، أي تغير الأوضاع الاجتماعية والتاريخية والإنسانية… متى صارت لدينا القدرة على التمييز بين ما هو ثابت، أي يشكل وضعًا إلهيًّا –وهو النصوص والأحكام المنزلة قرآنًا وسنة- وبين ما هو متغير واجتماعي وتاريخي من اجتهادات الفقهاء، فإننا بهذه القدرة نستطيع أن ندرك كيف نحفظ أصول الشريعة، وفي الوقت نفسه نعمل عقولنا في المجال الفسيح المتاح للاجتهاد في هذه الأحكام، بما يحفظ أصول الإسلام، ويرعى مصالح العباد، وبما يشيع العدل… ونحن نتذكر كلمة محمد إقبال التي لقَّنها له أبوه “اقرأ القرآن كأنه يتنزل إليك” وهذا القول هو واحد من تطبيقات أن القرآن نص غير تاريخي، فنحن نقرؤه في كل عصر كأنه تنزل إلى هذا العصر…”.
أما الجزء الثاني من الدراسة فهو تاريخي يوجز فيه البشري ما سبق وفصَّله في دراسات عديدة حول موجات الإصلاح منذ منتصف القرن الثامن عشر. ثم لخَّص البشري نتائج عرضه التاريخي التي يبرز فيها جوهر رؤيته عن “العلاقة بين الفكر والواقع” على نحو ما أشرنا إليه فيما سلف.
أما الموضع الثاني الذي يوضِّح الجديد لدى البشري بالمقارنة بغيره –من الذين يجرون على التنبيه لهذه القاعدة- فهو يتمثل في تلك العبارة البليغة “المؤمنة” التي أنقلها كاملة (ص 37) يقول: “… نقطة أخرى أدركتها بالمعايشة. إن الإسلام قلب المؤمن به جديد جدة نفسه وجدة حياته وحاضره. ومتى أمِنَ عليه من الغوائل، وأمِنَ على أصوله وثوابته، صار إسلامه عنده وكأنه أبلغ إليه في هذه الساعة متفاعلًا بأصوله وأركانه وقيمه مع حاضره وما يرنو إليه من مستقبل. ذلك أن الإسلام معتقد معقود في نفس المؤمن به، والمؤمن حاضر وحي وجديد. وهو مخاطب بأحكام الإسلام، قرآنًا وسنة، في يومه هذا. وهذا مفاد كون نصوصه غير تاريخية”.
“هذا بخلاف ما يمكن أن نسميه بالنظرة “الأثرية” للإسلام، التي تراه آثارًا، أو حتى لو كانت تحن إليه، فكما يحن الشاعر إلى مرابط قومه القديمة يستنشق عبيرها ويستحضرها في ذاكرته ساعة ثم يمضي”.
بهذا الإدراك لجدة الإسلام بوصفه معتقدًا، نفهم كيف هدم الوهابيون الأوائل كثيرًا من المزارات، وكيف قرَّر الأصوليون أن “العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”، لأن النص إلهي، وهو غير تاريخي. أما الفقه، فهو الوضع التاريخي، نأخذ منه ونترك وفقًا لما ندركه من جدَّةِ أصول الإسلام في نفوسنا، ومع تقديرنا أن الفقه هو الخبرة التاريخية التي يلزم استطلاعها، وهو تجارب الماضي التي نسترشد بها”.
وأخيرًا وبعد هذه التعبيرات أجدني لا أستطيع أن يترك قلمي الكتابة دون أن أسجل الملاحظة التالية: إن طارق البشري الفقيه القاضي، والمؤرخ السياسي؛ المسلم المؤمن، قد سطر كل هذه الصفحات التي تضمنتها هذه السلسلة محملًا إياها همَّه وانشغاله بأحوال الأمة في تاريخها المعاصر والراهن، ومفوحًا منها عبق رؤيته الإسلامية الحكيمة، سطر كل هذا دون أن يحيل إلى نصوص الأصول (القرآن والسنة) ولكن سطرها من واقع رؤية إسلامية واعية ومؤمنة لتاريخ المسلمين وحاضرهم بكل منعطفاته ومفترقاته، بكل تحدياته واستجاباته على تلك التحديات.
وإذا كنت قد ترددت قليلًا عند صياغة كلماتي السابقة إلا أنني أجد أن الكلمات التالية للبشري تصدقني القول: “… هذا هو العصر الذي نتصدَّى لحلِّ مشكلاته لصالح الجماعة. وإذا اتضح ما هو العصر اتضح معيار الحكم. ليس المشكل في فهمنا للإسلام ولكن المشكل هو في فهمنا للعصر؛ ليس المشكل في قراءتنا للنص ولكن المشكل في رؤيتنا للواقع” (ك: 4، ص 61).
وأخيرًا وعلى ضوء كل العرض السابق يتضح لنا كيف يتكامل لدى البشري ويتضافر الملمحان المنهجيان الأخيران وهما: العلاقة بين الفكر والواقع، والعلاقة بين الثابت والمتغير. كما اتضح لنا من قبل التكامل بين الملمحين الأول والثاني، أي الأمة والرؤية الكلية للتاريخ وكيفية توظيفها. ويتحقق إحكام التكامل المنهاجي وتراكمه بين هذه الملامح الأربعة وفي مجموعها من خلال رؤية البشري عن “العصر” وعن “المعاصرة”.
وبالرغم من أهمية هذه الرؤية وتفردها عن “وحدة العصر الحديث”، والمعاصرة فلم أجدني في بداية القراءة قادرة على تسكينها باقتناع في أحد أجزاء هذه الورقة.
ثم صممت لها وضعًا في الجزئية الثالثة. ولكن اختصار هذه الجزئية، على ما آلت إليه، لم يعد يتناسب وما أراه من قيمة منهاجية ومضمونية في الدراستين اللتين انبرى فيهما البشري لتقديم رؤيته عن “وحدة العصر” و”المعاصرة”. الأولى تحت عنوان “الإسلام والعصر: ملامح فكرية ومنهاجية” (ك: 4، ص 47- 61)، والثانية تحت عنوان: “مفهوم المعاصرة بين العالمين الغربي والإسلامي” (ك: 5، ص 48-65).
وإذا كنت قد وجدت للدراسة الأولى مكانها من العرض في الأجزاء السابقة –كما رأينا- إلا أنه ظل للثانية وضعها الخاص بالنسبة لتفاعلي مع أفكار البشري في كلياته وارتباطاتها. كذلك لم تسقط من ذهني الرابطة بينها وبين الدراسة الأولى، لماذا؟
إن الملاحظات التالية تلخص هذا الوضع المزدوج وتقدم الإجابة. ولقد أوردتها في هذا الموضع من الورقة لأنها تبرز –من وجهة نظري- ليس التكامل بين الملامح المنهاجية الأربعة فقط ولكن أيضًا التكامل بين مكونات البناء الأخرى. وتتلخص ملاحظاتي في أن الدراسة الأولى –للبشري- كانت تشرح العلاقة بين الإسلام والعصر على النحو الذي يبين كيف أن منهاجيته لشرح العلاقة بين الفكر والواقع والظرف التاريخي على صعيد المجتمعات الإسلامية، إنما تتمحور –هذه المنهاجية- حول ما يحفظ ويقيم أصول النظر في الثابت والمتغير، فالإسلام هو الثابت والعصر هو المتغير.
أما الدراسة الثانية فإنها تشرح بعمق ورحابة واقتدار وإبداع جوهر إشكالية العلاقة بين “نحن” و”الآخر” في العصر الحديث، والتي تتصدر المناقشات في الدوائر الفكرية تحت “مفهوم المعاصرة”. وأرى أن البشري في هذه الدراسة، قد قدم الخلفية والإطار الشامل الذي يفسر لنا لماذا رأى البشري “الوافد” قد أحدث الصدع وكيف أحدثه؟ لماذا تعد التبعية والتجزئة من أخطر التحديات المعاصرة؟ وما الذي يقع في صميم هذه التبعية والتجزئة: أهي العوامل المادية أم هو الوعي الحضاري؟
وأستطيع القول إن هذه الدراسة التي كتبها البشري في سنة 1993 إنما تضع أسانيد رؤية إسلامية واعية ناقدة “للعولمة”. وهي الرؤية التي تقيم أسانيدها على اعتبارات القيم، والوعي الأممي الحضاري. وبذا فهي -وإن كان لها سبق المشاركة في مناقشة واحد من أخطر أبعاد هذا الموضوع– أقصد “العولمة”، إلا أن البشري أرسى أيضًا من خلالها وبوضوح عميق الأسانيد التي تميز الرؤية الإسلامية في هذا المجال عن غيرها من الرؤى الناقدة أيضًا، أو الناقضة “للعولمة”. فمن أهم ما ثار في أوساطنا الفكرية والأكاديمية خلال العامين الماضيين تلك الفورة من الاهتمام “غير العادي” بما يسمى العولمة على نحو يذكرنا بنظيرتها التي جرت في بداية التسعينيات حول “النظام العالمي الجديد”. ومن بين بعض أهم ملامح الجدال بين الرؤى الأخرى الناقدة للعولمة هو أنه لا يمكن التمييز بين أسانيد رؤية إسلامية وبين رؤى أخرى ناقدة للعولمة سواء منها الرؤى القومية أو الهيكلية أو غيرها.
وتأتي دراسة البشري والتي كتبها قبل أن يحتدم الجدال لتقدِّم إسهامًا بالغ الأهمية في هذا المجال، في وقت لم يسطر البشري –ولو مرة واحدة- لفظة العولمة.
وهذه الدراسة من الدراسات التي لا بد وأن يحدث افتئات على مضمونها إذا تم اجتزاء عنها، حيث إن أجزاءها وسطورها محكمة وبالغة الإتقان في تعبيراتها وانتقالاتها. وبالرغم من هذا فإنني أنقل عنها بعض ما يمكن أن يشرح وجهة نظري السابقة.
كانت هذه الدراسة قد قدَّمها البشري تحت عنوان: “حول القيم والمفاهيم السائدة في المجتمع العربي” وذلك في ندوة الثقافة العربية “الواقع وآفاق المستقبل” التي عقدتها جامعة قطر في سنة 1993. ومن ثَمَّ فإن مدخل البشري لمناقشة العصرية والمعاصرة هو (القيم والمفاهيم السائدة في المجتمع العربي) “على اعتبار أن العصرية أو المعاصرة تبدو فيما يظنه البشري كالقيمة العليا التي صارت حاكمة في الثقافة السائدة… قد صارت أصلًا مرجوعًا إليه”.
ولقد بدأ البشري غرضه بمتابعة التطور في مفهوم “العصري” ومن ثم المقابل له أي “الرجعي”. وهو التطور الذي حدث في النصف الثاني من القرن العشرين بالمقارنة بمعانيها في النصف الأول من هذا القرن. ففي حين كان المعنى الاجتماعي يغلب في البداية (القيم السلوكية، العادات، أساليب الحياة…) بدأ المفهوم يكتسب بالتدريج مع الوقت دلالات أخرى تشير إلى معنى أممي “… فصار العصر يمثل وحدة جامعة تضم العصرين جميعًا في العالم أجمع، وصار العصري… يشير إلى من يندرج في وحدة الانتماء هذه بحسبانها تشكل وحدة انتماء حضاري وأممي، ولم تعد العصرية تقابل الرجعية كطرف صراع اجتماعي في داخل الجماعة المحلية، إنما صارت العصرية –بوجهها الأممي- تقابل التخلف على صعيد العالم أجمع. وقسم هذا المعنى العالم في وعي القائلين به إلى فريقين…”.
ويتساءل البشري: “… كيف أمكننا أن نقيم معايير للتقويم التاريخي والحضاري يتحول بها العصر من عنصر زماني إلى قيمة ثقافية حضارية، يبلور عليها مفهوم الأمة والجماعة ويصير غير المتمتع بخصائص العصر منكورًا عليه جدارة الانتماء إلى أمته؟!!”.
والإجابة لدى البشري تتلخَّص في أننا لم نقِم في وعينا من قبل (خلال السيطرة الاستعمارية في التاريخ الحديث) نسقًا واحدًا لتاريخ عالمي يقيم معايير موحدة للوجود والنمو والارتقاء. وحتى بعد التحرر كانت مهمتنا هي “اللحاق بالركب” ومن ثم وضعنا حاضر أوروبا صورة لمستقبلنا ومعيارًا لتقدمنا. وهنا بدأ المعيار التاريخي ومعيار التقويم الحضاري للعالم يتوحدان في وعي الثقافة السائدة (أي المسيطرة والحاكمة في مجتمعاتنا)… وبهذا المنظور تعدل في وعينا التصنيف الذي كان قائمًا؛ فبعد غازٍ ومغزو، ومُستعمِر ومُستعمَر، صار يتعلق بمعاصر ومتخلِّف… وأخذ هذا التصنيف يسود على ما عداه من تصنيفات تقوم على أساس الدين أو القومية أو اللغة أو العرق أو القارة.
وحيث إن الغرب هو الأكثر تقدُّمًا فلقد سادت خصائصه الحضارية بحسبانها خصائص العصر فكرًا ونظمًا، وأنماط حياة وسلوكًا، ومذاهب.
وهكذا بعد تحديد المفهوم السائد ينتقل البشري إلى تقديم رؤيته النقدية له. وهي تقوم على رفض الدلالة الأممية الحضارية “للعصر” الذي هو في الأصل وحدة زمانية، ذلك لأن هذه الدلالة تجعل العصر وحدة انتماء جماعي تحل محل وحدات الانتماء الأخرى، دينية كانت أو قومية أو غيرها. هذا ما يرفضه البشري كما يرفض أيضًا البشري مفهوم وحدة العصر لأنه ينتج عن القول بوحدة التاريخ الذي يعني وحدة الجماعة. وهذا الرفض قائم لدى البشري على نحو يدفعه للتساؤل هل توحَّد العالم أو الجماعة البَشَرية لن يتم لحساب فئة على حساب فئة أخرى؟ بعبارة أخرى ألن يكون على حساب اختلاف الجماعات والتكوينات الثقافية التي تحيا في هذا القرن؟
ويفصِّل البشري موقفه على ضوء نقد مدلولات هذا المفهوم “العصرية” بالنسبة للتقويمات الكلية والتقسيمات العامة للتاريخ، ولأدوات تحليل النظم والمؤسسات والأفكار والأحداث، فهو يقول: “… كيف يمكن أن تتوحد العصور وتتوحد الأحكام إلا بكثير من الشطط وتجاهل الواقع تجاهلًا يصل إلى حد إسقاطه كلية… إننا لا نعترض على حركة التاريخ الأوروبي ولا على تقسيماته وتقويماته (إلا) أن تعمم… أو نستخدمها كأدوات فكرية في تحديد واقعنا ووصفه، أو كمعايير نتحاكم بها في تاريخنا…” كما يقول على ضوء مناقشة بعض نماذج الاحتكام للغرب: “… إن هذه المفاهيم والقيم… لا تيسر لنا صواب النظر ولا صحة التناول. والأخطر من ذلك أنها تجعلنا دائمًا نقيس وفقًا لنموذج آت لنا من غير وقائعنا وخبراتنا… إن وحدة العصر كجامع حضاري أممي، تعني إلحاق عصرنا الراهن –أي حاضرنا- بعصر الغرب؛ أي بنمط الحضارة الغربية الغالبة المتصفة بوصف حضارة العصر الحديث. وهذا يعني –فيما يعني- أن التبعية في الحاضر ترتد تبعية على الماضي، كما أن وحدة العصر كجامع أممي استتبعت وحدة التاريخ”.
ولم يكن ليكتمل معنى هذه الخلاصة لدى البشري بدون قيامه بالتنبيه في نهاية الدراسة إلى خطورة النظرة التجزيئية للتاريخ الإسلامي التي تسود الدراسات التاريخية الحديثة، والتي لا تقتصر خطورتها على التجزيئ السياسي -وهذا وارد- ولكن لأنها تمتد إلى تقسيم الوعي الحضاري وضياع الرؤية التاريخية الواحدة للماضي.
وأخيرًا يجدر القول بأن علينا استدعاء أبعاد الجدل حول العولمة السائدة الآن في أوساطنا حتى نعرف ما الذي قصدتُه من أن فكر البشري “حول المعاصرة” إنما يقدم أسانيد رؤية إسلامية نقدية مشاركة في هذا الجدل.
*****
الهوامش:
(*) نشرت هذه الدراسة ضمن: إبراهيم البيومي غانم (محرر)، طارق البشري .. القاضي المفكر، دار الشروق، 1999، ص ص 170-215.
[1] لم تقدم هذه الورقة مكتوبة في ندوة الاحتفاء في 31 يوليو 1998، ومن ثم فهي تطوير للعرض الشفوي الذي قدِّم في هذه الندوة.
[2] ستتم الإحالة إلى الكتب التي تتكون منها المجموعة التي تحمل عنوان “في المسألة الإسلامية المعاصرة” وفق الترتيب التالي:
بين الإسلام والعروبة، دار الشروق، القاهرة، 1998.
الحوار الإسلامي – العلماني، دار الشروق، القاهرة، 1996.
الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دار الشروق، القاهرة، 1996.
الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر، دار الشروق، القاهرة، 1996.
ماهية المعاصرة، دار الشروق، القاهرة، 1996.
وسيتم الرمز للكتاب بالرمز (ك).
(*) ورد هذا الوصف في كلمة الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، وفي ورقته التي قدمها لندوة الاحتفاء بالمستشار البشري (المحرر).