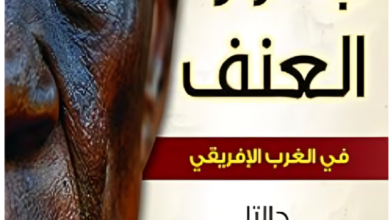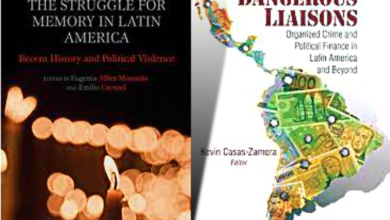عرض كتاب “انزياح المركزية الغربية”
نقد الحداثة لدى مثقفي ما بعد الكولونيالية الصينين والعرب والهنود

مقدمة:
يناقش الكتاب[2] إشكالية استمرار المركزية السياسية والفكرية للغرب، ويطرح الكاتب في صدر كتابه تساؤلًا رئيسيًّا: “كيف يحصل أنه بعد عقودٍ عدَّة من نهاية الإمبراطوريات الاستعمارية، لا يزال عالَمنا يعتمد على المعارف التي تمَّ تعميمها أصلًا لترسيخ أقدام الفتوحات الإمبريالية؟ لماذا لم يترافق إنهاء الاستعمار السياسي مع إنهاء الاستعمار العلمي، ممَّا يُسْهِمُ مجدَّدًا في تعدُّد مراكز إشعاع عالم الفكر؟، وفي سبيل معالجة ذلك أُطلقت أطر إبستمولوجية بحثية وسياسية عدة هدفت إلى إعادة النظر في الارتدادات التي نجمت عن تعميم الفكر الأوروبي، أهمها “الكونفوشيوسية الجديدة” و “دراسات ما بعد الكولونيالية”، ويرى الكاتب أن عمليات التفكير حول مشروع تفكيك هذه الهيمنة تمحورت في رفض ادعاءات الغرب بمشروعيَّته العالمية، وأن مسألة العلاقة بين الهيمنة السياسية والفكرية طُرحت من قبل مثقَّفين عرب في إطار النقاش حول الاستشراق مع صدور كتاب إدوارد سعيد بعنوان “الاستشراق”، ويحاول الكاتب بيان كيفية تحويل موقف اختلاف جماعي إلى موقف تمايز فكري بما يشكِّل أساسًا للتفكير النقدي، لإعادة النظر في التفسيرات التي تربط بين الهجرة والنقد من أجل إدراجها في إطار أوسع.
وينقسم الكتاب إلى جزأين:
الجزء الأول : الكونفوشيوسية الجديدة: حداثة آسيوية في أمريكا
اتساقًا مع طرح الكاتب في نقد استمرارية الاستعمار العلمي والفكري للغرب، يناقش في هذا الإطار ملامح انتقال الكونفوشيوسية إلى أمريكا في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي كإطار إبستمولوجي سياسي يهدف إلى إعادة النظر في تعميم الفكر الغربي، تنظيرًا لما يمكن أن يكون حداثة متحرِّرة من الغرب تستند إلى الكونفوشيوسية، وذلك اعتمادًا على فرضية ذات مستوى زمني: يؤكد على قدرة الفكر الكونفوشيوسي على تخطِّي بعض التناقضات الجوهرية التي تطرحها الحداثة العالمية، وآخر مكاني: يدعو إلى ضرورة تمكين الكونفوشيوسية من تسديد خُطى التجربة الغربية على ضوء التقاليد الفكرية التي نشأت في آسيا.
الفصل الأول: أصول الكونفوشيوسية الأمريكية: العلوم والسياسة والأجيال في القرن العشرين
- انهيار وإعادة بناء الكونفوشيوسية في العصر الحديث
يرى الكاتب أن التقاليد لا تظهر إلا عندما تُعيد الحداثة تشكيل المرجعيات الثقافية لمجتمع ما، ودائمًا يكون مثقفون عصريُّون يأخذون على عاتقهم إحياء أنظمة التفكير التقليدية، وهذا ما ينطبق على الكونفوشيوسية، إذ إن التحوُّل الحضاري الكبير الذي أُطلق عليه التحديث، ألْزم النخب الصينية بالقيام بعملية تكيُّف معرفي مؤلمة في مواجهة المعارف التي ضمنت السيطرة لأوروبا، حيث إن الفتوحات الأوروبية في القرن الـ19 تسبَّبت في جرح نرجسي للثقافة الصينية وحَمَلَتْها على النظر إلى نفسها على أنها واحدة من الثقافات العديدة القائمة، وبعد عقود يرث الكونفوشيوسيون مهمة عصرنة الكونفوشيوسية.
وبهذا ينتقل الكاتب ليستعرض المعارف الأوروبية في مواجهة الدولة الإمبراطورية الصينية استبيانًا لتحديات التحديث، ففي الوقت الذي سعتْ فيه الكونفوشيوسية إلى ابتداع ذاتها على أنها الثقافة الصينية فقد حُمِّلَتْ مسؤولية الضعف الذي ضرب البلاد، مع استيراد المستنيرين المعارف الغربية، وتمَّ إرساء المبدأ الأول: “دراسة التكنولوجيا المتقدِّمة للغرب من أجل الصمود في وجه الغرب”، الأمر الذي أدَّى إلى إبطالٍ شبه كامل لأهلية التقاليد الصينية في ظرف كانت فيه السلطة الإمبراطورية التي أضعفتْها المخاطر الخارجية غير قادرةٍ على القيام بعملية تحديث متماسكة. هذا المنحى أظهرَ تيارًا يُنادي بـ سقوط كونفوشيوس وشركاه والتخلُّص من التفكير التقليدي وتغريب الصين باعتبار ذلك مصدر التخلُّف الصيني، وقد حمَّل التيار الحداثي الكونفوشيوسية مسؤولية إضعاف الصين، وبلغ هذا الانتقاد ذروته في إطار حركة 4 مايو 1919، وفي هذا المسار يشير الكاتب إلى بزوغ الجيل الأول من الكونفوشيوسيِّين الجدد، الذي الذين سعوا لكي يرسموا للصين طريقًا للحداثة يستند إلى تراثها بدلًا من القطيعة معه، باعتبار أن فكرة التوفيق بين التقنيات الأوروبية والأخلاق الكونفوشيوسية تُعَدُّ مشروعًا مستقبليًّا للصين، وقد سعى هذا الجيل لضخِّ الروح في النظام الكونفوشيوسي وأتى بعدهم الجيل الثاني الذي أقام في المناطق الطرفية من الصين الثقافية وصولًا إلى الجيل الثالث من مفكِّري أمريكا الشمالية ذوي التأثير الأبرز في استمرارية الكونفوشيوسية التي انتقلت على مراحل من آسيا إلى الولايات المتحدة.
- في الشتات: جيل جديد من الكونفوشيوسيين الجدد على الأراضي الأمريكية
استنادًا على ما سبق، يذهب الكاتب لاستكشاف ملامح الجيل الجديد، تفسيرًا لاستمرارية المشروع الكونفوشيوسي في أمريكا الشمالية، فمعظم أبناء هذا الجيل ولدوا في الصين ودرسوا بعد ذلك في الولايات المتحدة مشكِّلين بذلك تبادلات مثَّلت المحصِّلة لتاريخ قديم وعمليات إعادة التشكُّل الحديثة، إذ ارتبط صعود الكونفوشيوسية الجديدة في الولايات المتحدة بتحولات المجتمع الآسيوي الأمريكي مع تضاعف الهجرات الصينية في منتصف الثمانينيَّات، مع التأكيد على أهمية الفضاء الأكاديمي الأمريكي في بروز الفكر الكونفوشيوسي آنذاك، وتُرجمت هذه التغيرات من خلال إعادة تشكيل الصينولوجيا الكلاسيكية (علم الصينيات) وإقحامه في نقاش فلسفي أوسع يتناول الطبيعة المتعدِّدة الثقافات للمجتمع الأمريكي، وقد كانت هذه المواجهة على درجة عالية من الحدَّة أدَّتْ إلى إعادة نظر شاملة بنظرة الغرب العلمية وما يتعلَّق بالعوالم غير الغربية.
الفصل الثاني: العودة إلى آسيا في السبعينيات والثمانينيات: الكونفوشيوسية والحداثة الآسيوية
يسعى الكاتب في هذا الفصل إلى تتبع عودة إحياء الفكر الكونفوشيوسي في آسيا، حيث وجد الكونوفوشيوسيون الأمريكيون في بروز آسيا أن الرأسمالية ساحة فكرية وسياسية يمكنهم من خلالها تأسيس مشروعهم التجديدي، ويشير إلى دور سنغافورة الحاسم كنقطة تواصل في التبادل بين الجامعات الأمريكية وآسيا باعتبارها منصة إقليمية للكونفوشيوسية آنذاك.
- التحديث والتغييرات الاجتماعية: إضفاء الطابع الكونفوشيوسي على سنغافورة
في ظلِّ التحوُّلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتْها سنغافورة في السبعينيَّات والثمانينيَّات، يتقصَّى الكاتبُ أبعادَ إضْفاء الفكر الكونفوشيوسي على سنغافورة، حيث انطلق النقاش حول القيم الآسيوية وقامت فرضية الكونفوشيوسية بدور مركزي. وفي نقاش العام 1975 أو فشل المحاولات الثقافوية الأولى، لجأت الحكومة إلى الأساتذة الجامعيِّين لبلورة إطار أيديولوجي للقيم الآسيوية، لكنهم عبَّروا عن شكوكهم بشأن وجود قيم آسيوية وهُوية كونفوشيوسية، وهكذا عندما حاول حزب العمل الشعبي إطلاق هذا النقاش فإنه واجهَ عقودًا من التنشئة الاجتماعية الحداثية المتغلغة في عقول الشعب السنغافوري، حيث إن النخبة المثقَّفة لم تكن على استعدادٍ لمُسايرة الحكومة في هذا الميدان.
في نهاية السبعينيات قامت الحكومة باتخاذ تدابير لتعزيز الهُوية الثقافية للسكَّان، وكذلك استمرَّ المثقَّفون في إبداء تحفظات حول مسألة الكونفوشيوسية الحديثة، وقد أدَّى هذا التجاذب في نهاية الأمر إلى دعوة الحكومة العديد من المتخصِّصين الأجانب بالكونفوشيوسية إلى سنغافورة بهدف جعلها مركز الكونفوشيوسية العالمي. وبهذا انخرطت سنغافورة في مشروع إحياء الكونفوشيوسية بدعم من السلطة.
- النمور الآسيوية: الكونفوشيوسية والرأسمالية
يستعرض الكاتب في هذا الإطار الأبعاد الاقتصادية للفكر الكونفوشيوسي في مواجهة الرأسمالية، ويقترب في طرحه من النماذج التنموية الآسيوية انطلاقًا من فرضية أن الأخلاقيات الآسيوية قامت بدور حاسم في تطوُّر الرأسمالية، فالتأكيد على أن الكونفوشيوسية تقوم بدورٍ في تنمية آسيا يقود إلى الاعتراف بوجودها الفاعل في منظومة الحداثة، ويتتبَّع الكاتب جذور النقاش الجديد حول الرأسمالية والكونفوشيوسية من خلال تحليل أفكار وكتابات بعض الشخصيات الرئيسية في النقاش حول الرأسمالية الكونفوشيوسية، وهكذا يؤكِّد الكاتب على العلاقة بين الحداثة والكونفوشيوسية ويستكشف الجوانب المظلمة في عمليات التحديث الغربية، ومن هنا كانت الصعوبة في إيجاد حلٍّ وسطٍ لفكر كونفوشيوسي، حيث تبدو المفاهيم الكلاسيكية للفكر السياسي الكونفوشيوسي غير متلائمة مع القضايا الراهنة، لذا لم يدُم النقاشُ حول الرأسمالية الكونفوشيوسية طويلًا، فالأزمة الاقتصادية التي ضربت المنطقة أدَّتْ إلى وضْع حَدٍّ للإيمان باستثنائية نموذج التنمية الآسيوي.
الفصل الثالث: النقاش حول حقوق الإنسان: نقطة التحول السياسي للكونفوشيوسية الجديدة
في هذا الفصل يعرض الكاتب لموقف الكونفوشيوسية الجديدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي جاء بعد احتجاجات تيانانمن عام ١٩٨٩ المنادية بالديمقراطية، ونتج عن تلك الأحداث أن أعادت الولايات المتحدة الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالأخصِّ بعد انتهاء الحرب الباردة. وتمثَّل ذلك بشكلٍ واضحٍ في مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في يونيو ١٩٩٣، ثم عرض لموقف القادة الآسيويِّين المتحفِّظ على ذلك الإعلان من خلال الاجتماع التحضيري في بانكوك في مارس ١٩٩٣، فقد رأوا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتجاهل الخصوصية الثقافية للشعوب غير الغربية بالأخص الثقافات الآسيوية، وتمَّ اعتبار هذا المؤتمر نجاحًا للأنظمة غير الديمقراطية.
وبحسب الكاتب، فقد نتج عن هذا المؤتمر أن عقد مركز الشرق والغرب في جامعة هاواي في أغسطس ١٩٩٥ ندوة بعنوان “الكونفوشيوسية وحقوق الإنسان”، وقد وقع مفكري الكونفوشيوسية في مأزق حيث يقوم مشروع إحياء الكونفوشيوسية الجديدة على فكرة التنوُّع الثقافي وبالتالي تأييد النظم القمعية، ومن ناحية أخرى تجاهل السمات الآسيوية للكونفوشيوسية ودعم الأجندة العالمية؛ لذلك بحسب الكاتب فقد سعى العديد من المفكرين الكونفوشيوسيِّين الجُدد إلى بلورة موقف يتفادَى منزلقين: العالمية المجرَّدة، التي تتعامى عن تنوُّع الخبرات الثقافية، والثقافية المشبوهة والتسلُّطية.
كما تناول الكاتب في هذا الصدد المواجهة الفكرية بين لي كوان يو وكيم داي جونغ، حيث رأى “لي” أن الثقافة قدر، وبالتالي فالثقافة التي يولد بها الأفراد تُقَيِّدُ خياراتهم السياسية والفلسفية دائمًا، في حين كانت مسألة تطبيق سيادة القانون والديمقراطية في آسيا مسألة جوهرية بالنسبة إلى “كيم”، بل استشرف أنه عند مطلع القرن الحادي والعشرين سوف تزدهر الديمقراطية على مساحة قارة آسيا بأكملها وعارض فكرة الحتمية الثقافية التي يسعى قادة آسيا التخفِّي خلفها.
ثم أضاف الكاتب أن الوضع أكثر تعقيدًا ممَّا يوحي به التعارض بين الليبراليِّين الكونفوشيوسيِّين والمحافظين.
بعد ذلك عرض لمقاربة الفيلسوف الأمريكي هنري روزمونت والتي مفادها نقد المقاربات المتحيزة مثل مقاربات لي وكيم. ثم عرض لمقاربة تو وايمنغ الذي اقترح إعادة النظر في العديد من الافتراضات المركزية للحداثة الغربية. وختم الكاتب الفصلَ بعرض مقاربة “تو” بأن فكرة الحداثة الكونفوشيوسية مشروع مزدوج يتضمَّن: التعبير من خلال مبادئ خاصة بالفلسفة الآسيوية عن أحاسيس عالمية، والإسهام أيضًا في تحديث هذه الأحاسيس العالمية والتعبير عنها.
الجزء الثاني: نظرة جديدة على العوالم غير الغربية: مثقفون عرب وهنود في الولايات المتحدة
يناقش الكاتب في هذا الجزء التيارات الفكرية المتنوِّعة وغير المتجانسة في النقد ما بعد الكولونيالي بين مثقفين عرب وهنود وجدوا مستقرًّا لهم في الولايات المتحدة، مثل إدوارد سعيد صاحب كتاب الاستشراق في عام ١٩٧٨.
الفصل الرابع: الاستمرارية والقطيعة في النقد العربي
وفي هذا الفصل يعرض الكاتب لأفكار إدوارد سعيد من خلال كتاب الاستشراق الذي يمثِّل حلقة في ثلاثية مخصَّصة للنظرة الغربية إلى العالم العربي والإسلامي، ويعدُّ الكتاب جزءًا رئيسًا من تاريخ سياسي مرتبط بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتجلِّياته في السياسة الأمريكية، لذا يتوجَّب إدراجُه ضمن سلسلة من التحوُّلات الخاصة بالتركيبة الأكاديمية الأمريكية، لأن النقد الذي يقدِّمه الكتاب ارتبطَ في الجزء الأكبر منه بالمواقع التي شغلَها في وسط جامعي كان يَمُرُّ في ذلك الحين بتقلُّبات حادَّة، لذا تحوَّل إلى نَصٍّ أكثر شمولية، حيث تبنَّته جميع الأقليات التي كانت في طوْر تنظيمها سياسيًّا، حيث شكَّل هذا الكتاب لحظة مهمَّة من عملية التفكير في ما انطوت عليه الحداثة السياسية والعلمية الغربية بالنسبة إلى الشعوب غير الغربية.
ويرى الكاتب أن كتاب الاستشراق يشكِّل لحظةً مهمَّةً في إمكانية الترويج لصيغٍ بديلةٍ عن الحداثة، أو تقف في مواجهة الهيمنة الغربية، فينطلق من تحليل نقدي للطريقة التي اتَّبعها التقليد الاستشراقي لإنتاج نظرة عن الشرق مكَّنت الغربيِّين من السيطرة، ويعلِّق الكاتب على طرح إدوارد سعيد في هذا الكتاب، فيقول بضرورة توسيع معنى الاستشراق ليصبح نمطًا فكريًّا قائمًا على التمييز الوجودي والعلمي بين الشرق والغرب دون اختزال، ويرى أن النظرة النقدية للكتاب تنطلق من استحالة عزل مجال المعرفة عن القوة.
بعد ذلك يحلِّل الكاتب طرح المفكر الماركسي المصري الفرنكفوني أنور عبد الملك من خلال مقال “الاستشراق في أزمة”، الذي يدعو الدول المتحرِّرة من الاستعمار إلى امتلاك أسلحة الغرب العلمية، حيث قارن الكاتب بينه وبين إدوارد سعيد من خلال دراسة المناقشات حول “الإبداع الفكري في الثقافات الأصلية” أو تحول العالم-ثالثية العلمية، إذ إن سعيد أعاد تعريف الفكر ما بعد الكولونيالي في فضاء متحوِّل بالنسبة إلى فضاء إنهاء الاستعمار العلمي، في حين أن عبد الملك يبيِّن أن النقد العربي والعالم-ثالثي اندرج بعمقٍ في نظامٍ سياسيٍّ كانت الدولُ القوميةُ تقومُ فيه بدورٍ مركزيٍّ جعلها تَرِثُ الشرعيةَ مع نهاية الاستعمار، واعتُبرت هذه الدول هي الضامنة لتحرُّر الشعوب المستعمرة، هكذا يوضِّح الكاتب موقف عبد الملك غير الملائم لعالم اجتماع يستند أساسًا إلى شبكات غير وطنية.
وفي هذا الإطار عرض الكاتب لمؤتمر كيوتو عام ١٩٧٨، ومؤتمر الجزائر ١٩٨١، لانعقادهما بهدف إعادة توجيه دقيقة تشكَّل من خلالها الفكر العالم-ثالثي عبر سلسة من العمليات النقدية المتنوِّعة، حيث ناقش الكاتب موضوع “الإبداع الفكري في ثقافات الشعوب الأصلية” من خلال عرض مداخلة أنور عبد الملك وسيد حسين الغطاس (صاحب كتاب “خرافة المواطن الأصلي الكسول”) والمؤرخ تشاترجي، وخلص في نهاية الفصل إلى أن فكرة القومية التي كانت لا تزال وسيلة مقاومة لمفكر من جيل عبد الملك، لم تعد كذلك بالنسبة لمفكر مثل تشاترجي.
الفصل الخامس: دراسات التابع الهندية والمنعطف السعيدي
في هذا الفصل يعرض الكاتب لدراسات التابع الهندية من خلال دراسة كيف أن المسارات عبر الوطنية لعدد من المفكرين الهنود أتاحت الإحاطة بالصيغة التي اتَّخذها نقدهم للغرب، وكيف أدَّى الْتقاء عددٍ من أعضاء الحركة مع إدوارد سعيد إلى إعادة بلورة طروحاتها، حيث كان لانتقال هؤلاء المثقفين خارج موطنهم أثر كبير في أطروحاتهم. ويؤكد الكاتب على الدور التأسيسي لرناجيت غوها لدراسات التابع الهندية منذ السبعينيَّات والثمانينيَّات، حيث جمع العديدَ من المؤرِّخين الهنود والبريطانيِّين حول مشروع إعادة قراءة نقدية للتأريخ الهندي في ضوء مفهوم الانتقال، حيث انتقل هؤلاء المثقَّفون بسبب هجرتهم والغموض النسبي لبداياتهم وصولًا إلى تحويل بالبُعد النسبي عن مراكز السلطة الفكرية إلى مقدرة على إعادة النظر بالتفسيرات القائمة، وبهذا قلبوا النماذج الكلاسيكية من خلال عرضهم لفهم تاريخ الهند الحديث، ليس انطلاقًا من نخبها، وإنما من خلال الفئات الاجتماعية التي تحتلُّ المواقع الأكثر تواضغًا، وتمَّ نشر ستة مجلدات حتى عام ١٩٨٨ بعنوان دراسات التابع: كتابات عن تاريخ ومجتمع جنوب آسيا، وقد أعطى رانجيت غوها مشروع “دراسات التابع” بُعْدًا نقدِيًّا للتأريخ، وكذلك شكلًا من أشكال التحليل الاجتماعي الشخصي.
ثم تحت عنوان من غياتري سبيفاك إلى إدوارد سعيد: نحو إعادة قراءة أمريكية لمشروع “التابع” يعرض الكاتب لدور غياتري سبيفاك الأكثر حسمًا في دمج مشروع التابع بالدراسات ما بعد الكولونيالية الأميركية بالتعاون مع زميلها في جامعة كولومبيا إدوارد سعيد، حيث تضمَّن إسهام سبيفاك في مشروع “دراسات التابع” محاولة نظرية حول مشروع تأريخ التابعين بالذات، وكذلك -بحسب الكاتب- فإن إسهام سبيفاك كان له أثرٌ بالغٌ في توجيه أنواع مختلفة من الانتقادات لدراسات التابع، في محاولة نظرية حول مشروع تأريخ التابعين بالذات، حيث أشارت أنها تنتوي تفكيك التأريخ، والقيام بقراءة نقدية أصبحت من المتخصِّصين فيها، ومع ذلك فإن إعادة القراءة التفكيكية التي قامتْ بها لم تتَّسم بالسلبية البحتة، فمن خلال اعتمادها التفكيك الإيجابي فإنها تنفذ في الواقع خطة لإعادة بناء تاريخ تحرُّري للعبودية، وقد عرض الكاتب لثلاثة انتقادات رئيسية وُجِّهَتْ إلى الباحثين في دراسات التابع، النوع الأول أتى من جيل شاب من اختصاصي الهند الذين تابعوا المشروع باهتمام، ولكنهم بدأوا يتساءلون عن المآزق التي يُخْشَى أن يعلقَ المشروع في شباكها، والنوع الثاني من الماركسيين الذين رأوا في مشروع “دراسات التابع” انحرافًا عن الأدوات النظرية للمادية التاريخية وخيانة للنضالات السياسية، أما النوع الثالث فقد تقاطعت فيه العديد من التيارات التي ترى أن مؤرِّخي “التابع” أهملوا بشكل منهجي أولئك اللاتي يشكِّلن نموذج التابع بامتياز وهن “النساء”.
بعد ذلك تحدَّث الكاتب عن تضافر جهود غوها وسبيفاك وسعيد في أواخر الثمانينيَّات، ثم عرض للانتقال النظري لقضايا أصبحت إشكالية في إطارها الأصلي من خلال مجموعة من الباحثين تحت عنوان مشروعات تأريخ بديلة: بارثا تشاترجي، وجيان براكاش، وديبيش شاكرابرتي. أما عن تشاترجي فقد استعرض الكاتب أفكاره التي ظهرت في كتاب الأمة وشظاياها والذي يعني أن الأمة ليست سوى مجموعة من الأجزاء لا يوحِّدها سوى ما يفرضه ميزان قوة السلطة ما بعد الاستعمارية، ويؤكِّد أن تشاترجي من أكثر الشخصيات التي يرتبط اسمها بشكل مباشر ببلورة نهج تأريخي متأثِّر بالتيارات ما بعد البنيوية والتفكيكية الأمريكية، أما براكاش فقد مثَّل نموذجًا متأخِّرًا للمشاركة في هذا المشروع، وقد تبنَّى النهج نفسه الذي اعتمده سعيد في كتاب الاستشراق، حيث سعى للترويج لتاريخ غير أصولي يشكِّل قطيعةً مع الأشكال السابقة في التأريخ، والذي تُعاد صياغته بلغة نظرية تستعير من توجُّهات سبيفاك التفكيكية، وبالنسبة لشاكرابرتي، فقد أعاد النظر بفكر ماركس الذي يتناغم بقوة مع المشهد الفكري الهندي بحيث تمكَّن من أن يرى بعيون جديدة كم أن الحداثة التي كانت الهند تبنيها تطبَّعت بالفكر الأوروبي، وبدأ بالفعل إعادة تقييمه، إلا أنه نظر إلى هذه الفكرة من ضمن سياقه المحدود وليس كمرجع نهائي لا يمكن تجاوزه، وكانت خلاصة أفكاره في كتاب “ترييف أوروبا”.
في خاتمة الكتاب ذكر الكاتب أن انتقال المفكرين السابق ذكرهم خارج أوطانهم هو الذي جعل منهم المتحدثين النقديين عن عوالمهم الأصلية في قلب الغرب، ثم وضَّح أنه برغم أهمية طروحات ما بعد الحداثة لكن لا يمكن التخلِّي عن كثيرٍ من المفاهيم المركزية للحداثة السياسية الأوروبية.
ثم أكَّد على أن علم اجتماع ما بعد الكولونيالية يكشف عن الاستمرارية والتوتُّرات التي تطْبع فضاء النقد السوسيولوجي الذي تحدَّث عنه في مطلع الكتاب؛ لذلك أوصى بأنه لا بدَّ من قراءة السوسيولوجيا السياسية لمثقَّفي ما بعد الكولونيالية على ضوء ما يمكن أن يتكوَّن منه أو يكون عليه فكر نقدي في عالم تعولم بالأساس تحت تأثير الغرب، لكنه يسعى حاليًّا للتخلُّص من هذا التأثير.
هوامش
[1] توماس بريسون، انزياح المركزية الغربية نقد الحداثة لدى مثقفي ما بعد الكولونيالية الصينين والعرب والهنود، ترجمة: جان ماجد جبور، (بيروت: مؤسسة الفكر العربي، 2019) الطبعة الأولى بالعربية.
[2] توماس بريسون هو أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس الثامنة، وباحث في “مركز البحوث الاجتماعية والسياسية في باريس” (Cresppa)، وفي “البيت الفرنسي-الياباني” (CNRS-Tokyo). له العديد من المؤلَّفات، من بينها: “المثقفون العرب في فرنسا: هجرات وتبادلات فكرية”.