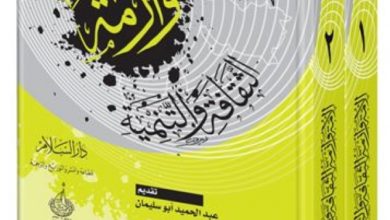التحديات الداخلية والخارجية أمام العالم الإسلامي.. المسار عبر ربع قرن
منتدى الحضارة (موسم 2025 - 2026) - اللقاء الافتتاحي

تقديم: د. مدحت ماهر
هذا هو اللقاء الافتتاحي للموسم الجديد من منتدى الحضارة، ذلك النشاط العلمي الحواري الذي ينظمه مركز الحضارة للدراسات والبحوث كل عام. ولقاءات هذا الموسم سوف تدور حول: تحديات وإمكانيات الأمة، لا سيما في مساحات الثقافة والمجتمع، متَّصلة بالأبعاد السياسية والاقتصادية وسائر المجالات والأبعاد الأخرى كما نفكر من منظور حضاري. الموسم السابق كان عن جديد العلم والعالم، وخُتِمَ بلقاء مهم عن الإسلام والمسلمين في اليابان[1]. وهذا العام نطوف في بقاع الأمة المختلفة وأقاليمها لنراجع حالة المجتمع والثقافة الإسلامية في هذا الأقاليم المختلفة، من منظور التحديات والاستجابات (الإمكانيات). ومفهوم التحديات مفهوم واقعي، أما مفهوم الإمكانيات فمفهوم واقعي وقيمي ومقوم وبنائي في ذات الوقت. ولذلك نفكر في هذا الميزان الذي يرى التحدي أو المشكلات أو حتى التهديدات كما يرى الفرص وإمكانات الحلول، وفتح مساحات البناء والتجديد.
ويسعدنا أن يكون هذا اللقاء الافتتاحي مع أستاذتنا الدكتورة نادية مصطفى، رئيس المركز، وأستاذ العلاقات الدولية، والخبير في العلوم السياسية. وحديثها سيكون بمثابة المظلة أو الإطار لهذه الدورة الجديدة من المنتدى. وستدور محاضراتها حول التحديات الداخلية والخارجية للأمة في ربع القرن الأخير: مسار هذه التحديات، وأهم نماذجها، وجهود وأشكال المقاومة والبناء في مواجهة هذه التحديات.
محاضرة د. نادية مصطفى: “التحديات الداخلية والخارجية أمام العالم الإسلامي.. المسار عبر ربع قرن”
تمهيد:
يواجه المتحدث في هذا الموضوع -من منظور حضاري- تحديان أساسيَّان:
الأول: تحدي الجمهور، فالمحاضرة قد تكون في موضوع جديد عليه تمامًا، أو لا ينتمي هذا الجمهور إلى نفس الدائرة الحضارية للمتحدث.
الثاني: تحدِّي معايشة الموضوع، تأتي هذه المحاضرة في موضوع عايشته وتفاعلت معه، فرديًّا وجماعيًّا -لفترة طويلة، حيث كان الموضوع في قلب العالم وفي قلب انتماء الباحث الحضاري. وفي قلب همِّه البحثي والأكاديمي ضمن ما يُطلق عليه (مشروع الاستراتيجية الكبرى الفكرية Grand strategy Intellectual Project).
ومن هنا كان السؤال: كيف أُخطط لحديثي، خاصة وأنه في مفتتح أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحضارة، وكيف يمكن أن أجعل الافتتاح لهذا العام توطئة للموضوعات التي ستتناولها موضوعات المنتدى؟ ودون انقطاع عما سبقه من ملتقيات؟ وكيف سأجيب عن سؤال: لماذا كانت هذه المحاضرة؟
ولا بد من إشارة هنا، هي أنه منذ تأسيس مركز الحضارة، ونحن نخطط: لإصداراتنا وأنشطتنا الرئيسية، عبر مسار بحثي ينطلق من محور: “الأمة في العالم أو أمتي في العالم”، وذلك انطلاقًا من بحث ثلاث قضايا كبرى: القوة – الجهاد – العلاقة مع الآخر، وذلك وفق منهاجية الرؤية الحضارية، التي يمكن للناظر في قوائم حولية “أمتي في العالم”، وأعداد فصلية قضايا ونظرات، ومشروعاتنا الكبرى أن يستخلصها، ويلتقط هذا الخيط الناظم لهذه الأعمال الذي يدور حول: ماذا يواجه أمتنا؟ وفقه واقع الوهن والاستضعاف المتزايد؟ وكيف نواجهه؟ وكيف نغيره بصيغة بنائية؟ وهو جهد يتراوح بين التحديات والتهديدات، ومن الفقه إلى الواقع، ومن التاريخ إلى الراهن، في ظل أن الغاية هي: التغيير الحضاري.
إذن، نحن -في مدرسة المنظور الحضاري- لا نقدِّم متناثرات، ولكن نقدِّم حلقات في سلسلة واحدة، هي جزء أساسي في التكوين الحضاري المعرفي والمنهجي والنظري، والوعي للمنتمين إلى هذه المدرسة.
عناصر المحاضرة:
بناءً على ما سبق، تنقسم هذه المحاضرة إلى مجموعة أجزاء:
تبدأ بتوطئة وتقديم حول ثلاثة مشاهد راهنة في قلب موضوعنا، ثمَّ نشرح مفردات عنوان المحاضرة وتعريف بمفاهيمه.
ثمَّ تنتقل إلى المحور الأول الذي يقدِّم رؤية الطائر من أعلى عن دلالة ذاكرة تاريخية ممتدَّة للأمة من “التحديات والاستجابات” إلى “التهديدات والمقاومة المستمرَّة”.
أمَّا المحور الثاني فيجيب عن سؤال: ماذا عن نصف القرن الأخير؟ كيف كان المسار وكيف قادنا إلى الوضع الراهن من صعود التهديد وبين أنماط المقاومة المستمرة.
ثمَّ يتولَّى المحور الثالث شرح الدلالات الخاصة بوضع الأمة منذ طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية – الإيرانية.
وأخيرًا، تأتي الخاتمة حول استراتيجية البناء على ضوء هذا التحليل، واجب الوقت.
توطئة وفاتحة: ما الجديد في هذه المحاضرة؟
ثمة ثلاثة مشاهد (من منطقتنا)، وثلاثة نماذج وراءها مسار، وذاكرة ودلالات من الشام الكبير: الحرب في غزة (فلسطين)، وحروب محور الإسناد وفي قلبها مركز الإسناد: إيران، والتغيرات الجذرية في سوريا. ولا أنسى ما يحدث في ليبيا والسودان. هذه المشاهد يتحدَّث الجميع في دلالاتها؛ فالحالة الفكرية للعامين الماضيين اتَّسمت بالارتباك والفوضى.
في وقت تبدو إسرائيل (على أنها الفاعل المحرك المتحدي المعتدي) ليس في قلبنا العربي فحسْب، ولكن في اشتباك مع دوائر عديدة: (إسرائيل والهند، إسرائيل وروسيا، إسرائيل والصين، إسرائيل وباكستان). فعبر مشاهد هذين العامين أضحت إسرائيل مركز التفاعلات: في الدوائر المختلفة من القلب العربي إلى الجوار والهند والصين، وحتى أفريقيا.
لقد أضحت المفردات المسيطرة على منطقتنا: التأثيرات المتداخلة والمتشابكة في ظل التردِّي العربي: حالة التجزئة، والانكفاء، والتطبيع، وحرب عالمية ثالثة، الحاضر الغائب فيها: أن القرار والسياسة العربية (في موات عربي).
الأسئلة الأساسية للمحاضرة:
ما معنى كل هذا الذي نعيشه؟ وما التحديات التي يكشف عنها هذا الفقه للواقع؟ وما درجة ما نواجهه الآن في العالم الإسلامي، ليس في منطقتنا العربية وحدها، ولكن في كافة أرجاء العالم الإسلامي؟ وكيف تحوَّلت التحديات إلى تهديدات عبر نصف قرن؟ ومن المسؤول؟
بدايةً، يجب أن نعلم جيدًا أن هذا لم يكن فجأة، ولم يكن بلا تخطيط من العدو، كما لم يكن من دون استجابات منا ومقاومة بكافة أنواعها. وهذه هي الرسالة الأساسية لهذه المحاضرة: فمهما بلغت التحديات من خطورة، نحن دائمًا لدينا استجابات وأنماط مقاومة؛ فنحن أمة لم تمت!
مفاهيم المحاضرة:
لماذا العالم الإسلامي؟ وما معنى التحديات الداخلية والخارجية؟ وما معنى مسار ربع قرن؟
العنوان دالٌّ على ما يُقال ويجب أن تكون مفاهيمه مُحددة حتى لا يلتبس علينا الأمر.
1- لماذا العالم الإسلامي وليس الأمة؟
مفهوم العالم الإسلامي هو مفهوم جيو-استراتيجي له بعد حضاري، وهو ليس ديموغرافيًّا أو دستوريًّا وحسْب. وبُعده الحضاري ينبع من الرابطة العقدية التي تجمع مكوِّنات هذا العالم باعتبارهم مسلمين.
والمنظور الحضاري للعالم الإسلامي بوصفه نظامًا فرعيًّا دوليًّا يأخذ في الاعتبار عدَّة أمور:
- التركيز على الإسلامي – الإسلامي (العلاقات البينية)
- التركيز على عناصر القوة والإمكانات الداخلية في الأوطان
- ثمَّ التركيز على البيئة الدولية المحيطة (النظام العالمي)
هذه ثلاث دوائر متحاضنة، الأمة في قلبها، فالعالم الإسلامي باعتباره نظامًا فرعيًّا ليس منفصلًا عن غيره من النظم الفرعية المحيطة به، وعن النظام العالمي الكبير. ومن هنا أهمية المقارنات الزمانية والمكانية عن هذه التحديات. فكلما أمكن ننظر إلى هذه التحديات في أطرها المُقارنة.
والحديث عن «العالم الإسلامي»، يثير إشكالية: فالرابطة العقدية الموجودة، فهل «العالم الإسلامي» بديل عن الأمة؟ أم فرضتْه معطيات الأمر الواقع حيث تغلبت معطيات الدول القومية (دول إسلامية) وضعف الروابط بين دوله؟
2- ما المقصود بالتحديات؟
مفهوم التحديات مفهوم متشعب ويتطلب النظر في عدة أمور:
- النطاق الزمني (للتحديات): تاريخ/ واقع/ مستقل
- النطاق المكاني (للتحديات): الأمة سواء الدولة أو الجماعات المسلمة أو حركات مسلمة داخل الأوطان
- منابع التحديات: من أين تنبع التحديات؟ أين مصادرها؟ وما تجلياتها؟
- مجالاتها: داخلي/ خارجي
- كيف أدرسها؟ ما مستويات دراساتها: واقع (سياسات) / فكر ورؤى / مؤسسات؟
3- خصائص الرؤية الحضارية في دراسة التحديات:
المقصود هنا دراستها برؤية حضارية كلية متكاملة، من أهم خصائصها:
- لا يُدرس الداخل منفصلًا عن الخارج
- لا يُدرس السياسي منفصلًا عن غير السياسي
- البحث عن الثابت والمتغير
- البحث عن العلاقة بين العقدي والقيمي والمعنوي وبين المادي
- البحث في التفاعل بين الفكر والنظم والحركة
- النظر في تاريخ هذه التحديات وواقعها ومستقبلها
- وأخيرًا مستويات ظهور هذه التحديات: في الدول / الجماعات / الأوطان
4- الطريقة المنهاجية: منهج النظر والتدبر في هذه التحديات
- مشاهد الواقع ودلالاتها
- الرجوع للتأصيل الحضاري
- المرور بالفكر والتاريخ
- العودة إلى الحاضرة برؤية أوسع
- الرؤية الاستشراقية (سيناريوهات واحتمالات)
5- مسار ربع قرن ودلالاته.. عن أي ربع قرن نتحدث؟
عن بداية القرن الواحد والعشرين، ونهاية القرن العشرين نتحدث. ومفهوم بداية القرن ونهايته مهم جدًّا في الدراسات التاريخية السياسية الحضارية، لأن القرن لا يبدأ عند بداية العام الجديد في الألفية (عام 2000 مثلًا) ولا ينتهي بعام 1999، وهكذا كل القرون، ولكن هناك مفاصل تنقل الأمة التي نتحدَّث عنها والعالم المحيط من مرحلة إلى مرحلة في المسار التاريخي؛ فيحدث تحوُّل في كل الأمور.
واختيار هذه الفترة إنما كان لتوصيل رسالة أن ما يحدث للأمة الآن في أسوأ تجلياته، وفي أكثر حالات الأمة وهنًا وفي حالة تتداعى عليها الأمم، لكن لا تزال هناك مقاومة.
لأن هذه التحديات وإن كانت مسائلها مستمرَّة عبر الأمة إلا أنه حدثت تغيُّرات في أبعادها: العسكرية والاقتصادية والثقافية والدينية، إذ مرَّت بتطوُّرات وتغيُّرات كثيرة. كما تنوَّعت هذه التغيُّرات من إقليم حضاري إلى آخر من أقاليم الأمة عبر العالم، ولكن ظلَّت تجمع بينها قواسم مشتركة كلية، تشير وتنبِّه دائمًا إلى أن شعوب هذه الأقاليم مهما بعدت عن بعضها، ومهما اختلفت سياقاتها ونظمها، هم أمة واحدة، رابطها الإسلام، بقول الله تعالى: ﴿هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 92].
إن الذاكرة عن المسار ومفاصله التاريخية ضرورة لفقه الواقع فقهًا حسنًا، وضرورة لاستشراف المستقبل من أجل تقديم نماذج عن البناء الحضاري وليس من أجل استمرار المقاومة وحسْب.
المحور الأول – ملامح خمسة عقود: الأمة في قلب العالم.. نظرة طائر
لم يكن هذا المشهد الممتد -الذي نعاصره- عبر خمسة عقود فريدًا من نوعه في تاريخ الأمة -العالم الإسلامي- ولكنه تكرَّر مرارًا من قبل في مفاصل تاريخية مهمة (بين قرون أو بين دول خلافة إسلامية، أو بين حروب استعمارية غربية حديثة أو..، ولكن كل هذه المفاصل المتراكمة عبر 10 قرون وأكثر من عمر هذه الأمة من عصر الرسالة إلى وقتنا أعطت دلالات مهمَّة حول ثلاث قضايا متحاضنة، فعبَّرت عن مسارات من النمو والصعود والوحدة ثم التراجع والضعف والفرقة والانحدار.
شهد كل مفصل دائمًا، تحديات وتهديدات خارجية (مثل الفترة الصليبية والاستعمار) واستجابات ومقاومات وجهود بنائية للتجديد والإصلاح. والأساس الذي نلاحظه أن الأمة حين استطاعت أن تستجيب بفاعلية وتوقف التحديات والتهديدات فيما يقرب من 10 قرون بالرغم من تكرارها وتعدُّد أشكالها وأدواتها، فإنه منذ القرنين الأخيرين: قرن تصفية الدولة العثمانية، ثم قرن الاستعمار الحديث، ثم الاستقلال السياسي الشكلي، ومعه دخلنا قرنًا ثالثًا، كان الأمر فيه مختلف تمامًا من حيث الاستجابات والمقاومات (المستمرة)؛ لكن هذه الأخيرة لم تستطع أن توقف التحديات أو تحول دون تحولها إلى تهديدات أو تحدث فيه ردَّة عكسية، فبدا لنا الظاهر أن الأمة في موات، وبدأنا نستخدم مفهوم (كلمة) العالم الإسلامي، وأن الأمة مجرد مفعول به. والسؤال الذي نحتاج أن نفكر فيه هو لماذا ساد هذا الاعتقاد؟
السبب هو أنه: قد تم تطبيق قواعد وأسس الرؤية الإيمانية الحضارية في البناء الحضاري الداخلي والتفاعل مع الأمم الأخرى، في الوحدة بين أركان الأمة منذ بداية عصر النبوة والخلافة الراشدة وحتى عصور الخلافة المتتالية في عصور قوتها ونهضتها[2]. وقد انطبقت السنن الإلهية في فترة الانحدار كما انطبقت على فترة النمو والصعود.
ولكن أضحت القضية الأساسية -خلال فترة الانحدار- هي أن هناك صدعًا في الأمة، وهناك وافدًا ذا مرجعية تغالب المرجعية الأصيلة وتحاول تشويهها، ومع ذلك ظلَّت المقاومة الحضارية قائمة. وفي ظل تصاعد جدلية شهود ومشهودية الأمة أضحى هناك رجحان لصالح تغلُّب “المشهودية”، كما حسمت ثنائية المقاومة والاجهاض لصالح تغلُّب إجهاض محاولات التجديد والإصلاح.
ومع ذلك يؤكِّد كلُّ هذا، أن الأمة محورٌ عالميٌّ وأساسيٌّ في قلب التوازنات العالمية إلا أنها لم تعد إلا مفعولًا به رغم أنماط مقاومتها. وكل هذه الأمور السريعة عن دلالات الذاكرة التاريخية مكتوب فيها بالتفصيل في العديد من أعمال مركز الحضارة[3].
ذاكرة مسار ربع قرن والمفاصل التاريخية للأمة في القرن الواحد والعشرين
في موضوع المفاصل التاريخية يكون الفصل التعسفي بين الفترات الزمنية صعب جدًّا، ومع هذا فإن قراءة التاريخ الإسلامي والعالمي على ضوء هذه الفكرة مجدٍ جدًّا[4]. وما أريد قوله: إن هذا النصف قرن (الربع الأخير من القرن العشرين، والربع الأول من القرن الواحد العشرين) غطى مركز الحضارة الكثير من القضايا الثلاثة الرئيسة به: القوة – الجهاد – العلاقة مع الآخر، سواء ما يتعلق بجزئيات هذه القضايا أو كلياتها.
كان العالم الإسلامي (خلال ربع القرن هذا) يعيش حربًا عالميةً ثالثةً، حربًا عالميةً بالقطعة، ساحتها أقاليم الأمة الحضارية. وهنا أستدعي جهد أستاذنا د. حامد ربيع في كتابه: (الإسلام والقوى الدولية)، وهو تحدث من في التأريخ المعاصر للعالم الإسلامي الذي بدأه بالثورة الإيرانية[5]. ولكن أريد أن أرجع إلى حرب أكتوبر 1973 لأقسم التطورات التي كانت في هذا النصف قرن إلى خمس مراحل:[6]
- مرحلة من أواخر السبعينيات حتى 1991
- مرحلة 1991 حتى 2001
- مرحلة 2001- 2011
- مرحلة 2011- 2023
- مرحلة 2023- 2025 (حتى الآن)
ولا ينظر هذا التقسيم فقط إلى عالمنا العربي معزولًا عن غيره من المناطق والدوائر الحضارية أو نطاقه العالمي، ولكن في ضوء مركز وحوله دوائر حضارية إسلامية عديدة، وإذا كنا نسينا توسيع هذه الدوائر، فإن عدونا (إسرائيل) لم ينس هذا أبدًا في تخطيطه الاستراتيجي. وبالتالي فإن الحديث عن العالم الإسلامي يدور في إطار دوائر:
- القلب العربي (الشام) مع القلب الآسيوي: تزامنًا وتفاعلًا، وصعود القلب الفلسطيني.
- القلب الآسيوي، أفغانستان، باكستان – إيران، والبلقان والقوقازي
- القلب المالاوي (في جنوب شرق آسيا)
وكلها قلوب دوائر حضارية فرعية في الأمة لكن بينها قواسم مشتركة مهمَّة جدًّا من التحديات والاستجابات عبر تاريخها، وفي إطار النظام العالمي الذي نوجد فيه جمعيًا.
المقولة الأساسية التي ننطلق منها تتناول كل مرحلة:
مَرَّ عالمنا العربي الإسلامي بمجموعة من التحديات، ودائمًا ما كانت هناك مقاومة للتحديات، ودائمًا ما كانت هناك محاولات إجهاض لها، وبالتدريج من مرحلة إلى أخرى تحوَّلت التحديات إلى تهديدات تجسِّد الخطر الشديد الذي أضحت عليه ثوابت الأمة، سواء على صعيد مجالات القوة المختلفة: عسكرية واقتصادية ودينية وثقافية ومرجعية.
منذ ما يقارب العقود الخمسة، منذ 1991، والأمة في قلب العالم من جديد بصفتها وصنعتها: الإسلام والمسلمون بعد أن كانت مجرد جزء من العلاقات الدولية، فلقد بات الإسلام والمسلمون مصدر تحدٍّ أو تهديد في نظر “الغرب” الذي يخبو نجمه (منذ سنوات) بعد أن وصل إلى ذروته. ومن ثم أضحى “العالم الإسلامي” بدوره هدفًا لتهديدات وتحديات من “الغرب” حماية لهذه الهيمنة المتآكلة، في إطار ما يشبه العملة ذات الوجهين للعلاقة بين المسلمين والغرب: تحدٍّ / استجابة، وتهديد / مقاومة.
وعبر هذا المسار الممتد انطبقت على الأمة أنماط تاريخية من نماذج الممارسة، وعلى نحو الذي كشف وبيَّن ماهية السُّنن الإلهية في الاجتماع البشري خاصة فيما يتعلَّق بالقضايا الثلاث الأساسية وأسئلتها الكبرى: متى وكيف تتراكم عناصر القوة وعكسها؟ ومتى وكيف تتحقَّق الوحدة وعكسها؟ ومتى وكيف تتبلور فاعلية الجهاد والعكس؟
وبالتالي، بيَّن المسار التاريخي للأمة ماهية هذه السُّنن، والتي تفسِّر الفجوة بين الأصل وما آل إليه هذا المسار وفقًا للسُّنن. فمثلًا كان قرن إسقاط الخلافة العثمانية وما تلاه من قرن حكم الاستعمار (ثم الاستقلال الرسمي)، مفصلين تاريخيين غاية في الخصوصية رتَّبا ما وصلنا إليه الآن: استمرار الانحدار، ولكن مع استمرار المقاومة، ولكن عجزت تلك الأمة طيلة ما يقرب من القرنين عن وقف التهديد الخارجي بكل أنواعه[7]، وذلك على عكس القرون السابقة حينما كانت الأمة قادرة على مواجهة التحديات والاستجابة الفعَّالة تجاهها.
وخلاصة القول سريعًا عن هذه النقطة بشأن هذه الذاكرة التاريخية[8]: أن الأمة عبر تاريخها كانت شاهدةً ومشهودةً، ثمَّ بعد أن كان شهودها هو الأقوى أضحت مشهوديتها تتسارع، ومع ذلك ظلَّت المقاومة الحضارية مستمرَّة.
وهنا نطرح سؤال: ما الجديد بين الثابت والمتغير عبر هذه العقود الخمسة الماضية؟
إن طرح هذا السؤال عقب هذا العنوان وهذا التمهيد يستهدف عدَّة أمور:
- نحن لسنا مفعولًا بنا فحسْب مهما بلغ مقدار الضعف والتجزئة بنا، ولكن نحن فاعلون أيضًا وباستمرار ، ولذا فالموضوع ذو وجهين وليس وجهًا واحدًا كما يبدو من العنوان.
- لم تعد ساحة التفاعل قاصرةً على النظم والحكومات الرسمية، ولكن الشعوب والحركات المختلفة لها دور لا يمكن إنكاره.
- لم يعد الفصل حاسمًا بين التحديات الداخلية أو الخارجية، ولكن هناك تداخلٌ شديدٌ بينهما في ظل العولمة وما بعد العولمة.
- صعود الأبعاد الدينية الثقافية الحضارية على نحو جديد، لا تجعل المواجهة بين النظم وبعضها فقط كما هو المعتاد، ولكن برز على صعيدها موضع الشعوب فرادى وجماعات وحركات، بوصفها فواعل أو مفعولًا بها. ووفق رؤيتي لم تكن هذه الأبعاد غائبة ابتداءً عن التفاعلات الدولية الإسلامية – غير الإسلامية، أو من بين غير المسلمين، ولكن تكتسب كل مرحلة صبغات خاصة. ففي النصف قرن الأخير أضحت هذه الأبعاد آخر ساحات المقاومة أمام التهديدات المباشرة لعصب الشعوب والمجتمعات.
المحور الثاني- خريطة أحداث الربع قرن الأخير ومفاهيمه
سأستعرض معكم خريطة أحداث تندرج تحت المقولة السابقة، ثمَّ بعد هذه الخريطة، سأكلمكم عن المفاهيم الذائعة السائدة في ربع القرن الأخير.
المرحلة الأولى: من أواخر السبعينيات حتى 2000
سأنطلق من تحيز مصري. وذلك من أمر ظهر قويًّا ثم أُجهض، وتحوَّل من تحرير إلى استسلام، ومعاهدة سلام، وليس معاهدة صلح، بل معاهدة سلام أبدي؛ فهذه آخر الحروب.
فهذه حرب أكتوبر 1973 التي رافقَها حظر البترول (سلاح البترول العربي[9]) التي اغتيل على إثرها الملك فيصل، وذلك عكس ما وصل إليه الأمر الآن بشأن تريليونات الخليج منذ 1973 حتى اللحظة الراهنة. هذا السلاح الذي قال عنه كسينجر ستكون هذه هي المرة الأخيرة التي تستخدمونه فيها، ودخلوا في استراتيجيات خطيرة ليقلِّلوا الاعتماد عليه أو ليحولوا دون استخدامه مرة أخرى كسلاح حظر كلي شامل يمكنه أن يؤتي تأثيره مثل ما حدث في عام 1973. وإلى جانب حرب أكتوبر وحظر البترول، شهدت هذه المرحلة عدة أحداثًا تاريخية مهمَّة، منها:
- الثورة الإيرانية 1979.
- الحرب العراقية الإيرانية 1980 – 1988.
- الانتفاضة الفلسطينية الأولى 1987
- احتلال إسرائيل جنوب لبنان 1982.
- الحرب الأهلية اللبنانية 1975 – 1990.
- طرد الروس من أفغانستان 1990.
- القنبلة النووية الباكستانية 1998.
- قضية كشمير (حرب كارجيل) 1999.
- قفزات ماليزيا وتركيا نحو الحضارية بعيدًا عن العلمانية المفرطة محققين نموذجًا تنمويًّا جديدًا.
- حروب البلقان من أجل الاستقلال على أساس قومي – إثني.
- الشيشان وآسيا الوسطى: انتفاضات ومقاومة (المسلمون المنسيون) من أجل الاستقلال بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وانتفاضتهم من أجل البقاء.
- تحرير جنوب لبنان 2000.
- بداية التسويات السلمية مع إسرائيل منذ عام 1975 وترجمتها في التسعينيات بعد ذلك.
- حركات إسلامية سياسية تتحدى النظم القائمة في المشرق والمغرب ومن روافد مختلفة.
- حركات دعوية وتربوية حفاظًا على الهوية الإسلامية في مواجهة العولمة.
لاحظ في هذا كله إنهاكًا تدريجيًّا للقلب العربي وصل لقمَّته عام 2001 بالاتهام بالإرهاب، وتقويض أركانه توطئةً لهيمنة إسرائيل، ولكن في مقابل ذلك كانت هناك بؤر صعود أخرى مضيئة في الأمة بعناصر قوة مختلفة، وظلَّت مستهدفةً من العدو (أمريكا وإسرائيل)، وكانت منها موجات مسانَدة في مواجهة إسرائيل. خلال هذه الفترة كانت الحروب الأهلية قليلة ومتناثرة: حرب أهلية في لبنان، ثم حرب أهلية في السودان، بعدها محاولة انفصال للوحدة اليمنية في الجنوب، وخلافات بين الجزائر والمغرب، لكن لم يكن الأمر قد وصل إلى ما وصل إليه من حالة عامة (من حروب أهلية داخل كل الأوطان العربية والإسلامية مرة واحدة).
المفاهيم الأساسية في هذه المرحلة:
خلال هذه السنوات ظهرت مفاهيم كثيرة أثارت الجدال الفكري الأكاديمي والسياسي والديني على مستوى العالم ومستوى الأمة، وتصدَّرت مفاهيم وشعارات مثل: العدو هو الإسلام، والإرهاب الإسلامي. وظلَّ المسلمون في قلب النظام العالمي لما بعد إنهاء الحرب الباردة والعولمة، ولكن في ثوب جديد بوصفهم “مشهودا عليهم”، ولكن لم تتوقف المقاومة[10]. ففي ظلِّ هذه الهجمة السياسية تكوَّنت وتبلورت المقاومة: فقد تكوَّنت حماس، وتكوَّن حزب الله، وظهر المشروع النووي الباكستاني، وطُردت روسيا من أفغانستان، كما برزت بؤرٌ حضارية جديدة في ماليزيا وتركيا، كما صاحبت زيادة ونمو تعداد وتأثير مسلمي الغرب.
ماذا يعني كل هذا؟
يعني هذا، أن التحديات والتهديدات مستمرَّة لكن بأدوات مختلفة وأن المقاومة لا تكف، كما لا تكف محاولات التقييد والحصار والإجهاض بيد الخارج، وبعضها كان بمساعدة من الداخل.
المرحلة الثانية: من أولى حروب القرن الواحد والعشرين إلى الثورات العربية
بداية القرن الجديد دُشِّنَ لها بما أسميته أولى حروب القرن الواحد والعشرين[11] (أحداث 11 سبتمبر 2001، وضرب برجي التجارة في أمريكا)، وما تلاها من عدوان على أفغانستان، واحتلال لها وعدوان على العراق ثم احتلال لها وانتفاضة الأقصى وإجهاضها عام 2002[12]. وهي مرحلة عاد فيها الاستعمار العسكري الغربي سافراً ظاهراً ملتحفاً بأردية دينية وثقافية وحضارية (قادمون لأجل استقرار العالم).
وقد أنتجنا -كمدرسة حضارية إسلامية- كثيرًا في هذه الموضوعات كما يقول المستشار البشري، ولكن ينقصنا العمل والتحويل لسياسات للبناء.
مجموعة مفاهيم المرحلة:
إن الخطابات والمفاهيم خلال الفترة من (2001 حتى 2004) تشير إلى حالة كبيرة متَّسعة الأرجاء عبر الأمة من المقاومة والتحديات الداخلية والخارجية، كان من أبرز نماذجها[13]:
1- خطاب ساخن غربي عن صدام الحضارات، والعدو هو الإرهاب الإسلامي
- حملات صليبية
- الإرهاب
- محور الشر
- من ليس معنا فهو ضدنا
- حروب حضارية
- حروب مواجهة بين “المتخلفين المستبدين الإرهابين” وبين دعاة “الحرية والحضارة”
- فرز وتمييز واستعلاء كبير على عالم الإسلام والمسلمين من النظم الغربية (أمريكية وأوروبية)
والشعوب الغربية في هذه اللحظة لم تكن بالقدر الذي أضْحت عليه من وعي منذ طوفان الأقصى ومن حيث التنبه إلى خطر الصهيونية على الداخل في دولهم. صحيح كانت في مراكز فكر يسارية دائماً مضادة للصهيونية.
وفي المقابل ماذا كانت الاستجابات العربية والإسلامية الرسمية؟
إن إرهاصات الخذلان الذي نعيشه الآن بدأت منذ 20 عاماً، والتي تجسدت في خطاب اعتذاري؛ كما تجلَّت في عقلية الوهن، التي ظهرت عام 1991 حين تم ضرب العراق باسم تحرير الكويت، ثمَّ هرولة عربية رسمية للاعتذار لإبراء الذمة عمَّا حدث في 2001، وما صاحبها من فتاوى دينية رخوة تعتذر عن الإسلام والمسلمين، وشعوب لم تنتفض بعد ما حدث من كل هذا. ومن ثمَّ، ترتَّب على ذلك أن: أصبح عندنا العراق محاصرًا ثم محتلًّا، مع مقاومة من داخله للاحتلال الأمريكي.
وفي مقابل هذه الاستجابات الرسمية استمرَّت محاولات المقاومة منذ 2001-2011 في مواجهة الطبعة الثالثة من الوهَن والتداعي، فبرزت نماذج عدَّة من المقاومة:
- مسلمو الغرب بين شقي الرحي قوانين الوطنية والمهاجرين
- انتفاضة الأقصى وقمعها 2002
- تحرير جنوب لبنان 2006
- جولة جديدة في تركيا مع «العدالة والتنمية» ضدَّ العسكرة والعلمانية المفرطة
- إيران بين الدعوات لجوار الحضارات وبين بناء القوة النووية الإيرانية
- ما بعد مهاتير في ماليزيا
- العدوان الأمريكي على أفغانستان واستمرار المقاومة حتى تمَّ الخروج الأمريكي عام 2020
- انتفاضات مسلمي غرب الصين (إقليم شينجيانج)
- وأقليات جنوب شرق آسيا المضطهدة: بداية الصحوة والقمع (الروهينجا)
ولكن في مقابل هذه الموجات من المقاومة، كانت موجات التدخُّل الأجنبي باسم الإصلاح السياسي والمجتمعي والمدني: (ضرب الثوابت، وتدعيم العلمية، وتجديد الخطاب الديني، وتغيير المناهج، والتربية المدنية، وإصلاح مناهج التعليم).
وهنا قفزت أدوات التدخُّل الدينية والثقافية والحضارية كما لم تقفز من قبل في العصر الحديث رغم أنها كانت موجودة دائماً طوال تاريخ المواجهة بين الإسلام والغرب بداية من الاستشراق، ولكن هذه المرة لم تُوَجَّهْ لعقل العلماء والأكاديميِّين والمفكِّرين وحدهم، ولكن أضْحت تضرب في الثوابت لدى الشعوب، وكل ذلك في ظل موجات من حوار الأديان والثقافات بين الاعتذار والهجوم وبناء الجسور والتعارف[14].
المرحلة الثالثة: عقد الثورات العربية (2011 – 2023)
في إطار فهم وقراءة المشهد الحالي، لا يمكن أن ننسى عقد الثورات العربية والحروب الأهلية العربية. لاحظوا أن الثورات العربية تعد آخر موجة مما سُمِّيَ التحول الديمقراطي في العالم الذي بدأ في أمريكا اللاتينية ووصل لدول القوقاز حتى وصل لبعض الدول الأفريقية، ثمَّ كانت موجة الثورات عام 2011 في دولنا العربية متأخِّرة جدًّا في اللحاق بركْب التحوُّل الديمقراطي من خلال حركة الشعوب (التحول الديمقراطي من أسفل) وليس من خلال الأعمال المؤسسية (التحول الديمقراطي من أعلى). وبالتالي فإن هذه المرحلة شهدت عدة ملامح أساسية.
ملامح كبرى أساسية:
- مقاومة النظم العسكرية العتيدة للثورات بأنماط مختلفة (ثورات مضادة لثورات الشعوب): مصر / سوريا / ليبيا / اليمن / ثم السودان.
- صعود حركات سياسية إسلامية متنوِّعة / سلمية / عسكرية / شيعية / سُنِّيَّة أضحت هي الفاعل ثم المستهدف.
- سياق إقليمي مُعَادٍ: تحالفت فيه نظم خليجية مع إسرائيل ضد النظم أو القوى الثورية وفق كل حالة.
- والأخطر تحول الثورات إلى حروب أهلية متعدِّدة الدرجات.
في هذا السياق والتحديات، تبلورت عدَّة نتائج وخلاصات:
أولًا- التحول في العدو: لم تعد إسرائيل هي العدو، ولكن أضحت إيران والإرهاب وليس إسرائيل.
ثانيًا- الحروب الأهلية والتجزئة: أضحت التجزئة شائعة في ظل حروب أهلية متزامنة داخل عدَّة أوطان ومثقلة على الشعوب (السودان – اليمن – لبنان) بعد ما كانت تشهد من أربعة عقود حروبًا أهلية محدودة النطاق، من قبل فرادى وعلى التوالي.
ثالثًا- الجوار الحضاري (الإيراني – التركي): أصبح يشارك بدرجات مختلفة في مقاومة العدو الأصلي (إسرائيل) من خلال توزيع أدوار عسكرية وسلمية ولكنها أدوار تنافسية بين إيران وتركيا.
رابعًا- تحديات السياق الدولي: لم يعد الإطار الدولي حول العالم الإسلامي يقدم فرصة للمناورة السهلة المجدية في مواجهة الهيمنة الغربية بقيادة أمريكية وإسرائيلية، ليس في المركز العربي وحده، ولكن في الدوائر الحضارية الأبعد المجاورة من إيران إلى باكستان (وذلك في ظلِّ الانشغال الروسي بأوكرانيا والصيني ببحر الصين وجنوب المحيط الهادي)؛ وبالتالي: ناورت الصين وروسيا بين الثورات وبين إسرائيل وأمريكا لخدمة مصالحها.
خامسًا- الموقف من الحركات السياسية الإسلامية: هو الاستهداف العلني والصريح والشامل للحركات السياسية الإسلامية بكل أنواعها، ووضع الجميع والمجتمع في سلة واحدة (الإرهاب). والإرهاب لم يعد ذريعة أمريكا وحدها، ولكن ذريعة النظم المستبدَّة لضرب هذه الحركات.
سادسًا- تزايد مظاهر التهديد السيبراني: أُضيف مصدر تهديد مباشر ضد الأمن السيبراني مع تزايد موجات التجسُّس والتدخُّل والضربات عن بُعد.
وأخيرًا: لم تنتهِ المقاومة في القلب العربي، وفي الشام الكبير، في غزة والضفة، وكذلك كانت مستمرَّة في أفغانستان حتى انسحبت أمريكا في مشهد مخزٍ للقوات الأمريكية، وعادت طالبان للحكم ثم جاء انفجار طوفان الأقصى ولم يكفَّ مسلمو الغرب عن مقاومتهم في مواجهة تيارات العنصرية المضادَّة للهجرة، والتي تزايدتْ مع تصاعد موجات الهجرة إلى القلعة البيضاء (أوروبا) منذ 2015.
المحور الثالث- دلالات طوفان الأقصى والحروب الإسرائيلية على غزة (2023- 2025)
أخيراً نَصِلُ إلى دلالات طوفان الأقصى والحروب الإسرائيلية أو المعارك الإسرائيلية الإيرانية. وهنا أؤكِّد أنه مع طوفان الأقصى تفجَّر الإيمان بأن المقاومة على مستوى الأمة لم تنته، وخاصةً في مواجهة العدو الرئيسي.
مشاهد كاشفة:
خلال هذه المرحلة، رأينا عدَّة مشاهدة كاشفة عمَّا وصلتْ إليه التهديدات من قلب الأوطان ذاتها بأيدينا وبموالاة مع الخارج صريحة وفاجرة:
- صدوع داخلية خطيرة في الأوطان: حول ضرورة المقاومة وأثمانها في مقابل ما يسمى التنمية والأمن القومي.
- غياب الوعي الجماعي الرشيد لمواجهة التحديات والتهديدات الحقيقية تحت سطوة أذرع الإعلام العميلة.
- انكفاء كل نظام وكل دولة داخل حدودها، وخذلان القدس والأقصى وغزة وقضية فلسطين كلها: إن لم يكن التواطؤ عليها سمةً عامةً يشارك فيها الجميع بدرجات، فلقد أنهى الطوفان الحدود بين محور ممانعة ومعتدلين، أو دول مواجهة ودول طوق.
- عدو الأمة -كما يصدَّر للشعوب – من داخلها، وفي تحالف واضح وصريح ومعلن مع عدوها الرئيسي الذي كشف بفُجر وفجاجة عن مخطَّطاتها التوسُّعية.
وفي المقابل، فإن الأمة تمَّ استحضارها ليتمَّ اختبار شهودها أو مشهوديتها حول القضية المركزية للأمة التي انتفض أبناؤها من جديد (فلسطين)، وهو ما كشف عمَّا يلي:
- تركيا: ظاهرة قولية قوية.
- إيران: تتدخَّل بقدر، وفق استراتيجية إيرانية قومية لها أدواتها في الخارج، وهدفها الرئيس حفظ المركز الإيراني (استراتيجية الردع التدريجي المتصاعد) وليس من أجل قضية فلسطين.
- باكستان: مناورة أخرى لمصالحها.
- كانت مساندة الشعوب عن بُعد دون تأثير على النظم، في ظل زيادة الفجوة بين النظم والشعوب العربية والإسلامية؛ فيما يتَّصل بالعجز عن المقاومة والنُّصرة الرسمية والوعي الشعبي بأهميتها ولكن مع عجز من نوع “استدعينا الأمة فلم نجدها إلا رمزًا” مؤسساتنا جميعًا أو رسميًّا فردية، أو شُعَبًا.
- امتداد اليد الإسرائيلية إلى الوسط الآسيوي، خاصة في ظل الحرب بين الهند وباكستان (دولة نووية إسلامية أخرى على القائمة).
الجديد فعلًا: هو الفرز القوى بين النظم الغربية وشعوبها؛ حيث شهدت هذه البلدان هَبَّةً غير مسبوقة لمساندة على أكثر من مستوى لغزة وفلسطين.
وأخيرًا، ماذا علمتنا غزة في فلسطين بشأن هذه التحديات جمعيها وعلى ضوء هذا المسار؟
علَّمتنا غزة: أن الشعوب والحركات هي التي عليها واجب عودة الشهود للأمة وليس النظم وحدها. ولتحقِّق هذا يجب أن تكون هذه الشعوب والحركات والجماعات محافظة على أمور كثيرة في ثوابتها. ومن هنا كان اهتمام الملتقى والحولية -كما قلت- بأن نتعرَّف على الداخل في أوطاننا العربية والإسلامية الذي يمكن من استمرار الصمود والمقاومة وبناء وعي جماعي جديد ومتجدِّد وإصلاح قلب الأمة وعمودها الفقري وأعصابها وليس مجرد سياستها العُليا وقوتها العسكرية والاقتصادية وإن كانت مهمَّة.
ملاحظات الختامية: خلاصات تدبرية، وواجب الوقت
الرسالة من هذا الملتقى: هو الإجابة على السؤال كيف ننظر؟ كيف نفكر؟ كيف نتدبَّر؟ كيف نستشرف؟
وخلاصة التدبُّر والتفكُّر في هذا الموضوع تصل بنا إلى أن:
- المقاومة مستمرة وقابلة للاستمرار، ومع الوقت قابلة لتغيير المعادلة وعدل الموازين سواء تجاه النظم (من النظم) أو من الشعوب؛ هذا الأمر يجب أن نؤمن به ولا نسقطه على الإطلاق والمقاومة متعدِّدة الدرجات والمستويات، ما نقوم به نحن هو مقاومة فكرية.
- المقاومة ضد احتلال الأرض وضد منع التسلُّح وضد امتلاك عناصر القوة وضد التجزئة وتجزيئ ما هو مجزَّأ أصلا وضد لعبة الإعلام التي تستلب الوعي حول من العدو؛ وهذه المقاومة يجب أن تستمرَّ ويزداد تفعيلها.
- ثبت وتأكد أن القدرة على الصمود في وجه القوة الصلبة الغاشمة واختلال موازين القوة، والنماذج عديدة، ليس في غزة وحدها، ولكن حدث مثلا في أفغانستان، وهو هو ناتج عن الإرادة والقوة المعنوية مهما كانت فداحة التكلفة؛ هكذا تتحرَّر الشعوب، وهكذا يحدث التغيير؛ لذا واجب الوقت هو الحفاظ على هذه القوة: الوعي، والإرادة، والانتماء، والاستعداد للتضحية، والإباء ورفض الاستسلام سواء بالنسبة لحركات المقاومة أو الدول التي ما زالت تقاوم.
- معنى النصر والهزيمة: ما معنى النصر والهزيمة في ظلِّ الأكاذيب الأمريكية والادِّعاءات الإيرانية والإسرائيلية المتبادلة بشأن من الذي انتصر؟ حتى يُخفوا ما يجري الإعداد له تاليًا؟[15]
إن النصر أن تصمد أمام عدوك، حين يكون الظرف غير مُواتٍ، وأن تُلحق بعدوِّك أكبر ما تستطيع من الخسائر، في حدود إمكاناتك، دون أن تهوِّن من صمودك، ولا من خسائر عدوك… وقد صمدت غزة رغم الحصار الطويل. وقد صمدت إيران، وصمدت العديد من النماذج المعتدَى عليها، والمحاصرة الآن ومن قبل.
- مفهوم من الذي يصنع السلام؟ أثير أن الذي لديه القوة هو الذي يستطيع أن يصنع السلام.. ولكن ما مفهوم القوة؟ وما مفهوم السلام؟ ومن يتحدث عنهما: المحتل / المعتدي / الغاصب؟ أم صاحب الأرض والحق / المقاومة؟
خلاصة الأمر أننا عبر ربع قرن من التحديات وربع قرن من التهديدات. تظل هذه التهديدات وما تلقاها من المقاومة تطرح معضلات وثنائيات أمام فقه الأولويات والمقاصد لترشيد المقاومة والبناء:
– هل تُعطى الأولوية للحرية وكسر الطاغوت كما حدث في حالة سورية أم مقاومة العدو حتى ولو كان النظام القائم متحالفًا مع من يقول إنه يتصدَّى للصهيونية؟
– اصطفاف الأمة أم تغلُّب المذهبي والمصلحي كما في حالة الحرب على إيران أو الحرب على غزة.
– الثبات على المقاومة والصمود أمام العدو مهما كانت التكلفة وهذا التدمير المدني؟ ولماذا هذه التكلفة الفادحة في الأرواح؟ وهو المدخل الذي تهاجَم منه المقاومة دائماً خلال العامين الماضيين.
– وأخيرًا القوة المادية والقوة المعنوية وتأثيرهما في ميزان القوة: إن عناصر القوة المادية (التي ثبت أنها لا تكفي بمفردها) متوفرة لدى أطراف كثيرة في منطقتنا، فالخليج عنده عناصر قوة، وإيران عندها عناصر قوة، ومصر عندها عناصر قوة، فالأمر ليس خللًا في ميزان القوة المادية، ولكن الإرادة والقرار مهمان والرؤية المرجعية أهم في تحديد هذا الأمر ولهذا فإن قصة القرارات والسياسات الخاصة بالدول التي عندها عناصر قوة واختياراتها مع المعتدي ضد المعتدى عليه تحتاج إلى فهم.
– الأمن القومي أم التنمية: هل تقدِّم مفسِّرات الأمن القومي ومفسِّرات التنمية والاستقرار والسلام شيئًا حقيقيًّا ملموسًا لدولنا؟
– الداخل والخارج: فيما يتعلق بحالة سوريا وحالة حزب الله؛ فالأخير يقبل السكوت عن إسناد المقاومة من أجل الداخل اللبناني، وسوريا تسكت عن العدوان الاسرائيلي وتأخذ جانب أمريكا لترفع العقوبات لأجل ضمنا استقرار الداخل السوري؛ فكيف تُدار هذه الموازنات؟ والأهم: كيف تُكسر؟
وخلاصة ما سبق يشير إلى أن عالمنا الإسلامي يتعرَّض -وباختصار شديد- إلى اقتلاع جذور فكرة المقاومة ذاتها بجعل تكلفتها عالية جدًّا وغير مثمرة من النواحي المادية التي تشكِّل مرجعية من يتحدَّث بها، وليس مجرَّد عملية إجهاض لحركات المقاومة، وبالتالي فإن لعبة العقول والقلوب وفي قلبها المرجعية الإسلامية بثوابتها هدفٌ أساسيٌّ وأداةٌ أساسيةٌ في هذه المرحلة لا يجب أن نغفل عنها، وتشهد على خطورتها حالة التشرذم في ردود الفعل من مواقع التواصل ومن مراكز فكرية وإعلامية حول قضية مصيرية نقودها وهي المواجهة مع العدو الصهيوني ونجد حولها هذا الاختلاف والتجزئة المميتة من الداخل، التي هي أشد خطورة أحيانًا من سلاح العدو.
اتجاهات النقاش:
دارت اتجاهات النقاش حول حقيقة كون العالم الإسلامي نظامًا فرعيًّا فعليًّا تتبنَّاه الدول وتتفاعل في إطاره، أم أن كل دولة تعتبر نفسها منتمية لأنظمة فرعية أخرى أهم ولا تُعنى بهذا المفهوم من الأساس. وبالتالي هناك أهمية لإعادة تفكيك وإنتاج مفاهيم: الدولة الإسلامية – العالم الإسلامي – الأمة الإسلامية، والعلاقة بينها، ووفقًا للغاية من الرسالة، فهل يمكن أن تكون دولة مثل جنوب أفريقيا جزءًا من العالم الإسلامي؛ لأنها هي من رفعت الدعوى في المحكمة الدولية ضد إسرائيل وليس أي من الدول المسلمة!
أمر آخر هو مسألة وضع أن الممثلين عن نبض الشارع والمسلمين هو الحركات السياسية الإسلامية بينما هي في بعض الدول والمواقف كانت وظيفية لصالح أنظمة معينة، في حين أنه على العكس هناك قوى مدنية حتى في الغرب عبرت بشكل أكبر من هذه الحركات عن تضامنها مع القضية الفلسطينية؛ ومن ثمَّ فهو أمر يحتاج لإعادة النظر فيه بشأن دور الحركات السياسية الإسلامية.
والإشارة إلى أن مسألة الاستهداف ليست قاصرة على الأمة الإسلامية (والعالم الإسلامي) ولكن أداة من أدوات القوى المهيمنة للإبقاء على سيطرتها على العالم؛ فالصين مستهدفة، وكذا روسيا، وغيرها كثير من دول ومناطق العالم. وأن مشكلة الخذلان هي مشكلة داخلية بالأساس وليست خارجية، بدأت من أخطاء في تعامل القوى الداخلية والنظم مع المشكلات والتحديات التي تواجهها، مثل مشكلات الأقليات، وغيرها من المشكلات التي يتمُّ التعامل معها بطريقة وضع التراب على المشكلات، وليس وضع حلول حقيقية لها. كما أنه جرى التأكيد على أن مسألة الأولويات والثنائيات هي فخٌّ يجب ألا نقع فيه؛ لأن تحرير الداخل جزء من مواجهة الخارج، وكذلك وضع ثنائيات الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الغرض منها لا تحقيق هذا ولا ذاك من الحقوق.
مسألة أخرى بشأن أخطاء -بل وأحيانًا- “انحرافات” المقاومة، مثل حزب الله وتدخُّله في سوريا، وانحرافه عن شعارات المقاومة، فلم ينصر الشعب، بل على العكس تدخَّل لقمع حركته، وبالمثل قامت به إيران في مشروعها التوسُّعي الطائفي في المنطقي، ومن ثمَّ ضرورة الاعتراف بأن ضعفنا هو من داخلنا، وعن ماذا ينبئ ذلك بخصوص قدرة الفواعل من الدول وغير الدول على تمثيل الشعوب والتعبير عن فاعلية مقاومتها؟
وكذلك التأكيد على ضرورة التنشئة الواعية للأجيال القادمة، خاصة في ظل التحديات الرقمية والتكنولوجية، وذلك لتسليح أفراد الأمة بأدوات المقاومة الحضارية الرقمية. وفي ظل تزايد تعداد المسلمين في الدول الغربية وفي خارج العالم الإسلامي، كيف يمكن مد أواصر وجذور التواصل مع هذه الفئات لتقوية الروابط بين الأمة؟ من ثمَّ هناك ضرورة لتأسيس مراكز فكرية وحضارية توجِّه المسلمين بشأن كيفية التحول من رد الفعل إلى الفعل الحضاري المؤثِّر.
التعقيب الختامي – د. نادية مصطفى:
- ما ذُكر من ثنائيات هي ثنائيات نكدة، وليس الغرض من طرحها الاختيار من بينها، بقدر ما هو الجمع بينها وفق أولويات وموازين دقيقة.
- ذكر الخارج والداخل والعلاقة بينهما، يأتي من منظور الحضاري في ظلِّ التشابك بينهما، وإن كان الاعتقاد السائد عندنا أن المنطلق والمُحدد هو الداخل.
- لا أحد يختلف أن لدى إيران مشروعًا توسُّعيًّا في المنطقة، وفي إطار جوارها الجغرافي، شأنها في ذلك شأن كافة القوى الإقليمية تاريخيًّا وحاضرًا، وفي إطار سياقٍ تاريخيٍّ وتحديات معيَّنة دفعتْها لذلك؛ ودائمًا ما كان عبر التاريخ تنافسٌ بين أركان متنافسة في العالم الإسلامي على الزعامة والقيادة ولكن في نطاق الدفاع عن العالم الإسلامي ضد غيره، وهناك أمثلة تاريخية كثيرة.
- العالم الإسلامي، هو نظام فرعي دولي (نوعي)، يعني أن الرابطة بين مكوناته معنوية عقيدية دينية، وليس نظامًا فرعيًّا إقليميًّا، كما كان الحديث عن رابطة عدم الانحياز. وليس من شروط الحديث عن نظام دولي فرعي (وفقًا لنظرية النظم أن يكون لأطرافه سلوك متَّسق أو نمط علاقات معيَّن أو يتحرَّك ككتلة واحدة)، وإنما وجود أنماط من التفاعل والعلاقات بين أطرافه.
- هناك أهمية للحديث عن قواسم مشتركة (إنسانية) بين المجموعات المختلفة من الفواعل، وهنا يكون مدخل للتعاون والعلاقات بين هذه المجموعات انطلاقًا من هذه القواسم والقيم المشتركة، دون إلغاء لماهية الرابطة الإسلامية والعقيدة لدى العالم الإسلامي، وبحسب الموضوع يكون التعاون أو عدمه، مصداقًا لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: 2].
- هناك ضرورة للتفريق بين الحركات السياسية الإسلامية، والتمييز بينها وبين أدوارها الإيجابية والسلبية تجاه القضايا المختلفة، وبخاصة تجاه القضية الفلسطينية، والعلاقة مع السلطة، ومن هنا تتبدَّى أهمية دراسة الفاعلين من غير الدول ودراسة فاعليتهم في الدفاع عن الأمة، والحفاظ على مرجعيتها، وفي إطار تنوُّع وظائفها الحضارية بين الديني والتعليمي والدعوي والسياسي والاجتماعي[16]، وفي تاريخ الدول الإسلامية لم تكن هناك فكرة الجيوش النظامية، حتى العصر العثماني تقريبًا، فحين تقوم الحروب الكبرى كانت هناك دعوة للجهاد[17].
- إن الحروب مع إسرائيل لن تكون حروبًا نظامية، ولكن ستكون حروبًا غير نظامية بين إسرائيل والفصائل.
- إن الصراع مع إسرائيل، هو صراع مركَّب ومتعدِّد الأبعاد، قومي وديني وعقيدي وسياسي وإنساني، ولا يمكن قصره على أنه صراع إسرائيلي فلسطيني أو أنه صراع إسرائيلي عربي، ولكنه صراع إسلامي إسرائيلي.
وأخيرًا، أقول إن العلم يجعلنا نضع الاختلافات إلى جوار بعضها، والاستفادة منها، وقراءتها في سياق إنتاج أفكارها، ولكن دون تبنيها أو التخلي عن أفكارنا وقيمنا ومعتقداتنا.
—————————————
الهوامش:
[1] للمزيد بشأن هذا الملتقى، والملتقيات الأخرى في الموسم السابق لمنتدى الحضارة انظر:
أياكا كورودا، الرؤية اليابانية للإسلام والعرب، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، 14 مايو 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/0mApY
[2][2] انظر هذه القواعد في:
– نادية مصطفى وسيف الدين عبد الفتاح (تحرير وإشراف)، حولية أمتي في العالم، العدد الأول: الأمة والعولمة، (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، 1999).
– نادية مصطفى وسيف الدين عبد الفتاح (تحرير وإشراف)، حولية أمتي في العالم، العدد الثاني: العلاقات البينية داخل الأمة، (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، 2000).
[3] انظر خاصة:
مجموعة من المؤلفين، حولية أمتي في العالم، العدد السابع عشر: مائة عام على إسقاط الخلافة، (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات والبحوث، 2024).
[4] للمزيد انظر: نادية مصطفى، الهجمات الحضارية على الأمة وأنماط المقاومة: بين الذاكرة التاريخية والجديد منذ الثورات العربية، العدد الثالث عشر من حولية أمتي في العالم “المشروع الحضاري الإسلامي: الأزمة والمخرج”، (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، 2017)، متاح عبر الرابط التالي: https://hadaracenter.com/?p=2954
[5] نادية محمود مصطفى، قراءة في أعمال حامد ربيع عن العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، (في): حسن نافعة وعمرو حمزاوي (تحرير)، أعمال ندوة قراءة في تراث حامد ربيع، (القاهرة: جامعة القاهرة، قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2004).
ونشر لاحقًا في: نادية مصطفى، قراءات في فكر أعلام الأمة، تقديم: سيف الدين عبد الفتاح، (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، دار البشير للثقافة والعلوم، 2014).
[6] للمزيد بشأن هذه المفاصل والمراحل انظر:
– نادية محمود مصطفى، كيف يتشكل عالمنا العربي الإسلامي في الحقبة الراهنة؟، منتدى الحضارة، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، 22 فبراير 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/zxSOP
[7] نادية محمود مصطفى، مدحت ماهر، مقدمة العدد، (في): مجموعة من المؤلفين، حولية أمتي في العالم، العدد السابع عشر: مائة عام على إسقاط الخلافة، مرجع سابق، ص ص 27 – 37.
[8] انظر بشأن هذه التحديات:
سيف الدين عبد الفتاح، التحديات السياسية الحضارية في العالم الإسلامي: مع إشارة للتحديات السياسية الداخلية، (في): الكتاب السادس: الأمة في قرن.. تداعى التحديات والاستجابات والانتفاض نحو المستقبل، العدد الثالث والرابع: عدد خاص تحت عنوان “الأمة في قرن”، (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، مكتبة الشروق الدولية، 2004)، ص 471.
[9] انظر مشروع تجديد نشر مؤلفات حامد ربيع، وبخاصة كتابي:
حامد ربيع، التعاون العربي والسياسة البترولية، مراجعة وتحرير: مركز الحضارة للدراسات والبحوث، (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات والبحوث، 2022).
حامد ربيع، البترول العربي واستراتيجية تحرير الأرض المحتلة، مراجعة وتحرير: مركز الحضارة للدراسات والبحوث، (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات والبحوث، 2022).
[10] للمزيد انظر:
– نادية مصطفى، الخطاب العربي-الإسلامي وضربات الناتو حول كوسوفا، (في): حولية “أمتي في العالم”، القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، فبراير 2000.
– نادية مصطفى، جدالات حوار/ صراع الحضارات: إشكالية العلاقة بين السياسي- الثقافي في خطابات عربية وإسلامية، مجلة السياسة الدولية، العدد 168، أبريل 2007.
[11] نادية محمود مصطفى، أولى حروب القرن الواحد والعشرين: رؤية أولية، مجلة السياسة الدولية، 2003.
[12] للمزيد انظر:
– حولية أمتي في العالم، العدد الثالث والرابع: عدد خاص تحت عنوان “الأمة في قرن”، مرجع سابق، (خاصة الكتاب السادس: الأمة في قرن تداعى التحديات والاستجابات والانتفاض نحو المستقبل).
– حولية أمتي في العالم، العدد الخامس: تداعيات اليوم الأمريكي: الحادي عشر من سبتمبر، (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، 2003).
– العدد السادس: الحرب على العراق وتداعياتها على الأمة، (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، 2005).
[13] نادية مصطفى، جدالات حوار/ صراع الحضارات: إشكالية العلاقة بين السياسي- الثقافي في خطابات عربية وإسلامية، مرجع سابق.
[14] نادية مصطفى وسيف الدين عبد الفتاح (تحرير وإشراف)، حولية أمتي في العالم، العدد الثاني: العلاقات البينية داخل الأمة، مرجع سابق.
[15] نادية مصطفى، كيف يتشكل عالمنا العربي الإسلامي في الحقبة الراهنة؟، مرجع سابق.
[16] Nadia M. Moustafa: The missing Logic in the discourse of peace and Violence in Islam, (in): Abdul Aziz Said, Mohammed Abu- Nemer, Meena Sharify- Funk (eds.), Contemporary Islam- Dynamic, not static, (London and New York: Routledge, 2006).
[17] انظر:
– مجموعة من المؤلفين، النظم السياسية في التاريخ الإسلامي (أ)، (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات والبحوث – دار الكتاب المصري، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 2022).
– مجموعة من المؤلفين، النظم السياسية في التاريخ الإسلامي (ب)، (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات والبحوث – دار الكتاب المصري، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 2024).
تاريخ اللقاء: 28 يونيو 2025
إعداد تقرير اللقاء: الباحث أحمد عبد الرحمن خليفة