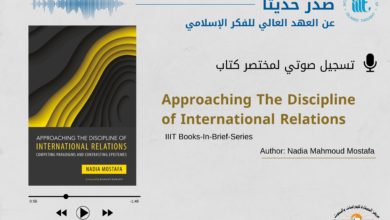في خبرة تطوير التعليم العالي: المسار والإشكاليات
نُشر في: د.سيف الدين عبد الفتاح (محرر)، التعليم العالي في مصر: خريطة الواقع واستشراف المستقبل، أعمال المؤتمر السنوي الثامن عشر الذي عقد في 14-17 فبراير 2005، جامعة القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة، 2006.

احتل تطوير التعليم العالي في مصر اهتمامًا جماعيًا، تمثَّل على عدة مستويات من المؤتمرات التي انعقدت منذ نهاية التسعينيات؛ من أجل البحث والنظر في هذا الأمر. وهو الأمر الذي يتفق الجميع على أنه في قلب عملية تحديث مصر، من خلال التنمية البشرية والإنسانية، وحيث إن هذا التعليم قد وصل إلى حالة “أزمة” تعبر عنها مؤشرات عدة. ولقد رصد هذه المؤشرات بطريقة كلية وشاملة، مشروع و”الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي” تلك الخطة التي ناقشها المؤتمر القومي لتطوير التعليم 2000[1].
وعلى رأس المؤتمرات التي درست هذه القضية، المؤتمرُ الذي نظَّمته جامعة القاهرة لتطوير التعليم الجامعي: “رؤية لجامعة المستقبل” (22 – 24 مايو 1999م)، المؤتمر القومي للتعليم العالي (13 – 14 فبراير 2000): “مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالي”. ولقد استغرق الإعداد للمؤتمر 18 شهرًا، ومن واقع الخريطة الكاملة لمحاور المؤتمر، نجد أنها غطت الموضوعات التالية: فلسفة التعليم الجامعي، نظم التعليم الجامعي، الإطار المرجعي للبرامج التعليمية، طرق التدريس، تقويم التعليم الجامعي، المعلِّم الجامعي، إدارة التعليم الجامعي والتمويل، الخدمات الجامعية[2].
أما المؤتمر القومي لتطوير التعليم العالي 2000، فلقد نظر في مشروع الخطة الاستراتيجية.
وجاء مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالي حصادًا لجهود عديدة استغرقت عدة مراحل، واشتركت فيها جهات ولجان عدة. فلقد شارك في إعداد المشروع مجموعات عمل تمثلت في: لجنة قومية، وست لجان فرعية، ولجان قطاعات التعليم بالمجلس الأعلى للجامعات، وفرق خبراء مصريين، وخبراء عالميين من البنك الدولي، وشخصيات عامة شاركت في جلسات استماع شارك فيها ممثلو اتحادات مهنية. ويتكون هذا المشروع من البنود التالية:
مقدمة تشير إلى المحدّدات الخارجية والداخلية المؤثّرة، والمبادئ والأسس التي احتوتها تقارير اليونسكو والتي تستند إليها استراتيجية تطوير التعليم العالي، الوظائف الأساسية للتعليم العالي، المنهج، وأيضًا المحدِّدات، الجوانب الإيجابية ومصادر القوة والفرص المتاحة لمنظومة التعليم العالي، ومواطن القوة والضعف فيها، القضايا المحورية للتطوير، الأهداف والتوجهات الاستراتيجية، مجالات ومشروعات الخطة.
ولقد انتظمت هذه المؤتمرات في إطار أكبر من الجهود التي تبلورت على مستويات عدة ابتداءً من صدور قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي 10 /1998 بتشكيل لجنة مؤقتة لتطوير التعليم الجامعي والعالي ووصولًا إلى عقد المؤتمر القومي لإقرار مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالي، ثم انتقالًا منذ انعقاد هذا المؤتمر إلى مناقشة أبعاد هذا المشروع في محافل ومنتديات عدة ناهيك عن بدأ تنفيذ مشروعات هذه الخطة البالغ عددها 25 مشروع على مستوى الجامعات والكليات والأقسام وذلك عبر ثلاث مراحل متتالية. والمشروعات التي تضمنتها المرحلة الأولى من التنفيذ (2002- 2007) هي المشروعات التالية:
تقييم الأداء وضمان الجودة، تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية والإدارية، مشروعات نوعية تمول من صندوق مشروع تطوير التعليم العالي، تقنيات المعلومات والاتصالات في منظومة التعليم العالي، تطوير الكليات التكنولوجية (المعاهد الفنية المتوسطة)، تطوير كليات التربية، برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم العالي Tempus-Meda، هذا ولقد تم تشكيل لكل مشروع ومدير تنفيذى لمتابعة العمل به.
هذا ولقد عقدت جامعات عدة مؤتمرات لمناقشة قضايا التطوير في كلياتها وجزئياتها[3] مما يعني أن النقاش حول التطوير مازال مستمرًا، في حين يجري تنفيذ المرحلة الأول منه. وإلى جانب هذه المؤتمرات التي نظمتها قيادات التعليم العالي الرسمية التنفيذية والاستشارية والأكاديمية على حد سواء كان المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا يتابع مهامه الاستشارية ويقدم تقاريره وتوصياته بهذا الشأن[4].
ومع التغيير الوزاري في صيف 2004 تجدد ارتفاع نبرة خطاب تطوير التعليم بصفة عامة، بعد أن كان قد خفت نسبيا. فلقد تعددت لقاءات الرئيس مبارك مع المسئولين والقيادات التعليمية في مصر وانعقد مؤتمر مكتبة الإسكندرية حول تطوير التعليم، وأصدر د. عمرو سلامة وزير التعليم العالي الجديد وثيقة تحت عنوان منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر[5].
إن هذا المسار، الذي امتد من نقاشات تطوير، إلى اتخاذ قرارات وزارية بتكوين لجان ووحدات للتطوير، إلى إقرار مشروعات للتنفيذ مرحليًا، وصولًا –الآن- إلى تجدُّد النقاشات وعقد المؤتمرات مرة أخرى حول نفس الموضوع بقضاياه المختلفة، إن هذا المسار -على هذا النحو الذي يجري عليه منذ 1998- لابد أن يثير سؤالين أساسيين:
السؤال الأول- هل عملية التطوير هي مجرد عملية فنية إجرائية أساسًا تغرق في الجزيئات المهنية أم هي تنفيذٌ لرؤية استراتيجية طويلة الأجل تشخّص موضع الخلل وتحدد الهدف وسبل الوصول إليه؟ وهذه الاستراتيجية المفترض أنها طويلة الأجل تتشكل في بداية مرحلة ويبدأ تنفيذها حتى نصل إلى تقييم مخرجاتها إيجابًا وسلبًا وهي استراتيجية تستهدف أو تستلهم مشروعًا حضاريًا للتطوير والإصلاح ينبى أو ينبثق عن رؤى حضارية لما نريده لأنفسنا، ومن ثم هل عملية التطوير الجارية في مصر تبنى على استراتيجية تنطلق من فلسفة محددة وتعكس أجندة أولويات واضحة؟ أم هي عملية متفرعة تنفذ مشروعات وخطط جزئية فنية متزامنة تتصل بالأعراض ولا تمتد إلى الجذور وتستجب لمتطلبات آنية ولا تدشن عملية استراتيجية من التطوير؟
السؤال الثاني- لماذا يتجدد خطاب التطوير وملتقياته الرسمية والأكاديمية مرة أخرى الآن، في حين أنه لم يتم بعد تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات الخطة القومية التي ثم إقرارها (2000)، ومن ثم مازال الوقت مبكرًاللحكم على إدارة هذا التنفيذ ناهيك بالطبع عن مخرجاتها بعد تفعيلها أي بعد الانتقال من مرحلة إعدادها إلى تطبيقها فعليًا؟ (نظام الجودة وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس مثلًا)؟ إذن ما الجديد الآن بالمقارنة بما بدأ منذ ما قبل 7 سنوات؟ هل هو انتقال من إقرار المبادئ والأسس إلى إقرار آليات الحركة والتنفيذ، كما أكدت على ذلك منطلقات محاضرة د. عمرو سلامة وزير التعليم العالي في جامعة القاهرة في 19/9/2004؟ أم أن الحديث أو حالة العيش في خطابات الإصلاح والتطوير قد اضحى من الأمور المعتادة، حيث أنه مع التشكيل الوزاري الجديد –ومن قبل حدوثه- اضحى حديث الإصلاح موضوع الساعة سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو التعليمي؟
أن الإجابة على هذين السؤالين هو محور هذه الدراسة. وهي تتطلب منهجًا كليًّا في القراءة في المصادر العلمية (وثائق المؤتمرات ونتائجها) من ناحية ومنهجًا كليًّا أيضًا في عرض نتائج هذه القراءة من ناحية أخرى.
ومن ثم فإن هذا المنهج لعرض نتائج القراءة المقارنة في المصادر السابق تحديدها سيتمثل في مناقشة بعض الثنائيات التي تعرض أهم الإشكالات الاستراتيجية التي يكشف عنها مسار عملية التطوير الذي سجلته وثائق المؤتمرات ابتداء من تحديد مؤشرات الأزمة، وتشخيص أسبابها، وتجديد أهداف ومعايير التطوير -بعبارة أخرى– ليس بطاقة هذا البحث أو غيره.
أن يرسم ملامح عملية التطوير بكل أبعادها، كما تقررت أو كما بدأ تنفيذها منذ المؤتمر القومي في 2000، ولكن بمقدور هذا البحث –بل هذا هو هدفه الأساسي- أن يقدم قراءة نقدية كلية في بعض أهم وثائق عملية التطوير المعلنة التي تحدد أهدافه وسبله ومشروعات تنفيذها، سعيًا لتقديم رؤية تقييمية تبرز أهم الإشكاليات التي تعترض هذه العملية والتي قد تقيد من مخرجاتها المأمولة.
فإذا كانت قضية التعليم قد أضحت -في ظل تأزمها- قضية أمن قومي، وإذا كانت عملية إدارة هذه الأزمة هي عملية معقدة مركبة مجتمعية وسياسية واقتصادية وليس تربوية فنية فقط، فإن التحليل السياسي لمحددات ومخرجات وآليات هذه العملية لهو من صميم اهتمام المحلل السياسي المأخوذ بمسار ومآل الإصلاح الشامل في مصر، ومن ثم فإن فلسفة التعليم والرؤية الاستراتيجية لتطويره هي المدخل المناسب لهذه الدراسة. فهل سيقدم هذا التحليل السياسي أساسًا يمكن أن تنطلق منه رؤى إبداعية لحلول جديدة؟
إذن ما هي أهم الإشكاليات الخاصة بمنظومة العملية التعليمية وفلسفتها واستراتيجيتها وأهم توجهاتها والتي نجمت عن القراءة النقدية المقارنة في وثائق لعملية التطوير طوال الفترة الممتدة من (1998 وحتى 2004)؟ وما مغزى اختيار هذه الإشكاليات؟ وما هي نتائج عرضها المتراكم؟
يمكن تقديم الرؤية النقدية حول مجموعات خمس من الإشكاليات التي تطرحها قضايا هامة تنبثق جميعها عن فلسفة التعليم ورؤيته الاستراتيجية.
أولًا- في فلسفة التعليم ورؤيته الاستراتيجية- عن وظيفة ودور التعليم: إشكاليات العلاقة بين القيمي والمادي (كيف)؟
ثانيًا- في دوافع التطوير وتحدياته: إشكاليات العلاقة بين الداخلي والخارجي (لماذا؟).
ثالثًا- في مصادر خبرة التطوير وتمويلها (من؟): إشكاليات العلاقة بين الاعتماد على الذات وبين المساعدة الخارجية.
رابعًا- في بعض قضايا التطوير ومجالاته وآلياته: إشكاليات تحديد الأولويات لكسر الحلقة المفرغة من التأزم، ومن التأرجح بين علاج الأعراض وعلاج الأسباب.
خامسًا- في تأثيرات بيئة منظومة التعليم الجامعي: إشكالية المدخلات (من منظومة تعليم ما قبل الجامعة، من منظومة القيم والأخلاق المجتمعية، من منظومة اقتصاد الدولة والمجتمع (الفقر والديون) من منظومة السياسة (الفساد، وقيود الحرية).
أولًا- قضية فلسفة التعليم والرؤية الاستراتيجية: إشكالية وظيفة التعليم الجامعي ودوره
إن عملية التطوير باعتبارها -وفق تعريف الخطة القومية- عملية تغيير جذري تتعامل مع أسباب ومصادر الخلل وصور الضعف في المنظومة القومية للتعليم العالي وتعمل على تنمية مصادر القوة وتستثمر صيغ التمييز في تلك المنظومة، وحيث أنه من الطبيعي أن يكون كل تطوير ذو طابع وطني وحضاري ومستقبلي، إذن لابد وأن يكون لكل تطوير فلسفة ورؤية تحيط بأهدافه وسياساته وإجراءاته، بل وتحددها ابتداءً
(1) مؤتمر تطوير التعليم الذي نظمته جامعة القاهرة 1999. ومن واقع بعض كلماته ومحاضراته الافتتاحية من ناحية، وعلى ضوء خريطة محاوره من ناحية أخرى، وبالنظر إلى توصيات المؤتمر من ناحية ثالثة، يمكن أن نسجل مجموعة من الملاحظات عن الاقتراب من قضية فلسفة التعليم الجامعي، وهي القضية التي تثير إشكالية المشروع الحضاري الذي يخدمه التعليم والتي يتفرع عنها إشكاليات أخرى تتصل بالرؤية الاستراتيجية التي تستند عليها عملية التطوير.
أ) من الكلمات الافتتاحية: نكتفي فيما يلى برصد المقتطفات التالية ذات الصلة بالقضية موضع اهتمامنا، ولذا فهي تقع جميعها في نطاق معالجة فلسفة التعليم الجامعي والرؤية الشاملة التي ينبثق عنها.
* من كلمة أ.د/ نجيب الهلالي -نائب رئيس الجامعة حينئذ- نورد المقتطفات التالية: “….. شتان بين قرن مضى وقرن قادم: فقد مضى قرن الحربين العالميتين وحركات التحرر والاعتزاز القومي، ونتقدم إلى قرن العولمة والتكتلات الاقتصادية والنظام العالمي…….. انتهت النظرة القديمة إلى التعليم.. على أنه من قبيل الخدمات. فالمؤسسات التعليمية في عالم اليوم هي.. مؤسسات إنتاجية بكل ما تحمله كلمة إنتاج من معنى، وأي منتج أغلى من الإنسان… قياس الكفاءة في أي نظام تعليمي ومعرفة جدواه تتحدد بالعوامل الرئيسية التالية (المحتوى العلمي وطرق التدريس، الإعداد والتأهيل والتقييم، حاجة سوق العمل، التمويل).
* ومن كلمة أ.د/ فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة (حينئذ) نورد مايلي: “… القرن الحادي والعشرين… يشهد فصلًا حاسمًا في المواقع والقدرات بين من يعرفون ومن لا يعرفون….. بين من يملكون المصدر الحقيقي للقوة ألا وهي “القوة العلمية” ومن يتخلون عنها، وستكون القوة العلمية هي المحور الذي تدور معه كل قوة….. ستكون الحد الفاصل في التواجد على الساحة الدولية….. فإن التكوين الصحيح للإنسان المصري يستلزم جعله قادر على التصدي للمشاكل وعلى الوعي الناقد بالواقع والتحليل الكامل لمقوماته والتكيف الصحيح مع أهدافه…”
* ومن كلمة أ.د/ مفيد شهاب وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي (حينئذ) نورد ما يلي: “…(من تحديات العصر): ثورة المعرفة الهائلة، والتطور التكنولوجي السريع، والنظام العالمي الجديد وخاصة ما يتعلق بمقاييس الجودة ووفرة الإنتاج. ولا شك أن تكوين الكوادر البشرية اللازمة لتحمل هذه المسؤولية إنما يتم داخل الجامعات، التي ينبغى عليها أن تقوم بدور أكثر فعالية في تحديث المجتمع علميًا وتكنولوجيًا وفكريًا وثقافيًا، وأن تكسب أفراده قيمًا سلوكية وعملية يمكنها من تدعيم خطوط التنمية في مجتمعنا…”.
ب) ومن المحاضرات الافتتاحية في المحاور ومن واقع خريطة موضوعات المحاور يمكن أن نسجل اقترابًا أكبر من أبعاد القضية وتحدياتها.
من واقع محاضرة د. فتحى سرور تحت عنوان فلسفة التعليم العالي في مصر: رؤى مستقبلية نورد ما يلي: “….التعليم العالي (يسهم) في توفير متطلبات التنمية الشاملة: من معارف متقدمة، ومشروعات بحثية أصيلة، ووسائط تكنولوجية فائقة وتنمية لقوى بشرية كفء وإعداد القيادات تمتلك المبادرات الخلاقة، وتكوين اتجاهات إيجابية عند الرأى العام نحو تثمين العلم والأدب والفن في إطار منظومة قيمية سامية…. يهتم التعليم العالي بمهام من أهمها:
(أ) المشاركة النشيطة في حل المشكلات الكبرى على الصعيد العالمي والمحلي والإقليمي مثل: الفقر، والجوع، والأمية، والاستبعاد الاجتماعي وتفاقم التفاوت على المستوى الدولي وداخل الأمم وحماية البيئة.
(ب) العمل الدائب من أجل تعزيز التنمية البشرية المستديمة وتحقيق العدالة وتطبيق مبادئ الديمقراطية وتحقيق التفاهم وإقامة ثقافة السلام واللا عنف وتحقيق التضامن الفكري والأخلاقي.
“… ومن أبرز وأهم التحديات المجتمعية (التي تواجه التعليم العالي في مصر) الآتي:
1- تحدي السباق الحضاري: إن التعليم العالي مدعو للإسهام الإيجابي في العمل على تدعيم حرية وكرامة الإنسان المصري، ومحاربة المناهج الخفية، وقوى الظلام التي تسرق أحلام بعض الشباب وتغمس أفكارهم في انحرافات خلقيه وفكرية.”
2- تحدي مظاهر العولمة ومخاطر صراع الثقافات: “يثير التوجه نحو العولمة الكثير من المخاوف والشكوك من سيطرة قوة عظمى على الكيانات الوطنية سياسيًا واقتصاديًا وعلميًا وثقافيًا، يتطلب ذلك أن تتناول البرامج الجامعية -مهما كانت التخصصات- ثقافة عامة للطالب الجامعي تعالج في موضوعية تامة إيجابيات وسلبيات مظاهر العولمة كما تعالج بفكر تحليلي ناقد الهوية الثقافية المصرية والشخصية المصرية، يتضمن ذلك أن تهتم البرامج الجامعية بصون الثقافة الوطنية ولا يعنى ذلك تجميدها أو انعزالها بل أن يكون ذلك في إطار تكامل الحضارات والثقافات وليس تأجيج الصراعات فيما بينها بما يؤدى إلى التوجه –من منطلق قومي- نحو العالمية الذي يعكس التكافل على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية تفاديًا للاستقطاب وللحيلولة دون العزل أو التهميش أو التجزىء وعلى أسس عرقية أو دينية أو طبقية”.
“…. (ومن الخطوط الإرشادية للعمل)….
Ø الاهتمام بالثقافة العامة للطالب الجامعي بما يحدث لديه توازنًا بين ما يتعرض له من تأثيرات مزدوجة وربما ثلاثية نتيجة الثقافات الوافدة والثقافة السائدة والثقافات السلفية التي ترفض الوافد والسائد.
Ø الاهتمام بالتربية القيمية ليس عن طريق مقررات إضافية ولكن عن طريق السلوكيات القدوة والالتزام بلوائح والتزامات أخلاقية مهنية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس حتى لا ينزلق الشباب إلى ما أسماه نادي روما بمجتمعات فقدان المغزى التي تتآكل فيها القيم الروحية وتحل محلها قيم الهوس الاستهلاكي والتي يقوم فيها الإنسان بما يملك وما يستهلك.
ومن واقع محاضرة أ.د/ مفيد شهاب وزير التعليم العالي –حينئذ- تحت عنوان “التعليم الجامعي فلسفته ودوره” نورد مايلي:
§ “…. كما أثبتت الدراسات أن الاستثمار في مجال التعليم استثمار اقتصادي والدولة النامية على وجه الخصوص لا تستطيع أن تنفق مبالغ باهظة على التعليم إلا إذا كان له عائد على الاقتصاد القومي يساوي نفقاته بل يزيد عليها، حتى يمكن أن يحقق الدور المطلوب منه وبذلك يكون عملية استثمارية ناجحة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن التعليم يعتبر أداة التماسك الاجتماعي والقومي، بجانب ما تحتاجه التنمية ذاتها من مصادر بشرية وقدرات ومهارات يهيئها التعليم…….”.
§ “….كان التعليم الجامعي يلعب دورًا اجتماعيًا كبيرًا لينتقل بالمواطن من مستوى معين إلى مستوى آخر، وظل هذا الدور هامًا، ويجب أن يستمر، إنما لا يجب أن يكون هو وحده الهدف من التعليم، فإلى جانب هذا الدور الاجتماعي والارتقاء اجتماعيًا ونفسيًا بالمواطن، فلابد أن نجيب على السؤال التالي: ماذا يقدمه هذا التعليم من منتج بشرى في مواجهة احتياجات السوق؟ وإذا كنا نتحدث على أن الجات والاقتصاد المفتوح لا يمكن أن نصمد أمامه إلا من خلال منتج سلعي قابل للتصدير به كفاءة ونوعية متميزة تصمد لمنافسة السلع الأجنبية، فذلك المنتج البشرى لابد أن يقدر على الصمود أمام المنتج الذي تخرجه الجامعات الأجنبية لأن المنافسة على مستوى العالم الذي أصبح قرية كونية، وهكذا فإن قضية النوع قضية تفرض نفسها على التعليم الجامعي مع الاحتفاظ بمبدأ التوسع في التعليم الجامعي، وهذا هو التحدي….”
§ “…. أهم الأهداف الاستراتيجية..حول أهداف منظومة التعليم تتمثل فيما يلي: تعظيم دور الجامعات ومراكز التعليم العالي كمراكز تعليم وتثقيف وتنوير لمصر والمناطق المحيطة بها مع الاحتفاظ بالهوية القومية….”.
§ “…. ووضعت مجموعة من المبادئ منها: أهمية وضرورة التطوير مع المحافظة على الخصوصية المصرية، تأكيد هوية الجامعات واستقلاليتها….”.
جـ) ومن محاضرات المحاور وعن خريطة هذه المحاور يمكن أن نتوقف عند ما يلي:
كان من أهم هذه المحاضرات: محاضرة د/ حامد عمار “رؤية مستقبلية لفلسفة التعليم الجامعي” ونورد منها ما يلي: “….وتأسيسًا على ذلك تتألف الرؤية الفلسفية لجامعة المستقبل في مصر، من تصور لنموذج معياري يحسن اتخاذه إطارًا مرجعيًا يمكن الاهتداء به، ترسيخًا للثوابت وتفعيلًا لأدائها….”.
“….( ومن ثوابت الرسالة الجامعية) أنها جامعة تجمع من ناحية بين استجابتها لغايات ومقاصد المجتمع الذي أسسها لترسيخ مقوماته الحضارية وتجديدها، ودعم ترابطه وتماسكه الاجتماعي ووحداته الوطنية، والوعي بوشائج المواطنة، حقوقًا وواجبات. كما أنها تضيف إلى ذلك من الناحية الأخرى مهمتها المجتمعية في ضخ مقومات الحيوية والتطوير والتجديد والنماء في كيان ذلك المجتمع، تمكينًا له من الإفادة من تجاربه وتجارب الحضارات الأخرى….”.
“….(ومن مواجهة متغيرات التطوير) ومما يساعد على الإبداع والتجديد في الجامعات تنوع المدارس الفكرية في الرؤى المعرفية، والمقاربات المنهجية، والمناظير والنظريات التفسيرية. وفي هذا الصدد يكون الأستاذ أو مجموعة من أعضاء هيئة التدريس معنيين برؤية موضوعية تؤلف مدرسة فكرية معنية، وقد يحتضن البعض الآخر مدرسة تختلف كثيرًا أو قليلًا عن الأولى. وسوف تفسح هذه التعددية الفكرية مجالًا لإثراء المعرفة والتعليم ولفتح آفاق جديدة لمعالجة مشكلاتها. والأستاذ المدرسة هو موقف ومنهج ورؤية موقف علمي رصين في مجال تخصصه، ومنهج ناقد وبناء إزاء قضايا مجتمعية، ورؤية متكاملة نافذة يتحلق حولها تلاميذه ومريدوه. ومن خلال ذلك تتبارز المدارس وتتلاحق على أساس الفكر والرؤية، وليس على أساس الأشخاص والأهواء. ويتنامى رصيد المعرفة من خلال الحوار، وتتوثق العلاقة بين الأستاذ والطالب، ويدرك الطالب أنه ليس هناك نص وحيد للمعرفة مطلقًا وقطعيًا، وأن ثمة وجهات نظر في تفسير الحقائق وتوظيفها. وبهذا تتولد المرونة الذهنية والانفتاح العقلى للمتغيرات والتحولات والاجتهادات التي تحقق التلاؤم مع الثورات العلمية والمعرفية حاضرًا ومستقبلًا….”.
الهوية إذن لدى د/ عمار هى هوية الحضارة وهوية المعرفة، الأولى تتفاعل في إطارها الجامعة مع المجتمع ومع الحضارات الأخرى، والثانية يتفاعل في إطارها الأنساق المعرفية المتقابلة.
q وفي محاضرة أ.د/ عبد السلام عبد الغفار تحت عنوان “تطوير التعليم الجامعي: لماذا؟” تم الاقتراب من قضية الهوية بطريقة واضحة وصريحة انطلاقًا من تحديد تأثيرات المتغيرات العالمية، الإقليمية، المحلية على طبيعة دور الجامعة المصرية، على اعتبار أن جميع هذه المتغيرات ينبغي أن يكون لها تأثيرها فيما نستهدفه من أهداف في الجامعة. ولهذا تتساءل المحاضرة هل يرى رجال الجامعة أن العمل الجامعي سواء في فلسفته وأهدافه وخدماته يرتبط بمثل هذه الأمور التي تؤثر في حياة مصر أم أنه بعيد عن هذه الأمور؟ وإذا لم نكن نستقى فلسفتنا وأهدافنا في التعليم الجامعي من ظروفنا السياسية والاقتصادية والثقافية فمن أين نستقيها؟ وهل يمكن أن تنعزل الجامعة عن المجتمع، وهل يمكن أن تنعزل الجامعة عن المجتمع بعيدة عن مشكلاته الاجتماعية والاقتصادية وتكتفي بدورها في تعليم ونشر المعرفة وتطويرها في صورها المختلفة؟ إذا كنا نشهد انتشار بعض المفاهيم، مثل العالمية والكونية، وإن كنا نستشعر أن هناك محاولات بدعوى هذه المفاهيم للتأثير في ثقافتنا، أليس من حق مصر على الجامعة أن تساعد في تأصيل وترسيخ هويتنا الثقافية وترسيخ أصولنا الثقافية مع المساعدة في تطويرها؟، هل ستستمر الجامعة في تبني مجموعة من الأهداف التي تدور حول المعرفة نشرًا وتطويرًا، أو نفكر سويًا في الاستجابة لما يحدث حولنا من تغيرات تحدثنا عن بعضها فنطور من أهدافنا؟ ويذكر د. عبد الغفار من بين هذه الأهداف:
مجموعة الأهداف الاجتماعية: وهى مجموعة من الأهداف التي تستهدف تحقيق كل ما من شأنه المحافظة على المجتمع وتطويره وتأكيد استمرارية هذا التطور، وتدعيم القيم الدينية وأساليب الحياة الديمقراطية وكل ما من شأنه تنظيم العلاقات بين الناس بعضهم البعض، كما تدور هذه الأهداف حول معاونة المجتمع في مواجهة مشكلاته المختلفة، المشكلة السكانية، الأمية، الإنتاج وغير ذلك من مشكلات.
وفي دراسة د. أحمد فؤاد باشا تحت عنوان “فلسفة التعليم الجامعي في عصر العولمة”، اقترب د. باشا مباشرة من قضية عدم وضوح فلسفة التعليم، إذ بين كيف أن الدراسات العالمية المقارنة تغزى الفجر الذي يصيب نظام التعليم في دول العالم الثالث إلى “أن كثير من الدول النامية قد غدت معرضًا عالميًا كبيرًا لأشتات من النماذج والفلسفات التعليمية الوافدة من كل انحاء العالم الصناعي، وأنها تحاول تطبيقها كما هي، أو مرتدية شعارات التجديد والتطوير في بيئة تختلف عن بيئاتها الأصلية”. ولذا فإن د. باشا وضع على رأس الأسس الفكري والعلمية الضرورية أسند صياغة رؤية مستقبلية لفلسفة التعليم الجامعي في ظل العولمة، ما أسماه “تأصيل الثقافة وتعزيز قيمتها بما يجعل سلوك الفرد فيها متوافقًا مع الإطار الفكري الذي يحكم حركة المجتمع ويحدد أهدافه، فالعلاقة جد وثيقة بين تنمية الإنسان حضاريًا وبين انتمائه فكريًا وعقائديًا.. وهنا تعتبر الثقافة الإسلامية الرشيدة” تخصصًا غائبًا في نظام التعليم العام، والحاجة إليه ضرورة حضارية لإذكاء الشعور النفسي القائم على المعرفة الصحيحة لطبيعة العلاقة بين ثلاثية الدين والكون والإنسان كما يعرضها المنهج الإسلامي المتفرد عما سواه. ويصدق الأمر نفسه على اعتماد الأساليب المناسبة لتعليم اللغة العربية، فإتقانها هدف أساسي من أهداف تطوير التعليم وضرورة لأزمة لبلوغ الأهداف الأخرى”. والأسس الأخرى التي ذكرها د. باشا هي تحقيق التكامل المعرفي من ناحية (ولذا تظهر الحاجة إلى عدة تخصصات غائبة منها تاريخ العلم وفلسفته التفكير العلمي، أخلاقيات العلم، مهارات عقلية وفنية وبدنية) ومن ناحية أخرى ممارسة حرية اتخاذ القرار الأكاديمي في ظل مناخ ديمقراطي ومن ناحية ثالثة: اعتماد المنهجية العلمية أساسًا في تطوير التعليم على ضوء أسس فلسفة التعليم وبعيدًا عن الضغوط التي يفرضها مناخ الخطر الذي يوتر الأعصاب ويبلبل التفكير (التفجر السكاني، التفجر المعرفي وتدفق المعلومات، اتساع الفجوة بين الشمال والجنوب) مع الأخذ في الاعتبار تجارب غيرنا.
وحيث يصعب في هذا المقام البحث في دراسات المؤتمر برمته حيث يبلغ عددها 68 دراسة قدمها أساتذة وخبراء وقيادات جامعة القاهرة وجامعات مصرية أخرى وفروعها، فإنه يكفي النظر في عناوين دراسات المحور الأول الخاص بفلسفة التعليم الجامعي وهي: حول الملامح الأساسية لتطوير التعليم الجامعي في مصر (د. شفيق بلبع)، فلسفة التعليم الجامعي في عصر العولمة (د. أحمد فؤاد باشا)، أبعاد أزمة التعليم في مصر (د. يوسف سيد محمود)، نحو رؤية معاصرة لوظائف الجامعة المصرية على ضوء تحديات المستقبل (د. محمد محمد سكران)، فلسفة التعليم الجامعي من المحلية إلى العالمية (د. فريد النجار)، إطار مقترح لفلسفة التعليم في المرحلة الجامعية الأولى في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية والقومية (د. مصطفى محمد عز العرب)، أهمية التعليم باللغة العربية (د. عبد الله التطاوي)، فلسفة التعليم باللغة العربية وباللغات الأجنبية (د. صابر عبد المنعم محمد)، التدريس باللغات الأجنبية في الجامعات المصرية ( د. محمد السيد سليم)، تطوير الفلسفة الإسلامية (د. زينب عفيفي شاكر). فإن هذه العناوين –في حد ذاتها- تثير قضية الهوية والانتماء بتفريعاتها المختلفة، سواء ما يتصل بالوظائف والأدوار الجامعية أو سواء ما يتصل بطرائق ولغات التدريس وخاصة إشكالية العلاقة بين التدريس بالعربية والتدريس باللغات الأجنبية.
ودون الدخول في تفاصيل هذه الدراسات يبقى السؤال هل انعكست مضامينها المباشرة أو غير المباشرة في توصيات المؤتمر بحيث تتضح رؤية استراتيجية تأخذ في الاعتبار هذه الأبعاد الحضارية عن وظيفة ودور الجامعة إلى جانب الأبعاد المادي.
يجدر هنا –وبصدد توصيات أعمال المؤتمر الذي بلغت أعداد صفحات كتابة بأجزائه الأربع ما يزيد عن الألف ومائتي صفحة، يجدر بشأن هذه التوصيات تسجيل ما يلي:
v لم تتضمن التوصيات في المحور الأول الخاص بفلسفة التعليم أي بند من بين بنودها الخمسة عشر يشير من قريب أو من بعيد إلى أمور تتصل بالهوية أو القيم أو الأخلاق أو الثقافة أو الخصوصية.
v التوصية عن المحور الخامس (طرق التدريس) وفي البند السابع بمايلي “توجيه البرامج وطرق التدريس لاحتياجات المنطقة العربية وأفريقيا ودول حوض البحر المتوسط مع وضع البرامج الخاصة بأفريقيا في المرتبة الأولى لأهميتها خلال الفترة القادمة.
v التوصية عن المحور السادس (المعلم الجامعي) وفي البند التاسع من بين بنوده بما يلي “اعتبار الجامعة…. بيت خبرة….والعمل على تسويق خبرتها داخل أفريقيا والبلاد العربية ودول حوض المتوسط….
v التوصية عن المحور السابع (الإدارة والتمويل) وفي البند الأول منه بما يلي “التأكيد على أن التعليم لا ينفصل عن التنمية باعتبار أنه يحقق عائدًا ومردودًا على الاقتصاد القومي، وعدم النظر إليه على أنه من قبيل الخدمات.
إن المقتطفات السابقة من الكلمات الافتتاحية ومن محاضرات افتتاحية ومن محاضرات المحاور تثير التساؤلات التالية:
1- هل دور الجامعة أضحى فقط دورًا استثماريًا اقتصاديًا، لتحقيق عائدًا ومردودًا اقتصاديًا فقط لمواجهة متطلبات التنمية واحتياجات السوق وتحديات العولمة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية؟ وأين أدوار الجامعة الحضارية والفكرية؟ وهل هذه الأدوار لتحصين الذات الوطنية والقومية أم لخلق ودعم الاتجاهات الإنسانية العولمية؟ وكيف يمكن الجمع بين الاثنين؟
2- هل تحديات عصر العولمة تقتصر على فجوة المعلومات والتكنولوجيا وكيفية عبورها باساليب وتقنيات حديثة لتطوير مقررات ومنظومات التعليم فقط؟ أليس لهذه التحديات أبعاد أخرى لا تقل خطورة؟ أين التحديات الداخلية؟
3- هل استشراف الرؤية المستقبلية للجامعة يكون بالاعتماد على الخبرات الأجنبية والخبرات والوثائق العالمية فقط؟ فهل تعكس هذه الخبرات خصائص وسمات أوضاع جامعاتنا ومتطلبات مجتمعاتنا ونظمنا المادية منها وغير المادية؟ إذن ما حدود العلاقة الرشيدة بين الخبرة الخارجية والداخلية؟
4- هل النص على أهداف وغايات ومبادئ الهوية والخصوصية كافيًا في حد ذاته ولا يحتاج مثل غيره من الأهداف والغايات والمبادئ (المتصلة بمنظومة التعليم) سياسات وبرامج محددة لخدمتها وتدعيمها؟.
5- هل يكفي أن يظل الاهتمام بالأبعاد الثقافية الحضارية حبيس نطاق مقاومة التطرف الفكري والديني وأطروحات صراع الثقافات؟.
وأخيرًا هل يمكن ألا تتضمن توصيات هذا المؤتمر ولو القدر اليسير من الإشارة إلى مشروع حضاري لتطوير التعليم؟
(2) وبالنظر في مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم والتي ناقشها المؤتمر القومي2000 نلاحظ ما يلي:
1- ومن بين مواطن الضعف المذكورة في منظومة التعليم تأتي في المقدمة “عدم وجود فلسفة عامة أو استراتيجية مستقبلية محددة لمنظومة التعليم العالي، غياب الرؤية الشاملة والنظرة الاستراتيجية لدور التعليم العالي في مستقبل التنمية واستثمار الموارد القومية، تراجع دور القيم الجامعية والمعايير الأخلاقية من حيث تأثيرها على أداء أعضاء هيئة التدريس بوجه خاص ومن حيث التأصيل لها والتأكيد عليها في المنظومة التعليمية بوجه عام.
2- أكد المشروع في مقدمته على دعائم أربع للتعلم: التعلم للمعرفة، التعلم للعمل، التعلم لتنمية العمل المشترك مع الآخرين، التعلم لتنمية الذات وإثراء الشخصية الإنسانية. كما حدد الوظائف الأساسية للتعليم العالي في: أعداد الطلاب للتعليم وتنمية قدراتهم، إعداد خريجين في مجالات التخصص المختلفة، اتاحة التعليم للجميع، التفاعل والعمل المشترك مع المؤسسات المختلفة في المجتمع، مواكبة المتغيرات العالمية وتنمية صيغ التعاون الدولي.
3- من بين المحددات المذكورة للإطار الإستراتيجي للتطوير يأتي في المقدمة المحوران التاليان:
– الالتزام بتقدير الظروف والمعطيات المحلية والتأكيد على الخصوصية الثقافية المصرية، مع تعميق القيم والأصالة القومية في منظومة التعليم.
– التوافق مع عالمية التعليم وإقامة التوازن بين متطلبات المحلية وضرورات التعايش مع المتغيرات العالمية فهمًا ووعيًا واستيعابًا وانتقاء وإفادة.
4- من بين الأهداف الاستراتيجية للتطور يذكر المشروع الهدف التالي (الثالث بين 6 أهداف): تعظيم دور مؤسسات التعليم العالي كمركز تعليم وتثقيف وتنوير لمصر والعالم العربي والإفريقي والإسلامي. وتوسيع نطاق مشاركتها في الفعاليات الدولية، مع تأكيد الهوية المصرية والحفاظ على الانتماء القومي.
5- وبالرغم من التأكيدات السابقة على هذه الموازنة بين العالمي والخاص والحضاري فعند النظر في المشروعات المقترحة للتطوير ماذا نجد؟ نجد في المشروع الخامس لتطوير برامج ومناهج التدريس تم تحديد غرض المشروع في الآتي: مواكبة أهداف خطط التنمية الشاملة للدولة، مسايرة التقدم التكنولوجي والتراكم المعرفي، إيجاد رؤى جديدة لمحتويات المناهج تتوافر فيها مقومات التحديث والتفاعل والارتباط مع متطلبات سوق العمل ومواقع الإنتاج والخدمات (أين ما يتصل بالهوية).
وفي المشروع العشرين: التنمية الثقافية والفنية والرياضية والرعاية الاجتماعية للطلاب: تم ذكر مايلي كغرض من أغراض المشروع: تعميق المشاعر الوطنية والتمسك بالقيم والأخلاق السوية، تعظيم مشاعر الولاء والانتماء للجامعة والمجتمع… ومن متطلبات تنفيذ هذه الأغراض تم الإشارة إلى: الاهتمام بالثقافة العامة للطلاب، ترسيخ القيم الأخلاقية لدى الطلاب عن طريق التأسي بالنماذج السلوكية التي تقدمها القدوة المتمثلة في عضو هيئة التدريس وأيضًا ترسيخ المفاهيم الأخلاقية لممارسة المهنة المناسبة.
بعبارة أخرى من بين 25 مشروع مقترح للتطوير لم يتم التطرق بصورة مباشرة أو غير مباشرة لقضية الهوية – ومترادفاتها أو نظائرها المتصلة بمشروع حضاري للتطوير إلا في المواضع المحدودة السابق الإشارة إليها. ناهيك عن عدم اقتران النص على المبادئ باقتراح آليات التنفيذ المحددة مثلما يتحقق مع الجوانب الأخرى للتطوير، الخاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، أو نظام الجودة..إلخ.
(3) وبالنظر إلى وثيقة: “منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر المستقبل” التي أعدها د. عمرو عزت سلامة، والتي تمثل منطلقًا من منطلقات للنقاش الدائر الآن عن تطوير التعليم (كما حدث مثلًا عقب محاضرة سيادته في جامعة القاهرة 19 في سبتمبر 2004، وفي حلقة النقاش التي نظمها نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة في 4 يناير 2005)، نجد تحت عنوان “الرؤية والرسالة” (وهو أول عنوان في الوثيقة) إن الرؤية والأهداف تدور حول أربع: المعرفة، التميز، والمنافسة القاطرة للتنمية، الإبتكار والإبداع.
وفي حين يشير البندان الأول والثالث للغاية فإن البندين الثاني والرابع يشيران إلى الوسيلة. ونلحظ أن تفريعات كلا من الغاية والوسيلة تقتصر على الجوانب الإجرائية العملية دون أي تطرق لأبعاد حضارية وهو الأمر الذي يحدد طرح نفس التساؤلات السابقة طرحها عن موضع هذه الأبعاد من فلسفة التعليم العالي في مصر ومن الرؤية الاستراتيجية لتطويرة.
بعبارة موجزة وبالرغم من أن الرؤية التي انطلقت منها وثيقة المؤتمر القومي (2000) قد عكست في أكثر من موضع منها وعيًا واهتمامًا بخصوصية المشكلات والأهداف، إلا أن المبادئ لم تترجم إلى مشروعات كما أن مفردات التميز والمنافسة والجودة والعائد والاستثمار الاقتصادي في الخطابات السائدة قد تجاوزت وتعدت ما يتصل بالوجه الثاني للعملة أي مفردات تتصل بالذات الحضارية مثل اللغة العربية والموروث الحضاري والقيم الأخلاقية.
وهنا يبرز السؤالين التاليين:
ما هو نطاق الهوية: هل هو الوطنى أم القومي أم العالمي؟ هل المقصود الهوية المصرية، أم العربية، أم هوية الإنسانية العالمية؟
هل النص صراحة –من عدمه- على هذه المصطلحات أو المفاهيم في الوثائق المختلفة المتصلة بتطوير التعليم الجامعي في مصر معيارًا كافيًا للحكم على درجة الاهتمام من عدمه بهذه القضية أو على درجة الوعي بها من عدمه؟ أم أن الواقع وأفعاله أي تحويل المقولات عن أهداف وسبل ودعائم تطوير إلى سياسات فاعلة هو المحك والمعيار الحقيقي لتشكيل الهوية وتدعيمها -على الأقل على الصعيد الوطني- وكنواة ومنطلق نحو الصعيد العربي وبدون انفصال عنه؟
بعبارة أخرى قد يتساءل البعض هل مع تزايد المشاكل والتحديات التي تواجهها الجامعات المصرية، وهي في حلها مشاكل مادية خطيرة ناجحة عن تزايد أعداد الطلبة وضآلة الموارد المتوافرة وخطورة المرحلة الانتقالية، هل مع هذا التزايد يصبح هناك محلًا للحديث عن الهوية والانتماء، وجميعها أمور معنوية قيمية، لم تعد تقدر على الاستجابة للتحديات المادية المتراكمة ومن ثم أليس التمسك بها أمرًا من أمور الحماس والانفعال؟ وفي المقابل إلا يمكن أن نطرح ساؤلًا مضادًا وهو كيف يمكن أن نجعل من دعم وتنمية الهوية سبيلًا من سبل علاج المشاكل المادية؟ أنها جميعًا تساؤلات تنبع من قلب الجدال بين اتجاهين رئيسيين اللذان تنقسم بينهما كل الجدالات المعاصرة في دائرتنا العربية إلا وهما الاتجاه البراجماتي – الذرائعي الشديد الواقعية والاتجاه القيمي المعياري الذي يرفض إسقاط متطلبات المرجعية والثوابت لصالح المتغيرات المتوالية ومن ثم يرفض الاعتراف أن اعتبارات الخصوصية والاعتزاز القومي يجب أن تفسح الطريق تمامًا لاعتبارات المصلحة البراجماتية واحتياجات السوق والجودة والمنافسة العالمية بدون ضوابط على أساس أنه بالرغم من أهمية وحيوية تلك الأخيرة إلا أنه يجب أن يتوافر الإطار القيمي الذي يمثل الروح للجسد.
هذا ولقد أعطت فعاليات ومؤتمرات أخرى –في جامعة القاهرة على سبيل المثال- اهتمامًا لهذه الأبعاد القيمية الحضارية، ولو من مداخل متنوعة.
فمن ناحية وفي ندوة عقدها نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة في فبراير 2000، عن مناهج الدراسة في الجامعات المصرية، وإلى جانب الاهتمام بأبعاد منظومة التعليم التي اهتمت بها المؤتمرات السابق الإشارة إليها، فلقد تميزت توصيات هذه الندوة بإعطاء مساحة أساسية لأمرين وهما:
Ø القيام بإعداد دورات دراسية لشباب الجامعة من المعيدين والمدرسين المساعدين في اللغة العربية على غرار دورة التويفل إذ لا يليق بأستاذ الجامعة ألا يعرف لغته الأم ولا يعرف كيف يوظف قواعدها حتى نتخلص من ظاهرة تفشي اللغة العامية في المحاضرات وتخلوا الكتب الجامعية من الأخطاء المتفشية بها.
Ø محاولة علاج ظاهرة التطرف الفكري عند بعض الشباب خلال منهج دراسي (للثقافة الدينية)،كمتطلب جامعي يدرس خلاله الطالب المسلم أصول العقيدة الصحيحة وقضاياها من الكتاب والسُّنة بروح التسامح الديني الذي يدعوا إليه القرآن الكريم والسُّنة النبوية.
ولا بأس أن يدرس الطالب المسيحي ما يخصه من أصول المسيحية التي يتولى تدريسها فريق من إخواننا المسيحيين وأن تكون هذه المادة شرطًا في الحصول على المؤهل الجامعي ولا يحتسب درجاتها ضمن المعدل التراكمي العام للطالب بحيث لا تؤثر على مجموع الطالب صعودًا أو هبوطًا.
هذا وكما تضمنت دراسات الندوة في مجموعها إشارة إلى دوافع الاهتمام بتطوير التعليم الجامعي مثل دافع إعادة بناء الإنسان المصري وإلى أسس بناء المنهج مثل الحفاظ على الثقافة القومية والوطنية. إلا أن إحدى هذه الدراسات قد ركزت بصفة خاصة على أهمية مقرر الثقافة الدينية وخصائصه وسماته. وهي دراسة د. محمد شامة “الثقافة الدينية حماية للفرد وأمن للمجتمع” ولقد ركزت الدراسة على البعد الثقافي في عملية التعليم مقرونًا بإشارة إلى الهوية.
فهو يرى أن الأسلوب الأمثل للحفاظ على هويتنا ثقافتنا –وتنمية هذه الثقافة- هو تسليح الشباب ضد كل ما هو سلبي وضار في الثقافات الواردة وتدريسه على النحو الذي يؤهله لفهمها فهمًا عميقًا ومواجهتها بمنهج علمي سليم. ولتحقيق هذا الهدف يرى د. شامة أن عملية تطوير المنهج متعددة الجوانب: دينية، اجتماعية، تربوية.
ومن هنا يبرز اهتمامه باقتراح منهج الثقافة الدينية وليس الثقافة الإسلامية ليندرج تحته كل الدارسين على اختلاف أديانهم وعقائدهم “فالثقافة الدينية، أيًّا كان الدين وعلى أي وضع كانت العقيدة، جزء أساسي من بناء الهوية الثقافية، بل في الجانب الأهم في تكوين شخصية الطالب دينيًا بحيث يكون قادرًا على التعامل مع الآخر”.
ويبرر د. شامة الاهتمام بالثقافة الدينية لارتباطها بهوية الأمة “لأن هوية الأمة تقوم على ثقافتها ووجودها يرتكز على دينها وعقيدتها…. فكلما حافظ الأفراد على ثقافتهم وحموها من الذوبان، برزت هويتهم وثبتت أقدامهم….كذلك الأمر فيما يتعلق بدينها وعقيدتها فالدين أساس الوجود ومرتكز الحياة، فلا توجد أمة بدون دين…..وخير دليل على أهمية تدريس مادة الثقافة الإسلامية في الجامعات الإسلامية ما نراه اليوم من شعور الشباب بأنهم ضائعون، لا يعرفون لهم هوية يرتكزون عليها، ولا يشعرون بكيان يجمعهم في نسق واحد، فهم مشتتون بين الثقافات المختلفة…. فعيونهم على الهجرة إلى خارج الوطن…. تاركين أوطانهم خالية من عقول…. فمعظم الشباب…. يحيى في وطنه غريبًا لأنه لم يتلق من الثقافة الدينية ما يشعره بهويته…. ولم يتعلم من القيم والمبادئ الدينية ما يحميه من الحيرة…. تدعوه تيارات ثقافية متعددة الألوان إلى التخلي عن هويته وثقافته…. ولكثرة هذه النماذج المعروضة عليه، وعدم حمايته بالثقافة الدينية…. فقد صاغ بنفسه نموذجًا لحياته لا يعرف له هوية…. لن يخرج شبابنًا من حالة الضياع…. إلا إذا أدرك هويته عن طريق دراسة مادة الثقافة الدينية في المرحلة الجامعية”. ويوضح د. شامة شروط وضع المنهج الدراسي للثقافة الدينية.
ومن ناحية أخرى: وفي مؤتمر شباب الجامعات وتحديات المستقبل ضمن فعاليات احتفالية عيد العلم في جامعة القاهرة (21- 23/12/2002)، كان عنوان المحور الثاني من أعماله هو الإعداد الفكري للشباب، مسبوقًا بمحور الإعداد التعليمي والعلمي، ثم متبوعًا بمحور الإعداد لسوق العمل، ثم محور إعداد الشباب لمجتمع المعلومات.
ويعكس هذا الترتيب للمحاور اهتمامًا بالإعداد الفكري. والمقصود به –وفق أعمال المؤتمر- الإعداد الثقافي والتربوي للشباب فيشمل التثقيف السياسي ودوره في خلق المواطن الصالح، والتثقيف الديني ودوره في الفهم الصحيح للدين، والتثقيف العلمي والاجتماعي ودور الإعلام.
وحيث لم تتوافر أعمال هذا المحور من المؤتمر فيمكن الرجوع إلى افتتاحية العدد الثالث من مجلة الجامعة والمجتمع والتي كتبها أ.د/ أحمد فؤاد باشا -نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة- حينئذ تحت عنوان “دور الجامعة في تأصيل قيم التقدم”.
ويقدم د. أحمد فؤاد باشا في هذا المقال الوجيز رؤية ثاقبة عن العلاقة بين النسق الفكري والقيمي وبين النسق العلمي أي عن العلاقة بين القيم والدين والعلم. وهي العلاقة التي تقع في صميم جوهر الحديث عن موضع الهوية من التعليم الجامعي فكرًا وواقعًا ومن ثم موقعها من التنمية الشاملة المرجوة، والتي يجب أن تستلهم فلسفة رشيدة ومتوازنة للتعليم. وهي الفلسفة التي تنطلق من أن الوعي بالذات بصورة متوازنة هو أساس الفعل الحضاري المثمر. ولعل المقتطفات المتتالية تستطيع شرح هذه الرؤية الثاقبة.
“….ويؤكد علماء التربية وجود علاقة وثيقة بين تنمية الإنسان حضاريًا، وبين انتمائه فكريًا وعقائديًا، أن المجتمع القادر على تحقيق التوافق والانسحاب بين حركة الحياة الواقعية وبين النسق الفكري الموجه لهذه الحركة، هو القادر في ذات الوقت على احتضان الفكرة الصائبة واستثمارها حضاريًا بما يحقق الخير والتقدم، سواء كانت هذه الفكرة علمية أو تقنية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غير ذلك مما يتعلق بمجالات النشاط الإنساني. “….وإلى جانب منهج النظر “أو التفكير” السليم في منظومة قيم التقدم تأتي قيمة “الهدف الأسمى” لمعرفة الحق والحقيقة في أعماق النفس الإنسانية وفي آفاق الوجود، بين الذات والموضوع، أو بين عالم الأفكار وعالم الأشياء، ففي غياب الهدف الأسمى يتجمد عالم الأفكار وعالم الأشياء، ويفقد كل منهما فاعليته الحضارية في الإفادة من الملكات التي منحها الله تعالى للإنسان، والثروات التي سخرها الله -تعالى- لخدمته ومنفعته في هذا الكون، وعندما تختل العلاقة بين الأفكار والأشياء، أو بين الذات والموضوع، أو بين الإنسان والكون، فإن هذه العلاقة لا تثمر مردودًا حضاريًا فاعلًا يحقق ارتقاء الإنسان فكريًا وعلميًا….”، ويمكن للثقافة في أمتنا العربية والإسلامية أن تقدم ما هو أكثر من مجموع عناصرها المادية والفكرية لبناء المجتمع المتوازن، فإذا تحقق ذلك للشباب وجدناه يتجه بحمية وحماس إلى الإبتكار والإنتاج بعزيمة وإيمان لثقته في قدرة هذا المجتمع على احتضان الأفكار الصائبة واستثمارها حضاريًا….”.
ومن ناحية ثالثة: لقد أفردت بعض مؤتمرات دولية نظمتها جامعات مصرية محورًا خاصًا بين محاور أعماله يتصل بالجامعة والهوية الثقافية (مؤتمر جامعة الأزهر حول التوجهات التنموية في تطوير التعليم الجامعي العربي، في يونيه 2004) أو يتصل مثلًا بتعليم القيم في الجامعات (المؤتمر القومي السنوي الحادي عشر (العربي الثالث): التعليم الجامعي العربي: آفاق الإصلاح والتطوير، ديسمبر 2004).
كما أولت أقسام علمية –مثل قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وفي مؤتمرين علميين تقويم محتوى المقررات الدراسية 2000، “ونماذج عالمية في تدريس العلوم السياسية (2001) أولت الأهمية لإشكالية هوية أقسام العلوم الاجتماعية والإنسانية في عالم وأن تساقطت حدوده الإقليمية كما تساقطت الحدود بين العلوم، إلا أن الحدود بين الخصوصية والعالمية مازالت قائمة وتثير جدلًا شائكًا. ومن أبرز القضايا التي ثارت قضية شعب التدريس باللغة الأجنبية في كليات الحقوق والتجارة والاقتصاد.
ومن ناحية رابعة وأخيرة
وبالنظر في مجموعة التقارير السنوية الصادرة عن المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا وذلك في الفترة من (1994- 2002) ماذا نجد بشأن فلسفة التعليم والرؤية عن تطويره باعتبار أن هذا المجلس يضم صفوة العلماء والمفكرين وأصحاب الخبرة السياسية والتنفيذية في هذا المجال؟
عند الحديث عن فلسفة التعليم الجامعي العالمي وغاياته واستراتيجيته وسياساته، تغلبت في هذه التقارير الغايات المتصلة بأمور عملية، لا يمكن إنكار أهميتها وحيويتها من أجل تطوير التعليم الجامعي، ولكنها جاءت على حساب غايات أخرى –معنوية قيميه وعلى رأسها بالطبع تلك المتصلة بالهوية. ولقد تفاوتت التقارير من حيث الوزن المعطى لهذه الغايات المعنوية.
فنجد تقرير الدورة الثانية والعشرين (1994- 1995) يعتبر التعليم خدمة اجتماعية أساسية واستثمار تنموي اقتصادى (ص 37 ) وإنه يهدف ضمن –أهداف أخرى- إلى بذل العون والإرشاد للمواطنين للمحافظة على القيم وصيانة الذاتية الثقافية والتراثية والحضارية للمجتمع، ومن بين السياسات المقترحة لتحقيق هذا الهدف وغيره لم يأت التقرير على ذكر أي سياسات تتصل بالهوية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولكن عاد هذا التقرير وافرد جزئية خاصة تحت عنوان دور الجامعة في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية (كما نرى لاحقًا).
وفي توصيات تقرير الدورة الثالثة والعشرون (1995-1996)، وفيما يتصل بأسس إعادة هياكل التعليم الجامعي والعالي، ومن بين عشرات البنود جاء في (ص 137) في بند واحد مايلي: “أن يزود الخريجون بثقافة دينية واعية تعمل على ترسيخ القيم الروحية والأخلاقية في نفوسهم على اعتبار أنها مؤثرة على حسن الأداء وإتقانه وعلى زيادة الإنتاجية وتعظيم المخرجات.
وفيما يتعلق بالغايات والأهداف الكبرى نص التقرير (ص 147) في البند الأخير من بنود أربعة على ترسيخ القيم والمبادئ والأخلاقية والدينية والإنسانية التي تسهم في تكوين المواطن الصالح وتحقيق أماني الوطن وفيما يتصل بالمعايير المنظمة للسياسات الجامعية نص (ص 147) على “الجرعة الاجتماعية والثقافية التي يزود بها الدارس والباحث ومدى تعرفه على أصولها ومدى انتمائه إلى مجتمعه وتراثه الوطني، ومدى تمسكه بالقيم الرفيعة والمبادئ…”.
أما تقرير الدورة 24 (1996 – 1997) فلقد نص في فقرة واحدة بين العديد من الفقرات التي تناولت سمات خريج الغد وقدرته على مايلي (ص98) “الاتصال والتعامل مع المجتمع بقيمه ومفاهيمه وطموحاته وتراثه…” “الإنسان الحر الذي يعيش في مجتمع ديمقراطي يحترم كرامة الإنسان المؤمن بالعلم كوسيلة لحل مشاكله هو إنسان الغد المطلوب”.
وعلى العكس فإن تقرير الدورة 25 جاء ثريًا بما يتصل بالبعد الثقافي والإنساني (كما سنرى لاحقًا)
وفي تركيزه على مفهوم الجودة الكلية في التعليم العالي لم يول تقرير الدورة السابعة والعشرون (1999-2000) الاهتمام للأبعاد المعنوية (غير المقيسة) في الجودة قدر اهتمامه بالأبعاد المادية المقيسة والأبعاد غير المقيسة في مخرجات العملية هى الأبعاد المعرفية، الاجتماعية، الأخلاقية، الشخصية.
ويعود تقرير الدورة 28 (2000-2001) فيتوقف في فقرة جامعة شاملة من بين فقرات أهداف التعليم الجامعي عند موضوع الحصانة الوطنية الثقافية باعتبارها إحدى مستلزمات تحقيق فعالية الطلاب. ويذكر في هذا الصدد مايلي: “الحصانة الوطنية الثقافية: ذلك أن عالم المستقبل يقوم بالدرجة الأولى على كسر الحدود بين مختلف الثقافات، والتدفق المعرفي بين مختلف الدول، فإن هذا الأمر يتطلب حقن الطلاب بأمصال واقية تضمن لهم التعامل مع الثقافة العالمية بمنهجية نقدية تستطيع الانتقاء والاختيار، ولن يتأتى هذا إلا بتعزيز الهوية الوطنية والذاتية الثقافية؛ عن طريق تعزيز اللغة القومية والعقيدة الدينية والثقافة التاريخية الوطنية.
وعدا السمات والملامح السابق تحديدها –كما أفصحت عنها التقارير التسع- فيجدر ملاحظة أن القدر المذكور –عن الهوية- يكون مجردًا ومعزولًا عن بقية الأبعاد سواء على مستويات الفلسفة، الاستراتيجية أو السياسات والإجراءات اللازم اتباعها لتطوير العملية التعليمية. حيث لا تبين الرؤية التي تطرحها التقارير كيفية تفعيل الأمور المتصلة بالهوية والانتماء لتصبح مدخلًا أساسيًا من مداخل التأثير على عملية التغيير المرتقبة، من ناحية، وكيفية تحقيق عملية التغيير في إجراءات التعليم وسياساته تجديدًا ثقافيًا ومعرفيًا وليس مجرد الاستجابة لاحتياجات سوق العمل والالتزام بمعايير الجودة من ناحية أخرى. بعبارة أخرى يتم النظر للهوية أو البعد الثقافي أو البعد القيمي باعتباره منطقة حركة وليس مدخلًا في مناطق حركة أخرى خاصة بالسياسات التعليمية. وباستثناء التقارير كلها، فإن تقرير الدورة الثانية والعشرين (1994-1995) اختص الموضوع بجزئية مستقلة (ص 55 – 57) جاءت تحت عنوان “دور الجامعات في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية”، وهذا يعني أن التقرير قد اتخذ لقضية الهوية مدخلًا دينيًا أخلاقيًا.
ويبدأ التقرير بإرجاع القصور الذي يشوب تطبيق خطط التنمية إلى “….ضعف الجدية وفقدان الشعور بالمسئولية، وأحيانًا اللامبالاة وعدم الاكتراث، وإذا كان الأمر كذلك –وهو كذلك بالفعل- فإن الأمر يتطلب بإلحاح الالتفاف إلى التربية الدينية والأخلاقية والوجدانية- وهي الجوانب المهملة أو التي لم تحظ بالعناية اللازمة- حتى يمكن لنا أن نخدم الأجيال الحالية ونعد أجيالًا جديدة من المواطنين تكون قادرة على تحمل مسؤولياتها في بناء وسيادة هذا المجتمع والنهوض به. وهذا الأمر يقتضى الاهتمام بترسيخ القيم التي تأصل كل المعاني النبيلة في نفوس الأفراد والجماعات.
وقدم التقرير تصورًا للإطار العام للخطة المطلوبة يتمثل في النقاط التالية:
1- ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في المرحلة الجامعية يعتمد اعتماد كبيرًا على الجهود التي تمت قبل ذلك في مراحل التعليم قبل الجامعة، وعلى الدور المؤثر الذي تقوم به كل من الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع.
2- ضرورة إعادة النظر في مناهج التربية الدينية في مراحل التعليم العام.
3- ينبغي أن تقوم وسائل الإعلام المختلفة بحملة قومية للتوعية الدينية والأخلاقية لتوعية الجماهير وإقناعهم بضرورة التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية من أجل الارتفاع بمستوى الأمة في جميع المجالات.
4- ضرورة الارتفاع بمستوى الدعوة والدعاة فجماهير الأمة تتلقى ثقافتها الدينية العامة من الدعاة.
5- ضرورة تدريس مقرر لطلاب الجامعات المصرية في الثقافة الدينية والسلوك الأخلاقي يبرز الدور الحضاري للدين ويركز على أهمية دور القيم الدينية والأخلاقية في سلوكيات الناس وإحساسهم بالمسئولية ويقظة الضمير، والجدية في تحمل المهام فلا يترك طلاب الجامعات نهبًا لشتى الصراعات والانحرافات أو فريسة للجماعات المتطرفة دون توعية دينية سليمة تحميهم من الوقوع في يد مثل هذه الجماعات من ناحية، ومن ناحية أخرى تكون هذه التوعية عاملًا هامًا في تقوية إرادتهم وتحفيزهم من أجل العمل على خير بلادهم وتشعرهم بمسئولياتهم في هذا الصدد مع الطلاب. وبذلك نسد منافذ الانحراف الفكري والديني لدى الشباب.
6- رعاية الشباب في المرحلة الجامعية والعمل على حل ما يعانيه الشباب من مشكلات اجتماعية أو مادية أو علمية حتى يشعر بأنه محل الرعاية والاهتمام من الجميع، وبذلك نغرس في نفسه قيمة الانتماء لهذا الوطن والعمل من أجل خيره وتقدمه ويشارك في ذلك نخبة من رجال الدين والتربية لترسيخ القيم الدينية والأخلاقية.
ومرة أخرى يمكن أن نلاحظ من قراءة هذا النص أن الرؤية المطروحة تجتزئ موضوع القيم من إطارها الواسع المتصل بتفاعلات العملية التعليمية وتفعيلها حيث يتضح كون القيم مسارًا موازيًا لا يتقاطع مع العملية التعليمية ولا يصب فيها ولا يأخذ منها ولا يعطي لها. بحيث يظل معنى الأخلاق والدين محصورًا في دائرة ضيقة قاصرة على السلوك الفردي والشخصي للطالب الجامعي ولا يمتد نطاق تفعيلها إلى الأنساق المعرفية والفكرية التي يمكن أن تقدمها النظم التعليمية أو التي يمكن أن تخدم النظم التعليمية في مناطق أكثر التصاقًا ناهيك بالطبع عن أن مفهوم الهوية هو أكثر اتساعًا من مفهوم القيم.
ومن ناحية أخرى فإن تقرير الدورة الخامسة والعشرون قد أفرد بدورة جزئية خاصة ومنفصلة ولكن تحت عنوان “البعد الثقافي والإنساني وإعداد طلاب الجامعات والمعاهد العليا” (ص 167) وعدا النظر في ما يتصل بمفهوم البعد الثقافي والإنساني ومدى قربه أو ابتعاده عن مفهوم الهوية الوطنية أو القومية ومقتضياتها وتداعياتها فإن منطلق التقرير يؤكد على البعد البشري في التنمية وعلى البعد الثقافي الإنساني في هذه التنمية، إن كان يقتصر على النطاق الوطني للثقافة إلا أنه يقدم مفهوم البعد الثقافي ودوره والدوافع إليه على النحو الذي يحقق درجة أكبر من الترابط والتكامل مع الأبعاد الأخرى في العملية التعليمية. فيحدد التقرير دور الثقافة كالآتي: (ص 168)
“ومما لا شك فيه أن للثقافة دورًا هامًا في تشكيل شخصية الفرد وتنمية ذاتيته حيث تسهم في صقل شخصيته، وصياغة سلوكه وعاداته، وتدعيم مبدأ التسامح الفكري لديه. هذا بالإضافة إلى تحقيق مزيد من ارتباطه بالمجتمع الذي يعيش فيه، بل وبالعالم كله”.
والمقصود بالبعد الثقافي في هذا التقرير هو: (ص170-171).
إتاحة الفرص لطلاب الجامعات والمعاهد العليا –من خلال آليات وأساليب ووسائل معينة- للتزود بالمعارف والاكتشافات والاختراعات بطريقة تمكنهم من توظيفها في حياتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع. هذا بالإضافة إلى إتاحة الفرص أمامهم لممارسة القيم الدينية والاجتماعية والسلوكية والوطنية والأخلاقية وغيرها. ونستطيع القول بأن الإعداد الثقافي والإنساني لطلاب الجامعات والمعاهد العليا يهدف إلى تكوين المواطن المستنير الذي تتوافر لديه الحساسية للتغيرات التي تحدث حوله، بحيث يتحول إلى مواطن مثقف يتجاوز حدود المواطن المتعلم.” (ص 171-172)
ووفق التقرير يتطلب تعميق مفهوم البعد الثقافي التأكيد على عدة ركائز أساسية هامة، من بينها: الاهتمام باللغة القومية، والفكر الديني السليم –دون تهويل أو تهوين- والاهتمام بتاريخ مصر والعالم العربي، واكتساب اتجاهات إيجابية نحو القيم الاجتماعية السامية كالمواطنة، والانتماء والولاء، واحترام قيمة العمل، واحترام الملكية العامة، والتعامل مع التحدي الحضاري الذي نواجهه في وطننا العربي، بالإضافة إلى الاهتمام بتوجيه وتعديل سلوكيات الطلاب.
والجوانب الثقافية التي يدعو التقرير للاهتمام بها هي: الثقافة الدينية، الثقافة اللغوية، الثقافة النفسية، الثقافة التنموية، الثقافة البيئية والأمانية، الثقافة الصحية، الثقافة السكانية والأسرية، الثقافة السياسية، الثقافة العلمية، ثقافة الاتصال، الثقافة الفنية والجمالية.
خلاصة القول
أن الطرح السابق عن فلسفة التعليم ورؤيته الاستراتيجية، إنما لا يغطي كل أبعاد هذا المجال، ولكنه ركز بدرجة أساسية على البعد الذي يثير إشكالية العلاقة بين المادي/ القيمي على مستويات عدة أما الأبعاد الأخرى، مثل تلك المتصلة بالعلاقة مع الخارج، والعلاقة بين الدولة/ المجتمع/ لفرد فيما يتصل بالحقوق والواجبات في نطاق منظومة التعليم وعملياتها وغيرها.. فسيتم استدعائها في المحاور التالية من الدراسة.
وفيما يتصل بهذا البعد عن العلاقة بين القيمي/المادي في فلسفة التعليم، يتضح لنا من الطرح السابق مجموعة من الثنائيات في الأولويات عن وظيفة ودور وأهداف التعليم الجيد ومحدداته وهي تتلخص كالآتي:
مدخل في التنمية الشاملة ووسيلة مخرج من مخرجات التنمية، دور تنموي اقتصادي/ دور في الحراك الاجتماعي ومساحة للتنشئة على المواطنة، هدف معرفي (انتاجًا ونشرًا وتوظيفًا)/ هدف إنتاجي، وظيفة خدمية/ وظيفة مجتمعية، إعداد المواطن القادر على خدمة الأمة وحمايتها/ إعداد المتخصص والمنتج البشري ذو العائد الاقتصادي، وظيفة خدمية/ وظيفة إنتاجية ذات عائد اقتصادي، متطلبات واحتياجات سوق العمل/ احتياجات العقل والمعرفة وبناء الأمة بالمعنى الشامل، متطلبات مادية للتطوير/ متطلبات معنوية قيمية أخلاقية، مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية/ مواجهة تحديات العمران الحضاري.
ويجدر الإشارة إلى أن هذه الثنائيات التي تفصح عنها خطابات وثائق التطوير، إنما تشير إلى أن رؤى التطوير إنما تواجه مشكلة استراتيجية وهي عدم الاتفاق على فلسفة للتعليم.
ومن ثم فإن صياغة سياسات التطوير، وسياسات التعليم ذاته -ووفق محددات عملية التطوير القائمة وخصوصية التجربة ذاتها- لابد وأن تنطلق من رؤيه يجب أن تحدد اختياراتها بين مكونات هذه الثنائيات. ومما لا شك فيه أن نمط الاختيار هو الذي يحدد نمط الخبرة ومآل مخرجاتها كما أن هذا الاختيار وتحديد الأولويات لابد أن ينهى ظاهرة الثنائيات تلك. ومن الواضح –حتى الآن- إن استمرار هذه الثنائيات من أوضح الأدلة على عدم وجود فلسفة محددة لتطوير التعليم العالي في مصر. ولكن لماذا؟ وما مخاطر هذا الوضع؟ وهذه الأسئلة تقودنا إلى المحاور التالية من الدراسة.
ثانيًا- قضية دوافع التطوير وتحدياته: إشكاليات العلاقة من الداخلي والخارجي (لماذا؟)
حددت الخطة القومية لتطوير التعليم العالي (2000م) 29 من مواطن الضعف في منظومة التعليم العالي، وهي ليست من مواطن الضعف –وفق تعبير الخطة- بقدر ما هي مؤشرات على حالة الأزمة التي وصل إليها التعليم العالي في مصر. ومما لا شك فيه أن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم أو الأمس القريب، ولكن من المؤكد أنها نتاج تراكم سياسات تعليمية وأوضاع بيئية متنوعة.
ومع ذلك، وبدلًا من تحديد الأسباب الأصيلة لهذه الأزمة وتسميتها بمسمياتها الصحيحة نجد أن وثائق التطوير المشار إليها –إلى جانب العديد من الدراسات التي ناقشتها مؤتمرات الجامعات المصرية حول التطوير منذ 1995 وحتى الآن- تبادر بتبرير الحاجة للتطوير بضرورة الاستجابة للتحديات التي تمثلها العولمة والثورة المعلوماتية والمعرفية والتقنية. حقيقية أن تلك الأخيرة تمارس تأثيراتها، ولكن من المؤكد أن التأثيرات السلبية منها تتضاعف نظرًا لحالة المنظومة التعليمية ذاتها المتأزمة وعدم قدرتها على الاستجابة الفاعلة لهذه التحديات، نتيجة ما تعاني منه مسبقًا من مشاكل تتصل بمكونات المنظومة الكبرى: الطالب، الأستاذ، العملية التعليمية (موارد، ومقررات وهياكل وإجراءات ولوائح، سياسات تغيير جذرية في نظم القبول بالجامعات ونظم تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتنمية قدراتهم، ونظم تمويل التعليم العالي وتوفير الاستثمارات وغيرها…) كما نشير لاحقًا.
ب) إلا أنه يبقى لهذه القضية (أي العلاقة من الداخل والخارجي) وجه آخر ومستوى آخر:
فبعد البدء بإعطاء وزن ملموس للخارجي، باعتبار أن متطلبات عصر المعلومات والتقنية والعولمة هو التحدي الرئيس والمعلم البارز أمام منظومة التعليم الجامعي في مصر التي أرادت الخطة الاستراتيجية للتطوير (2000) التصدي لها، لابد وأن يثور التساؤل حول مضمون واتجاه هذه الاستجابة “الخارج”.
وهنا نستكمل ما سبق طرحه في البند السابق من إشكاليات قضية فلسفة التعليم ورؤيته الاستراتيجية، حيث تثور عدة إشكاليات تنبثق أيضًا من حديث العولمة، ولكنها تولد استجابات مختلفة.
ومن أهم هذه الإشكاليات ما يتصل بالهوية الحضارية، سواء على مستوى التوجه العام والاستراتيجية العامة أو سواء على مستوى مقررات ومناهج التعليم على سبيل المثال وليس الحصر.
فمن ناحية: يشير البعض[6] إلى أن خطابات الدوافع والتبرير تحفل بمفردات التعاون الدولي، المعايير الدولية، الانفتاح على والاندماج في ما يحدث في الخارج من تطورات وفي المقابل نجد غياب مفردات أخرى تتصل بالذات الحضارية مثل اللغة العربية والموروث الحضاري والعروبة والإسلام والإرادة الوطنية والاستقلال الفكري، والقيم الأخلاقية والوحدة والترابط.. وهي المفردات التي تعكس تمسكًا بالهوية والشخصية القومية والذات الحضارية، في مواجهة توجهات التذويب والتنميط أو كما يعالج البعض الآخر[7]، تكوين إنسان كوكبي قادر على التعايش مع الآخر بعيدًا عن التنميط المجتمعي الذي كانت تمارسه المؤسسات التربوية لإنتاج مواطن ينتمي لمكان وتراث محدود، وانطلاقًا من الإيمان بقدرة المتعلم على الاختيار (تقرير مصيره في كل شئون الحياة ومنها التعليم بوصفه فعالًا وذاتًا حرة غير مشروطة بالأطر المكانية والمجتمعية وعلى اعتبار أن التقنيات الحديثة في التعليم ليست مجرد وسائط ووسائل تعليمية تحقق الأهداف والغايات التقليدية للتعليم بل هي تستهدف تغيير بيئة التعليم وتوجهها فلسفة ترى الإنسان المتعلم ذات لا سلطن على عقله وفاعل حر قادرًا على تدعيم هويته المنفتحة على الآخر.
وبناء على تلك الأطروحات السابقة فإن تطوير التعليم، والعيون على الخارج، لا يمكن أن يحقق التنافسية الحقيقية بدون مقاومة ومعالجة المشاكل الداخلية التي تعوق التطور الفعال، مثل الفقر والأمية الثقافية ناهيك عن متطلبات تحصين الهوية المهددة بتأثيرات العولمة السلبية.
ومن ناحية ثانية- تشير رؤية أخرى[8] إلى إشكالية إضافية. فبالرغم من تقديرها الجهد الكبير الذي يبذل لتنفيذ مشروعات التطوير في ظل المرحلة الأولى من الخطة القومية (2002- 2007)، وبالرغم من اعترافها أنه مازال الوقت مبكر للحكم عليها وتقويم نتائجها إلا أنها تشير إلى أن هذا الجهد في معظمه إنما يسبح في “مياه وافدة” ويندر أن ينبع من روافد عربية وإسلامية أصيلة، حيث أن جميع العلوم التي تقدم لطلاب (كلية التربية) تنطلق من منهجية معرفية غربية بحيث سادت غربة العلوم التربوية مما أثر على الطلاب، إذ أن هذه العلوم تربيهم على التبعية الثقافية وعدم الاعتزاز بهويتنا الحضارية المتميزة. ولذا دعت هذه الرؤية إلى ما يسمى بالتكامل المعرفي على مستوى مضمون المقررات ومناهجها.
هذا ولم تكن فكرة تعدد المدارس الفكرية والنظرية في الجامعة غائبة من قبل، بل اعتبرها البعض أساسًا للتنوع والثراء الفكري الذي يمثل أحد أهم متطلبات التطوير سواء على مستوى أعضاء هيئة التدريس أو القدرات التي يجب أن يتفاعل معها الطلاب[9]، ولقد اهتمت أقسام وكليات عدة بتقويم هذا الأمر، ونذكر منها على سبيل المثال قسم العلوم السياسية الذي ناقش في مؤتمرين علميين سنويين متتاليين قضيتين في غاية الأهمية وهما تقويم محتوى المقررات الدراسية، وخبرات عالمية مقارنة في مجال تدريس العلوم السياسية. وكانت قضية التنوع أو الخصوصية والعالمية في قلب أوراق ومناقشات هذين المؤتمرين. وجاءت قضية إنشاء شعب التدريس باللغات الإنجليزية والفرنسية في بعض كليات الجامعات المصرية على رأس القضايا موضع الاهتمام ومحل الجدل بين المدافعين عنها والمعارضين لها[10].
هذا وكان المؤتمر العلمي الذي انعقد على هامش اجتماع مجلس اتحاد الجامعات العربية في (قطر، في أكتوبر 2003)، قد اتخذ موضوعًا له “اللغة والهوية والتعليم الجامعي في الدول العربية”[11].
ومن ناحية ثالثة: احتلت أيضًا قضية تحديات العولمة لمنظومة التعليم المصرية اهتمام المجالس القومية المتخصصة: المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي، وكان من بين أهم أبعاد هذه التحديات تلك المتصلة بالتحديات الثقافية والحضارية للعولمة، فما موضع اهتمام تقارير المجلس بها مقارنة بغيرها؟ وبالنظر في عينة من التقارير السنوية الصادرة عن المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا وذلك عن الفترة من (1994 – 2002)، أي ابتداءً من الدورة الثانية والعشرين وحتى الدورة التاسعة والعشرين، ماذا نجد بشأن قضية الهوية وموضوعها من قضية التعليم في مصر؟.
تكتسب هذه الفترة –التي تغطيها التقارير- دلالة خاصة بالنسبة لمحك اهتمامنا، وذلك لأنها الفترة التي تصاعدت فيها وتيرة الاهتمام بالعولمة وآثارها على المنطقة العربية والإسلامية، بل والعالم أجمع بالطبع.
ولقد ظهر هذا جليًا في معظم التقارير المشار إليها، ولكن يظل السؤال التالي مطروحًا، إذا كانت الأبعاد الثقافية للعولمة وانعكاساتها على إشكاليات الهوية والثقافية قد حازت نصيبًا كبيرًا من المهتمين بالعولمة وتداعياتها على مجتمعات واقتصاديات وسياسات دولنا العربية والإسلامية، فهل حظت هذه التداعيات –في مجال التعليم- على اهتمام تقارير المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، وبالقدر الذي يتناسب مع خطورتها؟ وكيف شخصت التقارير هذا الوضع وكيف اقترحت الحلول له؟
إن القراءة في هذه التقارير التسع يقودني إلى استخلاص عدة ثنائيات خطيرة وهامة طرحتها تحليلات هذه التقارير. وهى ثنائيات تعكس إشكاليات هامة تثيرها قضية العلاقة بين الهوية وبين تطوير التعليم الجامعي في مصر، وعلى النحو الذي يطرح معنى جديدًا للهوية غير المعنى السائد في الذهن.
وتتلخص هذه الثنائيات على النحو التالي:
العالمي / المحلي، التقليدي/ البديل، احتياجات العقل/ سوق العمل، احتياجات الجودة/ الانتماء، اللغة العربية/ اللغة الأجنبية، الحل من الخارج / أم من الداخل، حل المشاكل المحلية أم مواكبة متطلبات المنافسة العالمية، الخصوصية المصرية / الهوية العربية الإسلامية. وهذه الثنائيات تتسم بأنها ليست ثابتة المضمون أو المحتوى كما أنها ليست ثابتة من حيث اتجاه أو نمط العلاقة بين شطريها.
ذلك لأن سياسات التعليم في مصر تأثرت بطبيعة النظام السياسي والاقتصادي وطبيعة البيئة الإقليمية والعالمية. مما لا شك فيه أن أهداف سياسات التعليم وتحدياتها خلال الحقبة الناصرية تختلف عن نظائرها في المراحل التالية:
إذن فما خصائص هذه الثنائيات وما هو الإطار العام الذي انبثقت عنه وما دلالاتها بالنسبة للإشكالية محل الاهتمام؟ أي موضع قضية الهوية من إدارة عملية التعليم الجامعي ومن تشخيص مشاكل وتحديات هذه العملية واقتراح الحلول لها في نهاية القرن العشرين وبداية قرن جديد من عمر العالم؟
من القراءة التراكمية في التقارير التسع المشار إليها يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات حول: تشخيص الحالة الراهنة وتحدياتها وباعتبارها دافعًا أو مبررًا للتطوير المطلوب، فلسفة التعليم الجامعي وغاياته، التوصيات والحلول المقترحة فيما يتصل بالاستراتيجية والسياسات:
فلقد اجتمعت التقارير على رصد وتشخيص حالة التعليم الجامعي في مصر بأنها حالة أزمة مستحكمة تواجه تصاعد التحديات التي فرضتها التغيرات العالمية في عصر قوة المعلومات على هذا التعليم. وإن حل هذه الأزمة هو المفتاح الأساسى للتنمية في مصر.
ولقد حازت الأبعاد المادية لتشخيص الأزمة على الأولوية بالمقارنة بالأبعاد المعنوية ومن ثم بقضية الهوية. حيث لم يكن ما يتصل بتلك الأخيرة يتعدى فقرة في تيار متدفق من الصفحات. كما أنه لم يتم استخدام هذا المصطلح في مقابل استخدام مصطلحات قد تبدو مترادفة أو متقاطعة معه.
· ففي تقرير الدورة 22 (1994 – 1995) ومن بين 8 بنود تصف الوضع الراهن تحت عنوان (أين نحن) نجد إشارة غير مباشرة في البند رقم 6 ص 34 على النحو التالي “الانبهار بكل ما هو أجنبي ونقص الاستفادة بالطاقات الوطنية البشرية مما يؤدي إلى قصور في التنمية البشرية الوطنية الشاملة والمتواصلة.
· وفي التقرير الصادر عن الدورة 23 (1995 – 1996) وعند تحديد متطلبات التنمية الشاملة، وشروط تحققها وعلى رأسها مخرجات عملية التعليم الجامعي لم يأت ذكر الهوية أو الانتماء أو البعد الثقافي أو البعد القيمي الأخلاقي والديني. وتم الإشارة فقط إلى تعليم أبناء المجتمع علمًا نافعًا ومفيدًا يبنى الإنسان بناء متكاملا عقلًا وجسدًا وروحًا وضميرًا وسلوكًا، ويكسبه مهارات على العمل والإنتاج (ص 133-134).
· أما تقرير الدورة 24 (1996 – 1997) في جزئية تحت عنوان التعليم الجامعي والعالمي في ضوء تحديات المستقبل فلقد ركز على تحديات عصر المعلومات الخاصة بالتكنولوجيا في أبعادها المادية البحتة فقط..
· ولكن يعود تقرير الدورة 25 (1997 – 1998) ليفرد جزأ خاصًا بالبعد الثقافي والإنساني في إعداد طلاب الجامعات والمعاهد العليا يلخص فيه الوضع الراهن لهذا البعد كالآتي: عدم الاهتمام الكافي بتنمية الوعي الثقافي لدى الطلاب مقارنًا بإكسابهم معلومات العلم الذي يتخصصون فيه، عدم ارتباط المقررات الدراسية بقضايا المجتمع ومشكلاته بطريقة مباشرة في معظم الأحيان، وجود فجوة لدى بعض الطلاب بين ما يعرفون من أفكار وآراء وقيم اجتماعية أصيلة وبين ما يمارسونه من سلوكيات، قلة تأثير الجامعات والمعاهد العليا في المجتمع المحلي ثقافيًا. ولذا فإن هذا التقرير –دون غيره- أفرد مساحة أساسية للبعد الثقافي والإنساني عند تحديد فلسفة التعليم ومخرجاتها كما سنرى.
· ومع حديث تقرير الدورة 26 (1998 – 1999) عن تعظيم عائد مخرجات التعليم الجامعي والعالي في المجتمع المعاصر، نجد ضعف المضمون الخاص بالثقافي والإنساني أو القيمي والأخلاقي. فبالرغم من تركيز التقرير على تناول تحديات عصر العولمة على مخرجات العملية التعليمية والعوامل المؤثرة على هذه المخرجات، إلا أن ما يتصل بالأبعاد المعنوية بمعناها الواسع كان غائبًا بدرجة كبيرة لصالح الأبعاد المادية اللازمة لتحقيق كفاءة النظام التعليمي وسياسات القبول وسياسات التقويم للأداء الجامعي.
· وتكررت نفس الصورة في تقرير الدورة 27 (1999 – 2000)، والذي جاء تحت عنوان “الارتقاء بمستوى خريج التعليم الجامعي والعالي في إطار مفهوم الجودة الكلية لمواجهة تحديات المستقبل. فعند تحديد الوضع الراهن لمستوى خريج التعليم الجامعي والعالي كمنطلق –للحديث عن كيفية تحقيق الجودة سجل التقرير تدنى مستوى مخرجات هذا التعليم، ولخص أسبابها، والتي ليس من بينها ما يتصل بالأبعاد الثقافية أو القيمية.
· وهكذا ومع الاستمرار في التصدي لتحديات العولمة على عملية التعليم الجامعي في عصر المعلومات، وهى تحديات جد خطيرة، كان لابد وأن ينعكس هذا على الرؤى الإستراتيجية للتعليم الجامعي والعالي. ولذا فإن الرؤية التي قدمها تقرير الدورة 28 (2000 – 2001)، والذي جاء تحت عنوان “رؤية استراتيجية للتعليم الجامعي والعالي لمواجهة القرن الحادى والعشرين” حددت موضع الأبعاد الإنسانية في غمار تأثيرات العولمة على النحو التالي: “….فسوف يشهد مجتمع ما بعد الحداثة -المسألة الإنسانية وتأثير العالم الجديد والتكنولوجية في تخليقه- أثارًا بعيدة المدى على الإنسان في علاقته ببيئته وفي تحديد مصير المجتمع وتكوينه الذي يثير تحولات نفسية واجتماعية عميقة في وعى الإنسان والقيم الأخلاقية، وهذه هى المسألة الإنسانية التي يجب على مجتمع البحث العلمى التحسب لها”.
ولقد سجل هذا التقرير –من ناحية أخرى- وكقسمات للواقع المعاش ما يلي:
أولًا: تأثر فلسفة التعليم الجامعي بالعلاقات السياسية والثقافية المعقدة بين مصر وعدد من القوى الكبرى فضلًا عن تأثير بنية التركيب الطبقى. ومن ثم فإن تطور بوصلة هذه العلاقات عبر النصف القرن الأخير من القرن العشرين قد أدى إلى تحول الأمر إلى شيء من “الموزاييك الفكري” الذي يحتاج لعلاج ما اقترن به من حدوث اضطراب فكري.
ثانيًا: أبعاد الجدل الذي ولده التحول نحو اقتصاديات السوق حول أثر هذا التحول على مهام الجامعة: هل هي التعليم والتثقيف، أم تلبية احتياجات سوق العمل، أم تجمع بين الاثنين؟
وأخيرًا وبغض النظر عن القواسم المشتركة بين بعض من مشاكلنا وبعض من مشاكل العالم في هذا الصدد، فهل يكفي مثلًا في تقرير الدورة التاسعة والعشرين (2001 – 2002) للمجلس القومي للتعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي تشخيص التحديات بأنها تحديات العولمة أو المنافسة مع الخارج فقط؟ أين التحديات الداخلية النابعة من طبيعة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لابد من إدارتها من الداخل أولًا قبل أن نتحدث عن متطلبات مواجهة التحديات الخارجية؟
وهل يكفي من ناحية أخرى –حين اقترح سبل التطوير ومواجهة التحديات، الرجوع إلى تقرير اليونسكو 1998 عن آفاق التعليم الجامعي في بداية القرن الواحد والعشرين؟ أم أن الأخذ بتقنيات العولمة- هو السبيل المتاح؟
وهل يكفي النص في التوصيات –فيما يتصل بالهوية- على فقرة غامضة واحدة هي الحفاظ على خصوصية الثقافة المصرية؟ وهل تقلصت الهوية لتصبح هوية محلية فقط؟
ثالثًا- مصدر خبرات التطوير وموارده المالية: إشكاليات العلاقة بين الاعتماد على الذات وبين المساعدات الخارجية
لكل مشروع تطوير –ذو توجه مستقبلي ووطني وحضاري- فلسفة ورؤية كلية تحدد الوظيفة والدور من ناحية والدوافع والمبررات من ناحية أخرى، كما لابد أيضًا وأن تحدد من الذي يقوم بالتطوير وما هي الموارد المتاحة لهذا التطور
\ من الذي قدم مشروع التطوير الذي تم اعتماده في المؤتمر القومي (2000) والذي بدأ تنفيذ مشروعاته مرحليًا؟ وكيف يتم تمويله؟
حقيقة شارك قطاع واسع من الخبراء –ولمدة عامين، منذ صدور قرار وزير التعليم العالي 1998 بشأن التطوير، في مناقشة المشروع وحتى إقراره، كما استغرق الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الأولى عامين آخرين، ولكن يجدر تسجيل بعض الملاحظات التي أوردتها بعض الدراسات المتخصصة في هذا المجال:
1- انتقد البعض[12] انطلاق مسار عملية التطوير من اللجنة القومية لتطوير التعليم التي يرأسها الوزير المختص ويشترك في عضويتها 16 من أعضاء الحكومة من إجمال 25 عضوًا، مما يعني غلبة عنصر السلطة الحكومية وماله من تأثير على حرية التفكير والقرار. كما انتقد الاعتماد على المؤسسات الدولية المالية والخبرات الأمريكية والأوربية منذ بداية العملية. حيث أن المؤتمر الأول الذي نظمته اللجنة القومية في يونيو 1999 كان بالتعاون مع البنك الدولي كسبيل من سبل مساندة البنك الحكومة المصرية في وضع السياسة العام والإطار الاستراتيجي لتطوير التعليم الجامعي، وهو الأمر الذي يمثل ملمحًا من ملامح ضعف الإرادة الوطنية والتعرض لضغوط املاء شكل معين للتطوير ومنهج محدد من التفكير. ولقد شارك في هذه الندوة رئيس مجموعة خبراء البنك الدولي، وممثل هيئة المعونة الأمريكية، ورئيس الوفد الأوربي بأوراق عن دور القطاع الخاص في التعليم الحكومي وعن أهمية الموارد البشرية للتنمية الاقتصادية. كما نوقشت في المؤتمر أوراق عمل قدمها خبراء أجانب من جامعة كاليفورنيا، ومن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومن إدارة التعليم في البنك الدولي، ومن مدرسة لندن للاقتصاديات، ومن جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة. وبالرغم من الاعتراف باهمية الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال، إلا أن هذه الرؤية الناقدة تساءلت عن أسباب عدم الاستعانة بتقارير المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجي وأعرب عن أسفه لضياع كل هذه الجهود “بحيث نجد أنفسنا وكأننا لا نعلم كيف نطور التعليم الجامعي، فنعقد الاتفاقيات ونستقبل المنح ونطلب القروض ويتدفق الخبراء الأجانب لتعليمنا كيف نطور؟” في حين أن شعبة التعليم الجامعي في المجلس القومي تداوم –باعتباره بنكًا عقليًا تابع لقيادة الدولة- على التفكير والدراسة والبحث في هذا الأمر ما يقرب من الثلاثين عامًا. كما أن قضية تحديث التعليم العالي هي الشاغل الأساسي للمجلس منذ 2003.
2- وتفسر رؤية ناقدة متخصصة أخرى[13]، غياب فلسفة هادية للتطوير بأمور تتصل بمن يقومون على التطوير ومواردهم، على اعتبار أنهم من الوزراء الذين (توجههم تعليمات السيد الرئيس وقد يلتزمون بها أدبيًا، ولكنهم يتحركون عمليًا برؤى شخصية لا تلتزم باستراتيجية مؤسسية تحكم الوزراء ولا يحكمونها، بل يغيرو منها متى أرادوا مما يحدث انقطاعات وتناقضات، فالمهم أن يطبع كل تغيير ببصمة الوزير) ومن الاستشاريين -وبالذات من رجال التربية- الذين تنوعهم أدبيات تتباين بين نزعات ليبرالية أو اشتراكية أو سلفية، ولكن تجمعهم في أغلبهم براجماتية المصلحة الشخصية ومسايرة السلطة وتبرير مقاصدها وتطبيق قراراتها وتنفيذ أوامرها، وشعارها فلنفعل شيئًا [كله زي بعضه – الدولة عاوزة كدة] وارتاحوا جميعًا لسياسة النقل والتقليد، وأصبحت صيغ التطوير جاهزة ومعبأة في قرارات ومشروعات هيئات ومنظمات دولية. ويقوم بالتنفيذ خبراء أجانب أو اختصاصيون مصريون، ولا فرق ما دام التطوير عملية استيراد وتشغيل (له إرشادات كتالوج).
علينا أن نتعلم التطوير بروح ديمقراطية، وأن نترك للأمة حق سيادتها في اتخاذ قرارات مصيرية تتصل بالتنمية البشرية، وأن تكون للأحزاب وجماعات المثقفين مشاركة حقيقية في صياغة رؤية وطنية للتطوير.
وإذا أصبح لنا رأي عام مرضي عنه ومتفق عليه، أمكن القول بوجود فلسفة مصرية نستطيع في ضوئها أن نضع التجارب العالمية في تطوير التعليم الجامعي موضع نظر ونقد وتعديل وتكييف بما يتفق وخصوصية ثقافتنا، وأولويات حاجاتنا، وإمكانات واقعنا.
هذا وتبلغ ميزانية تمويل مشروعات التطوير الجاري تنفيذها وفق خطة (2002-2007)، 6 مليون دولار لمشروع الأداء والجودة، 6 مليون دولار مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، 12 مليون دولار مشروعات نوعية تمول من صندوق مشروع تطوير التعليم العالي (HEEPF) و10.5 مليون دولار مشروع تقنيات المعلومات والاتصالات، 17 مليون دولار من أجل تطوير الكليات التكنولوجية (المعاهد الفنية المتوسطة) 14 مليون دولار: تطوير كليات التربية، 33 مليون يورو: برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم العالي.
وهذه المبالغ تمثل -فيما عدا صندوق مشروع التطوير- منحًا ومساعدات، في حين تعد ميزانية الصندوق قرضًا وحيث أن بنود ومراحل هذه المشروعات مازالت في قيد الإعداد للتنفيذ[14]، وحيث أن معظمها مازال من المبكر جدًا تقويم مخرجاته ونتائجه بالنسبة للتطوير، فيكفي طرح التساؤل الآتي: كيف يمكن تقييم الإعداد لتطبيق هذه المشروعات؟ وما هو مردود مثل هذه المشروعات على تطوير منظومة التعليم وفق الأهداف والمبادئ والأسس المحددة في الخطة القومية؟[15] هل هذه المشروعات النوعية في نطاق الجودة أو تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس أو… غاية في حد ذاتها أم وسيلة لتطوير أكثر جذرية في المستقبل؟ ومن ثم ما هي مشروعات المراحل الثلاثة الأخرى حتى (2017م)؟ وهل تتصل بالقضايا الكلية والهيكلية –وسياسات إدارتها: مثل نظام القبول ونظام التعيين، ومصادر التمويل؟
خلاصة القول
ومن واقع طبيعة الطرح السابق –فإن قضية تمويل التطوير قاصرة على تمويل المشروعات الست وليس المقصود بها تمويل التعليم وسياساته. فتلك الأخيرة قضية أخرى أكثر خطورة، وأن كانت تمس أيضًا جوانب أخرى من دور الدولة في تمويل التعليم العالي- مقارنة بالأطراف الخارجية والداخلية المدنية منها والأهلية – فإذا كانت الدولة قاصرة -بذاتها أو بموارد مجتمعها المدني والأهلي- عن توفير موارد تطوير المشروعات الفنية الست، فهل ستكون قادرة على توفير ما هو أكثر الحاحًا أي الاستثمارات الضرورية في مجالات هيكلية؟ وهذا يقودنا إلى المحور التالي.
رابعًا: قضايا التطوير ومجالاته وآلياته: إشكاليات تحديد الأولويات: بين استيراد الحلول المدعومة من الخارج وبين ديمقراطية تصميم الحلول، والتأرجح بين علاج أعراض الأزمة وبين علاج أسبابها الهيكلية
حفلت وثائق التطوير الرسمية ودراسات المؤتمرات المتخصصة بقوائم القضايا التي يجب أن تتصدى لها عملية التطويرًا تحقيقًا لمبادئ وأسس وأهداف هذه العملية[16]. وبالنظر إلى قائمة القضايا التي قدمتها الخطة القومية (2000) نجد أنه يمكن تصنيفها إلى 6 مجالات تتصل بمنظومة التعليم وهيكله، والجودة والأداء، والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والتمويل، والعلاقة بالبيئة الخارجية للمنظومة.
وبالنظر إلى مضمون المشروعات الخمس وعشرين المقترحة للتطوير نجد أن هذه المشروعات تغطي مساحات ممتدة من هذه المجالات ومن خلال آليات متعددة لتحقيق التطوير في كل مجال. فعلى سبيل المثال نجد أن مشروع تطوير نظم الالتحاق بالتعليم العالي، ومشروع إنشاء مركز دراسات ومتابعة توظيف خريجي مؤسسات التعليم العالي، ومشروع التنمية الثقافية والفنية والرياضية، مشروع تنمية برامج التميز لرعاية المتفوقين والموهوبين، مشروع دعم مراكز التميز العلمي والبحثي في مؤسسات التعليم، جميعها مشروعات تتصل بالطلاب في مرحلة ما قبل التخرج.
وبالمثل يمكن تصنيف بقية المشروعات الخمس وعشرين وتوزيعها بين المجالات الست أو القضايا الثلاثة عشر المحددة للتطوير والتي تضمنتها الخطة الاستراتيجية. ولكن تبقى المجموعتان التاليتان من الأسئلة مطروحة: من ناحية هل يعكس ترتيب هذه المجالات الثلاثة عشر وكذلك المشروعات الخمس والعشرين في الخطة أي نوع من الأولوية وفق فلسفة تطوير التعليم ورؤيته الاستراتيجية؟ بعبارة أخرى ماذا بعد رصد وتشخيص ملامح الأزمة، وصياغة المبادئ والأسس والأهداف، وتحديد مجالات التطوير، اليس هناك أولوية للتنفيذ، حتى يمكن كسر الحلقة المفرغة التي تدور فيها سياسات التطوير منذ أكثر من عقد وحتى يمكن علاج الأسباب وليس الأعراض؟ بعبارة أخرى: من أين نبدأ؟ وكيف نتحرك ومتى تنتهي عملية التطوير؟ وما مخرجها النهائي المتوقع؟ ومن ناحية أخرى هل يعني بداية المرحلة الأولى من تنفيذ التطوير بمشروعات ست أن هذه المشروعات هي التي تحوز الأولوية، وهي التي تمثل القاعدة التي تنطلق منها بقية مراحل التطوير وتنبى على نتائجها ومخرجاتها؟
وحيث أن موضوعات بحوث المؤتمر ستتصدى لموضوعات ومجالات التطوير وسياساته وآلياته في المحورين الثاني والثالث منه، وحيث ليس بمقدور هذه الدراسة بالطبع التصدي للإجابة على مجموعتي الأسئلة السابقتين إلا أنه يمكن طرح بعض الملاحظات الاستفسارية –وليس التقويمية- عن أربعة قضايا: الجودة، زيادة القدرة الاستيعابية للجامعات (أي إعداد خريطة جديدة لمنظومة التعليم العالي)، وسياسات قبول الطلاب في التعليم العالي وسياسات التمويل. والقضية الأولى يتصدى لها أول مشروع من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها والتي يتم تمويلها من المنح الخارجية، أما القضايا الثلاثة التالية، فهي تمثل –من وجهة نظري- أولوية تتطلب التصدي لها وخاصة أنها تثير إشكاليات تتجادل حولها التوجهات المختلفة، من قبيل إشكالية الجامعات الخاصة (خصخصة التعليم)، ومجانية التعليم الحكومي؛ والاستثمارات اللازمة لدعم التعليم العالي بأبعاده المختلفة (الأبنية وتقنية المعلومات والمكتبات، وقدرات الطالب وأعضاء هيئة التدريس، وجميعها أمور لازمة وشروط سابقة لتفعيل عملية تطوير محتوى المقررات وطرق التدريس والتقييم…) فبالرغم من الإيمان بأهمية العنصر البشري وضرورة تنميته إلا أن الحيز المكاني ومحدودية أعداد الجامعات القائمة بالمقارنة بالمطلوب والأعداد المتكدسة من الطلبة في الحيز الضيق من ناحية وعدم توافر الموارد المادية لتفعيل العملية التعليمية من ناحية أخرى يمثلان قيودًا شديدة الخطورة على تحقيق نتائج إيجابية من وراء عملية تطوير التعليم الجارية بحيث لا يصبح هناك مجال للحديث عن نظم تقييم الأداء والجودة في ظل استمرار هذه القيود.
أولًا الملاحظات الكلية على مشروع تقييم الأداء والجودة
وهي ابتداء ملاحظات تدور حول فلسفته ومصداقيته في ظل مؤشرات ومعطيات أزمة التعليم القائمة، وليس حول مضمونه أو آلياته ومخرجاته المحتملة.
وتتلخص هذه الملاحظات فيما يلي:
1- أن إعمال نظام الاعتماد وضمان الجودة يفترض أن أدارة الجامعة أو المعهد لها صلاحيات كاملة في الأمور المحورية ذات التأثير على جودة العمل التعليمي ومخرجاته، وأهمها نظم ومعايير قبول الطلاب ونظم وشروط معايير تعيين أعضاء هيئة التدريس وتقويم أدائهم وإنهاء خدماتهم. ومن ثم كيف يمكن تطبيق نظم جددة وأداء في كليات تفتقد بعضها المقومات اللازمة للدراسة نظرًا لمشكلة الإعداد الكبيرة. حيث لا تسمح هذه الأعداد بقيام عملية تعليمية ذات معنى ترضى عنه أي هيئة للاعتماد وضمان جودة التعليم في أي مكان في العالم[17].
2- ومن ثم فلا يمكن تبرير الحاجة لنظام الجودة باعتباره سبيلًا لمواجهة تحديات العولمة وتحقيق التميز والمنافسة، ذلك لأن التحديات الداخلية النابعة من ظروف البيئة المحيطة تفرض قيودها على فعالية بل ومصداقية تطبيقه، ومن ثم تصبح الحاجة ضرورية لإبداع نظم جودة تأخذ في الاعتبار ظروف دول الجنوب وذلك بدلًا من استيراد المعايير الدولية لتأسيس هذه النظم، وهي النظم التي يتم تطبيقها في الدول المتقدمة للحفاظ بالفعل على مستوى التقدم والمنافسة والتمييز.
في حين نجد أن نظمنا التعليمية ليست بقادرة على المنافسة بل هي في حاجة لإصلاح لتصل إلى مستويات الأداء العادية غير المتأزمة. ومن ثم فهي تحتاج لمعايير جودة تقيس فعالية الخروج من حالة الأزمة، ولتصبح أداة لكسر حلقة سوء الأداء المفرغة في نظم التعليم، أو على الأقل تساعد على أدارة الموارد القائمة بصورة أكثر رشادة وذلك في حال استمرار الظروف البيئية المحيطة على ماهي علية بدون تغيير.
3- ولعل من أبرز الأمثلة الدالة على أهمية توطين معايير الجودة وتقييم الأداء، وليس التطبيق الحرفي للمعايير الدولية، ما يتصل بلغة التدريس.
فمن معايير الأداء الأمثل أن تكون اللغة الوطنية هي اللغة الأولى في التدريس، إذن كيف سيكون موقف الكليات التي تطبق نظام شعب التدريس باللغات الأجنبية؟
ثانيًا: الملاحظات الكلية حول القضايا الثلاثة الأخرى في ارتباطاتها
ابتداء نلحظ أن الوثيقة التي قدمها د. عمرو سلامة تحت عنوان منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والتي دارت حولها خلال الشهور الماضية مناقشات متنوعة (مثل التي جرت عقب المحاضرة التي ألقاها سيادته في جامعة القاهرة في 19/9/2004، ومثل التي جرت في حلقة النقاش التي نظمها نادي أعضاء هيئة التدريس في 4 يناير 2004) هذه الوثيقة قد نصت على ست محاور للعمل لتحقيق الأهداف، ويتناول المحور الأول منها قضية رفع القدرة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي، ويتناول المحور السادس دعم الأنشطة الطلابية وتحديث اللوائح وهي موضوعات لا تتناولها مشروعات التطوير الجاري تنفيذها والتي أشارت إليها المحاور الأربع الأخرى من الوثيقة.
وتتلخص الملاحظات النقدية الكلية في هذا الصدد على النحو التالي:
(1) تتداخل إشكاليات رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي مع إشكاليات إنشاء الجامعات الخاصة، وتطويرها وإشكاليات سياسات تمويل التعليم العالي وسياسات قبول الأعداد الكبيرة من الطلاب في الجامعات الحكومية حيث التعليم مجانًا.
(2) المنطق الرسمي (كما عبر عنه د. عمرو سلامة في إجاباته على الأسئلة عقب محاضرته في جامعة القاهرة) يتلخص في المقولات التالية:
1- التعليم عملية مجتمعية شاملة يشارك فيها الجميع، وخاصة من حيث مصادر التمويل، ومع ضرورة استجابة الدولة والوزارة لمطلب الحاجة للتعليم الجامعي من جانب الشعب (10% زيادة كل عام في المقبولين بالجامعات) يظل هناك قصور في الاستيعاب، فضلًا عن مشكلة الموارد المالية والتمويل.
2- الدولة لم تقصَّر في التعليم العالي المجاني وستجتهد قدر طاقتها لتقديم هذه الخدمة. ولكن -في نفس الوقت- لماذا لا يتم توفير نظام يمكّن الطالب الذي يريد دراسة تخصص معين، ولم يتم قبوله في الجامعات الحكومية، أن يحقق رغبته؟ والتعليم الموازي فكرة على هذا الطريق، ولكن مازال موضوعًا تحت الدراسة، ولن يحدث تعجُّل في إقراره قبل دراسة متعمقة لإيجابياته وسلبياته. وبالمثل، فالجامعات الخاصة تقدم نفس الفرصة للطالب الذي يريد دراسة تخصص معين ولم تقبله الجامعات الحكومية.
3- التعليم العالي الحكومي متميز بالمقارنة بأي نظام تعليمي آخر داخل مصر، وما زالت الجامعات المصرية الحكومية أقدر من نظائرها الخاصة، ويظهر ذلك في مستوى خريجيها الذين يدرسون في الخارج، وكيف يَقْدِرون على التنافس في أكبر الجامعات العالمية.
4- الجامعة الأمريكية في القاهرة هي الجامعة الأجنبية الوحيدة وفق قانون تأسيسها 1935، والجامعات الأخرى -الفرنسية والألمانية- إنما تكونت برأسمال مصري 100%، ولكن تتلقى عونًا علميًا من فرنسا وألمانيا.
5- لا يوجد فجوة طبقية بين الفقراء والأغنياء مرجعها أقسام اللغات في بعض الكليات، وليس هناك مؤشرات على شعور طبقي عدائي متبادل، ولكن من يريد التعلم بالإنجليزية فهو يدفع أعباء هذا التعليم، وليس لهذا الوضع أي علاقة بالطبقية.
6- ومن ناحية أخرى، الجامعات الخاصة أصبحت مكونًا أساسيًا في بنية التعليم في مصر، وهي تقوم بدور في استيعاب الطلبات على التعليم الجامعي (والذي تعجز الجامعات الحكومية على الوفاء به كاملًا). وإذا كانت تقوم على مبدأ الربح، وهذا شأن كل مشروع خاص، فلتربح! ولكن شريطة أن تقدم خدمة جيدة، كما يجب أن تضع نظامًا للقبول يحقق الكفاءة والعدالة.
(3) في هذا الصدد تثور الأسئلة التالية:
¨ لماذا هذا التطور في الطلب على التعليم العالي (الحكومي) بالرغم من البطالة وبالرغم من ضعف معدلات الحراك الاجتماعي الناجم عن التعليم العالي بالمقارنة بمعدلات سابقة؟ وهل وضعنا المقارن مع الدول الأخرى –وخاصة الكبرى- من حيث القدرة الاستيعابية للجامعات معيارًا صالحًا ورشيدًا لتبرير الحاجة لدفع هذه القدرة استجابة لتطور الطلب على التعليم؟ وهل هذا “التطور على الطلب” ناجم عن شروط صحيحة وتعبير حقيقي عن “الاحتياجات”؟ أم هو تطور للطلب على نمط جديد من التعليم لا توفرة المؤسسات التعليمية الحكومية المجانية الراهنة؟
¨ كيف سترفع الحكومة القدرة الاستيعابية في الجامعات الحكومية الحالية (10% سنويًا) في ظل أزمة تمويل الجامعات وفي ظل التداعيات السلبية للأعداد الكبيرة على العملية التعليمية؟ وألن يكون السبيل المقترح لتحقيق هذه الزيادة على حساب “النوعية” المرجو تحقيقها في ظل مشروعات التطوير الجاري تنفيذها؟ أم أن الضغوط الاجتماعية والسياسية –تحت مزاعم الحفاظ على مبادئ الدستور التي تكفل مجانية التعليم والحفاظ واستقرار النظام السياسي- ستتفوق في تأثيراتها بالمقارنة بالحسابات العقلانية الرشيدة؟
¨ بعبار أخرى كيف سنواجه إشكالية العلاقة بين التوسع في التعليم العالي وبين إشكالية نوعية مخرجات هذا التوسع أم سنظل تدور في حلقة مفرغة تستحكم معها مؤشرات أزمة مخرجات التعليم نظرًا لسلبيات الأعداد الكبيرة وتدهور قدرات أعضاء هيئة التدريس؟ وهل سيظل بالإمكان التوسع في ظل استمرار “المجانية”؟
(4) لا تنفصل قضية تمويل التعليم العالي، عن قضية الجامعات الخاصة والأهلية والدولية في مصر، أو عن قضية مستقبل الجامعات الحكومية وخاصة ما يتصل بالجوانب المختلفة لتطويرها والتي نصت عليها مشروعات التطوير. ففي مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم ينص البند الحادي عشر من بنود قائمة مجالات ومشروعات التطوير على تنمية مصادر إضافية متعددة لتمويل التعليم العالي وترشيد مجالات الإنفاق، ومن ثم تضمنت قائمة المشروعات المقترحة للتطوير مشروعًا (الثالث والعشرون) لتنمية مصادر إضافية متعددة لتمويل التعليم العالي. ولذا نتساءل: أين هذا المشروع؟ وما مخرجاته؟ هل نظام التعليم الموازي أم الرسوم الإضافية أم المساعدات الخارجية أم أقسام اللغات في بعض الكليات؟ أم إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية؟
¨ ولكن أين ترشيد المجانية في التعليم العالي الحكومي الذي يستوعب النسبة العظمى من طلبة التعليم العالي بكل أنواعه؟
¨ ولماذا –وكما يتساءل بعض المتخصصين[18]- الاستغراق في شذرات تطوير لا تتناسب مع فقر القدرة وفقر الرغبة لدى الأفراد والحكومة، ولا تعتمد على ترتيب أولويات؟ فلماذا إضاعة الوقت والجهد والمال القليل في مشروعات تطوير لا نجد لتنفيذها أثارًا إيجابية في تحقيق رقي منظومة التعليم (ويضرب لذلك مثلًا دورات تنمية قدرات أعضاء التدريس)؟
(5) أن الغرض من طرح هذه الأسئلة هو تركيز الضوء على المخاطر التي تحيط بالتعليم العالي الحكومي. (ناهيك عما يجب أن تحظى به الجامعات الخاصة أيضًا من ترشيد لسياسات القبول ومعايير الأداء).
ذلك لأن التعليم –وخاصة الجامعي- هو قضية أمن قومي ومسئولية جماعية ولكن لا يمكن أن تتخلى الدولة عن دورها فيه، مهما كثر الحديث عن مزايا وضرورات أدوار القطاع الخاص والأهلي.
إذن ما مصير الجامعات الحكومية الوطنية؟
حقيقة أن الخصخصة (الوطنية، والأهلية، والدولية) هي من سبل رفع القدرة الاستيعابية، ولكن لا يجب أن يكون الثمن هو تآكل استقلالية عملية التطوير الوطنية نظرًا لتزايد وزن “الخارجي” في منظومة التعليم، أو تآكل مسئولية الدولة عن ضبط وترشيد دور القطاع الخاص والأهلي في مجال تمويل التعليم العالي، أو افتقاد الخريجين لقيم مشتركة تجمعهم نظرًا لتخرجهم من أنساق ومنظومات ثقافية متشرذمة وليس مجرد متنوعة أو متعددة، أو استمرار تدهور الجامعات الحكومية “المجانية”. ومن ثم فإن سبل تفعيل هذه الجامعات لا تقل أهمية عن السبل الأخرى، ليس للتوسع في التعليم العالي فقط ولكن لتحسين نوعية أدائه ومخرجاته خدمة لأهداف المعرفة والتنوير والتنشئة والعمران الحضاري ومتطلبات السوق، أي خدمة لمتطلبات التنمية الشاملة. والسبيل لذلك لن يكون بالالتفاف على المجانية أو على مشكلة الإعداد الكبيرة (التي تحول دون بروز أو ظهور النخب المتميزة من الطلبة) ذلك الالتفاف الذي يتحقق بأساليب تتعرض لانتقادات شديدة، مثل شعب التدريس باللغات، الرسوم الإضافية تحت مبرر تقديم خدمات إضافية للطلبة (مثل الكومبيوتر)، وأخيرًا ما يسمى نظام التعليم الموازي الجاري النقاش حوله الآن[19]، ولكن يكون بإعطاء الأولوية لمشروعات مثل مشروع تطوير نظم الالتحاق بالتعليم العالي ومشروع تنمية مصادر إضافية متعددة لتمويل التعليم العالي، وهما من مشروعات الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالي[20]، والتي تتصدى لأسباب أساسية من أسباب الأزمة وليس أعراضها.
(6) ومن ثم فإن زيادة القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية، بوضعها الحالي أو وفق التطوير المقترح، استجابة لزيادة الطلب على التعليم العالي سيكون على حساب إنسانية التعليم وآدميته وفعاليته، حيث يظل الكم -وليس النوع- هو المحك, ويساعد على هذا استمرار التمسك بمجانية التعليم باعتبارها مكسبًا متبقيًا من مكاسب نظام ثورة يوليو 1952،وآخر صمام آمان ضد انفجار اجتماعي مرتقب ساهم في تشكيلة فشل متراكم لسياسات سابقة في مجالات مختلفة.
فإنه مع مزيد من الجامعات الخاصة والأهلية والأجنبية، ومع استمرار مجانية التعليم في الجامعات الحكومية، لن يتحقق إلا وأد هذه الجامعات الحكومية. فلتبقَ هذه الجامعات تحت إدارة الحكومة، ولكن ليصبح لها نظام للقبول يرشد المجانية دون فقدان العدالة والتكافل، من خلال نظم المنح الدراسية ورعاية الطلبة المتميزين. كما ينبني على نظام جديد لقبول الطلاب. ولذا يقترح البعض[21] النظر في الأخذ بنظام مراحل التعليم الجامعي، حيث يتم التمييز بين المرحلة الأولى (سنتين) (والتي يكون بمقدورها الانتشار إقليميًا لاستيعاب أعداد كبيرة وتحقق مزايا مهنية عالية) وبين المرحلة الثانية التي تأخذ التخصص العريض ويتم القبول فيها وفق معايير ومقاييس فنية ومنهجية فتساعد بذلك على تقليل الفقد أو الهدر في التعليم بسبب نظم القبول القائمة على مكتب التنسيق بوضعه الحالي. كما ينصب المشروع السادس من المشروعات المقترحة في الخطة الاستراتيجية للتطوير على تطوير نظم الالتحاق بالتعليم العالي، حيث ينص على مراجعة نظم القبول بحيث تقوم على أساس قياس قدرات الطلاب بجانب معيار مجموع الدرجات وذلك لتحقيق فرص أفضل لاستكشاف الموهوبين والمتفوقين وتوجيه الطلاب نحو التعليم النظري أو التطبيقي وفقًا لقدراتهم وبما يساعد على التفوق.
وفي المقابل فإن المساعدات الخارجية في تطوير وتوسيع التعليم العالي لا يجب أن تكون على حساب استقلالية عملية التطوير وبالمثل فإن: الجامعات الأجنبية وإن كان سبيل للمساعدة العينية العلمية إلا أنها تمثل نفوذًا أجنبيًا جديدًا وازدواجيات متنامية في الانتماءات تنال من المشروع الوطني للتعليم العالي.
وأخيرًا فإن استقلال التعليم العالي لا يتحقق في مواجهة “مراكز التعليم الخارجي” فقط، ولكن تجاه الدولة أيضًا، والمقصود ليس استقلالًا ماليًا فقط، لكن سياسيًا بالأساس لضمان حرية اختيار القيادات وممارسة حرية الرأي والتعبير، والسماح بالأنشطة السياسية للطلبة.
خلاصة القول: يجب التخلص من تسييس فلسفة التعليم العالي التي جعلت منه –بالتدريج- وسيلة لاسترضاء الشعب بالحديث عن حقوقه قبل مطالبته بواجباته؛ ولذا حان أوان المطالبة بالواجبات سواء من جانب الحكومة أو الشعب. والمطلوب من جانب الحكومة هو إنقاذ الجامعات الحكومية، وليس استبدال نظم تعليم موازية أو نظم تعليم خاصة وأهلية بها، في حين تظل الحلول الموضوعة لعلاج الجامعات الحكومية هي حلول ترميمية وليست حلولًا جذرية. إن فلسفة التعليم المثُلى الآن هي أن التعليم العالي حقُُّ لمن يقدر عليه، ليس ماديًا ولكن فكريًا ومعنويًا. فالقدرة هنا تفوق البعُد المادي، لأنه (مقارنة بالقدرة الاستيعابية وليس بالنظر إلى تنامي الطلب) كَمْ هو ضخمُُ عدد الطلبة الذين يدخلون الجامعة -كحق لهم مكتسب- وليس لديهم القدرة عليه. وبالمثل فإن التدريس بالجامعة، ليس هو حقًا مكتسبًا ومستمرًا لمن تم تعيينه من أوائل الدفع، ولكنه مكتسب يتم بالاختبار، وليس وظيفة حكومية يتربع فيها الأستاذ دون محاسبة أو تطوير، كما هو مفترض أن يكون وضع الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس. ومن ثم فإن الأولوية يجب أن تُعطى لأمرين هما من صميم العمل لإنقاذ الجامعات الحكومية، وهما:
من ناحية إعادة النظر الصريح والواضح في مجانية التعليم، وتخطيط وسائل علاج مساوئها بطريقة جِذْرية، وليس بالطريقة التدرجية الجاري تنفيذها (أقسام اللغات، التعليم الموازي…)، فهذه التدرُّجية لن توفر الحلول المناسبة في الوقت المناسب؛ لأن التدهور قد وصل أقصاه فالمجانية حق اسىء توظيفة ولم يعد يؤد الهدف منه نتيجة ضغط الأعداد الكبيرة وغيرها على نفس الأعداد من الجامعات.
من ناحية أخرى: إعادة النظر في نُظُم اختيار وتعيين أعضاء هيئة التدريس، ووضع نظام لمراقبة الأداء والمحاسبة، فضلًا عن وضع نظام جديد للرواتب وللحوافز؛ لتوفير المناخ اللازم للتفرغ الحقيقي لشئون البحث والتدريس في نطاق الجامعة.
خامسًا- قضية تأثيرات بيئة منظومة التعليم العالي: إشكاليات العلاقة بين المدخلات والمخرجات
يتضح من الطرح في البنود الأربعة السابقة أن التطوير لم ينطلق من فلسفة محددة ورؤية استراتيجية واضحة، ومن ثم فإن تأثيرات الخارجي على تحديد دواعي ومتطلبات التطوير كانت حاضرة، كما أن قضايا ومجالات التطوير التي بدأ تنفيذها ليست الأمن قبيل القضايا الجزئية التي تقع في نطاق علاج أعراض الأزمة، كما أنها تبدو كعمليات فنية إجرائية تفتقد البوصلة لأنها لا تقوم إلا على فلسفة الحلول المؤقتة التسكينبة ولا تواجه كل ما يتصل بأثر المدخلات من البيئة المحيطة بمنظومة التعليم.
ومن ثم لابد من طرح التساؤل التالي: هل يستقيم تطوير منظومة تعليم متأزمة بانفصال عن المنظومة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمثل بيئة لها؟ حيث أن مخرجات التعليم ليست نتاج الوسط الاجتماعي فقط بل هي أيضًا مدخل في عمليات التغيير الاجتماعي الشاملة. ولذا فإن هذه العلاقة المركبة بين نسق التعليم والنسق الشامل المحيط من أعقد العلاقات حين البحث عن موطأ لكسر الحلقة المفرغة التي تدور فيها مجتمعاتنا. وتتعدد الأدلة على ذلك، كما تتعدد مستويات التفسير. فمما لا شك فيه أن التغيرات الاجتماعية والسياسية منذ ما بعد ثورة يوليو، وعبر السبعينيات والثمانينيات انعكست على منظومة التعليم بطرق مختلفة لعل من أهمها ضعف مخرجات التعليم ما قبل الجامعي والتي تمثل مدخلًا للتعليم العالي، قيم التحولات الاجتماعية السلبية، والتدخلات السياسية في الجامعة. وتلك الأخيرة تتخذ صورتين: القيود المفروضة على النشاط السياسي للطلبة وعلى الأنشطة الفكرية والانتماءات السياسية والفكرية لأعضاء هيئة التدريس من ناحية، واستقطاب أعضاء من هيئة التدريس وانجذابهم للقيام بأدوار ووظائف سياسية في خدمة النظام السياسي القائم مما ترتب عليه سلبيات عدة، من أهمها حرمان العملية التعليمية والبحثية من قدرات علمية لانشغالها في متطلبات الدور السياسي على حساب ما يجب بذله من جهد لتنمية قدرات عضو هيئة التدريس أو على حساب فعالية وكفاءة العملية التعليمية.
ومن ناحية أخرى فإن مشاكل النظام الاقتصادي تحاصر العملية التعليمية بالفقر ومحدودية الموارد اللازمة للاستثمار في التعليم، فضلًا عن أن البطالة والركود الاقتصادي يخلقان بيئة نفسية سلبية تحيط بالطلبة وتؤثر سلبًا على قدراتهم ورغباتهم في التحصيل العلمي مما يخلق حالات اللامبالاة وعدم البذل للجهد العلمي الرصين.
وبالرغم من أنه لا يمكن وقف عمليات تطوير التعليم العالي انتظارًا لتغير البيئة الاجتماعية والاقتصادية المحيطة، وبالرغم من أن جميع الطاقات والجهود يجب أن تتكاتف لتنفيذ ما يمكن تنفيذه من مشروعات تطوير، إلا أنه يجب الوعي لحقيقة هامة وهي أن التغيير الجذري للتعليم العالي لإخراجه من أزمته ليس إلا جزءًا مندمجًا من عملية إصلاح شاملة وجذرية، ومن ثم فهو يرتهن بعملية إصلاح سياسية واقتصادية جذرية، ولا يجب أن تصبح قضية تطوير التعليم العالي مجرد ساحة أخرى، إلى جانب الإصلاح الأقتصادي –لجذب الانتباه بعيدًا عن ساحة الإصلاح السياسي المرجو تحت حجة القول أنه لا إصلاح سياسي بدون إصلاح اقتصادي ومجتمعي سبق وأن متطلبات الإصلاح السياسي (التعديل الدستوري، إلغاء قانون الطوارئ… إلخ). هي من قبل مهددات الاستقرار في مصر الآن. أن السياق السياسي المحيط هو من أهم محددات عملية التعليم وتطويرها. فإن طبيعة هذا السياق وما يتوافر من موارد اقتصادية ومجتمعية ودرجة تعبيره عن رضاء عام، هي التي تؤثر على طبيعة فلسفة التعليم ورؤيته الاستراتيجية والقائمين على وضع سياساته وتوفير مصادر تمويله. فبقدر شرعية النظام السياسي بقدر ما تتحقق ديمقراطية صنع وتنفيذ السياسات الوطنية ليس في مجال التعليم فقط ولكن في كل المجالات الأخرى.
*****
الهوامش:
[1] المؤتمر القومي للتعليم العالي (فبراير 2000) مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالي.[2] أعمال مؤتمر جامعة القاهرة لتطوير التعليم الجامعي (رؤية لجامعة المستقبل)، مايو 1999، أربعة أجزاء.
[3] على سبيل المثال وليس الحصر: مؤتمر التعليم العالي في الوطن العربي (يوليو 1990، رابطة التربية الحديثة، القاهرة: كلية التربية، جامعة عين شمس)، جامعة المنوفية: “مؤتمر التعليم العالي في مصر وتحديات القرن الحادي والعشرين”، مايو 1996، جامعة الزقازيق: “المؤتمر العلمي السنوي الثاني، إدارة الجودة الشاملة في تطوير التعليم الجامعي” مايو 1997، كلية التربية جامعة المنصورة بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة: آفاق الإصلاح التربوي في مصر، كلية أكتوبر 2004.
جامعة الأزهر: مؤتمر التوجهات التنموية في تطوير التعليم الجامعي العربي، ورؤية مستقبلية، القاهرة، يونيو 2004، مركز تطوير التعليم العالي جامعة عين شمس، المؤتمر القومي السنوي الحادي عشر (العربي الثالث): التعليم الجامعي العربي: آفاق الإصلاح والتطوير بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية القاهرة ديسمبر 2004.
[4] تقارير المجلس القومي للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا (الدورة 22- الدور- 295).
انظر أيضًا: المجالس القومية المتخصصة: كتاب التعليم وقضاياه في بحوث ودراسات المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا (1974- 2002)، القاهرة 2002، الباب الثالث: في مجال التعليم الجامعي والعالي.
[5] المؤتمر القومي للتعليم العالي (فبراير 2000) مرجع سابق
[6] د. سعيد إسماعيل علي: تجديد العقل الجامعي (في) مركز تطوير التعليم الجامعي، جامعة عين شمس، مرجع سابق، ص188.
[7] طلعت عبد الحميد: “مواجهات إجرائية لاستراتيجية عربية للتعليم العالي” في مرجع سابق: ص 207-214.
[8] د. عبد الرحمن النقيب: التكامل المعرفي كأداة لإصلاح التعليم الجامعي: كليات التربية نموذجًا (في) مرجع سابق: ص 226.
[9] د. حامد عمار: رؤية مستقبلية لفلسفة التعليم الجامعي، (في) أعمال مؤتمر جامعة القاهرة لتطوير التعليم الجامعي، مرجع سابق، الجزء الرابع ص 1215-1222.
[10] د. مصطفى منجود (محرر): نماذج عالمية في تدريس العلوم السياسية أعمال المؤتمر العلمي لقسم العلوم السياسية، 2001 كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2002.
– د. أحمد ثابت (محرر) تقويم محتوى المقررات الدراسية، أعمال المؤتمر العلمي لقسم العلوم السياسية، 2000، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2001.
[11] انظر على سبيل المثال: د. محمد السيد سليم: التدريس باللغات الأجنبية في الجامعات المصرية (في) أعمال مؤتمر جامعة القاهرة لتطوير التعليم الجامعي، مرجع سابق.
– د. نادية مصطفى: تقييم محتوى مقررات العلاقات الدولية، أثار التشعيب (في) د. أحمد ثابت (محرر) مرجع سابق.
[12] انظر على سبيل المثال: د. نادية مصطفى: دور الجامعات العربية في الحفاظ على الهوية العربية، حالة جامعة القاهرة، بحث مقدم إلى مؤتمر دور الجامعات العربية في تقرير الهوية العربية، مؤتمر مصاحب للاجتماع 36 لمجلس اتحاد الجامعات العربية، (قطر، أكتوبر 2003).
[13] انظر تحليلًا لهذا البعد في: د. نادية مصطفى، مرجع سابق.
[14] د. سعيد إسماعيل علي: مرجع سابق 184.
[15] د. محمود قمبر: تجارب عالمية في تطوير التعليم الجامعي (في) مركز تطوير التعليم الجامعي، جامعة عين شمس، مرجع سابق ص 526-529
[16] وحول بنود وتفاصيل كل مشروع وموضعه من عملية التطوير انظر (مرفق 3).
[17] فعلى سبيل المثال وليس الحصر: هل مشروع تأسيس ماجستير للدراسات الأوروبية المتوسطية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يعبر عن استجابة فعالة للتحديات التي تواجه الدراسات العليا في الجامعات المصرية؟ يحتل أولوية بين متطلبات التطوير في مصر أم هو مجرد استجابة لمتطلبات سياسات الاتحاد الأوروبي في مجال الشراكة الثقافية، وعلى النحو الذي يحقق أهداف ومصالح هذا الطرف الأوروبي أساسًا؟ وهل التدريس بالإنجليزية في هذا البرنامج ونشر المراجع المؤلفة في نطاقه بالإنجليزية هو سبيل من سبل التطوير؟
[18] انظر على سبيل المثال: وثيقة مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم (مرفق 1 ص 13).
انظر أيضًا فهارس كتب أعمال المؤتمرات التي نظمتها الجامعات المصرية في هذا المجال خلال الأعوام السبع الماضية للتعرف على أهم القضايا التي حازت على الاهتمام المتخصصين التربويين ورجال الفكر والإسلام والأكاديميا في مصر.
[19] د. أحمد فاروق عبد الحافظ: إدارة الجودة الشاملة والاعتماد للجامعة ومؤسسات التعليم العالي (في) المؤتمر القومي السنوي الحادي عشر لمركز تطوير التعليم الجامعي جامعة عين شمس التعليم الجامعي العربي: آفاق الإصلاح والتطوير ص 42-43.
[20] د. محمد صبري الحوت: “الفقر وتمويل التعليم الجامعي” دراسة في إشكالية التطوير في المؤتمر السنوي الحادي عشر، لمركز تطوير التعليم الجامعي، جامعة عين شمس، مرجع سابق، ص 457-458.
[21] انظر: د. محمد صفي الدين خربوش: التعليم الموازي بين المؤيدين والمعارضين ورقة نقاش قدمت لمنتدى التعليم العالي، الحلقة الأولى، 28/12/2004 (كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
انظر د. محمود قمبر: مرجع سابق ص 506
المؤتمر القومي للتعليم العالمي (فبراير 2000) مرجع سابق.
للتحميل اضغط هنا