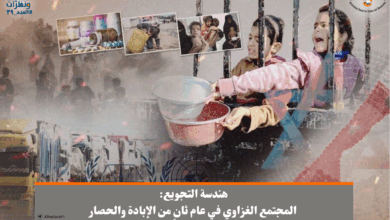جهاز الدولة وهيمنته على المجتمع المصري

مقدمة
يعدُّ جهاز الدولة المصري أحد أعرق الأجهزة الإدارية في التاريخ، وهو أقوى تنظيم سياسي في الدولة المصرية، ويستطيع هذا الجهاز القيام بأدوار محورية في توجيه السياسة المصرية والتحكُّم في شؤون المجتمع، ومن هذا المنطلق فإن هذا التقرير يحاول رصد التحولات التي طرأت على هذا الجهاز منذ الحقبة الناصرية حتى عهد مبارك، مع إطلالة تاريخيَّة سريعة أقدم -عند اللزوم- لبيان ما اعترى هذا الجهاز من تحولات وتقدير مدى مساهمتها في التغيُّرات التي طرأت على المجتمع المصري.
ويسعى هذا التقرير لاستكشاف دور هذا الجهاز من ناحية مدى تقبُّله لمشاركة المجتمع الذي يُفترض أن يُقدِّم خدماته له، وكيف يقيم العلاقة معه؟ وهل يسعى لتحقيق مصالح المجتمع العامة أم يخدم بقاء سيطرته وهيمنته عليه كهدفٍ رئيسي يتغلَّب على العديد من الأبعاد الأبقى أثرًا والأجدى نفعًا ممَّا يتعلَّق بتحقيق الصالح العام للجماعة والوصول إلى إدراكٍ حقيقي لمشكلاته والسعي لتوفير الحلول اللازمة لها؟ وهل تحقِّق سياسات هذا الجهاز -بالطريقة التي يدير بها شؤون المجتمع- مقتضيات الأمن القومي أم لا؟ وسياسات الجهاز في المجالات المختلفة هل يُراعى فيها رأي المجتمع ويقام بشأنها حوار مجتمعي لبيان وجهة نظر هذا الجهاز ومدى تحقيقها لرغبات أفراد المجتمع وجماعاته وتطلُّعاتهم أو للاستدراك على هذه السياسات من آراء المجتمع أو تغييرها كلية أم أنها تُفرض عليه باعتبارها صادرة عن مصدرٍ يحوز سلطة أبويَّة تكفل له التوجيه دون عصيان؟ ومن يحدِّد أولويات الدولة: الجهاز أم المجتمع؟ وهل هناك مساحة لحركة المجتمع أم أنها مضيَّقة ومقموعة؟ وسيتم هذا بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال استعراض تطور الجهاز الإداري للدولة ومدى تغلغله في مساحات كان يستقل المجتمع بإدارتها وهيمنته عليها ودور التشريعات والسياسات المتعاقبة في استقرار هذا الوضع واستتبابه.
إن هيمنة جهاز إدارة الدولة على مجتمعٍ ما يكفل للقائمين على هذا الجهاز توجيه الجهاز لتحقيق مصالح قد لا تكون تمثِّل أولويَّةً للمجتع الذي يتحكَّم هذا الجهاز في إدارته وتسيير شؤونه، بل وكثيرًا ما يحدث أن يستغلَّ القائمون على هذا الجهاز ما لديهم من سلطات تفوق قدرات المجتمع على العقاب أو المنع أو المساءلة أو الرقابة لتوجيه سلوك هذا الجهاز بما يحقِّق أهدافهم الخاصَّة أو على الأقل تحقيق ما لا يخضع لرقابة المجتمع ورغباته ومصالحه من سياسات وأهداف، بالرغم من أن هذا الجهاز الإداري منوط به تنفيذ ما تقرِّره السلطة التشريعية من تشريعات وتحديدٍ للأولويَّات، وما تصدره السلطة القضائية من أحكام. في حين أن احترام الجهاز الإداري لسلطة المجتمع وخضوعه لرقابته يكفل للمجتمع تحديدًا لأولوياته ومقتضيات أمنه القومي، وتحقيقًا لأهدافه، وتنفيذًا لتوجُّهاته.
وتتحقَّق هيمنة جهاز الدولة على المجتمع باحتكار هذا الجهاز الأدوات التي يتمُّ بها تسيير شؤون المجتمع ومنعه للمجتمع من التمكُّن من تحصيل هذه الأدوات أو شبيهًا بها أو قريبًا منها بجهوده الذاتيَّة. والجهاز الإداري في الدولة المستبدَّة دائمًا ما يسعى للسيطرة على شؤون التشريع ومحاربة أي مرجعية خارجه، بحيث يكون هو المرجعية الأعلى في الدولة، وهو في سبيله لذلك لا يكتفي بالتدخُّل عن طريق ما لديه من نفوذ للسيطرة على المجالس التشريعيَّة وضمان وصول الأعضاء الذين يصنعهم على عينه لضمان ولائهم وخضوعهم له، ولكنه فوق ذلك يحرص على الاستئثار بقدرٍ من الحق في التشريع بشكل مباشر وغير مباشر من خلال قرارات إدارية تصدر منه، كما يحرص على تقرير العديد من الاستثناءات في التشريعات التي تقرِّرها هذه المجالس فيما تصدره من قوانين، بحيث يظل لهذا الجهاز الحق المتجدِّد في عدم الالتزام بنصوص القانون أو تأويلها على حسب هواه دون تحمُّل أيِّ تبعة. ويسعى الجهاز الإداري في الدولة المستبدة للسيطرة كذلك على مرفق القضاء ليضمن عدم صدور أحكام تُخِلُّ بهذه المكانة التي يحظى بها باعتباره المرجعية العليا والوحيدة وحتى لا يجد نفسه مضطرًّا -بحكم مسؤوليته عن تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء- عن تنفيذ ما لا يرضى أو ما يتعارض مع مصالحه. فضلا عن سيطرته على الجهاز التنفيذي للدولة الذي يتحكَّم في معايش أفراد المجتمع وجماعاته من شؤون الري والزراعة والصناعة والتعليم والصحة والثقافة… إلخ. وهو بموجب تحكُّمه في كلِّ هذه المجالات يملك قدرًا كبيرًا من المعلومات تتجمَّع عند رأس هذا الجهاز، وفي الوقت ذاته فإن هذه المعلومات يتم حجبها عن المجتمع، وهذا يتيح للجهاز حريةً كبيرةً في الحركة، في حين تضيق مساحة هذه الحركة جدًّا بالنسبة للمجتمع؛ ممَّا يجعله عاجزًا عن اتِّخاذ القرار المناسب ممَّا يتعلَّق بأيِّ شأنٍ مركَّب أو معقد ومتشعِّب في مستويات ومجالات مختلفة من شؤونه؛ لعدم إحاطته بالمعلومات المتعلِّقة بهذا الشأن ومدى صلته وارتباطه بالشؤون الأخرى. كما تتوافر للجهاز الإداري سطوة أمنية يستعين بها في قمع المجتمع عندما يريد، ويفرق بها بين جماعاته بحيث لا تتجمَّع عليه، ويدير بأدواته الأمنية الكثير من الشؤون المدنيَّة للمجتمع.
لقد كان ظهور أساليب الإدارة الحديثة في أوروبا ونماذج التنظيمات الحديثة هناك متوازنًا في أوروبا الغربية مع تطوُّر مجتمعاتها واقتصادها وحركاتها السياسية والاجتماعية وأنشطة جماعاتها الفرعية، ولذلك فإن النمو المتوازي والمتكافئ لنظم الإدارة والحكم الحديثة ولنماذج تنظيم الهيئات والمؤسَّسات في الغرب كان مطَّردًا سواء في أبنية إدارة الدولة المركزية أو في مؤسَّسات المجتمع المدني أحزابًا وجمعيات ونقابات واتحادات رجال أعمال وغرف تجارية وصناعية وشركات وغير ذلك. فكان اشتداد عود أجهزة الدولة من حيث القدرات والكفاءات يوازيه ويوازنه اشتداد عود أجهزة إدارة جهات المجتمع المدني، فلم تطغَ قوة الدولة الحديثة على أجهزة إدارة الهيئات المدنية والشعبية ولا أزهقت روحها. أما في بلادنا العربية والإسلامية والشرقية بعامة، فلم يحدث هذا النمو المتوازي والمتكافى. فأجهزة الدول الحديثة في بلادنا إمَّا كوَّنها الاستعمار بعد سيطرته على ما سيطر عليه من بلادنا، وإما أنها نشأت نشأة محلية بخبرات التنظيمات الأجنبية لمواجهة مخاطر الخارج. وكل ذلك خضع بعد ذلك للهيمنة الاستعمارية مع نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. وهذا التنظيم الحديث سواء كان في الأجهزة المدنية أو العسكرية أكسبها قدرات فائقة بالمقارنة بالتنظيمات التقليدية السابقة، من حيث أنماط تقسيم العمل وتداول المعلومات وتركيم الخبرات وكسب المهارات التخصُّصيَّة والتحليليَّة الحديثة والاعتماد على نظم الإدارة غير الشخصية وعلى المعلومات والخبرات المكتوبة وأساليب حفظ ذلك كله وانتقال الخبرات عبر الأجيال[1].
وتجدر الإشارة إلى أن وضع المؤسَّسات والتكوينات الأهلية يعدُّ أحد المؤشرات المهمَّة على درجة الديمقراطية والحرية وإمكان تداول السلطة في المجتمع، إذ لا يمكن الحديث عن تداول الحكم بين مختلف القوى السياسية في غيبة مجتمع مدني قوي يوفِّر للمجتمع مؤسَّسات مدنية تعلي من شأن قيم الديمقراطية وتنشر الثقافة الديمقراطية، حيث يعتبر المجتمع المدني بمثابة البنية التحتيَّة للديمقراطية السياسية ومع التعددية الحزبية والانتخابات تعتبر هذه المقومات الثلاث شرطًا رئيسيًّا لتداول الحكم[2].
أولًا- الجهاز الإداري قبل الدولة القومية
كانت المجتمعات قبل ظهور الدولة القومية لا تعتمد كثيرًا على تدخُّل الدولة بشكلٍ كبير في شؤون المجتمع، وكان المجتمع يقوم بالتسيير الذاتي للكثير من شؤونه بعيدًا عن تدخُّل الدولة، وقد كان لضعف وسائل التمداتصالات والمواصلات مع اتساع الدول القديمة جغرافيًّا أثر كبير في هذا الوضع. وفي المجتمع الإسلامي كان تسيير المجتمع لشؤونه بنفسه بعيدًا عن سيطرة الدولة أكبر من غيره من المجتمعات الأوروبية بحكم العوامل السابق الإشارة إليها، بالإضافة لانفصال السلطة التشريعية عن الحاكم، لصدورها عن الله سبحانه وتعالى، والسبيل إلى معرفة أحكام الله تكون عن طريق العلماء الذين يبرزون في المجتمع بشكل طبيعي عن طريق الاجتهاد في تحصيل العلم ثم اعتراف الجماعة العلمية أو مجموع العلماء في مكان معين بالعالِم الجديد دون أي تدخُّلٍ من سلطة الحاكم في هذا الأمر، ثم قبول العامة لهؤلاء العلماء وثقتهم فيهم ورضاهم بهم وبما يقررونه من أحكام، فضلا عن كفالة المجتمع من خلال الأوقاف على التعليم بمختلف مجالاته من ظهور العلماء حتى لو كانت هناك عوائق مادية تقف حائلا دون تمكُّن البعض من الاستمرار في مجال التعليم والتدريس من بعد.
وكذلك الاستقلال الذي حازه القضاء في التاريخ الإسلامي لصدور القضاة في أحكامهم عن ما تقرَّر في أحكام الفقهاء، خاصة المذاهب الفقهية المعتمدة والشائع اتباعها في الأمة دون هيمنة من السلطة على هذه الأحكام ولا إمكانية تدخُّلها في صياغتها وتقريرها.
وبعد ذلك هناك هيئات أهلية كانت على قدرٍ كبير من استيعاب قطاعات من المجتمع ولو بشكل جزئي وبقدر يفوق قدرة الدولة في كثير من الأحيان عن شغله، وذلك كالمذاهب الفقهية التي انتشرت متجاورة في كل قُطر ومتجاوزة لكل قُطر في الوقت ذاته، وصبغت عادات وتقاليد أتباعها بما قرَّرته من أحكام، وكذلك الطرق الصوفية وطوائف الحرف والعائلات الكبيرة… وغير ذلك من تشكُّلات أهلية، وهي بطبيعة الحال تشكيلات جامعة غير مانعة، جامعة للمنتمين إليها في مساحةٍ معيَّنة، وغير مانعة لهم من الاندراج في غيرها ممَّا لا تشغله هي من مساحات، وصار لها بمرور الوقت الكثير من النفوذ على المجتمع، وهو نفوذ غير مفروض على المجتمع، بل نابع منه وبتمويله، وهو نفوذ صار يوازي سلطة الدولة ويزاحمها في الكثير من المساحات، ويغل يدها عن الانفراد بالمجتمع والاستبداد به، وفي أوقات الأزمات وضعف سلطة الدولة فإنه يقوم بما ينبغي عليها القيام به، وهو ما تجلَّى في الحالة المصرية بشكلٍ بارز في مقاومة الاحتلال الفرنسي نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر ثم إحلال محمد علي واليًا على مصر وفرضه على الدولة العثمانية من جانب القوى والتشكلات الأهلية في القُطر المصري.
وإذا كان محمد علي قد بدأ مرحلة نهضة جديدة إلا أن من أخطر وأسوأ ما فيها سعيه لضرب هذه التشكُّلات الأهلية والسيطرة عليها وعلى الأوقاف، وإنشاء هيئات موازية تتجاوز القديم وتطغى عليه.
وإذا كان توغُّل جهاز محمد علي في الشؤون الأهلية والاجتماعية، من حيث السيطرة على الأوقاف والهيمنة على التكوينات الشعبية، إذا كان لذلك ما يبرره في عهد محمد علي لما ألقى عليه مشروعه السياسي من مهام جسام، تتعلَّق ببناء الجيش وإعداد التعليم المناسب لمهن حديثة يقتضيها هذا الإعداد، ومن حيث التمويل الذي تعيَّن معه السيطرة بقدر الإمكان على فائض القيمة الاجتماعي وتعظيم الدخل القومي بما يقتضي من اعتبار مصر شبه مشروع اقتصادي إنتاجي واحد، بمعنى أنه إذا كان توغُّل الجهاز وقتها متلائمًا مع ضخامة المهام وعظم التحديات المطروحة، إذا كان ذلك كذلك، فإنه بعد إفشال مشروع محمد علي منذ 1840 وبعد حصر نظامه وأهدافه في مصر فقط، لم يعد هذا التوغُّل في ضخامته مناسبًا لهذه المحدودية في الأهداف وفي النطاق. ومع ذلك فقد زاد نزوعه إلى الهيمنة والحلول محل أي نشاط جمعي أهلي، كما ستجيء الإشارة إليه[3].
ويلخِّص المستشار طارق البشري مسار جهاز الدولة وما اكتسبه من طباع خلال القرنين الماضييْن في كتابه “جهاز الدولة وإدارة الحكم في مصر المعاصرة”، قائلًا: لدينا جهاز إداري للدولة وفقًا لنُظم الإدارة الحديثة، بدأت نشأته خلال حكم محمد علي بعد أن تخلَّص من بقايا النُّظم القديمة، وكان ذلك على وجه التقريب منذ نحو 1820. ومن ثم يمكن حساب عمر جهاز إدارة الدولة الحديث لمصر من هذا التاريخ؛ فيكون عمره الآن.. نحو مئتي سنة. وتقوم إزاءه تجربة نظام ديمقراطي نيابيٍّ حقيقيٍّ لا تتجاوز مجموع أعوامها وشهورها المتقطعة الأعوام التسعة. فمصر منذ 1923 لم تعرف نظام حكم يقوم على وجود حقيقي لنظام برلماني منتخب انتخابًا حرًّا ونزيهًا ويمارس عمله في استقلالية عن السلطة التنفيذية، لم تعرف ذلك إلا في سنوات لا يزيد مجموعها على ثمانية أعوام في ظل دستور 1923 أي في الفترة من 1923 إلى 1952، وكان ذلك في فترات متقطعة لم تزد أطولها على عامين وبلغ بعضها ستة أشهر أو ثلاثة أشهر، وكان أحدها مدَّته نحو ثماني ساعات سنة 1925. كما عرفت مصر هذا النظام النيابي المنتخب المستقل بعد ثورة 25 يناير 2011 في ظلِّ التعديل الدستوري الذي جرى في 19 مارس 2011، عرفته مصر لستة أشهر من يناير إلى يونيو 2012، وتلاه رئاسة جمهورية منتخبة بنزاهة وحيدة لمدة سنة واحدة من يونيو 2012 إلى يونيو 2013 دون برلمان، وذلك في ظلِّ دستور 2012. بمعنى أننا على مدى تسعين سنة لم نعرف نظامًا نيابيًّا حقيقيًّا إلا مدَّة تكاد تبلغ تسعة أعوام.
وهناك ملاحظة تتعلَّق بحالة الطوارئ وكانت تسمَّى حالة الأحكام العرفية، التي تعني من الناحية القانونية منح السلطة التنفيذية وجهاز إدارة الدولة، سلطة إصدار القوانين بدلًا من السلطة التشريعية المنتخبة وإمكان إنشاء محاكم قضائية خاصة بدلًا من السلطة القضائية المستقلَّة. هذه الحالة أُعلنت ومُورست في مصر في ظل دستور 1923 منذ 1939 عندما أشعلت الحرب العالمية الثانية، واطَّرد إعلانها وتطبيقها من بعد. على مدى هذه السنوات بقيت سارية ونافذة ولم تُرفع ولم تُزل إلا مُددًا منقطعة لا تبلغ الأعوام العشرة، وهي من سنة 1945 إلى 1948، ومن 1950 إلى 1952، ومن 1964 إلى 1967، ومن 1980 إلى 1981، ثم شهورًا في 2012. وفيما عدا هذه المدد المتقطِّعة بقيت حالة الطوارئ قائمة ونافذة رغم النظام الدستوري القائم في كل من هذه الفترات. وحتى في فترات رفعها كانت تصدر قوانين تؤدِّي في التطبيق إلى كفالة «حق» الدولة وجهازها الإداري في ممارسة السلطات الاستثنائية على المواطنين.
ففي سنة 1964 مثلا صدر قانون تدابير أمن الدولة ليحل محلها عند رفعها، وفي 1972 صدر قانون حماية الجبهة الداخلية، وفي 1980 صدر قانون الوحدة الوطنية، وفي 2013 صدر قانون منع التظاهر وهكذا. ومعنى ذلك أننا عشنا في مصر في حالة طوارئ ثابتة اعتاد عليها جهاز إدارة الدولة وتشكَّلت في إطارها تجاربه ومهاراته وأساليب إدارته للشؤون العامة وللتعامل مع المواطنين. بمعنى أنه في «ثقافته» الإدارية وبحكم تجاربه وخبراته لم يعد يستطيع الحكم ولا ممارسة مهام عمله في التعامل مع المواطنين إلا في ظلِّ ما تنتجه هذه «حالة الطوارئ» من سلطات وقدرات غير مقيدة، أي في إطار سلطات طليقة من القيود. أخشى أن أقول إنه لم تعد إمكانية الحكم وإداراته تنفصل عن خبرة الاستبداد ومعارفه وعادات تعامله. وأظن أن هذا هو أحد مشاكل ما تواجهه ثورة 25 يناير 2011 من انتكاسات جرت منذ 3 يوليو 2013 [4].
ولهذا التاريخ المتعلِّق بتشكيل جهاز الدولة وكيفية إدارته لشؤون الحكم، فإن جهاز الدولة تبدو علاقته بالرأي العام المصري وبالقوى والجماعات الشعبية المتعدِّدة علاقة يشوبها التوتُّر والتحرُّج في الغالب من الأوقات والأمور، وإن أسلوب تشكيل هذا الجهاز ونظم علاقاته بالرأي العام وأسلوب عمله ونشاطه؛ أي نظام جريان المعلومات في داخله ونظم اتِّخاذ القرارات وطرائق تنفيذها، كل ذلك يجري بواسطة نخب ثقافية ومهنية على عزلة عن جماهير الناس خارجها، وهي في الغالب الأعم ليس لديها الاستعداد والتأهيل، وليس في تشكيلات الجهاز النظامية ما يمكن العاملين فيه من تبادل النظر والمشورة مع أيٍّ من التكوينات الشعبية التي يتعاملون معها. وليس ثمة وجه اعتياد للقائمين على هذا الجهاز للنظر بندِّيَّة وتكافؤ مع من هم خارجون عنه، ولا توجد أساليب نظامية للتبادل الصحي للمعلومات والمواقف. والمشكل الأساسي في ذلك هو بناؤه شبه المنغلق من الناحية التنظيمية الذي لا يجعله في نشاطه المعتاد يتفاعل مع التشكيلات الشعبية والاجتماعية من خارجه[5].
بيد أن المعضلة الأساسية تتمثَّل في محورية هذا الجهاز بالنسبة لدولة كمصر بخلاف دول أخرى في محيطها أو في مناطق أخرى من العالم، يمكن أن يحتلَّ فيها جهاز الدولة موقعًا متراخيًا عن غيره من القوى والتنظيمات في هذه المجتمعات كالقبائل والعائلات الكبيرة وبعض الطوائف المعيَّنة ذات النفوذ في تلك المجتمعات؛ إذ تستطيع أيٌّ من هذه القوى أو التنظيمات حمل كثيرٍ من الأعباء والانفراد بالقيام بها بغير حاجة إلى جهاز الدولة أو موازنته في عددٍ من الأعباء والمهام.
ولكن مصر على توالي العصور وتتابعها -كما يوضِّح البشري- تحتاج دائمًا إلى جهاز الدولة، لا ليحفظها فقط من عدوان الخارج عليها، وما أكثر الطامعين فيها على توالي الأزمنة! كما أنه لازم لها أيضًا ليس فقط بسبب أن يقوم على حفظ التوازن بين جماعاتها وتكويناتها الاجتماعية كالطوائف أو القبائل؛ لأن مصر لم تعانِ من التحديات الطائفية والقبلية التي وجدت عند غيرها من الشعوب والجماعات الوطنية. ولكن جهاز الدولة لازم لها أيضًا وعلى نحو هام لإدارة الشؤون المعيشية لشعبها بوصفه جماعة وطنية عامة. مصر ليس فيها انقسامات طائفية ولا إقليمية ولا قبَلية مما يمكن أن يشكِّل صراعات جماعية بها، وممَّا يمكن أن يولِّدَ احتياج كلٍّ من هذه الجماعات الفرعية لأن تدير الشؤون المعيشية لناسها كما نرى ذلك في البلدان التي تعرف هذه التكوينات القوية، والتي تنعكس في خدمات التعليم والصحة والشؤون الحياتية الأخرى لكل منها. ولأن مصر لم تعرف ذلك فقد ألقي على جهاز إدارة دولتها كل هذه الأعمال لعموم الشعب المصري، فلم يتكون بوصفه جهاز إدارة للشأن السياسي وحده أم للجماعة الوطنية التي نشأت الدولة على أساسها، ولكنه تكوَّن بوصفه جهاز إدارة لكل الشؤون المعيشية للشعب المصري كله. وهو جهاز بهذا التكوين ينعكس في داخله كل مكونات الأقاليم المصرية وقاطنيها بغير فروق جوهرية بين من يعملون به من كافة الأنحاء. إن ذلك يُقيل جهاز الدولة من مواجهة الصراعات الطائفية أو القبلية، ولكنه يلقي عليه عبء هذه الإدارة اليومية للشؤون المعيشية للمصريين كافَّة، دون أن يخفِّف عنه هذا العبء جماعاتٌ فرعيةٌ تقوم بشؤونها الذاتية لأقسام من الجماعة الوطنية[6].
ثانيًا- تمدُّد جهاز الدولة[7]
كانت الوزارة الأولى [1878] تضم وزارات سبعة تشمل الوظائف السيادية للدولة على النحو الذي أشير إليه في «السياستنامه[[8]]». ولكن يمكن ملاحظة أن التشكيل الوزاري الإداري المركزي بدأ يمدُّ وجوهًا للإشراف على بعض جوانب ما كان يُعتبر من قبل نشاطًا اجتماعيًّا أهليًّا، لا تراقبه الدولة إلا في إطار إشراف الحسبة بمنع ما ظهر ضرره من منكرات ومظالم وإيجاب ما ظهر تركه من معروف. فنلحظ بدء اهتمام «بالمطبوعات والمطابع الأهلية» فضلا عن موضوع «الصحة» ممَّا صار يتبع وزارة الداخلية، وكذلك وجوه اختصاص لا تتعلَّق بالمدارس الأميرية التي تنشئها الدولة فقط، ولكنها تمتد إلى «المدارس والمكاتب الأهلية»، وكذلك المحاكم الشرعية والمجالس المحلية، ثم يرد النظر أيضا في شؤون الزراعة والملَّاحات والمحاجر والمعادن و«ملاحظة التياترات (المسارح)»، بمعنى أن الإدارة المركزية لمصر صارت إلى التدخُّل في أنشطة كانت متروكة للمجتمع الأهلى.
وقد تأكَّد هذا المسعى من السيطرة وبسط النُّفوذ على مساحات كان يستقلُّ بها المجتمع الأهلي في القرن العشرين، فنلحظ أن: وزارة الأوقاف التي ظهرت مع أول تشكيل وزاري في 1878، ألغيت في يناير 1884، ثم أعيدت في نوفمبر 1913 وبقيت إلى اليوم. ثم انسلخت الشؤون الزراعية لتشكِّل مصلحةً مستقلَّة في 1910 [بالقانون 34] ثم صارت وزارة مستقلة، وفي نوفمبر 1919 [القانون رقم 7] تجمَّعت مصلحة السكة الحديد والتلغراف والتليفون ومصلحة البوستة ومصلحة الفنارات والأشغال البحرية والملاحة النهرية والنقل الميكانيكي والطرق والكباري، وتشكَّلت منها وزارة المواصلات. وفي ديسمبر 1934 أنشئت وزارة للتجارة والصناعة شملت مصلحة التجارة والصناعة التي كانت تابعة لوزارة المالية، وفي أبريل 1936 أنشئت وزارة الصحة العمومية وضمَّت المستشفيات والمعامل ومقاومة الأوبئة، كما ضمَّت شؤون الأمراض المتوطِّنة ورعاية الطفل ومقاومة الحشرات ومراقبة الأغذية والمنازل غير الصحية والمحال المقلقة للراحة والخطرة والضارة بالصحة، مع الإشراف على شؤون مياه الشرب وعلى الصرف الصحي. وفي أغسطس 1939 أنشئت وزارة للشؤون الاجتماعية، لتقوم على شؤونٍ ومصالح منها «المسارح ودور السينما والنوادي والجمعيات والمهرجانات والموالد، ومنها الجمعيات التعاونية والتعاون بمختلف صوره، ومنها أعمال البر والإحسان، وكذلك مصلحة العمل والخدمات الاجتماعية والإرشاد والدعاية ومحاضرات التثقيف والمعاهد الليلية وحماية الطفولة والأسرة ومسألة العاطلين عن العمل… إلخ». وعبارة «إلخ» وردت بالقرار المنشئ للوزارة. ثم في أول يوليو سنة 1943 أنشئت وزارة التموين «تختص بشؤون التموين عامة» ثم أنشئت وزارة للوقاية المدنية مهمَّتها التدريب وإنشاء الفرق وتنظيم وسائل الدفاع المدني أثناء فترة الحرب، وذلك في يوليو 1943، ثم في مارس 1946 أنشئت وزارة التجارة والصناعة وضمَّت إليها اختصاصات وزارة التموين. وفي فبراير سنة 1950 أنشئت وزارة للشؤون البلدية والقروية تتبعها إدارة البلديات والأسواق والمذابح والمجاري وغالبها كان تابعًا لوزارات أخرى من قبل مثل وزارة الأشغال العمومية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة، ثم أنشئت وزارة الاقتصاد لتتبعها مصالح اجتزئت من وزارتي المالية والتجارة والصناعة. وبعد ثورة 23 يوليو 1952 أُنشئت «وزارة الإرشاد القومي» في نوفمبر 1952 وضمَّت الإذاعة والسياحة والدعاية ومراقبة السينما والمطبوعات والمعارض والمتاحف، ونُصَّ على أن من أهدافها توجيه أفراد الأمة وتيسير سبل الثقافة الشعبية «وعرض نتائج النشاط الأهلي والحكومي» وتزويد الرأي العام بالبيانات والإحصاءات الصادقة، وفي يونيو 1956 صارت وزارة الشؤون الاجتماعية باسم «وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل». ثم في أغسطس 1961 انفصلت وزارة العمل بوصفها وزارة مستقلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية. وظهرت وزارات أخرى على مدى الستينيات وما يليها تختص ببعض وجوه النشاط، مثل وزارة الصناعة ووزارة البترول ووزارة الإنتاج الحربي ووزارة التخطيط، وكذلك وزارتا الإعلام والثقافة بدلًا من وزارة الإرشاد القومي، ووزارة السياحة ووزارة الكهرباء.
يُبَيِّن هذا العرض شبه التفصيلي صورة سريعة لمدى تضخُّم جهاز الدولة المصرية على مدى من السنين يجاوز القرن ونصف القرن. وأن طول المدة يكشف دلالة مهمَّة، تتعلَّق بأن التضخُّم ودواعيه يتعلَّق بظاهرة ممتدَّة تتجاوز مراحل تاريخية ونُظُمًا سياسية ملكية أو جمهورية وبرلمانية أو رئاسية وديمقراطية أو استبدادية ودستورية أو فردية.
لكن المشكل في تمدُّد أنشطة جهاز إدارة الدولة التي حلَّتْ فيها الدولة محل الأنشطة الأهلية للأفراد والجماعات. أو وجوه التمدُّد هذه في أجهزة رقابة الدولة على الأنشطة الأهلية للأفراد والجماعات. والذي صارت به الدولة وأجهزتها، ليست فقط على سيطرة كاملة على الوظائف السيادية التي تعكس المصالح العليا للجماعة وتعكس أمن هذه الجماعة، وإنما صارت على توغُّلٍ هائلٍ في الأنشطة الاجتماعية ووجوه العمل الأهلي، وهو توغُّل يتَّخذ لتحقُّقه طريقين، إما إحلال النشاط الإداري الحكومي محل النشاط الأهلي، وإما الرقابة المستديمة على النشاط الأهلي بما يلحقه بالنشاط الإداري الحكومي ويجعله تابعًا لهذا العمل الحكومي. ومثال ذلك ما نلحظه بشأن الأوقاف والتعليم الأهلي والجمعيات والتعاونيات والنقابات المهنية والنقابات العمالية والصحافة، ومثاله أيضًا، يتعلَّق بأجهزة الدولة ذات الاستقلال التنظيمي التي امتدَّتْ إليها ذرائع للإلحاق الحكومي لها بالسلطة التنفيذية، مثل الأزهر والجامعات التي أنشئت من بعد والهيئات القضائية.
ثالثًا- التكوينات الأهلية وتأثُّرها بتمدُّد النشاط الحكومي
تأثرت التكوينات والأنشطة الأهلية بطبيعة الحال بفعل هذا التمدُّد الحكومي بواسطة جهاز الدولة الإداري على مساحات كان يستقلُّ بها العمل الأهلي، ولأنه في كثير من الأحيان كان هذا التمدُّد مقصودًا منه غل يد المجتمع الأهلي عن التحرُّك في مساحات معيَّنة، فإنه مع إصابته بالضعف لأسبابٍ متعدِّدة لم يستطع مقاومة هذا التغوُّل الحكومي، فبات إمَّا غائبًا عن هذه المساحات أو موجودًا بصورةٍ باهتة في تلك المساحات كتابع ومستخدم من قبل هذا الجهاز.
- مثلا من بين التنظيمات والتكوينات الأهلية «التقليدية الموروثة»، نجد من أهمها الطرق الصوفية والوقف، وبالنسبة للطرق الصوفية تبدو اللائحة التنظيمية التي صدرت في 2 يونيو 1903 هي من بواكير امتداد سلطة الدولة بالتنظيم والإشراف على الطرق الصوفية. وشكَّلت اللائحة مجلسًا صوفيًّا من شيخ مشايخ الطرق ومن أربعة مشايخ من ثمانية يُنتخبون لمدة ثلاث سنوات. وفي 1910 صدرت لائحة داخلية ولم تكن للدولة على الطرق هيمنة كاملة إلا أن شيخ مشايخ الطرق يصدر بتعيينه قرار من رئيس الدولة. وفي ظلِّ السلطة الفردية التي كانت تجري مجرى الأعراف في التشكيلات المؤسَّسية القديمة، فقد كان امتلاك سلطة تعيين شيخ المشايخ يعني الكثير بالنسبة للدولة، والتي تملك هذا التعيين، وقد صدرت هاتان اللائحتان في عهد السيد محمد توفيق البكري الذي كان شيخًا للمشايخ ونقيبًا للأشراف وكان أديبًا ومن الشخصيات السياسية والاجتماعية ذات الأثر والقول المسموع، ولم تعرف مشيخة الطرق الصوفية من بعده شخصيَّة على هذا المستوى الفذِّ من التأثير.
يقارن ذلك مثلا بما صدر في سبتمبر 1976، حيث صدر القانون رقم 118 بشأن نظام الطرق الصوفية، وجعل المجلس الأعلى للطرق الصوفية هو الهيئة المتحكِّمة في الطرق، فله الإشراف ومنه تصدر الموافقة على إنشاء طرق جديدة، وله أن يحظر نشاط أي هيئة أو جماعة وله تعيين مشايخ الطرق ووكلائهم وتأديبهم وعزلهم، وهو الذي يرخِّص بالموالد والمواكب والإشراف عليها وإنشاء مكاتب تحفيظ القرآن والزوايا. وهذا المجلس يشكَّل من شيخ مشايخ الطرق رئيسًا وعشرة من مشايخ الطرق منتخبين ومن ممثِّلٍ لكلٍّ من الأزهر ووزارة الأوقاف ووزارة الداخلية ووزارة الثقافة وأمانة الحكم المحلي. وشيخ مشايخ الطرق يعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية من بين مشايخ الطرق المنتخبين لعضوية المجلس الأعلى، والأعضاء المنتخبون يجري انتخابهم بمقرِّ المجلس المحلي لمحافظة القاهرة وبإشراف رئيس هذا المجلس وبحضور محافظ القاهرة. وشيخ المشايخ هو من يعيِّن وكلاء للمشيخة الصوفية بسائر المحافظات والأقسام والمراكز، ووكيل المشيخة هو من يتولَّى الإشراف العام على شؤون الطرق وهو من يثبت جميع المخالفات للقانون والنظام ويأمر بالوقف المؤقَّت لأيٍّ من أعضاء الطرق أو المسؤولين فيها. والجمعية العمومية للطرق تتكوَّن من كلِّ مشايخ الطرق الصوفية المعتمدة. والقانون حدَّد هذه الطرق المعتمدة، ومنع إنشاء أي طريقة صوفية أخرى جديدة إلا بقرار من وزير الأوقاف بالاتفاق مع وزير الداخلية وبناء على موافقة المجلس الأعلى، وشيخ كل طريقة يصدر بتعيينه قرار من المجلس الأعلى.
وهكذا يظهر إلى أيِّ حدٍّ صار هذا النوع من النشاط مهيمَنًا عليه من جهاز الدولة المركزية ولم تعُد له أية قدرة على المبادرة الذاتية تتَّفق مع طبيعة أنه نشاط أهلي[9].
- وبالنسبة للوقف، فإنه بعد انتهاء سيطرة محمد علي، عاد الوقف بالتدريج وعبر السنين ليتبوَّأ مكانة بين مؤسسات التمويل الأهلية للقيام على عددٍ من الشؤون الاجتماعية وتسيير المرافق وخدمة التعليم، والتعليم كما هو معروف يقتضي وضعًا مستقرًّا وتمويلًا ثابتًا، وسياسة تعليمية تبتعد عن كثرة التغيير والتعديل. والوقف فيما يتعلق بالتمويل يكفل هذا القدر من الثبات والاطِّراد لعمليةٍ تتطاول وتستغرق لتمامها ما يزيد على السنوات العشر للطالب الواحد. وقد بدأ موضوع الوقف يثور سياسيًّا عند سيطرة الوفد ومعه حزب الأحرار الدستوريين على مجلس النواب سنة 1926 و1927 وأرادوا أن يقلِّموا من سلطة الملك ويحدُّوا من إمكانات طاقاته التمويلية عن طريق سيطرته على الأوقاف، وذلك بربط ميزانية الأوقاف بالميزانية العامة للدولة. وأثير في هذا الصدد طريقة تعيين شيخ الأزهر وشيوخ المعاهد، ورأى برلمان حكومة الائتلاف أن يكون مدخله للنفوذ إلى هذه المناصب هو مناقشة ميزانياتها. ثم استطرد الأمر إلى المطالبة بإلغاء الوقف بدعوة صريحة كان عمدتها محمد علي علوبة باشا قطب الأحرار الدستوريين ويوسف الجندي من زعماء الوفد، وعارضهم بقلم ثابت لا يهدأ الشيخ محمد بخيت المفتي السابق… ثم في الأربعينيات صدر القانون 48 لسنة 1946 فأجاز الرجوع في الوقف الأهلي [الوقف على الذرية] وحدَّد أقصى مدة للوقف الأهلي أن يكون على طبقتين فقط أو أن يكون لمدة لا تجاوز ستين عامًا. ثم جاءت ثورة 23 يوليو لتلغي الوقف الأهلي أصلًا وتوزِّع أعيانه على الواقف إن كان حيًّا أو على المستحقِّين. أما الوقف الخيري وهو ما يهمُّنا هنا فقد أصدرت القانون 247 لسنة 1953 الذي ينص على أنه إذا لم يعيِّن الواقِفُ جهةَ برٍّ أو عيَّنها ولم تكن موجودة «أو وجدت جهة برٍّ أوْلى» جاز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى ألا يتقيَّد بشرط الواقف وأن يصرف الريع أو بعضه فيما يراه من وجوه أخرى. كما نصَّ على أنه إذا كان الوقف على جهة برٍّ كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشرط الواقف النظر لنفسه. ثم صدر القانون 152 لسنة 1957 الذي نصَّ على أن تُستبدل الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات برٍّ عامَّة وتسلَّم للهيئة العامة للإصلاح الزراعي مقابل سندات على الخزانة. ثم صدر القانون 122 لسنة 1958 يخول وزارة الأوقاف إدارة الأعيان التي ينتهي الوقف فيها إذا كان المستحقون يقيمون عادة خارج مصر. ثم صدر قانون برقم 44 لسنة 1962 بأن تسلَّم الأعيان الموقوفة على جهات برٍّ خاصَّة إلى المجالس المحلية، وهي من يتولَّى نيابةً عن وزارة الأوقاف استغلالها. ثم أنشئت بالقانون 80 لسنة 1971 هيئة الأوقاف المصرية لتسترد ما كان بقي مما آل إلى هيئات الحكم المحلي، وهي هيئة حكومية تتبع وزارة الأوقاف.
ويظهر من ذلك كله أنه بالنسبة للوقف الخيري فإن مجموعة القوانين المتلاحقة من 1953 إلى 1962 قد قضت على الوقف الخيري برمَّته، فهي ناطت النظارة بوزارة الأوقاف على خلاف شروط الواقفين، وهي خوَّلت الوزارة أن تعدل في مصارف الوقف على خلاف شروط الواقفين دون أن تجد ضرورة اللجوء إلى المحكمة لتقوم بهذا الأمر، وهي استبدلت بأعيان الوقف سندات. فلم يبق من الوقف لا أغراضه ومصارفه.. ولا ناظره ولا أعيانه. وكل ذلك آل إلى الدولة المركزية بموجب مشيئتها المنفردة[10].
وبعد أن كان نص القانون يجمل تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوقاف كما نصَّت على ذلك المادة 11 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بقولها: “يُصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتنظيم العمل بالـهـيـئـة وتـشـكـيـل مـجـلس إدارتها وبيان اختصاصاته وتحديد العلاقة بين الهيئة وكل من وزارة الأوقاف والهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجـالـس المحلية ، وأوضاع نقل العاملين اللازمين للعمل إليها”. فإن الاتجاه الآن لتعديل القانون، لينصَّ بالتفصيل على شغل مقاعد مجلس إدارة الهيئة من كتيبة من كبار موظفي الدولة وهيئاتها المختلفة، حيث ينص التعديل الذي انتهت إليه لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب في 15 أبريل 2019 على المادة (6) في القانون الجديد المقترح من الحكومة على أن: “يتولَّى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكَّل برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من: رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة – ممثل عن محافظ البنك المركزى يختاره المحافظ – ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية – ممثل عن وزارة الإسكان يختاره وزير الإسكان – ممثل عن وزارة التنمية المحلية يختاره وزير التنمية المحلية – ممثل لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق يختاره وزير العدل – الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – رئيس الهيئة المصرية للمساحة – رئيس قطاع بوزارة الأوقاف يختاره وزير الأوقاف – اثنين من علماء الشريعة الإسلامية يختارهما وزير الأوقاف باعتباره ناظر الوقف – ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم رئيس الهيئة”[11].
فبالرغم من أن الهيئة تقوم على إدارة أموال أهلية غير حكومية، إلا أن السلطة لم تُتِحْ لممثِّلين عن المجتمع أو الواقفين أو خلفائهم أيَّ مقعد من مقاعد مجلس إدارة الهيئة التي تدير وتتحكَّم في أموال الوقف! بالرغم من أن دستور 2014 ينص في المادة رقم 90 منه على أن: “تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك”، فأي استقلال تضمنه الدولة وهي تسعى لبسط مزيدٍ من الهيمنة على هيئة الأوقاف وإدارتها من خلال ممثِّليها دون غيرهم!
- وفيما يتعلَّق بالمجالس المحلية التي كان ينبغي أن تمثِّل المجتمع وتكون على قدرٍ من الشراكة مع السلطة في إدارة هذا المستوى القاعدي من المجتمع، فقد حدث تراجع في حجم ونطاق الاختصاصات الممنوحة للوحدات المحلية، فحيث ترك القانون رقم 124 لسنة 1960 الباب مفتوحًا لزيادة اختصاصات الوحدات المحلية أدَّت القوانين التالية إلى تقليصها، فبات يغلب على اختصاصاتها الطابع الاستشاري غير الملزم، كما أن هذه المجالس لم تكن تملك حق التقرير والرقابة والإشراف؛ ولذلك أمْسَت التفصيلات التي وردت في اللائحة التنفيذيَّة للقانون رقم 43 لسنة 1979 باختصاصات الوحدات المحلية والتي فيها حق كل وحدة في إنشاء وتجهيز وإدارة المرافق المحلية في دائرتها عديمة القيمة، كما أن المشرِّع المصري غالَى في تعداد المستويات المحلية وأسرف في منح المستويات الأعلى سلطة وصاية على المستويات الأدنى، وقد ترتَّب على ذلك أمران: أولهما- تداخل سلطات الوصاية وعرقلتها للعمل في معظم الأحيان، وثانيهما- ضعف الوحدة المحلية من حيث الموارد والإمكانيات بسبب صغر حجم بعضها. بالإضافة لذلك فإن السلطة خصَّصت إيرادات محدودة للوحدات المحلية[12].
لقد تمَّ إهدار فرصة لمشاركة أكبر للمجتمع في مساحة من إدارة شؤونه ومعاونة السلطة في أداء مهامها وتحسين مستوى الرقابة والإشراف وتقليل نسبة الفساد، لكن السلطة التي سبق بيان رؤيتها بشأن المجتمع ودوره لم تكن لتتنازل عن هيمنتها وسطوتها عليه حتى لو كان ذلك مخفِّفًا من بعض الأعباء عن كاهلها، وقد وضح ذلك أكثر فيما بعد، إذ إن آخر انتخابات للمحليات جرت في عهد مبارك وفي ظل سيطرة الحزب الوطني سنة 2008، وقد أجريت على حوالي 52 ألف مقعد، حسم حوالي 44 ألفًا منها بالتزكية، وقد تمَّ حلُّ هذه المجالس بالقانون 116 لسنة 2011 الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب ثورة يناير، وذلك بتاريخ 4 سبتمبر 2011، وبالرغم من أنه نص في مادته الثانية على أن: “تُشَكَّلَ بقرار يصدر بذلك من مجلس الوزارء مجالس شعبية محلية مؤقَّتة فى المحافظات، بحيث تضمُّ فى تشكيلها عددًا كافيًا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة ومن القيادات المجتمعية الأهلية وممثلًا عن الشباب وآخر عن المرأة، وذلك كله بناءً على عرض من وزير التنمية المحلية والمحافظين”. بالرغم من هذا النص فإن هذه المجالس لم تشكَّل حتى الآن، وتصدر من وقتٍ لآخر تصريحات لمسؤولين عن قرب إجراء انتخابات المحليات، لكنها لم تجدْ سبيلًا للتطبيق حتى وقت كتابة هذه السطور برغم كونها استحقاقًا دستوريًّا يجب إجراؤه.
فسلطة الجهاز الإداري في مصر تفضِّل الحكم منفردة بعيدًا عن أي مشاركة شعبية بالرغم من أنها قادرة على السيطرة على نتائج الانتخابات كما فعلت في 2008 وما قبلها، ولكن آليات الاستبداد تفضل الانفراد ما دام ممكنًا، فهي تفضِّل فرض قراراتها بالإكراه بواسطة جهازها الهرمي، عن تنفيذ هذه القرارات بواسطة التقدير الاجتماعي والاحترام المتبادل والثقة والوضع الاجتماعي بين القيادات المجتمعية المحلية، وتفضِّل الاعتماد على الموظفين الساعين إلى الاستقرار الوظيفي والترقِّي المهني عن الاعتماد على التكوينات الأهلية والعائلات والتنظيمات الاجتماعية المحلية المختلفة، بالرغم من أن تنفيذ القرارات من خلال رفع الواقع بواسطة أهل كل مجتمعٍ محلي والتوصُّل إلى اقتراحات الحلول المبدئيَّة منهم، سيؤدِّي إلى إدراك أفضل ومن ثم تنفيذٍ أسلس للقرارات المتَّخذة لكونها نابعة بشكلْ أو بآخر من خلال ذوي الشأن أنفسهم وبمعاونة حكومية فتكسب التعاطف أو الاقتناع اللازم للحصول على المردود الأفضل للقرارات اللازمة لحلِّ مشاكل المجتمع المحلي[13].
- وبالنسبة لنقابات العمال، فقد كان تكوين النقابات العمالية في بدايات القرن العشرين شبه مقصور على العمال الأجانب بما لهم من تمتُّع بالامتيازات الأجنبية، كما أن تشكيل الجماعات كان يجري بأقلِّ قيود إدارية طبقًا لأحكام القانون المدني. وقد اطَّرد تدخُّل القانون لحماية حقوق العمال وخاصة بعد الأزمة المالية التي حدثت في بداية الثلاثينيات. ثم صدر قانون نقابات العمال رقم 85 لسنة 1942 وأخرج من نطاق تطبيقه موظفي الحكومة والعمال الزراعيِّين. وأجاز إنشاء نقابة عمالية لعمال جهة واحدة أو لصناعات متشابهة. ولم يجز للنقابة أن تعمل إلا بعد تسجيلها في وزارة الشؤون الاجتماعية، ولهذه الوزارة أن ترفض طلب التسجيل فيلجأ الطالبون إلى المحكمة، ولمصلحة العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية أن تحل النقابة.
وبعد ثورة 23 يوليو توسَّعت الحركة النقابية العمالية طولًا وعرضًا [القانون 319 لسنة 1952 ثم القانون 91 لسنة 1959] ولكن أهم ما آل إليه الأمر هو أنه باسم توحيد الحركة النقابية واكتسابها القوة بالتوحيد، خُوِّلَ العاملون في كلِّ مهنة أو صناعة معيَّنة أن ينشئوا نقابة عمالية واحدة، وللنقابة الواحدة هذه أن تنشئ نقابات فرعية في المحافظات وأن تشكِّل لجانًا نقابية في المنشآت. ومن هذا صار البناء فوقيًّا بأن تنشأ النقابة العامة أولا ثم هي من يشكِّل منْ دونها في الفروع. والأخطر من ذلك أن نيط بوزير الشؤون الاجتماعية -ومن بعده وزير العمل عندما استقلَّت وزارة العمل عن وزارة الشؤون الاجتماعية- أن يحدِّدَ هو المهن والصناعات التي يجوز تكوُّن النقابة العامة لعمالها، بمعنى أنه صار هو من يعيِّن القاعدة العمالية الأساسية التي يقوم عليها البنيان النقابي. وتضمَّن القانون الساري بعد ذلك على النقابات العمالية ذات الأحكام [القانون 37 لسنة 1976] وذلك فضلا عن سلطة الجهة الإدارية المختصَّة [وزارة العمل] في الاعتراض على تكوين المنظمة النقابية وطلب حلِّها[14].
- وبالنسبة للنقابات المهنية، فبالرغم من أهميَّتها وأنها على مدى القرن العشرين كانت أكثر تكوينات النشاط الأهلي نجاحًا وأكثرها قدرة على اتخاذ القرارات شبه المستقلة وأكثرها قدرة على الضغط على الدولة فيما يتعلَّق بما يخصُّ كلَّ نقابة، فنلحظ أنه صار لكل نقابة «جهة إدارية مختصة» هي وزارة من الوزارات أو وزير من الوزراء في مُكْنَتِهِ الطعن والاعتراض على أيٍّ من وجوه نشاط النقابة، كل فيما يخصُّه، وزير العدل بالنسبة للمحاماة، ووزير الأشغال بالنسبة للمهندسين، وزير الصحة بالنسبة للأطباء… وهكذا.
ثم رأينا بعد ذلك أنه في ظرف رأت فيه الدولة أن استقلالية النشاط النقابي المهني قد جاوزت ما رأته الدولة من دور لها لجأت إلى إثارة الصراع بين أعضاء النقابات وابتدعت أسلوب فرض الحراسات على النقابات لتدمِّر قدرتها على العمل الأهلي المستقل، وانصاعت المحاكم وراء هذه السياسة وأنفذتها، فصدر القانون رقم 100 لسنة 1993 الذي أدَّى إلى تجميد أوضاع غالبية النقابات المهنية وعدم إجراء انتخابات لهيئاتها القياديَّة وتعديل قانون النقابات العماليَّة بما يُعطي لقياداتها العُليا الموالية للحكومة حق الاستمرار في نشاطها بعد إحالتها للمعاش إذا قدَّمت عقودًا جديدة للعمل في القطاع الخاص[15].
- وبالنسبة للجمعيات، فقد عُرف العديد من الجمعيات مع أواخر القرن التاسع عشر، وكان وضعها القانوني أنها تنشأ بوصفها جماعات مدنية تتَّفق مع المبادئ العامة الواردة في القانون المدني 1883، وتجري الرقابة عليها من خلال النزاعات التي تعرض على المحاكم لتقوِّم معوجًا أو تنهي حالة شاذة أو تبطل عملًا خاطئًا. وكان من أهم هذه الجمعيات: الجمعية الخيرية الإسلامية، والجمعية الزراعية، ونشأت كلها في نهايات القرن الماضي، ثم جمعية الإسعاف ونشأت في 1902، ومجمل الأحكام التي كانت تضبطها هي ما ورد بالقانون المدني من أن الجمعية تتكوَّن من عدَّة أشخاص لتحقيق هدف غير الربح المادي، وكان شهر الجمعية مقصودًا به حماية من يتعاملون مع الجمعية من غير أعضائها.
وبعد ثورة 1919 تزايد عددها وبدأت القيود تتزايد على إنشائها فعُرفت جمعيات تصدر بها مراسيم من الدولة وجمعيات لا يلزم لإنشائها صدور هذه المراسيم، وبدأ نوع من التفرقة ترتَّب على ذلك مما يتعلَّق بحصول الجمعية على رعاية الدولة ومدى تمتُّعها بإصدار التراخيص لجمع التبرُّعات، ثم في 1938 [القانون رقم 17] حُظر إنشاء جمعيات دائمة أو مؤقتة من التي يرتدي أعضاؤها زيًّا خاصًّا بها مثل القمصان الزرق والقمصان الخضر التي كانت تستخدمها الأحزاب [حزب الوفد وحزب مصر الفتاة]، وكذلك حُظرت الجمعيات التي تدعو لمذهب سياسي ما. وفي عام 1945 صدر قانون ينظم الجمعيات اشترط لنشوء الجمعية أن تُسجَّل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وأن للوزارة أن تمتنع عن تسجيلها إذا وجدتها مخالفة للقانون، وللوزارة حق الإشراف المالي عليها والتفتيش، وللوزير إلغاء انتخابات الجمعيات العمومية للجمعيات وله حق طلب حل الجمعية. ولا يجوز لها جمع التبرعات إلا بترخيص. ثم انتقلت الرقابة والوصاية إلى وزارة الداخلية فترة ما بعد 1951. وصدر القانون رقم 384 لسنة 1956 يلغي أية جمعيات ذات أهداف مخالفة للقانون وأن للدولة مراجعة سجلاتها والعلم المسبق باجتماعاتها والاعتراض على قراراتها. ثم صدر القانون رقم 32 لسنة 1964 فبلغ الأوج في السيطرة المستبدَّة لأجهزة الدولة على الجمعيات، وقد أعلن إلغاء الجمعيات الموجودة كافة وأن عليها أن تقدِّم طلبات جديدة بإنشاء جديد في ميعاد ستة أشهر من صدور القانون، وجعل للحكومة حق رفض تسجيل الجمعية إذا تعارض قيامها مع ما تعتبره الدولة من احتياجات الأمن أو كان متعارضًا مع النظام العام، ومنع النقابات المهنية من إنشاء جمعيات تابعة لها، وجعل للوزارة تعيين ممثِّلين لها بالجمعيات، ولها حل مجلس الإدارة وتعيين مجالس إدارة مؤقتة وهكذا، وقد بقي هذا القانون معمولا به حتى عام 1999 [القانون رقم 153]. وقد كان تعديل نظام الجمعيات ممَّا استدعى خلافات كبيرة وعميقة بين الدولة وطالبي التكوين الحر للجمعيات واستقلالها عن رقابة الدولة، وتدخَّلت في هذا الصراع هيئات أجنبية باسم حرية التكوين، واستمسكت الدولة بقدر من السيطرة باسم حماية الأمن العام من نفوذ قوى التمويل الأجنبية[16]. وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا في 3 يونيو 2000 بعدم دستورية هذا القانون[[17]]، إلا أن الحكومة عاودت إصداره بنفس مواده استيفاءً للشكل فقط[18]، ومرَّت السنون ووقعت أحداث ثورة يناير 2011، ففرضت واقعًا جديدًا أتاح -بالرغم من وجود القوانين المقيِّدة للعمل الأهلي- حرية حركة للعمل الأهلي، ونشأت العددي من المؤسسات والجمعيات والمبادرات الأهلية فضلا عن الأحزاب التي ملأت الساحة، إلا أن ما تلا أحداث 30 يونيو و3 يوليو 2013 من عودة لأشخاص ورموز النظام الذي قامت ضدَّه ثورة يناير أعاد الأمور خطواتٍ إلى الوراء، حيث تمَّ إغلاق العديد من المنظمات الأهلية بممارسات مباشرة من جانب السلطة، وأغلقت العيد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية أبوابها وأوقفت أنشطتها بسبب الأوضاع المستجدَّة، وتم منع العديد من قيادات هذه المنظمات -خاصة الحقوقيَّة- من السفر، بالإضافة إلى صدور قرارات حكومية بالتحفُّظ على أموالهم ومنعهم من التصرُّف فيها.
وفي 2017 صدر القانون رقم 70 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، وثارت بسببه عاصفة من الانتقادات الخارجية، ممَّا دعا الحكومة إلى إعادة النظر في القانون، وقد وافق مجلس النواب المصري في 14 يوليو 2019 على قانون جديد حافظ على هيمنة الدولة واقتصرت التعديلات به على إلغاء العقوبات السالبة للحرية تقريبًا، وفي المقابل تمَّ فرض غرامات كبيرة تصل إلى نصف مليون جنيه على ما اعتبره القانون مخالفات، مثل إجراء الجمعية استطلاعات للرأي أو بحوث ميدانية دون الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتصل الغرامات إلى مليون جنيه إذا تلقَّت الجمعية تمويلا من الخارج دون تصريح من الوزارة المختصَّة، ومنح القانونُ الوزيرَ المختصَّ سلطة وقف نشاط الجمعية لمدة سنة لبعض المخالفات الإدارية مثل الانتقال لمقرٍّ جديد دون إبلاغ الجهة الإدارية خلال ثلاثة شهور، وفرض القانون على الجمعيات العمل في مجالات تنمية المجتمع المحدَّدَة في نظامها الأساسي دون غيرها مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع، وهو ما يتيح للسلطة هيمنة شبه تامَّة على نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويمنحها حق الاعتراض على كل ما تراه -أو ما يراه أحد موظَّفيها- متعارضًا مع خطط الدولة، ويقضي على استقلالية المؤسسات الأهلية في العمل لتحقيق أغراض القائمين عليها ما دامت لا تخالف النظام العام الذي لا يجوز الخروج عليه[19].
- وبالنسبة للجمعيات التعاونية، فإن الدعوة إليها ظهرت مع نشاط الحزب الوطني في العشرات الأولى من القرن العشرين، ونوقش مشروع قانون بشأنها أمام الجمعية التشريعية في سنة 1913 وكان من وقفات سعد زغلول وقتها أن هاجم ما تضمَّنه المشروع من سيطرة الحكومة على هذا التكوين الأهلي. ثم لم يصدر قانون بالتنظيم إلا في 1927، ثم عُدِّلَ بقانون جديد في 1944، ثم صدر قانون آخر رقم 317 لسنة 1956 ثم صدرت تباعًا مجموعات من القوانين ينظِّم كلٌّ منها وجه نشاط تعاوني: قانون للتعاون الزراعي وقانون للتعاون الإنتاجي، وقانون للتعاون الاستهلاكي، وقانون للتعاون الإسكاني وقانون لتعاونيات التعليم. وكلٌّ من هذه القوانين يرسم «جهة إدارية مختصة» هي وزارة أو هيئة حكومية منشأة ومختصَّة بالرقابة على هذا النوع من أنواع التعاون، ويحدد وزيرًا مختصًّا لكلِّ نوعٍ منها، وذلك لتنظيم سلطة الرقابة الوصائية التي تمارسها الدولة على كل من هذه الأنشطة والجمعيات. ولا أريد الإطالة في الشرح والتفصيل لأن الأساليب متشابهة والنتائج واحدة وهي ضمان الهيمنة المتسلِّطة لجهاز الإدارة المركزي للدولة على هذه الوحدات التي تنشأ طواعية وبالمبادرات الذاتية لنشاط الأهالي[20].
- وفي مجال التعليم حرصت السلطة باستمرار على بثِّ معاني الخضوع لها في مقرَّراتها التعليمية كأحد أدوات السيطرة والهيمنة على المجتمع، ففي دراسة أجراها كمال المنوفي (1988) استهدفت معرفة كيفيَّة إسهام المدرسة والمقرَّرات المدرسيَّة في تشكيل عقليَّة الطفل تجاه الحكومة، وتصوُّره لدور الجماهير، ودور المدرسة في خلق الوعي والانتماء الوطني والقومي… إلخ. وقد أوضح التحليل أن هذه المقررات تعتبر الخضوع للحكومة ضمانًا لاستمرار الدولة واستقرارها، في حين تُعد معارضة الحكومة والخروج عليها وبالًا على الدولة. والحكومة كما تصوِّرها هذه المقرَّرات هي صانعة كل شيء، وهي التي تقدِّم الخدمات في كل الميادين وبصورة مثالية، أما الحكَّام فهم مناضلون من أجل الشعب، وبهم ينهض المجتمع ويتخطَّى الصعاب. وفي هذه المقررات تبدو رموز السلطة في صورة مثاليَّة. فرجال شرطة المرور والمعلِّمون والأطباء والموظَّفون كلُّهم يتَّسمون بالصفات الحميدة ويؤدُّون عملهم على خير وجه، وفي الحديث عن الحكم المحلي يصوَّر هذا النظام على أنه منحة من الحكومة وليس حقًّا للمواطنين، ولا يرد أي ذكر لمسألة الرقابة الشعبية. وهذه الصورة المثالية تختلف عن الواقع المعاش[21].
ويتبين من تحليل الدكتور المنوفي لذلك النموذج في حينه أيضًا أن الإشارات إلى دور الشعب كميًّا وكيفيًّا، تأتي ضئيلة. فعلى المستوى الكمي تتكرَّر الإشارة في المقرَّرات المصرية (محل الدراسة) إلى الحكومة/الدولة 36 مرة، وإلى الشخصيات القيادية 144 مرة، مقابل 7 مرات فقط إلى الشعب.
وعلى المستوى الكيفي يبدو الشعب في هذه المقرَّرات تابعًا منقادًا، أو على أحسن تقدير متعاونًا مع الحاكم في الاتجاه الذي يقرِّر المضيَّ فيه، أما الزعماء والحكَّام فهم المبادرون والفاعلون والشجعان والمنتصرون في المعارك التاريخيَّة[22].
وحديثًا في النشرة التوجيهية للتربية الاجتماعية (تعد بمثابة دليل عمل للاختصاصيِّين الاجتماعيين بالمدارس) للعام الدراسي (2013/2014)، تمَّ التنبيه على «تفعيل برامج الانتماء والولاء للوطن لكي لا ينساق شبابنا وراء الشائعات أو الاعتصامات أو المسيرات التي تؤدِّي في النهاية إلى تعطيل الإنتاج وتأخُّر برامج التنمية، وتجديد الثقة دائمًا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء الانتقالي، للتأكيد على وحدة واستقرار البلاد». هذه النشرة وُزِّعت على المدارس بمراحلها المختلفة، وهي صادرة عن وزارة التربية والتعليم التي تُعتبر بحسب النشرة نفسها «المؤسسة التربوية المعنيَّة بإعداد وتعليم النشء والشباب ليكونوا مواطنين صالحين»[23].
- واستخدمت السلطة آليات التشريع لضمان إحكام السيطرة على التعدُّدية الحزبية التي بادرتْ بها الدولة في 1976 بعد أن ألغت الأحزاب عقب يوليو 1952، ولأسباب غير ديمقراطية، فكان صدور قانون الأحزاب نفسه أوضح مثل لذلك، بما تضمَّنه من أحكام تضمن سيطرة السلطة إنشاء الأحزاب الجديدة ونشاط الأحزاب القائمة، وخلال عمر التعدُّدية صدرت قوانين جديدة وعُدِّلَتْ قوانين قائمة لسدِّ الثغرات التي كشف عنها التطبيق، ومثال ذلك تعديل قانون الأحزاب السياسية لتجريم أيِّ نشاط للأحزاب تحت التأسيس عندما نجح الحزب الاشتراكي الناصري تحت التأسيس أن يمارس نشاطًا سياسيًّا واسعًا وفعَّالًا قبل التصريح له بقيام الحزب، وكذلك صدور القانون رقم 2 لسنة 1977 بعد انتفاضة 18 و19 يناير 1977 لوضع قيودٍ جديدة على النشاط السياسي الجماهيري، وصدور قوانين الاشتباه وحماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي في مواجهة تصاعد النشاط السياسي الجماهيري للأحزاب السياسية عام 1978، وتعديل قوانين المطبوعات والنَّشر أكثر من مرة للحدِّ من فاعليَّة الصحف الحزبيَّة، وعندما صدر قانون الشركات المساهمة تضمَّن نصًّا يشترط موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركات المساهمة التي تعمل في مجال الصحافة والنشر لضمان التحكُّم في صدور الصحف الجديدة[24].
- ولضمان الحيلولة دون التواصل بين الأحزاب السياسية والقواعد الجماهيرية الواسعة، صدرت العديد من القوانين في مقدِّمتها قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي يضع أجهزة الإعلام الجماهيري كالإذاعة والتليفزيون تحت سيطرة حكوميَّة كاملة، بما يؤدِّي إلى حرمان الأحزاب السياسيَّة المعارضة من الاستفادة من هذه الأجهزة لطرح برامجها ومواقفها على المواطنين في حين كان يتمتَّع الحزب الحاكم [آنذاك] بفرصٍ واسعة في هذا المجال.
ثم تنظيم ملكية ونشاط الصحف المملوكة للدولة تحت مسمَّى الصحف القوميَّة بوضعها تحت سيطرة مجلس الشورى الذي كان يعمل بتوجيهات حكوميَّة ويتم من خلاله تعيين رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير هذه الصحف بحيث أصبحت أداةً للحكومة وتوجُّهاتها لا تستطيع الأحزاب وقوى المجتمع المختلفة من استخدانها لطرح توجُّهاتها أو شرح مواقفها للرأي العام[25].
خاتمة
أوضح استعراض مظاهر هيمنة السلطة على المجتمع المصري وتغوُّلها التدريجي منذ قرنين على مساحات ومجالات العمل الأهلي، مدى نجاح هذه السلطة من خلال جهازها الإداري في بسط سيطرتها ونفوذها على حركة المجتمع وقواه المختلفة ورفضها لمشاركة المجتمع وتحجيم دوره قدر الإمكان، وتجريده من كل وسائل القوة الذاتيَّة بحيث يظل مفتقرًا إلى جهاز الدولة، وغير قادرٍ على التصرُّف دون الرجوع إليه والحصول على رخصة منه للقيام بأيِّ فعلٍ ولو كان بسيطًا، وهو ما قامت به السلطة عبر جهازها الإداري من خلال مختلف منافذ الهيمنة على نشاط المجتمع الأهلي والسيطرة على كلِّ مساحات ومجالات عمله في النقابات والجمعيَّات والأحزاب والتعليم والإعلام… إلخ، وأن هذا الجهاز هو الذي بات بيده المنح والمنع، وهو من يحدِّد الأولويَّات دون مراعاة لرأي ذلك المجتمع القابع تحت وصايته.
وبالرغم من أن هذا الجهاز الذي يفترض أن تناط به مهمة التنفيذ لما تقرُّه كل من السلطتين التشريعية والقضائية من قوانين وأحكام دون تدخُّلٍ منه عملا بمبدأ الفصل بين السلطات أو على الأقل التوازن بينها، ولكنه عصف بهذا المبدأ وبسط هيمنته على هاتين السلطتين أيضًا، بحيث لم يعد بمقدور أيِّ هيئة في المجتمع أن تنفكَّ في حركتها عن سلطة هذا الجهاز ومراعاة سطوته على أقل تقدير.
وكشف هذا الاستعراض في المقابل عن مدى الضعف الذي وصلت إليه قوى المجتمع وعدم الحفاظ على مقومات الصمود في وجه هذا التغلغُل الإداري، الذي غلَّ يد المجتمع عن النظر في شؤونه والاستقلال بإدارتها ما دامت لا تتَّصل بالشؤون السياديَّة، وما دامت تُراعي ما يلزم من حفاظٍ على الوحدة واحترام النظام العام والثقافة السائدة، وهو ما كان يحقِّق منفعة مزدوجة تتمثَّل في تحقيق النفع العاجل للوحدات الأهلية لمعرفتها باحتياجاتها الخاصة ووسائل تحقيقها، والتخفيف من الأعباء عن كاهل الدولة وعدم استغراقها في تفاصيل يمكن أن يتم التعامل معها بواسطة الوحدات المجتمعية الأصغر.
لكن السلطة التي طغى الاستبداد على وسائلها في التعامل مع المجتمع أَبَتْ في البداية إلا أن تتغلغل رويدًا رويدًا على مساحات كان يختص بها ويستقل بالتعامل مع شؤونها بما يتناسب مع كل بيئة اجتماعية وثقافية واقتصادية بما يلزمها، ثم زادت السلطة من احتكارها لشؤون المجتمع في مقابل قيامها بالعديد من شؤونه، ثم هي الآن تتملَّص من التزاماتها تجاه المجتمع وتطالبه بمقابل مادِّيٍّ مباشر لما تقدِّمه له من خدمات احتكرت لنفسها في البداية حقَّ تقديمها دون شريك مقابل تحكُّمها في توزيعها وتقديمها بمقابل مناسب لعموم المجتمع، وتسعى الآن لاستمرار استبدادها دون تقديم مقابل، وهي معادلة جديدة للحكم يصعب أن تستمرَّ دون تكاليف ضخمة، تصر السلطة على دفعها في وسائل قمع المجتمع المختلفة، وتأبى أن تقدِّمها له بما يخفِّف من أعباء تثقل العديد من فئاته بالأعباء المالية والنفسيَّة والجسديَّة بما يفوق طاقتها على الاحتمال.
وإذا كان المجتمع ظلَّ يقوم ببعض المهام فإن ذلك كان بدافع القصور الذاتي الذي ظلَّ يأكل من قوة المجتمع وعافيته شيئًا فشيئًا لصالح سلطة الدولة، ولم يعد يتبقَّى للمجتمع الكثير إذا ظلَّ هذا الجور على حقوقه في التحرُّر من تسلط أجهزة الدولة وهيمنتها عليه في شؤونه التي ينبغي أن يقوم بإدارتها بنفسه في مساحات لا يضرُّ السلطة التي تعمل لتحقيق الصالح العام أن تتركها له، بحيث يُبدع المجتمع أشكالا مختلفة لمعالجة مشاكله وتقديم الحلول اللازمة لها في مساحات كالتعليم والوقف وإنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الأغراض المختلفة المحققة لخير المجتمع وتنميته وتحديد أولويَّات الوحدات المحلية الصغيرة والاستحواذ على قدرٍ أكبر من حرية الحركة في إدارتها ومعالجة مشكلاتها… إلخ، دون استبداد فوقيٍّ يعوق بنظرته الضيقة مساعدة المجتمع في حلِّ مشكلاته والتخفيف من أعبائه، من حيث يدَّعي العمل على حلِّ المشكلات وتذليل الصعوبات!
وإذا كانت الحقبة الناصرية هي أكثر الفترات وضوحًا في الجور على مساحات حركة المجتمع وقمعها، فإن ذلك لا ينفي في الوقت ذاته أن ما تلا هذه الحقبة من سياسات في عهدي السادات ومبارك لم تكن أقل وطأة على المجتمع، وإن كانت أهدأ تنفيذًا وأقل ضجيجًا، فلم يقصِّر كلا النظامين في تجريف الحياة السياسية والاجتماعية، وأداتهم الأساسية في ذلك المزيد من التحكُّم في المجتمع والسيطرة عليه بأدوات التشريع والقضاء والجهاز الإداري وسياساته، فضلا عن أن عهد عبد الناصر كان أسبق فكان لا يزال في المجتمع بقيَّة من قدرة على العطاء في مساحات الوقف والتعليم واحتفاظ العائلات الكبيرة والعلماء والمثقفين والشخصيات العامة بقدرٍ من النفوذ والتأثير في مساحات معيَّنة، إلا أن ذلك تقلَّص بمرور الوقت وبفعل سياسات النظم المتعاقبة، ممَّا أدَّى إلى انهيارٍ كبير في الكثير من الكفاءات التي كانت تفخر بها مصر في القطاعات المختلفة (التعليمية والصناعية والزراعية والصحية… إلخ)، وانهارت تبعًا لذلك العديد من المؤسسات العلمية والصناعية والتربويَّة… إلخ. وبات المجتمع خلوًا من عناصر ومقومات نهوضه وتقدُّمه، وإن وجد شيئًا منها فإنها تبقى مع إيقاف التنفيذ أو يصير خيرها لغير المجتمع الذي هو أحق بها من سواه.
كما زادت بمرور الوقت فجوة بين المجتمع والنخب الحاكمة لجهاز الدولة تتعلَّق بالأبعاد الثقافيَّة والفكريَّة، بسبب نزوع السلطة إلى الاستبداد، فألجأها ذلك إلى تبنِّي كل ما يمكِّنها من الانفراد بالمرجعيَّة في تقرير كل ما يتَّصل بشؤون المجتمع، ويُرجع المستشار البشري هذا الوضع إلى ما يسمِّيه «المسألة الثقافية» ويوضِّحها بقوله: إن ثمة هوة تفصل بين ثقافتين في المجتمع، أولاهما- الثقافة العامة الموروثة والسائدة بين جماهير الشعب المصري في ريفه وحضره الشعبي وفي المستويات الاجتماعية غير الميسورة، وثانيتهما- الثقافة الوافدة التي تنتشر بين النخب الاجتماعية المتميزة اقتصاديًّا وتعليميًّا، ولأن هذه النخب تنتشر في مجالات السيطرة والنفوذ في شؤون الاقتصاد والسياسة والمؤسسات الاجتماعية، ونسبتها بين المهنيِّين أكبر بطبيعة الحال من نُدرتها النسبية بين الطبقات الشعبية، فإن هذا الوجود الأغزر يوجد في أجهزة إدارة الدولة، ونضح هذا الوجود على سلوك الدولة وأجهزتها، وانعكس انعزالًا عن جماهير الشعب. كما أن ما يشيع لدى هذه النخب من أن الفكر الوافد هو ما يعبر عن التطور والمدنية الحديثة ويعكس مفاهيم المعاصرة؛ قد ولَّد لدى هذه النخب الإحساس بأن الجمهرة الشعبية تتَّصف بالتخلُّف والجمود، وهذا الإحساس برَّر لها أخلاقيا وفلسفيًّا النزوع للاستبداد والشعور بالقوامة والوصاية على من ليسوا بعد جديرين أن يدركوا مصالحهم ويقبضوا على ناصية أمورهم بأيديهم[26].
وبالرغم من وجود ضغوط دولية تتعلَّق بالديمقراطية وحقوق الاجتماع والتعبير عن الرأي… إلخ، ممَّا قد يفيد المجتمع وتكويناته الأهلية، فإن عبد الغفار شكر يرى أنها تبدو مسخَّرةً لخدمة أهداف ومصالح معينة للقوى الدولية الكبرى، بحيث إنه يتم التغافل عنها من جانبها عندما تشعر أنها قد تهدِّد مصالحها، وتدعمها جزئيًّا وبطريقة انتقائيَّة إذا كانت ستحقِّق مصالحها، وإذا كان ذلك قد تحقَّق شيء منه في نهاية القرن العشرين ومطلع الحادي والعشرين، فقد تراجع هذا المنحى تراجعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، وبات دعم النظم الاستبدادية والتغافل عن أفعالها في العديد من بقاع العالم أمرًا ماثلًا للعيان. لقد قامت مئات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الجديدة التي تنشط حول أهداف مفتَّتة وقضايا جزئيَّة دون ارتباط بالأسباب المشتركة لهذه المشاكل الجزئيَّة التي تعود بالأساس إلى العولمة الرأسمالية وسياساتها؛ ممَّا يهدد مؤسَّسات المجتمع المدني بالتحوُّل عن دورها الأساسي كجزءٍ من المجتمع الديمقراطي إلى ملطِّفٍ ومخفِّف لحدَّة المشاكل الناجمة عن سياسات العولمة وتأثيراتها على دول الجنوب وتكرِّس في نفس الوقت الحكم الاستبدادي[27].
لا يعني هذا الطرح دعم فكرة “الدولة الضعيفة” الموجودة في كثير من البقاع أمام مجتمعات أقوى منها تأثيرًا وأكثر حضورًا، ولكن على العكس فإن افتراضَ سلطةٍ ما بأن قوَّتها في مواجهة مجتمعها هي سبيلها إلى البقاء فتحرص على قمع المجتمع وتفتيت قواه، لممَّا يجدر التنبيه على فساده، إذ السلطة القوية ينبغي أن تكون سبيل مجتمعها القوي أيضًا للتقدُّم والازدهار.
إن مصر التي عرفت منذ القدم دولة مركزية بسبب اعتمادها الكلِّيِّ على النيل، كان ازدهارها وتقدُّم أحوال الإنسان بها يكونان دائمًا في عصور الدولة القويَّة، لكن ما معنى قوة الدولة التي تتقدَّم بها أحوال المجتمع؟ إنها -كما يوضِّح جلال أمين- تتمثَّل في تلك الدولة التي تحصِّل الضرائب وينضبط بها نظام التعليم وتنفق على المشروعات والخدمات العامة، وتقدِّم الدعم للفقراء. أما الدولة الضعيفة فهي تلك التي لا تحصِّل الضرائب ولا تُحترم فيها القواعد، وتخرق فيها القوانين[[28]].
إذا كان ذلك كذلك فإن حرص السلطة على استجماع كل ما تستطيع من قوة مادية ومعنوية في مواجهة المجتمع وقواه المختلفة مع بسط مظاهر الهيمنة والنفوذ على مساحات حركته ومجالات عمله، لم يؤدِّ إلى وجود دولة قويَّة[[29]]، بل على العكس ضعفت الدولة إجمالا في مواجهة فواعل داخلية وخارجية مفروضة عليها، وباتت أقل قدرةً على التأثير في محيطها وأكثر عرضةً للتأثُّر والاستجابة بتلك الفواعل التي لا يعنيها سوى تحقيق مصالحها الآنيَّة والتي ليس من بينها بطبيعة الحال إعادة إحياء قوى المجتمع وتكويناته الأهليَّة، بل على العكس ترغب في إضعاف كل مظاهر المقاومة لنفوذها التي يمكن أن تصدر عن مجتمع عفيٍّ يدرك مصالحه فيسعى لتحصيلها، والأخطار التي يتعرَّض لها فيتجنَّبها أو يقاومها ويواجهها.
*****
هوامش
[1] طارق البشري، جهاز الدولة وإدارة الحكم في مصر المعاصرة، (القاهرة: دار نهضة مصر، 2013، نسخة إلكترونية متاحة على تطبيق Google Books)، ص 25.
[2] عبد الغفار شكر، الصراع حول الديمقراطية في مصر، (القاهرة: مركز البحوث العربية والأفريقية، مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفيَّة، 2009)، ص 10.
[3] طارق البشري، جهاز الدولة وإدارة الحكم في مصر المعاصرة، مرجع سابق، ص 41.
[4] المرجع السابق، ص ص 13-15
[5] المرجع السابق، ص ص 7-8.
[6] المرجع السابق، ص ص 6-7.
[7] انظر في ذلك: المرجع السابق، ص ص 37-44.
[8] انظر نص وثيقة «سياستنامه» (التي تعد أول وثيقة دستورية في مصر، وقد صدرت سنة 1837) منشور على موقع جامعة مينيسوتا عبر الرابط التالي: https://cutt.us/W0ad4
[9] طارق البشري، جهاز الدولة وإدارة الحكم في مصر المعاصرة، مرجع سابق، ص ص 48-50.
[10] المرجع السابق، ص ص 50-51.
[11] محمود حسين، “دينية البرلمان” تحسم تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوقاف بمشروع قانونها الجديد، موقع اليوم السابع، 15 أبريل 2019، متاح عبر الرابط التالي: http://bit.ly/2ktl1Yf
[12] عطية حسين أفندي، النظام القانوني للإدارة المحلية في مصر، (في): السيد عبد المطلب غانم (تحرير)، السياسة والنظام المحلي في مصر، (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، 1995) أعمال المؤتمر السنوي الثامن للبحوث السياسية (القاهرة: 3-5 ديسمبر 1994)، ص ص 66-69.
[13] انظر: السيد عبد المطلب غانم، مقدمة المحرر، جدول (1) عن “خصائص إدارة الدولة وحكم المجتمع، (في): السيد عبد المطلب غانم (تحرير)، السياسة والنظام المحلي في مصر، (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، 1995) أعمال المؤتمر السنوي الثامن للبحوث السياسية (القاهرة: 3-5 ديسمبر 1994)، ص 17.
[14] طارق البشري، جهاز الدولة وإدارة الحكم في مصر المعاصرة، مرجع سابق، ص 54.
[15] انظر:
– المرجع السابق، ص 54
– عبد الغفار شكر، الصراع حول الديمقراطية في مصر، ص ص 101-102.
[16] طارق البشري، جهاز الدولة وإدارة الحكم في مصر المعاصرة، مرجع سابق، ص ص 51-56.
[17] حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 153 لسنة 1999 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، موقع محكمة النقض، متاح عبر الرابط التالي:
[18] عبد الغفار شكر، الصراع حول الديمقراطية في مصر، ص 103.
– قانون الجمعيات الأهلية الجديد.. نظرة موضوعية، صفحة “الموقف المصري” على موقع فيس بوك، 15 أغسطس 2019، متاح عبر الرابط التالي: http://bit.ly/2klt6OJ
– نورا فخري، ننشر النص الكامل لقانون الجمعيات الأهلية بعد تعديله في ضوء توجيهات الرئيس، موقع اليوم السابع، 7 يوليو 2019، متاح عبر الرابط التالي: http://bit.ly/2lJPa5C
[20] طارق البشري، جهاز الدولة وإدارة الحكم في مصر المعاصرة، مرجع سابق، ص ص 54-56.
[21] فتحي أبو العينين، الثقافة السياسية للمصريين في الدراسات المصرية.. مراجعة عامة وملاحظات أولية، (في): كمال المنوفي وحسنين توفيق (تحرير)، الثقافة السياسية في مصر بين الاستمرارية والتغيير، (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، 1994)، أعمال المؤتمر السنوي للبحوث السياسية (القاهرة: 4-7 ديسمبر1993)، المجلد الأول، ص ص 108-109.
[22] المرجع السابق، ص 110.
[23] منى علام، التعليم والسياسة: المدرسة أداةً للتدجين، موقع السفير العربي اللبناني، 29 أكتوبر 2014، متاح عبر الرابط التالي:
[24] عبد الغفار شكر، الصراع حول الديمقراطية في مصر، ص ص 101-102.
[25] المرجع السابق، ص 102.
[26] طارق البشري، جهاز الدولة وإدارة الحكم في مصر المعاصرة، مرجع سابق، ص ص 8-9.
[27] عبد الغفار شكر، الصراع حول الديمقراطية في مصر، ص ص 47-50.
[28] انظر: جلال أمين، مصر والمصريون في عهد مبارك [1981-2008]، (القاهرة: دار ميريت، 2009)، ص ص 18-19.
[29] في تعامل المجتمع مع هيمنة أجهزة الدولة المترهِّلة التي تحاول فرض سيطرتها عليه والتفافه عليها، انظر: سيف الدين عبد الفتاح، الزحف غير المقدس.. تأميم الدولة للدين، (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث، 2016).
- فصلية قضايا ونظرات- العدد الخامس عشر ـ أكتوبر 2019