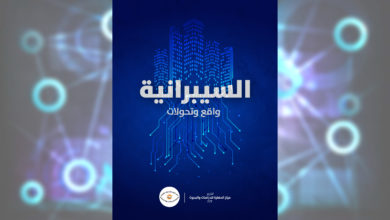التدخلات الخارجية ومسيرة أزمات المنطقة: التجربة التاريخية وآفاق المستقبل

إن مكونات عنوان الدراسة الخمسة: التدخل، الأزمات، المنطقة، التاريخ، المستقبل، وموضعها من موضوع الندوة يفرض الاقتراب منها اقترابًا تاريخيًا نظميًا، وليس تأريخيًا، يستدعي طرح الأسئلة التالية: أي منطقة تلك التي تجمع العرب وإيران؟ كيف نحددها أو نعرفها تاريخيًا؟ وأي تدخل خارجي؟ وأي نمط من الأزمات؟ ومنذ متى؟ وكيف نتابع المسار وكيف نستقرأ دلالاته؟ وابتداءً كيف نربطه بالوضع الراهن ثم نستشرف مستقبله؟ وقبل هذا وذاك لماذا هذا التحديد: العرب وإيران وما دلالته التاريخية؟
إن الإجابة على مثل هذه الأسئلة الكبرى الاستراتيجية تحتاج مقدمة لتحديد الإشكاليات والإطار الفكري والمقولة والمنهاجية في جزء أول، على أن يتضمن الجزء الثاني النماذج والأنماط التاريخية.
لتحميل الدراسة اضغط هنا.
الجزء الأول: الإشكاليات والمقولة والمنهاجية
أولاً: إشكاليات الدراسة وإطارها الفكري
إن مكونات عنوان الدراسة – وموضعها من عنوان المؤتمر أيضًا – يفرض ست قضايا منهاجية: فمن ناحية، العلاقة بين العام وهو التاريخ الإسلامي وبين الخاص أي تاريخ العلاقة بين العرب وإيران. ومن ناحية أخرى العلاقة بين التدخلات الخارجية وبين تفاعلات ركنين من أركان الأمة وركنين من أركان العلاقات الإسلامية – الإسلامية وهما العرب والفرس.
ومن ناحية ثالثة: مسيرة أزمات المنطقة مقارنة بمسيرة وحدتها وتضامنها البيني أو في مواجهة الآخر، ومن ناحية رابعة: العلاقة بين صراعات القوى التقليدية (السياسية – العسكرية – الاقتصادية) وبين الصراعات الحضارية التي تستدعى منظومات القيم والمتغيرات غير المادية أيضاً إلى التحليل، ومن ثم ومن ناحية خامسة، العلاقة بين الرابطة العقدية التي تجمع شعوب الأمة وبين صراعات أو تنافسات المصالح الوطنية والقومية التي هي من طبائع البشر. وأخيرًا استدعاء التاريخ من أجل المستقبل ولكن مرورًا بتشخيص الحال الراهن وبمقتضيات تغييره وبوجهة هذا التغيير.
هذا واقترابي لدراسة العلاقات الدولية من منظور إسلامي، يحدد موقفي من هذه القضايا الست ومن منطلقات الدراسة وإطارها الفكري على النحو التالي[1].
أولاً: إن الاقتراب من تاريخ العلاقة بين العرب والفرس أو المنطقة العربية وإيران أو العرب والايرانيون (أياً كان الوصف الآن) لا يمكن فصله عن التاريخ الإسلامي برمته سواء ما يتصل بتاريخ العلاقات بين المسلمين أو تاريخ علاقاتهم بالغير، وهذا الاقتراب يعالج ما قد يبدو من اقتراب قومي أو مذهبي تجزيئي ينال من فكرة وحدة تاريخ الأمة أي وحدة تاريخ شعوبها ثم دولها، مهما انتقلت جميعها من الوحدة إلى التعددية ثم إلى التجزأة السياسية في ظل دول قومية حديثة، ذلك لأن الأمة مفهوم عقدي اجتماعي يقوم أساساً على الرابطة العقدية بين شعوبها وليس التكوينات السياسية الواحدة فقط، ومهما تعددت ثقافات شعوب الأمة ولغاتها ومذاهبها[2].
ثانياً: تفاعلات ركني الأمة هذين، لم تكن مثالية على الدوام فبقدر ما شاهدت من إيجابيات في مراحل بقدر ما شاهدت في مراحل أخرى من سلبيات مختلفة الأنماط، تبدأ من الصدام العسكري المباشر إلى التحالفات مع الآخر في مواجهة بعضهما البعض.
وهذا التداول هو سنة من السنن الإلهية في الاجتماع البشري بصفة عامة واجتماع المسلمين أيضًا. ومن ثم فإن “أزمات المنطقة” ليست إلا وجهًا واحدًا للعملة ولكن هناك وجه آخر وهو الوحدة والتضامن. ويتبادل الوجهان مواقعهما صعودًا وهبوطًا عبر المسار التاريخي للأمة العربية والأمة الفارسية. بل إن مراحل الوحدة والتضامن لم تخل من الأزمات وإن اختلفت بالطبع تكرارية وطبيعة الأزمات مقارنة بمراحل التجزئة. ولكل من هاتين الحالتين للأزمة أو الأزمة قواعد تفسيرها من منظور إسلامي، وفق رؤية سننية.
ثالثاً: الخارج لعب دائماً دوره تجاه الأمة وتجاه العلاقات الإسلامية – الإسلامية بصفة عامة والعلاقات بين العرب والفرس بصفة خاصة.
ومن ثم فإن تدخلات الخارج مكون أساسي من مكونات فهم ودراسة تاريخ الأمة عبر مساره بل لا يستقم فهم العلاقات الإسلامية الإسلامية –تاريخاً وراهناً– بدون استدعاء هذا المتغير الخارجي والبحث في تأثيراته مقارنة بتأثيرات العوامل الداخلية والبينية (مثل القومية، والمذهب، وتنافس المصالح) وعلى نحو يوجد العلاقة بين التاريخ الإسلامي وما يسمى “التاريخ” العالمي الذي هو في الواقع تاريخ المركزية الأوربية الغربية
ورابعًا: أن التركيز على الأبعاد السياسية، الاقتصادية ، العسكرية في العلاقات – سواء صراعية أو تعاونية – يسقط جانب هام منها وهو الثقافي – القيمي. حيث إن هذا الأخير لا ينفصل عن الأبعاد التقليدية بل يقع في صميمها. ولم تخل علاقات المسلمين التاريخية مع الآخر- ولو في قمة حالاتها الصراعية والقتالية من أشكال التفاعل الحضاري التي أثرت في وتأثرت بعلاقات القوى السياسية وتوازناتها، بل إن الصعود الراهن للأبعاد الدينية والثقافية والحضارية على ساحة العلاقات الدولية (واقعًا وتنظيرًا) ليبين العودة إلى المسار الطبيعي للأمور بعد أن تم استبعاد هذه الأبعاد -القيمية – نظرًا لاختزال دراسة الظواهر الاجتماعية في المادي فقط [3]. ولكن الخطير هو أن هذا الاستدعاء الراهن – الذي جاءت المبادرة به من الغرب ذاته الذي سبق وأعلى من المنظور المادي والوضعي – يقترن بنظره صراعية للعلاقة بين الغرب والعالم الإسلامي، وبتوظيف سياسي للقيم والدين والثقافة.
ومن ثم فإن دراسة المسار التاريخي للعلاقات بين العرب وإيران – في ذاتها – أو من حيث تأثيرات الخارجي عليها، تنطلق من رؤية حضارية تجمع بين السياسي التقليدي وبين ما هو قيمي – ثقافي . فإن تدخل الخارج في الدائرة الحضارية الإسلامية – (سواء غير المباشر أو المباشر أو خلال الهجمة الأولى –الحروب الصليبية– أو منذ الهجمة الثانية مع بداية القرن 16م) كان دائماً عملة ذات وجهين لم ينفصلا: الوجه التقليدي في قلبه صراعات القوى والمصالح الاقليمية والقومية، ووجه حضاري في قلبه تفاعلات الدين الثقافة، الهوية[4]، فمثلاً لقد تشابه الايرانيون والعرب – وخاصة في القرنين التاسع عشر والعشرون من حيث مواجهة تحديات عمليات التحديث والتغريب المفروضة من الخارج…
خامساً: العلاقة بين الرابطة العقدية والمصالح القومية ليست علاقة تناقض –كما يصور البعض– على اعتبار أن الأولى مثالية قيمية تتحدث عما يجب أن يكون، والثانية واقعية براجماتية تتحدث عما هو قائم من طبائع البشر والاجتماع البشري. فإن تكريس هذا التناقض وقبوله هو بمثابة تأكيد للمقولات العلمانية وبعض مقولات استشراقية عن الفجوة بين الأصل في الإسلام والتطبيق في تاريخ المسلمين. ومن ثم يجدر النظر للعلاقة على نحو آخر وهو : متى حقق التمسك بمتطلبات الرابطة العقدية مصالح الأمة ومصالح الأقوام والكيانات السياسية المختلفة، ومتى حدث العكس؟ ومن ثم كيف يمكن تفعيل هذه الرابطة العقدية لتترجم نفسها في مصالح ممتدة؟ وكيف مارس التأثير الخارجي تأثيره السلبي على الرابطة الحضارية؟ حيث إن تعاظم هذا التأثير – في ظل الضعف الداخلي – من شأنه أن ينال من قدرة مقاومة المشترك الحضاري[5]. بعبارة أخرى فإن المصالح القومية وتوازنات القوى السياسية لا يجب أن تكون مستبعدة من تحليلات الرؤية الإسلامية للتاريخ الإسلامي، لأن تلك الأخيرة هي واقعية أيضاً بقدر ما هي قيمية ، ولكن وفق مفهوم رشيد للواقع – يسعى لفهمه وتدبره لإمكانية تغييره وليس الوقوع في أسر حتمياته في ظل حسابات الكسب والخسارة الوطنية الآنية المضحية بمكاسب الأمة الآجلة.
وسادسًا وأخيرًا، فإن فهم وتدبر واقع المسلمين (فقه الواقع) استشرافًا لإمكانيات تغييره ولمستقبله لابد وأن يبدأ من فقه التاريخ فقهاً علمياً منظماً . فإن دراسة التاريخ الدبلوماسي أو العسكري أو الحضاري تؤدى وظيفة هامة لمتخصصي هذه المجالات إلا أن لدراسة التاريخ أهمية أخرى لدى منظري العلاقات الدولية – وخاصة المدرسة النظمية التي تنبني عليها دراسة تطور وتعاقب النظم الدولية تاريخيًا، كل هذا من أجل تعميق فهم الأوضاع الراهنة من خلال اكتشاف ما تمثله من اتصال أو انقطاع مع أنماط تاريخية من التفاعلات الدولية[6].
وعلى ضوء كل ما سبق طرحه من قضايا منهاجية ست فإن خصائص منطلق دراستي وإطارها النظري والفكري وأهدافهما تتلخص في الآتي:
(1) هو اقتراب نظمي تاريخي (من رؤية إسلامية) بمعنى أنه يتجه للتاريخ بحثًا عن كيفية تطور النظم الدولية واستكشاف أنماط التفاعلات وأسباب التطورات، وبالتركيز بالطبع على الأمة الإسلامية كنظام تفاعلات عالمي ممتد عبر التاريخ، يمثل جزءًا ومكونًا من النظام العالمي، وانطلاقاً من فهم واستدعاء السنن الكونية والقيم، كإطار مرجعي لفهم وتفسير واستشراف هذه العلاقات الدولية[7]. ومن ثم، فإن العرب وإيران – وفق اقترابي- ليسما مجرد جوارين جغرافيين أو قوميتين متمايزتين أو دول قومية ذات مصالح متنافسة على الزعامة الإقليمية وتحقيقاً لمصالح وطنية ولكنهم ابتداء ركنين أساسيين من أركان هذه الأمة عبر تاريخها انطبقت على كل منهما على حدة وعلى تفاعلاتهما التاريخية البينية وعلى تفاعلات الآخر الخارجي معها –بأنماطها المتغيرة– السنن الإلهية في الاجتماع البشرى والأممي، أو ما يمكن أن نسميه بلغة علماء النظم الدولية المهتمين بالتطور التاريخي للنظم الدولية قواعد وأسس تشكل أنماط نظم العلاقات وتغيرها. وعلى ما بين الاقترابين من اختلافات من منظور غربي (مادى) ومن منظور إسلامي (قيمي)، إلا ان قاسماً مشتركاً أساسياً بينهما وهو أن متابعة تطور التفاعلات عبر التاريخ لابد وأن يكشف عن أنماط متكررة (وإن كان التاريخ لا يعيد نفسه) يمكن من خلالها تحديد قواعد وتصريحات عن فهم وتفسير واستشراف المسار التاريخي للأمم أو الدول … سواء بالانطلاق من الاطار المرجعي ابتداء (القرءان كما في حالة السنن والقيم) ثم ننتقل على ضوئه لقراءة واقع التاريخ الماضي والحاضر، أم ذاته (سواء ابتداء من إطار مرجعي بشرى يصوغ افتراضات أو مقولات أو بدونه ) ليصل إلى صياغة تعميمات.
(2) إن اقتراب دراستي على هذا النحو إنما يؤسس ابتداء لقواعد وأسس مناقشة تشوهات وتحيزات معرفية وفكرية وسياسية سادت دوائر متعددة (أكاديمية وإعلامية وسياسية) عن العلاقات بين العرب وإيران (سواء آنيا أو تاريخياً) وجميعها أعلَّت وبصورة اختزالية فجة إما الاختلافات القومية والمذهبية أو التدخلات الخارجية (وخاصة في المرحلة الحديثة) ومن مثل هذه المقولات: الصراع القومي بين العرب والفرس، التأثيرات الفارسية والشعبية على وحدة الخلافة العباسية، الصراع الفاطمي – العباسي، الصراع الصفوي – العثماني صراعًا مذهبيًا، التحالف الصفوي مع الأوربيين ضد العثمانيين، التحالف البهلوي الأميركي- الصهيوني ضد القومية العربية، صدام حسين (في حربه مع إيران) حارس بوابة القومية العربية، خطر تصدير الثورة الإسلامية والتشيع، مد النفوذ الإقليمي الإيراني للمنطقة، المساومات الايرانية الأمريكية حول العراق المحتل، محور إيران – سوريا – حزب الله خطر يهدد سنة العرب.
ويجدر التنبه إلى أن جميع هذه المقولات وغيرها- باستدعاءاتها التاريخية والراهنة إنما تولد حالة فكرية أو ذهنية ليس عن العلاقات بين العرب وإيران فقط بل تمتد إلى تاريخ المسلمين كله، وهي حالة توسمه إما بنظرية المؤامرة أو توسم بنظرية دموية العلاقات الإسلامية – الإسلامية وصراعاتها – باستثناء العصر النبوي، ولذا يطرح البعض للنقاش مصداقية تطبيق الإسلام عبر تاريخ المسلمين ومن ثم يطرح إشكالية العلاقة بين الأصل والتطبيق في تاريخ الإسلام والمسلمين.
وكلا الحالتين يمثلان اختزالاً لظاهرة كلية وأكثر تركيباً وهو اختزال يعلى من الثنائيات بين الداخلي / الخارجي، الأممي/ القومي / المذهبي، الرابطة العقدية / المصالح القومية.
في حين أن منظوراً إسلامياً للتاريخ وتفاعلاته ، ودون إنكار لتأثير كل متغير من هذه المتغيرات، لابد وأن يتجاوز هذه الثنائيات ويقدم طرحاً كلياً شاملاً يحدد موضع كل متغير من هذه المتغيرات ووزنه النسبي وتأثيراته مقارنة بغيره وذلك عبر مراحل تطور المسار التاريخي ووفق التفسير الإسلامي (الرشيد) لهذا التاريخ وهو التفسير السنني – الشرطي وعلى ضوء منظومة القيم الإسلامية كإطار مرجعي، وليس، التفسير الجبري أو القدري أو التفسير الانحداري أو الصعودي (خير أمة أخرجت للناس)[8].
إن هذه المنطلقات للدراسة ومنظورها لتبين أن مدخلي للتاريخ ليس محايدًا أو موضوعيًا أو غير أيديولوجيًا وأنه وإن كان مدخلاً نظميًا دوليًا إلا انه من منظور إسلامي حضاري مقارن يعالج تحيزات المنظورات الأخرى لعلم العلاقات الدولية التي وظفت التاريخ بصفة عامة وموقفها من التاريخ الإسلامي بصفة خاصة، مثل تحيزات الإهمال أو الإسقاط للتاريخ الإسلامي أو الاختزال (في المادي فقط) وذلك عند تفسير مسار هذا التاريخ الإسلامي من المدخل القومي أو المذهبي أو صراع القوى[9].
كذلك فإن منطلقي المرجعي هذا يقتضي أن يتم شرح عنوان دراستي في إطار كلى يصل بنا للإجابة على السؤال التالي، متى أضحى التدخل الخارجي أو العامل الخارجي أساسيًا في إثارة أو إدارة أزمات المنطقة وكيف تم ذلك؟ ولماذا؟ وذلك علاجًا للتحيز الذي يركز على نظرية المؤامرة فقط أو يلقى بالمسئولية على النظام الدولي فقط أو العكس، أي التحيز الذي يركز على صراع القوى والمصالح فقط أو الاختلافات المذهبية والقومية فقط ذلك لأن صورة المسار التاريخي أكثر تعقيدًا أو تركيبًا من هذا الاختزال المتحيز معرفيًا وفكريًا ونظريًا وكذلك سياسيًا.
كما أن هذا المنطلق للدراسة وإطارها المرجعي يستلزمان – او يستهدفان – عند معالجة حالة العلاقات بين العرب وإيران بل وغيرهما من علاقات شعوب الأمة (لا أقول دولها فقط) مثل الأتراك والفرس، والعرب والزنج، الترك والألبان، السلاف (البوشناق) والأتراك، العرب والترك والفرس والمغول..، العرب- الأكراد، الأتراك الأكراد ..) [10].
إعادة بناء المفاهيم السيارة سعياً لإعادة تشكيل الوعي الجماعي والذاكرة الجماعية لشعوب الأمة، التي سقطت في براثن مفردات ومفاهيم الكيانات القومية والقطرية ذات المصالح القومية المتنافسة (على حساب مقتضيات الرابطة العقدية )[11]. وعلى نحو دفع للوراء بمفردات الكيان الحضاري الممتد المكون من شعوب وأمم وقوميات وتربطه رابطة عقدية وله قواعده وأسسه الحاكمة ومنظومة قيم تستهدف جميعها ضبط وعلاج مثالب التجزئة دون أن تنفى سنة التنوع والتعدد في إطار المقاصد الشرعية ومصالح الأمة.
ومن قبيل هذه المفاهيم المتقابلة (والتي قد تصل إلى التضاد) يمكن أن نورد المجموعات التالية:
أ- دول قومية متجاورة جغرافيًا / أركان دائرة حضارية واحدة.
الجوار الإقليمي / الجوار الحضاري.
الأمن القومي / الأمن الحضاري.
حضارة مصرية وحضارة إيرانية تشاركان في حضارة عالمية / ثقافة (أو حضارة) في إطار حضارة إسلامية.
ب- الصراع الإقليمي / التنافس الإقليمي.
الأدوار المتبادلة / الأدوار المتكاملة.
النظم السياسية المختلفة الإطار المرجعي/ منظومة القيم المشتركة للمجتمعات والشعوب.
المصالح القومية المتصارعة /المصالح الوطنية المتنافسة في إطار مشترك ثقافي وحضاري.
الاستقطاب الثنائي الإقليمي بين القوميات / الإدراك المتبادل والتعارف الحضاري والروابط الحضارية التاريخية.
ج- النظام العالمي / العولمة بأبعادها المختلفة.
حضارة عالمية / حوار وتحالف حضارات.
الحوار بين مصالح سياسية واقتصادية/ الحوار الحضاري.
خلاصة القول عن هذا المنطلق للدراسة أمرين: الأمر الأول: أنه منطلق حضاري بالمعنى الواسع ، وليس منطلق سياسي تقليدي يكرس مفهوم صراع القوى والمصالح (من منظور وضعي علماني مادي) على حساب غيره من المفاهيم ولذا فإنني سأنظر للعرب وإيران –عبر التجربة التاريخية كركنين من أركان دائرة حضارية واحدة، باحثة في إشكالية العلاقة بين هذا الانتماء الحضاري المشترك وبين إداءة المصالح القومية المتنافسة، ومتساءلة عما أحاط بتأثير التدخلات الخارجية من تصاعد وصولاً إلى الاختراق الحالي.
الأمر الثاني: عن منظوري هذا ليس قيميًا بمعنى أنه يبحث فيما يجب أن يكون وفق إطار مرجعي ديني، ولكنه منظور حضاري قيمي يشخص ويفسر ويمثل أساساً للتدبر من أجل إمكانيات التغيير الراهن والمستقبلي. فالقيم ليست مثالية مجردة ولكن إطار مرجعي للتغيير[12].
(3) وكما أن خصائص الوضع الراهن، ومنذ 1991، في المنطقة العربية وجوارها الحضاري الإسلامي (تركيا، وإيران، وباكستان، وأفغانستان) أو ما يسمى الشرق الأوسط الكبير أو الموسع – التي تسعى الاستراتيجية الأمريكية العالمية لإعادة تشكيله (وفق ما يسمى بخطة حدود الدم) تقدم الكثير من المؤشرات المتكررة بكثافة والتي تبين كيف أن هدف التدخل الخارجي هو إعادة تقسيم المنطقة من جديد على أسس قومية ومذهبية على نحو قد يؤدي إلى غياب دول قائمة مثل العراق أو السودان أو السعودية أو إمارات وممالك الخليج أو إيران أو لبنان أو مصر. ومن ثم، فإن العلاقات الراهنة بين العرب وإيران وخريطة تحالفاتها وتحالفاتها المضادة وأزماتها ليست إلا مشهدًا واحدًا من مشاهد هذا السيناريو. ومن ثم فإن التحذير من خطورة هذا الوضع لن يكتسب صداه بدون بيان كيف أن السيناريو الراهن هو الصيغة المتطورة لسيناريوهات مناظرة شهدها تاريخ علاقات عالم المسلمين بعالم الغرب. وإن اختلفت بالطبع درجات وطبائع التدخل الخارجي باستخدام ورقة الاختلافات والخلافات.
وعلى ضوء كل ما سبق من منطلقات تحدد منظور دراستي وغايته ودوافعه، تتشكل مقولة الدراسة الأساسية ويتحدد منهج استقصائها ومناقشتها ، كذلك فإن المدى الزمنى لهذا الاستقصاء والمناقشة يطرح نفسه: من أين البداية للتجربة التاريخية محل الاهتمام وصولاً إلى المرحلة الراهنة وهي المرحلة التي يعاد فيها تشكيل المنطقة العربية وجوارها الإيراني والتركي، أي يعاد تشكيل ما يسمى “الشرق الأوسط الكبير أو الموسع” وهو المرادف الأمريكي للفضاء الإسلامي الحضاري في قمة اتساع الدولة العباسية ومركزية دورها العالمي ومحوريته، كذلك وأن تحديد المدى الزمني على نحو يمتد إلى التاريخ يقودنا إلى الفواعل محل الاهتمام، وهذا بدوره يقودنا إلى عنوان المؤتمر برمته هذه المرة وليس عنوان الدراسة فقط. وفيما يلي بعض التفصيل حول هذه العناصر.
ثانيًا: مقولة الدراسة ومنهجها:
المقولة تنبني على نتائج دراسة ممتدة للتاريخ الإسلامي وفق إطار منهجي نظمي يستقصى مسار تطوير قضيتين رئيسيتين وهما قضية وحدة الأمة والجهاد [13].
وهي تتلخص كالآتي[14]:
أن فقه الواقع الراهن من خلال استدعاء فقه التاريخ لا يستقم بدون فقه الأصول. ففي ظل رؤية للأصول الإسلامية ترى في وحدة الأمة أصلاً، فإن خرجنا بحكم الواقع عن الأصل إلى سياق تجزيئي، فوجب علينا أن نجعل الأصل غاية يُسعى إليها ونعمل لاستعادته.
بل إن مفهوم الأمة الإسلامية ذاته يحمل ضمن ما تمليه الأصول رؤية متكاملة للعلاقات بين عناصر الأمة، حتى مع تعدد عناصر تمثيلها، وهو يسع مفهوم العلاقات البينية بهذا الاعتبار.
وعناصر توحيد الأمة أكثر من ان تحصى أو تعد وأهمها وحدة التكوين العقدي في إطار عقيدة التوحيد الجامعة ووحدة القبلة والوجهة، ووحدة المقصد والهدف خاصة إذا ما تعرفنا أن أصل مفهوم الأمة من “الأم” ومطلق الأم القصد والوجهة.
إن النظر إلى التعاون والتكامل والتكافل والتضامن كعمليات تشير إلى تفعيل أمرين مهمين يتكاملان في هذا المقام؛ الأول: المقاصد الكلية الحافظة، الثاني: السنن الكلية القاضية والتي تعنى بأن لهذه العمليات سنناً تحقق فاعليتها ، كما تؤدي إلى عكس مقصودها.
ولا يجب أن ينظر إلى الشرع في إطار نصوصه فحسب أو معانيه الجزئية المباشرة، بل إن من الضروري استلهام كلياته التأسيسية، وهو ما يعنى أن البحث في المصالح المعتبرة لكيان الأمة، أجزاء وتكوينات، جزء لا يتجزأ من التوجيهات الشرعية، وأن هذه المصالح إنما تمثل عناصر للضرورة الواقعية الناهضة بكيان الأمة، فأينما كانت المصلحة فثم شرع الله.
ومن هذا الإطار الكلي المحيط تتضح ضرورة تحديد المستويات التي تدور حولها العلاقات الإسلامية – الإسلامية وأهمها:
- النصرة والتخاذل في عالم المسلمين.
- حل المنازعات التي تقوم بين الدول الإسلامية ووضع طرف غير مسلم فيها.
- التحالفات والحروب فيما بين الدول الإسلامية ووضع طرف غير مسلم فيها.
- أولويات التعامل والتكامل والثقافي والاقتصادي.
ولكن ماذا تقول لنا دراسة خبرة التاريخ الإسلامي حول نمط تطور العلاقات الإسلامية – الإسلامية في المستويات السابق تحديدها؟
إن دراسة هذه الخبرة تبين لنا الرابطة التفاعلية بين ثلاثة محاور أساسية:
عوامل قوة وضعف الدول الإسلامية، العلاقات بين الدول الإسلامية، العلاقات بين الدول الإسلامية وغيرها من الدول. وتنبثق هذه المحاور الثلاثة عن قضيتين أساسيتين تقعان في صميم الاهتمام بفقه العلاقات الإسلامية الدولية الراهنة. الأولى هي قضية العلاقة مع الآخر غير المسلم في ظل قواعد العلاقات الصراعية القتالية أو التعاونية السلمية التي يطرحها المفهوم الواسع للجهاد. والقضية الثانية هي انتشار نموذج الدولة القومية أمام ضغوط التعددية السياسية الدولية، وصولاً إلى حالة التجزئة. والإطار العام الكلى الذي تنبثق عنه بدورهما القضيتان يتمثل في التطور التاريخي لوضع الأمة في النظام الدولي على نحو أفرز التبعية بعد الاستقلال، والهيمنة من ناحية، كما شهد، من ناحية أخرى، شحوب فكرة الأمة وتدهور الالتزام بمقتضياتها بالنسبة إلى العلاقات الإسلامية –الإسلامية على نحو أفرز التجزئة والقطرية بعد الوحدة والتعددية.
بعبارة أخرى فإن خبرة التاريخ الإسلامي عن نمط تطور العلاقات الإسلامية – الإسلامية بعيداً عن الوحدة لا ينفصل عن خبرة نمط تطور العلاقة مع الآخر (نحو التبعية)، أو عن خبرة نمط التطور الداخلي في الدول الإسلامية (نحو التغريب). ولهذا؛ فإن آفة الواقع الراهن للأمة هي أن التجزئة تقترن باختراق خارجي ضخم لشبكة العلاقات الإسلامية – الإسلامية، كما تقترن بتغريب الأمة.
إن مراجعة نتائج الدراسة النظمية للتاريخ الإسلامي في عصوره المتعاقبة والتي قدمها مشروع العلاقات الدولية في الإسلام تبين لنا أن ازدهار وتدهور الدولة الإسلامية الموحدة تحدد بعدد من العوامل الرئيسية، وهي العقيدة، ومدى استقرار الجبهة الداخلية، والقدرات العسكرية، ووضع المركز في هيكل الاقتصاد العالمي، وطبيعة العلاقة داخل النسق الفرعي الإسلامي، وقوة وضعف الخصم، وتدخل الخصم في الشئون الداخلية للطرف الإسلامي، والحروب كنقاط للتحول في تاريخ الدول.
فالدول الإسلامية تمتعت بمركز متميز في هذا النظام في ظل تمسكها بالعقيدة الإسلامية، واستقرار الجبهة الداخلية، وتنمية قدراتها العسكرية، واحتلالها مركزاً متميزاً في هيكل النظام الاقتصادي العالمي، ومناصرة الأطراف الإسلامية لبعضها البعض، ومن ثم إمكانية عدم تدخل القوى الخارجية في شئونها، إلا أنها تعرضت للتدهور في ظل انتفاء مثل هذه العوامل. هذا وسنشير فقط إلى خبرة واحد فقط من هذه العوامل وهو العامل المتصل بالتفاعلات بين الدول الإسلامية، إذ إن متابعة تطور أنماط التفاعل الإسلامي – الإسلامي تشير إلى نتائج أساسية حول قضايا: الوحدة، التعددية، النصرة، التحالفات والحروب.
إن توحد الفواعل الإسلامية ترتب عليه نتائج إيجابية في دعم موقف هذه الفواعل في مواجهة الفواعل غير الإسلامية، وبالتالي ساهم في تدعيم قوة الفاعل الإسلامي المركزي.
إن الأطراف الإسلامية فشلت في بعض الفترات التاريخية، في مناصرة فواعل إسلامية أخرى بعضها البعض، على النحو الذي قيد من فعالية دور القوى الإسلامية في النظام الدولي وفي مواجهة أطراف غير إسلامية. إن الصراعات بين الفواعل الإسلامية اتخذت مظهرين رئيسيين: الدخول في تحالفات مع فاعل غير إسلامي ضد فاعل إسلامي، والصدام العسكري المباشر بين هذه الفواعل، ولقد كانت المحصلة النهائية لجميع هذه الأنماط من التحالفات والحروب – في غير صالح الأمة في مجموعها في صراعها ضد الآخر. إن المحصلة النهائية للصراع بين القوى الإسلامية أضعفت من الدور الإسلامي في توجيه التفاعلات الدولية في مراحل محددة وبصورة تراكمية حتى الآن.
كما أن المحصلة النهائية للحروب الإسلامية –الإسلامية ساهمت في تدهور الدولة العثمانية، ومن ثم انهيارها وتفككها ومعها آخر الرموز –ولو الشكلية- للوحدة السياسية الإسلامية، حتى وصل الأمر إلى سيادة نمط التجزئة والانقسام والتعددية المفرطة، في وقت تغلبت فيه، في المقابل، هيمنة وتفوق دور الطرف الآخر. ولكن على المدى الطويل، ومن خلال المراجعة الكلية الشاملة للتواريخ الإسلامية، يمكن القول إن توالى الأجناس المسلمة (العرب، الترك، الفرس) على قيادة المسلمين ومواجهة الخصم كان في مجموعة لصالح خدمة الإسلام ولصلاح الأمة واستعفائها ونهوضها بعد كل مرحلة من مراحل الخبو. وبالرغم من ضخامة مصادر التحدي، فإنه يمكن القول إن ضعف الدور القيادي لطرف مسلم يعوضه نمو دور طرف آخر، ولو في محور جغرافي مختلف وفي مواجهة خصم آخر. إلا أنه ظل التنافس بين هذه المراكز والذي تحول إلى صراع مفتوح في ظل التدخل الخارجي آثاره السلبية لكل مركز ناهيك عن مصالح الأمة في مجموعها.
في ضوء ما سبق (مدلولات قراءة خبرة التاريخ، ومن مدلولات الفجوة بين الأصل وبين هذه الخبرة )، يمكن أن تتبين لنا حقيقة وضع المرحلة الراهنة من واقع العلاقات الإسلامية-الإسلامية، فهي، تمر بمرحلة متطورة من التحديات تمثل في حد ذاتها نمطاً من التحديات للأمة، والتي تمثل تراكماً مع مراحل سابقة من مراحل التطور التاريخي لوضع الأمة في العالم.
بعبارة أخرى: المرحلة الراهنة من تاريخ الإسلام والمسلمين هي مفترق طرق جديد تمر به تطورات العلاقات فيما بين المسلمين، وبينهم وبين العالم المحيط. وإذا كانت مفارق الطرق السابقة قد قادت إليها عمليات تحول وتغير، سواء في أوضاع المسلمين أو العالم المحيط، فهذا أيضاً شأن المرحلة الحالية (منذ نهاية القرن العشرين وبداية القرن الخامس عشر الهجري) التي تفرز أثواباً جديدة من التحديات التي تواجه الأمة. فالداخلية منها والخارجية والبينية ليست مستحدثة أو طارئة ولكنها متواترة ومتكررة منذ أن بدأت مرحلة الأزمة الكبرى من الضعف والتعددية والتجزئة والتراجع أمام الآخر، وإن كانت تتخذ أشكالاً متغيرة بتغير الأوضاع والظروف من مرحلة إلى أخرى. إلا أنها تراكمت عبر القرون التي شغلها منحني انحدار الحضارية الإسلامية والخلافة الإسلامية ثم الأمة الإسلامية شعوبًا ونظمًا.
ولذا فإن الاشكاليات الأساسية التي يتمحور حولها موضوع الدراسة تتلخص في الأسئلة التالية: أين تأثير الرابطة العقدية المشتركة التي تمثل صميم منشأ الأمة الإسلامية؟ وما طبيعة هذا التأثير بالمقارنة بما تمارسه العوامل الأخرى من تأثير على قضايا العلاقات الإسلامية- الإسلامية المختلفة. وما الدرجة التي وصلت إليها الفجوة بين قواعد الأصل وبين فقه الواقع الراهن، مروراً بفقه خبرة التاريخ؟
بعبارة أخرى، كيف نرصد أبعاد ما يبدو لنا كمعضلة العلاقة بين الرابطة العقدية وبين المصالح القومية وسيادة الدول؟ وكيف يمكن أن نفهم أو نفسر هذه المعضلة: تنامي القصور في قواعد ومتطلبات العلاقات البينية الإسلامية الفاعلة على الأصعدة السياسية والاقتصادية وكذلك الثقافية الحضارية في مقابل تنامى تأثير العامل الخارجي في العلاقات الإسلامية – الإسلامية في مستوياتها المختلفة؟ وما هي المستويات التي تكمن فيها إمكانيات تجديد طاقات التعاون والتكامل بين شعوب الأمة؟ وقبل هذا وذاك، تقليل الادراكات المتبادلة عن الخطر أو التهديد الذي تمثله الدول الإسلامية لبعضها البعض؟
وهذه المقولة للعامة نختبرها ونستقصيها باستدعاء حالة العلاقات بين العرب، ومنهج هذا الاستقصاء هو رسم خريطة التفاعلات ومفاصلها، واستكشاف أنماط تطور العلاقات ومحددات تشكيلها، وذلك بالاستعانة باقتراب نظمي دولي، وبذا يتحقق الانتقال من العام إلى الخاص، والعام هو الجماعة الإسلامية على المستوى العالمي، والخاص هو العلاقات عن العرب وإيران. وذلك لأنه بالإحالة إلى طارق البشري[15]، فإنه عندما نتجه إلى الجماعة الإسلامية على المستوى العالمي، إنما يتعين علينا أن نحث في العلاقات الداخلية بين وحدات هذه الجماعة والعلاقات المتبادلة والمشكلات القائمة، سعيًا لإدراك المشترك العام والوصول بالاستقراء إلى ما يعتبر وجود صالح عام يجمعها ويشكل مع الوقت معيارًا لفض الخلافات، ومجالاً للتقارب”.
ثالثًا: منهج الدراسة: الأنماط والنماذج والمحددات
إن استقصاء واستدعاء التجربة التاريخية للعلاقة بين العرب وإيران لشرح هذه المقولة والتدليل عليها، لا يعني التاريخ التفصيلي لهذه العلاقات، ولكن يعني كما سبق القول رسم خريطة أنماط التفاعلات وتقديم بعض نماذجها المفصلية ومتابعة مسار الخبرة صعودًا وهبوطًا وتحديد العوامل المشكلة لها.
وعند التمييز بين عدة مراحل مرت بها هذه التجربة التاريخية في حد ذاتها وفي سياقها العام المتصل بالعلاقات البينة على صعيد الأمة برمتها فإن المعيار الأساسي للتقسيم هو درجة الوحدة مقارنة بدرجة التأثير الخارجي عليها. وهي الدرجة التي تتحدد بدورها وفقًا لمدى تكرار وطبيعة مجموعة أنماط التفاعلات. وهي أنماط مرتبة تصاعديًا من حيث درجة تدخل العامل الخارجي وخطورته:
1- التحالف مع طرف غير مسلم في مواجهة طرف غير مسلم معتدى أو مهدد.
2- عدم النصرة في مواجهة طرف غير مسلم معتدى أو مهدد.
3- التحالف مع طرف غير مسلم في مواجهة طرف مسلم منافس.
4- الحروب المباشرة بين المسلمين ومكاسب طرف غير مسلم منها.
5- توظيف الخارج للمسلمين بعضهم ضد بعض.
6- تهديد مباشر من الخارج: الاحتلال والتقسيم والتغريب باسم التحديث.
وهذا الترتيب التصاعدي للأنماط يفرض بحثنا عن الآتي: ما الفارق بين أنماط التاريخ في تطورها والأنماط الراهنة؟ وما درجة الوعي بهذا الاختلاف وبقدر ما يعينه بالنسبة لدرجة التأثير السلبي للتدخل الخارجي في المراحل الحديثة مقارنة بدرجة تأثير المتغيرات الداخلية والبينية؟
ومن ناحية أخرى، فإن المشترك الأدنى بين جميع هذه الأنماط هو المصالح القومية المنافسة في مقابل مقتضيات الرابطة العقدية (وفق الأحكام، والسنن، والقيم، والمقاصد الشرعية)، فمتى تحقق حفظ هذه المصالح واحترام هذه المقتضيات في نفس الوقت؟ ومتى حدث العكس؟ ومتى تكرر نمط حسن الجوار والتعاون والتضامن ومتى حدث العكس وتكررت الأزمات؟
ومما لا شك فيه أن كل من هذه الأنماط ونمط تكرارها وتعاقبها عبر مراحل تطور العلاقات بين العرب وإيران هي نتاج مجموعة محددات وهي ما يسميه البعض البنية الداخلية، البنية الإقليمية، البيئة الدولية.
وبالتركيز على المتغير الذي تبحث الدراسة في تأثيره –وفق العنوان- أي المتغير الخارجي. فهنا يجب أن نميز بين أمورٍ ثلاثة وفق مقتضيات دراسة السياسات الخارجية والنظم الدولية: ألا وهي خصائص النظام الدولي (هيكل النظام، آلياته، وقيمه)، وانعكاسه على وضع المنطقة في تفاعلاته، نمط التدخلات الخارجية في دولة بعينها (من هو مصدر التهديد الخارجي الأساس للمصالح القومية وما هي أدواته)، نمط التحالفات والتحالفات المضادة بين القوى الدولية حول المنطقة المعينة وآثارها على أنماط التحالفات بين دول هذه المنطقة (من هو الحليف ومن هو المتحدي الأساسي لأمن المنطقة وتشكيل توازناتها الإقليمية).
ومن ناحية أخرى: فإن استدعاء هذه المستويات الثلاثة للمتغير الخارجي للتمييز في الدراسة بين الأنماط التاريخية المتعاقبة، إنما يستدعى بدوره –وبدون إسقاط– المتغيرين الآخرين ألا وهما الاختلافات القومية والمذهبية، وتنافس المصالح القومية، حيث إن المتغير الخارجي لم ينفصل عنهما.
ولقد نجح هذا المتغير الخارجي في أوقات محددة حين كانت النظم الداخلية في الدائرتين العربية والايرانية والقيادات ومشاريعها الإقليمية تعلي من هذين الجانبين بل وتوظف النظام الدولي –كل في مواجهة الآخر – لخدمتهما. وحتى وصلنا الآن إلى توظيف المتغير المذهبي ورقة لخدمة الاحتلال الخارجي من جديد. ومن هنا أهمية الامتداد التاريخي للدراسة لمناقشة تكرار أنماط التفاعلات التي تؤكد أو تدحض هذه المقولة.
رابعًا: النطاق المكاني والزماني للدراسة: أي منطقه؟ ولماذا صفة العرب وإيران؟ ومنذ متى؟
يطرح عنوان المؤتمر قضية منهاجية أخرى تتصل بتحديد الفواعل محل الاهتمام .فهل شعوب، أم أقوام، أم دول؟ وكيف نحدد –من ناحية أخرى– النطاق الزمني للدراسة؟ فأي مراحل التاريخ الإسلامي، تساعد على اختبار أنماط التدخلات الخارجية السابق تحديدها؟
وعنوان المؤتمر جاء توفيقًا بين اقتراح أولى قدمه برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات وهو: (العلاقات العربية الإيرانية) بين التدخلات الخارجية والمصالح القومية والاختلافات المذهبية، وبين اقتراح المركز الدولي لحوار الثقافات (العرب وإيران: التدخلات الخارجية والمصالح القومية). ولذا يثور السؤال لماذا ليس العرب والفرس أو الإيرانيون؟
وأرى أن الشق الأول من عنوان المؤتمر (العرب وإيران) يطرح رؤية جيواستراتيجية أرادت أن تتجاوز ثنائية المذهب التقليدية (السنة / الشيعة) وثنائية القومية (العرب / الفرس) على اعتبار أن إيران تضم قوميات أخرى إلى جانب الفارسية والعرب بينهم السنة والشيعة. كذلك فإن هذا العنوان يتجاوز صيغة المنطقة العربية حتى لا تصبح إيران مجرد جوار جغرافي.
ولكن من ناحية أخرى، فإن هذا العنوان وضع قومًا وهم العرب في مقابل دولة إسلامية (وفق التقسيم الحديث للدول الإسلامية) إيران (على الأقل منذ الدولة الصفوية وحتى الآن، مروراً بالقاجارية ثم البهلوية ثم الجمهورية الإسلامية). ومع ذلك فإن هذا العنوان يساعد على حل إشكال آخر وهو أن العرب، عبر تاريخهم في سياق التاريخ الإسلامي، لم يحكمهم بعد العصر العباسي (بل ومنذ أواخر هذا العصر) عرباً فقط كذلك لم تتأسس لهم دول وُصفت بالعربية ولكن توالت عليهم، باعتبارهم قوم من أقوام المسلمين تجمعهم دول خلافة مركزية أو لا مركزية، وأسر وممالك وسلطنات أسسها غير عرب وإن كانوا مسلمين . وإذا كان البعض يلمّح إلى هذا الوضع – من مدخل تجزيئي قومي أو عرقي (مثلاً وصف الحكم العثماني بالاحتلال) إلا أن البعض الآخر –ومن مدخل أممي إسلامي– يقدم رؤية أخرى ترى أن تاريخ العرب هو جزء من تاريخ المسلمين، وإن العرب نزلت بينهم الرسالة وقادوا عملية تأسيس وتوسيع وإدارة الخلافة الإسلامية (القرون السبعة الهجرية الأولى) ولقد لعبت أقوام أخرى (الترك السلاجقة، والفرس) أدوارهم السياسية خلال العصر العباسي ثم انتقلت قيادة الأمة إلى أقوام أخرى، ثم بدأت تعددية القوى السياسية الإسلامية متزامنة مع مزيد من النفحات القومية ومزيد من التدخلات الخارجية منذ القرن العاشر للهجرة. (الامبراطورية المغولية في الهند، الدولة الصفوية في إيران، العثمانية في الأناضول والمنطقة العربية وشرق أوروبا والبلقان)[16].
بعبارة أخرى واستكمالاً لشرح مقوله الدراسة فإن التحرك نحو اللامركزية في دولة الخلافة وصولاً إلى التعددية السياسية في شكل دول قومية قد اقترن بتزايد مصادر التهديد الخارجي وتعدد أنماطه. مما يعنى أن تنافس الأقوام والمذاهب ثم المصالح القومية للكيانات السياسية – وإن كانت جميعها أمورًا طبيعية وسنة من سنن الله لها قواعد إدارتها بين المسلمين، وبينهم ومن غير المسلمين، إلا أن عامل الضعف الداخلي ابتداء قد مكن للتدخل الخارجي وتوظيفه لهذا التنافس البيني الإسلامي – الإسلامي ليحوله بالتدريج الى صراع وتناقض تتآكل في ظله كل مفاهيم وحدة الأمة بتنوع أعراقها وأقوامها ومذاهبها، فبعد أن كان التعدد والتنوع قيمة مضافة ومصدر قوة أضحى عبئًا وتكلفة وذو عواقب سلبية في ظل تصاعد نمط ودرجة التدخل الخارجي مع تنامي قوة مصادر التهديد المحيطة وتوسعها نحو المنطقة. هذا هو درس المسار التاريخي، الذي تستدعيه مناقشتنا للنطاق المكاني للدراسة.
خلاصة القول؛ أعتقد أن عنوان المؤتمر، وكذلك أحد مكونات عنوان دراستي – وهو (المنطقة) هو مخرج ذكى من كل الأفخاخ الجيواستراتيجية ذات الدلالات الخفية والصريحة التجزيئية للأمة الإسلامية –ككيان حضاري اجتماعي ممتد يجمع بين مكوناته المتعددة – عرقيًا وقوميًا ومذهبيًا وثقافيًا ولغة- رابطة عقدية، كان لها تأثيراتها الإيجابية على عناصر قوة هذا الفضاء الحضاري الإسلامي المتعدد وتكاملها فيما بينها وفي مواجهة الآخر وذلك في مراحل القوة الحضارية والشهود، ثم أضحى هذا التنوع وبالتدريج، عبئًا وثقلاً وتكلفة بل مصدر تهديد متبادل، ومن ثم أداة للتوظيف ضد وحدة هذه الأمة بل ووجودها وقدرتها على مقاومة هجمات الهيمنة الحديثة.
الجزء الثاني: النماذج التاريخية الشارحة لأنماط التدخلات
أولاً: النطاق الزمني للنماذج التاريخية
إن كل ما سبق شرحه من دلالات النطاق المكاني– يقتضي أن نحدد أيضاً النطاق الزمني وهو النطاق الذي سنقدم من ساحته النماذج التاريخية الشارحة لتطور أنماط التدخلات الخارجية وتفاعلاتها مع العلاقات بين العرب وإيران ذلك لأنه لا يمكن وفق منطلقات ومنهاجية الدراسة إدعاء متابعة المسار الكامل التفصيلي للتجربة التاريخية الاسلامية – سواء الكلية أو الخاصة بالعلاقة بين العرب وإيران.
ولكن يمكن التوقف عند نماذج تاريخية تمثل مفاصل في التحولات العالمية وفي تحولات العلاقات الإسلامية – الإسلامية. مع الأخذ في الاعتبار، الانطلاق من معايير التقسيم الإسلامي للتاريخ، وليس تقسيم التواريخ الأوربية أو العالمية.
هذا ويركز النطاق الزمني للنماذج على القرون الخمسة الأخيرة، مع استدعاء موجز لدلالة القرون العشرة الهجرية الأولى. ويرجع هذا التحديد لنطاق النماذج التاريخية الزمني لعدة اعتبارات تتصل بمفاصل إعادة تشكيل التوازنات العالمية في ظل تنامى قدرات الأوربيين وتوسعهم الخارجي، كما تتصل، من ناحية أخرى، بمفاصل إعادة تشكيل توازن القوي الإسلامية في ظل ظهور ثم نمو التعددية السياسية الإسلامية. وتتلخص هذه الاعتبارات في الآتي:
فعلى جانب: فإن النظام الدولي الشامل ابتداء من القرن السادس عشر الميلادي/ العاشر هجري، شهد تحولات هامة على نحو انعكس على العلاقات الإسلامية – الإسلامية من ناحية ونمط التدخلات الخارجية في أرجائه من ناحية ثانية وعلى نمط العلاقة بين العرب وإيران من ناحية ثالثة وعلى نمط أزمات هذه المنطقة الحضارية من ناحية رابعة.
حيث أضحى النظام الدولي أو السياسات الدولية مقارنة بما سبق من قرون مصدر تحدى ثم تهديد مباشر متعدد الأنماط. ففيما عدا الحروب الصليبية لم تشهد شعوب أو أراضي الأمة الإسلامية على امتدادها هجوماً مباشراً مثلما الذي شهدته منذ القرن الخامس عشر ميلادي/ التاسع هجري، مع بداية الهجمة الأوربية الحديثة ابتداء من استرداد الأندلس، وصولاً إلى الاحتلال الاستيطاني الصهيوني في فلسطين، مروراً بحلقات أخرى في ظل توازنات أوربية وإسلامية متحولة [17].
ولقد تعددت أنماط التدخلات وأدواتها عبر أرجاء الأمة، وسنقتصر على النماذج المفصلية المتصلة بالعرب وإيران مع استدعاء سياقاتها الكلية على ضوء ما سبق شرحه من قضايا منهاجية كمنطلق للدراسة.
وثاني الاعتبارات وراء تحديد النطاق الزمنى متصل بالمنطقة ذاتها: العربية – الايرانية – التركية. فمنذ القرن السادس عشر الميلادي والعاشر الهجري شهدت بدورها تحولات من أهمها: نشوء الدولة الصفوية وتبلور توجه جديد للدور الإقليمي الإيراني، حكم العثمانيين للمنطقة العربية بعد اتجاههم للجنوب وسقوط المماليك.
وهكذا فإن هذه القرون الخمسة تقدم دلالات نظمية كلية هامة مقارنة بنظائرها في القرون السابقة. فهي تشهد الانتقال من مرحلة صعود المكانة العالمية للأمة إلى مراحل الخبو والدفاع والتدهور، كما تشهد مراحل من تماسك دولة فارس وقوتها وأخرى لانقسامها وضعفها، كما تشهد مراحل مختلفة من توازنات القوى الاقليمية الإسلامية في ظل مراحل متفاوتة من حيث درجة كثافة وتكرارية التدخلات الخارجية.
ثانيًا: النماذج التاريخية في مرحلة الوحدة والفتوح والشهود الحضاري (خبرة القرون العشرة الهجرية الأولى)
مما لا شك فيه أن دلالة نماذج هذه القرون الخمسة تتضح أكثر بمقارنتها بنظائرها في مرحلة الوحدة والفتح والشهود الحضاري ولذا سأتوقف هنا برؤية تمهيدية سريعة على هذه المرحلة أيضًا التي استغرقت سبعة قرون هجرية (حتى العصر العباسي) ثم اعقبتها ثلاثة قرون انتقالية من توازن القوى العالمي والإسلامي استغرقهم العصر المملوكي. فإن شهدت هذه المرحلة بعض نتوءات التهديد الخارجي (الحروب الصليبية، الغزوة التتارية الأولى والثانية). والتآكل الحضاري وتنافسات الأقوام والأسر، إلا أن التعددية القومية والعرقية والمذهبية كانت مكونًا من مكونات الإنجاز الحضاري الإسلامي وانجاز الفتوح الإسلامية العالمية، وانجاز الدفاع عن الثغور والرباط، ولم تنجح التدخلات الخارجية في اللعب بهذه الورقة، كما لم تكن هي في ذاتها مصدر تهديد لوحدة الأمة وإنجازاتها.
هذا وإن لم تكن ثنائية العرب-الفرس أو العرب-إيران، وبالمثل العرب-الترك غائبة عن الساحة الا أنها لم تكن بنفس الوضوح الذي أضحت عليه في الخمسة القرون التالية حين انتقلت قيادة الأمة إلى الترك العثمانيين ومنافسة الصفويين لهم وما تلي ذلك من تطورات حتى الآن.
كذلك لم تكن تأثيرات هذه الثنائية سلبية أو خطيرة بل لم تكن المنافسات التي أحاطت بها تنطلق أساسًا من المذهب أو القوم بقدر ما تعكس تنافسات القوى والمصالح في فضاء حضاري ممتد تمتزج فيه الشعوب مع انتماء لكيان أكبر هو الأمة ولو في ظل قيادة أسر متنافسة على الحكم ولكن متنافسة في حماية الأمة من التهديد الخارجي.
ويكفي أن نستدعي ما يلي على سبيل التذكرة وليس المسح الشامل:
- دور البربر في فتوح شمال أفريقيا والأندلس (من قدم طارق بن زياد باعتباره من البربر؟)
- الترك السلاجقة ودعم قدرة الخلافة العباسية على التصدي للبيزنطيين وبداية الحملات الصليبية.
- الدولة الفاطمية –الشيعية في مصر ودورها في مقاومة البيزنطيين ولو في إطار من المنافسة مع الخلافة العباسية والسلاجقة.
- دور صلاح الدين الأيوبي (الكردي) في الحروب الصليبية.
- فشل محاولات الأوروبيين في التأثير على التوازن العباسي-الفاطمي، وعلى التفاعلات العباسية-البيزنطية- الصليبية، وكذلك فشل التحالف مع تيمور لنك للإحاطة بالمماليك والدولة العثمانية الناشئة والتأثير.
- دور ورثة إمبراطورية تيمور لنك: ايلخانات (فارس) والقبيلة الذهبية في القوقاز (بعد إسلامهم) في التصدي لمطامح إمارة موسكو الناشئة وفي وقت لم يمثل الروس مصدر تهديد مناظر للتهديد البيزنطي أو الصليبي.
- إمارة عثمانية الناشئة في وقت احتضار الخلافة العباسية ثم نمو الدولة العثمانية في ظل “العصر المملوكي”.
وهذه النماذج وغيرها تعاقبت على تاريخ القرون السبعة الهجرية الأولى[18] وشهدت هذه القرون –بالنظر إلى الفضاء التركي-الإيراني –العربي التاريخي المعروف الآن بأسيا الوسطى وإيران والقوقاز والمشرق العربي – أنماطًا كبرى من التفاعلات المتعاقبة نستطيع أن نوجزها فيما يلي: التفاعل الإيجابي المتبادل بين أقوام المسلمين من العرب والترك والفرس منذ الفتح الإسلامي وفي ظل قيادة العرب وفتوحهم تجاه بيزنطية. حيث أسهم فقهاء وعلماء الفضاء الإيراني التركي في الإنجاز الحضاري الإسلامي الضخم الذي تحقق، كما كان هذا الفضاء مصدر حركية ومبادرة عسكرية (السلاجقة) اضافت لقوة مركز الخلافة الإسلامية وقت التهديد الخارجي المضاد والذي تمثل في بقايا الإمبراطورية البيزنطية والإعداد للحملات الصليبية، مع انعدام مصدر تهديد مسيحي من الشرق واقتصاره على الغزوتين المغوليتين الأولى والثانية.
وعبر القرون الثلاثة الانتقالية –التي شغلها العصر المملوكي [19]، فإن الفضاء التركي-الإيراني-العربي في آسيا قد شهد أولاً (قرن 7هـ، 8هـ) تفاعلات العلاقة بين العرب والفرس والترك وبين ايلخانات المغول قبل وبعد إسلامهم وبين الروس والإمارات الصليبية في الشام وممالك البحر المتوسط الإفرنجية. وهي التفاعلات التي تحالف فيها مغول فارس (الدولة الايلخانية قبل إسلامهم) مع الصليبين في الشام وبعض الممالك الأفرنجية ومملكتي أرمينيا والكرج ضد المماليك، وفي المقابل تحالفت القبيلة الذهبية مع المماليك في مواجهة الحلف السابق. وكان دخول كل من إيلخانات فارس والقبيلة الذهبية الإسلام ضربة للمخطط الصليبي الإفرنجي لحصار المسلمين (عربًا وفرسًا وتركًا) بين أوروبا وآسيا المسيحيين. ومع الهجمة المغولية الثانية بقيادة تيمور لنك في نهاية القرن التاسع الهجري، برزت أنماط مناظرة من التفاعلات الإسلامية –الإسلامية، والإسلامية المسيحية وضح منها أيضًا عدم نجاح توظيف القوى الخارجية للصراعات البينية. فبعد توحيد تيمور لنك إمبراطورية المغول في آسيا الوسطى والقوقاز في نهاية القرن التاسع هجريًا والسيطرة على الهند وقع الصدام بين مراكز قوة ثلاثة: مغولية، تركية عثمانية وتركية مملوكية على ساحة فضاء عربي-فارسي-تركي من ناحية كما برز من جهة أخرى حرص قوى مسيحية أوروبية (إمبراطور القسطنطينية، ملك أسبانيا، ملك بريطانيا) على التحالف مع بتمور لنك في مواجهة القوتين الإسلاميتين –المملوكية والعثمانية- والتي تقود كل منهما ساحة من ساحات المواجهة مع العالم المسيحي (هجومًا ودفاعًا)، وإن كان هذا التحالف لم يتم إلا أن الهجمة المغولية الثانية كان لها أثارها طويلة الأمد على توازن القوى الإسلامية المسيحية خلال القرون التالية.
فلقد أُجهَدِت القوة المملوكية مما سهل من مهام الالتفاف الأسباني والبرتغالي من الجنوب نحو البحار الجنوبية، وبعد استرداد الأندلس، كما تأخر نمو القوة العثمانية الفاتحة في أوروبا مما أوقف موجه جديدة من الفتوح العثمانية في أوروبا لمدة نصف قرن تقريبًا، ناهيك عن الآثار المدمرة على قرارات مسلمي آسيا الوسطى والقوقاز والإيرانيين على نحو ساعد على امتداد اذرع روسيا فيما بعد، حيث تلاعبت روسيا بخانات المغول الثلاثة بعضهم ببعض حتى تمكنت روسيا القيصرية من التفوق والإعلان عن تبدل جذري في الأدوار الخارجية تجاه المنطقة في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي. وبذا تبلور مصدر تهديد خارجي جاء من الشرق وهو روسيا، في نفس وقت بداية الالتفاف الجنوبي للقوى الأوروبية الصاعدة: أسبانيا، البرتغال، هولندا.
وفي هذا الإطار تأسست الدولة الصفوية وأُعلن مولدها، مع مولد مرحلة كبرى جديدة من تطور التدخل الخارجي في العالم الإسلامي وتطور توازنات القوى الإسلامية الإسلامية.
خلاصة القول نستطيع أن نميز –باختصار بين نمطين كبيرين افرزتهما تفاعلات الفضاء العربي-الإيراني-التركي عبر ما يقرب من ثلاثة قرون (العصر المملوكي) قبل أن يتفاقم التدخل الخارجي في القرون التالية، وهما أن شرق آسيا المسلمة كان مصدرًا لتهديدات ضاربة تتجه للقلب الإسلامي في المنطقة العربية باحثة عن النفوذ والتوسع، ومن ناحية أخرى: اتجه الأوروبيون للتحالف مع هذه القوى الآسيوية (المغول) الزاحفة نحو الغرب ضد القوى الإسلامية الحاكمة للفضاء العربي وجواره التركي والإيراني (العثمانيون والمماليك). كما اتجه الأوروبيون للتحالف فيما بعد مع قوة فارسية اتجهت بنفوذها غربًا وهي الدولة الصفوية.
ثالثاً: النماذج التاريخية في مرحلة التعددية والتراجع والهجوم الخارجي
وعودة إلى الفترة منذ نهاية القرن الخامس عشر الميلادي والعاشر الهجري وحتى الآن التي تصاعدت خلالها التدخلات الخارجية ويمكن تقسيم هذه الفترة الممتدة إلى المراحل الفرعية التالية:
المرحلة الأولى: حتى نهاية القرن الثامن عشر، والثانية استغرقت القرن التاسع عشر وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى، والثالثة، تمتد حتى نهاية الحرب الباردة وتداعيات الحادي عشر من سبتمبر.
ولقد شهدت المرحلة الأولى الهجوم على أطراف العالم الإسلامي ونجاح سياسات الاسترداد الاسبانية وبداية الروسية في نفس الوقت الذي انفجرت فيه جدالات الصراع العثماني الصفوي.
وتبدأ المرحلة الثانية مع الحملة الفرنسية على مصر ومؤتمرات التوازنات الأوربية الجديدة من فيينا إلى فرساي والتي استقطعت من أوصال الامبراطورية العثمانية ودشنت الموجة الثانية من التنافس الاستعماري الحديث، في نفس الوقت الذى فشلت فيه الاصلاحات العثمانية وبدأ الضعف يدب في الدولة الصفوية وحتى سقوطها، وبذا فإن هذه المرحلة الثانية هي مرحلة بداية تقسيم الكيان المكتمل في ظل التنافس الاستعماري الذى دخلته الامبراطورية الروسية القيصرية والتي مثلت مصدر تهديد أساسي لكل من إيران والدولة العثمانية المتهاوية على حد سواء[20]. شهدت المرحلة الثالثة استكمال استعمار العالم الإسلامي وتقسيمه مع نشأة الدول الإسلامية الحديثة بحدودها الاستعمارية في ظل تدخلات خارجية في طبيعة النظم السياسية والاجتماعية (خلال الاستعمار وبعده) أو تدخلات أخرى بالوكالة (إسرائيل) وبالتحالفات والتحالفات المضادة مثلاً الولايات المتحدة وبريطانيا مع الأسرة البهلوية في مواجهة التيار القومي الثوري في المنطقة العربية، ثم تبادل الأدوار بين إيران الثورة الاسلامية وبين دول عربية من حيث التحالف مع الولايات المتحدة وعقد السلام مع إسرائيل، وفي ظل صعود لخطاب الاختلافات القومية (العربية – الفارسية) ومن ثم الاعداد من جديد ومرة أخرى لتقسيم الكيان المجزأ بالفعل[21].
ومع انتهاء القطبية الثنائية وبداية عصر الأحادية والهيمنة الأمريكية والعولمة شهدت المنطقة العودة للاحتلال العسكري من ناحية وإعادة تقسيم المجزأ من قبل في ظل صعود قوى لخطاب الاختلافات المذهبية (السنية – الشيعة) ومن ثم ظهور مشروعات إعادة تشكيل الفضاء الحضاري التركي –الإيراني العربي، وفق خطوط تقسيم مذهبية وطائفية وقومية (خطة حدود الدم) ومشروع الشرق الأوسط الكبير أو الموسع[22].
وعلى ضوء تطور السياقات الكلية وبالانتقال إلى النماذج التاريخية الممتدة يبرز التساؤل التالي:
كيف أدرك الطرفان، العرب وإيران بعضهما البعض – عبر هذا المسار التاريخي؟ هل كمصدر للتحدي أم المنافسة أم مصدر للتهديد والخطورة؟ وما هي مصادر التهديد الخارجية المشتركة لهما أو لكل منهما؟ وكيف تصرف الطرفان تجاه هذا المشترك: هل وفق نمط الموالاة حماية للذات أم ماذا؟
وبغض النظر عن حجم التدخل الخارجي وأدواته في المراحل الفرعية الثلاثة، ألم يكن للمصالح القومية المتنافسة بل والمتصارعة (بين الدول الاسلامية الحديثة ) دورها في إذكاء حسابات الخطر والتهديد المتبادل؟ ومن ثم تهيئة المجال للخارجي للتمكين من خلال توظيف هذه الورقة؟ حيث تآكلت القدرة على تحجيم الأثر السلبي للتدخل الخارجي نظراً لاستمرار التردي الداخلي.
إن استدعاء النماذج التاريخية الشارحة والمتصلة بالدائرة العربية – الايرانية – بصفة خاصة سيساعد على تقديم الإجابة على هذه الأسئلة وذلك حتى يتضح لنا ليس فقط مدى تأثير الخارجي، ولكن تأثير العامل المتهيئ – أي تجزئة الكيان الحضاري الواحد الممتد المكونة من عدة أقوام إلى دول حديثة متصارعة على أسس قومية أو مذهبية أو سياسية.
وفيما يلي نقدم رصدًا لخريطة بعض النماذج التاريخية ذات الدلالة عبر هذه المراحل الثلاث:
ففي المرحلة الأولى [23]: تبلورت التعددية السياسية في ظل تنافس قوي عثماني -صفوي على ساحة الفضاء العربي-التركي-الإيراني، الآسيوي بصفة أساسية، استغرق ما يناهز الثلاثة قرون (1525- 1774): ابتداءً من تأسيس الصفوية في وقت وصلت فيه القوة العثمانية إلى مرتبة القوة العالمية الأساسية، وبدأت فيه الهجمة الأوروبية الثانية على العالم الإسلامي وصولاً إلى بداية المسألة الشرقية ومولد نظام جديد للهيمنة الأوروبية في ظل بداية الهجوم المباشر على العالم الإسلامي. وكانت إيران الصفوية ثم القاجارية أحد ساحاته الأساسية (تهديد روسيا القيصرية) كما كانت المنطقة العربية سواء في الشام أو شمال أفريقيا ساحة أخرى له (أسبانيا والبرتغال، ثم فرنسا وبريطانيا). وساهم الصراع الصفوي -العثماني في تآكل قدرة الطرفين على حماية مصالح الأمة وحمايتها في مواجهة هذه الهجمة.
وهنا يمكن أن نرصد المجموعتين التاليتين من النماذج والأنماط:
1- الحروب العثمانية -الصفوية وتحالف الصفويين مع الأوروبيين ضد العثمانية، وعواقب هذه الحروب بالنسبة للدور العثماني في أوروبا والدور الإيراني في آسيا: الفشل في استمرار الفتح في أوروبا والفشل في حماية آسيا الوسطى والقوقاز وإيران من النفوذ الروسي ثم البريطاني.
وفي حين كانت العراق ساحة الصراع بين العثمانيين والصفويين حتى القرن 17، فإن البحث في دوافع وأهداف جولات الحروب والتصالح بين الطرفين لتبين كيف أن العوامل الاستراتيجية والاقتصادية قد لعبت دورها إلى جانب العوامل المذهبية، وأن القوى الأوروبية (الأسبان) وظفت هذا الصراع (اتصالات الشاه الصفوي بالأسبان) لتخفيف الضغط العثماني على الهاسبورج في أوروبا. وفي نفس الوقت الذي اقترن فيه الصراع العثماني الصفوي بالتوجه العثماني نحو الجنوب وضم المنطقة العربية، فلقد كان ذلك التوسع استجابة لمواجهة التهديدات البرتغالية للسواحل العربية والإسلامية على المحيط الهندي والبحر الأحمر والخليج العربي، وكذلك استجابة للتهديدات الأسبانية لسواحل المتوسط والمحيط الأطلنطي (القرنين السادس عشر والسابع عشر).
وبعد أن ظل النفوذ السياسي الأوروبي ضئيلاً في منطقة الشرق الإسلامي، حيث كانت القوى المغولية والعثمانية والفارسية مازالت قوية، إلا أنه مع ازدياد تآكل هذه القوى عبر القرن الثامن عشر تزايد النفوذ السياسي الأوروبي إلى جانب النفوذ التجاري. وكان الصراع العثماني الصفوي- كما أجمعت معظم التحليلات (مهما اختلفت في تقدير وزن العامل المذهبي في هذا الصراع) –في صميم أسباب هذا التآكل مما هدد الأراضي الإيرانية والتركية والعربية على حد سواء بهجوم أوروبي مباشر.
2- أصداء الحروب العثمانية الصفوية على بداية تخلخل المركزية العثمانية على الولايات العربية العثمانية من ناحية، وتزايد التهديدات الروسية لآسيا الوسطى والقوقاز من ناحية أخرى (خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر).
فمن ناحية الشام والجزيرة والخليج:
فإذا كانت الحركات الاستقلالية في الشام (المعنييون ثم الشهابيون والدروز في لبنان، وظاهر العمر والجزار في فلسطين، وحركة العظم في دمشق) قد تعاونت مع قوى أوروبية، ضد المركزية العثمانية، فلقد كان للصراع الصفوي العثماني ظلاله على مآل هذه الحركات؛ حيث كان هذا التعاون يقلق السلطة العثمانية ويدفعها للتدخل وخاصة في الأحوال ذات الصلة بالصراع مع الصفويين. فمثلاً ارتبط سقوط فخر الدين المعني (1613م) برغبة السلطان العثماني في تأمين ظهره خلال انفجار القتال على الجبهة الصفوية، أو نظرًا للاتصالات بين المعنيين والصفويين والقوى الأوروبية. وبالمثل فإن سقوط آل العظم في سوريا (1730) ارتبط بعواقب الهزيمة العثمانية على الجبهة الفارسية حينئذ.
ومن ناحية ثانية فإن النزاع الصفوي العثماني قد انعكس أيضًا على الجزيرة العربية والخليج، في ظل تطور توازن القوى الأوروبية (البرتغالي- البريطاني- الهولندي ثم البريطاني- الفرنسي) حول المنطقة. فمع استمرار التوجهات الصفوية والعثمانية نحو الخليج، تشككت إمارات هذه المنطقة تجاههما وحرصت على محاولة الاستقلال بين الصفويين والعثمانيين مستعينين في ذلك بالقوى الأوروبية. فمثلاً ساند البريطانيون الزيديين في اليمن ضد العثمانيين وأضحت التدخلات الأوروبية هي الأساس في هذه المنطقة بعد انهيار الدولة الصفوية وانشغال العثمانيين بهزائمهم على الساحات الأوروبية منذ نهاية قرن الثامن عشر الميلادي.
ومن ناحية آسيا الوسطى والقوقاز:
فكان التوسع الروسي على حساب ورثة القبيلة الذهبية في ظل مراقبة عثمانية وعجز الأوزبك عن المقاومة مع تحالف ضمني صفوي -روسي (1552- 1605). ثم أضحى القوقاز ساحة للصراع الروسي-العثماني-الصفوي، وامتد التهديد الروسي لشمال الدولة الصفوية (1605- 1774) مهددًا أراضيها في ظل تصاعد الصراع العثماني الصفوي.
المرحلة الثانية[24]: (1774-1925): تصفية الدور العثماني العالمي ونهاية الدولة الصفوية (1722) ثم نشأة الدولة القاجارية (1795)، في ظل توالي موجات الاستعمار على العالم الإسلامي لاقتسامه، في إطار نظام جديد لتوازنات القوى الأوروبية.
ولم يعد بمقدور العثمانيين أو الصفويين (ثم القاجاربين) توظيف هذه التوازنات في صراع كل منهما ضد الآخر، حتى أدت التدخلات الأوروبية إلى تصفية كل من الكيانين عقب تسويات الحرب العالمية الأولى.
وهنا نستطيع أن نوجز النماذج والأنماط التالية:
- تزايد النقل عن الغرب والتأثر بنموذجه السياسي والحضاري: وإذا كانت سياسة الإصلاحات العثمانية مؤشرًا على ذلك، فإن الدولة القاجارية مثلت تطورًا في تاريخ فارس؛ حيث تحول النظام إلى ملكية دستورية ذات حكومة تمثيلية برلمانية. ولقد تعرضت كلٌ من الدولتين لمشاكل داخلية فضلاً عن الضغوط الخارجية التي أحاطت بهما في ظل شبكة من التفاعلات العثمانية –الفارسية الأوروبية ذات الدلالة بالنسبة لمستقبل العالم الإسلامي، في محاوره الجغرافية المختلفة.
وإذا كانت محاولات الإصلاح في الدولة لتجديد القوة الذاتية (بالنقل عن الغرب) لم تحقق ثمارها، فقد كان لها آثارها على طبيعة نموذج نظام كل من الدولتين (وخاصة من حيث إشكالية العلاقة بين الديني، والسياسي) من جهة، وعلى تطور التحالفات والتحالفات المضادة بين الدولتين وبين القوى الأوروبية من جهة أخرى، مما يدفع للتساؤل عن قدر مسئولية الصراع بين العثمانيين والقاجاريين، وبينهم وبين الأوروبيين عن الفشل في حماية أرجاء العالم الإسلامي –بجناحيه العربي و التركي- الفارسي من الاستعمار التقليدي خلال القرن التاسع عشر الميلادي.
- تحول الاهتمام العثماني نحو البلقان والولايات العربية (جناحًا طور المسألة الشرقية في القرن التاسع عشر) في ظل تكالب استعماري عليهما وتنامي الحركات الاستقلالية في الولايات العربية والحركات الانفصالية في البلقان.
- انخفاض حدة الصراع العثماني القاجاري طوال القرن التاسع عشر الميلادي، مع عدم قدرة الطرفين على التحالف في مواجهة التهديدين الروسي والبريطاني المشترك سواء في وسط آسيا والقوقاز أو في العراق والشام والجزيرة والخليج.
فبقدر ما استطاعت فارس –في البداية- أن توظف التنافسات البريطانية-البرتغالية ثم البريطانية -الفرنسية لخدمة مصالحها التجارية ولمناهضة الدولة العثمانية، بقدر ما أفاد هذا التوظيف اختراق النفوذ الأجنبي للمنطقة. مما أثر سلبًا على العلاقات الإيرانية في الخليج (في ظل التنافس البريطاني-البرتغالي) وفي القوقاز (في إطار الصراع العثماني-الروسي) وفي آسيا الوسطى (في إطار الصراع الروسي- البريطاني).
- ومن ثم تحققت بالتدريج القفزة الروسية من احتلال القرم إلى احتلال القوقاز وآسيا الوسطى، في ظل نمو المصالح البريطانية في الهند بعد سقوط الدولة المغولية الإسلامية، مما صعد من التهديد الروسي والبريطاني لكل من القاجارية والعثمانية، وحتى انتصرت روسيا على كل من الدولتين على التوالي في حرب 1826، 1828م.
وكانت المعاهدة التي عقدت بين الدولتين العثمانية والقاجارية في أرضروم عام 1838 خير شاهد على النهاية التي انتهى إليها العالم الإسلامي بعد هذه الحروب، إذ أصرت كلٌ من روسيا وانجلترا على التواجد في المؤتمر، وتمت المفاوضات بين إيران والدولة العثمانية بتوجيه منهما، بينما لم تكن أسباب النزاع تستوجب هذا التدويل للمسألة ولم تختلف مواد المعاهدة المعقودة عما سبقها من معاهدات.
وبمعنى أدق: أصبح الصدام بين الصفوية الشيعية والعثمانية السنية يهم كل الاهتمام الدولتين: الإنجليزية والروسية، وكانت كلٌ منهما ترى أن بقاء الوضع الراهن -من حيث الحفاظ على قوة محدودة لكل منهما تحول دون تدهورها الكامل- خير من التورط في عمليات اقتسام لهما تؤدي إلى ارتباكات دولية معقدة، وكانت النتيجة المحتومة هي وقوع الدولتين في براثن النفوذ الخارجي.
وأخيرًا وقعت الدولة القاجارية فريسة للاتفاق الروسي البيريطاني1907 لاقتسام مناطق النفوذ في آسيا الوسطى وإيران، في نفس الوقت الذي كانت تجري اتفاقات أخرى حول المنطقة العربية (الاتفاق الودي 1904، ثم سايكس بيكو 1916…) ولقد كانت ورقة القومية ورقة أساسية في عمليات إعادة التشكيل والتقسيم في تسويات الحرب العالمية الأولى على نحو خلق خريطة جديدة للفضاء الحضاري الإيراني –التركي- العربي، بعد تصفية الخلافة وسقوط الدولة القاجارية وتعرضها بدورها –مثل أراضي المركز العثماني ذاته- لمخاطر التقسيم.
المرحلة الثالثة[25]: تستغرق القرن العشرين وتبدأ مع إرهاصات تغير توازن القوى المتعدد التقليدي في فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، وعلى ضوء عواقب وتداعيات تسويات كل منهما بالنسبة لإعادة تقسيم الدول والشعوب الإسلامية بين حدود جديدة، وصولاً إلى توازن القوى الثنائي القطبية وحالة الحرب الباردة والصراع الأيديولوجي وحتى بداية نظام الأحادية الأمريكية في ظل تصاعد استراتيجية المحافظين الجدد تجاه العالم الإسلامي. وفي نفس الوقت الذي انتهت فيه الخلافة العثمانية وتأسست الدولة البهلوية في إيران اكتمل اقتسام واستعمار العالم الإسلامي (الشام) كما استمرت حركات المقاومة للاستعمار وجهود الإصلاحات الداخلية.
ومن ناحية أخرى وبعد الاستقلال السياسي وفي ظل ميكاينزمات الاستعمار الجديد شهد العالم الإسلامي استمرار الاختلافات والانقسامات –سواء السياسية أو الثقافية والمجتمعية- والتي لعبت ميكاينزمات الاستعمار دورًا أساسيًا في تكريسها مما دعم أيضًا من وضع التبعية في النظام الدولي المعاصر.
ومن هذا الإطار الكلي يمكن رصد النماذج والأنماط التالية عن أزمات العرب وإيران الداخلية وعلى صعيد العلاقات بينهما:
- مخاطر تقسيم إيران والدول العربية وتركيا خلال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية: تهديد وحدة الأراضي بعد تهديد الاستعمار.
- التدخلات في النظم الداخلية وأنماطها السياسية والثقافية: تصاعد التغريب في ظل الاستعمار العسكري ثم الاستعمار الجديد والحروب السياسية على القوى المناوئة للنظم المتحالفة مع القوى الأوربية على سبيل المثال: انقلاب القصر في إيران خلال الحرب العالمية الثانية، اجهاض حركة مصدق .
- تداعيات الصراع العربي –الإسرائيلي على خريطة القوى السياسية داخل كل من إيران والدول العربية وتبادل الأدوار بين بعض النظم العربية وإيران من حيث الموقف من استراتيجية المقاومة أو السلام. وهنا نشير إلى شبكة التحالفات الإيرانية قبل الثورة الإسلامية مع القوى الكبرى المتوالية (بريطانيا ثم الولايات المتحدة) في مقابل شبكة تحالفات عربية مضادة مع نفس القوى أو الاتحاد السوفيتي، ثم تبادل الطرفين الأدوار بعد الثورة الإيرانية الإسلامية وبعد عملية التسوية السلمية مع إسرائيل وفي ظل الاستراتيجية الأمريكية لإعادة تشكيل الشرق الأوسط. وهي أدوار متبادلة سواء في مواجهة القوى الخارجية المهددة للمنطقة أو تجاه المشروع الحضاري للمنطقة، أو تجاه قيادة العالم الإسلامي.
- الحروب الإقليمية المباشرة مثل الحرب العراقية الإيرانية، ومواقف إيران والدول العربية من حروب إقليمية -عالمية تالية: تحرير الكويت، احتلال العراق، احتلال أفغانستان وجميعها حروب كان محورها استهداف قوى إقليمية لمناوئة للهيمنة الأمريكية والصهيونية، ومن هنا جاءت سياسة الحصار المزدوج لكل من العراق وإيران، وإدارة الحرب بينهما في الثمانينيات، وحتى احتلال العراق، وحصار إيران واحتوائها وتقييد تسليحها وتشوية دورها الإقليمي وتحالفاتها في المنطقة.
- التدخلات الخارجية في إدارة الصراع العربي -الإسرائيلي، وأمن الخليج، وتسليح دول المنطقة، وصراعات الحدود..؛ ومن ثم فإن هذه القضايا أضحت محكًا لأزمات متكررة في المنطقة تصطدم حولها مواقف ومصالح الدول العربية وإيران انعكاسًا لشبكة تحالفاتهم المتضادة مع القوى الخارجية. وهي التحالفات التي تتبادل على صعيدها إيران والعرب أدوار التحالف مع القوة الكبرى والساعية للهيمنة على المنطقة والسيطرة عليها (الفارق بين نموذج إيران الشاه قبل الثورة، ونموذج مصر منذ معاهدة السلام والاعتماد على الدور الأمريكي).
- بعد الأزمات التقليدية الناجمة عن حروب إقليمية مباشرة أو بالوكالة تبلورت –منذ 1991 وعلى نحو متصاعد تدريجيًا- سيناريوهات إعادة تقسيم المنطقة باستخدام الورقة المذهبية والقومية، وذلك تكرارًا لسيناريو الحرب العالمية الأولى وتسوياتها، حيث يعاد تقسيم المجزأ من قبل بل وإعادة احتلاله عسكريًا، وعلى عكس سيناريو الحرب الباردة والصراع الأيديولوجي العالمي فلم تعد خطوط التحالفات والتحالفات المضادة خطوطًا أيديولوجية ولكن حضارية ودينية ومذهبية وقومية.
- اتساع أجندة القضايا التي تديرها أساسًا القوى الخارجية وتتدخل من خلالها. فلم تعد مقصورة على قضايا الحرب الباردة الشرق أوسطية أو العربية أو العالمية، وفي قلبها الصراع مع إسرائيل، ولكن اتسعت وتجزأت في نفس الوقت هذه الأجندة لتُصبح هناك قضايا النظم الفرعية (مثل أمن الخليج وتنازعه الأولوية مع الصراع العربي الإسرائيلي).
ثم ظهرت أنماط جديدة من القضايا مثل: التحول الديمقراطي، وحقوق الإنسان، والحريات الدينية، و”الإرهاب الإسلامي”، على حساب قضايا التخلف والتجزئة والاحتلال العسكري والاستيطان الإسرائيلي. وجميعها قضايا تقفز أبعادها الدينية والثقافية مما يبين أن أساليب التدخل التقليدية قد ارتدت أثوابًا جديدة وتظل إحدى سماتها التلاعب بالقوى الإقليمية المتنافسة، وأحد أوراق التلاعب ورقة المذهبية والقومية.
- اتساع نطاق الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي ليتخطى نطاق ما يسمى النظام الإقليمي العربي ليصل إلى إيران وأفغانستان وباكستان من ناحية وإلى قلب أفريقيا الزنجية. من ناحية أخرى، وهما الجانبان اللذان صارا في قلب التفاعلات العربية، ليتبلور ما يُسمى نظام الشرق الأوسط الكبير. وإن كان البعض يتحفظ عليه باعتبار أنه مصطلح من صك/ ابتداع الاستراتيجية الأمريكية -إلا أنه أضحى ذو دلالة مهمة وكبيرة؛ حيث بين كيف أن إسرائيل –بمساعدة الغرب- لم تكتفِ بتدعيم استيطانها في فلسطين ونشر نفوذها السياسي على ما كان يسمى دول المواجهة ولكن امتدت سياساتها الهجومية إلى ما هو أوسع من دول الطوق إلى إيران وتركيا وقلب أفريقيا … وهكذا، بل وإعادة توظيف ورقة الصراع بين القوميات والمذاهب على نحو جديد. ولهذا لم تعد أجندة قضايا المنطقة تتمحور -ولو شكلاً- حول إدارة الصراع العربي- الإسرائيل فقط، بل أضحت تدور حول عواقب وتداعيات نضج التحالف الأمريكي-الصهيوني، والذي لا يقتصر هدفه على العرب فقط ولكن يمتد إلى الدائرة الإسلامية برمتها، وهكذا كان دائمًا دأب التدخلات الخارجية، تتخذ رأس حربة ثم توسع نطاقها.
ولذا لا عجب أن يبرز كيف أن اتساع بنود الصراعات الإقليمية لأجندة التدخلات الخارجية، على النحو الموضح سابقًا، قد أحاط به أو اقترن به بنود حضارية بالمعنى الواسع هي أيضًا في صميم إدارة الصراعات الإقليمية بالتدخلات الخارجية، من قبيل: حقوق الإنسان، التعددية الثقافية والسياسية، الحريات الدينية، حقوق الأقليات القومية وحقوق الطوائف والمذاهب، فالأخطر في هذا أن هذه البنود لا تقتصر على الداخل أو البيني العربي أو الإيراني أو التركي ولكن تمتد إلى ما هو متصل بالبيني العربي—التركي، والبيني العربي-الإيراني.
والبيني التركي-الإيراني حيث إن ورقة القومية والمذهبية والطائفية تشهد ازدهار استخدامها في الاستراتيجية الأمريكية-الصهيونية لإعادة تشكيل ليس المنطقة العربية ولكن الفضاء العربي-التركي-الإيراني- الملاوي- الزنجي الإسلامي برمته، وليست خريطة الدم المعلن[26] عنها أخيرًا إلا الدليل الثاني بعد خطة برنادر لويس[27] حيث إن المطلوب هو تقسيم المقسم بعد أن تم خلال قرنين سابقين تقسيم المكتمل. وهذا التقسيم الجديد يخدم مصالح رأسمالية عالمية لم تعد تنظر للعالم إلا بمعيار ما يخدم الاستثمارات والمصالح التي اتخذتها معيارًا لتقسيم الدول[28].
- الأمن الحضاري للأمة برمتها ولأركانها: العرب، الترك، الفرس، الأكراد، الملاو، الزنوج، في قلب لتهديد الأمن القومي للدول الإسلامية الحديثة، وذلك في ظل عملية إعادة التشكيل الجارية التي تشهد درجة من التدخل الخارجي –غير مسبوقة- من حيث كثافتها وامتداد نطاقاته وتعدد أدواته، وذلك في وقت لا يوجد قوة إقليمية عربية قادرة أو راغبة في قيادة عملية المقاومة للتهديد الخارجي، ليس لما تبقَ من أراضٍ وثروة فقط ولكن لم تبقَ من منظومة قيم الحضارة الإسلامية. وفي المقابل فإن الجوار الحضاري التركي، والجوار الحضاري الإيراني، والجوار –البعيد- المالاوي- يشهد منذ أكثر من عقدين تجارب قوى صاعدة تقدم نماذج إسلامية متنوعة وتدير عمليات المقاومة باستراتيجيات متعددة. والخطورة –وكما حدثنا التاريخ- فإن تحالفات القوى الخارجية مع الدول العربية تستهدف ضرب أو احتواء أو تصفية نموذج المقاومة الإيراني وشبكة تحالفاته مع العرب (سوريا- حزب الله- حماس) كما تستهدف هذه التحالفات –من ناحية أخرى- عدم دعم جسور العلاقة مع النموذج التركي تحت تأثير التحالف الإسرائيلي-التركي، وتشويه ما تبقى من جسور مع الأفارقة المسلمين. (تحت تأثير دارفور)
ولذا فإن طرح قضايا الهوية والثقافة والحضارة ليس ترفًا بالمقارنة بقضايا وأزمات القوة الصلدة التي يعاني منها المسلمون، بل إنها محدد أساس من محددات تجديد القدرة على مقاومة الاحتلال الجديد وتغريب العولمة. ولا عجب أن كانت العلاقات الدولية –من منظور إسلامي- هي علاقات غير علمانية بالأساس ولكن حضارية. وإذا كان الغرب، منذ وستفاليا- قد عَلمَنَ العلاقات الدولية كما عَلمنَ من قبل الدول القومية، فلقد كانت العلمنة هذه هي الرداء الشكلي الذي أحاط بجولات الاستعمار الأولى والثانية والتي وأن أدعت حمل رسالة التمدين والتحضر لشعوب العالم، إلا أنها اتسمت بالدموية والعنصرية والاستغلال، ليس المادي فقط ولكن القيمي والثقافي. ولذا فإذا استدعت القوى الغربية الآن رداء الثقافي القيمي الحضاري لتدخلاتها الراهنة، فإنه استدعاء دموي تجزئي يضيف حلقة أخرى إلى حلقات التدخلات الخارجية في الفضاء العربي-التركي- الإيراني للشعوب والدول الإسلامية على مر تاريخ الإسلام.
خلاصة القول في هذه المرحلة: إنه يمكن أن نضع عنوانًا لخبرة القرن العشرين “من الاحتلال واكتمال الاقتسام بين دول قومية حديثة إلى التجزئة باسم حقوق الإنسان”. ويمكن إيجاز خصائصها في الآتي:
- أزمات حركات التحرر الوطن وأزمات تأسيس الدول القومية الحديثة وإدارتها بعد الاستقلال (علاقة المعارضة بالحكم، نمط التنمية وتغير المجتمعات، منظومات القيم) جميعها تدخل فيها الخارج بدور أساس.
- تفاوت أوضاع القوى الأركان التي قادت الأمة على التوالي: مصر، تركيا، إيران.
وحدث التغير في هذه الأوضاع وفق أنماط مختلفة من النماذج السياسية والاقتصادية والاجتماعية أضافت إلى أعباء التقسيم، حيث اعتمدت أيضًا بدرجات كبيرة على الخارج.
- الصراعات والأزمات الإقليمية هي ميراث استعماري بالأساس والقليل منها هو تعبير حقيقي عن تنافسات على قيادة العالم الإسلامي، والبعض منها تعبير عن محاولة البعض التصدي لمشروعات الهيمنة الخارجية.
- عدم وجود قوة قائدة للعالم الإسلامي ولكن قوى إقليمية تتنازعها تحالفات مع قوى عالمية. بل لم يعد تعريفٍ هذا العالم تقترن بهذه الصفة الجامعة، ولكن شيوع تقسيمات جغرافية وقومية ونسبة إلى موضعها من القوى العالمية (الشرق الأدنى، الشرق الأوسط…).
- علاقات بينية محددة لا تقارن بالعلاقات مع مراكز القوة العالمية، وهيمنة النظام الرأسمالي العالمي ليس على هذه العلاقات في شقها الاقتصادي فقط ولكن الثقافي أيضًا، وفي امتداداتها الداخلية الوطنية، وعلى نحو يؤدي إلى تفكيك نواة المجتمعات الإسلامية ألا وهي الأسر، بل وتفكيك المواطن الواحد كمدخل لتفكيك الوطن بعد أن جرى تفكيك الأمة.
- من الاحتلال إلى التجزئة: فبعد تقسيم الأمة واستعمارها ثم إعادة تشكيلها في دول قومية حديثة جاء التدخل لتجزئة هذه الدول القومية تحت مبرر فشلها في تحقيق المواطنة والديمقراطية والحرية، ومن ثم أضحى تنوع الأمس ومصدر وركيزة القوة الحضارية مدخلاً للتدخل الخارجي والتجزأة.
وأخيرًا ما آفاق المستقبل على ضوء هذه الخبرة التاريخية الممتدة التي مرت بها الأمة ولعب فيها العرب والفرس دورهم كجزأ مندمج منها أو كأركان متنافسة على قيادة هذه الأمة، وأخيرًا كأوراق في لعبة التدخل الخارجي؟ حيث يبدو كل طرف الآن كأنه مصدر التهديد والخطر على الطرف الآخر، سواء كان هذا الطرف هو الذي يتصدى لمقاومة مشروع الهيمنة الخارجية أو المتحالف معها أو على الأقل غير الراغب في هذه المقاومة. ولكن يظل لجانب الحفاظ على المصالح الوطنية على حساب مصالح الأمة مسئول عن مصداقية هذا الشعور المتبادل بالخطر من عدمه.
وكما كانت منطقة العراق وديار بكر والشام منطقة الصدام المباشر بين الصفويين والعثمانيين، فهي تعود الآن، ولكن في ظل سيناريو جديد للتدخلات الخارجية –محكا إضافيًا- لكيفية تفعيل الرابطة العقدية لخدمة المصالح القومية المتنوعة وحماية حقوق شعوب الأمة في مجموعها. سواء كانوا عربًا أو فرسًا أو تركًا أو أكرادًا أو ..إلخ. كأساس ومنطلق للتصدي لمشروع الهيمنة الأمريكية الصهيونية، بعد أن واجهت هذه الشعوب مشروعات تدخل وهيمنة سابقة ابتداءً من البيزنطيين والصليبين، والاستعمار الأوروبي، والحرب الباردة..
الحمد لله
القاهرة، أكتوبر 2007
_____________________
* نُشرت الدراسة تحت عنوان ” التدخلات الخارجية ومسيرة أزمات العلاقات العربية – الإيرانية: التجربة التاريخية وآفاق المستقبل” في: د. نادية محمود مصطفى، د. باكينام الشرقاوي (تنسيق علمي وإشراف)، أسامة أحمد مجاهد (تحرير ومراجعة)، إيران والعرب: المصالح القومية وتدخلات الخارج (رؤى مصرية وإيرانية)، القاهرة، مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات: جامعة القاهرة، 2009.
وأعيد نشرها في : د.نادية مصطفى، العلاقات الدولية في التاريخ الإسلامي: منظور حضاري مقارن، (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، القاهرة: دار البشير للثقافة والعلوم، 2015) الجزء الأول.
[1] حول جميع هذه القضايا المنهاجية وكيفية الاقتراب منها لعلاج تحيزات توظيف التاريخ في دراسة العلاقات الدولية، وهى التحيزات الغربية التي تسقط عمدًا أو سهوًا جزئيًا أو كليًا التاريخ الإسلامي من جهود التنظير للعلاقات الدولية، وخاصة الدراسات النظمية، وحول أبعاد إطار نظري لكيفية توظيف التاريخ الإسلامي في دراسة تطور النظام الدولي، ولكن من بؤرة تطور وضع العالم الإسلامي على صعيده، وموضع قضية الوحدة وقضية الجهاد من هذا الإطار النظري، حول كل هذه القضايا المنهاجية المتصلة بموضع التاريخ من التنظير للعلاقات الدولية من منظور إسلامي، انظر:
– د. نادية محمود مصطفى: مدخل منهاجي لدراسة تطور وضع العالم الإسلامي في النظام الدولي (في) د. نادية محمود مصطفى (إشراف وتحرير): مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 1996. الجزء السابع، وانظر موجزاً لهذا العمل وغيره من أجزاء المشروع، (في) د. نادية محمود مصطفى، د.سيف الدين عبد الفتاح (محرران)، مركز البحوث والدراسات السياسية، مركز الحضارة للدراسات السياسية، القاهرة،2000.
استنادًا إلى المرجع السابق أيضاً، وإضافة إلى خبرة البحث والتدريس المقارن في منظورات علم العلاقات الدولية وفي القضايا الدولية الإسلامية المعاصرة (بامتداداتها التاريخية) (1996-2006) انظر: د.نادية محمود مصطفى: التاريخ ودراسة النظام الدولي: رؤية مقارنة: بحث مقدم إلى الندوة المصرية -الفرنسية التاسعة: العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية: الآفاق والتوقعات، مركز البحوث والدراسات السياسية –كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2000 (غير منشورة).
– د. نادية محمود مصطفى: إشكاليات البحث والتدريس في العلاقات الدولية من منظور حضاري (في) د. عبد الوهاب المسيري (محور): حوار الحضارات ومسارات متنوعة للمعرفة، أعمال المؤتمر الدولي الثاني للتحيز بالتعاون بين برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات (جامعة القاهرة)، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، يناير 2007(تحت الطبع).
و(في): أحمد فؤاد باشا وآخرون، المنهجية الإسلامية (الجزء الثاني)، مركز الدراسات المعرفية، دار السلام، القاهرة، 2010.
[2] انظر حول مفهوم الأمة: د.منى أبو الفضل: الأمة القطب، دار الشروق الدولية، القاهرة، القاهرة، 2005.
د. أماني صالح: توظيف المفاهيم الحضارية في التحليل السياسي: الأمة كمستوى للتحليل في العلاقات الدولية (في) د.نادية مصطفى (تقديم): التأصيل النظري للدراسات الحضارية، إعداد وتنسيق علمي: د.نادية محمود مصطفى ود.منى أبو الفضل، جامعة القاهرة: برنامج حوار الحضارات (2003- 2005)، دار الفكر، دمشق، 2008. (سبعة أجزاء)
– د. نادية محمود مصطفى، د. سيف الدين عد الفتاح: المقدمة التحريرية للعدد الثاني من أمتي في العالم (العلاقات الإسلامية – الإسلامية البينية)، مركز الحضارة للدراسات السياسية، القاهرة، 2000.
– د.السيد عمر: حول مفهوم الأمة في قرن: نقد تراكمي مقارن، في: الكتاب الأول: (الماهية، المكانة، الإمكانية)، الأمة في قرن: عدد خاص من حولية “أمتي في العالم”، مركز الحضارة للدراسات السياسية، القاهرة، 2000- 2001، ص 61- 130.
[3] انظر حالة مراجعة العلم في: د.نادية محمود مصطفى: عملية بناء منظور إسلامي للعلاقات الدولية: إشكاليات البحث والتدريس (في) د.نادية محمود مصطفى، د.سيف الدين عبد الفتاح (محرران): المنهاجية =الإسلامية في العلوم الاجتماعية: العلوم السياسية نموذجًا، مركز الحضارة للدراسات السياسية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 2002.
و(في): أحمد فؤاد باشا وآخرون، المنهجية الإسلامية (الجزء الثاني)، مركز الدراسات المعرفية، دار السلام، القاهرة، 2010.
[4] انظر رؤية تاريخية مختصرة للعلاقة بين وجهي العملة في:
– د. نادية محمود مصطفى: خبرة العصر المملوكي: من تصفية الوجود الصليبي إلى بداية الهجمة الأوروبية الثانية، الجزء العاشر، د.نادية محمود مصطفى (إشراف وتحرير): مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، مرجع سابق.
[5] انظر: مناقشة هذه الإشكالية في مقدمة العدد الثاني من حولية أمتي في العالم، مرجع سابق.
[6] د. نادية محمود مصطفى: مدخل منهاجي …، مرجع سابق.
[7] د.سيف الدين عبد الفتاح: مدخل القيم: إطار مرجعي لدراسة العلاقات الدولية في الإسلام، (في) د. نادية محمود مصطفى (إشراف وتحرير): مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، مرجع سابق. الجزء الثاني
[8]] ) انظر في هذه التفسيرات المقارنة: د. نادية محمود مصطفى، مدخل منهاجي …مرجع سابق.
[9] انظر عرضًا مقارنًا لهذه المنظورات في د.محمد السيد سليم: تطور العلاقات الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين، قسم العلوم السياسية، جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2002.
ويجدر الإشارة إلى ان هذا العرض المقارن وإن بدأ بتسجيل تحيز هذه المنظورات للخبرات الأوربية والغربية والتي أسقطت خبرات أخرى، إلا أنه عند تحديد الإطار النظري لدراسة تطور السياسات الدولية عبر قرنين، لم يعالج هذه التحيزات وسقط في براثنها.
في حين أن جهود أخرى – اجتهدت لعلاج هذه التحيزات تجاه التاريخ الإسلامي بصفة عامة، وتواريخ بعض شعوبه ومناطقه، انظر:
– د. نادية محمود مصطفى: مدخل منهاجي …، مرجع سابق.
– د. ودودة بدران: وضع الدول الإسلامية في النظام الدولي في أعقاب سقوط الخلافة العثمانية في (1924-1991) (في) د. نادية محمود مصطفى (إشراف وتحرير): مرجع سابق، الجزء الثاني عشر.
– وانظر: أيضًا دراسات د.نادية محمود مصطفى، حول الدولة العثمانية وآسيا الوسطى والقوقاز، والبلقان:
– د.نادية محمود مصطفى: الدولة العثمانية في دراسات التاريخ الإسلامي والنظام الدولي (في) د.عبد الوهاب المسيري (محرر)، إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد، أعمال الندوة التي نظمها المعهد العالمي للفكر الإسلامي في واشنطن بالتعاون مع نقابة المهندسين، القاهرة في 19- 21 فبراير 1992، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 1994.
– د. نادية محمود مصطفى: آسيا الوسطى والقوقاز بين القوى الإسلامية الكبرى وروسيا، أنماط ومحددات التطور التاريخي للتفاعلات الدولية، إطار مقترح للتحليل السياسي للتاريخ الإسلامي (في): د.مصطفى علوي (محرر): الوطن العربي وكومنولث الدول المستقلة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1994.
– د.نادية مصطفى: البوسنة والهرسك، من إعلان الاستقلال وحتى فرض التقسيم (مارس92-يولية93)، نجاح العدوان المسلح في فرض الأمر الواقع أمام أنظار النظام العالمي الجديد، (في): تقرير الأمة في عام (1993م- 1413هـ)، مركز الدراسات الحضارية، القاهرة، 1994.
– د.نادية مصطفى: كوسوفا بين التاريخ والأزمة الراهنة، حولية أمتي في العالم (1998)، مركز الحضارة للدراسات السياسية، القاهرة، 1999.
[10] انظر بحوث الجزء الخامس، من موسوعة الأمة في قرن (6 أجزاء) تحت عنوان الأقوام والأعراق والملل في عالم متداخل، والموسوعة من إعداد مركز الحضارة للدراسات السياسية، القاهرة، دار الشروق الدولية، 2001-2002.
[11] د.سيف الدين عبد الفتاح: الأمة الإسلامية وعواقب الدولة القومية، حولية أمتي في العالم، العدد الثاني (1990)، مركز الحضارة للدراسات السياسية، القاهرة، 2000.
[12] انظر رؤية للقيم من منظور إسلامي تنقد حال دراسة القيم وترسم إطار مرجعي (في): د.سيف الدين عبد الفتاح: القيم مدخل منهاجي، مرجع سابق.
[13] هذه الدراسة تقدمها خمسة أجزاء من مشروع العلاقات الدولية في الإسلام تناولت العصر الأموي والعباسي (من إعداد د.علا عبد العزيز) والمملوكي والعثماني (من إعداد أ.د.نادية محمود مصطفى) والحديث (من إعداد أ.د.ودودة بدران).
وحول نتائج تحليل هذه الأجزاء الخمسة انظر: د.ودودة بدران: وضع الدول الإسلامية…، مرجع سابق.
[14] انظر (في): د. نادية محمود مصطفى، د. سيف الدين عبد الفتاح (تحرير): مقدمة العدد الثاني من حولية أمتي في العالم (العلاقات الإسلامية – الإسلامية)، مرجع سابق، ص14-23.
[15] طارق البشري: تقديم العدد الثاني من حولية أمتي في العالم، المرجع السابق، ص9.
[16] انظر د. نادية محمود مصطفى: العصر العثماني ..، مرجع سابق.
[17] د.نادية محمود مصطفى: العصر المملوكي، مرجع سابق.
– د.نادية محمود مصطفى: العصر العثماني، مرجع سابق.
[18]] ) انظر تفاصيل: د.علا عبد العزيز: العصر الأموي …، مرجع سابق (الفصل الثاني).
– د. علا عبد العزيز: العصر العباسي ..، مرجع سابق (الفصل الثالث).
انظر أيضًا بداية –بالتركيز على الفضاء التركي-الإيراني –العربي الآسيوي:
– د.نادية محمود مصطفى: آسيا الوسطى والقوقاز: بين القوى الإسلامية الكبرى وروسيا، أنماط ومحددات التطور التاريخي للتفاعلات الدولية: إطار مقترح للتحليل السياسي للتاريخ، مرجع سابق، ص 70-81.
– وانظر كذلك: نتائج تحليل تفاعلات العصرين الأموي والعباسي مقارنة بالعصرين المملوكي والعثماني –من حيث البحث في أثر العامل الخارجي (في) د.ودودة بدران..، مرجع سابق.
[19] د.نادية محمود مصطفى: العصر المملوكي…، مرجع سابق، ص 13-25، ص69-70، ص90-98، ص 112-118.
[20] انظر هذه التفاصيل وفق تقسيم مراحل العصر العثماني في د. نادية محمود مصطفى، مشروع علاقات الدولية في الإسلام، مرجع سابق.
– انظر أيضاً هذه التفاصيل ولكن وفق مراحل تطور السياسات والتوازنات الأوربية في د.محمد السيد سليم، مرجع سابق.
[21] د.ودودة بدران، مرجع سابق.
– د.محمد السيد سليم، مرجع سابق.
[22] انظر الملامح الكبرى الاستراتيجية لتوازن القوى العالمي وتوازنات القوى الاسلامية في هذه المرحلة المعاصرة منذ 1991 وحتى 2007، وحول مفاصلها الأساسية: حرب الكويت، حرب أفغانستان، احتلال العراق، ازمة إيران النووية، انتفاضة الاقصى وتداعياتها حتى الآن. العدوان الإسرائيلي على لبنان وحزب الله…
– انظر على سبيل المثال: العدد الثالث من حولية امتى في العالم (تداعيات الحادي عشر من سبتمبر على الأمة الإسلامية)، مركز الحضارة للدراسات السياسية، القاهرة، 2003.
– العدد الرابع من حولية أمتي في العالم (تداعيات احتلال العراق على الأمة)، مركز الحضارة للدراسات السياسية، القاهرة، 2004.
– العدد الخامس من حولية أمتي في العالم (الاصلاح في الأمة بين الداخل والخارج)، مركز الحضارة للدراسات السياسية، القاهرة، 2006.
– د. نادية محمود مصطفى، التحديات السياسية الخارجية للعالم الإسلامي، بروز الأبعاد الثقافية والحضارية (في) د. نادية محمود مصطفى (إشراف وتقديم): موسوعة الأمة في قرن، مرجع سابق، الجزء السادس (التحديات والاستجابات والانتفاض في الأمة).
– د. نادية محمود مصطفى، د.باكينام الشرقاوي (محرران): مشروع الشرق الأوسط الكبير والأمن العربي، أعمال المؤتمر السنوي التاسع عشر لمركز البحوث والدراسات السياسية، ديسمبر 2005، جامعة القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، (تحت الطبع).
[23] كل من:
– د. نادية محمود مصطفى: آسيا الوسطى والقوقاز…، مرجع سابق، ص 82-100.
– د. ودودة بدران، مراجع سابق.
– وانظر التفاصيل (في) د.نادية محمود مصطفى: العصر العثماني…، مرجع سابق.
– ونقلا عن هذا المصدر وحول الدولة الصفوية وتفاعلاتها الدولية انظر ما يلي:
– د.بديع جمعة/ د.أحمد الخولي: تاريخ الصفويين وحضارتهم، دار الرائد العربي، بيروت، 1976، ج1، ص ص 99-100.
– د. أحمد الخولي: الدولة الصفوية، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، 1981، ص ص 49-95.
– د. وجيه كوثراني: الفقيه والسلطان، المركز العربي الدولي، القاهرة، 1990، ص 52-54.
– د. محمد عبد اللطيف هريدي: الحروب العثمانية- الفارسية وأثرها في انحسار المد الإسلامي عن أوروبا، دار الصحوة، القاهرة، 1408هـ- 1987م، ص ص 69- 85.
– إبراهيم العدوي: التاريخ الإسلامي: آفاقه السياسية وأبعاده الحضارية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1976, ص ص 442- 443.
[24] كل من:
– د. نادية محمود مصطفى: آسيا الوسطى…، مرجع سابق، ص 90-91.
– د. محمد السيد سليم، مرجع سابق.
– د. باكينام الشرقاوي: التغيير السياسي في إيران ما بين المحددات والقضايا، (في): د.نادية محمود مصطفى (إشراف وتقديم): موسوعة الأمة في قرن، مرجع سابق، الجزء الثالث.
=- وحول مزيد من التفاصيل التاريخية انظر: د.نادية محمود مصطفى: العصر العثماني، (الفصل الثالث)، مرجع سابق.
ونقلا عن المصدر السابق، انظر:
– انظر تفاصيل التطورات السياسية والاجتماعية في:
– H. Braun: Iran under the Safavids in the 18 th Century (in) I. Kissiling (and others) (eds), op.cit.
– انظر التفاصيل التاريخية التي تم منها استخلاص هذه الأنماط في: – د.أحمد الخولي ود.بديع جمعة: مرجع سابق، ص ص 319- 321، 362- 368.
– كارل بروكلمان: مرجع سابق، ج3، ص ص 156- 160.
– أحمد محمد الساداتي: أفغانستان والسيد جمال الدين الأفغاني، 1961مكتبة القاهرة الكبرى، القاهرة، ص ص 41-44.
– H. Braun: op. cit. pp 193, 199- 204.
– د. محمد عبد اللطيف هريدي: مرجع سابق، ص ص 69- 85.
– جورج كيبرك: موجز تاريخ الشرق الأوسط، ترجمة: عمر الإسكندراني ود.حسين سلي، مركز دراسات الشرق الأوسط، القاهرة، 1975، ص ص 102-107.
– د. أحمد الخولي: الدولة الصفوية، مرجع سابق، ص ص 189-192.
– د. جمال زكريا قاسم: الخليج العربي: دراسة لتاريخ الإمارات العربية في عصر التوسع الأوروبي الأول (1507-1840م)، دار الفكر العربي، القاهرة 1985، ص ص 99، 100-101، 162- 166.
– د. أحمد الخولي ود. بديع جمعة: مرجع سابق، ص ص 256-258، 248-430.
– H. Braun: op. cit, pp 194- 196.
– وأنظر أيضًا نص الاتفاقيات التالية بين طهران وأطراف أوروبية وذلك بشأن امتيازات إقليمية للأوروبيين 1600م، وامتيازات لهولندا 1622م، ولإنجلترا 1629م، وذلك على التوالي في:
– J.C. Hurewitz: “Ottoman Diplomacy and the European State System”, Middle East Journal, Vol. 15, 1961pp. 15-19, 22-25.
– كارل بروكلمان: مرجع سابق، ص ص 156- 166.
– د. أحمد الخولي: مرجع سابق، ص ص 222- 237.
– H. Braun: op. cit, pp. 199-200, 202, 205.
– محمد السيد سليم: العلاقات بين الدول الإسلامية، جامعة الملك سعود، الرياض، 1412هـ، 1991م.
[25] حول خصائص الأطر العامة لهذه المرحلة انظر:
– د. ودودة بدران: مرجع سابق (الفصل الأول: وضع الدول الإسلامية في النظام الدولي، مراحل وأنواع الاستعمار، الفصل الثاني: ميكانيزمات الاستعمار).
– د. محمد السيد سليم: مرجع سابق.
– د. باكينام الشرقاوي: مرجع سابق.
وحول ما يتصل بالعلاقات الإيرانية والعربية ووضع الفضاء الحضاري العربي الإيراني في التفاعلات الدولية وخصائص التطورات الداخلية العربية والإيرانية لهذه المراحل، انظر على سبيل المثال:
– د. باكينام الشرقاوي: مرجع سابق.
– د. حسنين توفيق: مثلث العلاقات المصرية –التركية- الإيرانية: المحددات، المسارات، الآفاق، أمتي في العالم، العدد الثاني، مرجع سابق.
– د. نادية محمود مصطفى: أوروبا الغربية وأمن الخليج (1980- 1987)، مجلة الفكر الاستراتيجي العربي، إبريل 1989.
– انظر المواقف والسياسات الإيرانية منذ 2001 تجاه أحداث المنطقة، في الأعداد 4، 5، 6 من حولية أمتي في العالم، مرجع سابق.
– د. رؤوف عباس (محرر): العلاقات العربية الإيرانية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة.
=- د.نازلي معوض (محرر): مصر ودول الجوار الجغرافي، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة.
– وانظر ضمن إصدارات مركز دراسات الوحدة العربية على سبيل المثال ما يلي:
– مجموعة باحثين، العلاقات العربية-الإيرانية: الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل، أعمال الندوة التي عقدها مركز دراسات الوحدة العربية في الفترة من 11 ـ24 سبتمبر/ايلول 1995م، ط1، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1996.
– د.نيفين عبد المنعم مسعد، صنع القرار في إيران والعلاقات العربية-الإيرانية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2002.
– مجموعة باحثين، العرب وجوارهم… إلى أين؟، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2002.
– مجموعة باحثين، حال الأمة العربية 2005: تحدي البقاء والتغيير، ط1، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2006.
[26]] ) انظر خارطة جديدة للشرق الأوسط تحت عنوان: “خارطة الدم” في:
Http:// www. armed forces journal.com 2006/06/1833899.
[27] Bernard Lewis: Rethinking The Middle East: foreign Affairs. Fall 1992.
انظر أيضًا:
– Barry Rubin: Reshaping the Middle East. Foreign Affairs.
Summer 1990.
[28] Richard N. Hass, New Middle East, foreign Affairs, fall: Nov. Dec. 2006.