إسرائيل من الداخل: ظاهرة ما بعد الصهيونية… الأبعاد والمضامين
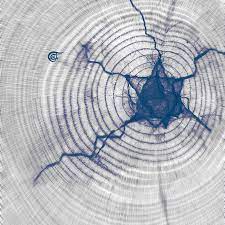
مقدمة:
تثير دراسة ظاهرة “ما بعد الصهيونية” الصعوبات والإشكاليات التالية:
أولا، أن ما يقال له “الصهيونية” هو في الواقع مفهوم ينطوي على الكثير من الغموض والتعدد والتناقض، حيث لا توجد صهيونية واحدة، ولكن توجد صهيونيات كثيرة، ولم يزدها تعاقب العقود قبل إنشاء إسرائيل وبعده إلا غموضا وتعددا وتناقضا. ولذا حينما يذكر مصطلح “ما بعد الصهيونية” فإننا لا نعلم بالتحديد ما هي الصهيونية أولا. ويوضح الدكتور عبد الوهاب المسيري أن “كلمة صهيونية Zionism مصطلح فضفاض للغاية، يصعب تعريفه بشكل مباشر، لا لأنه مركب أو لأنه فريد، وإنما لأنه يشير إلى نزعات وحركات ومنظمات سياسية غير متجانسة، بل متناقضة أحيانا في أهدافها ومصالحها ورؤيتها للتاريخ، وفي أصولها الإثنية والدينية والطبقية. كما أن المصطلح يستخدم عادة مع صفة تحد من مجال معناه أو توسعه”، ومن ذلك (1) ومن “صهيونية صهيون”، و”صهيونية الصالونات”، و”الصهيونية الدينية”، و”صهيونية غير اليهود (الأغيار)”، و”الصهيونية السياسية”، و”الصهيونية العملية”، و”الصهيونية التركيبية”، و”الصهيونية الثقافية”، و”الصهيونية الديمقراطية”، و”الصهيونية المراجعة”، و”الصهيونية الراديكالية”، و”صهيونية الدياسبورا”، و”صهيونية الخط الأخضر”، و”صهيونية الأراضي”، أو “الصهيونية التوسعية”، و”الصهيونية المتوحشة”، أو”صهيونية الحد الأقصى”، و”الصهيونية المعتدلة”، أو “صهيونية الحد الأدنى”، و”الصهيونية العضوية”، و”الصهيونية الديمغرافية”، وهي كلها لا يجمع بينها سوى القليل من المقولات العامة المشتركة الكاذبة. ومن أهم هذه المقولات:(2)
1- أن هناك رابطة ما، بين يهود العالم تجعل منهم كيانا متميزا عن المجتمعات التي يعيشون فيها، وتبيح من ثم الحديث عن عامٍّ يهودي من قبيل “الشعب اليهودي”، و”الثقافة اليهودية”، و”الشخصية اليهودية”، و”التاريخ اليهودي”، و”معاداة اليهود”… إلخ..
2- الاتفاق على هدف نقل “الفائض البشري” اليهودي من شرق أوربا إلى فلسطين لحل المشكلة اليهودية (مشكلة عدم اندماج هؤلاء اليهود في المجتمعات الغربية، وتهديدهم لمصالح يهود غرب أوربا المندمجين في مجتمعاتهم) من خلال إنشاء كيان عميل للدول الغربية الكبرى فيها، وإن تسمَّت هذه العملية بأنها “عودة” إلى “أرض الميعاد” أو غير ذلك من الصياغات الدينية لتسويغ قبول الصهيونية لليهود في العالم.
3- تفريغ فلسطين من أي مضمون أو صبغة غير يهوديين، ونفي الوجود العربي فيها، إلى حد اعتبارها “أرضا بلا شعب”، تنتظر “عودة” ما يقال له “الشعب اليهودي” الذي لا أرض له كما تزعم الصهيونية، وهو ما يترجم عمليا إلى استئصال الوجود العربي أو طرده أو تهميشه ودفعه إلى الخارج، مقابل تهويد الأرض وملئها بالمهاجرين اليهود.
وفي هذا السياق تبرز الحقائق التالية:
1- أن جميع هذه التنويعات الصهيونية نشأت في الغرب أو في إسرائيل، ولم تعرفها التجمعات اليهودية في العالم الإسلامي. والأكثر من ذلك أنها بدأت ظاهرة مسيحية بروتستانتية خالصة، ولم يعتنقها اليهود الغربيون في غرب أوربا ولا شرقها إلا في مراحل متأخرة من بنائها. وهو ما يوضح ارتباطها بالتحولات التي شهدتها أوربا في العصر الحديث وأوضاع اليهود فيها. (3)
2- أنها قد ارتبطت من ناحية أخرى، بالصراع الأوربي المسيحي البروتستانتي ضد الدولة الإسلامية في مراحلها المتأخرة، وتطورت في مضمونها وشكلها من مجرد دعوة تبشيرية بروتستانتية، إلى رؤية ثقافية علمانية رومانسية للشعب العضوي والرابطة القومية المزعومة بين اليهود في عصر القوميات العضوية الأوربية، إلى دعوة سياسية صريحة لاستعمار فلسطين وإقامة دولة لليهود فيها، ثم ممارسة سياسية وعسكرية عبر مراحل ذلك الصراع المتأخرة، الذي انتهى بالقضاء على الخلافة الإسلامية، وخضوع العالم الإسلامي بأسره للقوى الاستعمارية الغربية،(4)وكانت ذروة ذلك بالنسبة إلى الصهيونية هي إنشاء دولة إسرائيل، ثم تثبيت وجود هذه الدولة وإضعاف أعدائها وتمزيقهم، بالحرب تارة وبالدبلوماسية تارة أخرى، على نحو ما تشهده المرحلة الراهنة من تطور الصراع العربي الإسلامي- الإسرائيلي الصهيوني. وهنا يمكن القول إن التطور الإيجابي للصهيونية ودولتها ليس إلا الوجه الآخر للتطور السلبي للجامعتين الإسلامية والعربية، وهذه هي طبيعة الصراع، باعتباره علاقة لا يتم فيها تحقيق مصلحة طرف إلا على حساب الطرف الآخر. وهنا يجدر التساؤل عن موقع “ما بعد الصهيونية” في هذا السياق التاريخي لذلك الصراع.
3- أن وزن الاعتبارات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية في بنية الصهيونية كأيديولوجية وكحركة سياسية، بغض النظر عن صياغتها الدينية الدعائية، قد تعاظم إلى أن سيطر على مختلف الأسس الدينية التي سلبتها الصهيونية مضمونها الديني، وملأتها بمضمون استعماري علماني، ووظفتها، كما استلبت الاشتراكية والديمقراطية ووظفتهما لاحقا، للحصول على تأييد التجمعات اليهودية المختلفة في العالم، والحصول على دعم القوى الدولية،(5) إلى أن أخذت الصهيونية الدينية في التعملق بديباجتيها المسيحية واليهودية في العقود الأخيرة مع دخول الأيديولوجيات العلمانية في إسرائيل وخارجها مرحلة الأزمة. وهو ما يكشف دينامية العلاقة بين تيارات الصهيونية المختلفة ويثير التساؤل حول وضع “ما بعد الصهيونية” ضمن بنية الصراع الداخلي في إسرائيل.
ثانيا، أن كلا من التنوعات الصهيونية قد انتقد من داخله ومن خارجه، وكانت العلاقة فيما بينها علاقة صراعية أو تنافسية، حاول كل منها فرض نفسه على الساحة اليهودية واستقطاب أكبر قدر من التأييد داخل إسرائيل وخارجها لموفقه ورؤيته. ومن ثم فإن الصهيونية قد أضافت إلى الانقسامات بين اليهود، من حيث زعمت وحدتهم، انقسامات جديدة بين مؤيديها ومعارضيها، وبين أنصار كل من الفريقين. وتعرض كل من هذه التيارات إلى مراجعات وانتقادات من قبل مؤيديه ومعارضيه، وهو ما يجعل ظاهرة “ما بعد الصهيونية” غير منفصلة عن هذا السياق، الأمر الذي يثير التساؤل: إلى أي مدى تعتبر ظاهرة “ما بعد الصهيونية” غير صهيونية كما يستوحى من تسميتها؟ أو بعبارة أخرى: ما هو الصهيوني وما هو غير الصهيوني في ظاهرة “ما بعد الصهيونية”؟
ثالثا، أن ظاهرة “ما بعد الصهيونية” كما يبدو من تسميتها أيضا، لا تحمل توجها نحو شيء محدد ولكن “تجتمع” فقط على تجاوز الصهيونية إلى شيء لم يتحدد بعد، ولا يوجد اتفاق بشأنه. والأكثر من ذلك أنها لا تتفق في تقييم الصهيونية التي “تتفق” على تجاوزها، ولكنها تتفاوت في النظر إلى تلك الأيديولوجية بين إدانتها وتمجيدها. ولذا يقال إن تصنيف مفكر ما على أنه صهيوني أو ما بعد صهيوني هو أمر ذاتي إلى حد بعيد. الأمر الذي يثير بدوره صعوبة جديدة تتعلق بكيفية الفصل بين الأبعاد الذاتية والموضوعية لهذه الظاهرة.
وفيما يلي اجتهاد لتحديد ماهية الظاهرة “ما بعد الصهيونية” وأبعادها، وعوامل ظهورها، واستخلاص لمقولاتها بهدف التعرف على مدى ابتعادها عن الصهيونية أو اقترابها منها.
أولا، تحديد الظاهرة ’’ما بعد الصهيونية’’:
يكشف تحليل الدراسات المتاحة لظاهرة “ما بعد الصهيونية” عن بعدين أساسيين يحددانها، أحدهما فكري، والآخر عملي. وتفصيل ذلك كما يلي:
أ- البعد الفكري:
ينطوي هذا البعد على مكونين متميزين أحدهما أيديولوجي، والآخر أكاديمي.
أما البعد الأيديولوجي، فهو ينقسم بدوره إلى قسمين بناء على التقويم النهائي حسب رأي أحد الأساتذة الإسرائيليين:(6) “الأول ينظر إلى الصهيونية بإيجابية، بل حتى بإيجابية شديدة، لكنه يقرر أن الصهيونية حققت أهدافها كلها، ولم يبق لها ما تفعله. ومهما تكن الحال، فإن هدف جعل الشعب اليهودي شعبا طبيعيا قد تحقق، سواء أكان وفق تخيل هيرتسل، أم لا. لذا فلنبدأ الآن العمل من أجل الأهداف التي تسعى لها الأمم التي تعيش بأمان في دولها، مثل رفع مستوى المعيشة، وتطوير الرفاه الثقافي والاجتماعي”. والثاني “هو أساسا، تجسُّد جديد للأيديولوجيا المعادية للصهيونية، العائدة إلى فترة “ما بعد الكارثة” [على يد النازية] وما قبل قيام الدولة.
كانت الصهيونية، إلى حين قيام الدولة، تمثل أقلية في أوساط الشعب اليهودي، وتواجه معارضة من أجزاء متعددة منه. ولم تكن جهودها تتمتع قط بإجماع عريض. ولم يتكون إجماع يهودي عليها إلا بعد “الكارثة” وتأسيس دولة إسرائيل؛ عندئذ فقط أصبحت الصهيونية مسألة وحّد الاتفاق عليها جميع اليهود في إسرائيل والشتات.*
وبقي هذا الإجماع قائما حتى حرب الأيام الستة. بعد ذلك، وخصوصا بعد حرب الاستنزاف (1968-1970) وحرب “يوم الغفران” (1973) بدأ المرء يسمع أصداء إعادة نظر فيما يتعلق بصحة [أطروحات] الصهيونية”. وبذلك تصبح ظاهرة “ما بعد الصهيونية” عودة إلى الأصل في معاداة الصهيونية أو رفضها، بعد فشل الصهيونية في التجربة العملية. ولعل ذلك موقف أكثر تطورا من معاداة الصهيونية الأولى، إذ يأتي الموقف الجديد بعد إيمان بفشل الصهيونية، أو، على الأقل، افتضاح أكاذيبها، في حين أن الموقف الأول كان غالبا بسبب التشكك في نجاحها!
وأما البعد الأكاديمي، فهو يتميز – رغم عدم انفصاله الكامل عن البعد الأيديولوجي- بسمتين أساسيتين، أولاهما أنه لا يتضمن تأييدا للصهيونية على غرار الشق الأول من البعد الأيديولوجي السابق ذكره، ولكنه يهتم بتفنيد مزاعمها وأساطيرها، أو على الأقل إبراز العناصر التي أخفتها الصهيونية عن عمد، في روايتها للتاريخ الإسرائيلي، وبالذات الحضور العربي، والعلاقات العربية- اليهودية في فلسطين إبان إقامة الدولة الإسرائيلية، وهو ما يكشف الطبيعة الاستعمارية لهذه الدولة. والسمة الثانية، هي أن هذا المجهود يحلل هذا التاريخ وتلك العلاقات، أو يحلل ظاهرة “ما بعد الصهيونية” نفسها بشكل منهاجي، وينتمي القائمون به إلى ثلاثة حقول من العلوم الاجتماعية وثيقة الصلة بموضوع الصهيونية وما بعدها، هي التاريخ والاجتماع،** والسياسة. ولذا تتميز جهود هذا الاتجاه بدرجة عالية من الرصانة، والمصداقية العلمية، بخلاف الأعمال الأخرى، التي لا تحظى بهذا الأساس العلمي سواء في تأييد الصهيونية أو مناهضتها، التي يمكن تصنيفها ضمن البعد الأيديولوجي الصرف، الذي يظهر في أعمال مثقفين وصحافيين وفنانين من غير المختصين بهذه العلوم.
وإذ يناقش علماء “ما بعد الصهيونية” تلك الموضوعات، التي تم صبغها بصبغة صهيونية أيديولوجية، وعممت طوال العقود السابقة على المؤسسات العلمية والتربوية الإسرائيلية، فإنهم ينتقدون هذه المؤسسات، ويعتبرون تأريخها لهذه الموضوعات نوعا من التضليل وتغييب الحقائق، فرضتهما على المواطنين الإسرائيليين.
ب- البعد العملي:
ينصرف هذا البعد إلى الممارسات الفعلية لكل من الحكومات الإسرائيلية، والأحزاب والقوى السياسية، والمجتمع الإسرائيلي، التي تتضمن مخالفة للصهيونية في كثير من النواحي. ولذا يوضح البعض أنه إذا كانت تجليات الظاهرة “ما بعد الصهيونية” في بعدها الفكري تعكس آراء نخب ذات نفوذ ضئيل في المجتمع الإسرائيلي، فإن “ما بعد الصهيونية هي أيضا عملية اجتماعية وسوسيولوجية، لذلك فهي أوسع انتشارا وأكثر نفوذا مما نميل إلى الاعتراف به، إذ إنها تظهر في جوانب كثيرة من مواقف الحكومة والأحزاب السياسية”. (7)
ويرتبط هذا البعد من الظاهرة “ما بعد الصهيونية” بالتحولات التي شهدتها إسرائيل منذ الستينيات، بسبب عديد من العوامل سيلي تفصيلها. أي أنه ناتج من تفاعل الصهيونية كأيديولوجية مع الواقع، الذي مثل الاختبار العملي لمقولاتها، وأبرز من ثم الحاجة إلى التخلي عنها أو مراجعتها على الأقل، (سواء لفشلها، أو لنجاحها) وأفسح بذلك المجال لظهور “ما بعد الصهيونية” كفكر وحركة.
وفي هذا السياق، يعتبر قسم كبير من الكتاب الإسرائيليين أن الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، والتوصل إلى اتفاقات أوسلو كان ذروة هذا التحول العملي عن الصهيونية بشكلها التقليدي. ومن ذلك ما يؤكده ميرون بنفنستي- وهو صحافي إسرائيلي- بقوله:(8) “… ظل شعور رابين بالولاء لميراث الآباء المؤسسين مستمرا… ومضى 18عاما منذ أن ولي قيادة الشعب إلى أن جاء الاعتراض على مفهومين أساسيين وجها خُطى المشروع الصهيوني منذ اصطدامه بعداء العرب، أبناء البلد، “غير المتوقع”: الأول، أنه توجد في أرض إسرائيل جماعة قومية شرعية وحيدة، وبالتالي فإن حق الشعب اليهودي في المطالبة بالوطن كله هو حق مطلق؛ والمفهوم الآخر هو أن العرب لا يفهمون سوى لغة القوة.
وفي اللحظة التي صافح رابين ياسر عرفات، كان بذلك يعيد تعريف المفاهيم الأساسية للصهيونية: يعلن عن انتصار الصهيونية، وينهي مهمته كابن واصل مهمة الآباء، وبات يعتقد أنه يستطيع أن يكون أبا مؤسسا لإسرائيل جديدة، وموجها لأبناء جدد في بلورة الحقبة الجديدة”.
كما يرى بني موريس وهو واحد من الملقبين بالمؤرخين الجدد أن “إسرائيل دخلت في الأعوام الأخيرة حقبة ما بعد أيديولوجية، أي ما بعد صهيونية، بدأت فيها المصالح والقيم الخاصة والفردية تطغى على قيم الجماعة بكاملها…..”.(9)
ولعله من الجدير بالملاحظة أنه إذا كانت الأبعاد العملية للظاهرة “ما بعد الصهيونية”، وبدرجة أقل الأبعاد الأيديولوجية، تم تقبلها بشكل أو بآخر من قبل معظم المجتمع الإسرائيلي، وبالتدريج، ربما على اعتبار أنها من مقتضيات العمل السياسي، الذي يتطلب المساومة و المناورة والتكيف، أو لأن الأيديولوجية الصهيونية نفسها وطبيعة الحياة في إسرائيل تتسمان بقدر كبير من التماهي، وتواجد الأضداد في إطار ما يصفه بعض المختصين*** بالخاصة الإسفنجية التي تمتص- دون أن تستوعب- مختلف التناقضات، وتسمح لكل فريق بأن يفسر الصياغات الهلامية كما يشاء، حتى تستقطب تأييد أكبر عدد ممكن من يهود العالم بكل ما بينهم من تمايز، ولأن التغيرات الاجتماعية تفرض نفسها بشكل تسللي تراكمي، فإن “ما بعد الصهيونية” كعمل أكاديمي حديث قد قوبلت بهجوم شرس من مختلف الاتجاهات الإسرائيلية، بلغ حد وصفها بالعمالة والدعائية التحريضية ضد إسرائيل. ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة هذه الأعمال، وما تضمنته من حقائق قاسية تم التوصل إليها بشكل علمي، وكونها أتت من أساتذة مختصين بالعلوم الاجتماعية، ومنتمين إلى المؤسسات العلمية الرسمية الإسرائيلية، الأمر الذي يمكن تفسيره على أنه شهادة وفاة إسرائيلية ورسمية للصهيونية، ودعوة من ثم إلى تغيير جذري ليست هذه الاتجاهات المسيطرة مستعدة لإجرائه في الوقت الراهن. ويوضح هذه الحقيقة أحد رواد هذه الظاهرة بقوله: “من المهم أن نلاحظ أن مثقفي ما بعد الصهيونية أو المؤرخين الجدد أو علماء الاجتماع الجدد ليسوا أول من تحدى الرواية الصهيونية لماضي إسرائيل وحاضرها. لكن من سبقهم إلى ذلك كانوا على الأغلب من اليساريين من أعضاء الحزب الشيوعي أو الجماعات الهامشية كحزب مبام. والتوجه الأيديولوجي لهذه المجموعات الأخيرة، بالإضافة إلى حقيقة أنهم لم يكونوا مؤرخين أو علماء اجتماع بحكم المهنة.. قد جعل من السهل الاستخفاف بنتائج بحثهم، ووصفها بأنها مجرد ادعاءات لنشطاء سياسيين خارج الإجماع القومي. وعلى النقيض من ذلك فإن المؤرخين الجدد وعلماء الاجتماع الجدد، بوصفهم دارسين معتمدين في بيئة أكاديمية رسمية للبحث في ماضي البلد وتدريسه، كانوا أول من يتحدى التفكير التقليدي من داخل النظام”.(10)
ويفسر ذلك أن مصطلح “ما بعد الصهيونية”، يشير أساسا في الكتابات الإسرائيلية إلى البعد الفكري لهذه الظاهرة، وبشكل خاص الشق الأكاديمي منه، في حين لا يذكر معظم المحللين البعد العملي للظاهرة، ربما بسبب أنه لا يروق لهم- وهذه سمة صهيونية ممتدة، أي الانفصال بين القول والفعل، فبوسع المرء أن يكرر باستمرار أنه صهيوني تارة أو يهودي تارة أخرى، في الوقت الذي تدل تصرفاته العملية على غير ذلك- أو في المقابل، لاعتباره غير كاف للدلالة على التحول عن الصهيونية إلى شيء بعدها نظرا إلى أن الصهيونية من الهلامية بحيث تحتوي تناقضات كثيرة وتفسيرات أكثر يمكن أن تعتبر الأفعال غير الصهيونية صهيونية أو العكس.
ويظهر هذا التركيز على الجانب الفكري لظاهرة “ما بعد الصهيونية” في تعريفاتها التي يقتضي هذا المقام ذكر بعض منها. فمثلا، يعرفها أمنون روبنشتاين- وهو أستاذ في القانون في جامعة تل أبيب ووزير سابق للمعارف، ومن المدافعين عن الصهيونية- بقوله: “ما بعد الصهيونية اسم مشترك لعدد من المقاربات الجديدة المنتشرة مؤخرا بين مجموعة من المؤرخين الملقبين بالجدد، ومن علماء الاجتماع الملقبين بالانتقاديين…”.(11)
ويعرفها توم سيغف- وهو مؤرخ وصحافي إسرائيلي- بقوله: “أنا لا أعرف ما هو [الشيء المسمى] “ما بعد الصهيونية”. وفي نظري إنه في المحصلة شتيمة موجهة إلى شخص تختلف مقاربته للصهيونية عن مقاربة من شتمه. لا معنى للتظاهر بأن ما يجري الحديث عنه هو نقاش في شأن كتابة التاريخ، لأن النقاش مع المؤرخين الجدد نقاش سياسي بشأن ما يحدث الآن وما ينبغي أن يحدث غدا”.(12)
أما بني موريس فيشير إلى أن “مفهوم ما بعد الصهيونية لم يخترعه المعارضون له، وإنما اخترعه المؤيدون؛ لذلك فهو ليس شتيمة” ويردف: “في نظري، ما بعد الصهيونية هو ضرورة أن يعيد الثوريون تشكيل حياتهم بعد أن انتهت الثورة. في الماضي كنا نحكم على كل شيء بمعيار وحيد: إذا كان مفيدا للصهيونية، أو مسيئا لها. لقد نظمت الصهيونية لنا عالم قيمنا. وما بعد الصهيونيين يريدون أن تكف الصهيونية عن أن تكون الأب والأم الفكريين لنظرتهم إلى العالم”.(13) ومع ذلك يرفض بني موريس تسمية جهوده في كتابة تاريخ موضوعي وعلمي بأنه عمل “ما بعد صهيوني”، ويؤكد أن مؤلفاته التي كشفت عن الوجه المخبوء المظلم للصهيونية، ساهمت في إغناء البحث في الحركة والدولة التي أنشأتها.(14)
ويجمل إيلان بابي- وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، والمدير الأكاديمي لمعهد جفعات حفيفا لأبحاث السلام- طبيعة الظاهرة “ما بعد الصهيونية” باعتبارها ظاهرة ثقافية تطلق على جميع أولئك الذين قاموا بمراجعة أعمال المجموعة الأكاديمية الصهيونية الرئيسة في إسرائيل أو انتقدوها، والفنانين والروائيين وغيرهم ممن يستخدمون خطابا ثقافيا جديدا. ويوضح أن “مصطلح ما بعد الصهيونية خليط من أفكار عامة معادية للصهيونية، وإدراك ما بعد حداثي للواقع. وقد أصبح تعبيرا ملائما يجمع معا اليهود الصهيونيين والمعادين للصهيونية في الوسطين الأكاديمي والسياسي الإسرائيليين. [إذ] إن تعبيري معادٍ للصهيونية وصهيوني في عالم الباحثين هما، إلى حد كبير، مسألة تعريف ذاتي. فوسط هذه المجموعة تبدو أعمال أولئك الذين يعلنون صراحة أنهم صهيونيون معادية بصورة عامة للصهيونية كأعمال أولئك المؤلفين الذين يعلنون صراحة أنهم معادون للصهيونية…..
أما بالنسبة إلى الجزء المتعلق بما بعد الحداثة من المعادلة فإنه ينبثق من توجه لدى البعض في هذه المجموعة للنظر إلى الواقع الحالي في إسرائيل كمرحلة سقط فيها معظم الحقائق الصهيونية، لكن لا يوجد ما يشير إلى ما سيحل محلها. وهكذا فإنهم، إذا ما استعرنا الخطاب ما بعد الحداثي، قد فككوا الحقيقة لكنهم يعجزون عن إعادة بنائها..”.(15)
ثانيا، عوامل ظهور ’’ما بعد الصهيونية’’:
أ- العوامل الداخلية:
تعتبر أيديولوجية النظام السياسي السائدة في الدولة أحد محددات قوتها، وتطورها الداخلي، وسلوكها الخارجي. وفي هذا السياق، فإن الأيديولوجية الصهيونية نفسها تصبح من محددات ظهور تيار “ما بعد الصهيونية”، وذلك بالنظر إلى ما تحويه من تناقضات داخلية، لا تتطلب كثيرا من الحصافة لإدراكها، وإدراك هشاشة أسسها، والتمرد عليها. ومن ناحية أخرى، بالنظر إلى مدى ملاءمتها من الناحية العملية، بصرف النظر عن سلامة فروضها، لمتطلبات المرحلة الحالية.
ولعل هذا البعد الأخير (مدى الملاءمة لتحقيق المتطلبات الراهنة) هو الأهم في هذا المقام، حيث ظلت الصهيونية، بكل تناقضاتها وهشاشة أسسها، هي الأيديولوجية السائدة في المجتمع الإسرائيلي حتى الآن، ولم يجرؤ على تحديها إلا أطراف داخلية مهمشة، وجميعها تقريبا لم تمنعه مواقفه الرافضة للصهيونية من المشاركة في النظام السياسي القائم عليها، والتكيف مع مقتضيات ذلك النظام قدر الإمكان. وهنا يمكن التساؤل: ما الذي تغير في المجتمع الإسرائيلي، وساهم في ظهور “ما بعد الصهيونية” كفكر وحركة تتسمان بالتمرد على أيديولوجية الدولة؟
وللإجابة عن هذا السؤال، يمكن توضيح الحقائق التالية:
1- نجاح الصهيونية في التحول من مشروع إلى دولة:
تبع إعلان الدولة الإسرائيلية في 1948 انتقال معظم صلاحيات المنظمة الصهيونية إلى الحكومة الإسرائيلية، بل حتى تفكير رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول بن جوريون في حل هذه المنظمة منذ وقت مبكر، دلالة على أن الدولة لم تعد بحاجة إلى المنظمة الصهيونية. كما أعيد تعريف الصهيونية وتحديد أهدافها المرة تلو الأخرى بما يتناسب مع هذه الحقيقة، ومع مستجدات التوازن في العلاقة بين الدولة والمنظمة. كما ظهرت صهيونيات جديدة على النحو السابق ذكره، أو بالأحرى، تغيرت مضامين صهيونيات قديمة، وفقا لتغير احتياجات الدولة وموازين القوى داخلها، والظروف التي تمر بها في بيئتيها الإقليمية والدولية. والجدير بالملاحظة أن كل هذه الصياغات تتجاور في الواقع، وتؤثر في طبيعة الدولة وسلوكها الخارجي بحسب موازين القوى بين أنصارها، كما أن كلا منها ينتقد الآخر، ويسعى إلى تعظيم نصيبه من التأثير على حسابه. ولذا لا يستغرب ظهور تيار جديد ينتقد كل التيارات الصهيونية السابقة، سواء أمثل في مجمله تيارا أيديولوجيا جديدا، (ليبراليا مثلا، حيث يصف بعض ما بعد الصهيونيين اليمين واليسار الإسرائيليين العلمانيين بأنهما علمانيان ليبراليان شكلا فقط.(16) وهذا هو البعد الأيديولوجي في “ما بعد الصهيونية”) أم اكتفى بنقد ما هو قائم دون تطوير أيديولوجية بديلة. (وهذا هو البعد الأكاديمي في معظمه وإن كان يميل إلى أيديولوجية ليبرالية “حقيقية”).
2- تعزز الهوية الإسرائيلية:
يرتبط بما سبق، ويترتب عليه، ظهور أجيال جديدة من الإسرائيليين الذين ولدوا هم وآباؤهم في إسرائيل، وهم من يطلَق عليهم “الصَّبَّاريم”، وكان ذلك سببا في تغليب الهوية الإسرائيلية لديهم على ما عداها من هوية يهودية- صهيونية، وخاصة أبناء الفئات العلمانية، ذات التوجهات اليسارية. ويمكن الافتراض أنه كلما تعززت هذه الهوية الإسرائيلية العلمانية اليسارية، التي تتضمن، فيما تتضمن من تحولات قيمية، الانفصال أو، بالأحرى، الاعتراف بالانفصال عمليا عن يهود الخارج، أو حتى النظر إليهم باحتقار كونهم لا يكفون عن التدخل في الشئون الإسرائيلية، أو أنهم يدعمون اتجاهات داخلية على حساب أخرى، أو أنهم يكتفون بدعم إسرائيل من الخارج دون أن يهاجروا إليها، فإن الصهيونية تفقد كثيرا من صلابتها، وتفقد أحد أسسها وهو افتراض وحدة اليهود وكونهم يمثلون شعبا واحدا أو قومية جامعة.
3- تطور المجتمع العلمي والثقافي والفني:
نظرا إلى أن “الصهيونية” (أيا كانت صياغاتها) قامت على أساطير لا يصعب تبديدها، وهو ما فعلته على الدوام الأطراف العربية داخل إسرائيل وخارجها، وغيرها بما فيها أطراف يهودية، فإن تطور المجتمع العلمي في إسرائيل، والانفتاح على المدارس الفكرية والعلمية في الخارج، إن لم يكن الارتباط بها والتبعية لها، لا بد من أن يؤدي إلى ظهور تيار من الأكاديميين والمثقفين لا يتورعون عن مهاجمة هذه الأيديولوجية ونقض أسسها، وخاصة من زاوية هيمنتها على عالم الفكر والعلم والفن، إضافة إلى هيمنتها على عالم السياسة. وهذا ما كان من الطبيعي أن يفعله أنصار “ما بعد الصهيونية” الذين يمكن النظر إليهم باعتبار أنهم ثمرة العاملين السابقين: تحول المشروع إلى دولة، وتعزز الهوية الإسرائيلية العلمانية.
4- الصراع الداخلي:
يتكون المجتمع الإسرائيلي كمجتمع مهاجرين من مجموعات متمايزة من السكان الأصليين (الفلسطينيين)، والمستوطنين اليهود، بأقسامهم المختلفة. وقد تبنت النخبة الأوربية الشرقية (الأشكنازية) التي تولت الحكم في إسرائيل استراتيجية بوتقة الصهر، لدمج مختلف الفئات الإسرائيلية في أنظمة الدولة المختلفة، القائمة على الصهيونية العمالية. الأمر الذي ضمن لهذه النخبة وضعا متميزا، احتكرت فيه السلطة قرابة الثلاثين عاما، وأسست مؤسسات الدولة وأنظمتها المختلفة وفقا لرؤيتها ومصالحها، يستوي في ذلك النظام التعليمي وغيره. ولذا رغم أن ظاهرة “ما بعد الصهيونية” تعتبر ظاهرة يسارية، فإنها قوبلت بهجوم اليسار قبل اليمين، إذ كانت النخبة العمالية التي أنشأت الدولة وقادتها خلال تلك العقود الأولى هي هدف جل انتقاداتها.
بيد أنه في أعقاب الهزيمة الإسرائيلية في حرب 1973، بدأت تطفو إلى السطح مختلف التناقضات الداخلية في إسرائيل التي كبتتها النخبة الأشكنازية اليسارية، “وتفجرت التيارات الاجتماعية والثقافية الخفية المعبرة عن السخط والعداء في المجتمع الإسرائيلي في بداية السبعينيات، في صورة احتجاج اجتماعي ضد الشرور التي ارتكبتها الدولة بحق الجماعات اليهودية المحرومة، ولا سيما الجماعات ذات الأصول الشمال إفريقية. وحاول النشطاء الشباب والصاخبون محاكاة المعارضة التي عبر الأمريكيون الأفارقة عنها، فأسسوا في بداية السبعينيات حركة “الفهود السود” الخاصة بهم. وكانت الحركة تمثل مطلبا اجتماعيا من أجل توزيع جديد وأكثر عدلا لموارد البلد الاقتصادية، ونصيبا من تحديد هويتها الثقافية”.(17) والمعروف أن اليهود الشرقيين، ومنهم العرب، لم ينتجوا فكرا صهيونيا، ولم يساهموا في إنشاء إسرائيل، ولكن هاجروا إليها بعد إنشائها تحت ضغوط وإغراءات متنوعة.
وقد أحدثت هذه الحركة تحولين هامين في الساحة الإسرائيلية، أثرا بعمق في الأيديولوجية الصهيونية، أحدهما سياسي، إذ استغل اليمين الإسرائيلي هذه الحركة في إزاحة اليسار، بأيديولوجيته الصهيونية العمالية التي مثلت الجسم الرئيس للصهيونية، والصعود إلى السلطة لأول مرة في 1977، بأيديولوجيته الصهيونية المراجِعة (التصحيحية)، ومذهبه الاقتصادي الليبرالي. والآخر أكاديمي، شكل “انطلاقة الظاهرة ما بعد الصهيونية”، إذ جذبت هذه الظاهرة أنظار علماء الاجتماع الإسرائيليين لبحث المضامين النظرية والمنهجية لتطور حركة احتجاج اجتماعية في إسرائيل. وتزامنت حركة الاحتجاج اليهودي الشرقي مع بروز شعور مضطرد بالثقة الوطنية في أوساط الفلسطينيين في إسرائيل، وعززت قضيتهم قضايا الآخرين الذين كانوا يشعرون بأنهم مستبعدون من الرواية التاريخية الصهيونية، وبأن تاريخهم تعرض للتشويه في المناهج التعليمية المدرسية والجامعية.
ومنذ أواخر السبعينيات فصاعدا، بات الأكاديميون يمثلون، بمساعدة البحث التاريخي أو السوسيولوجي قضايا جميع الفئات المحرومة بوصفها قضايا تقتضي بحثا علميا. ورغم إخفاقهم في استحداث جبهة سياسية مشتركة من الفلسطينيين واليهود الشرقيين والنساء (كأقلية)، فقد بقيت رؤيتهم للربط بين هذه الفئات رائجة على المستوى الأكاديمي، وتعززت بأعمال الفنانين والأدباء في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان، حيث حاول الجميع تبني تفسير لاصهيوني للواقع في الماضي والحاضر. كما اتسمت رؤاهم بالنسبية، والتعددية، ونقد الأوهام التي ولدتها المفاهيم الغربية كالحداثة والتنوير، التي تعبر عن انتصار العلم والمنطق على الأفكار غير المتحضرة الآتية من العالم غير الغربي. كما انتقدوا المؤسسات العلمية الإسرائيلية، وأبرزوا التناقض بين مساهمة دارسي التيار السائد الإسرائيليين (الصهيونيين) في بناء الأمة، وبين مهمة الجامعة المتمثلة في تشجيع الأبحاث التعددية والانتقادية، واتهموا التيار السائد من علماء الاجتماع (الصهيونيين) باستخدام طرق ومناهج تلائم الادعاءات الأيديولوجية الصهيونية بشأن الأرض والشعب اليهودي. وكانت ذروة هذا الاتجاه المتنامي هي ظهور دراسات اجتماعية نقدية إسرائيلية طبقت المنظور الاستعماري على الصهيونية، متلاقية بذلك مع الرواية الفلسطينية للتاريخ.(18)
5- كشف وثائق حرب 1948:
تعمل الحكومة الإسرائيلية بالنظام المتبع في بريطانيا والولايات المتحدة، الخاص بكشف الوثائق السرية بعد مرور ثلاثين عاما عليها.(19) ويعتبر البعض أن هذا العامل قد ساهم في دفع ظاهرة “ما بعد الصهيونية”، حيث تكشفت، بشكل رسمي، الطبيعة الاستعمارية لدولة إسرائيل، واعتمادها على العنف في التخلص من السكان الأصليين، وطردهم من أراضيهم، وهي أمور كانت المؤسسات الرسمية تنكرها. وربما يكون هذا العامل هامشيا، بالنظر إلى الاعتبارات السابقة، وما سيلي من اعتبارات خارجية شجعت ظهور “ما بعد الصهيونية”؛ فمن ناحية، كانت حقائق طرد الفلسطينيين من أراضيهم، واستخدام وسائل العنف في التعامل مع السكان الفلسطينيين معروفة بشكل أو بآخر من خلال عمليات التوثيق العربية والأجنبية لهذه المرحلة، كما شاهد هذه الحوادث من عاصروا هذه المرحلة من التيارات المختلفة المعادية للصهيونية. ومن ناحية ثانية، فإن كشف هذه الوثائق لم يثن أنصار التيار الصهيوني السائد في إسرائيل إلى الآن عن الاستمرار في تبني الموقف الصهيوني، ومقابلة جهود ما بعد الصهيونيين بهجوم عنيف، كما سبق توضيحه. ومن ناحية أخيرة، فإن جهود ما بعد الصهيونيين ليست كلها في مجال التأريخ (المستفيد الأكبر من كشف تلك الوثائق)، ولكنها تتضمن أعمالا اجتماعية، وأدبية، وفنية، ولا تقتصر بطبيعة الحال على مرحلة 1948. وعلى أية حال، فإن الكشف عن هذه الوثائق، قد زود أنصار “ما بعد الصهيونية” بلا شك بقوة إضافية للاستشهاد بنصوص رسمية على صحة ما ذهبوا إليه.
ب- العوامل الإقليمية:
1- حرب 1967:
كشفت هذه الحرب الوجه التوسعي للصهيونية، وجردتها من أساسها الأخلاقي الذي زعمته، وساعدت من زاوية أخرى على ربط الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بالفلسطينيين في إسرائيل، الذين تعمق وعيهم بهويتهم الفلسطينية، وتعززت بذلك قوة أحد الأطراف المعادين للصهيونية عداء مبدئيا.
ومن ناحية أخرى، أحدث احتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة تداعيات داخلية أخرى تمثلت في تزايد الوزن النسبي لليمين بشقيه العلماني والديني في مواجهة التيار الرئيس في الصهيونية وهو الصهيونية العمالية. وهما تياران هامشيان، الأمر الذي أدى في محصلته إلى زوال الهيمنة العمالية وتفجر الصراعات الداخلية، وإفساح المجال أمام مختلف الفئات المعادية للصهيونية، وبخاصة العرب والمتدينون. ومن ناحية ثالثة، فإن زهو النصر قد دفع بالإسرائيليين إلى الاعتقاد بدخول مرحلة الاستهلاك الجماهيري، والتحلل من قيم التقشف والجماعية، التي فرضتها المخاوف الأمنية، ولا سيما مع تزايد تدفق المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل على نحو غير مسبوق، وتغلغل النموذج الأمريكي في إسرائيل منذئذ.(20)
2- حرب 1973:
أدت هذه الحرب إلى شعور متزايد وخاصة لدى الشباب (الجنود) بتكلفة الاحتلال، وبدأت مراجعة المقولات الصهيونية الأساسية، وأهمها أن إسرائيل تمثل ملاذا لليهود في العالم المعرضين للاضطهاد، وفقدان الأمن. حيث “لاحظ هؤلاء.. أن أولئك الذين تحرروا من الخوف كانوا يهود الشتات، وأنه إن كان ثمة يهود واجهوا خطر الإبادة وكارثة جماعية فهم أولئك الموجودون في إسرائيل وحواليها. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو كانت دولة إسرائيل قادرة على منع وقوع كارثة جماعية، كما حدث في الحقيقة في حرب “يوم الغفران”، فإن الثمن غال جدا، ولدى اليهود خيارات أخرى للاستمرار في البقاء”.(21) وهكذا بدأ هؤلاء يقارنون بين تكلفة الدولة والعائد منها!
ومن ناحية أخرى، عززت هذه الحرب من قوة العرب في إسرائيل، وبالمثل من قوة المتدينين الصهيونيين وغير الصهيونيين، الذين عملوا على شغل الفراغ الذي خلفه زوال الهيمنة العمالية.
3- غزو لبنان:
جمع غزو لبنان بين نتائج العاملين السابقين، وهما إظهار الوجه التوسعي للصهيونية ودولتها، والشعور المتزايد بتكلفة الاحتلال. ومنذئذ تزايد نفوذ حركات السلام الإسرائيلية، وإعلاء الفردية وقيمة الحياة على الأهداف الجماعية الصهيونية.
4- الانتفاضة الفلسطينية:
هدمت الانتفاضة مختلف أساطير الصهيونية بشأن الوجود العربي في فلسطين، وكان من أخطر إنجازات الانتفاضة إظهارها عجز الجيش الإسرائيلي عن توفير الأمن لليهود الإسرائيليين، وإظهار بشاعة الاحتلال في مواجهة المنتفضين، وتقوية ارتباط فلسطينيي إسرائيل بفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة، ونمو وعيهم القومي، ومطالبهم بحقوقهم كجماعة قومية متميزة ليست صهيونية وليست يهودية. وإزاء مكاسب الانتفاضة المتزايدة، وتآكل شرعية الاحتلال وتزايد تكاليفه، لم تجد إسرائيل مفرا من الاعتراف بالشعب الفلسطيني، والتفاوض مع ممثليه، والتسليم ببعض الحقوق للفلسطينيين في إسرائيل وإن كان ذلك على أساس فردي وليس قوميا.
5- القبول العربي بخيار التسوية السلمية للصراع العربي- الإسرائيلي:
أثبتت معاهدة 1979 بين مصر وإسرائيل، وفشل الدول العربية التي قاطعت مصر بسببها في تقديم بديل من التسوية السلمية للصراع العربي- الإسرائيلي، ثم انتقال هذه الدول في أعقاب الحرب العراقية- الإيرانية، الواحدة تلو الأخرى إلى الخيار نفسه، وكذا منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما توج في النهاية بالاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ثم معاهدة 1994 بين إسرائيل والأردن، إلى هدم الذريعة التي بررت بها الصهيونية كل جرائمها ضد الفلسطينيين والعرب، وهي أسطورة “لا خيار”، وأن اليهود مضطرون دائما إلى عدم الثقة بالآخرين، لأنهم دائما مضطهدون، وغرباء. فقد أثبتت هذه التطورات لقسم كبير من الإسرائيليين أن الصراع ليس قدرا ولا حتما، وأن من الممكن التعايش مع الفلسطينيين والعرب في سلام إذا قرروا ذلك وتخلوا عن احتلال الأراضي العربية، وتشكيل تهديد للعالم العربي. وكانت هذه هي دعوة حركات السلام، ومعظم اليسار الإسرائيلي، الذي انبثقت منه “ما بعد الصهيونية”.
جـ- العوامل الدولية:
ترتبط ظاهرة “ما بعد الصهيونية”- شأن الصهيونية ذاتها- بالتحولات الدولية ارتباطا وثيقا، حيث تعتبر الظاهرة الصهيونية، والدولة التي أنشأتها نبتا غربيا، لا يمكن فهمه في غير سياق الحضارة الغربية، ووضع اليهود فيها، ودور إسرائيل في استراتيجيات القوى الكبرى التي ترعى وجودها وتفوقها على محيطها الإقليمي.
ويبدو المدخل المناسب لدراسة أثر العوامل الدولية في ظهور “ما بعد الصهيونية” هو دراسة الاستراتيجية الأمريكية في العالم العربي بعد الحرب الباردة، ودور إسرائيل فيها، وأحوال الأقليات اليهودية في العالم والولايات المتحدة بشكل خاص.
وباختصار، يمكن الافتراض أن تفكك الاتحاد السوفيتي، وما تبعه من تداعيات إقليمية بفقدان العرب سندهم التقليدي في الصراع ضد إسرائيل والصهيونية، والقوى التي تساندهما، ومن ثم القبول العربي بمختلف إملاءات عصر ما بعد الحرب الباردة، من تحول- أو مزيد من التحول- نحو اقتصاديات السوق، وقبول عام بوجود إسرائيل، وبالتسوية الدبلوماسية للصراع العربي- الإسرائيلي، وتواجد عسكري أمريكي مكثف في منطقة الخليج العربي… إلخ.، قد أدى كل ذلك إلى تراجع أهمية إسرائيل (على الأقل بصيغتها الحالية إذا توخينا الحذر) كثروة استراتيجية للولايات المتحدة في هذه المرحلة. فقد اختفى الاتحاد السوفيتي العدو الاستراتيجي الذي اعتبرت إسرائيل رأس حربة لمواجهته، وتم ترويض روسيا، ولم يعد في العالم العربي ممانعة للمصالح الاستراتيجية الأمريكية، إلا من قبل جماعات معينة (“أصولية إسلامية”) لا تزيدها الصبغة الصهيونية الفاقعة إلا اشتعالا وتهديدا لتلك المصالح، وأنظمة معزولة تتولى الولايات المتحدة ترويضها وإخضاعها بنفسها (ضرب السودان ثم العراق مثلا)، أو من خلال المؤسسات الدولية التي تهيمن عليها (العقوبات على العراق وليبيا مثلا).
وهكذا، فإن مصالح الولايات المتحدة العالمية (أي في العالم)، هي وحلفائها المنتصرين في الحرب الباردة، وعلى رأسها إقامة نظام عالمي على أسس النموذج الليبرالي الغربي في السياسة والاقتصاد والثقافة، وعولمة هذا النموذج، بدمج النظم الإقليمية وفواعلها الرئيسة في هذا النظام “العالمي”، تتعارض بلا شك مع الاعتبارات الأيديولوجية والدينية التي لا تنسجم مع هذه المصالح. وهي في ذلك الصهيونية، والقومية العربية، والإسلام، والمسيحية، واليهودية، وأية قيم مطلقة، أو أفكار بالية، تعوق السيولة المطلوبة لإعادة تشكيل العالم، وفرض النموذج الأمريكي المراد عولمته.(22)
ولا يتحدى هذه المقولة كون الأقليات اليهودية الأمريكية المؤمنة في غالبيتها بالصهيونية واقعة في أهم مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة، وبدرجة أقل في الدول الغربية المنتصرة في الحرب الباردة، إذ إن صهيونية هذه الأقليات، منذ بداية ظهور الصهيونية الحديثة، هي صهيونية توطين لا استيطان، ودعم من بعد للمشروع الصهيوني (مشروعها) الذي استهدف التخلص من “جيوش المتسولين” من يهود شرق أوربا الذين هددوا مراكز هؤلاء اليهود الغربيين في مجتمعاتهم الأوربية الغربية، بعد أن اندمج هؤلاء تماما في هذه المجتمعات. كما كانت العلاقة بين اليهود شرق الأوربيين المستوطنين (وفيما بعد إسرائيل التي شكل هؤلاء نخبتها المسيطرة)، وهؤلاء اليهود المندمجين في الغرب علاقة صراع على من تكون له اليد العليا، وهو ما يشار إليه في دراسات الصهيونية بالصراع على المركزية: مركزية إسرائيل في مواجهة مركزية “الشتات” أو “الدياسبورا” حسب تعبير الصهيونية. وهو صراع لم يزل قائما، ويتجلى في كثير من الأمور الجوهرية مثل تحديد من هو اليهودي، والعلاقة بين إسرائيل والمنظمة الصهيونية. ولذا يمكن القول بثقة كبيرة إن تأييد يهود الغرب لإسرائيل في المواقف المختلفة ينبع من تلاقي المصالح الإسرائيلية مع مصالح دولهم وليس لكونهم يهودا (ذوي صيغة مخففة من اليهودية)، أو صهيونيين (متملصين من الصهيونية والتزاماتها وأولها الهجرة إلى إسرائيل التي تشكل روح الصهيونية).(23)
ويرتبط بحقيقة أن هؤلاء اليهود الغربيين لا يفضلون الهجرة إلى إسرائيل على البقاء في “الشتات” أو “المنفى” كما تدعي الصهيونية، وأن كل من تنتظر إسرائيل هجرته قد هاجر بالفعل، وبالأحرى أن متسولي أوربا الشرقية الذين كانوا يهددون استقرار أوربا الغربية ويهودها قد هاجروا أو تم التخلص منهم، الاستنتاج المنطقي أنه لم يعد ثمة مبرر للصهيونية، على الأقل بشكلها التقليدي (الأوربي). ويدعم ذلك، ويترافق معه، أن الدول الأوربية التي أفرزت الصهيونية، وضمنت وجود إسرائيل وبقاءها مقابل رعاية هذه الأخيرة لمصالحها في العالم العربي، قد سلمت منذ زمن بعيد قيادة النظام الدولي وعقد تبادل المنافع الاستراتيجية مع إسرائيل إلى الولايات المتحدة، ليتغلغل نموذج هذه القيادة الجديدة في إسرائيل، (وفي تلك الدول الأوربية ذاتها) وهو نموذج مختلف في بعض جوانبه- وإن كانت خلفيته الحضارية العلمانية أوربية- عن النموذج الأوربي الذي اشتقت منه الأنظمة الإسرائيلية.
ويمكن القول إن هاتين النتيجتين (لا مزيد من الهجرة، وهيمنة النموذج الأمريكي على إسرائيل) قد أفرزتا نتيجة ثالثة، وهي تغليب الهوية الإسرائيلية على الهوية اليهودية- الصهيونية، بل حتى تغليب المصلحة الفردية على المصلحة الإسرائيلية العامة. ومن تكرُّس هذا الاتجاه تتولد ظاهرة “ما بعد الصهيونية” كفكر وكحركة، ويتوقع لها أن تسود المجتمع الإسرائيلي، كما سيكون من دواعي سرور يهود الغرب، وفقا لهذا التحليل أن يتبنوها، ويتخففوا من كثير من أعباء إسرائيل والصهيونية. ولعل هذا هو ما يحدث بالفعل، لا سيما أن دعاوى “ما بعد الصهيونية” ليست لها مطالب استقلالية عن الولايات المتحدة، ولا تهدد مصالحها، كما سيتبين من دراسة مقولاتها، ولا تستطيع ذلك، بل إنها تندمج مع “حركات السلام” في تحقيق نفس الأهداف الأمريكية الجديدة في العالم العربي.
وفي هذا السياق نستطيع أن نفهم الآن دلالة أخرى، غير أكاديمية، للتمييز الهام بين وصف “المؤرخين الجدد” و”المؤرخين التصحيحيين” الذي أوضحه إيلان بابي، فالأول صنيع المدرسة الأوربية في التاريخ، والثاني صنيع المدرسة الأمريكية، وهو الذي تتمثله “ما بعد الصهيونية”، كمحاولة لتفهم العدو (السوفيتي بالنسبة لمؤرخي الحرب الباردة من الأمريكيين التصحيحيين، والفلسطيني أو العربي بالنسبة إلى مؤرخي ما بعد الصهيونية التصحيحيين الإسرائيليين)! وتثير هذه النتيجة التساؤلات التالية: إذا كان التأريخ التصحيحي الأمريكي يعيد النظر في مرحلة الحرب الباردة، بعد انتصار الولايات المتحدة في هذه الحرب وانتهاء الصراع لصالحها، فهل تشعر إسرائيل بأنها في وضع مماثل بالنسبة إلى الفلسطينيين والعرب اليوم؟ وهل انتهى الصراع العربي- الإسرائيلي في تصور تصحيحيِّي المؤرخين الإسرائيليين لصالح إسرائيل؟ أم أن ما يحدث هو محض استجابة إسرائيلية للترتيبات الأمريكية الجديدة في النظام الإقليمي العربي، وعملية “صنع السلام” بين العدوين الإسرائيلي والعربي، التي تقتضي (في الجانب الأكاديمي من هذه العملية) أن يتفهم كل منهما الآخر، ويعيد النظر في تاريخ الصراع بينهما؟ وهنا يمكن التساؤل عن علاقة “ما بعد الصهيونية” بحركات السلام، ومراكز صنعه، التي تمولها الولايات المتحدة وحلفاؤها في إسرائيل وغيرها. (سبق تعريف واحد من أبرز أساتذة السياسة ما بعد الصهيونيين (إيلان بابي) بأنه المدير الأكاديمي لمعهد جفعات حفيفا لأبحاث السلام) كما يمكن التساؤل عن وجود مراكز وشخصيات أكاديمية تمارس الفعل نفسه في الدول العربية في المقابل!
يوضح إليعيزر شفايد تأثيرات عامل ما بعد الحداثة الأمريكي في المجتمع الإسرائيلي التي ساهمت في ظهور تيار “ما بعد الصهيونية”، حيث يؤكد “أن الصهيونية، كحركة قومية ديمقراطية، تطورت على خلفية، وتحت رعاية الفلسفة القومية الديمقراطية في أوربا الغربية، وأن المذهب الليبرالي الديمقراطي الأمريكي، في المقابل، هو مذهب لا قومي، وإلى حد كبير معادٍ للقومية وفردي إلى أقصى الحدود؛ وفي نموذجه الأساسي، ينظر إلى الدولة باعتبارها ملكا لمواطنيها، خلافا للدولة- الأمة التي هي ملك للأمة بصفتها كائنا تاريخيا وبالتالي فإنه [أي هذا المذهب] يعتبر الدولة مسئولة عن رفاه وسعادة مواطنيها كأفراد، لا عن استمرار بقاء الأمة ككائن مستقل ذاتيا.”
ويزيد شفايد: “إن تبني مفاهيم الديمقراطية الليبرالية هذه، وتقبل روحية الفردية والمنافسة المقترنة بهذه المفاهيم، والإحساس بأن دولة إسرائيل ظلمت الفلسطينيين- بمن فيهم من كانوا مواطنين إسرائيليين- كل ذلك أدى إلى انحلال الفهم القومي الأساسي الذي اشتُقَّت منه الديمقراطية الإسرائيلية في الأصل”،(24) أي الدولة اليهودية، وأدى إلى ظهور “ما بعد الصهيونية”.
ولعل هذا الفهم “القومي” كان ضروريا ومناسبا أيضا في بداية الأمر نظرا إلى وجود من يتبناه وينتفع به، وهم يهود شرق أوربا الذين شكلوا معظم المستوطنين الأولين ونشأت الصهيونية من أجل التخلص من عبئهم، وبعد أن عولجت مشكلتهم بإنشاء دولة لهذه “القومية اليهودية” المزعومة، وهجرة هؤلاء اليهود إليها، أو بإبادة بعضهم، لم يعد لهذا الفهم ضرورة! ويلاحظ هنا أن الصياغات الصهيونية، وما بعدها تناسب الواقع وظروف اليهود في التشكيل الحضاري الغربي خطوة بخطوة، كما تناسب التغير في موازين القوى كذلك. حيث يلائم ذلك النموذج القديم حالة التبعية للقوة أو القوى الأوربية التي رعت الصهيونية في فترة التعددية القطبية الأوربية، وفكرة الدولة القومية/ العضوية التي قامت عليها. ولا شك أن تبعية إسرائيل الشاملة للولايات المتحدة بعد ذلك قد فرضت التحول عن الفهم القديم، وتبني نموذجها ولو كان مدمرا لإسرائيل بمعايير الهوية اليهودية- الصهيونية، وذلك ما يفسر تصاعد الصراع الداخلي وحدة الاستقطاب في إسرائيل في الوقت الراهن. وإذا كانت الولايات المتحدة تحاول من خلال فرض هذا النموذج دمج إسرائيل في محيطها الإقليمي وتخفيف عبء الدفاع عنها، فإن في هذا انتصارا لإسرائيل من ناحية، وراحة لليهود الغربيين المندمجين، من ناحية أخرى، حينما تتحول إسرائيل إلى عضو شرعي في محيطها الإقليمي، وتخْفُت حدة المطالب الصهيونية لهم بالهجرة، أو الدعم، الذي يعرضهم في كثير من الأحيان للحرج.
وفي هذا السياق نفسه، يمكن أن نتذكر مجددا تأثير الدولي (الأمريكي) في الداخلي (الإسرائيلي) باعتبار ظاهرة “ما بعد الصهيونية” في أحد جوانبها، انعكاسا للتمرد على فكرة بوتقة الصهر، الذي سبق ظهوره في الولايات المتحدة، وانتقل بالتبعية (أو بالتماثل كون المجتمعين مجتمعي مستوطنين من أمم شتى) إلى إسرائيل.
كما يشار أخيرا إلى عامل هامشي، هز شرعية الصهيونية المزعومة، ووضع كثيرا من مؤيديها في حرج، وخاصة خارج إسرائيل، وهو قرار الأمم المتحدة في سنة 1975، الذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية. وقد اتُّخذ هذا القرار بُعيد حرب أكتوبر 1973، التي ردت جزءا من الاعتبار العالمي للموقف العربي في الصراع ضد إسرائيل والصهيونية. وعلى الرغم من أن هذا القرار قد قوبل بالرفض من قبل إسرائيل، واعتبرته نوعا من الظلم والعدوان على روح الدولة الصهيونية، وتجاوبا مع مصالح أعدائها، فإنه، بلا شك، قد نال من سمعة الصهيونية وزعمها أنها حركة تحررية قومية أخلاقية، وأفقدها جزءا من مصداقيتها غير الكاملة لدى اليهود وغيرهم. وعلى الرغم من أن هذا القرار أُلغي في مطلع التسعينيات، فإن ذلك الإلغاء، الذي جاء متناقضا مع تطور النظام الدولي وفكرة العولمة، لم يلغ حقيقة أزمة الصهيونية، والحاجة إلى مراجعتها أو استبدالها، لأسباب موضوعية داخلية وخارجية.
ثالثا، مقولات ’’ما بعد الصهيونية’’:
نظرا إلى أن “ما بعد الصهيونية” لا تمثل اتجاها نحو شيء محدد بصفتها ظاهرة “ما بعد حداثية” بقدر ما تهتم بنقد الصهيونية، فإنه قد يكون من المفيد التعرف على أهم انتقاداتها للصهيونية، وإجراء تحقيق لمواقف المفكرين المنتمين إلى هذه الظاهرة بشأن قضايا محددة، تمثل الأسس المشتركة لكافة الصهيونيات التي يفترض في “ما بعد الصهيونية” تجاوزها.
أ- الانتقادات الموجهة إلى الصهيونية:
1- نقد التفكير الأيديولوجي:
يرى جرشون شافير، وهو أحد أقطاب ظاهرة ما بعد الصهيونية أنه “في حين أن الأساطير تضخم النزاع وتنقله إلى مستوى كوني، حيث يكتسب سمات نزاع لا يمكن حله، [مثل عدم قابلية اليهود للاندماج في المجتمعات غير اليهودية] فإن ثمة مكونا مهما من التفكير الأيديولوجي، هو أنه يخفي التناقضات الاجتماعية خلف واجهة من العلاقات الاجتماعية المتجانسة. وتحاول الأيديولوجيات عامة أن تنفي أو أن تخفي التناقضات التي تظل بلا حل. ويتم هذا الأمر من خلال إظهار المصالح الخاصة لطبقة أو لحزب أو لأمة ما أنها تقدمية مستقبلية، بل حتى ثورية، وبالتالي تمثل مصالح المجتمع الأوسع ككل. والهيبة التي تعطى لمثل هذه المجموعة الثورية [الممثلة للمصالح المعنية] تتيح لها أن تفرض سلطتها المعنوية وزعامتها السياسية على الجماعات الأخرى. والتفكير الأيديولوجي هو أيضا الرواية الغائبة النموذجية بالنسبة إلى القومية الحديثة. وفي هذا القالب جرى النظر، في معرض استعادة أحداث الماضي، إلى “حركة العمل” ومؤسسيها من موجة الهجرة الثانية كأنهم كانوا عازمين منذ البداية على تشكيل التاريخ على غرارهم”.(25)
ويعتقد شافير أنه رغم أهمية الأيديولوجيا بالنسبة إلى الدول الطبيعية، فإنه من الأفضل للمؤرخين الإسرائيليين أن يتبنوا أسلوبا علميا في التفكير، ويكتبوا تاريخا مستقلا عن الدعاية الصهيونية. ويقول: “لقد تخلت النظريات المعاصرة عن الاعتقاد بأن الأسطورة والأيديولوجيا أسلوبان في التفكير بدائيان أو غير صائبين ينبغي استبدالهما بالبحث العلمي؛ إذ لا ريب في أنهما يؤديان أدوارا ثقافية مهمة. لكنني أرى أن قيام تاريخ مستقل أمر مرحب به، ولا سيما في ثقافة سادتها الأسطورة والأيديولوجيا زمنا طويلا”.(26)
2- الجدل حول أساس الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي:
تذكر الرواية الصهيونية للتاريخ أن الصراع الفلسطيني (العربي)- الإسرائيلي نشأ أساسا بسبب معاداة الفلسطينيين والعرب لقيام الدولة الإسرائيلية، التي قامت على مُثُل اشتراكية وليبرالية غربية، الأمر الذي يجعل الصراع هنا صراعا بين الخير والشر، بين التقدم الغربي والتخلف العربي، بين الحق اليهودي في فلسطين وممانعة العرب في تقديم هذا الحق لليهود، بين الديمقراطية اليهودية/ الإسرائيلية والهمجية العربية.. إلخ.– وهذا هو الجانب الأسطوري للصهيونية- وتنظر إلى الفلسطينيين والعرب باعتبارهم مجرد عقبة كان على المستوطنين الأولين تخطيها. وفي المقابل، يؤكد أنصار “ما بعد الصهيونية” أن الانفصال، ومن ثم الصراع، بين الفلسطينيين والمجتمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين كانا النتيجة وليس السبب لطبيعة الاستيطان الاستعماري اليهودي هناك، وكونه استعمارا استيطانيا إحلاليا؛ فقد نشب النزاع بين نموذجين استعماريين تطورا عبر تاريخ الاستيطان اليهودي في فلسطين ما بين موجتي الهجرة الأولى (1882-1903) من ناحية، التي سعت إلى إنشاء مستعمرة زراعية إثنية تقوم على شراء اليهود الأراضي العربية واستغلال اليد العاملة العربية فيها، ومن الناحية الأخرى، موجة الجرة الثانية (1903-1914)، التي سعت إلى إنشاء المستعمرة اليهودية الصافية، واستخدام اليد العاملة البيضاء في مختلف الأعمال والمهارات، وسعت بذلك إلى الحلول محل السكان الأصليين في سوقي العمل والأرض، وهو النموذج الذي ساد في النهاية، وكانت الكيبوتسات أكبر شواهده، حيث لم يك من الممكن لفلسطيني شراء الأراضي التي يملكها اليهود، و لا العمل فيها. وإذا كان النموذج الأول سعى إلى تهميش العرب واستغلالهم، فإن النموذج الثاني سعى إلى استبعادهم. ومع تطور المشروع الصهيوني قام باستئصال أعداد كبيرة من السكان الأصليين من خلال الغلبة. وهكذا فإن طبيعة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي الإحلالية هذه هي التي ولدت الصراع، وإخفاء هذا الصراع تحت غمامات أسطورية وأيديولوجية أطال من أمده وساهم في تصعيده ليصبح صراعا عربيا- إسرائيليا شاملا.(27)
3- تفنيد مقولة ’’عبء اليهودي الأبيض”:(****)
اعتبرت الصهيونية (العمالية) أن “المنافع الاقتصادية للاستيطان اليهودي بالنسبة إلى الصهيونيين هي الرد الحاسم على القومية العربية، وأنه كان من المنتظر أن تستفيد الجماهير العربية من التحديث الذي جلبته الهجرة والاستيطان اليهوديان. لذا كانت الحجة تقول إن الدوائر الضيقة فقط من النخبة- أي طبقة الأفندية ملاك الأرض، والطبقة الوسطى المسيحية، ومن ثم الزعامات الرجعية للدول العربية- هي عدو الصهيونية”.(28)
ويرد شافير على هذه المقولة بأن “التحديث الذي مارسته الحركة الصهيونية في فلسطين كان جزءا لا يتجزأ من علاقة استعمارية؛ فأهداف الاستيطان اليهودي، أي احتلال العمل.. واحتلال الأرض.. هذه الأهداف جميعها كانت قومية وتستثني الآخر… والواقع أن مؤسسات الحركة العمالية كانت هي الأقل قدرة على العودة بالنفع على عرب فلسطين.”(29)
تفنيد مقولتي “أرض بلا شعب” و “المجتمع المزدوج”:
حاولت الصهيونية تقديم طرح آخر لعلاقتها مع السكان الأصليين غير نموذج عبء اليهودي الأبيض، هو نموذج الانفصال القومي، الذي يتم التعبير عنه في الأدبيات الصهيونية بالمجتمع المزدوج، والاقتصاد المزدوج، ويمكن تلمس تطبيقات لهذا النموذج كذلك في برامج حزب العمل واليسار الصهيوني، واتفاق أوسلو، القائم على الفصل بين السكان اليهود والفلسطينيين في فلسطين (ككل)، وهو ما يطلق عليه “الحل الجغرافي”. ويفترض هذا الطرح أن المهاجرين اليهود لم يكن في استطاعتهم استغلال الفلسطينيين لأن المجتمعين ظلا منفصلين. وينتقد شافير(30) هذا الطرح الصهيوني لتاريخ العلاقات الفلسطينية- اليهودية أيضا بقوله: “لا ريب في أن المجتمعين كانا على درجات مختلفة من النمو، وكذا الاقتصادان، إذ لو لم يكن الأمر كذلك لما قُيِّض للاستيطان اليهودي الاستعماري النجاح. غير أن .. المجتمع اليهودي ما كان له أن يبقى مكتفيا بذاته ما دام عازما على التوسع. فقد كان الييشوف [المجتمع الاستيطاني اليهودي قبل إعلان الدولة الإسرائيلية] يتفاعل مباشرة مع المجتمع الفلسطيني، ومن خلال شراء أرضه حد من مصادر رزقه التقليدية، وفي وقت لاحق اقتلع من الجذور جزءا كبيرا من سكانه من خلال الغلبة”.
أما القول بأن الاستيطان الصهيوني كان استيطانا استعماريا لكن دون مضمون استعماري (وهو زعم مضحك) فإن “هذا الأمر لا يصح إلا إذا كان التدخل قد تم في بلد خال من السكان. فالعداوة الجوهرية بين السكان الأصليين والمهاجرين تنبع أساسا من إصرار المهاجرين على أن الأرض التي اختاروها أرض خالية من قوميات أخرى. وعمليا، كان هذا يعني أن القادمين الجدد نظروا إلى السكان الأصليين أنهم جزء لا يتجزأ من البيئة الواجب إخضاعها وترويضها وجعلها قابلة للعيش بالنسبة إليهم. أما السكان الأصليون، الذين تعرضوا لفقدان أملاكهم الموروثة وانتابهم الفزع من أن أرضهم ستصبح مع مرور الزمن خالية منهم حقا، فقد عزموا على الدفاع بالقوة عما بقى لهم”.
ب- موقف ما بعد الصهيونية من قضايا الصهيونية:
1- قانون العودة:
يرى أنصار :ما بعد الصهيونية” في قانون العودة اليهودي قانونا تمييزيا ضد الفلسطينيين، وفي حين يدافع البعض عن هذا القانون من منطلق إنساني إذ يوفر- حسب الزعم الصهيوني ملاذا لليهود في العالم من الاضطهادات المحتملة، ويشبهونه بقوانين إعادة التوطين في بلدان أخرى،(31) فإن “ما بعد الصهيونيين” ينتقدون هذه المزاعم. ويقول بابي:(32) “يذهلني أن يخطر في بال من هو في نظري قانوني لامع (وزير المعارف السابق في حكومة العمل أمنون روبنشتاين) أن القراء لا يدركون أن الهدف من قانون العودة الإسرائيلي، خلافا لقوانين إعادة التوطين في أمكنة أخرى، هو إقامة تمييز ضد سكان محليين موجودين سلب منهم حقهم الطبيعي في المواطنة باسم قانون العودة. كما أن أي قانون إعادة توطين في أي مكان آخر في العالم لا يضمن سلفا للعائدين حقوقا تمنحهم أفضلية على مواطني الدولة القانونيين”.
ويرى بني موريس أن قانون العودة سيبطل بصورة طبيعية لا أيديولوجية، بسبب مشكلات استيعاب المهاجرين إلى إسرائيل، حيث لم يعد هناك مكان لاستيعاب مزيد من المهاجرين، وأن مصالح الموجودين في إسرائيل أهم من مصالح من يحتمل أن يهاجروا إليها.(33)
2- طبيعة الدولة الإسرائيلية ووضع الفلسطينيين فيها:
تتفاوت مواقف الإسرائيليين بشأن طبيعة الدولة، دينية، علمانية، يهودية، ديمقراطية تعددية، ويميل أنصار “ما بعد الصهيونية” إلى إضفاء الطبيعة الديمقراطية التعددية على الدولة الإسرائيلية، حيث يعتبر أحد أهم انتقاداتهم للصهيونية هو احتكارها الرؤية وفرضها على الجميع رغم ما يعانيه المجتمع الإسرائيلي من تمايزات لم تأخذها الصهيونية في الاعتبار.
وإذا كان بني موريس مثلا، يؤيد استمرار الطبيعة اليهودية لإسرائيل،(34) فإن بعض الاجتماعيين النقديين يدعو إلى طبيعة ديمقراطية تعددية للدولة، على خلاف الطبيعة اليهودية الأرثوذكسية الراهنة التي تستبعد العرب، وتضيق على العلمانيين واليهود غير الأرثوذكس. وفي هذا المجال ينتقد باروخ كيمرلنج (أستاذ الاجتماع بالجامعة العبرية في القدس)(35) تأسيس شرعية الوجود الإسرائيلي على منطلقات دينية يهودية، وينتقد كذلك مؤسسات الدولة وقوانينها الأساسية اليهودية، التي كرست نظام الملل الذي ورثته من الحكم العثماني والحكم الاستعماري البريطاني، فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية والقضاء الشرعي، وإدخال عناصر دينية- يهودية في القوانين المتعلقة بالمناسبات الرسمية وأيام العطل وحرية العمل وما شابه. أما القوانين ذات الطابع العلماني التي لم تصطبغ بصبغة يهودية- دينية، مثل قانوني العودة والجنسية، فيرى أنها حملت بأهداف صهيونية تمييزية ضد الفلسطينيين الذين هربوا أو أرغموا على الهرب من الأراضي التي وقعت تحت سيطرة الدولة، وضد أولئك الذين بقوا داخلها ومنعوا من لم شمل عائلاتهم. كما سخرت قوانين أخرى مثل قانون مكانة الهستدروت الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية لتحقيق منافع خاصة لمواطني الدولة اليهود فقط، مثل قوانين الخدمة الأمنية الخاصة بمنح منافع لليهود على حساب العرب، والاتفاق بين الصندوق القومي اليهودي وبين إدارة أراضي إسرائيل الذي يمنع تأجير أراضي الدولة البالغة مساحتها 93% من الأراضي الواقعة داخل الخط الأخضر لغير اليهود. وفي حين عملت المحاكم ومحكمة لعدل العليا خاصة في الأعوام الأخيرة من أجل تأسيس دولة قانون مستنيرة وعصرية، فقد كان ذلك داخل إطار الحدود اليهودية للدولة، وهكذا فإن المحاكم كانت في الخمسينيات والستينيات وسيلة لسلب المواطنين العرب أراضيهم ولم تقدم أية مساعدة للمتضررين من الحكم العسكري سيئ الذكر.
3- عودة اللاجئين الفلسطينيين:
إذا كانت المقولة الأساسية لظاهرة “ما بعد الصهيونية” هي أن قيام دولة إسرائيل قد انطوى على كارثة للشعب الفلسطيني، تمثلت في اقتلاع جزء كبير من هذا الشعب من أرضه، وتعرض الجزء الآخر للقمع وللقتل، فإن المثير للنظر هو أن أنصار “ما بعد الصهيونية”، وإن كانوا يتعاطفون مع حق مطالبة الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه، لا يقدمون في الغالب تصورا لما يجب أن يصحح به هذا الخطأ/ الخطيئة التي ولدت بها إسرائيل، الذي يتمثل حسب الرؤية الفلسطينية العربية في عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم في فلسطين 1948، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين في إسرائيل ذاتها.
ينتقد بابي مثلا وصف أمنون روبنشتين لتحليل الصهيونية بوصفها استعمارا بأنه صنيع أكاديميين مبتدئين، ويقول: “أمة فلسطينية بأكملها تحولت إلى لاجئين وتطالب لا بإقامة دولة فحسب، بل أيضا بالعودة إلى وطنها (اليهود أرادوا أن يفعلوا ذلك بعد ألفي عام، والفلسطينيون يطالبون بذلك قبل مرور خمسين عاما). ولو لم يأت اليهود إلى هنا لما أصبح الفلسطينيون لاجئين. ولم يسع أحد، باستثناء اليهود العائدين، لاقتلاعهم، أو طالب لنفسه بوطنهم. وهذا هو الموضوع وليس شهادة هذا أو ذلك من قادة السرايا في البلماح”.(36) ولكنه لا يتجاوز في الواقع تحميل إسرائيل المسئولية عن قضية اللاجئين، دون أن يطرح حلا لهذه القضية.
وقد انتقد باروخ كيمرلنج(37) بالفعل هذا التجاهل من قبل مفكري “ما بعد الصهيونية” لهذه المسألة المحورية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، موضحا أن مختلف المقاربات لهذه القضية تهتم بالمسائل العقيمة والهامشية دون أن تعالج هذه المشكلة، إذ تركز على الاتهام والشعور بالذنب دون المساهمة في طرح بدائل عملية. ولكنه هو أيضا- في معرض مناقشته لكتاب إليا زريق حول هذه المشكلة- اكتفى بمدح المؤلف لكونه تجاوز النقد الأيديولوجي لإسرائيل، وشرع في تحديد المشكلة تحديدا علميا ببحث أعداد اللاجئين، واستطلاعات آرائهم بشأن العودة إلى فلسطين أو البقاء في البلدان التي لجأوا إليها. ولذا يكتفي كيمرلنج بإبراز المشكلة على نحو عملي، وعوامل استمرارها، وخطورة عدم حلها دون أن يفضل أيا من الحلول المطروحة: العودة إلى نفس القرى التي أخرجوا منها، أم الذهاب إلى الدولة الفلسطينية التي لم يكونوا يوما من سكانها، أم البقاء في منفاهم.
4- الأراضي المحتلة والاستيطان:
لا يقدح مفكرو “ما بعد الصهيونية” في وجود إسرائيل. ويقول بني موريس: “…أعتبر نفسي بالتحديد مواطنا وصهيونيا. وأعتقد أن من حق كل شعب أن تكون له دولة، بما في ذلك الشعب اليهودي، وأؤيد قيام الدولة اليهودية، على الرغم من الظلم الشديد الذي لحق بالفلسطينيين من جراء ذلك، وأؤمن باستمرارية هذه الدولة كدولة يهودية”!(38) ويفضل جميعهم حل تقسيم فلسطين، بصرف النظر عن حدود هذا التقسيم، على اعتبار أن ذلك يحقق لكل من الطرفين جزءا من مطالبه التي لا يمكن تحقيقها كاملة، وهي في ذلك فكرة “أرض إسرائيل الكاملة” التي يؤمن بها اليمين الإسرائيلي، وفكرة “تحرير فلسطين من النهر إلى البحر” التي يؤمن بها القوميون والإسلاميون من الفلسطينيين والعرب. ويرى شافير(39) أن “إعادة الانتشار الإسرائيلية من قطاع غزة وأريحا، ولاحقا من المراكز المدينية في الضفة الغربية، بدأت عملية جزئية من تصفية الواقع الاستعماري، سحب أدوات سيطرته السياسية والعسكرية الذي يتوقع أن تتبعه إزالة المستوطنات…”.
ويضيف: “وحيث أن المستوطنين اليهود في فلسطين لم يكن لهم وطن أم مستعمر يعودون إليه بعد تصفية الواقع الاستعماري، فإنهم تطوروا مع الوقت ليصبحوا هم أيضا سكانا أصليين. وهذا الاختلاف أمر تجاهلته منظمة التحرير الفلسطينية التي أملت حتى أوائل السبعينيات بأن تحاكي جبهة التحرير الجزائرية في طرد المستوطنين الفرنسيين من الجزائر، من خلال تحرير فلسطين من مستوطنيها اليهود. إن التحقيق الجزئي لأهداف المستوطنين المهاجرين الذين تجذروا في العمق وأسسوا مجتمعا ذا سمات ثقافية وإثنية ودينية مميزة يعني أن تصفية الواقع الاستعماري المطلوبة لصنع السلام في إسرائيل، كما أدركت منظمة التحرير ذلك، ستكون جزئية أيضا، وستتم في الغالب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وبالإضافة إلى ذلك فإن الفلسطينيين الذين أصبحوا مواطنين إسرائيليين ويملكون حقوقا مدنية وسياسية، بما في ذلك حق التصويت، برهنوا عن اندماجهم الجزئي داخل إسرائيل، وذلك بعدم مشاركتهم في انتفاضة الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال العسكري… لكن في كثير من الحقول الأخرى، كالتوظيف والحقوق الاجتماعية والتربوية، بقي هؤلاء الفلسطينيون.. مواطنين من الدرجة الثانية. إن معضلة العلاقات بين الأكثرية اليهودية والأقلية العربية تكمن فيما إذا كان سيتم الاعتراف بالأقلية العربية أقلية قومية لها حقوق ناجمة عن ذلك، أو ما إذا كان سيتم منحها خيار الاندماج كأفراد في كثير من المؤسسات التي يحظر على هذه الأقلية دخولها عرفا وقانونا. ومن شأن أية مقاربة من هاتين المقاربتين أن تضيف قدرا من تصفية الواقع الاستعماري الداخلي إلى عملية تصفية الواقع الاستعماري في الضفة والقطاع.” ويرى شافير أيضا أن “تدهور مؤسسات الدولة مع تزايد النزعة الليبرالية أدى إلى تراجع أيديولوجية الاستيطان ومؤسساته، التي نزعت الشرعية عن حقوق الفلسطينيين الوطنية”.
5- العلاقات مع العالم العربي:
ينتقد أنصار ما بعد الصهيونية الصهيونية من منطلق أنها صعدت الصراع الفلسطيني- اليهودي داخل فلسطين ليصبح صراعا عربيا إسرائيليا معقدا، ووضعت إسرائيل في محيط إقليمي عدائي بأفعالها هي التي أنكرت الحق الفلسطيني، وبررت ذلك بحجج أيديولوجية أسطورية. ولذا تتضمن دعواهم نزعة إلى تصحيح الخلل القائم في بنية الوجود الإسرائيلي من خلال تطبيع الدولة على المستوى الداخلي بإضفاء الطبيعة الديمقراطية عليها، وتصفية الواقع الاستعماري الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن ثم تطبيع علاقاتها بالنظام الإقليمي العربي الذي تقع إسرائيل على حدوده. وفي هذا الصدد يوضح بابي مثلا أن التحرر ما بعد الصهيوني من “القيود المزيفة للموقف الليبرالي القومي أو الاشتراكي الديمقراطي (الصهيونيين)… ليس تباهيا خلقيا وتظاهرا بالورع، ولا يتم باسم منظومة القيم الخلقية هذه أو تلك. إن هذا التحرر هو قبل كل شيء استجابة لواقع نزاع طويل، ولعدم استقرار اجتماعي، ولاغتراب إسرائيل عن العالم المحيط بها”.(40)
ومع ذلك يلاحظ أن تركيز ما بعد الصهيونية ينصب على الأبعاد الداخلية ولا يولي اهتماما كبيرا لمسألة الاندماج الإقليمي.
رابعا: تقويم ظاهرة ’’ما بعد الصهيونية’’:
لعل أهم ما يمكن استخلاصه من الاستعراض العام السابق لظاهرة “ما بعد الصهيونية” هو أنها تلمس بوضوح حقيقة أزمة شرعية الوجود الإسرائيلي، وأن وجود إسرائيل إنما تم على حساب مجتمع فلسطيني متطور، وألحق ضررا بالغا بهذا المجتمع القائم بالفعل من أجل إقامة مجتمع آخر متصور. وتلتقي أعمال “ما بعد الصهيونية” المختلفة على هذه المقولة، لكنها في الوقت نفسه لا تتجاوز إقرار حقيقة طالما أنكرتها الصهيونية ومؤسساتها، وكافح الفلسطينيون والعرب من أجل تأكيدها. ولا يتطرق أي من علماء “ما بعد الصهيونية” إلى حل أزمة الوجود الإسرائيلي، ولكنهم يركزون فقط على أزمة هوية إسرائيل المشتعلة المتفرعة من تلك الأزمة، وذلك من خلال تطبيع هذه الدولة، وإضفاء الطبيعة الديمقراطية عليها، وتأكيد الهوية الإسرائيلية لسكانها. وهو ما يجعل من الممكن وصفهم بأنهم “أنصاف المنصفين”، إذ توصلوا إلى جوهر الأزمة، ولكنهم يهربون من مواجهتها مواجهة جذرية، بإعادة الحق المغتصب إلى أهله.
ويلاحظ أن تعامل “ما بعد الصهيونية” مع الأبعاد التاريخية للأزمة الصهيونية/ الإسرائيلية قد تم بتفصيل ورصانة، وروعيت فيه الموضوعية والتماس الحقيقة، وانتقدت فيه مقولات الصهيونية من أسسها، ولكن عند الانتقال إلى الحاضر، وما ينبغي أن يتم تصحيحا للخلل الذي ترتب على الصهيونية وإنشاء إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني، والأمة العربية المسلمة، فإن “ما بعد الصهيونية” تنغمس في إغراءات الوضع الراهن الذي تكرست فيه دولة إسرائيل، بصرف النظر عن عدالة الأسس التي قامت عليها. وإذا كانت الصهيونية ادعت ليهود العالم حقا (شرعية وجود) في فلسطين، سواء أكان ذلك الحق المزعوم دينيا أم تاريخيا أم خارجيا استعماريا، فإن “ما بعد الصهيونية” ادعت لهم حقا أمر واقعي. وهي حجة لا تبرر، من وجهة نظر بعض الأطراف العربية على الأقل، استمرار إسرائيل، ولا تقسيم فلسطين، ولكنها تضمن فقط لهؤلاء الذين يريدون البقاء في فلسطين العربية- الإسلامية من اليهود، دون اعتداء على أهلها وهويتها، حق المستأمِن. ويميل أنصار “ما بعد الصهيونية” إلى فكرة “العدالة التقسيمية” التي أقر بها اليسار الإسرائيلي في أواسط الأربعينيات، ثم تطورت إلى شعار “دولتين لشعبين”، ومبدأ الفصل الجغرافي، الذي لا يمس الوجود الإسرائيلي، ولكن يتطرق وحسب إلى جزء من الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد عشرين عاما من تأسيسها. ويظهر ذلك الأمر جليا في اقتصار الانتقادات “ما بعد الصهيونية” على الطبيعة التمييزية لقانون العودة مثلا دون دعوة صريحة إلى إلغائه، أو إعادة المستوطنين الجدد على الأقل إلى بلادهم الحقيقية، وتجاهل مسألة عودة اللاجئين الفلسطينيين، وهي القضايا التي تمس إسرائيل ذاتها وليس الأراضي المحتلة في 1967. أما مسألة منح حقوق متساوية للعرب والإسرائيليين في إسرائيل، فهي لا تعتبر من قبيل مراجعة الصهيونية بقدر ما هي معالجة للواقع الإسرائيلي، وأزمة الهوية وتَهَدُّد “الديمقراطية الإسرائيلية” في الوقت الراهن، الذي ترتفع فيه موجة التطرف الديني، وتتطلب تضافر الجهود العربية واليهودية العلمانية لمواجهتها، أو حتى تحييد الطرف العربي داخل إسرائيل ومنعه من استغلال ذلك الصراع من أجل الحصول على مكاسب جوهرية. وهذا كله لا يخرج عن استمرارية التعامل الصهيوني التكتيكي مع المشكلات الجوهرية التي تعانيها الدولة الإسرائيلية.
لكل ذلك يمكن افتراض أن ظاهرة “ما بعد الصهيونية” ربما لا تعدو في جوهرها عملية التأسيس العلمي لوجود إسرائيل واستمرارها وتأكيد الهوية الإسرائيلية، بعد أن تهاوت الأسس الأيديولوجية والأسطورية لذلك الوجود، ولم تعد مقنعة ولا قابلة للحياة في الواقع الراهن. ولذا فإن ما تقابل به هذه الظاهرة من انتقادات إسرائيلية لا يعدو أن يكون نوعا من عدم الاتساق مع الذات، وصعوبة في التكيف، وهما مشكلتان طالما عانتهما التيارات الصهيونية، كل بدرجة أو أخرى، ذلك إذا طرحنا جانبا احتمالات التآمر والخداع والدعاية التي تزين هذه الظاهرة في أعين العرب من خلال إظهارها بمظهر الظاهرة الهامشية المنبوذة في إسرائيل وسط خضم صهيوني منغلق وعدواني، التي تحتاج إلى الدعم أو حتى التبني.
______________
الهوامش
(1) عبد الوهاب المسيري، موسوعة تاريخ الصهيونية، ج.1، القاهرة: دار الحسام، 1997، ص.: 23 وما بعدها.
(2) المرجع السابق، مواضع متفرقة.
(3) المرجع السابق، ص.: 45-49.
(4) المرجع السابق، ص.: 48 وما بعدها.
(5) المرجع السابق، ص.: 76 وما بعدها. وأيضا: ص.: 98-99. وللمؤلف نفسه: الأيديولوجية الصهيونية- دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة، 60، الكويت: المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، 1982، ص: 191 وما بعدها.
(6) أليعيزر شفايد، أهداف الصهيونية اليوم، في: مجلة الدراسات الفلسطينية،33، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1988، ص.:92.
* يجدر هنا التساؤل: على أية صهيونية اتفق جميع اليهود في إسرائيل وخارجها؟ كما تجدر الإشارة إلى وجود قوى لا صهيونية في إسرائيل على الأقل، أهمها الفلسطينيون وبعض القوى الدينية التي لم تزل تكفر الدولة، ولا تؤمن بالخلاص البشري الذي جلبته.
** يطلق على المؤرخين “ما بعد الصهيونيين” اسم “المؤرخون الجدد” على غرار مدرسة التأريخ الجديد في أوربا التي عملت على المزج بين عدة فروع معرفية لوضع تاريخ الدبلوماسية والنخبة ضمن منظور اجتماعي ولا نخبوي أوسع، وهي تسمية لا تنطق على مؤرخي “ما بعد الصهيونية” لأنهم، على العكس من ذلك، عالجوا السياسة بتحليل نخبوي، وتمسكوا، مثل التيار الصهيوني، بالمنهج الوضعي. ولذا من الأجدر تسميتهم “المؤرخين التصحيحيين”، على غرار المدرسة التصحيحية في كتابة التاريخ الأمريكية المتصلة بالحرب الباردة. انظر: إيلان بابي، ما بعد الصهيونية- توجهات جديدة في الخطاب الأكاديمي الإسرائيلي حول الفلسطينيين والعرب، مجلة الدراسات الفلسطينية،31، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1997، ص.: 84. كما يطلق على علماء اجتماع “ما بعد الصهيونية” اسم “الاجتماعيون النقديون”، و”الجدد” أيضا. ويهتمون بدراسة البنية التحتية الأيديولوجية للمجتمع الإسرائيلي. انظر: جرشون شافير، علم الاجتماع النقدي وتصفية الواقع الاستعماري الإسرائيلي، مجلة الدراسات الفلسطينية،29، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1997، ص.: 134.
(7) شفايد، مرجع سابق، ص.:92.
(8) ميرون بنفنستي، اغتيال أب، هأرتس، 9/11/1995، في: أحمد خليفة، اغتيال رابين والحكومة الجديدة وسياسة بيرس السلمية- مقتطفات من الصحف العبرية، مجلة الدراسات الفلسطينية،25، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1996، ص.: 159. وانظر أيضا: زئيف شطرنهل، الثورة الثانية، في: المرجع نفسه، ص.: 162-164. وانظر: جرشون شافير، مرجع سابق، ص.:133.
(9) بني موريس، قمت بعمل صهيوني، هأرتس، 16/6/1997، في: خليفة، الصهيونية وما بعد الصهيونية ..، مرجع سابق، ص.:112.
*** المسيري، موسوعة تاريخ الصهيونية، ج2، ص.: 17 وما بعدها.
(10) بابي، مرجع سابق ص.: 79.
(11) أمنون روبنشتاين، الثورة فشلت الصهيونية نجحت، هأرتس، 10/6/1997 في: أحمد خليفة (محررا)، الصهيونية وما بعد الصهيونية ومعاداة الصهيونية في الجدل الإسرائيلي الأكاديمي والسياسي، مجلة الدراسات الفلسطينية،33، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1998، ص.:102.
(12) ندوة حول الصهيونية وما بعد الصهيونية ومعاداة الصهيونية، في: المرجع السابق، ص.: 115.
(13) المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(14) بني موريس، مرجع سابق، ص.:111.
(15) إيلان بابي، مرجع سابق، ص.: 78-79.
(16) انظر: ندوة حول الصهيونية، مرجع سابق، وكذا: شطرنهل، 163.
(17) بابي، مرجع سابق، ص.:86.
(18) المرجع السابق، ص.: 87-89.
(19) المرجع السابق، ص.: 83.
(20) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، انظر: عبد الوهاب المسيري، أزمة الصهيونية، مجلة البحوث والدراسات العربية، 28، القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 1996، ص.: 101 وما بعدها.
(21) شفايد، مرجع سابق، ص.: 94.
(22) لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن، انظر: عبد الوهاب المسيري، النظام العالمي الجديد ونهاية التاريخ والإنسان، الأمة في عام، القاهرة: مركز الدراسات الحضارية، 1992، ص.: 80 وما بعدها.
(23) لمزيد من التفاصيل حول علاقة يهود الغرب المندمجين بالمشروع الصهيوني، انظر: المسيري، موسوعة تاريخ الصهيونية، ج.1، ص.: 101-102.
(24) شفايد، مرجع سابق، ص.: 94-95.
(25) شافير، مرج سابق، ص.: 135-136.
(26) المرجع السابق، ص.: 140.
(27) المرجع السابق، ص.: 131-133.
**** مصطلح “عبء اليهودي الأبيض” صاغه الدكتور عبد الوهاب المسيري على غرار مصطلح “عبء الرجل الأبيض” الذي بررت به الدول الاستعمارية سياساتها تجاه السكان الأصليين في المستعمرات، الذين استغلتهم، أو حتى أبادتهم، بحجة أنها تحمل إليهم التقدم والحضارة! وهو مصطلح بالغ الدلالة على جوهر الصهيونية كحركة استعمارية غربية عنصرية. انظر: عبد الوهاب المسيري، الأيديولوجية الصهيونية، دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة، ج.1، عالم المعرفة، 60، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1982، ص.: 180-190.
(28) شافير، مرجع سابق، ص.: 136.
(29) المرجع السابق، ص.: 136-137.
(30) المرجع السابق، ص.: 137-138.
(31) روبنشتين، مرجع سابق، ص.:103.
(32) إيلان بابي، الأكاديمي هو أيضا سياسي، هأرتس، 16/6/1997، في: خليفة، الصهيونية وما بعد الصهيونية..، مرجع سابق، ص.: 109.
(33) ندوة حول الصهيونية..، مرجع سابق، ص.: 122.
(34) موريس، مرجع سابق، ص.:111.
(35) باروخ كيمرلنج، لا هي ديمقراطية ولا هي يهودية، هأرتس، 27/12/1996، في: خليفة، الصهيونية وما بعد الصهيونية..، مرجع سابق، ص.: 96 وما بعدها.
(36) بابي، الأكاديمي هو أيضا سياسي، مرجع سابق، ص.: 109-110.
(37) باروخ كيمرلنج،حق العودة- كم وإلى أين، هأرتس، 10/6/1998، في: مجلة الدراسات الفلسطينية،36، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1998، ص.: 148 وما بعدها.
(38) موريس، مرجع سابق، ص.: 111.
(39) شافير، مرجع سابق، ص.: 140 وما بعدها.
(40) بابي، الأكاديمي هو أيضا سياسي، مرجع سابق، ص.:107.
- نُشرت هذه الدراسة ضمن: د. نادية مصطفى، د. سيف الدين عبد الفتاح (إشراف عام)، أمتي في العالم: الأمة والعولمة (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية،1999).




