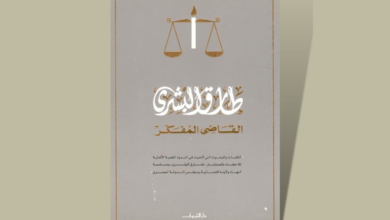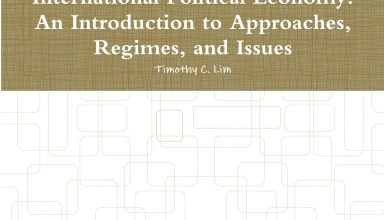عرض كتاب: الفقيه والمعمار

التاريخ الحضاري الإسلامي مفخرةٌ لكل منتمٍ لتلك الحضارة الثرية الممتدة عبر آلاف السنين، شرقًا وغربًا، جنوبًا وشمالًا. قد ينعتني القارئ بالتحيز، واللاعلمية؛ فأرد عليه قائلةً إن “تحيز” المرء، في هذه الحالة، لخصوصيته وجذوره وأصوله، لا يُعدّ جُرمًا بأي حالٍ من الأحوال، إنما هو عين الدين والفضيلة والمنطق والعقل؛ شريطةَ ألا ينتقل هذا “التحيز” المحمود إلى تحيُّز وعنصرية ضد الآخرين، فيصير مذمومًا ومٌحرمًا وآثمًا.
هذا الشعور بالفخر –الخالي من أي غرور أو تكبر ضد الآخر– هو عين ما أحسستُ به طوال قراءتي لكتاب “الفقيه والمعمار: دراسة حول أثر الفقه في العمران الإسلامي في مصر”، الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، القاهرة، عام 2022. هذا الشعور الذي صاحبني ولازمني، طوال فترة القراءة والمطالعة، كان في ازديادٍ كلما قاربت على النهاية. والحق يُقال إنه كان شعورًا ممزوجًا بالحسرة والألم والغضب، بل ممزوجًا بتساؤل كان مُلحًّا علي طوال تصفحي للكتاب، وهو: أين نحن من كل تلك الحضارة؟ أين نحن من كل ذلك التحضر؟
الكتاب الماثل أمامنا من تأليف الأستاذ الدكتور “محمد عبد الحفيظ”، أستاذ الحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر. قام المؤلف، على امتداد 541 صفحة، بعرض صفحةٍ مضيئةٍ من تاريخ الحضارة الإسلامية، وهو بالمناسبة تاريخ مليء بآلاف الصفحات المضيئة. تمثلت تلك “الصفحة”، باختصارٍ شديد، في العلاقة الوطيدة والمُركبة والفاعلة بين الفقه والمعمار بمصر المملوكية والعثمانية: كيف أثر الفقه على المعمار في تلك الفترة؟ كيف تُرجمت الأحكام الفقهية إلى حلول وابتكارات معمارية تحقيقًا للمقاصد الشرعية للدين؟ كيف حافظ المعماري المصري المسلم على دينه من خلال تصميمه وتخطيطه للمنشآت والمباني؛ سواءٌ كانت دينية أو مدنية؟ كيف كانت العلاقة بين الفقيه والمعماري علاقة انسجام وتكامل، هدفها الأول والأخير خدمة هذا الدين؟
فهرس الكتاب والمراجع
افتتح المؤلف الكتاب بـ”تصدير” للأستاذ الدكتور “نظير محمد عياد”، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ساعتها (مفتي الديار المصرية حاليا)؛ تلاه بمُقدمةٍ، ثم تمهيدٍ تحت عنوان “التعريف بفقه العمران”؛ منطلقًا بعد ذلك إلى الفصل الأول عن “مصادر فقه العمران”، ثم الفصل الثاني عن “منظومة إدارة العمران في مصر الإسلامية وعلاقتها بالفقهاء”، ثم الفصل الثالث عن “أثر الأحكام الفقهية على تخطيط وعمارة المدن”، ثم الفصل الرابع عن “أثر الأحكام الفقهية على المنشآت الدينية في مصر”، وأخيرًا الفصل الخامس عن “أثر الأحكام الفقهية على المنشآت المدنية”.
اختتم المؤلف كتابه بـ”خاتمةٍ”، أعقبها بـ”ملحقٍ” للوحات والأشكال التوضيحية عن نماذج من العمارة الإسلامية في مصر، المتأثرة بالأحكام الفقهية؛ وهو ملحق يتعدى السبعين صفحة؛ تعقبه “المصادر والمراجع” التي اشتملت على فوق الـ130 مرجعًا؛ منها الوثائق المحفوظة بـ”دار الوثائق القومية بالقاهرة”، وتلك المحفوظة بـ”دفتر خانة وزارة الأوقاف المصرية”؛ ومنها المخطوطات؛ مثل مخطوطات “أبو العباس أحمد بن عمر الديربي الشافعي الأزهري”، ومخطوطات “ابن الشحنة عبد البر”؛ ومنها المصادر العربية لأبرز العلماء والفقهاء المسلمين الذين تناولوا مجال العمارة الإسلامية بمصر، مثل: “الزركشي” و”السيوطي” و”الرملي” و”البجيرمي” و”المواردي” و”الخرشي” و”الزرقاني” و”البهوتي”. وأخيرًا، المصادر الأجنبية التي من أهمها مؤلفات Ulku Bates, Nelly Hanna, Ernst Grube.
فقه العمران…الولادة والبداية
بدايةً، قام المؤلف بتعريف “العمران” و”العمارة”. فأما “العُمران”، بضم العين، فهو كل ما يُعمر به البلد؛ وهو مرادف للحضارة والتمدن. وأما “العِمارة”، بكسر العين، فهي كل ما يتعلق بالفن العملي والعلمي لإنشاء مبانٍ، تتوفر فيها المنفعة والمتانة والاقتصاد والجمال. بدأت نشأة هذا العلم “فقه العمران” – أي العلاقة بين الفقه والعمران، في أواخر القرن الثاني الهجري، الثامن الميلادي. تنوعت المصادر المكتوبة عنه ما بين “الكتب المستقلة” المتخصصة في فقه العمران –والتي تميز فيها فقهاء المذهب المالكي على وجه الخصوص– و”الكتب المتخصصة” في بعض نوعيات المباني، مثل المساجد والحمامات والسباطات والأجنحة، و”كتب الفقه العام” التي اشتملت على أحكامٍ كثيرة مرتبطة بالعمران، و”كتب الفتاوي والنوازل” التي تناولت أسئلة افتراضية، عكست قدرات المفتين على مواكبة المتغيرات والمستجدات فيما يتعلق بأحكام العمران؛ مثل: “نوازل البرزلي” و”نوازل الونشريسي” بالمغرب العربي، وكتب “الحاوي للفتاوي” و”فتاوي السُبكي” بمصر. وكذلك “كتب الحسبة” التي تناولت مهام المحتسب في مجال العمران، ودوره المركزي في عملية الضبط الحضري للمدن الإسلامية؛ و”كتب النصيحة” التي تناولت قضية “تكثير العمارة” بوصفها أحد أركان الملك التي يجب على الحاكم الاهتمام بها. وأيضًا “محاضر الكشف وسجلات المحاكم الشرعية” التي عكست محاضر الكشف على المباني، والوقائع المسجلة في سجلات المحاكم الشرعية بالبلدان الإسلامية المختلفة؛ و”كتب الوثائق والعقود” التي بينت كيفية كتابة وثائق العقود، وتوصيف أجزاء المنشآت التي يجب ذكرها عند كتابة العقود؛ على اعتبار أن علم التوثيق هو أحد فروع علم الفقه. وأخيرًا، “كتب الأقضية والأحكام” التي تناولت استنباط الأحكام، وقدمتها إلى القضاة لتنفيذها.
أول من كتب في “فقه العمران” هو “عبد الله بن عبد الحكم “، الفقيه المصري المالكي الذي سجل أولى قواعد فقه العمارة في كتابه “القضاء في البنيان”. وللفقهاء المصريين علامات مميزة في الكتابة عن فقه عمارة المساجد؛ فيأتي على رأسهم “محمد بن عبد الله الزركشي”، صاحب كتاب “إعلام الساجد بأحكام المساجد”، الصادر في 794 هجريًا؛ وهو أول كتاب صُنف مستقلًا في أحكام المساجد. وكذلك برع فقهاء مصر في الكتابة عن فقه عمارة الحمامات، وعن الشروط الواجب مراعاتها عند بناء الحمامات.
إن ازدهار الحركة الفقهية في مصر المملوكية والعثمانية هو ما جعل المؤلف يولي شطره نحو دراسة الإنتاج المعرفي الفقهي لعلماء مصر؛ وهو ما يُكسب هذا الكتاب خصوصية؛ باعتباره أول كتاب يبرز جهود فقهاء مصر في مجال فقه العمران؛ على عكس الدراسات السابقة التي كانت تعتمد فقط على الإنتاج الفقهي لعلماء المالكية المغاربة. لقد قدم المؤلف نصوصًا جديدة من فقه العمران، نصوصًا لم تنشر من قبل، مبرزًا الجانب التطبيقي للضوابط والأحكام الفقهية للعمارة الإسلامية في مصر وحدها، مُقدمًا نماذج تطبيقية جديدة من العمائر الإسلامية المصرية التي روعي في عمارتها الضوابط الفقهية والقيم الإسلامية.
تطور فقه العمران
يشتمل “فقه العمران”، كما أورد “عبد الحفيظ”، على مجموعة ضوابط فقهية متعلقة بالبناء؛ استمدها الفقهاء من الكتاب والسُنة، لتصير في النهاية القوانين الحاكمة لحركة العمران والعمارة في المدن الإسلامية. بدأت تلك الضوابط، بصورة مُبسطة، مع تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الذي أقر بهديه الشريف المبادئ العامة المنظمة لحركة العمران؛ مثل: تحديد اتساع الطرق، أحكام الجدران المشتركة بين الجيران، نظام الوقف والإقطاع، إحياء الأرض الموات.
ومع ازدياد حركة العمران، وظهور إشكاليات مُستجدة متعلقة بالبناء، أخذت هذه الضوابط في النمو والتراكم والتحول – بمرور الزمن- إلى إطار قانوني لحركة العمران في المجتمعات الإسلامية، التزم بها الحكام والمحكومون على حد سواء. فأضحت الأحكام الفقهية هي الإطار النظري الذي التزم به المهندسون عند وضع التصميمات المعمارية للمنشآت الإسلامية؛ سواء كانت عناصر داخلية أو خارجية.
لقد اجتهد الفقهاء المصريون، كما يؤكد “عبد الحفيظ”، في وضع الحلول المعمارية المناسبة التي تتفق مع أحكام الشريعة؛ فكانت مقاصد الشريعة ظاهرة وواضحة في حركة العمران. فانعكس مقصد حفظ الدين في إنشاء القلاع والحصون والخنادق. وانعكس مقصد حفظ النفس في إقامة المساكن والبيمارستانات. وانعكس مقصد حفظ العقل في إقامة المدارس والكتاتيب، وحظر إقامة الخمارات. وانعكس مقصد حفظ المال في إنشاء الو كالات والأسواق. وانعكس مقصد حفظ النسل في تسهيل بناء السكن، وحظر بناء دور الدعارة. ويُلاحظ أن معظم القواعد الفقهية، المُتبعة في هذا الشأن، كانت متصلة على وجه الخصوص بـثلاث قواعد أساسية: “لا ضرر ولا ضرار”، “الضرر يُزال”، “دفع المفسدة مُقدم على جلب المنفعة”.
ويشير المؤلف إلى اتجاهين في دراسة العلاقة بين الفقه والعمران: التوجه الأول الذي يتناول الرؤية الفقهية البحتة دون الغوص في الجانب التطبيقي على الآثار الإسلامية القائمة، والتوجه الثاني الذي يستنبط الضوابط الفقهية الحاكمة للعمران، فيطبقها على العمائر الإسلامية القائمة. وقد كان للباحثين الغربيين السبق في لفت الانتباه إلى أهمية المصادر الفقهية الإسلامية في دراسة العمارة الإسلامية والعمران الإسلامي. كان أبرزهم Robert Brunschvig في القرن العشرين، والمستشرقان البولونيان “تاديوس لفتكس” و”موتيلانيسكي” في القرن الـ19 الميلادي. ولم ينتبه الباحثون العرب إلى ذلك المجال إلا في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين؛ وكان أبرزهم “حسن الباشا” و”محمد عبد الستار عثمان” و”محمد الكحلاوي”.
منظومة إدارة العمران
اشتملت منظومة إدارة العمران في مصر الإسلامية على مؤسساتٍ عدة، ارتبطت بعلاقاتٍ وثيقة مع الفقهاء الذين انعكس اجتهادهم على البيئة العمرانية في مصر؛ إذ كان يتم استشارتهم في أمور العمران، بل في أمور الدولة المختلفة. والحق، أن نشاطهم قد ظهر بوضوح في مصر الأيوبية والمملوكية، بعد قيام الدولة بدعمهم إحياءً للسُنة، خاصةً بعد انتهاء الحكم الشيعي للفاطميين؛ فحظوا بمكانةٍ عاليةٍ واحترامٍ ملحوظ لدى سلاطين الأيوبيين والمماليك.
وقد انعكست اجتهادات وفتاوي الفقهاء على جميع مؤسسات الإدارة العمرانية، كما أكد المؤلف. وهي تلك المؤسسات التي تلخصت في التالي: الخليفة أو السلطان؛ مؤسسة القضاء؛ مؤسسة الأوقاف؛ الحسبة؛ ديوان بيت المال؛ ديوان الأسوار؛ شاد العمائر؛ أرباب الحرف المعمارية؛ وشاد الطرقات؛ وديوان الكشف. فأما الخليفة، فكان مُلزمًا، شرعًا، بـ” تكثير العمارة”، وتأكيد النهج الديني؛ من بناء وترميم المساجد، إلى تحصين الثغور، إلى إقامة الحصون والقلاع، إلى إحاطة المدن بالأسوار والأبراج. كذلك، كان مُلزمًا بمنع البناء في أماكن معينة لدفع الضرر الذي قد يلحق بالمصلحة العامة للأمة؛ ومن ثم شرع الفقهاء أخذ إذن الخليفة في العديد من الأنشطة المعمارية.
وأما مؤسسة القضاء، فكانت مسئولة عن الفصل في القضايا الخاصة بالمباني التي تنشب بين الجيران، والإشراف على الديوان المختص بتسجيل الأوقاف، من أجل حفظ أصولها والإبقاء على استثماراتها. هذا إلى جانب إشراف القضاة على بعض أعمال التعمير والتجديد الخاصة بالمساجد الجامعة، وإشرافهم على نُظار الأوقاف، والسماح لهم بأية تجديدات لازمة في مباني الأوقاف. وطبعا، كان القضاة – في كل ذلك – مُلتزمين بالرجوع إلى كتب الفقه المعتمدة، وتطبيق أحكام الشرع المنصوص عليها.
وأما مؤسسة الأوقاف، فكان لها دور مركزي في عمران المدن الإسلامية، إذ لم تعد قاصرةً على الأراضي الزراعية، بل امتدت لتشمل العمائر بكافة أنواعها؛ من القصور إلى المدارس إلى البيمارستانات إلى الحمامات إلى الأسبلة إلى الكتاتيب إلى الحوانيت إلى الطواحين إلى الأفران إلى مصانع الصابون والنسيج إلى معاصر الزيت والقصب إلى معامل النشادر. لقد كان للأوقاف مكانة مميزة لدى المصريين منذ تعرفهم عليها في القرن الأول الهجري؛ فتعلقوا بها تعلقًا واضحًا. وهو الأمر الذي يُفسر سر تودد الخلفاء والأمراء للمصريين بتلك المنشآت الوقفية الكثيرة، والتي تطورت بشكلٍ لافت في الحقبتين الأيوبية والمملوكية. وقد كانت مؤسسة الأوقاف يُطبق عليها الأحكام الفقهية المقررة في المذاهب الأربعة.
أما المحتسب، الذي عرفه المصريون منذ القرن الثالث الهجري، فكان مسئولًا عن الإشراف على أعمال البناء، ومنها الكشف –بمشاركة المعماريين- على صحة متانة المباني، وتطبيق الشروط الصحية المفروضة على الصناعات المقلقة والمُضرة بالصحة، مثل المدابغ ومسابك الحديد والزجاج وقمائن الجير؛ ومنها منع بناء المنشآت في الطرق العامة النافذة لحفظ حق الطريق، والرقابة على أصحاب الحرف المعمارية. وتقوم جميع تلك المسئوليات والاختصاصات على مبادئ فقهية متمثلة في قواعد دفع الضرر وتقديمه على جلب المنفعة، وتقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. ولذلك كان من ضمن شروط وظيفة المحتسب إلمامه بأمور الشريعة والدين؛ ومن ثم كان المُحتسبون يُختارون غالبًا من بين الفقهاء. وكما يؤكد “عبد الحفيظ”، فقد كانت وظيفة المحتسب وظيفةً دينية، رفيعة الشأن والمقام.
ومن ضمن مؤسسات إدارة العمران في مصر الإسلامية، “ديوان بيت المال” الذي كان يُصرف جزء من إيراداته في إقامة العمائر المختلفة التي شهدت ازدهارًا معماريًّا هائلًا –وصل إلى حد الإسراف– في عصر المماليك؛ وهو ما عارضه بعض الفقهاء. وكذلك نجد “ديوان الأسوار” –الذي أنشأه “صلاح الدين الأيوبي”– المسئول عن إنشاء الأسوار حول المدن الإسلامية؛ بهدف حمايتها وصيانتها من الأعداء؛ وهو مقصد شرعي حث عليه الفقهاء. فكان لذلك الديوان، مخصصات مالية وأوقاف معروفة. ثم نجد “شاد العمائر” الذي كان مُختصًا بالإشراف على العمال بموقع البناء، من حيث التأكد من اتصافهم بالأمانة والعفة والمعرفة بأمور البناء، وكذلك من حيث وجوب التلطف في معاملتهم، والترفق بحالتهم الجسدية، فلا يتم تكليفهم فوق طاقتهم، كما يقول الشرع الحنيف. وهو المختص أيضًا بجمع العمال والبنائين والعتالين وغيرهم من أرباب الحرف المعمارية للمشاركة في الأعمال التي كلف بها الخليفة أو السلطان. وأخيرا، نجد “شاد الطرقات” المختص بتوسيع الطرق وإصلاحها؛ و”ديوان الكشف” المختص بالكشف على صحة ومتانة الجسور السلطانية. وذلك عملًا بالقاعدة الشرعية “لا ضرر ولا ضرار”.
كما يتبين لنا، نرى جميع وظائف إدارة العمران في مصر الإسلامية، وقد طُعِمَت بالقواعد الفقهية والقيم الإسلامية؛ من دفع الضرر بكل صوره وأشكاله، إلى حفظ المصلحة العامة، إلى احترام وتبجيل الشريعة في القضاء والأوقاف، بل حتى في معاملة العمال. لقد كانت الشريعة حاضرةً في جميع تلك الوظائف العمرانية، وإن حدثت بعض التجاوزات من قبل السلاطين، التي ظلت في حيز الاستثناء لا القاعدة. وكان صوت الفقيه واضحًا جليًا في كل صغيرةٍ وكبيرةٍ تختص بالبناء في مصر الإسلامية؛ وكان رأيه مسموعًا ومأخوذًا به من قبل السلطان والقاضي والمحتسب والأوقاف.
أحكام الفقه وتخطيط المدن
كما يوضح المؤلف، فإن قواعد حركة الإنشاء في مصر، وضعها علماء وفقهاء مسلمون، مستنبطين إياها من القرآن والسُنة وأفعال الخلفاء الراشدين عند تأسيسهم للمدن الجديدة. جميعها كانت قواعد تستجيب إلى مقاصد الشريعة المتضمنة لحفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال. وطبقًا لذلك، تصير المدينة الإسلامية دارًا واحدةً، تعبر عن وحدة الأمة ووحدة العقيدة؛ فكل انتفاع فيها يتنزل طبقًا للمقصد الشرعي الأسمى المتمثل في درء المفسدة المُقدم على جلب المنفعة، كما أورد الكتاب.
وقد حدد الفقهاء واجبات الحاكم عند تخطيط المدينة، متناولين منهجية الفكر الإسلامي في التخطيط العام للمدينة والتخطيط الخاص لوحداتها البنائية. فكان أبرزهم “ابن أبي الربيع” و”ابن الفقيه الهمذاني” و”ابن أبي زرع” و”ابن خلدون” و”الماوردي”. وقد وضع “ابن أبي الربيع” شروطًا ثمانية لذلك التخطيط؛ مستخلصًا إياها من وصايا النبي عليه الصلة والسلام وخلفائه الراشدين في أثناء تخطيطهم للمدينة المنورة، عاصمة الإسلام الأولى، وكذلك من طريقة بناء المدن الإسلامية المبكرة مثل البصرة والكوفة والفسطاط.
وتلخصت الشروط الثمانية في التالي: أولًا- أن يُساق إليها الماء العذب. ثانيًا- أن يُبنى في وسطها مسجدٌ للصلاة؛ تأكيدًا على مركزيته في حياة المسلم؛ بما يعني توجيه تخطيط شوارع المدينة نحو المسجد الجامع توجيهًا رئيسيًّا. ثالثًا- أن تٌقدر طرقها وشوارعها حتى تتناسب ولا تضيق. رابعًا- أن تُقدر أسواقها بحسب كفايتها؛ بمعنى ألا تزيد البضائع عن الحاجة، فتنخفض الأسعار وتبور السلع، وألا تقل عن الحاجة فيصير وجودها نادرًا، فيرتفع سعرها. خامسًا- ألا تجمع أضدادًا مختلفة في موضعٍ واحد؛ بحيث يصير هناك انسجام عرقي وحضري ومجتمعي. سادسًا- أن تُحاط بسورٍ صيانةً لدماء المسلمين وأعراضهم من أعداء الإسلام. سابعًا- أن يُنقل إليها من أهل العلم والصنائع بقدر الحاجة لسكانها. ثامنًا- أن تتناسب عدد الأيدي العاملة بها مع حاجة السكان والصناعة.
جميع تلك الشروط، كما يؤكد المؤلف، تنبع في الأساس من تصور مقصدي شرعي، غايته إرساء مدينة قوامها الشريعة، تستمد أصولها وفروعها من البعد المقاصدي للشريعة. فتوفير الماء العذب، وإيجاد الانسجام الحضري العرقي المجتمعي، وتقدير الطرق، يقوم بتلبية مقصدي حفظ النفس والنسل. وإقامة المسجد في وسط المدينة، وإحاطتها بسورٍ منيع، يلبيان مقصد حفظ الدين. وتوفير العدد المناسب من أهل العلم والبضائع والأسواق والأيدي العاملة يلبي مقصدي حفظ المال والعقل.
وقد روعيت أغلب تلك الشروط عند إنشاء عواصم مصر الإسلامية (الفسطاط والعسكر والقاهرة والقطائع). فكان إنشاء مدينة الفسطاط على نهر النيل؛ وكذلك مدن العسكر والقطائع التي امتاز موقعها بالقرب من نهر النيل؛ ومن ثم سهولة وصول الماء العذب إليها. وكذلك تم اختيار مواقع العواصم الأربعة بالقرب من الطرق التجارية لتوفير الغذاء والمؤن. وروعي بالنسبة لمدينة القاهرة، اختيار موقعها بالقرب من المرعى والاحتطاب؛ فتميزت بوجود أرض خصبة صالحة للزراعة (نظرًا لوقوعها على نهر النيل)، وبوجود المراعي في ظواهرها. أما مدينة الفسطاط، فقد تم اختيار موقعها ليصير ذا حصانة طبيعية، فتوسطت بين حمايتين: حماية التلال من الشرق والشمال، وحماية خندق مائي طبيعي من الغرب؛ وهو نهر النيل.
أحكام الطرق عامل مؤثر
من أكثر الأحكام الفقهية التي أُخذ بها في عملية التخطيط والبناء العمراني بمصر الإسلامية، كانت أحكام الطرق؛ وهي تتمثل في حفظ حق الطريق لكل مارٍ؛ سواء من بني الإنسان أو بني الحيوان. وكان الهدف الشرعي من تطبيق أحكام الطرق هو منع حدوث الضرر الذي يمثل قاعدةً شرعيةً أصيلةً وأساسية في الفقه الإسلامي. وقد تناول المؤلف –في خلال كتابه– نماذج كثيرة عن كيفية تطبيق حكم المحافظة على حق الطريق، وهدم كل ما يناقض ذلك الحكم. كما استفاض في الحديث عن المعالجات والابتكارات المعمارية –من قبل المهندسين– لحفظ ذلك الحق، ولاسيما في ظل تزايد المنشآت المعمارية التي كان يحتفي بها العديد من الخلفاء المماليك والعثمانيين.
وكما يبين المؤلف، فإن الهدف الأكبر من تطبيق أحكام الطرق تمثل في منع الضرر المُعوق للمرور، سواء بالنسبة للبشر السائرين على أقدامهم أو الراكبين، أو بالنسبة للدواب المُحملة. ومن هنا أفتى الفقهاء المصريون بوجوب المحافظة على الطرق النافذة العامة من أي اعتداء يعرضها للضيق أو إعاقة المرور. فالطرق النافذة العامة ملك لجميع الناس، وللناس جميعًا حق المرور والارتفاق بها. أما الطرق غير النافذة، والمملوكة لسكانها، فلا يجوز لغير أهلها إحداث أمرٍ فيها دون إذن منهم، كحفر بئر أو بناء قنطرة.
وقد تناول الفقهاء مسألة سعة الطريق، فقدروا أن يصير أقل مقياس للسعة هو ما يسمح بمرور دابتين متخالفتين مُحملتين؛ سواء من حيث الارتفاع أو العرض. ومن أهم الفتاوي التي أفتوا بها –لحفظ سعة الطريق– وجوب هدم المبنى العائق للطريق؛ سواءً كانت هذه الإعاقة متمثلةً في البروز بالسلالم الخارجية، أو المطلات والخرجات، أو المصاطب والدكك؛ وكذلك وجوب هدم الجدران المائل والمباني الخربة لما تمثلها من خطرٍ على الجار أو المار، حفظًا للنفس والمال، بل وجوب هدم عشرات المآذن والقباب إن كان بناؤها كاشفًا ومنتهكًا لستر البيوت، حفظًا للنفس والنسل.
ونظرًا للتكدس العمراني الملحوظ في ظل القاهرة المملوكية والعثمانية –وذلك تلبيةً لرغبة السلاطين في بناء منشآت تحمل أسماءهم في القاهرة– صار المعماري مُلزمًا بالتعامل مع هذا الوضع المعقد لحفظ حق الطريق. فابتكر معالجات وحلولًا معمارية، استفاض المؤلف في عرضها كتابةً وتصويرًا؛ فكانت في ظني من أكثر الأجزاء إمتاعًا وتأملًا في الكتاب.
وكان من ضمن تلك المعالجات المبتكرة لحفظ حق الطريق: اتخاذ سلالم خارجية على الوضع الجانبي للمبنى بدلًا من امتدادها في وسط الطريق؛ حفر أنفاق رابطة بين الشوارع النافذة؛ شطف الزوايا الواقعة على النواصي؛ بناء الأسبطة والمعابر والسقائف أعلى الطريق؛ ليمر المارة من تحتها، شريطةً أن تكون على ارتفاع يسمح بمرور الفارس برمحه، والهودج بمحمولته، كما حدد الفقهاء. فالسقائف والمعابر -وأية حلول مبتكرة – لابد أن تحفظ المصلحة العامة التي لا تنازل عنها بأي شكلٍ من الأشكال.
أحكام الضرر وتخطيط المدن
“لا ضرر ولا ضرار” هو الحديث الشريف والأصل الذي قام عليه التخطيط المادي للمدن الإسلامية؛ وكذلك قامت عليه التكوينات المعمارية للمدينة ببعضها، والمتغيرات التي تطرأ عليها. وبموجب قاعدة “الضرر يُزال” (إحدى القواعد الكلية الفقهية الخمسة) أفتى الفقهاء المصريون بإزالة الضرر أيًا كان نوعه. وقد حصروا أنواع الضرر في التالي: ضرر الصوت والإهتزاز (صوت أعمال الحدادة والطواحين)؛ ضرر الدخان والأتربة (دخان الحمامات والأفران)؛ ضرر الروائح الكريهة (المراحيض ومدابغ الجلود ومعامل الخل وإسطبلات الخيول)؛ ضرر حجب الضوء والشمس والهواء عن الجار؛ ضرر الكشف والاطّلاع (ومنها البناء على أرض مرتفعة تكشف ستر الناس)؛ ضرر الميازيب والأقصاب؛ ضرر منع مطل البحر أو المسطحات المائية.
وقد استجاب المعماريون المصريون لجميع تلك الأحكام؛ فأبدعوا في تقديم الحلول الآتية: قاموا بتجميع مباني أعمال الحدادة في مكان متقارب؛ وقاموا بإنشاء الطواحين وإسطبلات الخيول والمدابغ ومعامل الخل ومصانع الخزف والفخار وأفران حرق الطوب في خارج المدينة، أو قريبة من السور؛ وقاموا برفع المآذن بارتفاع شاهق تجنبًا لضرر الكشف؛ وامتنعوا عن بناء الميازيب في الطرقات الضيقة منعًا لإحداث مزيد من التضييق، وكذلك منعًا لإحداث النجاسة، وبنوها فقط في الطرق الواسعة بشرط ألا يزيد طولها على نصف الطريق، كما أفتى الفقهاء. وكذلك قاموا برفع سقف الحمامات والأفران منعًا لضرر الدخان. ومن جميع تلك الأضرار، كما أوضح المؤلف، يعتبر منع ضرر الكشف من أقوى الضوابط الفقهية في العمارة الإسلامية؛ وذلك حرصًا على حفظ عرض المسلم الذي يُعد مقصدًا من مقاصد الشريعة.
ضوابط عمارة الأراضي
أرسى فقهاء مصر قواعد فقهية متعلقة بالبناء على الأراضي في المدينة الإسلامية؛ منها حُرمة البناء على الأراضي المغصوبة؛ ومنها حُرمة غصب أراضي الوقف، ووجوب تنفيذ شروط الواقف فيما يختص باستغلال أرض الواقف؛ ومنها عدم جواز تملك أراضي طرح النهر (الأراضي التي نشأت على ساحل النهر نتيجةً لانحسار مياهه) للسلطان، وإنما حبس رقبتها لعامة المسلمين، فيصير لها حكم الأوقاف؛ ومنها عدم جواز البناء في المناطق القريبة والمحيطة بالعقارات والمساجد والأنهار والآبار والعيون (وهي ما تُسمى بـ”الحريم”)، على اعتبار أن لكلٍ منهم “حريمه” الذي لا يجوز الاعتداء عليه بالبناء.
وكما أفتى الفقهاء بالممنوعات والمحظورات، فقد أفنوا أيضًا بالإيجازات؛ فأجازوا البناء في الأرض الموات، وكذلك والغرس والسقي فيها، على اعتبار أن عمارة الأرض غير المملوكة، والبعيدة عن العمران، مطلبٌ شرعيٌّ، عملًا بالحديث النبوي الشريف: “من أحيا أرضًا ميتةً فله فيها أجر”. كما أجازوا استغلال المساحات الخالية من البناء لإقامة الميادين والأفنية والرحبات للمنفعة العامة، كأن تكون مُلتقًا لسكان الحي في الاحتفالات والمواسم، أو محلًا لأسواق تجارية، أو ألعاب رياضية، أو استعراضات عسكرية.
وقد نزلت جميع تلك القواعد الفقهية إلى حيز التنفيذ، وتُرجمت على أرض الواقع. فاحترم الحكام والأمراء والسلاطين تلك القواعد، ونفذها المعماريون باحترامٍ مماثل؛ وانعكس ذلك في اتجاه التعمير بالقاهرة. فتم منع البناء على أراضي الوقف، منها أراضي القرافة التي كان قد أوقفها “عمر بن الخطاب” للدفن فقط، واتجه المماليك، بدلًا من ذلك، إلى إنشاء أضرحتهم في منطقة صحراوية شرقي القاهرة، مع العديد من المنشآت المعمارية الأخرى. وكذلك امتنع السلاطين والأمراء عن تملك أراضي طرح النهر، ملتزمين بآراء الفقهاء الذين منعوا تملكها، ولكن أجازوا إيجارها لمدةٍ طويلة، والانتفاع بها بناءً وزراعةً، مثل: “جزيرة الفيل”؛ مما دفع السلاطين والأمراء وعامة الناس إلى تأجيرها وتعميرها.
وكذلك مُنع البناء في “حريم” النهر والعقارات والمساجد، لما في “الحريم” من ضرورةٍ قصوى في مساعدة المنشآت المحيطة بها على أداء وظائفها بصورةٍ صحيحة. وحيثما حدثت تجاوزات في التعدي على ذلك “الحريم” –وبالطبع كانت هناك تجاوزات– كان يتم رفعها، أو يتم تحريم تلك البناءات المتجاوزة فقهيًا، مثلما حدث بالنسبة لمساجد حي بولاق التي بُنيت في حريم نهر النيل في العصر العثماني، فتم تحريم الصلاة فيها بناءً على فتوى بعض الفقهاء.
أحكام الفقه والمساجد
من أهم الضوايط الفقهية التي روعيت في أثناء بناء مساجد مصر الإسلامية: حفظ مركزية المسجد وطُهريته، شكلًا ومضمونًا، بالنسبة للمصلين. فأما بالنسبة لحفظ مركزية المسجد وطُهريته، فقد بذل المؤلف جهدًا مشكورًا في رصد ذلك الكم الهائل من الضوابط الفقهية التي ساعدت على تحقيق تلك “المركزية” وتلك “الطهارة”. فتبعًا لكون المسجد –كما أوردنا سابقًا– أهم منشأة معمارية في المدينة الإسلامية، وتبعًا لكونه بيت الله الذي يُذكر فيها إسمه، فقد شرع الفقهاء مجموعة من الضوابط، كي يصير هذا البناء طاهرًا من جميع الأوجه.
ومن تلك الضوابط، أن يكون موقع البناء طاهرًا من الرجس والدنس؛ وأن تكون الأرض المُقام عليها المسجد غير مغصوبة أو متنازع عليها؛ وأن تكون جميع المواد المُستخدمة طاهرةً بما فيها الماء الذي يُخلط به الطين والملاط؛ وأن يُحرم تسخير أو إذلال العمال في أثناء بناء المسجد لكونه يشوب الطهارة المعنوية؛ وأن يُمنع بناء الكتاتيب في داخل المساجد لصعوبة التحفظ من نجاسة الأطفال؛ وأن تُبنى المراحيض في خارج المسجد، في الجهة المعاكسة لاتجاه الريح، بل وعدم جواز حفرها تحت صحن المسجد؛ وأن تُبنى الفوارات (فساقي الوضوء) لتجديد وضوء المصلين، حفاظًا على صلاتهم.
وكما يؤكد مؤلف الكتاب، فقد اجتهد المعماريون في إنزال تلك الضوابط على أرض الواقع؛ اللهم إلا بعض التجاوزات التي حدثت على أيدي بعض الأمراء الذين قاموا –على سبيل المثال– بضرب كلام الفقهاء عرض الحائط؛ فاغتصبوا أراضٍ من أجل إنشاء مدارس دينية مثل المدرسة الأقبغاوية (الأمير أقبغا). ولكن في الأصل والأساس، كانت الضوابط الفقهية تُترجم إلى أدوات وتقنيات معمارية؛ والتي كان منها –على سبيل المثال– توجه العديد من المعماريين المصريين نحو بناء مساجد كثيرة من الحجر تفاديًا لإشكالية الماء النجس، على اعتبار أن عملية صب الحجر لا تحتاج إلى استخدام الماء، على عكس صب الطوب؛ ومنها إلحاق الكتاتيب بالمساجد؛ ومنها بناء المراحيض بعيدًا عن المساجد.
أما بالنسبة للضابط الفقهي المتمثل في عدم جواز قطع صفوف المصلين، والالتزام بإقامة الصف مستقيمًا، فقد أبدع المعماريون المصريون إبداعًا ممماثلًا، محمودًا ومشهودًا. فمن تخطيطهم المستطيل للمسجد (حتى يتسع لأكبر عدد من المصلين في الصف الأول، وحتى يساعد على إستقامة الصفوف)، إلى استخدام الإيوانات المغطاه بالأقبية (لتلافي إستخدام أعمدة تفصل بين المصلين، وتحول دون استقامة صفوفهم)؛ إلى إبقاء صحون المساجد فارغةً من غرس الأشجار أو حفر الآبار (حتى تصير خالصةً للصلاة والمسجدية وإقامة الصف)؛ إلى عدم الإكثار من بناء المقصورات (لتفادي قطع صفوف المصلين)؛ إلى بناء سقائف تحيط بقاعة الصلاة من جميع الجهات، عدا جهة المحراب، على شكل حرف U (لتوفير مكان لصلاة المتأخرين حتى لا يقطعوا صفوف المصلين)؛ إلى عدم بناء المأذنة في وسط المسجد (لمنافاتها مبدأ المسجدية التي تقتضي أن تكون ساحة المسجد كلها للمصلين فقط).
ومن ضمن نماذج الالتقاء والتزاوج –إن إجاز التعبير– بين الفقيه والمعماري في بناء المساجد، والإبقاء على صفة المسجدية، وعلى مركزيته بالنسبة للمجتمع المسلم، عدم التبذير أو الإسراف في زخرفة وزينة المساجد تفاديًا لإشغال فكر المصلي بها، وفصل المسجد عن الضريح عبر الدهاليز والممرات تفاديًا لإشغال المُصلي بالضريح، وجعل أرضية المحراب مساويةً لأرض المسجد تفاديًا لإشغال المأموم برفع الصلاة إلى الإمام.
أحكام الفقه والمنشآت المدنية
من أهم الأحكام والمبادئ الفقهية التي رعاها المعماريون المصريون عند بنائهم للمنشآت المدنية، والمتمثلة في الأسواق والوكالات والبيوت والحمامات والأسبلة والبيمارستانات: مبدأ الخصوصية ومنع ضرر عند بناء البيوت والحمامات؛ مبدأ عدم جواز شغل الطريق وعدم الإضرار بالسلع عند بناء الأسواق والوكالات؛ مبدأ فضل السُقيا عند بناء الأسبلة؛ مبدأ فضل الصدقة الجارية عند بناء البيمارستانات.
أما بالنسبة للأسواق والوكالات، فقد اهتم الفقهاء المصريون بأمرها، وألفوا كتبًا مستقلة، أبرزها كتاب “أحكام السوق” لـ”يحيى بن عمر الكناني الأندلسي” المتوفى في نهاية القرن الثالث الهجري، والذي تناول كيفية تخطيط الأسواق وإرساء قواعد التجاور بين الأنشطة التجارية المختلفة، مفتيًا بعدم جواز شغل الطريق من قبل أصحاب الأسواق والحوانيت لكونه يمثل عدوانًا على المارة. ومن الضوابط الفقهية التي وضعها “الشيرازي” وجوب اتساع وارتفاع السوق، وتبليطه وتسقيفه حفظًا للسلع من التلف.
وانعكست تلك الأحكام في تصميم وتخطيط المعماري: فقام برفع أرضية السوق عن أرضية الشارع حفظًا لحق الطريق، وقام بمنع بناء الأسواق في الطريق غير النافذ منعًا لضرر الكشف من قبل المترددين عليها أو الجالسين أمامها، وحفظًا لخصوصية سكان الرباع السكنية التي تعلو تلك الأسواق؛ وقام بفتح الأبواب المؤدية للطوابق العليا من الخارج وليس من داخل السوق؛ منعًا لاختلاط السكان بالتجار؛ وقام بإنشاء الفساقي في صحون الأسواق توفيرًا للتهوية ومنعًا للإضرار بالسلع، خصوصًا المتعلقة بالطعام والشراب؛ وقام ببناء الأسواق في القاهرة إلى جهة الشمال الغربي –وهي جهة هبوب الرياح في مصر– تحقيقًا للتهوية الصحية وحفظ السلع من الضرر؛ وقام بإضافة زاوية أو مسجد صغير ت وسط السوق حفاظًا على أداء فريضة الصلاة بالنسبة للتجار، ومن ثم تحقيقًا لمقصد “حفظ الدين”؛ وقام بحجب النوافذ المطلة على صحن الوكالة بمشربياتٍ من الخشب الخرط؛ مثل: وكالة الغوري ووكالة بازرعة بالقاهرة، تجنبًا لضرر الكشف؛ وقام بإلحاق الرباع السكنية أعلى المنشآت التجارية حلًا لمشكلة ازدياد السكان، خاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة والأسكندرية ودمياط، وتحقيقًا لحديث رسول الله، حينما شكا إليه “خالد بن الوليد” ضيق مسكنه، فقال له: “ارفع الُنيان إلى السماء”.
وأما بالنسبة للمساكن والبيوت، فقد راعى المعماري المصري في مصر الإسلامية قاعدة الخصوصية، مبتكرًا حلولًا معماريةً حافظةً لتلك الخصوصية، وحاميًا للبيت المسلم –ذلك الكيان الاجتماعي– من أعين وأذن الدخلاء والمتطفلين. فقام بتنكيب الأبواب (أي عدم مواجهتها ببعضها البعض) حتى لا يكشف الخارج والداخل إليها؛ وقام بوضع مطارق من حديد على الأبواب مراعاةً لمبدأ الاستئذان؛ وقام بتصميم المداخل المنكسرة التي لا تؤدي مباشرةً إلى داخل البيوت، حفظًا لحرمتها؛ وقام بتصميم المشربيات على الواجهات منعًا لضرر الكشف؛ وقام بتصميم البيت من الداخل إلى الخارج – وليس العكس – حتى تمر حركة الحياة من خلال حرم البيت، في معزلٍ عن أي امتداد إلى بيوت الآخرين، مُستبدلًا الفراغ الداخلي بالأفنية الداخلية المكشوفة التي كانت بمثابة الرئة لوحدات البيت المختلفة، ومركزًا لتهوية وإضاءة البيت، وكذلك محلًا للخصوصية والتواصل الاجتماعي بين أفراد الأسرة.
كذلك برع المعماري المصري في تصميم قاعات رحبة في داخل البيوت لاستقبال الضيوف، ومنها المضيفة التي جعلها في الطوابق العلوية، بعيدةً عن أجنحة الحريم (والمندرة في الطوابق السفلية)، محققًا بذلك قيمتي إكرام الضيف وستر العورات. ثم برع في تصميم المطابخ معاكسةً لاتجاه الرياح، منعًا لتسرب روائح الطهي إلى للجيران، مع إضافة المداخن أعلى البيوت لتصريف الدخان. أما بالنسبة لدورات المياه، فقد جعلها مخالفةً لاتجاه الرياح واتجاه القبلة معًا. هذا إلى جانب إبداعه في إقامة جدران سميكة بين البيوت، تحقيقًا للخصوصية السمعية، وإقامة أسوار مرتفعة على أسطح البيوت في المناطق الحارة، سترًا للسكان الذين يفترشون تلك الأسطح من أجل النوم.
أما بالنسبة للحمامات العامة، فقد أفتى بجوازها الفقهاء –بل بضرورتها– تحقيقًا للطهارة الجسدية، ومن ثم الصحية، والتي تعتبر من مقاصد الشريعة في حفظ النفس. ومن ثم، ارتبط الكثير منها بالأوقاف والبيمارستانات. وقد راعى المعماري المصري الضوابط الفقهية في بناء الحمامات العامة، كما راعاها من قبل في بناء البيوت والمساجد. فراعى بناء الحمام العام متقدمًا على جدار القبلة في المسجد؛ وراعى اختيار موقعه بحيث لا يسبب ضررًا للجيران (على اعتبار ما يسببه كثرة زائريه الداخلين والخارجين من إزعاج)؛ وراعى توفير مُصليات ومساجد صغيرة لمرتادي الحمام حتى لا تفوتهم الصلاة؛ وراعى إنشاء خلاوي جانبية للمستحمين المرضى والمحارم الذين يعاونونهم؛ وراعى بناء مستوقد الحمام ملاصقًا لمكان متسع مكشوف (المنشر) لتسليط دخان الحمام على هذا الفضاء؛ منعًا لضرر الدخان الذي يُسود الثياب والحيطان؛ وراعى بناء جدران سميكة ونوافذ مرتفعة منعًا لنفوذ الهواء البارد الذي قد يضر بالمستحمين؛ وأخيرًا، راعى بناء مداخن مرتفعة منعًا لضرر الدخان.
أما بالنسبة للأسبلة، فقد حرص الفقهاء على بنائها باعتبارها من أفضل أوجه الصدقة الجارية. فتسهيل الحصول على المياه، وفضل سُقيا للإنسان والحيوان، من أوجه البر التي يتقرب بها العبد إلى الله؛ ولاسيما بعد ظهور الحاجة الملحة لها، نتيجة ازدياد عدد السكان في المدن المصرية الكبيرة، وعدم كفاية الآبار وحدها لتوفير السقاية اللازمة. وقد ترجم المعماري المصري ذلك ترجمةً ماديةً حية؛ فقام ببناء أسبلةً ملحقةً بالمساجد والمدارس والخانقوات والزوايا والوكالات والمساكن؛ بل قام بتوفير حجرة “المزملاتي” الذي كان يتولى نقل المياه إلى السبيل.
وأخيرًا، نأتي إلى البيمارستانات (المستشفيات) التي عدها الفقهاء أيضًا من أبواب الصدقة الجارية الضرورية الملحة، لكونها تتعلق بالمقاصد الشرعية في حفظ النفس والعقل والنسل. وهو الأمر الذي دفع الكثيرين من الخلفاء والسلاطين والأمراء نحو وقف الأوقاف المختلفة عليها، لكي تستمر في أداء رسالتها. ومن نماذج العمارة التي أحدثها المعماري المصري في البيمارستانات، محققًا لمقاصد حفظ النفس والعقل، تفننه هندسيًا في بناء التكوينات الداخلية التي تساعد على توفير التهوية الجيدة والإضاءة الطبيعية المعينة على إيجاد مناخٍ صحي يُسرع في عملية الشفاء والعلاج. كذلك اختياره –في كثير من الأحيان– إلحاق الحمام العام بالبيمارستان لارتباط النظافة بالصحة. إضافةً إلى بنائه فاصلًا بين المرضى الرجال والنساء، منعًا لضرر الكشف. وأيضًا، إقامته لقاعات مخصصة –في داخل البيمارستان– لتدريس علم الطب، كواجب شرعي حث عليه الفقهاء، معتبرين إياه من فروض الكفاية التي إن لم يقم بها بعض المسلمين من أهل البلد، أثم بها أهل البلد المسلمون جميعًا.
ما بعد القراءة
هالني ذلك الزخم الثري من صور التحضر الإسلامي؛ تحضرٌ في الرؤية الكلية للمعمار، وفي السياسات والأدوات المعمارية. وأذهلني ذلك الرصيد الضخم من نماذج الحضارة الإسلامية التي فاض بها تاريخنا الإسلامي. إنه رصيد قوامه وعماده حفظ حقوق الإنسان –على أعلى مستوى يمكن للمرء تصوره– وليس قوامه البهرجة والسفسطة والزينة. إلى هذا الحد كانت حضارتنا الإسلامية حريصةً على خيرية الإنسان وصلاحه ونمائه دينًا ونفسًا ونسلًا وعقلًا ومالًا؟ إلى هذه الدرجة كانت حضارتنا الإسلامية حاميةً للإنسان الذي يعيش تحت مظلتها –أيًا كانت عقيدته– حاميةً له من أي ضرر يصيبه؛ سواءً كان هذا الضرر متمثلًا في مبنى يكشف ستره، أو رائحةٍ تؤذي أنفه، أو دخانٍ يُسود وجهه وملابسه، أو منشأةٍ تضيق عليه الطريق، أو صوتٍ يُقلق منامه وراحته؟ إلى هذه الدرجة كان الحفاظ على بني الإنسان، أكرم من خلقه الله على وجه الأرض؟ إلى هذه الدرجة كان الإدراك بمعنى “الإنسان الخليفة” الذي اصطفاه الله على الملائكة ليصير خليفةً له على الأرض؟ فيُصلح ويُعمر ويبني بسم الله وفي سبيل الله؟
وهو ما يجعلني التطرق إلى نقطةٍ جانبية، واجب علي ذكرها في هذا المقام؛ وهو أن العالم الإسلامي لم يشهد “عصورا وسطى”، وهو المصطلح الذي استخدمه المؤلف –في ظني عن سلامة نية– أكثر من مرة. وهو مصطلح يشيع استخدامه في كتب التاريخ الغربي التي صنفت العالم كله تحت المُسميات الغربية؛ إلا أن هذا الكلام غير صحيح من الناحية العلمية. ذلك أن العالم الإسلامي لم يشهد ذلك الانهيار الذي شهده الغرب فيما بين القرنين الثامن والحادي عشر الميلاديين (الفترة المؤرخة غربيًا بالعصور الوسطى)؛ إنما كان يشهد –خلافًا لذلك– أزهى عصوره الحضارية؛ ثقافيًا وعلميًا وأدبيًا ومعماريًا وفنيًا. لقد أرادت القوى الغربية الاحتلالية أن تُلحق “العصور الوسطى” عنوةً بالعوالم الحضارية الأخرى، غير الغربية، ومنها الإسلامية، حتى تدفن أي فكرة تشير إلى إحتمالية وجود حضارات أخرى، قد تكون متقدمة على نظيرتها الغربية.
نعم، لقد كان تقدم حضارتنا ناتجًا عن تضافر وتناغم الدين مع الدنيا، وليس فصلهما كما كان الوضع في الحضارة الغربية؛ ذلك هو السر الكامن لتميز حضارتنا الإسلامية. وذلك ما أوضحه الكتاب الماثل أمامنا: كيف تضافرت وتناغمت الضوابط والأحكام الفقهية مع الابتكارات والحلول المعمارية. كيف انسجمت أحكام الدين والشرع مع المنتجات المعمارية المادية الصلبة. كيف قام الفقيه والمعماري – معًا – بعزف لحنٍ واحد، أطرب وأمتع كل من أسمعه. كيف التحم الدين مع الدنيا بدون وقوع أي نشاز. ذلك “النشاز” الذي طالما أجزم الغرب بحدوثه، فبات يحُذر منه الجميع، ويُخوف منه الجميع، بل يُجرم جميع من يدعون إليه، فيُصنفهم تارةً بالإرهابيين، وتارةً بالمتطرفين، وتارةً بالمتخلفين.
وهنا يتبادر إلى ذهني السؤال التالي: أين ذلك التاريخ الحضاري في كتبنا المدرسية؟ وفي وسائلنا الإعلامية؟ وفي خطبنا الدينية؟ ولماذا اقتصرت المناهج المدرسية على تدريس التاريخ السياسي فقط وإغفال التاريخ الحضاري المجتمعي الذي ظل مستمرًا رُغمًا عن استبداد الحكم السياسي في مواضع كثيرة من تاريخنا الإسلامي؟ وهو ما أعطى الفرصة والمجال للتهكم والتهجم على تاريخنا؛ وذلك نتيجةً للنظرة الأحادية القاصرة التي تهتم بالزاوية السياسية فقط، أي بالساسة والحكام فقط، دون الناس والشعوب والمجتمعات.
الإجابة عن ذلك السؤال نستطيع استنباطها من طبيعة منظومة الحكم التي استقرت في بلاد المسلمين بعد إجلاء القوات المحتلة (سواء البريطانية أو الفرنسية) في أواسط القرن العشرين، وهو ما سُمي “استقلالًا” وما هو باستقلال. بمعنى آخر، إن هذا “الاستقلال” لم يكن إجلاءً حقيقيًا للمحتل، ولم يكن استقلالًا حقيقيًا للبلدان والشعوب الإسلامية عن الحكم الغربي؛ إنما كان استقلالًا عن الذات الحضارية الإسلامية، واستقلالًا عن كل شيء يُذكرنا بتميزنا وتفوقنا الحضاري الذي كان، واستبداله بسرد كل العيوب التي لحقت بتاريخنا السياسي، كأنه هو الجانب الوحيد لتاريخنا، حتى يصير الفرد المسلم كارهًا لأصوله، أو متحرجًا منها على أقل تقدير.
أما أكثر ما أصابني بالإحباط –جراء قراءة هذا الكتاب– عقدي مقارنةً سريعة بين المعمار في مصر الإسلامية وبين المعمار في مصر الحالية. إنه فارقٌ ما بين السماء والأرض؛ فارقٌ ما بين معمار كان مراعيًا لأدق حقوق الإنسان، يصل إلى مراعاة حقه في استنشاق الهواء النظيف، وتفقد عينه وأذنه وجلده وبشرته من أي ضررٍ كان، وبين معمارٍ حالٍ متجاوز لحقوق الإنسان كلها، يصل إلى إخراجه غصبًا وعنوةً من مسكنه، الذي آواه عقودًا طوال، من أجل بناء كوبري أو إقامة مشروع استثماري. سنوات ضوئية فاصلة بين معمارٍ كان رحيمًا بخلق الله؛ معمارٍ كان يطوف حول مقاصد الدين، وتلبية المنفعة العامة، وبين معمارٍ فظٍ غليظ قاس، بات يطوف حول مقاصد المحاسيب ومصالح خاصة على حساب مقاصد الدين، وعلى حساب مصالح جموع الناس.
ماذا نرى الآن؟ محلات تعتدي على حق الطريق، وعلى حق الرصيف؛ عمارات تعتدي على حق الجوار، فتتجاوز المساحة المسموح بها في البناء، وتنتهك حق الخصوصية وحق الـمَطلّ؛ متاجر تقتحم وتغزو الأحياء السكنية، فتتُحدث ضجيجًا وازدحامًا وقذارةً؛ منشآت يُنفق عليها ببذخ وإسراف في مقابل مقابر اتُخذت بيوتًا ومأوى لأناسٍ لا يجدون قوت يومهم؛ ثم الطامة الكبرى التي تمثلت في نقل الناس من بيوتها بالقوة، وخلعها غصبًا من محيطها المجتمعي، من أجل تنفيذ مشاريع “قومية”، لا تنتفع منها العامة بقدر ما تنتفع منها الخاصة التي أدخلتنا في نفقٍ من الديون، سيمتد بنا إلى عقودٍ ممتدة.
ملخص القول، ما نشهده حاليًا من سياسات معمارية ليس له أدنى علاقة بالسياسات المعمارية في كتاب “الفقيه والمعمار”. فكل ما تطرق إليه الكتاب من تناول “الضرر” –بكافة أشكاله– وكيفية دفعه بكل السبل، لا يمتّ لواقعنا الحالي بأي صلة. بل العكس هو الصحيح؛ إذ تفننت السياسات الحالية في كيفية إحداث الضرر المادي والمعنوي بكل أشكاله؛ بل بصورٍلما يكن يتوقعها فقهاء ومهندسو مصر المملوكية والعثمانية.
نحن بتنا نعيش واقعًا، ينفصل فيه الدين عن السياسة انفصالًا كاملًا شاملًا، فأضحت سياسةً غير أخلاقية، وغير مسئولة. سياسةً ليس لديها أي مانع من إلحاق الضرر في أي وقتٍ وفي أي مكان بالناس والمجتمع. وليت هناك من يمنع تلك السياسات؛ فلم يعد هناك قضاء أو أوقاف أو محتسبون أو طوائف حرفية تقف سدًّا مانعًا ضد تلك السياسات. لقد تلاشت تلك المنظومة المجتمعية التي كانت تقوي المجتمع وتدعمه أمام الساسة والحكام. تلاشت تلك المنظومة التي كانت تراقب وتحاسب أفعال الساسة، وتُمكن الناس من رفع مظالمهم واسترجاع حقوقهم. وتلاشى معها الفضاء السياسي الرحب الذي كان متسعًا للمجتمع بأكمله.
فارق كبير وبونٌ شاسع بين منظومةٍ معماريةٍ تديرها مؤسساتٍ عدة، تتكاتف جميعًا من أجل المنفعة العامة، وتتشاور فيما بينها من أجل الخير والصالح العام، وبين منظومةٍ معمارية مُشَخصنة، يديرها شخصٌ واحد، ليحقق عبرها مصالحه الخاصة، ومصالح منتفعيه ومحاسيبه، محليًا وإقليميًا ودوليًا؛ على حساب شعبٍ بأكمله، يمثل أهل البلد وأصحابه الحقيقيين؛ يمثل مِلح الأرض.
التعمير –من منظور إسلامي– غايته تحقيق مقاصد الشريعة الخمسة، وليس الإبهار والبهرجة والزينة والإسراف؛ وليس تقديس الحكام، وإذلال الناس في تشييد أبنيتهم. وأينما انصرف التعمير عن تلك المقاصد الإسلامية العليا، بات فارغًا من مضمونه؛ مُخرِّبًا لحياة الناس، مُلحقًا الضرر بمعاشهم ودنياهم، وبدينهم واُخراهم… أضحى إفسادًا وتخريبًا ومواتًا وظلمًا. فنجد على جانب القصور والبنايات الفاخرة المُشيدة لتبجيل الحاكم، ونجد من جانبٍ آخر حياة الناس المُعطَلة المُكدَرة. “فكأين من قريةٍ أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئرٍ معطلةٍ وقصرٍ مشيد” (الحج: 45).