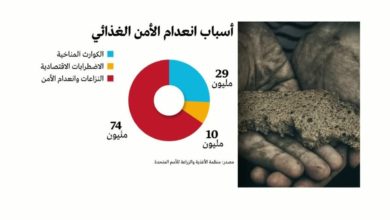سوريا الجديدة في الشام الكبير: بين الذاكرة التاريخية وتداعيات طوفان الأقصى

(1)
منذ السقوط السريع لنظام بشار الأسد وطيلة عام كامل منذ 8 ديسمبر 2024، لم تكفَّ الأصوات والأقلام من كافة الاتجاهات الفكرية والسياسية، وعبر أرجاء الأمة الإسلامية وأرجاء العالم، عن تناول هذا المفصل التاريخي للتحول الإقليمي من حيث الأسباب والمحددات، ومن حيث التداعيات والمآلات، ومن حيث التحديات الداخلية والخارجية أمام سوريا الجديدة، ووجهة وتوجه النظام الجديد على رأس هذه الدولة العربية الإسلامية في قلب الشام الكبير، خاصة أن هذا السقوط جاء خلال أسبوع واحد، وبعد أربعة عشر عامًا من الثورة المسلحة علي ذلك النظام.
وقد انقسمت الاتجاهات حول هذا المفصل بين عدة رؤى؛ فمن ناحية أولى: جاءت رؤى أصحاب نظرية المؤامرة؛ بأنها مؤامرة على الحرية والمدنية وحقوق الإنسان، أو على “الدول القُطرية الوطنية”؛ وذلك نتيجة انتصار فصيل سُني أصولي جهادي مسلح على نظام علماني عروبي عَلَويّ رفع -من قبلُ- شعار الممانعة؛ وهو فصيل له سوابق من المواجهات مع الشيعة والعلويين والدروز ومع الأكراد.
ومن ناحية أخرى: يأتي أصحاب نظرية أولوية حقوق الشعوب برؤى عن التحرر والعدالة والتنمية واستعادة هوية الأغلبية السُّنية وحقوقها؛ نتيجة انتصار ثورة مسلحة على نظام تسلطي علوي لم يجاهد إسرائيل بقدر ما تواطأ معها ضمنًا؛ بحيث كان في استمراره تحقيقا لمصالح إسرائيلية متراكمة طيلة خمسة عقود، وذلك على حساب مصالح الشعب السوري، ومن خلال التمييز الحادّ ضد الأغلبية العربية السنية ومكونات قومية ومذهبية أخرى (الأكراد، التركمان، والدروز).
ومن ناحية ثالثة: تأتي رؤى أصحاب نظرية أولوية الاستقلال عن المصالح الغربية والنضال ضد التحالف الأمريكي الصهيوني المباشر وضد من يوالي هذا التحالف من العرب، تأتي نتيجة انتصار ثورة مسلحة سرعان ما أعلن نظامُها الانتقاليُّ أولويةَ إعادة بناء الدولة وتقديمها على الصدامات الإقليمية، مع صمته عن الاعتداءات الإسرائيلية العسكرية المتتالية على الأراضي السورية.
لم تكن هذه الرؤى الأساسية المتجادلة وليدة فراغ، لكنها كانت -من ناحية- وليدة ذاكرة تاريخية شكلت وجهةَ نظر كل فريق، كما كانت -من ناحية أخرى- وليدة عام من المواقف والأحداث والتفاعلات الداخلية والخارجية؛ وهو العام المنصرم منذ نجاح الثورة السورية وحتى اكتمال الاعتراف الدولي بالنظام الانتقالي من داخل الأمم المتحدة، مرورًا بمواقف القوى الكبرى الغربية والقوى الإقليمية العربية، وعبر تبلور نواة مؤسسات داخلية من خلال: حوار وطني، اختيار رئيس، إعداد للانتخابات البرلمانية، ودعوات لبناء جيش وطني، ولإعادة إعمار اقتصادي، مجاهدة فتن انقسامات قومية ومذهبية، ناهيك بالطبع عن الاعتداءات الإسرائيلية العسكرية على سوريا دون مجابهة جادة من الجيش السوري الجديد. بعبارة أخرى، يواجه النظام الانتقالي السوري إشكاليات عديدة؛ من: الانقسام المجتمعي المذهبي والقومي والديني، والدمار الاقتصادي والاستقطاب السياسي الأيديولوجي، على النحو الذي تستغله قوى معادية لنجاح الثورة -بهذا الشكل- وبما يهدد من وحدة إقليم الدولة، بينما تتعدد الرؤى في توصيفه، وفي تحديد ما الذي يجب على النظام الجديد أن يفعله الآن.
وبقدر ما انطلقت كلٌ من هذه الرؤى الثلاث الرئيسة من توقعات عن مآل “النظام السوري الجديد”، بقدر ما كان الواقع الداخلي والإقليمي والعالمي يفرض تحديات بل تهديدات أمام هذا “النظام”. ولقد كان الوضع القائم من التعقيد بحيث أثار من الشكوك والاتهامات بقدر ما أثار من مخاوف على النظام وآمالٍ منه.
في هذا الإطار تعطي كل من هذه الرؤى الأولوية لجانب دون آخر من الصورة الكاملة: استكمال الثورة أم إعادة بناء الدولة؟ الاستقرار والتنمية أولًا أم مجابهة العدو الصهيوني والحليف الأمريكي أولا؟ تعبئة المساعدات الخارجية أم استقلال القرار الداخلي؟ إدارة التوازن بين الجماعات القومية والدينية والمذهبية حفاظًا على وحدة الأراضي السورية وتماسك المجتمع السوري أم المواجهة مع القوى الإقليمية المحركة للانقسام بين هذه الجماعات؟
ومن ثم، ففي إطار نظام إقليمي غير مستقر، وتحت وطأة نظام عالمي يقوده تحالف صهيوني غربي مصمم على تشكيل المنطقة تحت هيمنة صهيونية رأسمالية، يظل مآل النظام السوري الجديد واقعًا تحت علامات استفهام كثيرة، ويطرح التفكر في هذا المآل الأسئلة التالية حول قضايا مصيرية:
- كيف تحولت قيادة ثورية مسلحة (الشرع وفصيله) هذا التحول الجوهري المتمثل في قبول أمور كانت مرفوضة تماما بالنسبة لها من قبل؛ بحيث تم “رفع” سوريا بقواها من قائمة الإرهاب والعقوبات الأمريكية والدولية سواء المفروضة على ذلك الفصيل أو نظام بشار من قبله.
- هل هذه مجرد تحولات تكتيكية نحو أمريكا وإسرائيل والخليج من ناحية، ونحو العراق وإيران وفلسطين من ناحية أخرى؛ لتعبئة المساعدات، وكفّ العدوان المسلح، ووقف المقاطعة الاقتصادية، ومواجهة التدخلات الخارجية خاصة العاملة لتحريك الدروز والأكراد والعلويين ضد النظام الجديد؟
- أم إن هذا الفصيل الذي قاد الثورة المسلحة -وقائده الجولاني أو الشرع- كانا منذ البداية أداة خارجية ضد نظام بشار حتى تم إسقاطه في اللحظة الإقليمية المناسبة وفق مخطط أمريكي تركي خليجي إسرائيلي أو بعض ذلك؟!
- أم إن النظام الانتقالي الجديد قد يدير خطة انتقالية لتحقيق أولويات الاستقرار وإعادة البناء والأمن الداخلي أولًا، وكف العداءات الإقليمية ثانيًا، وكسر الحصار والمقاطعة الغربية والعالمية ثالثًا، ولكن دون مواجهة مع العدو الصهيوني؟
وبعبارة أخرى: هل تفرض ضخامة وتشابك وتعقد التحديات والتهديدات للنظام الجديد إعطاء الأولوية لإعادة بناء الدولة حتى ولو على حساب “أيديولوجية الفصيل الثوري القائد”؟ ومن ثم ما هي فلسفة هذا النظام الجديد: هل التطبيع مع إسرائيل، والاندماج في النظام الرأسمالي العالمي والإقليمي، واختيار جانب التحالف مع توجه النظام الخليجي الفرعي، أم التحالف مع الجوار التركي، أم مواجهة الجوار الإيراني ومحوره الإقليمي مع ما سبق؟
قد تقدم أوراق الملف التالي إجابات عن هذه الأسئلة المتشابكة، وذلك من واقع رصد الحالة السورية بأبعادها المختلفة خلال عام، ولكن يظل هناك أمران ضروريان ينبغي استدعاؤهما تمهيدًا لحسن تدبر هذه الإجابات أيا ما كانت:
الأمر الأول: هو أن التدبر في عام مرت به سوريا الجديدة لا يمكن أن يتم بمعزل عن السياق التاريخي للشام الكبير كله، حتى حاضره؛ وهنا تأتي أهمية استدعاء الذاكرة التاريخية الحضارية لهذا الشام في قلب المنطقة العربية.
الأمر الثاني: أن عامًا واحدًا لا يكفي لاستشرافٍ علميٍّ لحركة ومآل مسار النظام السوري الجديد؛ لأن هذا الاستشراف لا بد أن يتم من تحديد منطلقات وأهداف وبدائل وسينايوهات كل طرف إقليمي ودولي تجاه سوريا. لكن في المقابل فإن عامًا واحدًا، من موقع مصلحة “الأمة العربية الإسلامية” وجِواريْها الحضاريين التركي والإيراني، يكفي لإعادة تخيل ما يجب أن تكون عليه سوريا الجديدة في ظل الشام الكبير؛ حمايةً للشعب السوري (حقوقًا وحريات وهوية ومكانة) والتزاما بالقضية الفلسطينية، ومنعًا لمشروع تشكيل المنطقة وفق “الهوى الصهيوني الأمريكي”.
إن الأمرين لا يتصلان بسوريا الجديدة، فقط، ولكن بقلب الشام الكبير: “فلسطين”؛ فإن الصراع الحالي في “الشام الكبير هو -في واقع الأمر- صراع على فلسطين؛ وهو ليس صراعًا على أرض وحسب، ولكن على تاريخٍ ودينٍ وهويةٍ ومكانةٍ؛ وهو صراع على القدس في قلب فلسطين؛ برمزيتها المعروفة. وإذا كان المرحوم المستشار طارق البشري قد رأى أن “فلسطين وعاؤها القدس”، فإن فلسطين -بحدود الانتداب البريطاني- تظل قلب الشام الكبير؛ ذلك الفضاء الحضاري العربي الإسلامي الذي كان باكورة الفتوحات الإسلامية، وقد بقيت أرضه -منذ ذلك الحين- ساحة تدافع أساسية بين المسلمين والغرب الصليبي ثم الاستعماري. وهذا هو الشام المتجلي في فلسطين وسوريا وبينهما لبنان.
ومن ثم، فإن عصر “الصراع مع الصهيونية وإسرائيل” على ساحة الشام الكبير منذ 1897، ثم في فلسطين الانتداب (1920- 1948)، ثم فلسطين المحتلة من الكيان الصهيوني (منذ 1948) وتوسعاته، إنما هو حلقة من سلسلة ممتدة من هذا الصراع التاريخي على قلب وروح الشام الكبير الذي وعاؤه فلسطين والقدس. لذا، فإن مآل سوريا الجديدة لا ينفصل عن ذاكرة هذا التدافع المركب منذ أن كانت سوريا ولاية في دولة خلافة إسلامية متعاقبة عبر ثلاثة عشر قرنًا.
(2)
لم ينقطع الشام الكبير -عبر تاريخه ومنذ ما قبل ظهور الإسلام ثم ما بعده- عن باقي مكونات الفضاء الحضاري العربي (الجانب الأيسر من قلب الأمة الممتد حتى المحيط الأطلنطي) بدرجة أساسية، كما لم ينقطع -بعد ظهور الإسلام- عن الجانب الأيمن من قلب الأمة، الممتد حتى الصين شرقًا؛ حيث ساد حكم الإسلام للجانبين نحو عشرة قرون كاملة، تخللتها موجات التحدي ثم التهديد من أقوام غير مسلمة: الوثنية (المغول)، والمسيحية (البيزنطية، الصليبية، أوروبا الاستعمارية). هذا، ولم ينفصل جناحا الأمة شرقًا وغربًا عن بعضهما وعن الشام الكبير، وخاصة عبر الهجرات البشرية. فعلى سبيل المثال، فإن العثمانيين الذين سادوا الأمة والعالم طيلة ستة قرون جاءوا من غرب الصين رعاة رحّلًا في هجرة نحو الغرب الإسلامي بحثًا عن وطن ودولة، فانتقلوا من شرق الأمة إلى غربها، وجاوروا الشام حتى ضموه وبقية العالم العربي إلى حاضنة إسلامية شاملة في القرن 16م، كما كان معتادًا.
ومن ثم، كان الشام الكبير (الذي وعاؤه القدس- فلسطين) ساحة تدافع أقوام عدة: عرب وغير عرب، مسلمين ومسيحيين ويهود ووثنيين، شاع فيهم الإسلام -إما دينا وعقيدة، أو حضارة وثقافة، أو حكمًا وسلطانًا- واستوعبهم، فاستقروا على أرضه قرونًا طويلة.
كما كان الشام الكبير ملتقًى لطرق تجارة متنوعة من الشرق والغرب: برية وبحرية، ولعب ازدهار هذه التجارة -تحت تأثير التفاعل مع السياسة والحروب- أدوارًا في صعود هذا الفضاء الحضاري الإسلامي كله بجناحيه العربي وغير العربي، كما لعب أفول تلك التجارة وتراجع التفاعلات الحياتية دورًا مقابلًا في تراجع ذلك الشام وفضائه العربي الإسلامي وجوارهما الحضاري الإسلامي التركي والإيراني.
إن “الشام الكبير” المعاصر ذو منظومة ثلاثية عربية الأطراف (سوريا، لبنان، فلسطين- ومعها الأردن بوضعية مختلفة)؛ وهي ثلاثية تقع في نطاق جوار إقليمي حضاري إيراني- تركي، وتتسم بتعددية في مكوناتها العرقية والقومية والدينية والمذهبية؛ إنه بلقان الشرق الإسلامي ولكن بأغلبيات مسلمة.
فكلتا المنطقتين تاريخيًّا هما من مناطق التخوم والتلاحم بين فضاءات حضارية مختلفة، ومناطق عبور من بقاع إلى أخرى؛ وهذا يفسر التعددية في مكوناتهما المجتمعية والسياسية. فكلتاهما ذواتا خصائص ديموغرافية ودينية تعددية، وتعرضت هذه الخصائص لإعادة التشكيل طوعًا أو قسرًا تحت تأثير تحولات تاريخية مهمة، أثرت جميعها على الأوضاع السياسية لهذه المناطق ومواضعها في الصراعات الإقليمية والعالمية، وخاصة مع كل مفصل من المفاصل التاريخية لتطور النظم الدولية. وفي حين مثلت هذه التعددية المتنوعة نسيجًا مجتمعيًا متماسكًا في مراحل القوة الحضارية وتكامل أشكال الوحدة السياسية لهذا الفضاء الحضاري الشامي الإسلامي، وعلى نحو أسهم في مواجهة التهديدات الخارجية للأمة عبر التاريخ (روم بيزنطيين، مغول تترين، أوربيين صليبيين)؛ فإن هذه التعددية تحولت -بالتدريج في مراحل الضعف والتناحر البيني السياسي- إلى أداة مهمة للتدخلات الخارجية الرامية إلى تصفية ما بقي من التركة العثمانية في الشام، وحتى تم الاستعمار الأوروبي الحديث تحت رداء الانتداب والحماية، فبدأت مرحلة أخرى من تكريس التنافر بين مكونات أهل الشام (القومية المذهبية الدينية)، ناهيك عن تجزئته بحدود مصطنعة قسمت الفضاء الحضاري الممتد إلى دول قومية خلال الاستعمار وما بعده.
إن مراجعة الذاكرة التاريخية للنموذج “الشامي” تساعد على وضع التحذيرات والشكوك والمخاوف والأوهام التي تحيط بمستقبل سوريا الجديدة في المنطقة منذ طوفان الأقصى في حجمها الحقيقي دون إفراط أو تفريط؛ حتى تتبين شروط تحويل التعددية السلبية إلى تعددية راشدة، وخاصة في مواجهة التدخلات والضغوط من جانب الثورات المضادة الداخلية والأخرى الخارجية، والأهم من جانب المشروع الصهيوني الذي يضرب الآن بقوة على الجبهات الثلاث في آن واحد (فلسطين ولبنان وسوريا)، ولكنه في الوقت نفسه يَلقَى مقاومة متفانية باسلة بأنماط متنوعة عسكرية أو سياسية؛ مقاومة صامدة في مواجهة مرحلة متوحشة متوسعة من المشروع الصهيوني.
ومنذ عام أو يزيد (نوفمبر 2024) تدافعت من جديد على سوريا ولبنان وفلسطين في آن واحد أحداث مهمة (سقوط بشار الأسد، اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر 2024، ثم اتفاق وقف النار في غزة في يناير 2025)، تمثل مفرقًا آخر في منظومة الصراعات في الشام الكبير منذ طوفان الأقصى، بل منذ اندلاع الثورات العربية (في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين)؛ سواء من حيث حالة المشروعين المتنافسين على المنطقة من الجوار الحضاري الإيراني والتركي من ناحية، أو من حيث موضع المشروع الصهيوني بينهما وحالة المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي وأطماعه في المنطقة برمتها من ناحية ثانية.
- لقد شهد عقد الثورات العربية أو هذا الربع قرن الأخير اندلاع الثورة السورية، فالتدخل الإيراني المباشر في الحرب الأهلية بين نظام الأسد وفصائل الثورة والمعارضة السياسية والمسلحة، مع استمرار المقاومة في الضفة وغزة متحدية الاحتلال الصهيوني ومتحدية نظام السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ومتعرضة لموجات من العدوان الإسرائيلي المتتالية (2000، 2008، 2012، 2014، 2021)، وكذا في لبنان:فبعد انتصار حزب الله على العدوان الإسرائيلي يوليو 2006 دخل دوره العسكري والسياسي المدعوم من إيران مرحلةً ألقت بظلالها على الداخل اللبناني وعلى الجوار الإقليمي، على نحو متناقض: مساندة نظام الأسد في مواجهة المعارضة من جانب، ومساندة المقاومة من غزة في مواجهة إسرائيل من جانب آخر.
- حقيقةً، قدمت لنا الحالات الثلاث (سوريا، لبنان، فلسطين)، عبر عقدين ويزيد، تفاعلات متراكمة ومترابطة، جعلتها تمثل منظومة واحدة، وجاء طوفان الأقصى وتداعياته ليبرز هذا الالتحام والتواصل على النحو التالي:
فلقد ظهر خلال العدوان الإسرائيلي على غزة بعد طوفان الأقصى ولما يقرب من العام (حتى نهاية 2024) كيف أن إيران وحزب الله اللذين يساندان الأسد على شعبه، هما أيضا -في الوقت نفسه- يساندان المقاومة في غزة ضد العدوان الصهيوني، في ظل خذلان عربي واضح، ودور تركي مساند سياسيًا فقط؛ وهو الأمر الذي فجَّر معضلتين مهمتين لم تخلُ منهما الساحة العربية الإسلامية منذ عقود:
- الأولى هي المعضلة بين تحالف النظم المستبدة التي تتماهى تحت شعار محور الممانعة مع المشروع الإيراني الشيعي.
- والمعضلة الثانية هي أن حركة المقاومة ضد إسرائيل في فلسطين تلقى في نفس الوقت دعمًا إيرانيًّا في غزة، وفي المقابل فإن كلًا من حركات المعارضة المسلحة في سوريا وحركات المعارضة السياسية في لبنان تتواجهان مع هذا المشروع الإيراني وحليفه حزب الله في لبنان وحليفه الأسد في سوريا.
وهكذا أضحى هناك تقاطع أو تناقض بين أولويتين: التحرر من النظم المستبدة، والتحرر من الاحتلال الصهيوني وما وراءه.
ومنذ نهاية العام 2024 بدا أن هذه المعضلات تأخذ منحنى مختلفًا:
أولًا– بعد صمود حزب الله أمام العدوان الإسرائيلي الجوي والبري منذ سبتمبر 2024، جاء اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية أكتوبر 2024 ليخرج حزب الله من إسناد غزة، وليدخل حزب الله ذاته في مرحلة مواجهة جديدة مع الدولة اللبنانية وقوى المعارضة السياسية التي لم تكف عن الهجوم عليه منذ 2006. وازداد هذا الهجوم بعد الخروج الإيراني من سوريا. ورغم استمرار العدوان الإسرائيلي وعدم الانسحاب من جنوب لبنان، ورغم عدم قدرة الجيش اللبناني على وقف هذا العدوان، بل استجدائه التدخل الدولي من أجل التفاوض؛ ظلت الساحة اللبنانية تفرز تحديًا لحزب الله من أجل نزع سلاحه.
ثانيًا– إن نجاح فصائل المعارضة السورية المسلحة في إسقاط نظام الأسد في مشهد فريد من نوعه من حيث الإسناد القوي من تركيا ومن حيث التداعي السريع لإيران وحزب الله في سوريا من ناحية وروسيا من ناحية أخرى؛ حيث فقد الأسد -وبسرعة مذهلة- مساندة حليفين أساسيين سانداه طيلة ما يقرب من العقد ونصف؛ الأمر الذي انعكس سلبًا على إسناد حزب الله لغزة في مواجهة إسرائيل، التي ازدادت نشوتها بإعلان انتصار مزعوم على محور إيران.
ثالثًا– وبعد اشتداد العدوان الإسرائيلي على غزة، وفي ظل خروقات إسرائيلية كبيرة لاتفاق لبنان وتزايد التحديات بتصفية الوجود العسكري لحزب الله كحركة مقاومة من لبنان، ومع تسارع إسرائيل فور سقوط نظام الأسد بتوسيع مناطق احتلالها في منطقة الحدود الجنوبية لسوريا من ناحية، وتدمير قدرات عسكرية للجيش السوري من ناحية أخرى، ومع استمرار صمود المقاومة في غزة، جاء الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 12 يناير 2025، الذي تكرر توقعه دون نجاح منذ مبادرة بايدن في مايو 2024. ولقد جاء الاتفاق على النحو الذي يشير إلى عدم تنازل حماس عن ثوابت موقفها التفاوضي طيلة عام. ويتضح تدريجيًا خلال تنفيذه الذي بدأ منذ 19 يناير 2025، صعود حرب بين إسرائيل وحماس ولكن من نوع آخر؛ أي حرب إعلامية وسياسية حول أمرين: من المنتصر ومن المهزوم وحول التزامات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق (42 يومًا) وفرص وصعوبات الإعداد للتفاوض حول المرحلة الثانية والوصول لاتفاق بشأنها بالفعل، وأخيرًا فرص المرحلة الثالثة وفي قلبها إعادة الإعمار ومن يحكم غزة.
وازداد التهديد للمرحلة الأخيرة بل ولاستمرار الاتفاق كله مع تصريحات ترامب قبل وخلال وبعد زيارة نتيناهو لواشنطن (2-6/2/2025) عن التهجير القسري لأهل غزة للاستحواذ عليها من أجل إعادة بنائها. وبقدر ما كشفت هذه التصريحات عن نوايا الصهيونية اليهودية والصهيونية المسيحية تجاه تصفية القضية الفلسطينية من جديد، بقدر ما ألقت بانعكاساتها على ضلعي المثلث الشامي الأخيرين: سوريا ولبنان، وخاصة مع انهيار الاتفاق بتجدد العدوان الإسرائيلي في مارس 2025.
(3)
هذه المشاهد الثلاثة إجمالًا، ودون دخول في تفاصيل كل مشهد، تمثل حتى الآن (نهاية العام الأول من عمر “النظام الجديد” في سوريا ونهاية العام الأول من الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، ومع عقد ما سمي “اتفاق شرم الشيخ للسلام في الشرق الأوسط” في أكتوبر 2025) وبداية تدمير مرحلته الأولى)؛ تمثل منظومة واحدة لا يمكن الفصل بينها رغم ما تعكسه من تناقضات فيما بينها، وتحيّر وتقلق المهتم بشأن المقاومة ضد إسرائيل والحريص على استمرارها سواء في لبنان أو سوريا أو غزة من ناحية، أو المهتم من ناحية أخرى بشأن حريات وحقوق شعوب هذه الدول الثلاث من ناحية أخرى؛ وهي حريات وحقوق من أنماط متنوعة؛ لأن كل حالة تقدم مجموعة تحديات وإشكاليات خاصة أمام هذه الحريات والحقوق، وإن اشتركت المجموعات الثلاث في بعض الملامح المهمة.
هذه الملامح المشتركة ذات جذور تاريخية، وبقدر ما تفصح عن نفسها بأشكال متنوعة خلال مفاصل تاريخية متتالية خلال القرن الماضي، بقدر ما تفصح عن خطط القوى الاستعمارية التقليدية والاستيطان تجاه هذا الشام الكبير، وتجاه علاقات مكوناته الثلاثة بعضها ببعض. وهو الأمر الذي يمثل جوهر التحدي والتهديد لسوريا الجديدة؛ لأنه يكشف عن تعقيد المشهد من حولها وتداخله.
وتتلخص هذه الملامح المشتركة في الأبعاد التالية:
- احتلال إسرائيل للأرض وفرض ما يسميه نتيناهو إعادة تشكيل المنطقة بالقوة العسكرية ليتحقق سلام إسرائيل أي الهيمنة الإسرائيلية المفروضة بالقوة العسكرية:
وتعاني الحالات الثلاث بالطبع بدرجات متنوعة من هذا الاحتلال الصهيوني، وإن كان احتلال فلسطين 48 هو المنطلق، فلقد تلته التوسعات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة، وفي الجوار السوري واللبناني والأردني، (والمصري)، وذلك تنفيذًا للمخطط الصهيوني التوسعي التدريجي. ولقد كشفت حرب الشهور الخمسة عشر السابقة (أكتوبر 2023- ديسمبر 2024)، كيف أن هذه الحرب غاية في حد ذاتها على الجبهات الثلاث لتحقيق أهداف متكاملة تجاه كل منها؛ ضغطًا على حكومة الإدارة الانتقالية في سوريا واستفزازًا لها، وضغطًا على الداخل اللبناني لدفعه إلى تصفية القوة العسكرية لحزب الله، وضغطًا على الجميع لتصفية القضية الفلسطينية بتدمير المقاومة الفلسطينية في الضفة وغزة، بل بإبادة أهل فلسطين أو تهجيرهم القسري استعدادًا لضم ما تبقى من فلسطين إلى إسرائيل كما تم ضم الجولان بمباركة أمريكية.
- لا يجمع الحالات الثلاث أو يحتضنها إطار جامع إقليمي أكثر اتساعًا، شامي أو عربي، بل كانت كل منها عرضة لاختراق عبر إقليمي؛ سواء من الجوار الحضاري الإيراني أو التركي:
كما كانت كل منها اختبارًا جادًا وكاشفًا لعدم تماسك النظام العربي الرسمي في وقت التهديد أو عدم فعاليته أو انهياره؛ وذلك خلال المراحل المفصلية التي مرت بها كل دولة داخليًا وإقليميًا؛ كما حدث من قبل -على سبيل المثال- في الآتي: الوحدة المصرية السورية، ثم انقلاب البعثيين وإقامة النظام البعثي في سوريا، ثم الحرب الأهلية اللبنانية (1976-1990)، فنمو المقاومة الإسلامية الشيعية في لبنان منذ 1982، فالانتفاضة الفلسطينية الأولى 1987، فاتفاقيات السلام العربي والفلسطيني مع إسرائيل منذ 1990 وخاصة أوسلو 1993، ثم الانتفاضة الثانية 2000-2002 عقب اتفاقيات السلام مع إسرائيل، وصولًا إلى حصار غزة منذ 2006 وما بعده.
والجدير بالذكر أن الصراع مع إسرائيل كان في صميم التأثير على التفاعلات الداخلية في سوريا ولبنان، وفيما بينهما وبين الدول العربية الأخرى (الاستقطاب بين محور المقاومة والممانعة من جهة، ومحور التطبيع أو ما سمي بالاعتدال من الجهة الأخرى).
ويكشف المشهد الحالي بكل تناقضاته -وبعد عام من الثورة السورية- الكثير عن هذا الفراغ العربي الأكبر حول الشام الكبير بمكوناته الثلاثة؛ حيث تختلف -إن لم تكن تتصادم- سياسات أطراف عربية حول سوريا ما بعد الأسد، وحول لبنان ما بعد حزب الله، وحول فلسطين ما بين المقاومة أو الاستسلام، وما بعد طوفان الأقصى… الأمر الذي طرح الأسئلة التالية:
- كيف تحتضن -أو تحتوي أو تقيد- كل من السعودية والإمارات ومصر، النظامَ الجديدَ في سوريا لتدعيم إبعاده عن إيران، بل وعن تركيا أيضا؟
- وماذا عن التدخل الخليجي -السعودي بالأخص- في لبنان دعمًا لحكومته السنية ورئاسته المارونية في مواجهة حزب الله حليف إيران؟
- ولماذا برز الدور السعودي والقطري والإماراتي -ولو بدرجات مختلفة- لدعم النظام السوري مباشرة، أو بالوساطة لدى أمريكا من أجل رفع العقوبات عن سوريا، وعلى العكس من النظام المصري؟
- لماذا يخفي الخطاب العربي المعلن تأييده حل الدولة الفلسطينية دعمًا لخيار السلطة الفلسطينية الاستسلامي في مواجهة خيار المقاومة في غزة؟
من هذه الأسئلة، يتضح مدى التقاطع بين تأثير الأبعاد المذهبية والأيديولوجية وبين تأثير المصالح، على نحو يحُول دون اتخاذ مواقف عربية جماعية وفاعلة تجاه العدو الأول للجميع؛ ألا وهو إسرائيل، بل يحول دون المناورة بالمواقف تجاه سوريا ولبنان وفلسطين لصالح التنسيق مع أمريكا وإسرائيل.
- تغلب الدور السياسي الخارجي الأمريكي الأوروبي على الدور الإقليمي العربي في إدارة أزمات الحالات الثلاث؛ سواء في فترة الحرب الباردة، أو مع الانفراد الأمريكي في ظل تحالف وشراكة أمريكية إسرائيلية نافذة على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعبين السوري واللبناني في مواجهة نظام كل منهما: حليفًا للغرب (لبنان)، أو معاديا له (سوريا البعثية):
ولقد ظهر هذا التغلب الخارجي بوضوح في تحول مسار الصراع العربي مع إسرائيل من الحرب النظامية المفتوحة إلى التسويات السلمية، إلى معاهدات السلام ثم التطبيع. فلقد تم هذا المسار في ظل رعاية وضغط أمريكيين بالأساسي.
والآن تحضر أمريكا -بايدن ثم ترامب[1]– بكامل قوتها العسكرية والاقتصادية، وتشاركها الأيديولوجي الصهيوني المسيحي، وضغوطها السياسية، إلى جانب إسرائيل في حرب الإبادة على غزة 2023-2025، وفي الهجوم الجوي والبري على لبنان، وفي التفاهمات (كما يقال) حول الإسقاط السريع لنظام بشار والسعي لاحتواء النظام السوري الجديد من خلال مجموعة من الوعود والشروط والإملاءات والضغوط (كرفع العقوبات بشروط داخلية)، ورعاية الاتفاق اللبناني الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، والمشاركة في الوساطة حول الاتفاق الإسرائيلي مع حماس لوقف إطلاق النار في غزة؛ والذي تبلور في شكل خطة ترامب المفروضة والمعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025.
بعبارة أخرى: تمارس القوى الخارجية تأثيراتها من خلال أدوات اقتصادية وعسكرية؛ سواء بالعقاب أو الثواب، بالمنع أو المنح. ففي حالة الخذلان العربي والإسلامي عن النصرة أو تقديم المساعدة ولكن بشروط في الحالات الثلاث، ينفتح المجال وتزداد الحاجة إلى المساعدات الخارجية؛ سواء للإغاثة (لبنان وغزة)، أو لإصلاح الاقتصاد (سوريا)، وإلى وقف العدوان الإسرائيلي المتكرر على الجميع.
كما يتم التأثير الخارجي من خلال أدوات معيارية ذات أبعاد ثقافية دينية، ضغطًا وترهيبًا أو ترغيبًا. فإذا كانت حماس وحزب الله وفصائل المعارضة السورية إرهابية، فإن على حكومة الإدارة الانتقالية السورية، ووفق شروط أوروبا وأمريكا، أن تراعي حقوق الأقليات والمساواة بينها وتأسيس نظام ديمقراطي قوي وتشترك في محاربة الإرهاب. إن التابوهات الغربية عن حقوق الإنسان والحريات، تم إعلانها باستعلاء كشروط لرفع العقوبات عن سوريا والاعتراف بشرعية النظام الجديد.. وفي المقابل يتم انتهاك كل حقوق الإنسان والجماعات في غزة والضفة وفي لبنان وفي سوريا باسم الأمن الإسرائيلي. ومن أهم أدوات التدخلات الخارجية أيضًا ورقة التنوع الديني أو المذهبي أو القومي أو الأيديولوجي في سوريا ولبنان وفلسطين؛ حيث يتم استغلال وتوظيف هذا التعدد للنيْل من التماسك الداخلي السياسي والأمني (سوريا ولبنان)، أو وحدة أراضي الدولة (سوريا) أو لتصفية القضية برمتها (الاختلاف السياسي بين السلطة الفلسطينية والمقاومة في غزة حول نمط الموقف من إسرائيل).
- تأثير التغير في مراكز القوة العربية وفي أنماط التحالفات الإقليمية العربية وعبر الإقليمية مع الجوار الحضاري الإيراني والتركي:
هذه التغيرات ليست بجديدة على النظام الإقليمي العربي وجواره الحضاري، عبر قرن مضى، منذ سقوط الخلافة العثمانية (بل في القرن السابق عليها)، ولكن المرحلة المعاصرة، التي بدأت بثلاثة أمور: (الثورة الإيرانية، ثم اتفاقات السلام العربية مع إسرائيل (1981، 1992، 1993)، ثم صعود حزب العدالة والتنمية التركي وحكمه منذ 2002)؛ هذه المرحلة قادتنا تفاعلاتُها إلى المشهد الراهن بعد عامين من الطوفان وعام من سقوط بشار. ولقد تسببت أوضاع الشام المتدافعة، منذ عقدين، في تشكيل ملامح التوازنات الإقليمية وعبر الإقليمية الجارية:
- فمع الفراغ الإيراني في سوريا يتجدد دور تركيا بإسقاط نظام الأسد وبعده، وانفتح الباب أمام الدور السعودي الذي سبق أن ساند قوى الثورة ضد نظام الأسد وحليفه الإيراني منذ 2011، كما انفتحت الساحة اللبنانية أيضًا أمام الدور السعودي من جديد بعد تراجع النفوذ الإيراني في لبنان رغم استمرار وجود وتدافع حليفه الأساس حزب الله مع القوى السياسية اللبنانية الأخرى… والدوران السعوديان لا يصبان بقوة في مسار المقاومة ضد إسرائيل؛ حيث ترفع السعودية شعار السلام وحل الدولتين في وقت أُعلِن عن وفاة هذا الحل؛ فالداخل الإسرائيلي في معظمه مؤيد للحكومة اليمينية الراهنة.
وبالمثل تظل أيقونة المقاومة غزة تفتقد دورًا مساندًا سعوديًا مصريًا فاعلا وليس مراقبًا أو منتظرًا لأضواء خضراء من واشنطن. ولكن يظل للدورين السعودي والمصري، وتنسيق كبير مع التركي، بعد انفراجة العلاقات بين تركيا-أردوغان وبين مركزي القوة السعودي والمصري، يظل لهما تأثيرهما على مسار ما بعد وقف النار… أين هما من إعادة إعمار غزة ومن المنع الفاعل للتهجير القسري؟ وفي المقابل فإن الدور الاقتصادي الإماراتي السعودي ضروري أيضًا للاقتصاد السوري المتهالك والاقتصاد اللبناني الأكثر تهالكًا، ولقد وضح تأثيرهما على توجيه المسارين السوري واللبناني تجاه أمريكا وإسرائيل.
إلا أن للعملة وجها آخر… حول هذا الثقل في الدور الاقتصادي الخليجي، وما سيكون له من تأثير سياسي على أهداف سياسية أخرى للنماذج الثلاثة: طبيعة النظام السوري الجديد وتوجهاته الخارجية وخاصة تجاه إسرائيل، طبيعة الإصلاح السياسي ونمط توازنات القوى الجديد الداخلي في لبنان بعد ما أصاب حزب الله والدور الإيراني من تراجع والأثر على التوجه نحو إسرائيل، وأخيرًا: مآل استمرار المقاومة في غزة والضفة، ومآل المرحلة الثانية والثالثة من خطة شرم الشيخ وما يواجههما من ألاعيب وخروقات وتهديدات اليمين الإسرائيلي وترامب: هل سينجح فعلا نتيناهو -كما ادعى وزعم- في إعادة تشكيل المنطقة بقوة السلاح الإسرائيلي ووفقا لسلام إسرائيلي؟!
- قد يقدم البعض ردًا بالإيجاب على هذه الأسئلة، إلا أن البعض الآخر يرى العكس ويستدعي دور الجواريْن التركي والإيراني ويحذر من تداعيات هذا الدور الإسرائيلي المهيمن للاعتبارات التالية:
إن هذا الدور يسعى إلى احتواء النظام السوري الجديد ولبنان ما بعد وقف النار، تدجينا للأول وإضعافًا لدور حزب الله السياسي والعسكري كحركة مقاومة إسلامية؛ ومن ثم دفع لبنان، وكذلك سوريا نحو تفاوض من أجل اتفاق سلام مع إسرائيل.
- ومن ناحية أخرى، فإن انتهاء محور الممانعة بسقوط نظام الأسد -وبتراجع النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان وبفقدان حزب الله ومقاومة غزة مصدر المساندة العسكرية من إيران، وفي وقت يتصاعد تيار التطبيع العربي- هذا الانتهاء من شأنه أن يؤدي بمحور الاعتدال إلى التراجع بدوره، بل ربما إلى زواله بحيث تبقى الساحة حكرًا على حلفاء إسرائيل العرب في عملية السلام والتطبيع (كما ظهر في مؤتمر شرم الشيخ وما بعده)، إلى جانب دور تركي يسعى للحفاظ على مصالحه ودعم وجوده في جواره الشامي وفي شرق وجنوب المتوسط، ولكن في إطار من الموازنات مع الولايات المتحدة وحليفها إسرائيل.
بين هاتين الرؤيتين، ما زالت المقاومة -من قلب فلسطين؛ من الضفة وغزة وفلسطين 48- تقدم بديلا ثالثًا، يجعل منها محفزًا للتغير والتحول في أوطان الشام الكبير العربية الإسلامية، وفي الجوار الحضاري الإيراني-التركي بل وفي العالم؛ بحيث نرى الآتي:
- تداخلت أوراق مشروعي هذين الجاريْن بدرجة أكبر وعلى نحو اشتدت فيه تنافسيتهما، بل وأحيانًا تضاربهما؛ حيث تداخلت وتشابكت أجنحة الشام الكبير (السوري واللبناني والفلسطيني والأردني والعراقي) على نحو يزيد من تعقيد حسابات المشروعين في مواجهة بعضهما البعض، وفي مواجهة إسرائيل.
- وبعد أن دعمت إيران -تدريجيًا عبر ثلاثة عقود- محور المقاومة، أضحى المشروع الإيراني حاضرًا في “الشام الكبير”، وبقوة. وزاد هذا الحضور وضوحًا منذ طوفان الأقصى؛ بعد أن فتح حزب الله الجبهة اللبنانية -الإسرائيلية نصرة وإسنادًا لغزة، ثم تلاه الحوثيون في اليمن، كما ألقت إيران بثقلها -ولأول مرة وعلى نحو مباشر- في مواجهتين عسكريتين مباشرتين مع إسرائيل (2024- 2025)؛ أولاهما محدودة، والأخرى أكثر اتساعًا، ثم في حرب الاثني عشر يوما المفتوحة مع إسرائيل عقب شن الأخيرة عدوانًا عسكريًا مفتوحًا على مواقع عسكرية ونووية إيرانية.
- وبذا، تغيرت طبيعة التوازنات الإقليمية مع هذا التدخل الإيراني المباشر ضد إسرائيل، ومع استمرار استعداء إسرائيل وأمريكا لدول المنطقة على إيران؛ باعتبارها العدو الرئيس لهم والمهدد لأمنهم. لكن ظل لإيران حسابات أخرى تحكم طبيعة ودرجة تدخلها؛ سواء إلى جانب حزب الله أو حماس أو الحوثيين؛ وذلك لقبول تدخل ترامب لوقف الحرب مع إسرائيل في يونيو 2025؛ في الوقت نفسه الذي استمر فيه الضغط الإسرائيلي الأمريكي على كل من حزب الله وحماس لنزع سلاحهما ووقف أو تصفية المقاومة ضد إسرائيل.
- وبذا، فإنه بقدر ما قيَّد الدور الإيراني خلال حرب الاثني عشر يوما (يونيو 2025) من مقولة انفراد إسرائيل بالهيمنة الإقليمية على المنطقة، بقدر ما تزايدت التكهنات عن توقيت ومآل الجولة التالية من المواجهة الإيرانية-الإسرائيلية العسكرية في المنطقة، وما إذا كانت تتراجع فرص اندلاعها أمام محاولات أوروبا إعادة المواجهة إلى المسار التفاوضي حول المشروع النووي من ناحية، وأمام الانكفاء الإيراني على الداخل في محاولة إصلاح ما كشفت عنه الجولات العسكرية مع إسرائيل.
بعبارة أخرى، وبالرغم من الضربة التي وُجهت إلى النفوذ الإيراني في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، واستمرار الاعتداءات العسكرية على حزب الله في لبنان، وعلى الحوثيين، فإن الورقة الإيرانية ما زالت حاضرة ولكن بطريقة مختلفة في مسار تشكيل توازنات “الشام الكبير” وجواره العراقي والخليجي.
- في المقابل، كان للدور التركي مدخلٌ وتأثير مغاير في مواجهة إسرائيل ودول الشام الكبير؛ ففي ظل العلاقات الدبلوماسية القديمة مع إسرائيل، وفي إطار العلاقات الاقتصادية والعسكرية المفتوحة والمتنوعة معها من ناحية، وانفتاح الدور التركي -بقيادة حزب العدالة والتنمية- على محوري المعارضة السياسية الإسلامية، والمقاومة الفلسطينية المسلحة في المنطقة من ناحية أخرى، بدا أن الخطاب السياسي القوي لرئاسة تركيا ضد العدوان الإسرائيلي هو السلاح الأساسي لقيادة تركيا في مواجهة إسرائيل، ولم تستخدم -مثلها مثل الدول العربية- أوراق الضغط الاقتصادي التي في يدها ضد إسرائيل إلا مؤخرا في أغسطس 2025.
- إلا أن المواجهة الإسرائيلية التركية الحادة والمباشرة اندلعت على الساحة السورية، بعد الدور التركي في إسقاط نظام بشار الأسد، من خلال مساندة فصائل المقاومة المسلحة السورية؛ وهو الأمر الذي مثل متغيرًا آخر للتأثير في تشكيل التوازنات الإقليمية في مواجهة إسرائيل.
- صعود الحركات الإسلامية المعارضة والمقاومة في الحالات الثلاث والتهديد بتصفيتها أو احتوائها:
جاء هذا الصعود وعلى نحو جديد وبصفة خاصة منذ الثورات العربية، ولم تكن هذه الموجة استثناء، فقد سبقتها موجات أخرى معاصرة، منذ الثورة الإيرانية والصحوة الإسلامية داخل الأوطان العربية أواخر السبعينيات القرن العشرين، ثم مع نهاية الحرب الباردة؛ أضحى الإسلام والمسلمون في قلب تحولات النظام العالمي بقيادة أمريكية.
وبقدر ما أحاط هذه الموجات السابقة من إلصاق صفات الإرهاب والتطرف بها في إطار ما سمي الحرب العالمية على الإرهاب، بقدر ما ظل هذا السلاح السياسي والفكري موجهًا أيضًا للثورات العربية بكل نماذجها في: مصر، وتونس، وسوريا، وليبيا، واليمن؛ وذلك لاحتوائها أو إجهاضها؛ وسواء ظلت سلمية أو تحولت إلى القوة العسكرية. فلقد كان سلاح النظم القديمة ضد هذه الثورات بقيادة قوى وحركات إسلامية متنوعة، هو الاتهام بالإرهاب؛ وذلك لتبرير استخدام العنف السياسي والمسلح ضد هذه القوى التي أُلقيَ عليها مسئولية إجهاض هذه الثورات وتداعياته السلبية. ولقد ساندت إسرائيل -بطريقة أو بأخرى- النظم والثورات المضادة، وذلك بالتحالف -ولو الضمني- مع بعض القوى الإقليمية (السعودية والإمارات) ضد هذه الثورات التي صعدت معها القوى الإسلامية المحظورة من قبل إلى الساحة السياسية في مصر وتونس وليبيا. أما في سوريا فلقد حصلت فصائل الثورة المسلحة ضد نظام بشار على دعم سعودي مباشر في البداية، واستمرت قرابة الأربعة عشر عامًا حتى أسقطت النظام حليف إيران وحزب الله.
وإذا كانت تركيا قد أخذت جانب هذه الثورات بطريقة أو بأخرى في مصر وليبيا وتونس، فإن دورها تجاه الثورة السورية المسلحة تجاوز حدود المساندة السياسية. ومن ناحية أخرى، فإن إيران تجاوزت بعض هذه الثورات كما في سوريا واليمن، إما بالتحالف مع النظام في مواجهة الثورة كما في حالة سوريا، أو بإسناد فصيل سياسي مذهبي (الحوثيين) ضد الثورة وضد النظام السابق في آن واحد كما حدث في اليمن. وفي نفس الوقت كانت قوى المقاومة العسكرية الإسلامية ضد إسرائيل تنمو وتتدعم في كل من لبنان وفلسطين. وفي حين تقف إيران الآن تراقب الوضع في سوريا، فإن تركيا تسند حليفها الثوري السابق الذي انتقل من الجهادية الإسلامية إلى الحكم المدني الانتقالي.
وهكذا تشهد ساحة الشام الكبير ثلاثة نماذج من القوى والحركات الإسلامية المسلحة: فصائل المعارضة في سوريا التي وصلت للحكم، حماس والجهاد في غزة والضفة التي مازالت تقاوم عسكريًّا، حزب الله في لبنان الذي يصارع محاولات نزع سلاحه.
(4)
انطلاقًا من هذه الملامح المشتركة المعاصرة، وانطلاقًا من دلالات الذاكرة التاريخية، نصل إلى إجمال المشهد الراهن للمنظومة الشامية الثلاثية كإطار ناظم لسوريا الجديدة في قلب الشام الكبير، وكمنطلق للتدبر في إشكاليات مآلها بعد عام من نجاح ثورتها، وإعادة تخيل وضع حضاري مأمول لهذه الدولة العربية العتيدة:
- تقدم الحالات الثلاث المنجدلة ببعضها (السورية واللبنانية والفلسطينية) نماذج حية من نماذج الأوطان ذات “التعددية” التي تزخر بها أمتنا؛ أي تعددية مكونات المجتمعات دينيًا ومذهبيًا وقوميًا؛ وهي مكونات في حالة راهنة من الاقتتال أو الاختلاف الداخلي الحاد. هذه التعددية ليست -في حد ذاتها- سببًا أصيلًا وحيدًا في هذه الصراعات. فالذاكرة التاريخية تبين أن هذه الحالة الصراعية لم تكن سائدة إلا حين توافرت لها السياقات المغذية داخليًا وخارجيًا؛ بحيث تحولت من التعددية الرشيدة التي تمثل إضافة في الأوطان إلى آفة تفتُّ في عضد الأمة بسبب الاستبداد الداخلي والتدخلات الخارجية في توظيفها.
- الصراع مع إسرائيل، مازال في قلب هذه المنظومة، يؤثر في علاقات كل نموذج بالآخر وفي التفاعلات النظمية الإقليمية حول الشام. ويفصح حال سوريا، منذ سقوط بشار، عن هذا بوضوح؛ فلقد ساعد هذا السقوط على مزيد من التقييد لحزب الله وحماس مثلًا، وعلى إعادة تشكيل تحالفات وتوازنات إقليمية عربية عربية.
- تتقاطع عند كل الحالات الثلاث المنجدلة -وحولها- التفاعلات العربية العربية، ومع الجوار الحضاري الإيراني والتركي. فلقد مارست التدخلات العربية والأجنبية أدوارها في التأثير على حالة هذه المنظومة الثلاثية ولكن على نحو يبدو متناقضًا.
- لا تحقق القوى العربية أو الإقليمية تأثيرها ونفوذها في الشام الكبير إلا من خلال التدخل في النماذج الثلاثة معًا؛ فمن ناحية تضرب سياسات هذه القوى أحد هذه النماذج بالآخر ابتداء من الداخل أولًا، أو تتحالف من ناحية أخرى مع أحدها ضد الآخر.
- بعد أن توالت الأيديولوجيات الليبرالية واليسارية والقومية والبعثية على النظم وحركات المقاومة في الحالات الثلاث، عبر قرن، تشهد كل منها منذ عقدين من صعود المكون الإسلامي في هذه النظم أو الحركات السياسية مما ولَّد أنماطًا جديدة من التفاعلات الداخلية والبينية والتدخلات الخارجية تمحورت جميعها -بدرجة أو بأخرى- في مواجهة هذا المكون الإسلامي: شيعيًا كان أو سلفيًا جهاديًّا أو إخوانيًّا أو غير ذلك.
خلاصة القول: كانت الشام وجوارها الحضاري (فارس والأناضول) -تاريخيًّا- محطًا لأهم التهديدات الغربية الكبرى للأمة: البيزنطيين ثم الصليبيين ثم التتار، ومن الشام ومن حولها تم استيعاب هذا الوجود الدخيل ثم تصفيته، ولم يتم ذلك فجأة أو بسرعة ولكن عبر عمليات تدافع وتداول فيما بين من حكم المنطقة ابتداء من العرب المسلمين وبينهم وبين هذه القوى الغازية التي لم تستهدف الأرض والثروات فقط، ولكن أيضًا الدين والأعراف والتقاليد؛ أي استهدفت الناس والأهل. وكان الجوار الحضاري التركي تاريخيًّا في قلب هذه التفاعلات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في فترة تأسيس ونمو كيان تركي ممتد أظلته بعد فترة المظلة العثمانية. ولم تكن مصر بعيدة عن هذا القلب الشامي تاريخيًا، وإن اتسعت أحيانًا أو ضاقت المسافات السياسية بينهما. وكان قرن الاستعمار وما بعده (نصف القرن الأخير) مبعث تهديدات عدة أثرت على تشكيل المنطقة الديموجرافي والسياسي.
وتشهد المرحلة الراهنة من تاريخ الشام الكبير مقاومة حضارية ثلاثية المراكز، متعددة الأبعاد، قد تبدو في نظر البعض متناقضة داخليًا، تتنازعها القوى الإقليمية العربية أو قوى الجوار الحضاري، سواء لإخضاعها أو احتوائها… إلا أنها جميعها تشير إلى دخول الوجود الاستيطاني الصهيوني في فلسطين مرحلة تحدٍّ خطير لم يُشهد مثلها من قبل، وتحدٍّ يطل برأسه ليفتح عدة جبهات في الشام وجوارها البعيد (اليمن) في آن واحد، على نحو لم يشهد مثله من قبل هذا الكيان منذ قرن ويزيد. وكل هذا يمثل سياقًا ضاغطًا على النظام السوري الجديد، وما عليه إلا أن يصبح جزءًا منه أو رافدًا من مقاومته.
إن مرور عام على النظام السوري الجديد، بكل ما يواجهه من تحديات وتهديدات، يشير إلى اختياره التوجه الأول، ولكن التدافع ما زال قائمًا لم يتم حسمه بعد. فإلى أين سيصل هذا التدافع على أرض الشام وانطلاقًا منه؟ هل سنشهد انتصارًا من قلبه يصفي وجود كيان استيطاني صهيوني دخيل مزروع في قلب الأمة مثلما استوعب الشام وصفى من قبل الرومان والصليبيين والتتار والاستعمار الأوروبي؟
إن مصير “القدس-فلسطين في قلب الشام الكبير وفي قلبه الشام الصغير (دمشق)” تحدد مرارًا وتكرارًا بأنماط التدافع والتداول من جهة العرب والمسلمين: قوة وفتحًا ووحدة، أو ضعفًا وتراجعًا وتجزئة، وبحسب العلاقات بين أركان الأمة ذاتها وأدوارها وسياساتها تجاه هذا القلب النابض، وذلك في مواجهة القوى الخارجية التدخلية الساعية دائمًا للسيطرة على هذا القلب. وتقول عبرة التاريخ إن تلك القوى الخارجية لم تتمكن من هذا القلب وتسيطر عليه، لقوة في ذاتها أو وحدة في صفوفها، ولكن -ابتداءً وأساسًا- بسبب ضعف هذا الجزء من الأمة وتشتته، وضعف تضامن فضائه ووعائه الحضاري معه.
لذا، فالسُّنة تقول: إنه بقدر ما تستعيد هذه الأمة قوتها ووحدتها وتجدد سنة الجهاد ضد أعدائها المعتدين عليها والطامعين فيها، بقدر ما ينقلب المسار على المعتدي والمحتل. هذه هي القاعدة السُّننية، وهذا هو النمط التاريخي الذي تكشف عنه رؤية حضارية شاملة لتاريخ العلاقة بين الأمة الإسلامية والأمم الأخرى، وتتجلى على أرض الشام الكبير كثيرًا. ويتبين هذا النمط ويتجلى بشدة في هذه البقعة منذ نهاية القرن التاسع عشر، وعبر قرن وربع قرن من التحدي والتهديد الغربي والصهيوني لم تكف الأمة عن الاستجابة لذلك التحدي: مقاومة وصمودًا.
والحمد الله
القاهرة 25/12/2025
[1] لقد تكاملت إدارتا بايدن المنصرفة وترامب الجديدة في هذا الإسناد لإسرائيل لفرض هيمنة إسرائيلية بالقوة عقابًا لطوفان الأقصى في 7 أكتوبر، ومن أجل التهجير القسري لأهل غزة، ومن أجل تصفية حزب الله، ومن أجل احتواء وتقييد النظام السوري الجديد وتشكيل مساره الجديد من “السلام” (التطبيع وفق شروط إسرائيلية).