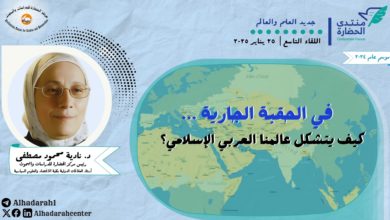حوار المعارف والثقافات وبناء العلوم الاجتماعية: من الخبرة الحضارية إلى تجاوز الأزمة المعاصرة

تقديم.. د. نادية مصطفى:
يأتي هذا اللقاء الثامن من لقاءات منتدى الحضارة في ختام عام 2024، الذي لم يكن مليئًا كله بالأخبار الجيدة، بل على العكس كان عامًا مليئًا بالتحدي والعدوان والمقاومة والصمود.. وهي التي جعلتنا نتساءل: أين موضع أمتنا من العالم في ظل هذه الأسلحة الموجهة إلى أمتنا؟ كما لو أنه ليس هناك في العالم إلا الرصاص والمدافع والقنابل في يدي من يقولون إنهم الأقوى، ويدعون أنهم الأصلح لأنهم الأقوى.. ولكن تقدِّم أمتُنا دائمًا -ومنذ فجر الرسالة- معانٍ ودروسًا أخرى عن أدوات القوة ومعانيها، والأهم قنوات وسبل التفاعل بين الأمم، حتى لو كان بالسلاح، فللسلاح قيم تديره وتحكمه وتضبطه.
ولقاء اليوم وموضوعه وصاحبه ومناسبته يقدِّم دلالات مهمَّة حول هذه المعاني التي بدأتُ بها. وفي هذا اللقاء نلتقي حول كتاب صدر، ومحاضرة ومحاورة مع صاحبه. وقد قُدِّرَ هذا الكتاب من محفل دولي جعله يحمل المعاني التي أقول عنها: الحوارية المعرفية والثقافية، والحوارية بين الحضارات المتقابلة، في ظل التراث الحضاري المُقارن، وصولًا إلى مفاصل الأزمات الحضارية ونقاط التحول الحضاري من دائرة أخرى، وهذا هو الوجه المقابل من صراعية الأسلحة في ظل منظومة القوة الطاغية.
وهذا الكتاب يضعنا أمام مرآة ننظر فيها إلى أنفسنا، وأمام نافذة ننظر من خلالها إلى العالم نبحث عن شيء آخر له جدوى وقيمة بنائية وإنسانية تضيف إلى الأمم والتفاعلات فيما بينها، ومن منطق القوة أيضًا وليس من منطق الاستضعاف. وهو يقدم لنا بداية من عنوانه: “حوار المعارف والثقافات وبناء العلوم الاجتماعية: من الخبرة الحضارية إلى تجاوز الأزمة المعاصرة”، وفهرسه، ذلك الوجه الآخر لعملة العالم الإنساني المتهاوي الذي نعيشه منذ أكثر من نصف قرن.
وهذا الكتاب ألَّفَه د. مدحت ماهر، وهو ركن من أركان الجيل الثالث في مدرسة المنظور الحضاري، صُبَّت فيه روافد المنظور، واستوعبَ بعمق وجدِّية وإخلاص رسائل أساتذتنا وروَّادنا وعلمائنا -الذين بدأوا هذه المسيرة على الأقل منذ نصف قرن- الذين فتحوا لنا الطريق والباب حول منظور حضاري للعلوم الاجتماعية الحديثة. وهذا الجيل الثالث الذي استوعب كل هذا التراكم؛ لأن المدارس لا تُبنى إلا بالتراكم والاستيعاب والهضم والتفاعل؛ وهذا ما يقوله كتاب د. مدحت، الذي وقف على ثغر، كما وقف الجيلان السابقان على ثغر آخر. فهذا الجيل الثالث قدَّم طبعة خاصة وجديدة لما أسمِّيه العلاقة بين العلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية الحديثة دون انقطاع عن التراث والأصول من قبل هذا، ودون الانغلاق على الذات دون معرفة لما يجري على مستوى العالم من تطورات في العلوم.
وأعتقد أن هذا الكتاب قدَّم على المستوى المنهجي والمعرفي مخرجات مهمَّة أعتقد أنها ضرورية وتأسيسية لجيل رابع يلتفُّ حول مركز الحضارة الآن ويسأل دائمًا -لأنه مهموم بنفس همِّنا، ويبحث فيما نبحث عنه- من أين نقرأ؟ ومن أين نبدأ؟ وكيف نسعى؟ فهذا الكتاب يُقَدِّمُ وجبةً منوَّعةً من جميع الأبعاد التي يمكن أن تُساهم في تأسيس مبتدأ، أو تُدعم من تأسيس مهتم في هذا المجال المتعلِّق بالعلاقة بين المعارف والعلوم الإسلامية ونظائرها الغربية، ولكن بمسار حضاري تاريخي ممتد، وليس الآن فقط.
وأخيرًا أقول للدكتور مدحت: المدرسة كلها تشكرك وتهنِّئك على هذا الإنجاز ابتداءً من أستاذتنا منى أبو الفضل، وأستاذنا حامد ربيع، وأستاذنا الدكتور طه العلواني، وأستاذنا الدكتور عبد الحميد أبو سليمان، والمستشار طارق البشري، والدكتور عبد الوهاب المسيري، ود. محمد عمارة، ود. جمال عطية، وأنا أتخيل أنهم يقولون هذا.
مداخلة د. مدحت ماهر حول الكتاب:
قصة الكتاب
قصة هذا الكتاب بدأت من الجيل الرابع (من الشباب)، حين أشار بعضهم إلى مسابقة في هذا الموضوع، حول تكامل وحوار المعارف والثقافات، وكانت الدكتورة نادية أول من حدَّثتها، وكانت أول من اقترحتُ عليها هذا الموضوع، وكتبتُ الفكرة في يومها، وقُبلت من هيئة المسابقة، وكانت المدة المتاحة لإعداد الكتاب من مايو 2023 حتى مارس 2024؛ وهي مدة كافية، ولكن داهمنا الطوفان.
ولأن الطلعات الأولى دائمًا ما تكون صعبة فمكثت في المبحث الأول حوالي شهر ثمَّ توقَّفت بسبب الطوفان؛ حيث كان رد الفعل الطبيعي، أني نسيت هذه الدراسة، وانمحت من ذهني في مقابل الاهتمام بالطوفان.. حتى أفقت متأخرًا جدًّا في يناير 2024، فأرسلتُ إليهم أسأل على مد فترة التسليم، فأجابوا بأنه يتعين الالتزام بالتسليم في الموعد المُحدد. فمنحتني أستاذتنا د. نادية مصطفى أجازة؛ للعمل على الكتاب حتى أنهيته قبل الموعد المطلوب بـ13 دقيقة. وعندما أقرأه الآن؛ أسأل: من الذي كتب هذا الكتاب؟ وكيف؟ فلله الحمد والشكر..
وهذا الكتاب من ثمرات العمل في هذه المدرسة.. حيث آمنَّا بأن العلمَ رَحِمٌ إنسانيٌّ كبيرٌ بين أهل العلم، أو كل من يريد أن يتأهَّل له، وآمنَّا بذاتنا كأمة لها تاريخ وحاضر ولها مستقبل بإذن الله.. وبناءً عليه فلدينا دافع لأن يكون لدينا إسهام ووجود في عالم المعرفة بدءًا من مستوى المنظور وحتى المفاهيم والمداخل المنهاجية.. والجديد هو مدرستنا بالنسبة للواقع الذي لم يعطِها حقَّها…
وهذا الكتاب نَتَجَ تحت القصف، ومن رحم المقاومة الحضارية، التي لا تقتصر على المقاومة السياسية، ولكن المقاومة المعرفية، وهذا المعنى الذي أرشدنا إليه الواقع العملي..
فرضية الكتاب وأسئلته وبنيته
كان هناك فرضية عندي ميل إليها، وليس عندي تأكُّد منها، وهذا جزء من الحالة البحثية، وهي: أن الحوار واحد من أدوات أو آليات تطوير المعارف: تأسيسًا وإنماءً وتشغيلًا، وتأصيلًا وتفعيلًا؛ فانطرح لدي السؤال: هل حدث ذلك في حضارتنا “الإسلامية”؟ وهل نمت العلوم في ظل الحضارة الغربية بهذه الطريقة؟ وإن كان كذلك.. فما أشكاله؟ وأنواعه؟ وما سياقاته؟
وهذه الفكرة تتَّسق مع رؤية مدرستنا التي نبَّهتنا إلى دور الأبعاد الثقافية والدينية والحضارية في العلوم، وأن للمعارف أفكار، وللأمم الكبرى قيم، وأصبحت هناك طريقة لقراءة العلوم والقضايا والموضوعات المختلفة من هذا المنظار..
ومن هنا تجسَّدت الفرضية الأساسية لهذه الدراسة في: “أن بناء العلوم وتجديدها رهن عوامل، من أهمِّها جريان الحوار فيما بين أهل العلوم، وفيما بينهم وبين أهل الأعمال، وفيما بين الجميع وبين مجريات الحياة التي يعيشونها”.
ومن ثمَّ، تمحور الكتاب حول التساؤلات الآتية:
1- كيف مضت العلاقة بين فكرة الحوارية وبين بناء وتطور العلوم في الحضارة الإسلامية في نصفها الأول بين القرنين الأول والسابع تقريبًا؟
2- كيف مضت العلاقة بين فكرة الحوارية وبين بناء وتطور العلوم في الحضارة الغربية في القرون الثلاثة الأخيرة؟
3- ما أهم سمات التجربتين التي خلصت بهما الدراسة؟
4- كيف شهد القرنان التاسع عشر والعشرون الأخيران الْتقاء التجربتين حال نضوج الأخيرة منهما ثم تأزُّمها، وحال تراجع الأولى ثم محاولات نهوضها؟
وكانت المنهجية المتَّبعة هي: مدخل التتبُّع التاريخي المعرفي عبر الحضاري (في البابين الأول والثاني)، ثم المقارنة المعرفية الحضارية من خلال الحوار بين الحضارتين (وفي الباب الثالث)… وامتدَّ النطاق الزمني للدراسة لأكثر من سبعة قرون من أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن خلدون بالنسبة للحضارة الإسلامية، ثمَّ تاريخ العلوم والحضارة الحديثة في الغرب في القرون الثلاثة الأخيرة..
وهذا الكتاب مكوَّن من ثلاثة أبواب تتضمَّن تسعة فصول و22 مبحثًا؛ كل باب من ثلاثة فصول، وكل من فصول البابين الأول والثاني ثلاثة مباحث، وكل من الفصلين الأولين من الباب الثالث مبحثان. وتحمل العناوين التالية:
الباب الأول- حوارية المعارف الإسلامية والاستيعاب الثقافي.
الباب الثاني- حوارية المعارف الحديثة في الغرب والتفوق الحضاري.
الباب الثالث- نحو تجدد حضاري في المعارف الإنسانية والثقافات.
والفصل الثالث من الباب الثالث هو الختامي: من عصارة الخبرة والعبرة إلى حوارية معرفية جامعة.
مضامين الكتاب وخلاصاته
خلاصة حوار المعارف في ظل الحضارة الإسلامية
اتَّسعت شجرة العلوم والمعارف في الحضارة الإسلامية لتضمَّ العلوم الدينية فالعلوم العقلية والطبيعية، ومن بينها برزتْ صياغاتٌ للمعارف الإنسانية والاجتماعية؛ في النفس والسلوك والسياسة والتربية والأخلاق والحروب والتجارة والصنائع والاجتماع الإنساني والعمران البشري.
وكان الحوار بأشكاله ومستوياته المختلفة -داخل الأمة وعبر حدودها الجغرافية والثقافية والحضارية- جاريًا غير منقطع، داخل كل حقل معرفي: بين علمائه، وبينهم وبين تلاميذهم، والحكام أحيانًا، والعامة، وقضايا الواقع، وداخل كل صنف أو مجموع معرفي، وبين بعض المجاميع. وتميَّزت حوارات العقيدة، وحوارات الفقه، وحوارات المنهج -خاصة مع الفلسفة والمنطق- بميزات القوة والحرارة والاستيعاب والصدام، واتصل بعضها بالسياسي والثقافي العام بقوة.
من أبرز أمثلة هذه الحوارات:
1- حواريات تأسيس المعارف: أرسى القرآن الكريم حوارية لتأسيس المعارف، قادها في أوائلها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فمن يبحث في سيرة وحياة النبي يجد حالة حوارية غزيرة، وسار على هديه الصحابة والصدر الأول؛ ومنه انبثقت أصول العلوم النقلية والتأويلية والاستنباطية وخاصة الفقهية واللغوية والأدبية والتوثيقية والتأريخية والتطبيقية في الإفتاء والقضاء والسياسة وما شابه.
وفي الدراسة أمثلة، منها: حوارية العلوم الأصلية وفيها يقول الخليل بن أحمد (100-175ه)، ولا يجد لذة في حياته إلا أن يحاور، ويؤثر عنه: “وما بقيت من اللذات إلا محاورة الرجال ذوي العقول.. وقد كانوا إذا عُدُّوا قليلًا فقد صاروا أقلَّ من القليل”.
2- حوارات بين الأقران: وفيها مثال حوارات الشافعي وأحمد، وهما في هذا الوقت رأسان في الفقه، وبينهما اختلافات في الفهم والتأويل، فهي حوارات أنشأت المدارس بدءًا من صورة المدرسة من العهد النبوي، مرورًا إلى حوارات أبي حنيفة وتلاميذه، وتطور المدارس الفقهية بعد ذلك.. كما ظهر أيضًا مفهوم الفريق البحثي (ومنهم أولاد موسى بن شاكر وأبو بكر الرازي، وظهور الاختراعات العلمية في عصورهم بمنجزات وأشكال مختلفة).
3- حوارات الترجمة والحوار مع معارف الآخرين: استقبل المسلمون العلوم الطبيعية والرياضية استقبالًا استيعابيًّا مع التحذير من حواشي كتاباتها العقيدية الفلسفية كالفلك أو الطبيعة، وبعض اللاأخلاقية كالسيمياء. ولم يوثق موقف لتحريم الحساب أو الرياضيات أو الطب أو الصيدلة أو تعلُّم اللغات.. إلخ. لكن شجرتها ستتَّسع مع الزمن… ومن أمثلتها: حوارية الانفتاح على الثقافات، وحركة الترجمة والنقل الكبرى بنقل كل ما كتبه الآخرون إلى العربية.
ولكن بعد هذه الحالة الكبيرة من الحوارات، اتَّضح أن معارف الآخرين أحدثت بعض الإشكاليات في لقائها مع معارفنا، إذ كان الحوار غير متكامل في بيان المفيد وغير المفيد أثناء الحوار المعرفي مع الآخرين، فوقف الغزالي يكتب “مقاصد الفلاسفة”، ثم كتب في حوارية التهافت “تهافت الفلاسفة” وكتب ابن رشد “تهافت التهافت”.. وحوار الغزالي مع مقاصد ثم مفاسد الفلاسفة، ثم مع نفسه لتقييم كل ما حوله من مصادر ووسائل وثمار المعرفة، بما فيها المستوردة، وصولًا إلى ابن رشد الذي رفض الغلو في النقد وما قد يحدثه من نقض؛ كل هذا بَيَّنَ بوضوح هذا النمط من الحوارات.
4- حوارية التصنيف: والتي ستظهر فيها لبنات العلوم الاجتماعية في الحضارة الإسلامية: الكتابة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية؛ فكتب أحمد بن علي بن يوسف “مفاتيح العلوم” في منتصف القرن الرابع الهجري لتصنيف هذه العلوم عبر نوع من الحوارية فيما بينها.
5- حوارية العلوم في شخص عالم أو طالب معرفة: البيروني نموذجًا؛ الذي كان يتناول الموضوعات والأمور بطريقة موسوعية تجمع بين العلوم الإسلامية المختلفة والطبيعية.
6- حوارية تأسيس أصول الفقه.. علم الأمة
منذ القرن الثالث الهجري تكاملت شجرة العلوم الإسلامية، خاصة الدينية، ثم أصول الاجتماعية والطبيعية والرياضية، وبين الرابع والسادس.. صار المسلمون أمراء أو أولياء المعرفة في العالم.
ومن هذا المنطلق، ولأن هناك علمًا لكلِّ أمة، هذا العلم نحن موصولون به في مستوى المنهج، كان رهان الدراسة أن علم أصول الفقه سيكون ذلك الواصل بين علوم الحضارة الإسلامية على المستوى المنهجي. وعندما قرأت مقدمة كتاب “المناظر”، وبعض القراءات للبيروني والخوارزمي أجد المقدِّمات فيها نفس الموجود في أصول الفقه، تأكَّد لديَّ هذا المعنى. كما اتَّضح أن الشافعي كان منهجه في “الرسالة” حواريًّا، وكان دافعه أن يُقَدِّمَ كتابًا يجمع فيه الفقهاء على قول، فكتب الرسالة كلها بطريقة سؤال وجواب (يقول، فأقول)؛ لكن الأكثر أنه وضع في وسط الرسالة فكرة “القياس”. والقياس باللفظ مستعملة في المعارف الاجتماعية والطبيعية في هذا الوقت. وعلماء المسلمون بتنوُّع تخصُّصاتهم مستعمِلون لكلمة القياس بشكل كبير جدًّا؛ فاتَّضح أنها آلية.
7- حوارية تخصُّص: ثمَّ مضت حوالي ثمانية قرون، أخذت المعارف الاجتماعية معها تخرج من رحم الكتابات الإسلامية والفقهية، فاتَّضح أن هناك معارف مُتخصصة في هذه العلوم.
8- خفوت الحوارية وتراجع المعارف: سيأتي ابن خلدون في القرن الثامن الهجري (القرن الرابع عشر الميلادي) ويعلن أن حالة العلوم في العالم الإسلامي أصابها الإرهاق، وأنه ليس هناك نوع من الحوارات الصحية، ويدعو لمنهج تجديدي لم يجد له آذانًا واعية كافية وقتها. فسار ذلك وسرى عبر نحو ثمانية أو تسعة قرون من تاريخ الحضارة الإسلامية، على وتائر مختلفة، حتى زحفَ دبيبُ الوهن والذبول في أوصال الحضارة وعلومها وحواراتها الداخلية والبينية والعابرة للحدود الثقافية؛ لتتراجع تدريجيًّا مكانتها من الصدارة إلى مواقع متأخِّرة.
حوار المعارف في ظل الحضارة الغربية.. خلاصات ودلالات
حين ذهبنا إلى أوروبا وجدنا لها تاريخًا طويلًا في المعارف، ولكن نحن نختصُّ بالقرون الأربعة الأخيرة، فأوروبا اليونانية كانت مشحونة بالحوارات، ولكن حينما دخلت إلى العصور الوسطى (عصور الظلام) انكتمت الحوارات. ولمَّا بدأت مفاهيم الإحياء والنهضة سنجد أن هناك صراعًا بين الحوارية والتسلُّط المعرفي والثقافي ثم السياسي..
ولما بدأت الحوارية تغلب (حتى وهي مأزومة في أولها) بدأت النهضة تتحرك معها، بدايةً من العلوم الطبيعية. ونتيجة لأن التسلُّط أخذ شكلًا دينيًّا؛ أصبحت المعارف ضد الدين، فكان ازدهار العلوم الطبيعية على حساب العلوم الدينية.
ومن ثمَّ، برزت حواريات مأزومة مرتبطة بأزمة الضمير الأوروبي بين نهايات القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر، ونظرية معرفة عبر حوارية صراعية؛ فكانت فكرة الأزمة حاضرة في أصول النظرية المعرفية الغربية؛ تبلورت في صورة ثنائيات كان مبدأها توقُّدَ الروح العلمية، والتَّوْقَ المتصاعد إلى المعرفة وسَبْرَ أغوار الكون والحياة والإنسان، والتعويل الكبير على “العلم” في بناء حضارة جديدة، وتخصيصه بمفهوم جديد ذي خصوصية.
تمثلت هذه الثنائيات منذ القرن الثامن عشر في:
– التراوح بين المنهج العقلي (الاستنباطي) ونسبة الإبداع المعرفي إليه، وبين تقديس المنهج التجريبي الاستقرائي، والميل الأغلب إليه.
– التأرجح بين تعظيم قيمة الإنسان والقيم الإنسانية خاصة الفردية، وبين تحييد القيم خاصة في البحث العلمي تجرُّدًا للحقيقة (المجردة).
– الجمع بين استفادات ضئيلة من الفلسفة القديمة والدين، وغلبة العلمانية المعرفية التي تراوحتْ بدَورها بين الحياد الديني (اللا أدرية) والإلحاد (إنكار العلَّة والغيب).
ولكن كل هذه الثنائيات كانت في حالة حوارية لا تنقطع منذ نهاية القرن السابع عشر إلى وقتنا؛ واستمرَّ الحوار بين الثنائيات: حوارية القديم – الجديد، الدين – العلم، التحكم – السعادة، المادي – الإنساني، وظلت مقولة الحديث هي الحاضر الأهم في حواراتهم، كما برزت في أفكار التقدُّم والثقافة والحضارة (الأنا الحاضر والمستقبل).
قادتْ كلُّ هذه الحوريات إلى وضع فلسفة للعلم تجسَّدت في مفهوم “الوضعية”، الذي جاء نتيجة تحولات ثقافية ومعرفية، وتحولات سياسية واقتصادية، وتحولات حضارية واستراتيجية، وارتبط باسم أوجست كونت.
ولم يقتصر تأثير “كونت” في (الوضعية) على أوروبا، وإنما سيرتبط اسمه مع أقرانه في تكوين مصر “الحديثة”، ممثلة في مجموعة “السان سيمونيين”، الذين كان من بينهم “ديليسبس”، وهذه المجموعة هم من كوَّنوا مدارس محمد علي الحديثة.
ثمَّ كان لكتب كونت تأثير كتأثير كتاب الرسالة؛ فقدَّم قانون تقدُّم المعرفة، وقرَّر أن يمحو الماضي ويمحو الآخر، ويصبح العلم هو دراسة الواقع والانطلاق منه.. ولم يستطع الغربيون التخلُّص من هذا القانون ربما حتى الآن، رغم مقولات ما بعد الوضعية. ووضع مُخَطَّطًا لتصنيف العلوم له دلالته، فوضع أوله الرياضيات والفيزياء والفسيولوجي وآخره تطورًا وانضباطًا العلوم الاجتماعية.
وخلاصة المقارنة هنا على مستوى الرؤية وتصنيف العلوم، أنه في الحضارة الإسلامية يأتي الدين ثمَّ العلوم الإسلامية فالعلوم الاجتماعية منبثقة عنها، فالعلوم الطبيعية مُستقبَلة من الدين باستيعابية وبعض المحاذير. أما في السياق الغربي فستكون العلوم الطبيعية هي الأساس.
وعلى هذا الأساس ظهرت حوارية تأسيس العلوم الاجتماعية في القرن التاسع عشر. فمثلًا أصبحت المادة والقيمة المادية والرقم محور علم الاقتصاد (تجسَّدت في أعمال جون ستيوارت ميل، وماركس، وريكاردو)، وأخذ علم الاجتماع والتربية والأخلاق (على يد هربرت سبنسر ثمَّ دوركايم) نفس الخط المنهجي في السير على العلوم الطبيعية ومنهج البيولوجي (التطوري)، والحوارات بين البيولوجي والسوسيولوجي.
وهنا تلزم المقارنة، فبينما كانت علومنا مندمجة ثمَّ تخصَّصت ثمَّ انزوتْ قبل أن تصل إلى التخصُّصات الحديثة، كان موقد الحضارة الأوروبية شديد الاشتعال، فانتقلت من الأفكار الفلسفية إلى بناء التخصُّصات، ومن التخصُّصات إلى التخصُّص الدقيق، وصولًا إلى “التفصُّص”.
وضربت الدراسة مثالًا بعلم السياسة، بدءًا من صانع التخصُّص الأكبر: ماكس فيبر، وكيف أنه بنى العلم عبر حوارات حياة، فهو أكثر ما يتكلَّم كان يحاضر. فكان ينشأ علم السياسة، وهو يتكلَّم في السياسة (فقد أسَّس بذلك سياسة العلم قبل علم السياسة). فأشار إلى أفكار تقسيم العمل، وحوارية المنهج والمضمون (الوضعية والسياسة)، إلى مقولات مثل السياسة مصالح واقعية لا واجبية، وأن السياسة سلطة. ومن تشرُّبه الشديد للمنهج، كان عنده المنهج يخلق الموضوع، فأكَّد أن السلطة (قلب السياسة) لا بدَّ أن تمرَّ بمراحل ثلاث، تؤدِّي إلى أن الحديث هو الأفضل، بدأت من السلطة التقليدية، ثمَّ السلطة الكاريزمية، ثمَّ السلطة العقلانية (المؤسَّسية). ومن يقرأ مقدمة كتابه “الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية” سيجد أنه لا يرى سوى الغرب وتقدُّمه (الغرب هو الإله)، وهذه واحدة من معاني حوار الثقافات عندهم، فكانوا يستعمرون العالم، ومن داخلهم كانوا يؤمنون أن العالم لا يستحقُّ إلا الاستعمار.
وانتقلت هذه المعاني في العلوم والواقع من أوروبا إلى أمريكا. فزادتْ من “وضعيَّة” العلوم، وبخاصة السياسة، فأنتجت السلوكية. ولكن على ما يبدو أن الحراك الأمريكي كان أشد من نظيره الأوروبي، فالسلوكية لم تكمل عقديْن حتى أعلنوا عن الأزمات: ما بعد السلوكية، وما بعد الوضعية، وما بعد الحداثة، وما أتبعها من حوارات تقويم من أواخر الستينيات حتى الآن.
المسلمون وحواريات المعارف والثقافات في القرن العشرين:
إذن، وصلنا إلى أن العلوم في القرن العشرين في أزمة كبيرة تمثَّلت في عنوان: “أزمة المعارف الاجتماعية الحديثة وحوار الثقافات في زمن العولمة”، وما نتج عنها في العلوم الاجتماعية عبر القرن العشرين من أطروحات وحوارات؛ فطُرحت الفينومينولوجيا على يد إدموند هوسرل، وكانت العودة إلى أسئلة الهوية والماهية، ومركزية الفيزياء، ونقد الوضعية المنطقية: كارل بوبر، واستمرار الحيرة، في ظلِّ أطروحات ما بعد الوضعية وثنائيات جديدة: الفرد والجماعة، الذات والموضوع، القيم والمصالح…
هذه الحوارات أدركناها -وكثير من علمائنا- مبكرًا، ومنهم حامد ربيع ومنى أبو الفضل، وهناك أساتذة عرب ومسلمون أدركوا مبكِّرًا إشكالية العلوم الاجتماعية بدءًا من الخمسينيات، وكتبوا عن إشكالياتها مع الإسلام. ففي نفس هذا التوقيت الذي أعربوا فيه عن الأزمة كانت مدرسة المنظور الحضاري تناقش نفس الأمور، ووصلت إلى موقف علمي ومعرفي وعقيدي، بأن الأصلح في حالة هذه الثنائيات هو التصالح وليس التصادم في إطار مفهوم المنظور الحضاري، بينما هم استمروا في حالة الأزمة، فتحولنا من عولمة الأزمة إلى أزمة العولمة وأمتنا في القلب.
والمخرج الآن -من المنظور الحضاري ومفكرين في الغرب- في حوار الثقافات والحضارات؛ ومن هنا بدأت تظهر مفاهيم وأفكار التداخلية والتقاطعية والبينية (طرح جو موران)، وتُسهم فيه بشكل قوي مدرسة المنظور الحضاري.
كيف استقبل المسلمون الغرب في القرن العشرين؟
نجد الإجابة عندهم أن علماء هذا القرن استقبلوا الغرب بنفس منطق المسلمين الأوائل عند التعامل مع العلوم والمعارف اليونانية، فاستقبلوه بالاستيعاب والتفاعل والحوار.
وفي رسالة الطهطاوي: “تخليص الإبريز في تلخيص باريز” كلام شديد الدقة في وصف حسنات العلم في الغرب ووصف سيئاته من منظور إسلامي كبير. ولذا فإن الطهطاوي يحتاج إلى تحليل معرفي لما كتبه عن العلم في نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر؛ كيف كتب هذه الجمل شديدة الدقة.. يصعب علينا أن نكتب في توصيف الغربي مثلما كتب الطهطاوي ونحن في الربع الأول من القرن الواحد العشرين. في أنه يرى عندهم ضلالات وهرطقات، ولكن لا يُرفضون، فلديهم علماء متميزون في كذا وكذا، وكان لدينا كذا وكذا ووصلنا إلى كذا وكذا.
وما بعد الطهطاوي، في القرن الشعرين، هناك حالة غريبة من الحوار بين مسلمين، لكن غربيين (ينتمون إلى الثقافة والحضارة الغربية) سيبدأون في قراءة الغرب وثقافته وحضارته من منظور ما وصلوا إليه في الإسلام مثل رينه جينو أو جارودي وبيجوفيتش والمسيري؛ وقراءتهم للغرب تؤكِّد مفهوم الاستيعاب والرفض والقبول، ووضعوا أيديهم على أمور أعتقد أن الغرب أحوج إلى السماع إليها.
ولكن هناك أيضًا حوار آخر داخل العلم، أختم به، وأسجل هنا خبرة أستاذتنا الدكتورة نادية مصطفى؛ فلها جملة قالتها: “لا مخرج من هذه الأزمة للعلوم إلا بالحوار الثقافي”. وجملة ثانية شديدة الأهمية وهي “أننا لا نريد أن نبني المنظور خارج العلم، ولكن عبر التفاعل مع ما هو داخل العلم”، والسؤال الذي كان لدي لماذا نبني من داخل المنظومة العلمية الحديثة؟ ولماذا ليس من خارجها؟
وقد ثبت بالتجربة صحة هذه المقولة؛ كما ثبت أن الطريقة الحوارية هي التي تُنتج شيئًا مفيدًا.. وقد جُربت الأخرى (إنتاج العلوم الاجتماعية من رحم العلوم الإسلامية فقط) ولم تؤدِّ هذه الجهود إلى نتائج ترتقي بالعلوم. وكانت الغلبة للتيار الوسط، الذي قال: نتمسَّك بما عندنا.. ونطَّلع على ما عند غيرنا، فننتج من داخل الموجود ولا نهدر ما قامت به الأمم، انطلاقًا من فريضة الاجتهاد، الذي اعتبره الشافعي مشروعًا بل مأمور به بل واجب على كل إنسان على قدر علم وحاجته وقدرته..
مداخلات وتعقيبات الحضور:
تنوَّعت تعقيبات الحضور وملاحظاتهم حول الكتاب بين عدة محاور، بدأت من الحديث عن طبيعة الكتاب وتوصيفه وتصنيف موضوعه، مرورًا بمنهجيته والمناهج المستخدمة فيه، ووصولًا إلى رؤيتهم النقدية وأسئلتهم حول الكتاب، وانتهاءً بتوصياتهم ومقترحاتهم لنشر الكتاب أو تطوير مضمونه.
بين الكتاب ومؤلِّفه
أكَّدت معظم التعليقات على الطابع الموسوعي والبانورامي للكتاب الذي يجسد الحضارات والمعارف والعلوم، فهو لا يركِّز على حقل معرفي واحد، ولكن يتحرَّك برشاقة بين الحقول المعرفية؛ فيصلُ الشرعيَّ بالمدني والديني والدنيوي، والشرق بالغرب، وهو عابر للأجيال والعصور والأزمنة، وكأنه يصطحب القارئ في رحلة عبر آلة الزمن تنقلت عبر العصور الإسلامية الأولى، ثم القرون التي شهدت الأزمات، وصولًا إلى الوقت الحاضر، تطوف به عبر الزمان والمكان والأفكار والأشخاص بشكل رائع وسلس. إذ تناول الكتاب محطات تطور المعرفة، وأبرز طابعها الإنساني. كما بَيَّنَ أن كثيرًا من العلوم نتاجٌ لتراث إنساني مشترك ساهمت فيه كل الحضارات والثقافات، وكان للحضارة الإسلامية باع نحتفي به في تكوين هذا العلم وبنائه.
فهذا الكتاب يروي قصة العلوم وتاريخها كما ينبغي أن نعرفها، وليس كما يتم ترديدها دائمًا ونقلها إلينا، كما يبدأها من حيث يجب أن تبدأ.. ويدرسها بالكيفية التي تثري المعرفة والقارئ. فهو كتاب تأسيسي حول تفاعل العلوم مع بعضها، وهو بداية لتأسيس علم مرتبط بالحوار؛ وهو قابل لتوليد أجندة بحثية حول هذا الموضوع.
والأَمْيَزُ في الكتاب أنه يقنع الباحث الاجتماعي بجدوى وأهمية العلوم الشرعية، وكيف يمكن النظر فيها على أنها ميدان يُعنى به الباحث الاجتماعي ربما قبل الشرعي! فمثلًا يقول الكتاب: “علم الفقه.. علم الحياة، ومركز الحياة الإسلامية، وأن الفقه علم مشترك جامع ما بين الشرعية والمجتمع..”.
كما نظروا إلى الكتاب بوصفه كتابًا مُعَلِّمًا، يزيد الإيمان أثناء قراءته؛ فالكتاب هو من الكتب التي يمكن تصنيفها بسهولة تحت قطاع الكتب المُجَدِّدَةِ.. فهو يدفع إلى إعادة النظر في كثير من التفاصيل العلمية التي يمرُّ عليها المرءُ مرورًا سريعًا، أو على الأقل لا يلحظ الروابط التي بينها أو التي يربطها بغيرها من الموضوعات.
وفي الكتاب دعوةٌ للحوار والتبادل والتلاقُح المعرفي والعلمي، فالحوار لم يكن قائمًا بين الحضارات والثقافات، ولكن أيضًا بين العالم والمتعلم، وأن العملية التعليمية قائمة على الحوار، وهنا درس للقائمين على عملية التدريس والتعليم، وكيف يستفيدون من هذا المنهج الحواري.
كما أن هذا الإنجاز هو نموذج للموضوعية الأكاديمية التي لم تمنع من ظهور روح الأصالة والانتماء للهوية العربية الإسلامية، وهو ما يخشى منه الكثير من الباحثين، هذا مثال نموذجي للجمع التكاملي بين الأمرين.
كما أشارت المداخلات إلى الإبداع والابتكار في مصطلحات الكتاب في نفس الوقت الذي يقدِّم فيه روح الشمولية والتكاملية والحوار، وعبور أزمة الجزر المنعزلة في العلوم.
وقد اتَّسم الكتاب أيضًا بسهولة قراءته، حتى مع عدم وجود خلفية في العلوم الذي تحدَّث عنها، فهو بعيد عن لغة الكتب الجافة. وهو مكتوب بنفَسٍ متمهِّل وتؤدة؛ فالأفكار تعالَج على نار هادئة.. ويمكن للإنسان أن يستوعب الفكرة بكافة تفاصيلها من خلال مطالعتها في هذا السِّفْرِ القيِّم.
ومن هنا ألْمح الحضورُ إلى أن هذا الكتاب أيضًا يعبِّر عن صاحبه، فيعبِّر عن سيرة ذاته، ويعبر عن التطوُّر والنموِّ وتزايُد الخبرة؛ فالكتاب مُلَخِّصٌ لهذا التطوُّر الذي طَرَأَ عليه، فهو يعبِّر عن حماس الشباب وخبرة الشيوخ الذي تراكم عبر الوقت.. كما يبيِّن أن لكاتبه قدمًا راسخة في فرعي العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية..
ومن يقرأ للدكتور مدحت ماهر يجد عنده الإحاطة الموضوعية والمنهجية الفريدة في النظر، واللغة العالية السلسة في الكتابة. كما أن بحوثه وموضوعاتها تحمل نفسَ الهمَّ، ولها نفس الخيط الناظم: الأمة بتراثها وحضارتها، وتجد ذلك في دراسته لنظام السياسة، وفي حقوق الإنسان والقيم والمنظور الحضاري والفقه والواقع والأخلاق والقانون.
والحوار عند المؤلِّف ليس عنوانًا لكتاب، ولكنه عنوان لشخصية كريمة سليمة الصدر واسعة الأفق رحبة مرحِّبة بالغير تحاوره وتناظره بحثًا عن الحق والحقيقة، تتأمَّل الكلمات والعبارات والجمل وتقدِّرها ولا تعكِّرها.
في منهج الكتاب ومنهجيته:
اختار الباحث استخدام مفهوم الحوار؛ وهو حوار يتَّسع معناه ليشمل معنى الفهم المتبادل، والجدل، وحتى التدافع. هو يتكامل مع كتاب طه عبد الرحمن حول “أصول الحوار وتجديد علم الكلام”، فهو استكمال أو تطبيق له.. كما وظَّف جملة من المنهجيات المختلفة، منها: تحليل النصوص، والتحليل المعرفي التاريخي المُقارن، كما دمج بين الحديث في تاريخ العلم وفلسفة العلم.
وقرأ بعض الحضور فكرة الحوارية التي انطلق منها الكتاب على أنها تصلح منهجية وأسلوبًا للدراسة، تنقلنا من عالم المداخل المنهاجية إلى عالم الأساليب البحثية، فالحوار وما يتفرع عنه من مراسلات، وأنواعها: التأسيس، والتطوير والتفعيل، وتبادلات معرفية، وحوار الثنائيات، والحوار الصراعي، والحواريات منها: حواريات تخصُّص وحواريات تفصُّص، تقدم طريقة لدراسة كثير من الموضوعات، كما تعبر عن أن الكتاب كُتِبَ بأسلوب حواري متميز؛ وهو يكمل على مدرسة ومنهجية المستشار طارق البشري في الكتابة الحوارية كما في كل كتبه ومنها: الحوار الإسلامي – العلماني، والحوار بين العروبة والإسلام وغيرها.
ويؤكد ذلك إشارة الكتاب إلى: “أن الحوارية تواصل لا انقطاع، واجتهاد لا تقليد ولا تبعية. الحوارية تواضع علمي لا ترفُّع فيه ولا استعلاء، والحوارية تسامح وقبول وأخذ ورد.. تأييد وتفنيد ونقد وبناء…” و”أن الاختلاف العلمي سنة وحقيقة، والأصل هو الحوار بين الآراء، والأصل في الحوار أن يأتي بجديد؛ فيؤكد صوابًا أو يصحح خطأً أو يعدل اعوجاجًا، ومن ثمَّ فالحوار هو باب العلم وطريقه وضمانته…”.
كما أخذت خريطة الحوارية في الكتاب عدَّة مسارات، منها:
- حوارية تأكيد على الاختلافات، وحوارية المراجعات (لمن سبق تصحيحًا أو إضافة).
- حوارية الوصول إلى نقطة الوسط.
- حوارية فرض الرأي الأقوى وحوارية إفناء الرأي الآخر.
- حوارية الصراع وحوارية الاستيعاب.
ولذا فإن الكتاب يقدِّم درسًا في المنهجية، ودرسًا في الإتقان، وفي الارتباط بين إشكاليته وفصوله، ودرسًا في كيفية تطبيق المنهج، كما يسدُّ فجوةً في التأليف والكتابات العربية المعنيَّة بالجوانب الحضارية المعرفية.
ملاحظات وأسئلة نقدية:
توقَّف بعض الحضور عند مفهوم “الحوار” في الغرب وتطبيقه على المعارف والعلاقة مع الحضارات الأخرى، إذ أشاروا إلى أن الذي كان يحدث في الغرب ليس حوارًا، واستخدام مفهوم هنا مجازي في أقصى تقدير، ومفهوم الحوار على طول الدراسة استخدم بمعنى فضفاض، وإن كان أصَّل له في أول الكتاب لغويًّا وشرعيًّا، لكن الحوار في اللغة العربية -كما ذكر الدكتور مدحت ماهر- يحمل معنى الرجوع والتداول والقبول والاعتراف بالآخر وبعض المعاني التي لا توجد بالضرورة في الحوارات الغربية، بينما كانت موجودة في الحضارة الإسلامية مع الحضارات الأخرى.
فالذي يحدث في الغرب ليس حوارًا بمعنى (Dialogue) وإنما كان بمعنى الجدل (Debate)، والجدل فيه معنى الصراع، فالفكرة السائدة في الحوارات في الغرب هي فكرة صراعية، ولكن نريد أن نؤكِّد على هذه الفكرة، ونبيِّن أنها لم تكن فقط تنعكس على العلاقة بين الغرب والثقافات الأخرى، ولكن داخل المدارس وبعضها في الغرب أيضًا، وربما داخل كل مدرسة. فهذا البعد الاستبعادي موجود في السياسة كما هو في العلم كما هو في الجانب السياسي والعسكري.
وهذا الصراع وصل إلى الصراع مع الله تبارك وتعالى؛ فنظرية ديكارت نادتْ بإحلال الإنسان محل الله تبارك وتعالى. فحاول تقديم رؤية للعالم بعين الإله، وأصبح الإنسان بديلًا عن الإله.
ورغم ما للغرب من هذه الرؤى والسمات في العلم، فإن المسلم مأمور بالحوار مع الآخر، ومع الغرب، انطلاقًا من نداء القرآن: (وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ..) الذي يدلُّ على وجوب الاستفادة من الآخر بطريق الحوار أو غيره. والعلماء المسلمون في السابق تعلَّموا من الحضارات الأخرى، ونحن الآن نتعلَّم منها، على أن نميِّز ما فيها، من باب طاعتنا لله عز وجل ودعوته لنا للعدل في هذا الأمر.
كما أخذ البعض على الكتاب فكرة قَصْرِ سِمة الموسوعية على علماء المسلمين في عصور ازدهار الحضارة الإسلامية دون غيرهم، إذ إن العلاقة بين التوسُّعية والتخصُّص -في بعض عبارات الكتاب- توحي أن علماء المسلمين تميَّزوا عن علماء الغرب في سِمة الموسوعية؛ على الرغم من أن الموسوعية سِمة معرفية إنسانية في تاريخ العلوم على مدار الحقب الزمنية المختلفة لأنها سبقت التخصُّصات الدقيقة التي نعرفها الآن. ومعظم العلماء قديمًا كان يطلق عليهم فلاسفة، التي تعني أنهم يتَّسمون بهذه السمة الموسوعية.
وبالمثل لاحظوا غياب التمييز بين العلوم الاجتماعية والإنسانية، ففي كثير من الأحيان كان يأتي الحديث عن كثير من العلوم بصيغة العطف؛ فهل يعني ذلك أنها فئة واحدة أم أن هناك تمايزًا بينها؟
وأخيرًا، مَثَّلَ غياب الواقع الراهن في الكتاب، ودراسة تأثيره على عملية الحوار بين الحضارات وبناء العلوم والمعارف وحواراتها أمرًا غريبًا عليهم، وذلك رغم أن الكتاب أُنتج في ظل مرحلة طوفان الأقصى، وتحت القصف كما أشار كاتبه.
بالإضافة إلى هذه الملاحظات طرح المعقِّبون جملةً من الأسئلة منها:
– أشار الكتاب إلى أن تراجع الحوارية أدَّى إلى تراجعات الحضارة الإسلامية؛ لأنها استبدلت الحوارية المعتمدة على تبادل الأفكار والبناء على حوارية صراعات؛ فكيف يمكن لحضارة “إسلامية” أن تفقد سمةً أصليةً مثل صفة الحوارية بهذا الشكل؟
– ولماذا تعمَّد الكتاب أن يحجم عن شرح تأثير الاستعمار في الحواريات وبناء المعارف؟
– وكيف نستعيد الحوار من وضعنا (تحت القصف)؟
– وما تأثير مناهج البحث الإسلامي في العلوم الغربية؟ فهل انتقل محتوى العلوم فقط إلى الغرب، أم انتقلت المنهجية العلمية أيضًا؟
– تحدث الكتاب عن عملية الحوار بين الحضارتين؛ ولكن ما هي آليات الحوار سواء داخل حضارتنا أو بين الحضارات: هل هي آليات الكتابة والتعلم والتدوين فقط؟ وما نتائج هذا الحوار؟ وكيف ساهم ذلك في حالة التلاقح الفكري سواء ما بين العلوم أو ما بين الحضارات؟ وهل هناك آليات للتنقيح قبل أن نكتشف الإشكاليات المترتِّبة على الأخذ من الغرب؟
– كيف يمكن أن نفتح الحوار-بعد هذا الاطلاع الطويل- مع حضارة تتعامل معنا بمنطق الاستعلاء؟ وكيف نغيِّره؟ فالمسألة ليست مجرد الانفتاح عليها ولكن كيف تنفتح هي علينا؟ وما آليات هذا الحوار؟
– لماذا ليست هناك حضارات أخرى تضمَّنها الكتاب؟ ولماذا لا نتحاور مع حضارات أخرى أكثر قبولًا لنا؟ قد تكون مختلفة لكن قد يكون لديها استعدادٌ أكبر للحوار ومشتركات أكبر في الجانب الروحي؟
– وماذا عن إسهام غير العرب وغير المسلمين في إنتاج وبناء المعارف الإسلامية بما يعزِّز الحوار، واستيعاب المختلفين؟
– هل يمكن تدشين مفهوم جديد اسمه “الحوارية النقدية” مبني على ما جاء في الكتاب؟
– ولو أمكن أن يتضمَّن الكتاب بعض النصوص التي تبرز نماذج من هذه الحوارات..
وأخيرًا أشارت التعقيبات النقدية إلى أن هذا الكتاب في موضوعه وطريقة سردِه يُشبه أن يكون هو النسخة الحضارية من دراسة كتاب «بنية الثورات العلمية». فالكتاب يُقَدِّمُ طرحًا موازيًا لطرح «كون» حول الثورات العلمية كطريقة للتقدُّم أو تراكم العلوم، وهو هنا يقترح مفهوم الحوار.. فإلى أيِّ مدى يقدِّم طرحًا متماسكًا مقارنة بما قدمه «كون»؟
ولذا فإن الكاتب مدعوٌّ أن ينتقلَ من الحديث في إطار المنظور إلى الكلام عن النظرية.. وهل يمكن من هذا الكتاب القيم أن نستخرج ملامح نظرية تشرح الطريقة التي تقدَّمت بها العلوم في الماضي ويمكن أن تتقدَّم فيه في المستقبل؟ وهل يمكن أن نستنبط من هذا الكتاب ونستخلص منه -انطلاقًا من شموليَّته وكلِّيَّته- ملامح نظرية بالمعايير التي نعرفها عن النظريات من حيث القابلة للتعميم والتجريد، والتي يمكن أن ترسم ملامح نظرية إسلامية في تقدُّم العلوم؟
واختتمت المُداخلات والتعليقات بجملة من التوصيات والمقترحات منها:
1- التوصية بترجمة الكتاب.
2- التوصية بتداول الكتاب ونشره على نطاق واسع في مختلف الجامعات والمراكز البحثية، على أساس أنه يقدم شرحًا: لنظرية المعرفة، والنقاشات، والحوارات بين العلوم والحضارات.
3- إقامة أكثر من ورشة عمل وحلقة نقاشية حول الكتاب: منهجه ومضمونه.
تعقيب ختامي.. د. نادية مصطفى:
قالت الدكتورة ناية مصطفى إنها عندما قرأت الكتاب؛ فإنه ابتداءً من عنوانه وفهرسه، ثم القراءة في أبوابه الثلاثة على التوالي فإن كل ذلك يفصح عن منهجيته من حيث المنطلق، والهدف والفرضيات والأدوات.. وعن هذا التراكم بين أجزائه. وقراءة هذا الكتاب تمثل ضرورة منهاجية لمن أراد أن يتعلَّم..
وتابعتْ: لذا فأنا أزهو بتلميذي الذي تابعتُ نموَّه وما أحدثه من تراكم. حاولت أن أكون موضوعية حضارية.. ولم أكن متحيِّزة بالمطلق، وإنما أنا متحيِّزة بالمعنى الذي قدَّمه المسيري، ومن علامات العلمية أن أُعلن تحيُّزي، وتأكَّدت أننا مدرسةً نفهم على بعضنا..
وهنا أقول عدة أمور:
– هذا الكتاب يمثِّل استيعابًا منظَّمًا وهضمًا عميقًا لمجموعة من المعارف المتحاضنة التي تشكِّل تأسيسًا لمن يدرس العلوم الاجتماعية من منظور حضاري.
– لن أستطيع أن أقدِّم علمًا من «منظور» من دون جملة هذه المعارف التي تشكِّل التأسيس، وتكوِّن الرؤية (الدراسات الحضارية – بتسمية د. منى أبو الفضل)؛ والتي تشمل القراءة في التراث الإسلامي والغربي، والفقه الإسلامي والتاريخ ومن الحقلين الإسلامي والاجتماعي.
– كنت أجد صعوبةً في الإجابة على سؤال يطرحه كلُّ من يريد التكوين في إطار هذه المدرسة: ماذا نقرأ؟
ولكن الآن، وقد استطاع الدكتور مدحت ماهر عبر كتابه هذا أن يُقَدِّمَ إجابةً عن هذا السؤال، وهو مَرَّ بها منذ عقود، لذا أستطيع أن أقول إن هذا الكتاب هو البداية. فصاحبه ذو تأسيس إسلامي معرفي، دعمه بالاجتماع المعرفي الحديث المُقارن؛ إذ قطع مشواره التأسيسي والعملي جامعًا بين القراءتين؛ النص والواقع، أو ما يُسَمَّى النظرية والتطبيق، وهو مستشعرٌ واقعَ أمَّته، فلم يكن منعزلًا عن واقع أمَّته وواقع وطنه… فالتأسيس في المنظور طريق ذو اتجاهين. وقد استطاع د. مدحت أن يجمع لنا -في هذا الكتاب- خبرة تفاعله مع هذه المجالات المتعدِّدة أفقيًّا ورأسيًّا من المدخل الحواري..
– ونحن في نطاق الجيل الرابع، علينا أن نبدأ طريقًا ذا اتجاه واحد يجمع بين العلوم الاجتماعية الشرعية بطريقة إبداعية.
– وهنا تأتي إجابتي على السؤال التالي: بما يفيد هذا الكتاب في مدرستنا؟
إن باحث العلوم السياسية والاجتماعية من منظور حضاري أو الذي يبحث أن يكون له منظور حضاري يحتاج إلى تأسيس وتدعيم بعدَّة أركان نظرية ومنهاجية عامة تمثِّل الحضنَ العامَّ لكلِّ المعارف الحديثة، قبل أن يتخصَّص..
فالمنظور الحضاري يستدعي معارف مختلفة (فلسفة وتاريخ واجتماع)، وذلك على عكس صاحب المنظور الوضعي المقيَّد بالواقع. فصاحب المنظور الحضاري أوسع أفقًا وأكثر حرية في التأسيس والتفكير ليس فقط في التعامل مع الواقع واللحظة الراهنة، ولكن لإحداث التغيير الحضاري الشامل.
– وهذا الكتاب قَدَّمَ هيكلًا مُحْكَمًا في كلِّ فصلٍ من حيث خريطة الحواريات سواء في مجال العلوم في الحضارة الإسلامية أو في مجال العلوم الغربية أو في مجال المقارنات بينهما، وهذه الخريطة المحكمة تقدِّم أنماطًا من الحوارات تعكس الانتقال من مفهوم الحوارية الواسع إلى مفهوم الجدال والصراع الفكري أو المعرفي، وداخل كل خريطة واحدة نماذج عدَّة..
– فالكتاب يقدِّم مجموعةً من النماذج الشارحة؛ أولها مفهوم الحوارية في القرآن.. وهو المعنى الذي يتجاوز الحواريات؛ وهو أيضًا المعنى الرشيد لمفهوم الحوار، الذي يتجاوز الحواريات المُسَيَّسَةَ أو البائسة.
– النموذج الثاني: الذي يقدمه الكتاب حول فكرة هدف العلم في المنظور الإسلامي؛ فالعلم ليس لله فقط ولا للعلم ذاته فقط، ولكن العلم استجابة لحاجتنا (المجتمع والأوطان)؛ وهذا هو التأصيل الإسلامي لمفهوم العلم.
– النموذج الشارح الثالث: بدأ بعد شرح جذع علوم الإسلامية وهو أصول الفقه، ثم تحدَّث عن الفروع، ثمَّ بدأ أول ما بدأ بعلوم التربية والأخلاق، وحين نقرأ هذا الجزء عن علوم التربية والأخلاق نعرف أن الأخلاق غاية التربية.
وختامًا، أقول إن قراءة الكتاب ليست مثل الاستماع إلى من يتكلَّم عنه، حتى ولو كان صاحبه، فقراءة الكتاب متعة، وأعتبرها ضرورة منهجية؛ لأجل التعرُّف على الأدوات والمناهج التي استُخدمت فيه: تحليل النصوص، والخرائط التي رُسمت في مكوِّنات الكتاب: أبوابه وفصوله.
إعداد تقرير اللقاء/ الباحث أحمد عبد الرحمن خليفة