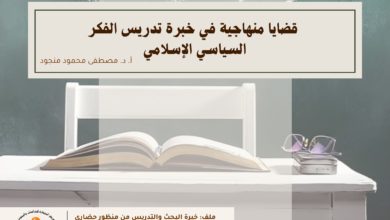تقرير حالة العلوم الاجتماعية في المنطقة العربية: خارطة المؤسسات والاهتمامات (2020- 2025)

مقدمة:
يستهدف هذا التقرير رصدًا أوليًّا للمؤسسات والمبادرات المعنية بتقييم حالة إنتاج العلوم الاجتماعية والإنسانية في المنطقة العربية، خاصةً ما يتعلق بالأبعاد المنهجية ومداخل دراسة قضايا المنطقة، وأهم إنجازاتها ومبادراتها في هذا المجال، مع الإشارة إلى مجموعة القضايا والموضوعات المرتبطة بها. ويركز هذا الرصد على جهود هذه المؤسسات خلال السنوات الخمس الأخيرة (2020 – 2025). ومن ثمَّ يقوم التقرير بتوضيح نشأة هذه التجارب، وأبرز أنشطتها، وبناء خريطة للموضوعات التي تهتم بها. وقد رُتبت هذه الجهود المؤسسية على أساس زمني يتعلَّق بتواريخ نشأتها (من الأقدم إلى الأحدث).
ولا يدَّعي هذا التقرير أنه رصد شامل ودقيق للمؤسسات العاملة المعنية بتقييم حالة العلوم الاجتماعية في المنطقة، ولكنه محاولة أولية للإلمام بأبرز هذه المؤسسات، وهو ما يستلزم أن تتبعه دراسات أخرى أوسع رصدًا للمؤسسات من ناحية، وأعمق تحليلًا لمخرجات ومنجزات هذه المؤسسات من حيث تقدير مدى إسهامها الفعلي في هذا الميدان، من ناحية أخرى.
أولًا: مبادرة الإصلاح العربي – باريس
تعرف نفسها على أنها: “مؤسسة فكرية تعمل بالشراكة مع 20 مؤسسة أخرى كمورد للمعرفة الحصرية عن حكومات ومجتمعات المنطقة العربية”، وفق أجندة أعمال تعاونت مراكز أبحاث السياسات من عشر دول عربية وأربعة مراكز أبحاث أوروبية وواحدة من الولايات المتحدة لوضع جدول أعمال للإصلاحات السياسية والاجتماعية في المنطقة على أساس الأولويات التي وضعتها مجتمعات المنطقة نفسها. وقد تأسَّست المبادرة عام 2005، ويقع مقرها الأساسي في باريس.
خريطة الموضوعات والاهتمام
تركز المبادرة عملها على إنتاج معرفة نقدية مرتبطة بمجالات السياسات الاجتماعية والسياسات العامة والحركات الاجتماعية والبيئة والمناخ، منها مشروع مهم تحت عنوان: “تطوير التحليل النقدي للسياسات العامة”، ويهدف لبناء قدرات الباحثين في العلوم الاجتماعية بالتعاون مع علماء الاجتماع المهتمِّين بإحداث تأثير سياسي من أجل تعزيز جهودهم في إنتاج البحوث والتوصيات ذات الصلة بالسياسات، بتمويل من مؤسسة شبكة كارنيجي – نيويورك، وذلك عبر زمالة تضم عددًا من الباحثين، ومجموعة من الويبينارات، والمؤتمرات. وكان من أبرز العناوين التي شملها المشروع:
- المعرفة بصفتها منفعة عامة: إعادة النظر في هدف إنتاج المعرفة وأساليبها
- إنتاج المعرفة في زمن الأزمات: ما هو دور الباحث.ة الناشط.ة؟
- النضال البيئي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أجندة بحثية
ثانيًا: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – الدوحة
تأسَّس المركز عام 2010 بوصفه مؤسسة أكاديمية عربية مقرها الدوحة، وله فروع في بيروت وتونس وواشنطن وباريس. وقد أسس المركز مشروع المعجم التاريخي للغة العربية، ومعهد الدوحة للدراسات العليا وهو معهد جامعي تشرف عليه إدارة أكاديمية ومجلس أمناء مستقل يرأسه المدير العام للمركز.
خريطة الاهتمامات الموضوعية وأبرز الأنشطة المعنية بتطوير العلوم الاجتماعية:
إلى جانب اشتباك المركز مع قضايا الواقع العربي الاجتماعية والسياسية، يكرس جهدًا كبيرًا لتطوير دراسة العلوم الاجتماعية وقضايا المنطقة، يظهر ذلك في عدد كبير من إصداراته (سلاسل الكتب)، والمؤتمرات، والدوريات. وفيما يلي أبرز هذه الأعمال المعنية بتطوير دراسة العلوم الاجتماعية وتقويمها في المنطقة:
- مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية
رغم أنه لا تحمل كافة دراساته عناوين مراجعة التراث الأدبي للموضوعات والمنهجيات المستخدمة فيها، فإن الأوراق الخلفية والمرجعية للمؤتمرات والأوراق البحثية المُقدمة فيها تقوم بهذا الدور. وقد عُقد منه حتى الآن 10 دورات. بعضها كان مُخَصَّصًا لقضية المنهج ومناهج البحث في العلوم الاجتماعية (الدورة السابعة). كما تناولت الدورات الأخرى مواضيع مثل: الثورات العربية، الدولة العربية، الثقافة السياسية، سؤال الأخلاق والقيم، وسائط التواصل الاجتماعي. ثمَّ الدورة الأخيرة عن: “العلوم الاجتماعية والإنسانية في البلدان العربية والذكاء الاصطناعي: الجدوى والإشكاليات والتحديات“.
- المؤتمر السنوي للدراسات التاريخية:
مؤتمر يعقده المركز في أبريل من كل عام “بهدف تطوير البحث التاريخي العربي، وتعزيز التراكم في المعرفة التاريخية، وتحقيق عملية التواصل بين المؤرِّخين العرب”. وقد عُقد منه حتى الآن 10 دورات. وشملت أبرز موضوعاته ذات الطابع العام والمنهجي في نفس الوقت: التاريخ الشفوي (2014)، التأريخ العربي وتاريخ العرب: كيف كُتب وكيف يُكتب؟ (2016). في حين أن معظم المؤتمرات الأخرى ركَّزت على إعادة قراءة أحداث بعينها مثل النكبة، تأسيس الدولة الأردنية، والحكومة العربية في دمشق، والحرب العالمية الثانية بعيون عربية.
- دوريات المركز العربي:
اهتمَّت مجموعة الدوريات التي يصدرها المركز العربي، وهي: حكامة (سياسات عامة)، سياسات عربية (علوم سياسية وعلاقات دولية)، عمران (علوم اجتماعية وإنسانية)، أسطور (دراسات تاريخية)، تبيين (دراسات ثقافية وفكرية)، استشراف (دراسات مستقبلية)، المنتقى (باللغة الإنجليزية)، بعدد من القضايا المتعلقة بدراسة العلوم الاجتماعية والسياسة خاصة، منها على سبيل المثال:
- حال العلوم السياسية والعلاقات الدولية
خُصص العددان 60 و61 من دورية سياسات عربية لتقويم حال وواقع العلوم السياسة في عدد من البلدان، منها: مصر والسودان والجزائر وتونس والمغرب. بالإضافة إلى عدد من القضايا المهمة مثل: التاريخ الاجتماعي لنشأة وتطور دراسة حقل العلوم السياسية، والواقع والتحديات، وأسباب غياب نظرية عربية للعلاقات الدولية، بالإضافة إلى تدريس العلاقات الدولية في العالم العربي.
بالإضافة إلى ذلك اهتمَّ المركز (العددان 57 و58 من سياسات عربية) بدراسة علاقة العلوم السياسية بالرياضة (السياسة والرياضة)، بعض دراساته ارتبطت بالجوانب المنهجية ذات الصلة بعملية البحث في العلوم السياسة ذاتها.
- قضايا تطور العلوم الاجتماعية في العالم العربية
تناولت عدَّة دراسات متفرِّقة نُشرت في دوريات المركز (خاصة عمران) عن تقييم حالة البحث المعاصر في العلوم الاجتماعية العربية، ومنها عن تقييم مشروع عبد الله الحموي في تصور علوم اجتماعية عربية، فضلًا عن تناول قضايا تتعلَّق بعملية إنتاج المعرفة مثل: الحرية الأكاديمية.
ثالثًا: المجلس العربي للعلوم الاجتماعية – بيروت
أُعلن عن تأسيس وتسجيل المجلس رسميًّا في بيروت منذ أكتوبر 2010، ليتَّخذ من بيروت مقرًّا له. وذلك بعد العديد من الاجتماعات التحضيرية والتشاورية بين مجموعة من الأفراد والمؤسَّسات والمانحين (مركز أبحاث التنمية الدولية الكندي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم [MBRF] ومؤسسة فورد). كما أنه افتتح مكتبًا فرعيًّا في عمَّان – الأردن (2021).
وتتمثَّل أهداف المجلس حسب ما يُعلن في: “.. تدعيم البحث وإنتاج المعرفة في مجال العلوم الاجتماعية في المنطقة العربيَّة من خلال دعم الباحثين ومؤسسات البحث العلمي والأكاديمي. كما يسعى المجلس إلى تعزيز دور العلوم الاجتماعية في الحياة العامة وإفادة السياسات العامة في المنطقة”.
ويبرز عبر أنشطة المجلس وبرامجه، هذا الاهتمام بعملية إنتاج العلوم الاجتماعية، وتقويم حالتها في المجتمعات العربية، وتدشين مجموعات عمل (تمثِّل جماعات علمية صغيرة) في مسارات بحث نوعية، منها:
- سياقات العنف في المنطقة العربية
- الدراسات النقدية حول الأمن في المنطقة العربية
- مجموعة العمل حول الإثنوغرافيا والمعرفة
- مجموعة العمل حول جندرة الأرشيف
- مجموعة عمل الإقليميَّات الجديدة
- مجموعة عمل البحوث حول الفنون
- صون إنتاج المعرفة في المنطقة العربية
- الممارسات النقدية
- إنتاج المجال العام في المجتمعات العربية: الفضاء، الإعلام، والمشاركة
بالإضافة إلى العديد من فرص التمويل والمنح والزمالات التي تهدف إلى خلق جيل جديد من الشباب والباحثين المعنيين بأجندة المجلس والآلية النقدية التي يعتمدها لإنتاج المعرفة والاشتباك معها.
ويُعد أبرز منتج للمجلس حول تقويم حالة العلوم الاجتماعية والإنسانية العربية هو مشروع “المرصد العربي للعلوم الاجتماعية“، الذي “يسعى إلى فهم طبيعة البحوث ذات الصلة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية والتعليم العالي في المنطقة العربية عن طريق معاينة ظروف إنتاج المعرفة في مجال العلوم الاجتماعية ونشرها وتحليلها. ويركِّز المرصد على ثلاثة مجالات رئيسية هي: (1) البنى التحتية لإنتاج المعرفة؛ (2) المسارات المهنية لمجتمعات البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية؛ (3) استخدامات العلوم الاجتماعية والإنسانية”.
وقد صدر عن هذا المشروع أربعة تقارير مجمَّعة، ومجموعة من الأوراق خاصة بكل بلد، وكذا قاعدة بيانات خاصة بالموضوعات التي يركِّز عليها المشروع[2].
كما سار عدد من مؤتمرات المجلس على نفس المنوال، وكانت عناوينها دالة في ذاتها مثل: مساءلة العلوم الاجتماعية في دوامة الأزمات.. موجات السخط والمطالبة بالتغيير (المؤتمر الخامس – ديسمبر 2021).
الموضوعات محل الاهتمام:
يركز المجلس العربي للعلوم الاجتماعية على مجموعة كبيرة من الموضوعات التي يعرفها على أنها “نقدية”، تهتم بقضايا: الجندر، العنف، والسلطة، والفقر، والمناخ، والبيئة، وأخلاقيات البحث، والإثنوغرافيا، والدراسات الأمنية النقدية، والصحة، ودراسات المدينة… إلخ.
رابعًا: مشروع العلوم السياسية للشرق الأوسط Project on Middle East Political Science (POMEPS) – واشنطن
يعرف المشروع نفسه على أنه “شبكة تعاونية بين مجموعة من المتخصصين في العلوم السياسية في الولايات المتحدة، تهدف إلى تعزيز مجال العلوم السياسية في الشرق الأوسط، كما تسعى إلى صياغة مناهج جديدة ومبتكرة للعلوم السياسية في المنطقة، ودعم نشر الأبحاث في هذا المجال في المجلات الأكاديمية الرائدة، وزيادة عدد علماء السياسة ذوي الخبرة الطويلة المتخصِّصين في شؤون الشرق الأوسط، وزيادة مساهمتهم في نقاشات السياسة الخارجية وفي عملية صنع السياسات في الولايات المتحدة.
يتبع المشروع معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة جورج واشنطن، ويتلقَّى دعمًا من مؤسسة كارنيجي في نيويورك. ويديره مارك لينش، وتشرف عليه لجنة توجيهية تضم علماء سياسيين بارزين من جامعات بحثية مرموقة. وقد عُقد الاجتماع الأول للمشروع في مايو 2010.
وتنظم الشبكة مجموعة من ورش العمل، واللقاءات التفاعلية (Seminars)، وحلقات بودكاست (وصلت إلى أكثر من 300 حلقة)، إلى جانب مؤتمر سنوي، فضلًا عن فرص ومنح تمويلية للمشاركة في المؤتمرات وزيارة دول في الشرق الأوسط.
الموضوعات التي يركز عليها المشروع:
يركِّز المشروع على مجموعة من الموضوعات، تُعَدُّ في ذاتها مداخل متميِّزة لدراسة قضايا المنطقة، من منظور “العلوم السياسة”، مثل سياسات البيئة، والرياضة، والهجرة واللجوء، والمرأة، والحوكمة… إلخ، ولعلَّ من أحدثها تقرير بعنوان: “الحرب في غزة والعلوم السياسية في الشرق الأوسط“. كما كان له نشرة مهمة معنِيَّة بأنشطة الباحثين (The Middle East Scholar Barometer) في الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية، وجمعية دراسات الشرق الأوسط (صدر منها 6 أعداد في أعوام: 2021، 2022، 2023).
خامسًا: مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية – الدوحة
يُعرف نفسه على أنه “كيان بحثي تابع لمكتب نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، معني بتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، والتجسير فيما بينهما، والمثاقفة الحضارية. ويعدُّ مركز ابن خلدون من المراكز القليلة في العالم الإسلامي التي تعاطت مع المنظومات الفكرية بأصالة حضارية، حيث سعى لأقلمةِ علوم الحضارات الأخرى بما يتلاءم مع سياقه الثقافي والمجتمعي، وهذا ما يعبِّر عن “إطار التوطين” الذي يُعَدُّ أحد الأطر الاستراتيجية للمركز”. وقد تأسَّس المركز في عام 2017.
له العديد من الإصدارات البحثية التي عُنِيَتْ بدراسة العلوم الاجتماعية: أزمتها، ومناهجها، وعلاقتها بالعلوم الشرعية، وأولويات البحث فيها، معظمها كان نتاج تفكير جماعي في مؤتمرات ولقاءات جمعت أساتذة من دول مختلفة من العالم العربي. من أبرز هذه الإصدارات:
- مدى كفاءة نظريات العلوم الاجتماعية في تفسير الواقع العربي
- المقاربات الشرعية المعاصرة للمفاهيم والموضوعات السياسية
- أولويات البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية والشرعية في العالم العربي
- أزمة كورونا وانعكاساتها على علم الاجتماع والعلوم السياسية والعلاقات الدولية
- أزمة العلوم الاجتماعية في العالم العربي
- توطين العلوم الاجتماعية في الخليج: الجهود والتحديات والآفاق
يبرز من إصدارات المركز وعناوينها، تركيزه على مدخل “العلوم البينية”، تحت عنوان كبير يُسمى “التجسير المعرفي”، ومن ثمَّ جاء عنوان إصداراته شبه الدورية (المُحكمة) باسم “تجسير لدراسة العلوم الإنسانية والاجتماعية البينية” لتعكس هذا الهدف. كما يعقد مؤتمرًا سنويًّا تحت عنوان “تجسير”. وتنعقد الدورة الثالثة منه في 30 نوفمبر 2025 من هذا العام تحت عنوان: “الأبحاث البينية في العلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعات العربية: الواقع والتحديات والآفاق”.
سادسًا: الشبكة العربية للعلوم السياسية (APSN) – بيروت
هي مبادرة أكاديمية غير ربحية تأسست في عام 2019، بهدف أساسي يتمثل في دعم وتعزيز البحث العلمي والتدريس في مجال العلوم السياسية وفروعها المختلفة في العالم العربي. وتتمثل رسالة الشبكة -وفقًا لموقعها- في: “دعم وتهيئة الفرص لزيادة المخرجات البحثية والتعليمية للمتخصِّصين والمتخصِّصات في العلوم السياسية”. ويقع مقرها الأساسي في بيروت.
مجالات الاهتمام والموضوعات:
تتمثَّل أهمُّ أنشطة الشبكة في:ورشة تطوير الأبحاث (سنوية)، وسيمينارات حول تدريس العلوم السياسية وموضوعاتها في المنطقة. وتشمل موضوعات اهتمامها: تدريس الحرب، مناهج البحث العلمي، الجندر والسياسة، تدريس العلاقات الدولية. كما للشبكة مشروع مهم عن “موارد” و”مخططات” تدريس مقررات العلوم السياسية في المنطقة.
كما تظهر من بين اهتماماتها الموضوعية: دراسة سياسة البنية التحتية في المنطقة، وعلاقة الشباب بالسياسة في المنطقة، وسياسات المراحل الانتقالية، واتجاهات البحث في السياسة العربية.
على الرغم من أن الشبكة يندر أن تصدر لها مخرجات ورقية “باسمها”، فإنها تعتمد على التأثير عبر التواصل المباشر والتفاعلي عبر ورش العمل واللقاءات التي تستهدف الباحثين والمتخصِّصين في العلوم السياسية في المنطقة. كما أنها تعتمد على مؤسسات شريكة عدَّة لإتمام أنشطتها، منها: مبادرة الإصلاح العربي، الجمعية الأمريكية للعلوم السياسة، جمعية دراسات الشرق الأوسط.
ولذلك تُعد قناتها على اليوتيوب المنصة الرئيسية للاستفادة من أعمال الشبكة ومتابعة أعمالها.
سابعًا: الشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية (إيناس) – بيروت
تُعرف نفسها على أنها: “شبكة علمية ومدنية دولية مستقلة تأسست عام ٢٠٢٠ بمبادرة من أكاديميين ومؤسسات علمية ومجتمعية في المنطقة العربية ثم توسَّعت لمناطق أخرى من العالم. ومقرها الرئيسي بيروت. تجمع الشبكة أكثر من ٧٠ مؤسسة علمية ومركز بحثي وجمعية مدنية على منصة واحدة بهدف التشبيك والتداول المعرفي من أجل فهم مشترك للتحولات التي تحدث داخل المجتمعات العربية وصولًا الى اقتراح استراتيجيات مختلفة معرفية وتطبيقية تقارب التحديات العربية الراهنة والمستقبلية، وذلك من خلال التداول المعرفي والحوار البناء مع الجماعة العلمية ومؤسسات البحث العربية”.
يتفرع عن الشبكة مجموعة من الوحدات البحثية، تعمل في إطار الأهداف العامة للشبكة. تشمل الوحدات: وحدة التغيرات الاجتماعية، الدراسات الاستراتيجية، التربية، دراسات السياسات، الدراسات التاريخية.
ولا يتَّضح من الموقع نشاط هذه الوحدات بصورة كبيرة، إلا أن كل وحدة توضح المؤسسات المشاركة فيها. كما يتفرع عن الشبكة شبكة أخرى تُسمى “شبكة دراسات المرأة”.
والملاحظة العامة عليها أن عدد المؤسسات المُسجلة من مصر قليلة جدًّا، في حين يندر أن نجد اسم مؤسسة خليجية، في المقابل تكثر أسماء مؤسسات من المغرب العربي.
يغلب على اهتمام الشبكة وإصداراتها دراسة الموضوعات الاجتماعية والمجتمعات العربية (مدخل اجتماعي سياسي للقضايا العربية) مثل: عودة اللاجئين السوريين، الحرب على غزة وسؤال القيم، التحولات في العالم العربي وأسئلة النهضة، النخب العربية في أزمنة التحول، القوى العالمية الكبرى ومنطقة الشرق الأوسط.
ثامنًا: الجمعيات العربية للعلوم الاجتماعية
يجدر بنا في هذا الصدد الإشارة إلى دور الجمعيات العربية المعنية بالعلوم الاجتماعية، ونركز هنا على نموذجي
“الجمعية العربية للعلوم السياسية -بيروت (1985)، و”الجمعية العربية لعلم الاجتماع – تونس (1985)”.
- وبالنظر إلى جهود الجمعية العربية للعلوم السياسية (بيروت)[3]، نجد أنها تقتصر على عقد مؤتمر سنوي يتعلق ببحث ودراسة قضايا معاصرة مثل “طوفان الأقصى”، والثورات العربية، والقضية الفلسطينية… إلخ، دون اهتمام حقيقي بقضايا العلم وتطويره. كما تَصدُر مجلتها “المجلة العربية للعلوم السياسية” بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت).
- أما عن الجمعية العربية لعلم الاجتماع (مقرها تونس)، فيبرز اهتمامها بتقييم حالة إنتاج المعرفة المتعلقة بعلم الاجتماع، وطبيعة الإسهامات غير الغربية بيها. برز هذا الاهتمام في دوريتها “إضافات” التي تُصدرها بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية منذ 2008، وصدر منها حتى الآن 67 عددًا. ونجد من بين عناوين دراستها وملفاتها ما يوحي بهذا الاهتمام (نرصد شيئًا منها خلال السنوات الخمس الأخيرة):
- فمثلًا جاء العدد 65 (صيف 2024) ليقدم “قراءة في حروب الإبادة” من منظور اجتماعي، كما جاء من ضمن عناوين دراسته: “في الحاجة إلى إيبيستيمية جديدة: غزة ونزع الهيمنة عن المعرفة الاجتماعية الغربية”.
- أما في العددين 61-62 (خريف 2023)، فنجد عناوين الدراسات التالية: إنتاج المعرفة في علم اجتماع المعرفة، تضافر المقاربات في الدراسات النقدية للخطاب، مقاربات الدراسات الأنثروبولوجية في زمن اللايَقين، إلى جانب (افتتاحية) العدد التي كانت بعنوان: ديمومة الحاجة للعلوم الاجتماعية في عالم متقلِّب.
- كما ضَمَّ ملف العددين 57-58 (2022) سبع دراسات حول “مساهمات جنوبية في علم اجتماع المعرفة” منها دراسة بعنوان: النظرية الاجتماعية الإسلامية: الإسلام والممارسة الاجتماعية.
ويمكن بمزيد من التصفُّح لأعدادها نجد هذا النوع من الدراسات المعنية بحالة العلوم الاجتماعية وإنتاجها في المنطقة العربية وجدالتها بين المحلية والإقليمية والعالمية منها مثلًا على سبيل المثال علم النفس الاجتماعي في المنطقة العربية.
تاسعًا: مؤتمرات العلوم الاجتماعية والإنسانية (العالمية)
مما ينبغي النظر إليه عند مراجعة حالة العلوم الاجتماعية الإنسانية النظر في الإنتاج العالمي المتعلق بها، والذي ينطوي دائمًا على نظرات وتقييمات من مناطق مختلفة من العالم، ومنها المنطقة العربية بالتأكيد، ويصدر عنها ملخص للأبحاث. ومن هذه المؤتمرات:
- المؤتمر العالمي للعلوم الاجتماعية (WORLD Conference on SOCIAL SCIENCE )
- المؤتمر العالمي للعلوم الاجتماعية والإنسانية (SHCONF)
إلا أن الإسهام الأهم الذي تلزم الإشارة إليه هنا هو تقرير العلوم الإنسانية العالمي – World Humanities Report الذي صدر بالشراكة بين المجلس الدولي للفلسفة والعلوم الاجتماعية واتحاد مراكز ومعاهد العلوم الإنسانية (بالتعاون مع اليونسكو)، وقد شارك المجلس العربي للعلوم الاجتماعية عبر نخبة من الأساتذة والباحثين العرب لإنتاج 25 ورقة بحثية بين عامي 2020 و2021 حول حالة إنتاج العلوم الاجتماعية في المنطقة، وذلك بموضوعات وقضايا مختلفة عن النسوية، والتاريخ الشفوي، والبيئة، ودراسة الأزمات، فضلًا عن تحليل ودراسة حالات مؤسسات ومبادرات معنية بالعلوم الاجتماعية في المنطقة العربية مثل معجم الدوحة للغة العربية، ومركز الدراسات الفلسطينية، ومنتدى المرأة والذاكرة، وغيرها.
خاتمة فاتحة.. ملاحظات وأسئلة:
تنقسم هذه الخاتمة قسمين؛ القسم الأول هو ملاحظات الباحث على هذه المؤسسات والموضوعات التي طرحها، أما القسم الثاني فهو يحمل مجموعة الأسئلة التي يجدر أن تكون موضع بحث فيما بعد:
أ) ملاحظات وأسئلة حول المؤسسات والموضوعات
يمكن عبر النظر في خريطة المؤسسات والموضوعات الخلوص بمجموعة من الملاحظات الأولية، تتعلق بـخمسة محاور أساسية:
- خلفية المؤسسات:
تشترك معظم المؤسسات في مجموعة من العوامل، أهمها: العمل مع الشركاء، ومحاولة بناء شبكة من العلاقات بين المؤسسات. والملاحظ أن معظم المؤسسات التي رُصدت تربطها ببعضها علاقات علمية تشاركية، انعكست في أجندات بحثية ومؤتمرات مشتركة، وتبادل في النشر والباحثين بين برامجهم المختلفة.
- التمويل:
يتضح من هذه المؤسسات حضور العنصر الأجنبي (الغربي) ليس فقط في التمويل، وإنما في التبادل والمشاركة العلمية: منها ما يتعلق بوضع الأجندات، وتمويل المشروعات البحثية، وبرامج إعداد الباحثين، كما يظهر في الخليفات الأكاديمية للباحثين، وهم وإن كانت جذورهم تعود للمنطقة، فإن جُلَّهم ممَّن أكملوا تعليمهم في الغرب، وبعضهم يتحدث العربية بصعوبة.
- البلدان:
تتركَّز مقرَّات المؤسَّسات والمبادرات المعنيَّة بتقييم حالة إنتاج العلوم الاجتماعية في المنطقة على هذا المستوى في بيروت، والدوحة، إلى جانب باريس وواشنطن وتونس، ولكن الغريب أن النظر في قوائم المشاركين في الشبكات وأنشطتها، يلاحظ عليها تراجع كبير في الحضور المصري تحديدًا، مع بروز واضح لذوي الأصول المغاربية (المغرب ثمَّ الجزائر فتونس) على مستوى المشاركة في هذه المؤسسات إداريًّا وبحثيًّا. وهو ما يحتاج إلى التأمُّل قليلًا خاصة عند حالة مصر، والخليج العربي.
أما عن مصر: فهل يمكن النظر إلى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية على أنه منخرط في تقييم حالة إنتاج معرفة اجتماعية عربية أو حالة (البحوث الاجتماعية) كما يحمل اسمه؟ أم إنه معنيٌّ بدراسة قضايا اجتماعية “مصرية” كما يغلب على عناوين إصداراته[4]؟ وبأي منظور؟
وبالمثل، نجد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي، فعلى الرغم من أن بها وحدة فرعية تُسمى “مجلس بحوث العلوم الاجتماعية والإنسانية والسكان“، فإن إجمالي إنتاجها صدر في خمس تقارير بحثية انصب اهتمامها على بناء استراتيجيات لمواجهة الإرهاب وهجرة العقول، وتجنيس الرياضيين المصريين، وربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، والهجرة غير الشرعية، ومشكلات العشوائيات. بالإضافة إلى مشروعين حاليين عن العنف الأسري في المجتمع المصري، والذكاء الاصطناعي في العلوم الاجتماعية والإنسانية (وهو معنيٌّ وفقًا لتوصيفه بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في بعض المجالات الاجتماعية)، دون الاهتمام بعملية تطوير بحوث العلوم الاجتماعية البحوث ذاتها فضلًا عن تقييم حالتها في مصر أو المنطقة.
أما عن دور المؤسسات الخليجية المعنية ببحوث العلوم الاجتماعية: فالملاحظة الأولية تشير إلى أنها -على كثرتها وضخامة تمويلها- أكثر عناية بالقضايا التطبيقية والموضوعات ذات العلاقة بالسياسات مثل مركز الخليج للأبحاث (السعودية)، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وغيرهما. ومع هذا، قد تبرز مؤسسات أخرى تهتم مثلًا بجوانب معرفية وفلسفية وبحثية، ولكنها ليست ذات صلة مباشرة بتقييم حالة العلوم الاجتماعية العربية مثل المؤسسات والمبادرات التي عرضْناها، ومن أمثلتها مركز نماء (السعودية)[5].
- التركيز على التأثير في مجتمعات الباحثين:
بالنظر في أنشطة هذه المؤسسات نجد أن لديها توجُّهًا واضحًا يركِّز على مجتمعات الباحثين، أو تكوين جماعات علمية تتبع هذه المؤسسات، وتسفيد من فكرها، بوصفها نقطة تأسيس وانطلاق، لكن لا تقف عندها. ومن ثمَّ تهدف للتأثير في بناء الأجندات البحثية للباحثين.
- التركيز الموضوعي:
يوجد اهتمام مشترك بين هذه المؤسسات بمجموعة من القضايا: البيئة، المناخ، الرياضة والسياسة، الإثنوجرافيا، في أمر يثير تساؤلات مهمة: عن من هي المؤسسة القائدة لهذه المؤسسات والشبكات؟ وما دور التمويل في توجيه أجندة البحث فيها؟ وما مساحات التمايز بينها إنتاجيًّا ومنهجيًّا؟
- غياب “الإسلامية”
يبرز في نطاق اهتمام هذه المبادرات والمؤسسات غياب «الإسلامية» بوصفها منهجًا وعاملًا مؤثِّرًا في عملية إنتاج المعرفة أو حتى في حضور المؤسسات ذات الطابع المعني بدراسة العوامل الدينية وتأثيرها في الموضوعات المختلفة، اللهم إلا عند استحضاره -أي عامل الإسلام- لنقده في ارتباطه بالأبويَّة وتحجيم أدوار المرأة والوقوف دون تحرر الأفراد، وذلك باستثناء مركز ابن خلدون الذي حاول تقديم نظرة مختلفة منبعها الحضارة والتجربة الإسلامية، إلى جانب بعض الدراسات القليلة في دورية “إضافات”.
ب) أسئلة حول المضامين وفعالية المؤسسات:
يثير التفكير في هذه المؤسسات والموضوعات التي هي محل اهتمامها عدَّة أسئلة، على رأسها: هل توجد مؤسسات عربية تضطلع فعلًا بإنتاج معرفة عربية أصيلة (نابعة من منظور غير غربي)؟ أم إنها تنتج داخل الإطار الغربي نفسه، ولكن مع تبني تيار أو تيارات نقدية فيه؟
ثمَّ، ما المقصود بـ “النقدي” في سياق إنتاج هذه المؤسسات؟ هل هو نقدي بالمعنى اللغوي، أي مجرد التفكير المتفحِّص لإبراز الجوانب المختلفة للموضوع، من جيد ورديء، أو إيجابي وسلبي؟ أم نقدي بالمعنى التلفيقي؟ أي مجرد دراسة الموضوع من مداخل مختلفة (غربية أيضًا) لا تُدرس بها قضايا المنطقة عادةً؟ أم إنه نقدي حقيقي بمعنى أنه يسعى لبناء منظور ما نابع من المنطقة (مصري، أو مغربي أو عربي) لنقد المعرفة الراهنة وإنتاج بديل لها؟
وأخيرًا، إلى أي مدى نجحت هذه المؤسسات في تحقيق هذه الأهداف “الكبيرة” التي وضعتها لنفسها؟ ثمَّ ما مدى التشابه والتمايز بينها؟ ومن ثمَّ، تحتاج أعمال هذه المؤسسات إلى تقويم ونقد ومقارنة وفقًا لأهدافها المعلنة أولًا، وبالمقارنة مع المؤسسات الأخرى العاملة في النطاق نفسه ثانيًا، ووفق معايير إنتاج وتوليد المعرفة الجديدة ثالثًا.
كما تُطرح مجموعة كبيرة من الأسئلة حول: مَن يُنتج ماذا؟ وكيف؟ ولصالح مَن؟ وبأي تكلفة؟ ومن أين يأتي التمويل؟ وكلها أسئلة تحتاج إلى نظر وبحث عميق، قد يفضي في النهاية إلى الوصول ليس فقط إلى حقيقة هذه المؤسسات وعلاقاتها وطبيعة منجزها.
وهذه الأسئلة التي أفرزتها الورقة تتطلَّب جهدًا خاصًّا في ورقة أخرى لاحقة إن شاء الله تعالى.
[1] باحث بمركز الحضارة للدراسات والبحوث.
[2] انظر قراءة مستفيضة في هذه التقارير:
جبريل علي، حال العلوم الاجتماعية والإنسانية في العالم العربي: قراءة في تقارير المرصد العربي للعلوم الاجتماعية، دورية عمران، العدد 52، المجلد 13، ربيع 2025، متاح على الرابط التالي: https://doi.org/10.31430/RBRO4299
[3] ولا يوجد موقع إلكتروني رسمي للجمعية، وهذا في نظر الباحث دلالة على محدودية تأثيرها خاصة في عصر أصبحت فيه التواجد الرقمي القوي دليل على القوة والتأثير. كما لا تُقدم الجمعية برامج ولا منح دراسة للباحثين لتطوير أبحاثهم.
[4] من أمثلة إصدارات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: المرصد الاجتماعي (رصد الظواهر المجتمعية في مصر)، المجلة الاجتماعية القومية (1964)، المجلة الجنائية القومية (1958)، ويُعد من أهم إصدارته مشروعاته: التقرير الاجتماعي المصري، وبحوث استطلاعات الرأي العام. للمزيد انظر الموقع الرسمي للمركز: ttps://ncscr.org.eg/static-content/14
[5] صدر عنه مجموعة من الكتب حول مراكز البحوث ودورها في الوطن العربي، ومراكز البحث الأمريكية ودراسة الشرق الأوسط، بالإضافة لمراكز البحث العلمي في إسرائيل وتركيا والهند، وذلك ضمن مشروع “دراسات صناعة البحث العلمي”، ولكن لم يصدر فيه سوى 5 كتب، للمزيد انظر: https://nama-center.com/Projects/Details/44.
كما يشارك نماء في الاشتباك بصورة نقدية مع كثير من الموضوعات وقضايا المعرفة والعلوم الاجتماعية كما يظهر في إصداراته (المؤلفة والمترجمة) المتنوعة، للمزيد انظر: https://nama-center.com/ProjectReleases