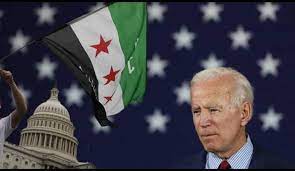المقاومة الحياتية في غزة: كيف يقاوم الفلسطيني سياسات الموت الصهيونية؟

مقدمة:
تعد سياسات الموت الصهيونية التي تعمل على إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أهم القضايا الدولية التي تعبر عن خلل عميق في النظام الدولي سواء من حيث شرعيته الأخلاقية أو آلياته القانونية، ويتكشّف هذا الخلل في سياسات سلطة الاحتلال الصهيونية في تمزيق الحياة الفلسطينية وتحويل قطاع غزة إلى مساحة للاستثناء من الحيز الإنساني والقانوني، واعتبار سكانه “حيوانات بشرية” كما قال وزير الدفاع الصهيوني السابق غالانت،[1] وهذا الخطاب الذي ينزع الإنسانية عن الفلسطينيين يعتبر خطوة أولية لإبادتهم. بالرغم من ذلك، لم يتراجع الإنسان الفلسطيني عن مقاومة هذه السياسات الصهيونية في حياته اليومية، ونحن هنا لا نتحدث عن المقاومة العسكرية المسلحة التي لها تأثيراتها الخاصة، لكننا نتحدث عن المقاومة اليومية للإنسان الفلسطيني المدني الذي يحاول أن يلملم شتات الحياة المتشذرة بغرض إعادة بناء المعنى الذي يحافظ على قدرته على البقاء والاستمرار في كل هذا الدمار المميت.
ويعتبر مفهوم الحياة اليومية من المفاهيم التي كانت محورا للتركيز بشدة في الفكر السياسي المعاصر، وذلك بعدما تجاوز هذا الفكر ارتباط السياسة أو الفعل السياسي بالمفاهيم التقليدية للمجال العام والسياسة التمثيلية. وساعدت تنظيرات مفكرين مثل ميشيل فوكو، بيير بورديو، هنري لوفيفر، ميشيل دي سيرتو وجميس سكوت -بالأخص آخر ثلاثة مفكرين- في هذا التحول للفهم السياسي الذي وجد أن السياسة لا يمكن أن توجد في فضاء مكاني أو زمني محدد*، بل هي تشمل الأفعال اليومية الاعتيادية التي تكون غارقة في علاقات القوة.[2] والأفعال اليومية كانت تبدو قبل هذا الفهم مجرد أفعال روتينية، تُمارس بواسطة الأفراد سواء بشكل فردي أو جماعي في ضوء السياقات الاجتماعية، فهي كانت في عُرف المألوف والبديهي وخارج حيز السياسة، لكن عندما تم التأمُل سياسيا في تلك الحياة اليومية؛ اتضح أنها ليست مجرد مجموعة من الأفعال المحايدة، بل هي تمثل حيزا واسعا للتلاقي بين السلطة والمقاومة.
تنطلق الورقة من هذا المفهوم؛ لتحاول الكشف عن المناطق التي تظهر فيها الذات الفلسطينية المقاوِمة كذات تقف بالمرصاد للصورة الإعلامية النمطية عن الجسد الفلسطيني المقتول والمُشيَّء الذي يتحول إلى أرقام وإحصاءات في النشرات الإخبارية.
أولا- بقاء الغزيين في الأرض كفعل مقاوم
تستهدف سياسات الموت الصهيونية في حرب الإبادة الجارية تحويل غزة إلى مساحة متكاملة للموت سواء باستهداف الأجساد مباشرة أو من خلال الحصار الذي يشّل الحياة الفلسطينية. وغرض الحكومة اليمينية من ذلك هو ترسيخ الإدراك في الوعي الفلسطيني بأن الحياة على هذه البقعة من الأرض أصبحت مستحيلة، وعليه، تكون الهجرة -التهجير بمعنى أصح- هي المرادفة للحياة الفلسطينية، وتكون بذلك النجاة الفردية هي هلاك الشعب. لكن الشعب الفلسطيني رضي بالاستشهاد على الأرض الفلسطينية بديلا عن تركها، وهذا ما يؤكد أن الوعي الفلسطيني المعاصر يُقام على دروس النكبة؛ فالوعي الشعبي الفلسطيني يدرك تمام الإدراك مآسي النكبة وما نتج عنها عندما خرج الفلسطينيون من أرضهم تحت وطأة القتل والتدمير، على أمل الرجوع إليها لاحقا[3]. وهذا الوعي يمكن أن نعتبره البوصلة الخفية التي توجه شعب غزة في قضية الأرض؛ لأن هذا الموضوع هو ما يجعل الذات الفلسطينية الحديثة -التي بدأت منكوبة*– تتجاوز نكبتها بالمقاومة والتمسك بالأرض حتى لو على حساب الحياة.
هذا ما ظهر في العديد من الفيديوهات المصورة للعديد من الفلسطينيين وهم يعربون عن تمسكهم بأرضهم وعدم قبولهم لأي عرض متعلق بقضيتها؛ تتلخص هذه الحالة في مشاهد عديدة منها مقطع لشاب فلسطيني يُصور على خلفية أصوات القصف وهو جالس أمام خيمة مقامة على الأنقاض قائلا: “نحن هنا صامدين ونريد أن نموت في الشجاعية (حي الشجاعية)، مدافع أو غير مدافع نحن غير خائفين، يقذفون كما يقذفون، نحن صامدين في الشجاعية ونريد أن نموت على أرضنا”، واستكمل حديثه بعدما نزل إلى الأرض ممسكا بقبضة يداه بعضا من ترابها قائلا: “هذه الأرض ملكنا، نريد أن نموت عليها، غير هذا لا يوجد موت عندنا .. نريد أن نخرج محمّلين على الأكتف ولا نسلم لنتينياهو“، وأكد المجاورون له من الفلسطينيين في المقطع المصور ذاته كلامه بقولهم إنهم يشاركونه نفس الرؤية[4].
هذا الموقف يقبل الموت الفردي بمعناه المادي، أي تصفية الجسد، لكنه لا يقبل القتل الانطولوجي الذي يحدث عبر التهجير وقتل القضية الفلسطينية والشتات النهائي للشعب. فرفض التهجير والقبول بالموت على أرض الوطن يُعيد تعريف السيادة على الأرض والجسد الفلسطينيين؛ لأن قرار البقاء على الأرض يُربك السلطة الكولونيالية الصهيونية التي تستخدم أقصى مراحل السيادة -وفقا لأدبيات السياسة الحيوية- أي تفعيل حق القتل، لكن دون جدوى.
فالإنسان الفلسطيني أكد امتلاكه لجسده لأنه رضي بالموت في سبيل أرضه قبل أن يُفرض عليه، واستعاد السيطرة على الأرض المنتهكة؛ لأن الموت لم يفزعه لتركها، بل قبِلَه في سبيل البقاء عليها. وكذلك يعيد الإنسان الفلسطيني المقاوم امتلاك الزمن الذي صادرته سلطة الاحتلال الصهيونية؛ لأنه يرفض أن تكون قضيته مجرد حكاية مؤسفة في التاريخ الإنساني الحديث، بل ببقائه على الأرض؛ يسيّر الامتداد التاريخي لوجوده في المكان الذي يشكل هويته؛ لكل ذلك، يتحول الغزوي من مجرد شيء غير إنساني قابل للنزع والقتل في خطاب السلطة الكولونيالية وبواسطتها إلى ذات سياسية مقاومة فعالة تعيد تأكيد حضورها على أرض الواقع أمام أكثر سلطات التاريخ المعاصر وحشية.
والعودة الجماعية لسكان غزة إلى شمال القطاع في أواخر يناير من عام ٢٠٢٥ تمثل خير شاهد على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه بالرغم من كل الدمار والموت الذي تعرض أو سيتعرض له، حتى مثلت هذه العودة صدمة كبيرة للمجتمع السياسي الإسرائيلي بكل أطيافه سواء المعارضة مثل يائير لابيد الذي اعتبرها دليلا على فشل الحكومة القائمة في إدارة الدولة، أو حتى إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الذي عد هذه العودة انتصارا لحماس[5]، أي أن عودة عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى أراضيهم المهدمة في الشمال أحبطت الحلم الكولونيالي الصهيوني. كذلك كشفت هذه اللحظة عن ظهور جسد جماعي فلسطيني متجاوز للجسد الفردي؛ لأن الرغبة الجماعية في العودة، والعودة فعليا، تشكلت رمزيا على شاكلة جسد جماعي تظهر على سطحه الجروح وعلامات النزيف، لكنه يسير -بالرغم من الألم- تجاه أرضه وبيته.
ويمكننا القول إن البقاء على الأرض الفلسطينية كفعل مقاوم تحت وطأة سياسات الموت الصهيونية، يعتبر بمثابة المظلة العامة للمقاومة التي تفرعت عنها كافة أشكال المقاومة اليومية الفلسطينية التي نستعرضها في هذه الورقة؛ لأنه عند قرار البقاء، تدرك الذات الفلسطينية أن هذا البقاء لا يستمر إلا بمقاومة سياسات الموت الصهيونية التي لو استسلم الشعب لها ستكون النتيجة هي تصفية قضيته. ومن ثمة، بعد هذا القرار يبدأ الفلسطيني في ابتكار تكنيكاته المقاومة.
ثانيا- الممارسات اليومية الرافضة لسياسات الموت الصهيونية
سياسات الموت الصهيونية إن لم تقتل الفلسطيني مباشرة، فهي تجعل ظروف حياته لا تساعد بأي شكل من الأشكال على البقاء. وما دام الإنسان الفلسطيني قد قرر البقاء، كان لا بد أن يبتكر ممارسات حياتية يومية تجعله يقاوم ظروف الموت التي يحياها، فالغزاوي يتصيد ثغرات الحياة اليومية كي يقاوم سلطة الاحتلال التي تريد قتله، ويعيش.
* الطهي وإعادة تشكيل الهوية الفلسطينية الصامدة:
يمكننا أن نعتبر الطهي الجماعي وتدبير المستلزمات الغذائية البسيطة أحد أشكال مقاومة الحصار المفروض على القطاع، فالطهي الذي يعتبر روتينا يوميا، قد اكتسب معنى جديدا وتحول إلى سلاح سياسي مقاوم، يحارب به الإنسان الفلسطيني سياسات الموت الصهيونية ويعيد الحفاظ من خلاله على هويته الثقافية ويُثبت للعالم من خلاله أنه لم ينكسر، فكما قال أحد الشهود الفلسطينيين: “بالنسبة لأهل غزة، تُعدّ الوجبات التقليدية رمزًا قويًا للهوية، وشهادةً على صمودنا، ووسيلةً لتوثيق الروابط العائلية حتى في أحلك الظروف… في كل مرة تجتمع فيها عائلتي حول المائدة لتناول وجبة، نتحدى القوى التي تسعى لطمس هويتنا”[6].
كما أن الطهي الفلسطيني تحول إلى رواية توثيقية لما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال تصوير المئات من مقاطع الفيديو لاختراعات شعبية لأكلات يمكن أن تُحضّر بمقادير بسيطة متوفرة في القطاع، وعُرفت هذه الاختراعات بأنها “وصفات حرب“؛ فهذه الممارسة ناهيك عن فاعليتها في الصمود أمام أزمة الغذاء إلا أنها ذات دور أرشيفي أيضًا[7]. وبالإضافة إلى هذه المقاطع المصورة للأطباق المطهية التي انتشرت في غزة، أظهر القائمون عليها بعدا جماليا مقاوما أيضا، ألا وهو تعمد تصوير هذه الأطباق مُزينة بجوار أي رمز فلسطيني (كالكوفية الشهيرة، أو شجرة..) أو أي مشهد يدل على استمرار الحياة والتعبير الجمالي للوجود في أرض حرب الموت والإبادة.
هذه الاختراعات ليست اختراعات غذائية موجهة إلى الجانب البيولوجي فقط، بل هي في الأساس عامل صمود أمام الحصار الذي يفرض الجوع على الفلسطينيين. كما أن مقاطع الفيديو المذكورة تعيد تصوير الذات الفلسطينية بوصفها ذاتا مبدعة محبة للجمال ومقاوِمة على عكس الصورة الإعلامية النمطية التي تُظهر الفلسطينيين متكدسين أمام عربات المساعدات الإنسانية وطوابير توزيع الغذاء، أو أنهم أشلاء أو مبتورين. بل وصل حد الصمود الهوياتي إلى تأليف كتب عن الطبخ، فقد ألفت امرأة غزوية تُدعى “منى زاهد” كتابا بعنوان “طبخة” يحمل ٢٠ وصفة للأكلات الشعبية الفلسطينية التقليدية، بالإضافة إلى وصفات لبدائل الحرب[8]. وقد جاء هذا الكتاب كفعل مقاوِم أرشيفي، يحاول أن يحفظ التراث الشعبي الفلسطيني المستهدف بالمحو؛ فتقول مؤلفة الكتاب عن دوره الثقافي: “وصفاتنا تروي للعالم قصصًا عن تاريخنا وقضيتنا ووجودنا. المقلوبة والمفتول والسماقية، كلها أطباق تُمثل شعبنا”. فهنا تحولت الأكلات الشعبية الفلسطينية إلى منصة عرض للهوية الفلسطينية الصامدة التي تحاول منظومة الاحتلال الصهيونية تفكيكها.
وفي إطار سياسة الصمود اليومي أمام الجوع، لجأ الفلسطينيون لطحن البقوليات كالعدس، والفاصوليا، والحمص والأرز بديلا عن الدقيق الذي شح وارتفع ثمنه بفعل الحصار الصهيوني؛ وذلك من أجل الحفاظ على إمكانية توفير بعض أرغفة الخبز في الحياة اليومية الفلسطينية[9]. ولتعويض الجسم الفلسطيني عن نقص البروتين، لجأ الأهالي لصيد السلاحف والتغذي على لحومها[10]. فالحياة الفلسطينية اليومية هي حياة البدائل، وهذا ما يعبر عن مدى الصمود الفلسطيني كفعل يومي يُحبط التدمير الحياتي الصهيوني.
كل هذه التكنيكات توضح أن الطهي الذي هو مجرد فعل يومي اعتيادي في الحياة الإنسانية، أصبح مجالا سياسيا في غزة، يعتمد عليه الفلسطينيون في المقاومة، ليس فقط من أجل وجودهم الجيولوجي -الذي يعتبر تحديا في حد ذاته- بل من أجل وجودهم الهوياتي. فالطهي كأداة، حافظ على بقاء الغزوي في عالم المعنى، الهوية، والسياسة بجانب حفاظه على وجوده البيولوجي.
* التعليم كأداة لاستعادة المكان والزمان في غزة:
كان التعليم أحد أهم الاستهدافات الصهيونية في حرب الإبادة الجارية، واتبعت سلطة الاحتلال سياسة تجهيل المجتمع الفلسطيني من خلال تدمير ٢٩٣ مدرسة من أصل ٣٠٧ في القطاع[11]. لكن لإدراك مدى أهمية التعليم للحياة الفلسطينية؛ حاول الفلسطينيون مقاومة سياسة التجهيل بابتكار بعض الأمور البسيطة التي ساعدت على استمرار تعليم العديد من الأطفال.
ساهمت هذه الآليات في إعادة تشكيل المكان، فقد حولت المبادرات الأهلية -الفردية والجماعية- الخيام من مكان للنزوح والمعاناة إلى مكان للتعليم. قامت -على سبيل المثال- مبادرة بواسطة فتاة مراهقة مجتهدة، تولت بموجبها تعليم مجموعة من الأطفال أساسيات اللغة الإنجليزية في وسط الخيام، وابتكرت الأدوات البسيطة التي مكنتها من إتمام هذه العملية التعليمية، كالاستعانة بـ”النايلون” بديلا للوحة الكتابة المدرسية. ولم تُعِد هذه المبادرة تشكيل المكان فقط، بل والزمان أيضا؛ حيث حددت هذه الفتاة لهذه العملية التعليمية ساعة يوميا، وهذه الساعة تكون ساعة منتجة وخلاقة، خارج حيز الحرب والدمار الذي يعيش فيه هؤلاء الأطفال باستمرار[12].
كما قامت مبادرات أخرى أكثر تنظيما وأوسع انتشارا، منها مبادرة مؤسسة “بيتنا الشبابيط” التي أقامت عدة فصول مدرسية للأطفال في خان يونس وسط أنقاض المباني وخيام النازحين، وغيرها العديد من المبادرات الشبابية التي عملت على استغلال المكان لتشكيل وعي الأطفال قدر الإمكان وعدم تركهم للجهل التام[13].
والملاحَظ من صور الأماكن التي استُخدمت لتعليم الأطفال هو أنها كلها وُضِعت بها رموز هوياتية مثل علم فلسطين أو صور لأماكن وطنية فلسطينية أو حتى حروف كلمة غزة متجاورة، وهو ما يمثل أهمية أكبر حتى من المحتوى التعليمي ذاته؛ لأن أحد أهم أهداف المؤسسات التعليمية الحديثة هو تشكيل الهوية الوطنية، وما تفعله هذه المبادرات التعليمية أنها تعوّض هذا الدور الذي أماتته سلطة الاحتلال بتدميرها للبنية التحتية التعليمية. هذه المبادرات لا تكون مفيدة فقط للأطفال، بل أيضا للمعلمين والشبان المتطوعين الذين يؤكدون ذواتهم داخل مساحات من الإنتاج والعطاء -عبر ممارسة التعليم- وتحطم رغبة سلطة الاحتلال في تشييئهم.
كل هذه المبادرات قد خلقت حيزا “زمكانيا” تعليميا خارج سيطرة المنظومة الكولونيالية الصهيونية؛ لأنها استطاعت أن تنشل الأطفال ومُعلميهم من مساحات الدمار إلى حيز خلّاق منتج ومفعم بالحياة، هذا الحيز الحياتي الذي يمكن فيه “سماع الأطفال وهم يقرأون ويغنون ويلعبون داخل “خيم التعلم” المقامة وسط المناطق المزدحمة وتحت أصوات الزنانات التي أصبحت جزءا من المشهد الصوتي، فتسمعهم يغنون الأغاني الشعبية والوطنية تارة، وتارة أخرى يتعلمون الموسيقى والدبكة، ويسردون القصص الشعبية والروايات الفلسطينية، ويلونون العلم الفلسطيني، ويعبّرون عن معاناتهم وآلامهم بالرسم على جدران الخيمة التي تؤويهم، فالجميع حاضر بمعاناته وذكرياته وتاريخه“[14].
كما أن هذه المساحات التعليمية ساعدت في حل المشكلات النفسية للأطفال الذين عانوا من أزمات نفسية بفعل حرب الإبادة، بالأخص أزمات فقدان أحد الوالدين أو كليهما بسبب الاستهداف الصهيوني للأجساد المدنية الذي كان أبرز ملامح سياسات الموت الصهيونية. فهذه المساحات جعلتهم يدخلون في علاقات مع بعضهم البعض، يلعبون ويمارسون العديد من الهوايات كالرسم والغناء ويكتشفون في ذواتهم مواهبهم الخاصة، وهذا ما خفف حدة الأزمات النفسية في مرحلة الطفولة في غزة[15].
بل إنه بدأ التنبّه إلى أهمية هذا النوع من التعليم الشعبي غير النظامي باعتباره تعليما غارقا في السياسة وأكثر قدرة على تنمية حس المقاومة لشباب المستقبل؛ لأنه في الأساس قد نشأ بوصفه رد فعل مقاوِم لتدمير التعليم النظامي في غزة، بالإضافة إلى أنه أقل حيادا تجاه القضية السياسية؛ لأنه يتم في ذروة تفجرها. ونتيجة لهذا؛ بدأت الدعوات الفلسطينية المطالبة باستمرار هذا الشكل من التعليم حتى بعد أن تتوقف الحرب. وهذا التعليم الشعبي يمتّن الهوية الفلسطينية؛ لأنه يُبرز السردية الوطنية الفلسطينية من خلال التاريخ والثقافة عبر الواقع اليومي المعيش. كما أن هذا التعليم سيكون له دور في إعادة رسم التاريخ الشعبي الفلسطيني، وذلك عبر إعادة رسم صورة اللاجئين، الأسرى والشهداء، من خلال تحطيم صورة العجز التي رسمت لهذا الثلاثي في الكتب المدرسية، وهذا عبر تأكيد السردية اليومية التي تأكد بطولات هذا الثلاثي، بعيدا عن الاكتفاء بذكر الأرقام الصماء؛ وهذا ما يساهم في توليد معرفة ذاتية تحررية مرتبطة بالواقع اليومي الحياتي، بدلا من المناهج المحايدة التي تفصل المسألة السياسية عن العملية التعليمية.[16]
فقد تحولت العملية التعليمية اليومية الفلسطينية الشعبية البسيطة إلى مساحة لإنتاج الحياة التي تحاول سلطة الاحتلال الإسرائيلية مصادرتها؛ حيث أعادت هذه العملية للإنسان الفلسطيني سيطرته على المكان والزمان وإنتاج المعنى، بالرغم من التخريب الصهيوني الذي يبتغي قتل كل هذه المساحات الحياتية الأصيلة.
* الطواقم الطبية والمستشفيات الميدانية وإعادة إنتاج الحياة:
إن للاستهداف الصهيوني للبنية التحتية الحيوية الغزوية، بالإضافة إلى الحصار الذي منع وصول المساعدات الطبية، آثارا كارثية على منظومة الصحة في قطاع غزة[17]، وتقع هذه السياسة ضمن سياق أوسع متعلق بإعاقة الحياة الفلسطينية. وبالرغم من كارثية الموقف الذي أسفر عن استشهاد آلاف الفلسطينيين وهم يكابدون الألم بفعل سوء الأوضاع الطبية، استمرت الأطقم الطبية في ممارسة عملها وسط هذه الظروف كي تنقذ ما تبقى من الحياة الفلسطينية، جاعلة من التطبيب بما توفر لها من إمكانات محدودة، فعلا مقاوما لسلطة الاحتلال التي تعمل على تصفية هذه الحياة.
فالمستشفيات الميدانية التي أقيمت بأبسط الإمكانات بديلا للمستشفيات الأساسية التي خرجت عن الخدمة بفعل القصف والتدمير الصهيوني، هي خير شاهد على الاستمساك بخيوط الحياة عبر مداواة آلام المصابين والحفاظ على حياتهم. فحتى أواخر مايو لعام ٢٠٢٥، أُقيمت (١١) مستشفى ميداني على شكل خيام، توزعت على مناطق القطاع لتنقذ ما يمكن إنقاذه من حيوات الفلسطينيين[18].
وبالنظر إلى ظروف عمل الطواقم الطبية في هذه المستشفيات الميدانية، وحتى قبلها في المستشفيات الأساسية، سندرك مدى الدور المقاوِم الذي يلعبه أفراد الطواقم الطبية بممارسة مهنتهم بشكل يومي فقط؛ فهم يعملون يوميا تحت أزيز طائرات الاحتلال، وهم لا يمتلكون حتى أساسيات أدوات العمليات الطبية، ومعرَّضين طول الوقت للاعتقال أو القصف. فهذه الشريحة بعملياتها الطبية تعيد تعريف الجسد الفلسطيني؛ لأنه إذا كان قد عُرف بواسطة سلطة الاحتلال الكولونيالية بأنه مساحة للاستثناء والموت، فالطبيب الفلسطيني يعيد التأكيد بأن هذا الجسد يستحق الحياة عبر دوره الوظيفي، بل حتى هذا الفعل الطبي يعيد السيادة على الجسد الفلسطيني؛ لأنه يحبط المحاولات السيادية الصهيونية في تصفيته. فهذه المستشفيات الميدانية تمثل مصانع لإنتاج الحياة في محيط من الموت، والطبيب الفلسطيني الذي يعمل عبرها تحول إلى رجل مقاوم وتحولت وظيفته إلى وظيفة سياسية؛ لأن مداواته لكل جرح يعد تحطيما لحلقات السلطة الكولونيالية التي تستعمر الأجساد الفلسطينية وتنفيها من الحياة.
فهؤلاء الأطباء يجرون العمليات على أضواء الهواتف المحمولة، ويبحثون دائما عن البدائل في العمليات الطبية تعويضا عن النقص، ويُفجعون أحيانا باستقبال ذويهم من المصابين والشهداء. فقد انتشرت العديد من مقاطع الفيديوهات المصورة لأطباء يجدون أبنائهم، أو آبائهم وأمهاتهم وأشقائهم ضمن الشهداء، ويحتسبونهم برضاء عند الله ويواصلون عملهم في إنقاذ الضحايا؛[19] فهم لم يُمكِّنوا منظومة الاحتلال الصهيونية من احتلال نفسياتهم، وبالرغم من كل ذلك يواصلون إنتاج الحياة بالتطبيب والمداواة للجرح الفلسطيني.
كل هذا العطاء يعيد ترميم المعنى الحياتي الفلسطيني في ظل التفكك الذي تفرضه منظومة الاحتلال الصهيونية، وليس فقط الاكتفاء بمداواة الجسد. فإذا كانت السيادة الصهيونية قد موضعت نفسها في القتل وتخريب الأجساد الفلسطينية؛ فإن الأطباء الفلسطينيين يخلخلون جوهر هذه السيادة بصمودهم وممارسة عملهم اليومي المنتج للحياة والمُداوي للأجساد في ظروف حتى لا تساعدهم على الصمود.
وقد كانت هناك ملحمة بطولية قادها الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان الذي أصر على البقاء في المستشفى واستمرار تقديم الخدمات الطبية للمصابين، وعدم الامتثال لأوامر إخلاء المبنى رغم الحصار الخانق والقصف، لكن عندما أجبرت قوات الاحتلال من هم داخل المستشفى على الإخلاء، خرج دكتور أبو صفية، وانتشرت صور ومقاطع فيديوهات توثق ظهور الدكتور وهو يسير وحيدا بزيه الطبي الأبيض وسط الأنقاض والركام متوجها نحو الدبابات الإسرائيلية، في رمزية تضع جسد الفلسطيني الطبي الصانع للحياة أمام الجيش الصهيوني المُصادر والنافي لها،[20] فالطبيب قد جعل من جسده -الذي أصيب مسبقا بنيران الاحتلال واستمر في مواصلة عمله- مصدرا لمقاومة الفضاء الصهيوني. وقد اعتُقل بعدها الدكتور وعانى التعذيب في سجون الاحتلال؛ لأنه كان رمزا مقاوِما عبر عمله وهويته المهنية.
* دفن الشهداء وكسر السيطرة الصهيونية على الموت الفلسطيني:
إذا كانت سلطة الاحتلال الصهيونية قد نزعت الإنسانية عن الجسد الفلسطيني خطابيا وانتزعت حقه في الحياة واقعيا؛ فقد احتلت موته أيضا وتحكمت فيه، وذلك استكمالا لنزع الإنسانية بمنع تكريم الجسد الفلسطيني الميت الذي يحفظ له إنسانيته؛ وذلك بتصعيب مهمة الدفن، وكذلك منع الطقوس الرمزية الاجتماعية المتعلقة بالموت كالعزاء. تلك المراحل التي تضمن استمرارية الوجود الاجتماعي وارتباط الإنسان بأرضه وتؤرشف تاريخ الجماعات عبر تجربة الموت، وتحفظ رمزية الشهيد الذي مات في سبيل بقاء الشعب على أرضه؛ تحول تحقيق هذه المراحل إلى مهمة صعبة في زمن حرب الإبادة التي احتلت بنيتي الحياة والموت.
حاول الفلسطينيون -قدر الإمكان- تحطيم سيادة وسلطة الاحتلال على موتهم من خلال تصميمهم على دفن جثث الشهداء بدلا من التعامل مع الجسد الفلسطيني باعتباره مجرد بقايا بيولوجية كما تحاول منظومة الاحتلال أن تجعله دائما. فقد حوّل الفلسطينيون العديد من الأماكن إلى مقابر من أجل دفن الشهداء، فأُقيمت المقابر في الحدائق العامة، والأسواق، وفي الشوارع العمومية وساحات مختلف المؤسسات العامة بل وحتى في بعض الأراضي الخاصة.[21] وبفعل جنون سلطة الاحتلال في إزهاق الأرواح؛ وجد الفلسطينيون أزمة في القبور، لذلك، لجأوا إلى إقامة مقابر عشوائية حرصا منهم على دفن ذويهم في أماكن معلومة لإحياء ذكراهم النبيلة باعتبارهم ليس فقط أقرباء، بل رمزا لتضحيات الشعب الصامد أمام سياسات الموت والمحو، أي أن هذا الجسد المُستشهد يُوجِد المزيد من الروابط بين الفلسطينيين غير الانتماءات التقليدية.
كما بدأ العاملون في الدفن بابتكار وسائل مكانية في المقابر تساعد على استقبال المزيد من الشهداء، كان من ضمن هذه الوسائل بناء طابق ثان في القبور لضمان حفظ كرامة المزيد من الشهداء بدفنهم.[22] كما يعمل الفلسطينيون على نقل جثامين الشهداء من المقابر العشوائية إلى المقابر الأساسية المعروفة في القطاع كلما أمكن ذلك.[23] وبالرغم مما يفتحه هذا التكنيك من مواجع لجروح لم تلتأم بعد، إلا أنه يعيد سيطرة أهل القطاع على أجسادهم مرة أخرى، فهم من يتحكمون في أجساد الشهداء وأماكنها وينقلونها من مكان إلى آخر، بعدما أرادت سلطة الاحتلال استعمار موتهم ونفي الجسد الفلسطيني منه كخطوة لاحقة لنفيه من الحياة ليصبح خارج كل أحياز الإنسانية الممكنة.
المكان والزمان اللذان يحكمهما القصف المستمر، عندما يحفر فيهما الإنسان الفلسطيني قبرا عشوائيا؛ ليدفن شهداءه ويحفظ لهم جزءا من التكريم الإنساني، يشهدان على تحول الفعل اليومي الإنساني إلى تحدٍ لسلطة تريد أن تمارس سيادتها عبر تشويه جسد الفلسطيني حيا وميتا والنزع المطلق لإنسانيته. وهذا الاستمساك الفلسطيني بدفن الشهداء حتى إذا نظر له الفلسطيني على أنه شرف عائلي أو واجب قرائبي، إلا أنه يمثل -سواء وعِيَ الفلسطيني ذلك في واقعه اليومي أم لا- حلقة أولية من حلقات استمرارية المقاومة الشعبية الفلسطينية. وموقع هذا الفعل من المقاومة أنه يحفظ للشهيد، الذي هو ملك لكل الشعب وكذلك رمز متجاوز لمادة الجسد باعتباره جامعا للهوية، كرامته بعد الموت، ويحافظ على جثمانه داخل باطن أرضه الذي اختار الموت عليها كبديل عن فراقها، وهو ما يخلق من قصة موته في الحاضر سردية تاريخية مقاوِمة، تجتمع عليها الأجيال اللاحقة.
وتثبيت الشهيد في مكان واضح باسمه وهويته يؤرشف لحظة الحاضر المقاوِمة، ويقاوم المحو التشييئي الذي يحول الشهداء إلى مجموعة من الأرقام منزوعة الهوية، ويجعل منهم استمرارا لذاكرة جماعية تشهد ببطولات هذا الشعب وتضحياته، وذلك من خلال التنشئة الاجتماعية الفلسطينية التي تتم عبر زيارة مقابر الشهداء وإحياء ذكراهم، والتذكير بثأرهم ودمائهم. فالذاكرة الشعبية الفلسطينية ممتلئة بالرموز المعروفة التي استشُهدت وظلت رمزا للصمود واستمرارية المقاومة. لذلك؛ فإن تعمُّد سلطة الاحتلال تشويه هذا الرمز عبر نفيه من الموت بعد قتله ليس جريمة ضد الإنسانية فقط، بل هو فعل سياسي يبتغي تصفية المقاومة الفلسطينية؛ وبالتالي يعتبر مجرد دفن الشهيد في مكان معلوم وسط كل هذا الموت والدمار فعلا مقاوما لأنه يحافظ على كرامة الشهيد ويُعيده داخل حيز الموت الإنساني، ويدعم الاحتفاظ برمزيته التي تمنح الشعب الفلسطيني محفزات المقاومة المستمرة بكافة أشكالها.
* المناسبات الاجتماعية كفضاء للمقاومة في زمن الإبادة:
الحياة اليومية الإنسانية حافلة بالمناسبات الاجتماعية التي تُضفي المعنى على الحياة، وتزيد من أواصر الانتماء بين أفراد المجتمعات، لكن المنظومة الكولونيالية الصهيونية قد قررت أن تحتل الحياة الفلسطينية بكل تفاصيلها اليومية، وتنتج الموت فيها باستمرار؛ لتجعل النجاة أولى حسابات الذهن الغزوي. وبالرغم من ذلك، سنجد أن القراءة اليومية لغزة تبشرنا ببعض المشاهد التي يسترق فيها أهل القطاع هامشا من زمن حرب الإبادة يصنعون منه الحياة الاجتماعية، ويؤكدون عبره استمرارية المعنى.
أغلب الصور الإعلامية تركز على تدمير الحياة الفلسطينية -في الأغلب بغرض توثيق الانتهاكات الصهيونية- دون التركيز على مناطق المقاومة اليومية الفلسطينية. وخطورة هذا الرصد -وإن كان غرضه التضامن- أنه يُظهر الذات الفلسطينية مهزومة وجسدها ميتا ممزقا، ولا يُظهر على سبيل المثال أن نسبة الزواج قد ازدادت في الشهور الأخيرة من الحرب بالرغم من تصاعد عنفها، حتى اضُطرت المحكمة الشرعية في غزة أن تتخذ من غرف المستشفيات مكاتب لإجراء عملها لتغطية هذه الزيادة[24]. فالصورة الإعلامية -حتى المتعاطفة- يغلب عليها الفلسطينيون الذين يقفون طوابير كي يحصلوا على بعض الغذاء الذي يسد رمق جوعهم، لكنها نادرا ما تُظهِر طوابير عقد القران التي ازدادت هي الأخرى. فشباب وشابات غزة يقاومون سياسات الموت بالدخول في علاقات زوجية تعيد إنتاج الحياة الفلسطينية وتدعم استمراريتها. وأصبحت الخيمة التي كانت ترمز إلى النزوح والتهجير والتدمير، منطقة جديدة للحياة، تشهد على علاقة حب هنا أو زيجة جديدة هناك، وتحوي مناطق مزينة وزغاريد ورقص وغناء، بالإضافة إلى التعليم الذي تحدثنا عنه سابقا.
حاول الفلسطينيون أن يقيموا أعراسهم بأبسط الطرق الممكنة، فانتشرت صور ومقاطع فيديو مصورة تعكس لقطات من أعراس بسيطة تجمع العريس والعروس بزي الزفاف ومن حولهم أقاربهم في سرور وبهجة. يقول أحد العرسان الذي صُور عرسه في أجواء الحرب بمدرسة تأوي نازحين: “رغم الحرب والحصار نحن نحب الحياة والفرح، أقمنا هذا الفرح رغم أن لدينا كثيرا من الألم والشهداء بين أفراد عائلتنا وأصدقائنا”[25]. وهذه الجملة تُعلن فشل سلطة الاحتلال في استلاب الحياة الفلسطينية؛ لأنها بعد كل ما ارتكبته من جرائم، لم تستطع منع الفلسطينيين من ممارسة الحياة والبهجة والعمل على استمرار وجودهم البيولوجي الذي يُرهق المنظومة الاستيطانية العنصرية. كما أن العائلات تُعوض أحيانا صعوبة توفر فستان زفاف للعروس بزي من التراث النسائي الفلسطيني، وهنا يتحول الجسد النسائي الفلسطيني من جسد مهزوم يبحث عن النجاة إلى جسد مقاوم، يُعيد تأكيد وجوده عبر انتزاع أزمنة البهجة من قلب سيولة الدمار، بل وعلى طريقته الخاصة التي تُبرز ثقافته وهويته التي حاولت سلطة الاحتلال أن تدفنهما بشتى الطرق[26].
بالإضافة إلى أن هذه الزيجات -وغيرها من المناسبات الاجتماعية الإنسانية اليومية- تخلق روابط إنسانية جديدة بين ساكني مناطق النزوح الذين ليسوا جميعهم على معرفة سابقة، فهذه المناسبات تفتح مجالا للتهاني والتعارف ومد جسور الروابط الاجتماعية بين أفراد مجتمعات النزوح الذين تعرفوا على بعضهم البعض حديثا، وبالتالي زيادة التضامن والصمود بين الفلسطينيين، وهو ما يعيق سياسة تشتيت الحياة الفلسطينية التي اتبعتها منظومة الاحتلال الإسرائيلية. وتعتبر هذه الزيجات المسروقة من زمن الإبادة مساحة مخلوقة للتعبير عن الهوية الثقافية أيضا سواء على مستوى الشكل أو المضمون، ففيها تُغنى الأهازيج التراثية الخاصة بالأعراس، فيتحول الأمر من مجرد زيجة إلى مساحة للتعبير عن الذات الفلسطينية المتمايزة التي فشلت منظومة الاحتلال الصهيونية في وأدها[27].
تقول صحفية فلسطينية قد عُقد قرانها على زميلها الذي أحبته وهما يوثقان جرائم سلطة الاحتلال في قطاع غزة: “نحن نعيش في زمن يُعدّ فيه الحب مقاومة، فجاء قراري كنوع من القوة والتحدي”،[28] فهنا تغلَّب الإنسان الفلسطيني على سياسات الموت الصهيونية بتحويله منطقة الحرب والدمار -التي من المُعتاد أن تُكرس الإحساس بالخوف واليأس- إلى منطقة إنسانية تتولد منها مشاعر الرغبة في البقاء والمقاومة عبر الحب. وهذا الحب تتمخض عنه زيجة وأطفال وإعادة بناء للحياة المهشمة، فالحياة قد وُلدت من رحم الموت والدمار بشكل جدلي بفعل الممارسات الحياتية بالقطاع. ومثل وهذه المواقف هي التي تعيد تصوير الفلسطينيين باعتبارهم شعبا إنسانيا ضد خطاب نزع الأنسنة الصهيوني الذي يلاحقهم دائما.
وبالرغم من أن سلطة الاحتلال لم ترحم غزة من القصف والموت والحصار حتى في أعيادها، كتكنيك لسياسة احتلال الزمن الفلسطيني؛ فقد انتزع الفلسطينيون حقهم في زمنهم عبر ابتكار أبسط الأعمال التي تجعلهم وأطفالهم يشعرون بفرحة الأعياد. فقامت الأمهات الفلسطينيات بخبز مخبوزات بسيطة في أفران بدائية وقودها الحطب المشتعل؛ ليحملها الأطفال في سرور ببهجة العيد[29].والمصلون أقاموا الشعائر الدينية بإقامة صلاة العيد على أنقاض المساجد المدمرة، وذهبوا لزيارة مقابر الشهداء كممارسة للعادة الاجتماعية المتعارف عليها؛ لتحيتهم وتجديد ذكراهم الدائمة. وقاموا أيضا بصلة الأرحام والتودد بين بعضهم البعض للتهنئة بقدوم العيد. كما حاول الفلسطينيون توزيع العيديات والألعاب البسيطة على الأطفال[30]، والكعك والحلويات على بعضهم البعض. وقد نُفِّذت مبادرات فردية للقيام بهذه المهام وكان يُدبر لها قبل قدوم العيد بشهرين، وهذا التخطيط والتنفيذ يحرر الزمن الفلسطيني من استعماره الكلي ويفتح مساحة للمقاومة عبر نشر بهجة الإحساس بالمناسبة الدينية والاجتماعية وسط ركام الخراب والموت.
كما كانت هناك مبادرات من فريق “سيرك غزة” بإقامة عروضه في مخيمات النزوح لإدخال البهجة على الأطفال والأهالي في ليالي العيد، وحولوا مخيمات النزوح والبيوت المهدمة إلى مسارح لتقديم العروض المرحة والفكاهية، مبتغين رسم الابتسامات على وجوه الأهالي وتعالي ضحكات الأطفال[31]. وهنا تحول مخيم النزوح من مكان محمَّل بالألم إلى مكان مفعم بالمرح. وكذلك سبق الاحتفال بالعيد احتفال بقدوم شهر رمضان المبارك أيضا؛ حيث انتشرت صور ومقاطع فيديو مصورة، تُظهر الأطفال ممسكين بالفوانيس الرمضانية، يأرجحونها في سعادة. وعُلقت الزينة الرمضانية بين خيام النزوح، مضفية على مكان النزوح طابعا جماليا يؤكد الفرحة وحب الحياة بالرغم من ظروف الموت والخراب[32]. كما استُغلت الجدران المهدمة لرسم الجداريات التي تحمل عبارات التهنئة والاحتفال بالشهر الكريم، استوقفني من بينها جدارية رُسمت على أنقاض منزل محطم تحمل عبارة: “رمضان من بين الدمار”[33]، فقد حولت هذه الجدارية الحائط المحطم الذي تدركه الأبصار عادة بوصفه مظهرا للخراب، إلى مصدر للتهنئة والفرحة بقدوم الشهر الفضيل.
* التوثيق الرقمي وأرشفة السردية الذاتية الفلسطينية:
في ظل عالم تتحكم فيه منصات الإعلام الكبرى الموجهة التي تعيد تصوير الواقع بما يخدم أجندتها، لعب الفلسطيني عبر حياته اليومية دورا إعلاميا عالميا بأبسط الأدوات التي يستخدمها يوميا، أبرزها الهاتف المحمول الذي كان يصور بكاميرته ما يتعرض له أهل غزة من سياسات موت صهيونية تُزهق أرواح وتُشوه أجساد مئات من الفلسطينيين يوميا. وهذا الدور هو ما كشف مدى بؤس الواقع الفلسطيني اليومي على كافة الأصعدة الحياتية، وهو أيضا صاحب الفضل الأكبر في التحول الغير مسبوق في الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية؛ حيث إن الشعوب التي كانت مُحاطة بالسرديات العنصرية المزيفة عن الفلسطينيين قد شاهدوا بأم أعينهم هذا الإنسان الفلسطيني المدني المسالم الذي يُقتل بأبشع الوسائل وهو محاصر وجائع ولا يمتلك أي منفذ للحياة بسبب الإحاطة العنصرية الصهيونية.
رأى المفكر الإيطالي أنطونيو نيجيري أن العولمة بأدواتها الاتصالية كما كرست الهيمنة الغربية على العالم، إلا أنها بتذويبها للحدود الفاصلة بين الأمم والشعوب قد فتحت آفاقا أوسع للنضال والتوعية الجماهيرية بقضايا التحرر من الرأسمالية الاستغلالية[34]. وأنا أعتقد أن ما فعله أهل غزة من توثيق للجرائم الصهيونية بتصوير الصور، ومقاطع الفيديو، وتسجيل السجلات الصوتية ونشر القصص اليومية مكتوبة عبر التدوين وكل ما يمكن توثيقه، ونشرها عبر منصات الغرب الرقمية، هو أشبه بمنطق “نيجيري” في استغلال أدوات الهيمنة الاتصالية في المقاومة.
حقا لقد واجه سكان القطاع الحجب والمنع في عرض سرديتهم الحية على منصات الغرب الرقمية بفعل “عنصرة” الخوارزميات التي كانت تحجب العديد من الحقائق عما يحدث في غزة[35]، لكن الواقع خير شاهد أنه بالرغم من ذلك استطاعت المحتويات الحية المنشورة للفظائع اليومية في القطاع أن تُوقظ ضمير قطاعات كبيرة من مختلف الشعوب، بالأخص الغربية التي تعتبر حكومتها الداعم الأول لدولة الاحتلال، وأصبحت المظاهرات الجماهيرية المقموعة في الشوارع الغربية نصرة لأهل غزة أحد أهم القضايا السياسية الداخلية في المجتمعات الغربية، ومن المظاهر التي تعبر عن تناقضات داخلية في هذه المجتمعات أيضا[36]، بل حتى أصبحت القضية الفلسطينية قضية حزبية تُستهلك في الدعاية الانتخابية، وبات هذا واضحا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة. وحدث هذا التحول الجديد من نوعه بعدما كانت القضية الفلسطينية قد خفتت تماما على الأجندة الدولية والإقليمية بعد موجات التطبيع العربي التي كانت آخرها عام ٢٠١٩، والتي كانت ستنتهي بتطبيع المملكة العربية السعودية قبل اندلاع الحرب مباشرة.
قد طور أهل غزة أدوات إعلامية بسيطة لتوثيق انتهاك يومهم المعيشي، من أمثلة ذلك اعتمادهم على قنوات التليجرام؛ التطبيق الروسي الذي لا يفرض قيودا على محتوياتهم التوثيقية مثلما تفعل البرامج التابعة لـ”ميتا”. وأثبتت دراسة أجريت عن دور منصة التليجرام فاعليتها في نشر السردية الفلسطينية المُحطِّمة للزيف الصهيوني، واعتبارها بديلا للمنصات الرقمية التي يسيطر عليها النفوذ الصهيوني[37].
وأهمية هذه الابتكارات هي أنها تمكّن أهل غزة من أرشفة الحياة والموت يوميا وفقا للسردية الفلسطينية الحية التي لا “تُمنتج” ولا يتم العبث بها عبر الخطاب واللغة، بل تعكس الواقع الحاصل في لحظتها كما هو. وفي اعتقادي، يُعيد ذلك للذات الفلسطينية امتلاك الحقيقة وعرضها كمنابر لمقاومة السرديات المؤدلجة التي تبثها مختلف وسائل الإعلام المُمأسسة. وتعيد هذه السردية الذاتية أنسنة الفلسطينيين الذين تحولوا إلى أشياء وأرقام في البرامج التلفزيونية وشرائط الأخبار السريعة؛ حيث إن مقطع الفيديو الذي يصور الشهيد وقصة موته وحزن عائلته من حوله، والقصة المكتوبة التي تُنشر لتحكي المعاناة اليومية وكيفية مقاومتها والتغلب عليها، والصورة التي تعكس تفصيلة معينة في حياة الفلسطينيين في زمن حرب الإبادة، كل هذه وسائل تثبت للعالم أن هذا الفلسطيني إنسان له قصة وحكاية وحياة بشرية، وعنده قوة وصمود أيضا لقدرته على مقاومة سياسات الموت الصهيونية بعد كل ما اقترفته من جرائم تفوق العقل وتضعنا في أزمة لغوية.
وهذا العرض الذي يتم عبر السردية اليومية الفلسطينية مختلف عن عرض المنصات الإعلامية الكبرى -حتى الداعمة للقضية الفلسطينية- في كونه ذا طابع أكثر شمولية، يعكس سياسات الموت ومقاومتها في آن، على عكس الصورة التي نمطتها وسائل الإعلام عن الجسد الفلسطيني المقتول أو المنتظر في الطوابير للحصول على أي شيء، بل هي عرضت بجانب تلك المشاهد، الجسد الفلسطيني المقاوم الذي يصنع الحياة ضد رغبة المنظومة الكولونيالية الصهيونية.
خاتمة:
إذا نظرنا إلى الحياة باعتبارها جزءا من السياسة وإلى الفضاء اليومي بوصفه تمظهرا للكفاح وأشكالا كامنة من المقاومة والصمود كما يقول آصف بيات[38]؛ سنجد أن الحياة اليومية الفلسطينية كما كانت مُخترقة عبر سياسات حياتية صهيونية مكثفة، فإنها كذلك مُعبأة بأشكال عديدة من المقاومة الحياتية والكفاح والصمود، وظهر ذلك في تحليل كيفية تدبير مستلزمات اليوم الفلسطيني من غذاء ودواء وتعليم وصحة، وقبل ذلك في القدرة على البقاء في الأرض أولا. وتجلى ذلك أيضا في كافة أنواع المناسبات الاجتماعية بمختلف أشكالها، السعيدة منها والحزينة، الجماعية والخاصة.
وكذلك تظهر المقاومة في الفضاءات المكانية المادية عبر جماليات الذات، والفضاءات الرقمية أيضا عبر الأرشفة اليومية ونشر السردية الذاتية. فكل تحليلات هذه الورقة تجعلنا ندرك أن الحياة اليومية الفلسطينية تُعيد انتزاعها لنفسها باستمرار من سيطرة المنظومة الكولونيالية الصهيونية، وتعمل أيضا على إنتاج الذات الفلسطينية المقاوِمة المبدعة والصامدة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المساحات من المقاومة تهددت في الأشهر الأخيرة من الحرب بفعل إحكام الحصار وتصاعد وتيرة سياسات الموت الصهيونية التي لم يجد النظام الدولي ولا الإقليمي حدًّا لها.
⁕ باحث في العلوم السياسية.
[1] وزير الدفاع الإسرائيلي: نحارب حيوانات بشرية.. لا كهرباء ولا طعام إلى قطاع غزة، RT، ٩ أكتوبر ٢٠٢٣، تاريخ الاطلاع: ١٤ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/47wM0Xp
* لا يمكن أيضا أن نغفل في هذا الصدد مفهوم السياسة في الرؤية الإسلامية، وهو أسبق من التنظيرات الغربية المشابهة، الذي يؤكد أن السياسة تشمل حياة الإنسان كلها؛ حيث يشير تعريف أحد المفكرين المسلمين إلى أنها تعني: “القيام على الأمر بما يصلحه..
راجع في ذلك على سبيل المثال: سيف الدين عبد الفتاح، مدخل القيم: إطار مرجعي لدراسة العلاقات الدولية في الإسلام، مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1999)، الجزء الثاني.
– سيف الدين عبد الفتاح (إشراف وتحرير)، معجم مفاهيم الوسطية: نموذج لبناء المفاهيم الأساسية من منظور حضاري، مركز الحضارة للدراسات السياسية ومنتدى النهضة والتواصل الحضاري، 2009.
[2] Mattias De Backer, Claske Dijkema, and Kathrin Hörschelmann, Preface: The Everyday Politics of Public Space, Space and Culture, Vol. 22, No. 3, 2019, pp. 243.
[3] أحمد صوان، من النكبة إلى الطوفان.. 77 عاما من مقاومة التهجير في فلسطين، القاهرة الإخبارية، ١٥ مايو ٢٠٢٥، تاريخ الاطلاع: ١٥ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/4hqKREo
* المقصود بالذات الفلسطينية المنكوبة هو لحظة وعي الذات الفلسطينية الحديثة بنفسها في الفترة التي تلت النكبة في عام ١٩٤٨، أي إدراك الذات الفلسطينية لوجودها في محيط القتل والتهجير، وهذا لا يعني أنه لم تكن هناك ذات فلسطينية قبل النكبة، لكننا نجادل بأن النكبة كحدث مؤسس كانت لحظة فارقة في تكوين الهوية السياسية والاجتماعية الفلسطينية المعاصرة؛ حيث تحول بموجبها الشعب الفلسطيني من شعب صاحب أرض إلى شعب منكوب ومشتت، وهو ما أعاد تشكيل وعي الذات الفلسطينية بنفسها في قوالب الفقدان والمقاومة، وهذا ما يفسر بداية تشكيل حركات المقاومة التحررية سواء اليسارية أو الإسلامية لاحقا.
[4] “نموت على أرضنا ولا نسلم لنتنياهو” فلسطيني يتحدى قصف الاحتلال لحي الشجاعية في غزة، قصص رصد، منصة X، ١٠ أبريل ٢٠٢٥، تاريخ الاطلاع: ١٥ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/xaoFs
[5] أمين خلف الله، 12 مخططًا إسرائيليًا أفشلتها عودة النازحين إلى شمال غزة، الجزيرة نت، ٣٠ يناير ٢٠٢٥، تاريخ الاطلاع: ١٦ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/kOjGU
[6] Hamza N. Ibrahim, Two Recipes, One Tradition: Making Musakhan in Gaza Before and After the Genocide, Palestine in America, 30 December 2024, last access in: 17 August 2025, available at: https://linksshortcut.com/IBSjl
[7] Noha Atef, GAZA “WAR RECIPES”: COOKING AS SURVIVAL AND RESISTANCE IN DISPLACEMENT, Hypothesis (The recipes project), 4 May 2025, last access in: 17 August 2025, available at: https://linksshortcut.com/GiIry
[8] Eman Elhaj Ali, Amid Israel’s Starvation Campaign, Palestinian Chef Fights to Preserve Heritage, Truthout, 9 May 2025, last access in: 18 August 2025, available at: https://linksshortcut.com/qLOWl
[9] With famine raging, legume flour is the last line of defence in the battle for survival in Gaza, Palestinian Information Center, 8 May 2025, Last access in: 18 August 2025, available at: https://linksshortcut.com/olQCk
[10] الجوع ألجأ الغزيين لأكل سلاحف البحر، الجزيرة نت، ٢٠ أبريل ٢٠٢٥، تاريخ الاطلاع ١٨ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/CXNQX
[11] Dawoud Abu Elkass, For Gaza students, big ambitions replaced by desperate search for food, Reuters, 12 August 2025, last access in: 19 August 2025, available at: https://linksshortcut.com/hEBud
[12] ساهر الغرة، التعليم في غزة: صفوف دراسية بين الخيام وتجارب الواقع الافتراضي، درج، ٢١ مايو ٢٠٢٤، تاريخ الاطلاع: ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/anhVR
[13] من قلب الخيام.. الغزيون يكافحون لأجل التعليم، المركز الفلسطيني للإعلام، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤، تاريخ الاطلاع: ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/JLQOI
[14] نادر وهبة، مبادرات التعليم الشعبي في غزة: تجارب المعلمين وتحدياتهم، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ٢٠٢٤، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/vbnUH
[15] المصدر السابق.
[16] المصدر السابق.
[17] Gaza’s Health System Near Collapse as UNRWA Warns of “Severe Operational Crisis”, SAFA Press Agency, 5 July 2025, last access in: 23 August 2025, available at: https://linksshortcut.com/Tpyrv
[18] حسين نظير السنوار، المستشفيات الميدانية في غزة: شريان حياة في مواجهة الإبادة، وفا، ٢٦ مايو ٢٠٢٥، تاريخ الاطلاع: ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/kDxOp
[19] شاهد.. طبيب فلسطيني ينهار باكيا بعد وصول جثماني والده وشقيقه إلى المستشفى الذي يعمل فيه، العربي – أخبار، يوتيوب، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣، تاريخ الاطلاع: ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/QOZTP
شاهد.. لحظات مؤثرة لطبيب فلسطيني تفاجأ بوجود إبنه بين الشهداء أثناء عمله في المستشفى، العربي – أخبار، يوتيوب، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣، تاريخ الاطلاع: ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/HjoLL
فيديو مؤلم.. طبيب في غزة يفاجأ بجثث أمه وابنيه في المستشفى، العربية، ٨ نوفمبر ٢٠٢٣، تاريخ الاطلاع: ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/sZZbP
طبيب في غزة يهرع لإنقاذ الجرحى.. فيجد عائلته بين الشهداء، أنيما ويب، يوتيوب، ٢٥ أبريل ٢٠٢٥، تاريخ الاطلاع: ٥ مايو ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/bMREg
[20] لحظة اعتقال الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، BBC News Arabic، يوتيوب، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، تاريخ الاطلاع ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/FlwFZ
[21] “أشبه بالظاهرة”: الأورومتوسطي يوثق أبرز المقابر الجماعية العشوائية في غزة في ظل استمرار الإبادة الجماعية، الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤، تاريخ الاطلاع: ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/cwkeM
[22] ياسر البنا، دُفنوا بعشوائية.. الغزيون يواجهون أزمة قبور للشهداء والمتوفين، الجزيرة نت، ٢٦ يوليو ٢٠٢٤، تاريخ الاطلاع: ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/mcvNE
[23] يسري العكلوك، نقل جثامين الشهداء ينكأ جراح الغزيين ويدفعهم لمواجهة الموت من جديد، الجزيرة نت، ١٨ فبراير ٢٠٢٥، تاريخ الاطلاع: ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/SVAyG
[24] وسام ياسين، طوابير لعقد القران.. شباب غزة يقبلون على الزواج في زمن الحرب، موقع الوديان، ١٤ يناير ٢٠٢٥، تاريخ الاطلاع ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/pqumO
[25] حفل زفاف بسيط يضفي قليلًا من الفرحة في جنوب غزة رغم مرارة الحرب، الشرق الأوسط، ٦ يناير ٢٠٢٤، تاريخ الاطلاع: ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/wdfeI
[26] حميدة أبو هويلة، أعراس الحرب… معركة الثبات على الفرح، ٢٤ فبراير ٢٠٢٤، تاريخ الاطلاع: ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/quXVw
[27] مجد ستوم، زواج في زمن الحرب، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ٢٠٢٤، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/CSArL
[28] يسري العكلوك، أعراس في زمان الحرب.. فتات فرح مؤجل، الجزيرة نت، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤، تاريخ الاطلاع ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/aFlRz
[29] غزة.. عيد بين القصف والكعك وبصيص من الأمل، Sky newsعربية، ٣٠ مارس ٢٠٢٥، تاريخ الاطلاع ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/ikbdq
[30] توزيع الألعاب على الأطفال في العيد في غزة، غيث غزة، يوتيوب، ٣١ مارس ٢٠٢٥، تاريخ الاطلاع: ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/wCxJW
[31] آلاء رجائي، “عيد الفطر: عيد مثقل بالآلام لأيتام غزة”، BBC news عربي، ٩ أبريل ٢٠٢٤، تاريخ الاطلاع ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/Kcrri
[32] في غزة، الأطفال يحتفلون برمضان رغم المأساة والحرمان من كل شيء، الأمم المتحدة، ١٨ مارس ٢٠٢٤، تاريخ الاطلاع: ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/mQAjZ
[33] الغزيون يحتفلون بقدوم رمضان لكنهم يخشون عودة الحرب، الشرق الأوسط، ١ مارس ٢٠٢٥، تاريخ الاطلاع: ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/FkGwv
[34] أنطونيو نيجيري، مايكل هاردت، الإمبراطورية: إمبراطورية العولمة الجديدة، ترجمة: فاضل جتكر، (الرياض، العبيكان، ٢٠٠٢)، ص ٨١ – ٨٦.
[35] لميس الأسطل، الإبادة الرقمية: صحفيو غزة.. بين قصف الاحتلال وخنق الخوارزميات، مجتمع التحقق العربي، ٢٧ يوليو ٢٠٢٥، تاريخ الاطلاع ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/pckwN
[36] Yasmeen Serhan, New Report Details How Pro-Palestinian Protests Are Suppressed in Democratic Countries, Time, 4 December 2024, last access in: 30 August 2025, available at: https://linksshortcut.com/hDUvo
[37] رباب حسين العجماوي، استخدام التليجرام كأداة فاعلة في نشر السردية الفلسطينية ٢٠٢٤م قناة “غزة الآن” نموذجا، مجلة البحوث والدراسات الإعلامية، مجلد ٤، عدد ٣٠، ٢٠٢٤، ص ٥٦٤ – ٦٠٥.
[38] آصف بيات، الحياة كسياسة: كيف يغير بسطاء الناس الشرق الأوسط، ترجمة: أحمد زايد، (القاهرة، المركز القومي للترجمة، ٢٠١٤)، ص ٤٤ – ٦٨.
نشر في العدد 39 من فصلية قضايا ونظرات – أكتوبر 2025