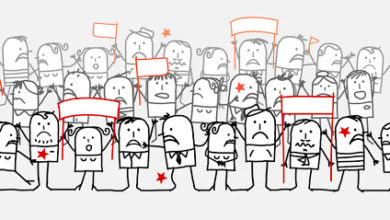الدولة المارقة: الرؤية الأمريكية للعالم بعد أحداث سبتمبر

مقـــدمة
إن التساؤل المبدئي هو هل تعد أحداث سبتمبر حدثًا مفصليًا فاصلًا في الرؤية الأمريكية للعالم؟ بحيث تشكل موضوعًا للتناول والدراسة، فهناك من يرى أن كل شئ قد تغير، وأن عالم ما بعد 11 سبتمبر لم يعد كما هو، وهو رأى سمعناه طوال التاريخ الحديث ابتداء من قيام الحرب العالمية الأولى والثورة الإيرانية وسقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي وحرب الخليج الثانية إلى غير ذلك من الأحداث التي اختلف حول ما. وهناك من يراها مجرد أحداث كان لها ما سبقها، وأنها -إن شئت القول- ساهمت في تعزيز توجه قائم أو رؤية مسبقة وسلوك مستمر للإدارة الأمريكية، بل واتخذتها ذريعة ومبررًا لا يقبل المساومة للتحرك قدمًا نحو خيارات غير مسبوقة، أو لم تكن لتقدم عليها لولا مبررات الحرب ضد الإرهاب، وضرورة الاصطفاف العالمي، واستحضار منظومة من مفاهيم الدفاع عن “الخير” و”الحرية” و”الحضارة” في مواجهة قوى الشر والبربرية، وهى مفاهيم غير قابلة للجدال أو تحديد موقف رافض منها.
إلا أن ما يُجمع عليه الفريقان في الرؤية والتصور هو انتهاء قرنين من الشعور الأمريكي بالأمن المستقر بعيدًا عن نزاعات العالم، والغموض الذي خلفته الأحداث على الرؤية الأمريكية للعالم وعلى توقعات السياسة الخارجية وعلى إدراك العالم للخطر الداهم للقيادة الأمريكية، فهي حملة ضد الإرهاب بلا آليات أو نهاية واضحة، وهى عدوان على كل ما يشكل مصادر الالتزام الدولي بالداخل والخارج: حجم الصدام ورقعته الجغرافية، التغيرات في الأنظمة الحاكمة الحليفة والمعادية، مدى استقرار الاصطفاف العالمي…إلى غير ذلك من الأمور التي ظلت بلا مقدمات متفق عليها، ونتائج شديدة الغموض، وخيارات مفتوحة على كل الاحتمالات.
ويمكننا بداية الإشارة إلى ثلاث مقدمات أولية: تتعلق الأولى بالنهج الانفرادي للإدارة الأمريكية قبل أحداث سبتمبر وطوال شهور السنة الأولى للإدارة الجديدة، وهو ما كان واضحًا في عدم التصديق على بروتوكول كيوتو الخاص بارتفاع درجة حرارة الأرض (مارس 2001)[1]، وفقد الولايات المتحدة لمقعدها في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (مايو)[2]، وتمرير قانون حماية الأفراد العاملين في قوات حفظ السلم من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (مايو)[3]، والإعلان عن نيتها الانسحاب من معاهدة ABM بعد ستة أشهر حسب نصوص الاتفاقية (يونيو) وهو ما تم في 13 ديسمبر[4]، وسحب مشاركة الولايات المتحدة من مفاوضات تطوير ومراقبة الأسلحة البيولوجية (يوليو)[5]، والانسحاب من مؤتمر دوربان لمناهضة العنصرية (سبتمبر).
على حين تتمثل المقدمة الثانية – والتي قد تتعارض مع المقدمة الأولى- في الاصطفاف العالمي خلف الولايات المتحدة بعد الأحداث، حيث لم يعد بإمكان الدول الأخرى – على الأقل بعدها مباشرة- سوى الانضمام القسري إلى جانب الحضارة والخير والتمدين بديلًا عن الشر والبربرية، على حين التحقت بعض الدول بحملة مكافحة الإرهاب لمصلحتها الخاصة كالهند وروسيا والصين، في الوقت الذي تملصت فيه ِِِالطرق والوسائل، وسعت إلى التعاون مع الولايات المتحدة في أكثر من مجال لمحاربة الإرهاب.
والنتيجة الثالثة التي ترتبت على كل ما سبق هي إثارة التساؤل مجددًا لدى الشعب الأمريكي: لماذا يكرهنا العالم إلى هذه الدرجة؟ حيث ساهمت الأحداث في تعزيز ائتلاف عالمي من مشاعر العداء والإدراك العالمي لخطورة التوجهات الأمريكية بعد الأحداث. فإذا كانت النظرية التقليدية للعلاقات الدولية تقوم على توازن القوى، وأن صعود إحدى تلك القوى يرتب ضرورة إيجاد قوة أو تحالف بديل، فقد حدث ذلك على مستوى الأفراد والجماعات والشعوب، فالمشاعر المعادية لأمريكا والمسيرات التي يشهدها العالم لمناهضة العدوان على العراق تشكل نوعًا من توزان القوى غير المسبوق في العلاقات الدولية.
وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة رصد الرؤية الأمريكية للعالم بعد أحداث سبتمبر، وهى رؤية تنطلق من خلفية “التوحد” أو “التفرد” أو “المروق” التي تتبعها الإدارة الأمريكية كأسلوب ونهج في العلاقات الدولية استنادًا إلى كونها القوة العظمى “الوحيدة” أو المتوحدة، والتي تتحمل مهمة غير مسبوقة في “تدبير” وإعادة نَظم العالم على شاكلتها، فالولايات المتحدة – كما يرى البعض وعلى خلاف روما- حاضرة في كل قارة، ضاغطة على كل إقليم، محشورة في كل بلد، بما يعنيه ذلك من دلالات الرؤية والسياسات والاستراتيجيات والآليات[6].
بتعبير آخر، فإن الإدارة الجديدة تشعر بتفردها الكامل وغير المسبوق، وأنها تحمل رؤية ومنظومة من القيم والأخلاقيات التي تسعى إلى تغيير العالم على شاكلتها، لكن مثل هذا التوحد أو التفرد إذا كان يمثل انقلابًا على كل ما تعارفت عليه الجماعة الدولية من مروق عما هو متعارف عليه، وهو اصطلاح تستخدمه الإدارة الأمريكية ذاتها لوصف مجموعة من الدول المعادية لها.
أولًا- مفهوم الدولة المارقة
حيث يعكس مصطلح “Rouge States”، نوعًا من الإدراك القيمي للسياسة الخارجية لإحدى الوحدات في نظرتها إلى الآخر الذي يرفض الامتثال للقواعد والترتيبات التي تفرضها القوى الكبرى في النظام الدولي، فهي وحدات منبوذة تعامل باعتبارها خوارج الجماعة الدولية[7]، فالدول المارقة هي وصف متعدٍ يفترض المروق أو الخروج عن إطار أو نظام ما، فهي تفترض وجود الآخر: النظام، والقيم، والجماعة، وهم خوارج عن قواعد ثابتة، أو ترتيبات تخضع لها باقي الوحدات وتمتثل. وهى كلمة قد تجد أصولها في وصف نوع من السلوك غير المنتظم أو الخاضع للقواعد، أو التصرف الأرعن غير المحسوب، وقد تكون مأخوذة عن فكرة الفيل الهائج خارج السيطرة.
ومن ثم، فإن تعبير “الدول المارقة” لا يعنى الإشارة إلى فئة موضوعية جديدة من الدول، بقدر إشارتها إلى تصور إدراكي لدى صانع القرار نحو بعض الدول التي لا تمتثل لقواعد وقيم الجماعة الدولية، فهي دول تقع خارج النظام الدولي، وإن كانت تسعى إلى تدميره من خلال امتلاك أسلحة الدمار الشامل، و رفض الامتثال للقواعد الدولية.
وما دامت الدول المارقة ليست تعبيرًا عن رؤية موضوعية قدر تعبيرها عن إدراك صانعي القرار الأمريكي، فلا توجد مؤشرات أو معايير متفق عليها لوصف تلك الدول بالمروق أو الخروج، ومن ثم فإن التعريف بها يكون بالمنطق المعكوس، أي أن نحدد ماهية الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة من خوارج الجماعة الدولية، ثم البحث عن المؤشرات والمعايير التي تجمع بين تلك الدول لوصفها بالخروج[8].
فالولايات المتحدة تجمع ما بين العراق وإيران وكوريا الشمالية، وأحيانًا ليبيا والسودان وأفغانستان في مدركها للخوارج، وأن ما قد يجمع بينها حسب تصريحات القيادات الأمريكية هو: امتلاك أسلحة الدمار الشامل، والتورط في الإرهاب الدولي، وأنها تمثل تهديدًا عسكريًا سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، وتحدى القيم الدولية.
بتعبير آخر فإن ما يجمع بين تلك الدول في الرؤية الأمريكية هو السعي إلى حيازة وتطوير أسلحة الدمار الشامل وتكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى، والمساندة الفاعلة أو الرعاية للإرهاب الدولي بما في ذلك استخدام الإرهاب في تقويض عملية السلام في الشرق الأوسط، وتحدى القيم الدولية سواء فيما يتعلق بانتشار تكنولوجيا السلاح أو الجزاءات الدولية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقيم والرموز الدولية.
إلا أن إعادة النظر وتطبيق نفس المعايير على القائمة المعلنة للخوارج، تعنى ضرورة ضم مجموعة أخرى إلى تلك القائمة، فبالنظر إلى حيازة أسلحة الدمار الشامل؛ فإن التحدي الأكبر للاستقرار من خلال نشر أسلحة الدمار الشامل لم يأت من ليبيا أو إيران، وإنما من الهند وباكستان وإسرائيل ثم كوريا الشمالية، والتي لا تمتلك تلك الأسلحة فحسب؛ بل باتت تهدد باستخدامها في سياساتها الدولية، وأن دول الخوارج من حيث تطويرها لإمكانات وبرامج تلك الأسلحة تأتى في مرتبة متأخرة للغاية.
ولأن باكستان والهند قد أصبحتا في عداد الدول النووية؛ فإن السياسات الأمريكية نحوهما قد اختلفت، ورغم سعيها الشكلي إلى فرض عقوبات على الطرفين، إلا أنها كانت حريصة على التأكيد على ضرورة ضم تلك الدول إلى الأسرة الدولية، وعدم خلق خوارج بقدرات نووية[9].
فالاختلاف ما بين سلوك الدول المتهمة بالخروج وبين القائمة الحقيقية للخوارج، يعنى أن الدول المارقة مجرد رؤية إدراكية لصانعي السياسة الخارجية الأمريكية عن مصادر التهديد الأساسية أو المختلقة في النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وأن الرابط الحقيقي الذي يجمع فيما بين تلك الدول هو عدم الامتثال للسياسات الأمريكية، أو كما يعبر عنه صانع القرار بأنه “العداء” للولايات المتحدة[10].
ولذا فإن التناقض ما بين السلوك الفعلي وبين قائمة الخوارج يدفعنا إلى ضرورة الإقرار بأن الخوارج ليسوا فئة من الدول على الإطلاق، وإنما مجرد صورة إدراكية يحتاجها صانعو القرار لتبسيط طبيعة العالم المحيط بهم، وأن ما تتقاسمه إيران وليبيا والعراق وكوريا ليس منظومة واحدة من السلوك الخارجي؛ وإنما الإدراك الشائع لدى صانع القرار، فهي نمط من أنماط رؤية الآخر المستخدم في تحليل العلاقات الدولية.
ويستخدم اقتراب الصورة الإدراكية للحكم على ثلاثة مستويات للسلوك: ما إذا كان الآخر يمثل تهديدًا معاونًا لتحقيق المصلحة القومية، ما إذا كان الآخر المستهدف أعلى/أدنى/ مساويًا في الإمكانات والقدرات، ما إذا كان الآخر أسمى/ أدنى /مماثلًا في القيم والثقافة والتمدين[11].
وتعرف السياسة الأمريكية صورة “العدو”، والتي استخدمت بشكل شائع للتعبير عن الرؤية الأمريكية للاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة. فهي إدراك لعناصر التهديد الذي يشكل نوعًا من المساواة في الإمكانات والقدرات، ومماثل أيضًا في المستوى الثقافي والحضاري، ومن ثم فإن الاستراتيجية الأكثر فاعلية تمثلت في الردع والاحتواء، واستبعاد فكرة المواجهة المباشرة مع خصم لديه تلك الإمكانات.
لكن مع انتهاء الخطر السوفيتي، وظهور قوى إقليمية أخرى تعارض الهيمنة الأمريكية ظهر مدرك جديد عن الدول المارقة، فلم يعد ينظر إلى العراق أو كوريا الشمالية على أنها دول تابعة للاتحاد السوفيتي السابق، وإنما تشكل فئة جديدة متميزة في العلاقات الدولية قائمة على منظومة أخرى من التصورات والمدركات.
وتتشارك صورة “الخوارج” مع صورة “الأعداء” في إدراك التهديد القوى والمباشر بالنظر إلى سعى تلك الدول إلى حيازة أسلحة الدمار الشامل ولدعمها للإرهاب الدولي، بل وقد تصير من المصادر الرئيسية لتهديد السلم والأمن الدوليين، لكنهما يختلفان في المؤشرات الأخرى، حيث تنظر الإدارة الأمريكية إلى الخوارج على أنها أدنى بكثير في القدرات والإمكانات من ناحية، وأحط في المستوى الثقافي والحضاري، فهي وحدات ينقصها احترام الأخلاقيات والمثل، وهى كخوارج لا تلتزم بقيم الجماعة الدولية، بقدر ما تهدف إلى تدميرها.
ولذا تختلف الاستراتيجيات المتبعة نحو الخوارج عن تلك التي اتبعتها في مواجهة الأعداء، ابتداء من فرض العقوبات والجزاءات الاقتصادية، واستهداف زعزعة استقرار الأنظمة الحاكمة والسعي إلى محاولة تغييرها عن طريق القوة المباشرة، مع الدفع إلى تبني اتفاقيات وآليات لمراقبة وضبط أسلحة الدمار الشامل، وانتهاء بتبني مبدأ الضربة الاستباقية ضد تلك الدول التي لا يمكن أن تتبع معها استراتيجية الردع السابقة.
حاصل القول أن التصور ا للدول المارقة، واعتبارها المصدر الأساسي لتهديد الجماعة الدولية ككل – من خلال سعيها إلى حيازة أسلحة الدمار الشامل ومساندة الإرهاب الدولي وعدم الالتزام بقيم الجماعة- كانت تضمن الدعم المطلوب لسياسات متجاوزة لكل الحدود المتعارف عليها في العلاقات الدولية، وهو ما يمكننا تأكيده من خلال تتبع توظيف الإدارات الأمريكية لفكرة الدولة المارقة.
فقبل عام 1980 ظهرت مصطلحات مماثلة من قبيل “Pariah State” و “ Outlaw States” في السياسة الأمريكية لوصف أنظمة بول بوت في كمبوديا أو عيدي أمين في أوغندا أو جنوب أفريقيا، والتي يجمع ما بينها الاعتراض على طبيعة السلوك أو النظام الداخلي لتلك الدول تجاه شعوبها، وليس طبيعة ارتباطاتها وسياساتها الخارجية[12].
ثم ظهر تطور مهم في مفهوم الدولة العاصية ابتداء من عام 1979 حينما ضمنت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن حالة العالم فئة جديدة سمتها “الدول الراعية للإرهاب”، حيث تحولت مؤشرات ومعايير الدولة من السلوك الداخلي إلى السلوك الخارجي مثل إيران وليبيا، والتي أضحت محور السياسة الخارجية في عهد ريجان، واتبعت في مواجهتها مجموعة غير مسبوقة من الإجراءات والعقوبات. على حين أدي انتشار برامج الصواريخ بعيدة المدى لدى الدول غير النووية، واستخدام البعض للأسلحة الكيميائية إلي الأخذ بالمعيار الثاني للدول المارقة ممثلًا في حيازة إحدى دول العالم الثالث لأسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها[13].
إلا أن التطور الحقيقي لمبدأ الدول المارقة إنما حدث بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وحرب الخليج الثانية، خاصة مع تطوير الإدارة الأمريكية لاستراتيجية المقدرة على الدخول في حربين إقليميتين في آن واحد، ومن ثم فإن الاستراتيجية العالمية التي كانت تستهدف مجابهة التهديد السوفيتي تحولت إلى استراتيجية إقليمية تركز على الخطر الناجم عن الدول المارقة.
ولعل بدايات التأصيل الحقيقي للمبدأ قد ظهرت في مجلة “الشئون الخارجية” عام 1994، من حيث تبنى سياسة الاحتواء المزدوج نحو إيران والعراق، وإضافة دول أخرى إلى قائمة الخوارج، وهى ليبيا وكوريا الشمالية وكوبا، حيث ما يجمع بين تلك الدول هو “السباحة ضد تيار التاريخ”[14]
فما يميز الدول المارقة هو السعي إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل، واستخدام الإرهاب كأداة للسياسة الخارجية للدولة و أنها أنظمة تمثل تهديدًا للمصالح الأمريكية الحيوية، ومن ثم فإن وضعها يستند إلى معايير تتصل بالسلوك الخارجي وليس بسياساتها الداخلية، وتصبح مهمة الولايات المتحدة هي السعي إلى إعادة تأهيل تلك الأنظمة – ولو من خلال التغيير والاستبدال- لتصبح عناصر صالحة وفاعلة في الجماعة الدولية.
ذلك على حين شكلت الدول المارقة واحدة من فئات أربع في تقسيم مادلين أولبرايت للعالم ما بعد الحرب الباردة: الدول الصناعية المتقدمة، الديموقراطيات الناشئة حديثًا في شرقي أوروبا، الدول العاجزة والمنهارة في أفريقيا وآسيا، والدول المارقة، وأن الفئة الأخيرة تمثل إحدى التحديات الكبرى التي تواجه الولايات المتحدة، لأن تلك الدول ليس لها من هدف سوى تدمير النظام العالمي[15].
ومن ثم فإن سياسة الدولة المارقة كانت بالأساس استراتيجية تعبئة سياسية اقترنت بمنظومة من الدول بهدف الحصول على الدعم الداخلي والخارجي في الإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة ما تمثله تلك الدول من مخاطر على المصالح الحيوية للولايات المتحدة وعلى النظام العالمي ككل، وهو ما نلاحظه فيما اتخذته من إجراءات من قبيل فرض العقوبات على كوبا في مارس 1996 وعلى إيران وليبيا في أغسطس 1996، بل وفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تتعامل مع تلك الدول، ناهيك عن تطوير نظام الدفاع الصاروخي والاستمرار في التجارب النووية لمواجهة التهديد المحتمل من إيران وكوريا الشمالية.
ولا يخفف من أهمية مبدأ الدول المارقة إسقاط إدارة كلينتون في يونيو 2000 المفهوم من مفرداتها، لأنها من ناحية استبدله بمفهوم مقارب، وإن غلبت عليه السمة الدبلوماسية وهو “الدول المثيرة للقلق” أو “الدول المعنية”، ومن ناحية أخرى أن إدارة بوش قد استعادت المفهوم الأصلي مرة ثانية منذ توليها السلطة في يناير 2001، وربطته بمفهوم “محور الشر”[16].
إلا أن مفهوم الدولة المارقة قد اكتسب أبعادًا جديدة من خلال المقارنة ما بين المعايير التي تحاول الإدارة الأمريكية من خلالها إضفاء سمة الخروج على تلك الدول وما بين السياسة الأمريكية ذاتها، وأن الدولة التي تستحق هذا الوصف في المقام الأول هي الولايات المتحدة، فهي الدولة المارقة بامتياز بحيازتها لكل المؤشرات والمعايير، سواء من خلال امتلاك أسلحة الدمار الشامل واستخدامها ضد الآخرين، أو تشكيلها لمنطق إرهاب الدولة ورعايتها للإرهاب العالمي أو – وهو الأهم- الخروج عن كافة المعايير والقواعد التي تشكل أساس الجماعة الدولية[17]. وهو ما تحاول هذه الدراسة رصده عبر مجموعة من المؤشرات بالتطبيق على الموقف الأمريكي من المحكمة الجنائية الدولية.
مجمل القول: إن “الدولة المارقة” ليست تعبيرًا عن فئة موضوعية قدر تعبيرها عن رؤية إدراكية للولايات المتحدة لمصادر التهديد الأساسية استنادًا إلى امتلاك تلك الدول لمؤشرات محددة، ومن ثم فهي تصلح للتطبيق على الولايات المتحدة ذاتها من خلال:
1. أنها الدولة المارقة بامتياز من خلال حيازتها لكل مؤشرات الدولة المارقة: الحيازة الفعلية لأسلحة الدمار الشامل، الاستخدام الفعلي لتلك الأسلحة في كل مناسبة، الخروج عن كل ما يمثل القواعد والقيم الدولية، رعاية الإرهاب العالمي.
2. أنها تعبير عن صورة إدراكية تمتلكها دول العالم ككل بأن الولايات المتحدة أصبحت مصدرًا للتهديد العالمي وواسع النطاق بشكل متزايد، خاصة بعد أحداث سبتمبر وتبني مبدأ الضربة الاستباقية.
3. التحول من فكرة Rogue State إلى فكرة Rogue Status، بمعنى أنها حولت السلوك المارق إلى مكانة معترف بها في الجماعة الدولية، والاعتراف بحصانة تصرفات الإدارة الأمريكية بالداخل والخارج مهما كانت درجة مصادمتها للقواعد والأعراف الدولية. وهو ما نحاول رصده من خلال الموقف الأمريكي من المحكمة الجنائية الدولية: سعي الولايات المتحدة إلى إجبار العالم على قبول حصانة قياداتها وأفرادها ورعاياها حتى في الجرائم الأشد خطورة على الجماعة الدولية.
وتهتم هذه الدراسة بداية برصد مؤشرات الدولة المارقة عقب أحداث سبتمبر على مرحلتين للتناول والرؤية: المرحلة الأولى- التمهيد للرؤية الأمريكية للعالم بعد أحداث سبتمبر، ورؤية العالم للتهديد الأمريكي من خلال عناصرها الثلاثة: الفشل في التمييز بين الصديق /العدو، و استراتيجيات التعامل (إمكانات التهديد)، والاتجاهات الانفرادية(مجالات السلوك المارق). و المرحلة الثانية- كيفية تحويل السلوك المارق إلى مكانة معترف بها في القانون الدولي من خلال الموقف الأمريكي من المحكمة الجنائية الدولية من خلال ثلاثة أفعال تمثل الرؤية المارقة للولايات المتحدة: قانون حماية أفراد القوات المسلحة بالخارج، وقرار مجلس الأمن رقم 1422 لعام 2002، والاتفاقيات الثنائية التي تعقدها مع أكبر عدد من دول العالم بغية حصانة أفرادها من اختصاص المحكمة.
ثانيًا – مقومات الدولة المارقة: الاستراتيجيات والمجالات والسلوك:
لقد كانت أول رسالة للعالم وجهها بوش في 20 سبتمبر 2001 هي: إما أن تكونوا معنا أو مع الإرهاب، مستخدمًا مفردات تتجاوز الإطار السياسي وتؤكد الانقسام الذي لا يقبل المساومة ولا يترك فرصة واحدة أمام العالم للاختيار، فإما أن تكونوا مع الحضارة والخير (الأنا)، أو مع البربرية والشر (الآخر)، مع التحذير الكافي للأمم التي سوف تسيء الاختيار ما بين الفريقين[18].
وهي مفردات تشكَل الإطار العملي للإدارة الجديدة وتستدعي مفاهيم مرجعية عن التمييز القائم ما بين الخير والشر، وبين الحضارة والبربرية، وبين الصديق والعدو متجاوزة المفهوم التقليدي لكارل شميدت عن مفهوم السياسة، والذي أعيدت صياغته وتوظيفه فيما بعد أحداث سبتمبر [19].
ومنذ أعلن بوش عن مبدئه، أصبح يشكل المفهوم الأساسي للسياسة الخارجية، محولًا بشكل كلى تركيز إدارته، حيث استخدم مبدأ بوش لتسويغ مجموعة من الإجراءات والسوابق بالداخل والخارج- تحت ذريعة الأمن القومي والدفاع عن النفس – لم تعهدها الإدارة الأمريكية حتى في أيام الحرب الباردة، وهى إجراءات أعادت تعريف رؤية أمريكا وعلاقاتها بالعالم، خاصة فيما يتصل بالتمييز الأساسي بين الصديق/ العدو من ناحية، والوسائل والأدوات التي تم انتهاجها في سبيل تأكيد الرؤية من ناحية أخرى[20].
معايير التمييز ما بين الصديق/ العدو
كان لدعوة بوش لشعوب العالم بحتمية الاختيار أثرها المباشر، فتحت دعوة بوش اضطرت باكستان إلى التخلي عن دعمها الطويل لطالبان، وواجهت السعودية حقيقة اتهام عدد كبير من مواطنيها في أحداث سبتمبر، مثلما واجهت غيرها من الدول العربية والإسلامية اتهامات المساندة للإرهاب عن طريق الدعم المادي أو المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية وشبكات التمويل أو التعليم الديني، أو اتهامات العجز والفشل في معالجة مشاكلها الأمنية، والتي سوف تتولاها الولايات المتحدة ولو بغير علم حكومات تلك الدول.
كذلك أعاد خطاب بوش تشكيل علاقات الولايات المتحدة مع القوى الأخرى مثل الصين وروسيا والهند، والتي تواجه كل منها إحياء “إرهابيًا” أصوليًا، واستغلت كل منها الخطاب الأمريكي للتخلص من مشاكلها الداخلية في سينكيانج و الشيشان وكشمير، كما استُغل المبدأ لعزل العراق وإيران وكوريا الشمالية باعتبارها “محور الشر”، حتى ولو لم تكن هناك دولة واحدة في العالم – سوى الولايات المتحدة – تصفهم بهذا، أو حتى وجود علاقات طبيعية بين الدول الثلاث، خاصة مع إعلان الحق الأمريكي في أي ضربة استباقية في أي مكان[21].
وأخيرًا فإن دول حلف الناتو قد لجأت لأول مرة في تاريخها إلى تفعيل المادة الخامسة من الميثاق، والتي تعتبر أن أي اعتداء على إحدى الدول الأطراف هو اعتداء على كافة الدول الأخرى وأن الإرهاب يشكل أحد مصادر التهديد الأساسية، مع استعداد الحلف للدخول في أية مبادرات تستهدف مكافحة الإرهاب بقطع النظر عن المعايير الجغرافية للحلف، الأمر الذي أعاد لمفهوم “الغرب” أبعاده الحقيقية الحضارية والثقافية والاجتماعية وأدى إلى استعادة مفهوم “الشرق” لدلالاته الأولى، بعد أن تم اختزاله بشكل مصطنع طوال الحرب الباردة في “إمبراطورية الشر”[22].
بتعبير آخر فإن الإدارة الأمريكية عقب الأحداث مباشرة فرضت التمييز المبسط الذي لا توجد فيه منطقة رمادية بين الحضارة والبربرية، مع افتراض تمثيل الولايات المتحدة لجانب الحضارة والخير والحرية، فهي حرب “من أجل الحضارة”، وألمانيا ترى أنه “هجوم على الحضارة العالمية جمعاء”، وفى خطاب الاتحاد يدعم بوش إلى ضرورة معرفة ما تخبئه دول من قبيل العراق وإيران وكوريا لأنها “محور الشر” الواجب علينا القضاء عليه. وهكذا أصبح لدينا مجالان متميزان: عالم يزعم نفسه ممثلًا للحضارة يحارب من أجل الخير ضد عالم البرابرة الذي يعمل باسم الشر[23].
والتمييز المقصود بين المجللين قائم على أسلوب الحرب الذي يتبعه كل فريق، وهو التمييز الذي رسمه جون كيجان في مناقشته لنظرية “صدام الحضارات” عقب أحداث سبتمبر، حيث ركز على أن الغرب يقاتل بشجاعة ووجهًا لوجه في معركة قائمة حتى النهاية، وهم يستخدمون الأسلحة المتاحة لكنهم يراعون قواعد وأعراف الحرب، بينما الشرق على العكس تمامًا يرونها نوعًا من اللعبة، يفضلون المراوغة والاختباء والخداع، مسترجعًا الأسلوب الإسلامي للحروب في القرن السابع: الهجوم المفاجئ والقتال والإبادة[24].
وبالرغم من الحرص الدبلوماسي بالتأكيد على أن الحرب ضد الإرهاب ليست حربًا على الإسلام، لكن الحق ما عبر عنه برلسكونى في الإقرار بسمو الحضارة الغربية التي تتكون من نظام قيم يمنح الناس الرخاء العام ويضمن احترام الحقوق والحريات الإنسانية، وهو احترام غير قائم في الأقطار الإسلامية بالنظر إلى غياب النظام القيمى، وأن هجوم سبتمبر هو هجوم على “حضارتنا”، حيث يرى أن هذا الهجوم يقع ضمن التاريخ الطويل ما بين “الغرب” المستنير الخلاق وبين “الشرق” المدمر، لأنه لا يمكن القول بالمساواة ما بين شعوب الصحراء شعوب الزراعة والصناعة[25].
واستدعاء للتمييز القديم ما بين الحضارة والبربرية، لم يكن من الصعب على القادة الأوروبيين وصف القاعدة وطالبان والدول التي تدعمهم (بما فيها الدول التي بها تعليم ديني أو شبكات تمويل على صلة بالإرهاب) على أنها تمثل نوعًا من البرابرة الجدد والأخطر من أسلافهم بما يمتلكونه من أسلحة الدمار الشامل، على حين أن الغرب لا يزال يمثل الشكل المتمدين للحرب النبيلة والفروسية.
ويذهب البعض بهذا التمييز إلى نتيجته المنطقية وهى تحديد المؤشرات والمعايير التي تحدد عضوية جماعة الدول المتمدينة، وكيفية التعامل مع الدول البربرية، حيث يميز دايموند بين العالم المتمدين المكون من الدول والجماعات الحديثة، والتي تمتلك حكمًا مؤسسيًا ونوعًا من فرض احترام السلوك المتدين، فهي مجتمعات تقوم على ثقافة الثقة والاحترام والتسامح والتوفيق، على حين أن العالم غير المتدين من ناحية أخرى هي مجتمعات غير تاريخية، ودول ضعيفة في طريقها إلى الانهيار.
وطبقًا لدايموند فإن هزيمة هؤلاء – القاعدة وطالبان الذين يلاقون الدعم الشعبي والتعاطف السياسي والدول الراعية التي تهدد الدول المتمدينة- يجب أن تتم عن طريق زيادة التدخل الأمريكي في المجتمعات غير التاريخية تلك، فهي قائد الجماعة المتمدينة ومثال الحكومة المشروعة، وعليها التزام قيادة العالم في هذا الطريق، فهي نوع من إعادة الاستعمار للدول العاجزة وغير التاريخية التي تشكل مجالًا لخلايا الإرهاب[26].
وهكذا بدا المشهد العالمي عشية الإعلان الأمريكي عن الرؤية الجديدة للعالم، فالعدو أضحى واضحًا وهو الإرهاب والدول التي تدعم الإرهاب، والصديق أصبح الجماعة الدولية بأسرها، أو بتعبير بوش “التحالف الضروري للأمم المتمدينة”، وإن كانت التطورات اللاحقة قد أثبتت عدم مصداقية مثل هذا التمييز البسيط للصديق والعدو[27].
حيث تلاحقت الأحداث وتجاوزت التبسيط المخل للعلاقات الدولية، لدرجة إقرار عدد كبير من المراقبين بأن السياسة الأمريكية لم يعد يفهمها أحد، فالحرب ضد الإرهاب أصبحت أمرًا خطيرًا ومبهمًا في آن واحد، حيث لم نعد نسمع بعد انتهاء معارك أفغانستان سوى أنباء الحصار والتدمير واعتقال الأشخاص، “وأصبح من المستحيل أن نقرر أننا انتصرنا”[28].
والأكثر أهمية في رؤية هؤلاء أن المفهوم الذي يشكل جوهر محاربة الإرهاب أصبح يطرح بشكل نادر، فالرئيس استمر في استخدام مبدئه لتبرير أية دعوات أخرى للتحالف ضد الإرهاب، لكن ماذا نعنى أصلًا بدلالة “مع” أو “ضد” الإرهاب؟ ما هو التحالف الذي يشارك الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد الإرهاب. فالعدو قد يبدو واضحًا، لكن من يقف إلى جانب أمريكا؟ الأمر الذي يعني الفشل في تحديد ماهية الصديق، و الذي كان بوش يعنيه بالتحالف الضروري للأمم المتمدينة[29].
وذلك لأن بوش عندما كان يتحدث عن ضرورة الدفاع عن التمدين والحضارة، فإن إداراته كانت تستبعد معظم الممارسات الحضارية التي تعترف بها الدول المتمدينة كمعايير للسلوك والفعل، إذ تقيم الشعوب المتمدينة علاقاتها فيما بينها على أساس من التفاهم والاتفاق والمشاورات، خاصة في مواجهة “الآخر” البربري الذي يعتمد على ممارسات تؤكد على التسلط والتفرد في صنع القرار.
فالمباحثات السنوية للسبع الكبار أو لأعضاء الناتو أو منظمة التجارة العالمية تمثل الأساس الاجتماعي للحضارة العالمية، حيث الرغبة في تحقيق الأمن وجني ثمار ومنافع الاقتصاد العالمي، وحيث الدبلوماسية هي اللغة الشائعة، لكن الولايات المتحدة -خاصة بعد أحداث سبتمبر 2001- صارت تنزع نحو التوحد والتفرد بشكل كبير، وصارت أكثر عنادًا في اتخاذ سياسات وإجراءات تغضب منها أقرب الحلفاء، مثلما أضحت أكثر حساسية لأقل انتقاد، معتبرة أية مناقشة حول حرية واشنطون في الفعل يجب أن تعامل على أنها فعل عدائي[30].
فلكي تؤثر على طبيعة المحكمة الجنائية الدولية وانتزاع الحصانة لقواتها العاملة بالخارج من الاتهام، هددت الإدارة الأمريكية بسحب كل دعمها المالي لقوات حفظ السلام، بل وجعلت من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلم في البوسنة والهرسك رهينة إلى أن يوافق مجلس الأمن على طلبها بالحصانة، عن طريق استخدامها لحق النقض لعدم تمديد فترة بقاء البعثة لعام قادم، بدلًا من أن تقوم بسحب قواتها العاملة في هذه البعثة[31].
ورغم الاقتناع الكامل بخطورة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض بفعل غازات الانبعاث –والتي تشكل أمريكا ربع مصادرها المعلنة على الأقل – فإن البيت الأبيض رفض الالتزام ببرتوكول كيوتو الذي استغرق عشر سنوات من التفاوض بين أعضاء الجماعة الدولية، معلنًا أن الولايات المتحدة سوف تتخذ من الإجراءات الداخلية ما يكفل القيام بدورها[32].
وهناك شكاوى متزايدة حتى داخل الإدارة ذاتها من أن الاتجاه “المتوحد” لأمريكا سوف يضر بالتحالف الأوروبي، بل وعندما طبق الناتو لأول مرة في تاريخه عقب أحداث سبتمبر المادة الخامسة من ميثاقه باعتبار الهجوم على أمريكا هجومًا على كل الدول الأعضاء، فإن رامسفيلد صرح بأن هذا ليس ضروريًا، وأن أمريكا لا تلتزم بالحلف، لأن المهمة هي التي سوف تحدد طبيعة التحالف المطلوب[33].
ذلك أن طبيعة العدو المفترض تفرض الحاجة إلى نوع من التضامن من الجماعة الدولية، القائم على اتفاقيات حظر التجارب النووية ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وعلى التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية، وعلى مؤسسات الشرعية الدولية، مثلما يقوم على أساس الرضا المشترك وواسع النطاق حول الديمقراطية والأسواق الحرة وحقوق الإنسان، فهي تستدعي ضرورة قيام السياسة على نظام قيمي وحضاري.
والرئيس الأمريكي ذاته قد اعترف بهذا التحدي، وكما حدد في خطابه في وست بوينت وفى استراتيجية الأمن القومي بأن لدينا أفضل فرصة منذ ظهور الدول القومية في القرن السابع عشر لبناء عالم تتنافس فيه القوى الكبرى بشكل سلمي. لكن المشكلة أنه في ظل تضارب اتجاهات الإدارة الأمريكية ومحاورها ما بين رامسفيلد / ديك تشيني، وبين كولين باول وولفوتز، أصبح الرئيس عاجزًا عن تحديد أي عالم يريد بناءه، وأضحى يتحرك في مساحة واسعة ومتناقضة تبدأ من أقصى درجات الانفرادية وبناء الأمة إلى أقصى درجات التورط الدولي وبناء العالم[34].
حاصل القول أن الحرب ضد الإرهاب هي نوع مختلف من الحرب بكل المقاييس والمعايير، ويتطلب التعامل معها نوعًا من إنعام النظر الجامع ما بين الرؤية والآليات والأدوات، ورغم تصريح الإدارة الأمريكية بأن أصدقاءها في الحرب ضد الإرهاب هم الجماعة الدولية ككل، فإنها – كما صرحت بذلك كوندليزا رايس عام 2000 “تبدأ رؤيتها للعالم وتمييزها ما بين الأصدقاء والأعداء من أرضية ثابتة للمصلحة القومية، وليس عبر الدفاع عن مصلحة ما مفترضة للجماعة الدولية”[35].
استراتيجيات التعامل (الإدراك العالمي للتهديد الأمريكي):
كانت الإدارة الأمريكية قبل أحداث سبتمبر تعتمد في رأى جون ايكنبري في رؤية بناء العالم من حولها على فكرتي الردع والليبرالية، بمعنى بناء نظام عالمي حول الاحتواء والردع وتوازن القوى من ناحية، وعلى الديمقراطية وحقوق الإنسان والأسواق الحرة من ناحية أخرى[36].
حيث أكدت إدارة بوش الأب على أهمية جماعة التحالف الديمقراطي عبر الأطلنطي، وشجعت التكامل في منطقة الهادي – آسيا، وفى كلا الحالتين فإن أمريكا كانت تعطى رؤية إيجابية للتحالف والمشاركة القائمة حول القيم والتقاليد المشتركة والمصلحة الجماعية.كما أن إدارة كلينتون حاولت وصف نظام ما بعد الحرب الباردة بمفردات نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان واقتصاد السوق، وأن الديمقراطية تقدم الأساس القيمى للجماعة العالمية، مثلما تشكل التجارة وتدفق الأموال قوى الإصلاح والتكامل.
وهناك نوع من التكامل والمنطقية في الرؤية الأمريكية للعلاقة ما بين القوة الأمريكية القائمة على الردع، وبين سعيها لنشر التحالف والقيم والرموز، حيث يمكن للولايات المتحدة أن تمارس قوتها، وأن تحقق مصالحها القومية الذاتية، ولكن بطريقة مغلفة بسياج النظام العالمي والجماعة الدولية.
والأمر يتم بصورة أو بشكل نوع من التبادل بين أمريكا والآخرين، فهي تمد حلفاءها بالحماية الأمنية الضرورية، وبحرية الوصول إلى الأسواق الأمريكية، والحصول على التكنولوجيات ضمن اقتصاد عالمي مفتوح، في مقابل التزام الآخرين بالدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي لمواقف الولايات المتحدة الأمريكية في قيادة النظام الدولي في أعقاب الحرب الباردة.
بتعبير آخر فإن الدول الأخرى وافقت على قبول القيادة الأمريكية والعمل ضمن النظام المتفق عليه، في مقابل انفتاح الولايات المتحدة الأمريكية على شركائها من خلال الاتفاقات والارتباطات الثنائية والجماعية، وأن تصبح أمريكا صديقًا للجميع عبر وسائل صنع القرار الجماعي. فالولايات المتحدة جعلت قوتها أمانًا للعالم، في مقابل أن يحيا العالم ضمن النظام الأمريكي.
لكن عددًا كبيرًا من المراقبين لاحظ ملامح استراتيجية جديدة آخذة في التشكل والظهور لأول مرة منذ انتهاء الحرب الباردة، والتي يبدو الدافع الظاهر أو السبب المباشر لها هو الاستجابة المباشرة للإرهاب؛ لكنها تشكل أيضًا رؤية أعمق حول كيفية حفاظ الولايات المتحدة الأمريكية على قوتها واستغلال هذه اللحظة المتفردة لإعادة تشكيل العالم وتحويل سلوكها إلى مكانة دولية معترف بها من قبل الجماعة الدولية [37].
وطبقًا لهذا البرادَيم الجديد، فإن أمريكا أصبحت أقل ارتباطًا بشركائها وبالقواعد والمؤسسات الدولية، بينما تخطو بشكل متسارع نحو لعب دور منفرد وغير متوقع في مكافحة التهديدات الإرهابية والدول المارقة التي تسعى إلى حيازة أسلحة الدمار الشامل، وبهدف إعادة تنظيم وإدارة النظام الدولي[38].
ويمكننا رصد مجموعة من الملامح الأساسية لهذه الاستراتيجية الجديدة من خلال تصريحات الإدارة الأمريكية عقب أحداث سبتمبر في سبع نقاط، والتي شكلت كذلك مصدرًا للشعور العالمي بخطورة السلوك والتوجهات الأمريكية الراهنة:
أولًا- الالتزام بالحفاظ على التفرد المطلق في العالم، بمعنى تنمية القوة الأمريكية بشكل غير مسبوق باعتبارها محور السياسة الأمنية، حيث أكد بوش على أن الولايات المتحدة لن تسعى إلى تحقيق الأمن من خلال الاستراتيجيات التقليدية لتوازن القوى، أو من خلال المؤسسات الجماعية والأسواق الحرة والديمقراطية كما كانت تفعل سابقًا، وإنما سوف تصبح أكثر قوة من كل خصومها. فالهدف بعد انتهاء الحرب الباردة كان يتركز في ضرورة الحصول على قوة غير مسبوقة في التاريخ، لكن ما يجرى الآن هو تحويل تلك القوة إلى مكانة معترف بها كأمر واقع ومقبول تقر بها الدول ككل وتعجز عن التفكير في تحديها[39].
ثانيًا- التحول الجذري في رؤية طبيعة وعناصر ومصادر التهديد العالمي وكيفية التعامل معه، فالتهديدات الراهنة تأتى من جماعات إرهابية صغيرة قد ترعاها الدول الخارجة، والتي قد تحصل على أسلحة نووية وكيمائية وبجيولوجية يمكنها أن تحقق الدمار الشامل، فهي تعانى من تهديد في صميم أمنها الداخلي، وهو تهديد للوجود، بل ربما يشكل التهديد الوحيد للهيمنة الأمريكية.
المشكلة أن هذه الجماعات الإرهابية لا يمكن التعامل معها بمفهوم الردع التقليدي الذي يمنع القوى العظمى من مهاجمة بعضها البعض خوفًا من النتائج المترتبة على ذلك، وهى معضلة عبر عنها رامسفيلد بقوله: “إن التحدي الذي يواجهنا في القرن الجديد تحدٍ مختلف: علينا الدفاع عن أمتنا ضد المجهول، غير المعلوم وغير المتوقع. فهناك جماعات إرهابية لا نعرف عنها شيئًا، ويمكن أن تحوز أسلحة الدمار الشامل، ويمكنها أن تهاجم قلب الولايات المتحدة الأمريكية دون إنذار أو سابق معرفة، وإن هذه هي معضلة الولايات المتحدة[40].
ثالثًا- ويترتب على ذلك انتهاء المفهوم التقليدي للردع، لأن مصدر التهديد الراهن ليس قوة عظمى منافسة يمكن إدارة الصراع معها على أساس المقدرة على الرد؛ أي الضربة النووية الثانية أو الانتقامية. لكنها شبكات إرهابية عبر الحدود وليس لها ثمة مجال إقليمي محدد ومعروف، ولا يمكن ردعها[41].
بتعبير آخر فإن الاستراتيجية التقليدية القائمة على الردع بمعنى القدرة على الرد الانتقامي لم تعد كافية بعد لتحقيق الأمن، وأن الخيار الوحيد هو الضربة الأولى الاستباقية لكل مصادر التهديد وخلايا الإرهاب. فاستخدام القوة يجب أن يكون بشكل استباقي مبدئي لكل التهديدات المحتملة قبل أن تتحول إلى مأساة داخلية، رغم أنها تتعارض مع القواعد الدولية التقليدية حول منع استخدام القوة ومبدأ الدفاع عن النفس، وهو ما تبرره أمريكا بأن غياب الدليل ليس دليلًا على عدم وجود أسلحة الدمار الشامل[42].
وهناك من يذكّر الولايات المتحدة بخطورة مثل هذا المبدأ، خاصة بواقعة ضرب إسرائيل لمفاعل العراق في 1981، والذي أدانته الأمم المتحدة واشتركت الولايات المتحدة ذاتها في الإدانة، ورغم أن إسرائيل – من وجهة نظرهم – كان لديها الدليل على وجود تهديد لأمنها القومي المباشر، فإن فكرة الضربة الوقائية أو الاستباقية لا تستند حتى إلى مثل هذا الدليل أو الافتراض. لأنه حتى في حالة عدم وجود تهديد واضح فإن الولايات المتحدة تدّعى اليوم الحق في الضربة الاستباقية، الأمر الذي يترك العالم دون قواعد واضحة وقاطعة حول استخدام القوة.
رابعًا: ويترتب على ذلك تجاوز عناصر ومصطلحات السيادة، فبسبب أن الجماعات الإرهابية لا يمكن ردعها، فإن الولايات المتحدة يجب أن تكون جاهزة للتدخل في أي وقت في أي مكان في العالم لضرب وتدمير الإرهاب. فإذا كان الإرهابيون لا يحترمون أية حدود فكذلك تفعل الولايات المتحدة وبدون رضا أو حتى علم الدولة المعنية. فضلًا عن أن الدول التي ترعى الإرهاب – سواء بالمساندة أو بالعجز عن فرض اختصاصها الإقليمي بفاعلية – تفقد من ثم حقوقها السيادية.
فكما عبر ريتشارد هاس مدير التخطيط السياسي بالخارجية، أن ما نراه في هذه الإدارة هو بزوغ مذهب جديد، ولست على ثقة بأنه يشكل مذهبًا في السيادة، فالسيادة ترتب التزامات. وأحد هذه الالتزامات ألا تدعم الإرهاب على أي نحو. فإذا فشلت حكومة ما في الوفاء بهذا الالتزام؛ فإنها تفقد بعضًا من الحقوق السيادية، بما في ذلك الحق في أن تترك وشأنها داخل إقليمها، على حين تكتسب حكومات أخرى من بينها الولايات المتحدة الحق في التدخل. وفى حالة الإرهاب يمكن أن يؤدى ذلك إلى حق الدفاع الوقائي، وبطبيعة الحال فإن الولايات المتحدة هي التي سوف تقرر أية دولة يمكن أن تفقد سيادتها[43].
وفكرة تجاوز السيادة تلك فكرة قديمة مارستها الولايات المتحدة ضد دول أمريكا اللاتينية كثيرًا، ومارستها ضد مجموعة كبيرة من دول العالم تحت ستار “التدخل الإنساني”، لكن الجديد في المبدأ الآن هو النطاق العالمي لها من ناحية، وأن الولايات المتحدة تصبح السلطة التي تقرر ما إذا كانت الحكومة قادرة على الوفاء بمتطلبات السيادة أم يجب تجاوزها، وما هي القواعد المتوقع تطبيقها في كل حالة.
خامسًا- التخفيف من الارتباط الأمريكي بالقواعد الدولية وبالمعاهدات متعددة الأطراف والشراكة الأمنية. وهذا الأمر ينبع بالأساس من طبيعة التهديدات ذاتها، لأن فكرة الضربة الاستباقية تتضمن معنى العدوان المتجاوز لمبادئ القانون الدولي، ومن ثم فإن القيم والقواعد والاتفاقات الدولية التي تحرم استخدام القوة، أو المؤسسات والآليات التي تفرض جزاءات على استخدامها بشكل غير مشروع وخارج إطار الدفاع عن النفس، يجب تجاوزها والتحلل منها لأغراض حماية الأمن القومي الأمريكي من ناحية، وعدم ملاحقة قادة وجنود الولايات المتحدة بجرائم العدوان أو الإبادة أو الحرب أو ضد الإنسانية. فالمهمة الحرجة هي القضاء على مصادر التهديد، لكن استراتيجية التوحد تحمل شكًا عميقًا في قيمة الاتفاقات الدولية ذاتها[44].
بتعبير آخر فإن ما يغلب على رؤية الولايات المتحدة عقب أحداث سبتمبر هو أنها لا يجب أن تنسحب من العالم، وفى نفس الوقت لا يجب أن تلتزم بالقواعد الدولية التي تحكمه، ولا بالمؤسسات والمعاهدات الدولية ابتداء من كيوتو إلى المحكمة الجنائية الدولية ومعاهدة الأسلحة البيولوجية، بل إن الولايات المتحدة وقعت مع روسيا اتفاقية رسمية حول تخفيض عدد الرؤوس النووية بناء على إصرار موسكو، لكن إدارة بوش كانت تطلب مجرد اتفاق جنتلمان.
سادسًا- أن الولايات المتحدة مدعوة إلى لعب دور مباشر وغير محدود للاستجابة إلى التهديدات، وهذه القناعة تقوم على افتراض عدم وجود دولة أو تحالف لديه من إمكانات القوة ما يكفل الاستجابة للتهديدات الإرهابية أو للدول المارقة عبر العالم، لكن العمليات المشتركة تحدّ من فاعلية القوات الأمريكية وتقيد حركتها في كسب الحرب بفاعلية. وهو ما عبر عنه رامسفيلد بأن “طبيعة المهمة هي التي تحدد طبيعة التحالف” وليس العكس.
سابعًا- أن الاستراتيجية الجديدة لا تهتم كثيرًا بفكرة الاستقرار العالمي، فإذا كانت الولايات المتحدة قد انسحبت من معاهدة الصواريخ البالستية أو رفضت التصديق على اتفاقيات أخرى، فهذا يعنى أنها تتحرك خارج مفردات الحرب الباردة، وأنها على قناعة بأن انسحابها من هذه المعاهدات لن يقود بالضرورة إلى سباق نووي جديد، كما كان الحال في فترة الحرب الباردة، وإنما تمهد الطريق لتخفيض تدريجي في أسلحة الدمار الشامل لدى روسيا. ومن ثم علينا تجاوز الاتجاهات التقليدية في رؤية طبيعة النظام الدولي، لأن الأمن لن يتحقق عن طريق الحفاظ على الردع وعلى العلاقات الثابتة بين القوى الكبرى، ففي عهد التهديدات غير التقليدية تلك؛ فإن التوازن العالمي للقوى ليس هو المحك الأول في السلم والحرب.
كذلك فإن اتباع النظرية الليبرالية التي تقوم على فتح أبواب العالم أمام التجارة والديمقراطية يمكن أن يكون له تأثير بعيد المدى في مكافحة الإرهاب، لكنها تتجاهل الخطورة الراهنة لهذا التهديد، فالخطر حال وجسيم ولا يمكن مواجهته عن طريق تقوية قواعد ومؤسسات الجماعة الدولية، والتي لن يكون لها سوى قيمة عملية ضئيلة، لأننا لو قبلنا فرضية رامسفيلد السابقة حول أننا لا نعرف ما يجب أن نعرفه، فإن كل شئ عداها يصبح ثانويًا: القواعد الدولية، معايير الشرعية، تقاليد الشراكة، وغيرها من الأطر التقليدية التي تجاوزتها الولايات المتحدة في استراتيجيتها الجديدة.
الاتجاهات الانفرادية (مجالات السلوك المارق)
كما سبق القول، فإن الرؤية الأمريكية للعالم قد تغيرت بشكل كبير بعد أحداث سبتمبر سواء من خلال تعيين ماهية العدو/الصديق (مصادر التهديد الأساسية)، وكيفية التعامل مع المتغيرات التي فرضها تغير محور الرؤية للعلاقة بين الأولويات والمصادر (استراتيجيات التعامل)، وكذلك تغيرت أنماط العلاقات والتفاعلات ومدى الالتزام بالحركة المتفردة أو بالدبلوماسية الجماعية.
حيث صدرت عقب الأحداث مباشرة دعوات إلى الاصطفاف وراء أمريكا، ركزت على أهمية بناء تحالفات دولية ضد الإرهاب، بما أعطى الانطباع الخاطئ بالاتجاه نحو الجماعية في الرؤية والبناء والتحرك[45]، لأن ربط التحالف بالمهمة يجعلها تحالفات مؤقتة (لأن المهمة هي التي سوف تحدد طبيعة التحالف وليس العكس)، ويجب ألا تقيد من حرية واشنطن وخياراتها في الحركة، ولا أن تشكل سابقة خطيرة في السياسات الخارجية، الأمر الذي يجعلها تراوح مكانها بين مناهج السياسة الخارجية[46].
لكن تفهم الإدارة الجديدة ورؤيتها للعالم يفرض علينا التركيز على ثلاث مقدمات:
الأولى- أن خيار الاعتزال لم يعد يشكل بديلًا بعد أحداث سبتمبر 2001، حيث وصل الخطر في إدراك الرأي العام إلى قلب الولايات المتحدة، رغم أن هناك أصواتًا نادت بضرورة اعتزال العالم بعد الهجوم.
الثانية- أن الخلاف الأساسي من ثم يقع على الاختيار ما بين الانفراد أو الجماعية، أو بتعبير أدق على الخط الفاصل بينهما في رؤية العالم وكيفية التعامل مع قضاياه، وأن الخلاف ما بين التوجهين هو اختلاف درجة ما بين مطلق التفرد وتمام الجماعية.
الثالثة- أن التوجه الغالب على الرؤية الأمريكية للعالم هو “التوحد” أو الانفرادية، وأن اختلاف الخيارات هو نوع من التمييز ما بين الانفرادية البحتة Pure Unilateralism وبين الانفرادية الموازية Parallel Unilateralism، فهي إما أن ترفض الارتباط بالمعاهدات والمؤسسات الدولية أصلًا، أو أنها ترتبط بها إلى الدرجة التي تحقق من خلالها مصلحة قومية خاصة، وإلا انسحبت منها[47].
فمن نافلة القول الإشارة إلى تزايد الاهتمام بالتوجهات الجماعية فيما بعد الحرب الباردة، لإعادة بناء النظام العالمي الجديد عن طريق التحالفات، وزيادة الاعتماد على المؤسسات والمنظمات الدولية وعلى القواعد والرموز وعلى الشركاء، حيث كان بإمكان الولايات المتحدة أن تدير شئون العالم ومسائله بشكل أفضل وتكسب شرعية مجددة لأهدافها وأفعالها وتضمن انتشار القيم الليبرالية والأسواق الحرة استنادًا إلى قوى العولمة[48].
لكن هذا التوجه الجماعي كان نظريًا أكثر منه تطبيقيًا، خاصة في مسائل الأمن، وأنها تقيد من حق الولايات المتحدة في الدفاع عن مصالحها بشكل أفضل، وأن آليات الجماعية تنطوي من ثم على قيود غير مقبولة على حريتها في الفعل في الخارج وانتهاك حقوق السيادة في الداخل، فالمؤسسات والآليات الدولية تنطوي غالبًا علي رؤية متعارضة مع المصالح الأمريكية، أو لا تعكس على الإطلاق المبادئ والقيم الأساسية للمجتمع الأمريكي[49].
ويحلو للبعض أن يحدد مجموعة من المصادر الأساسية التي تبرر هذه التوجهات المتفردة للسياسات الأمريكية، منها علي سبيل المثال القوة الأمريكية غير المسبوقة، والثقافة السياسية والمؤسسات الداخلية، حيث القاعدة الحاكمة للسلوك الأمريكي أن التحالفات هي سبيل الضعفاء، وأن الارتباطات الجماعية تعطيهم شعورًا زائفًا بالمساواة في السيادة أكثر من الارتباطات الثنائية التي تقيدها وتعيدها إلى حدودها الفعلية[50].
على حين أن الارتباطات الجماعية تمثل قيودًا علي الدول القوية، وأمريكا دولة تملك خيارات واسعة ابتداء من التفرد المطلق إلى الترتيبات الثنائية إلى التحالفات المؤقتة، مما يمكنها من التخلي عن التشاور وأن تفرض رغباتها وتتكفل بنفقات وأعباء الفعل المنفرد، فضلًا عن حساسية القيادات الأمريكية من سلوك المنظمات الدولية وسعيها إلى تقييد حرية الولايات المتحدة في الدفاع عما تعتبره من مصالحها.
وبالإضافة إلى ذلك هناك الشعور بالاستثنائية وأنهم غير باقي الأمم والشعوب، فضلًا عما تمثله المؤسسات الداخلية من قيود على صنع القرار الخارجي، فهذا الاختصاص المشترك ما بين مؤسستي الرئاسة والكونجرس يعقد من تصديق الداخل على الارتباطات الجماعية بالخارج، خاصة عندما تكون السيطرة على الكونجرس لغير حزب الرئاسة.
ولهذا فإن التوجهات الأمريكية تلك نحو العالم لم تبدأ مع إدارة بوش، ولم تشكل أحداث سبتمبر تغييرًا جذريًا فيها، بقدر ما أكدتها وأعطتها دعمًا وشرعية للمضي نحو خيارات غير مسبوقة لم تكن الإدارة الأمريكية بقادرة على ولوجها لولا الزخم المرتبط بالخوف من التهديدات الإرهابية، والخوف من استخدام أسلحة الدمار الشامل، والذي أحسنت الإدارة الحالية استغلاله وتضخيمه حتى لم يعد هناك من بديل سوى تلك الخيارات غير التقليدية.
ويمكننا الإشارة إلى عدد من المناسبات التي قاومت فيها الولايات المتحدة الارتباطات الجماعية، وأصرت على ضرورة إعفائها من الالتزامات المترتبة عليها، أو انسحبت من معاهدات أو تراجعت بعد التوقيع عليها أو فشلت في الحصول على تصديق الكونجرس، بما يعنى الفشل في الالتزام بالتعهدات الرسمية ورفض الأطر الجماعية للاستجابة للتحديات العالمية بمفردها، أو السعي إلى فرض ومد قانونها الداخلي على نطاق عالمي، الأمر الذي يؤكد فكرة المروق عن الجماعة الدولية.
ففيما يتعلق بالتسلح، فقد اختارت الإدارة الأمريكية ألا تنضم إلى غالبية دول الجماعة الدولية في التصديق على معاهدة أوتاوا حول استخدام الألغام الأرضية في ديسمبر 1997، وفى يوليو2001 لم تبقَ سوى أمريكا في معارضتها لاتفاقيات الأسلحة الخفيفة، وفى عام 1997 صدّق الكونجرس على اتفاقية الأسلحة البيولوجية ولكن بعد أن ضمّنها مجموعة من التحفظات التي لا تتفق مع أغراض وأهداف المعاهدة.
وفى إبريل 2002 وصل عدد الدول الموقّعة على الاتفاقية الأخيرة إلى 162 دولة والمصدقة إلى 144 دولة، ومن ثم محاولة وضع بروتوكول لمراقبة مدى التزام الدول بالاتفاقية منذ المؤتمر الرابع عام 1996، حيث ساندت الدول إنشاء مجموعة عمل لوضع مشروع البروتوكول، والتي قدمت مشروعها في مارس 2001 من 30 مادة وثلاثة ملاحق، واقترحت في المادة16 إنشاء آلية لمراقبة منع الأسلحة البيولوجية ومطالبة الدول بتقديم تقارير دورية عن مدى الالتزام بالمعاهدة.
ولهذا انتقدت الولايات المتحدة المشروع في 25 يوليو، باعتبار أن تلك الآلية ضارة بالولايات المتحدة وشركاتها الخاصة وتعرض بيانات الأمن القومي للخطر، فهي تضر ببرامج الدفاع ضد الأسلحة البيولوجية وبالملكية الفكرية للصناعات الدوائية والحيوية، وأن البرتوكول المقترح لا يمنع أيًا من الدول المارقة من امتلاك أسلحة بجيولوجية.
وأخيرًا وفى 7 ديسمبر وفى اليوم الأخير للمؤتمر الخامس اقترحت الولايات المتحدة بشكل غير متوقع تعليق مفاوضات مشروع البروتوكول لأنه لن يمنع الدول المارقة من حيازة أسلحة الدمار الشامل، واقترحت عقد اجتماعات سنوية بدءًا من نوفمبر 2002 لمرجعة التطور في التزام الدول بالإجراءات الجديدة[51].
كما أنها عارضت في عام 1999 الالتزام بمعاهدات حظر التجارب النووية وتبنت نظام الدفاع الصاروخي، بالرغم من القناعة التامة بأن هذا البرنامج يمثل انتهاكًا لاتفاقية الصواريخ الباليستية عام 1972 وأنه يهدد العالم بسباق نووي جديد، ثم انسحبت من الاتفاقية الأخيرة ذاتها في ديسمبر 2001، وبدأ الجدال حول ما إذا كان من الأفضل للولايات المتحدة الانسحاب من كل معاهدات ضبط التسلح.
إذ استندت الإدارة الأمريكية إلى نص المادة 15/2 من الاتفاقية التي تعطى لأي من الطرفين الحق في الانسحاب منها إذا كانت هناك ظروفًا غير عادية تتصل بموضوع المعاهدة وتتعارض مع مصالحها العليا، ذريعة للانسحاب من المعاهدة.
وحسب المذكرة الرسمية التي أرسلت إلى كل من روسيا و بيلاروسيا وأوكرانيا وكازاخستان في 13 ديسمبر 2001، فإنه منذ دخول المعاهدة حيز النفاذ عام 1972، امتلكت دول عديدة أو سعت إلى حيازة أسلحة الدمار الشامل، وأن البعض منها يعد العدة لاستخدامها ضد أراضى الولايات المتحدة، فضلًا عن تطوير برامج صواريخ بعيدة المدى، وهى أحداث تنبئ بتهديد مباشر وبضرر للمصالح العليا.
ونتيجة لذلك فإن الولايات المتحدة قد رأت ضرورة تطوير واختبار ونشر نظام دفاعي مضاد للصواريخ للدفاع عن إقليمها وعن قواتها خارج الوطن وعن أصدقائها وحلفائها، وهو ما يخالف جوهر المعاهدة، ولذا وبالنظر إلى الأحداث غير العادية والتي لها صلة بموضوع المعاهدة وتضر بالمصالح العليا، فإنها تمارس حقها في الانسحاب منها طبقًا للمادة 15/2[52].
وتمثل العلاقات المضطربة مع الأمم المتحدة بعدًا آخر لهذه التوجهات الأمريكية، والتي تنزع دائمًا إلى التهديد بسحب حصة الولايات المتحدة في ميزانية المنظمة كوسيلة للتهديد أو العقاب، بل ويرفض الكونجرس احترام المبدأ المستقر في العلاقات الدولية بأن الالتزام بتلك الحصص يشكل التزامًا قانونيًا على الولايات المتحدة، فبدأت في تقليص أو سحب التزاماتها السنوية في جهد متفرد بغرض إصلاح الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة [53].
ثم بدأت في الانسحاب من عمليات حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة، لأنها تقيد من خيارات الولايات المتحدة في الحركة، حيث تبنت في الأعوام الأخيرة توجهات انتقائية نحو المشاركة فيها، في نفس الوقت الذي لا تشعر معه بالحاجة إلى موافقة مجلس الأمن على استخدامها لقواتها في العلاقات الدولية، وقد تمثل تلك الأفعال نوعًا من الضرورة الإستراتيجية، لكنها بالتعبير الصحيح انسحاب من الشرعية الدولية للأمم المتحدة[54].
ولأنها الدولة الكبرى الوحيدة في العالم، التي تسعى إلى حماية ودعم حقوق الإنسان، فإن المصلحة الأساسية والجوهرية للولايات المتحدة هي في حكم القانون ونشر حقوق الإنسان عبر العالم، إلا أنها ترفض بعناد شديد أن تلزم نفسها باتفاقيات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، أو تخضع للأجهزة والآليات التابعة لتلك المعاهدات والاتفاقات، رغم إصرارها على إخضاع الآخرين لها.
ذلك أن سجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان يوضح الإعجاب العميق بالإنجازات التي يعكسها الدستور ووثيقة الحقوق، وعدم الرغبة في إخضاع الممارسات الأمريكية لرقابة أية آلية دولية، والتخوف من أن قبول أية معايير دولية لحقوق الإنسان – خاصة بعد التوقيع على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري – يعني الإضرار بجوهر الهوية الأمريكية، وأن هذا لا يتعارض مع أية سياسات تدخلية بالخارج بغية تأكيد التزام الآخرين بالمعايير المتعارف عليها لحقوق الإنسان[55].
بتعبير آخر فإن ما يبرر عدم توقيع الولايات المتحدة على معظم اتفاقيات حقوق الإنسان أو التراجع عن التصديق عليها أو التأخر الكبير في هذا الإجراء أو التصديق بتحفظات جمة تتعارض مع أهداف وأغراض الاتفاقيات هو أن هذه المعاهدات قد تحرم الأمريكيين- بشكل كلى أو جزئي – من حقوق وضمانات دستورية من قبيل الحق في إبداء الرأي والمحاكمة عن طريق المحلفين، أو أنها يمكن أن تضر بالتوازن الدقيق والحرج بين حقوق الولايات والحكومة الفيدرالية بمنح سلطات واختصاصات إضافية للحكومة الفيدرالية خاصة تلك المعاهدات التي لا تحتاج إلى تصديق لاحق.
كما أن تلك المعاهدات قد تضر بسيادة الولايات المتحدة وخلق مجال لانتقاد ممارساتها وسياساتها على الصعيد العالمي، وأن بعضها قد يتعارض مع السياسات الاقتصادية والمشروعات الاحتكارية وتشجع الشيوعية والاشتراكية[56].
ولهذا فإنها تحرص على تضمين أربعة تحفظات أساسية على كل ما تصدق عليه من معاهدات: أن الولايات المتحدة لن تلتزم بأية اتفاقية تتعارض مع الدستور، أنها لن تقبل اختصاص محكمة العدل الدولية فيما يتصل بتفسير أي منها، أنها لا تعتبرها ذاتية النفاذ وإنما تحتاج إلى التشريع اللاحق، وأنها لن تلتزم بأية بنود قد تخل بالتوازن القائم بين الحكومة الفيدرالية والولايات.
والمثال على ذلك هو العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والذي صدّقت عليه الولايات المتحدة في إبريل 1992 بعد 17 عامًا من دخوله حيز النفاذ و27 عامًا من تبني الجمعية العامة للعهد، وأدخلت فيه مجموعة من التحفظات، وبالرغم من أن عددًا كبيرًا من الدول قد انتقدت بشكل رسمي التحفظات الأمريكية، فإن لجنة حقوق الإنسان لم تناقش الآثار المترتبة على ذلك، وهو الأمر الذي يُطرح في كل مناسبة تبدى فيها الولايات المتحدة عدم التزامها بالمعاهدة[57].
ناهيك عن عدم الارتباط بالأجهزة والآليات القانونية والقضائية الدولية أو أن تلتزم بما يصدر عنها من قرارات لا تتفق والمصلحة الأمريكية، وأشهرها على الإطلاق الموقف من قضية نيكاراجوا في محكمة العدل الدولية، حيث سارعت الإدارة الأمريكية – فور علمها بإمكان تقدم نيكارجوا بشكوى للمحكمة عن الأفعال العدوانية ضدها – إلى إبلاغ المحكمة بتعديل قبولها للاختصاص الإلزامي لعام 1946، وأنها لن تلتزم بقرارات المحكمة لمدة عامين في أية نزاعات مع إحدى دول أمريكا الوسطى، وعندما رفضت المحكمة أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من الإجراءات مدعية أن قبول اختصاص المحكمة يشكل تهديدًا للأمن الأمريكي[58].
وإذا كانت للاتفاقيات الدولية فائدة خاصة في مسائل الخير العام أو المرافق الدولية العامة، فإن الولايات المتحدة ترفض الالتزام ببرتوكول كيوتو في مارس 2001 بعيدًا عن مشاركة 178 دولة في البرتوكول[59]، وهو الأمر الذي يمكننا ملاحظته في قضايا التجارة الدولية، والتي قد تعطي انطباعًا خاطئًا بتوجهات جماعية للإدارة الأمريكية، على حين أنها شاركت في بناء تلك المنظمات بشكل انتقائي من ناحية، ولقدرتها على تشكيل الأجندة الخاصة بها ورعاية سيادتها وتعظيم المنافع من ورائها من ناحية أخرى [60].
وهكذا نلاحظ أنه من قانون البحار[61] إلى بروتوكول كيوتو، ومن اتفاقيات التنوع البيولوجي إلي قانون تطبيق الجزاءات علي الشركات الأجنبية[62]، ومن انتقاد الدعوات إلى إصلاح البنك والصندوق الدوليين إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، فإن التوجهات الانفرادية هي التي تسود الرؤية الأمريكية للعالم.
وهو ما عبرت عنه لجنة الأمن القومي برئاسة جيرى هارت ووارين روومان، والتي ترى أن ظهور قوي جديدة – سواء بشكل مفرد أو تحالفات – سوف يحد من خيارات الولايات المتحدة بشكل متزايد على المستويات الإقليمية والعالمية، ولهذا يجب تطوير مؤسسات وآليات جماعية بالقدر الذي يقيد من سياسات تلك القوى أو التحالفات الأخرى وتمدنا بإطار عالمي للتعاون في مواجهة التهديدات التي لا يمكن للولايات المتحدة أن تواجهها في كل مكان.
إلا أن هذا لا يعني – ولا يجب أن يعني بأي درجة- أن الجماعية خيار دائم، فهي قد تكون مجرد آلية لتحقيق المصالح الأمريكية، و تلتزم بها طالما حققت الغاية منها، وإلا فإنها تعود إلي الانفرادية المطلقة في الرؤية والفعل والحركة وهو ما يدفع البعض إلى وضع مجموعة من القواعد التي تحكم الرؤية الأمريكية للعالم ما بين الانفرادية المطلقة والانفرادية الموازية أو قواعد السلوك المارق[63]، ومنها على سبيل المثال:
1- لا يجب التخلي عن الفعل المنفرد في الحالات التي تنطوي على مصلحة حيوية للولايات المتحدة، بالرغم من إمكان الحصول على الدعم والمشروعية.
2- الدولية لهذا الفعل، ففي الحرب ضد الإرهاب؛ علينا أن نفعل ذلك وحدنا، لكن التحالفات قد تعني مزيدًا من الدعم والمشروعية، فيجب الحذر من الدخول في ترتيبات جماعية قد تؤثر – بأي درجة حاليًا أو مستقبلًا- على قدراتنا على تكريس السلم في مناطق حيوية، لأن المصالح الأمريكية- استنادًا للدور العالمي لها- تختلف نوعيًا عن مصالح الدول الأخرى التي لديها اهتمامات محدودة.
3- فاتفاقية تحظر استخدام الألغام الأرضية قد يسهل على الدول الأخرى التوقيع عليها، لأنه ليس لديها ما تخشاه، لكن تلك الألغام هي التي تمنع اجتياح أراضى كوريا الجنوبية، والدور العالمي للقوات الأمريكية قد يتعارض مع الالتزام بالمحكمة الجنائية الدولية ما لم تكن هناك ضمانات بالإعفاء من اختصاصها، كما أن على الولايات المتحدة أن تعارض أية مبادرات جماعية تتعارض مع القيم ومع أسلوب الحياة الأمريكي أو تقيد من حريتها، من قبيل وضع نظام عالمي جديد لتدفق المعلومات أو نظام عالمي اقتصادي جديد أو معاهدات حقوق الإنسان والتي قد تتعارض جميعها مع خيارات الليبرالية والسوق المفتوحة وحرية التعبير عن الرأي.
4- يجب التذكير وإقناع العالم بأن آليات التفرد تلك قد تساهم في تحقيق المصلحة الجماعية أو الخير العام العالمي، فالجزاءات التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول التي لا تلتزم بمعايير حرية التجارة على سبيل المثال يجبر تلك الدول على السلوك الصحيح المتفق وقواعد منظمة التجارة العالمية، والسعي إلى تغيير الأنظمة الحاكمة في الدول المارقة يحقق مصلحة حيوية وعاجلة للجماعة الدولية.
5- أن الجماعية هي مسألة جوهرية في القضايا التي لا يمكن إدارتها أو التعامل معها بدون مساندة الدول الأخرى، لكن يجب وضع إطار متوازن وصحيح لهذا التعاون، فبصدد التغييرات المناخية التي يتهم خصوم الولايات المتحدة بأنها مصدر لربع غازات الانبعاث، لكنهم في اتهامهم يتجاهلون أن ثلاثة أرباع تلك الغازات تنبعث من خارج الولايات المتحدة.
ثالثًا: مؤشرات المكانة المارقة (المحكمة الجنائية الدولية)
إن النتيجة التي انتهى إليها الكثيرون هي أن إدارة بوش راحت تتبنى رؤية جديدة للسياسة الخارجية مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد خاضعة للقانون الدولي العام[64]. وقد حظي الموقف الأمريكي من المحكمة الجنائية الدولية بدراسات كثيرة، تناولت طبيعة الاعتراضات الأمريكية على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة، والنتائج المترتبة على ذلك، واعتبار هذا الموقف من أفضل دراسات الحالة لرصد طبيعة السياسة الخارجية الأمريكية[65].
حقيقة، فإن اهتمام الإدارة الأمريكية كان يركز على التهديدات بإمكان اتهام الأفراد التابعين لها بالرغم من أن أمريكا ذاتها ليست عضوًا في نظام روما. لكن خلف هذا التركيز وما استتبعه من ضغوط على مجلس الأمن وتمرير تشريعات تجيز اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والمناسبة لفك أسر أي أمريكي يخضع لاختصاص المحكمة، يكمن الاعتقاد برغبة الدولة العاصية المتمردة على كافة القواعد والتقاليد التي تحكم الجماعة الدولية إلى التحول إلى مكانة مقبولة من تلك الجماعة ففي يوليو 1998 حينما وقعت 120 دولة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، عملت الولايات المتحدة بقوة على كسب التأييد لإشراف الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن على الحالات التي ستحقق فيها المحكمة وتقاضى، ثم لم توقع عليها لأنها ستتمتع بالصلاحية القضائية على الرعايا الأمريكيين المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في أقاليم الدول التي صادقت عليها.
ولهذا سعت الولايات المتحدة إلى التوقيع على النظام الأساسي في 31 ديسمبر 2000 بالرغم من استمرار التحفظات الأمريكية، حيث أكد كلينتون على أن هذا التوقيع سوف يسمح للولايات المتحدة بالتأثير على تشكيل المحكمة وقواعد الإجراءات والأدلة، ومحاولة إدراج إعفاء لمواطنيها في الوثائق التكميلية، والتي قوبلت بالرفض، مما حدا بالرئيس كلينتون إلى التصريح بأنه لن يصدق على المعاهدة.
وتتلخص الاعتراضات الأمريكية على المحكمة الجنائية فيما يلي:
1- التعارض مع القانون الدولي، بمعنى أن إطار اختصاص المحكمة يتعارض مع المبادئ الأساسية للسيادة والقانون الدولي للمعاهدات، حيث يسمح للمحكمة بممارسة اختصاصها على رعايا دول ليست طرفًا في الاتفاقية. أي أنها تسمح بممارسة الاختصاص على الأفراد الذين يرتكبون جرائم على إقليم دولة عضو بالاتفاقية، حتى ولو كانوا رعايا لدولة لم تصدق عليها. ومن ثم فإن القوات الأمريكية العاملة بالخارج على إقليم دولة عضو يمكن أن يخضعوا لاختصاص المحكمة بالرغم من أن الولايات المتحدة ليست عضوًا بها[66].
2- استقلال المدعي العام وسلطته التقديرية: بمعنى أن قانون روما لا يوفر الإشراف الملائم على المحكمة وعلى المدعى العام، من قبل مجلس الأمن الدولي أو أي كيان آخر منتخب بطريقة ديمقراطية. فقد أوجدت المعاهدة مدعيًا عامًا يمكنه توجيه أي اتهام، لكنه لا يتحمل مسئولية أمام أي دولة أو مؤسسة غير المحكمة ذاتها، الأمر الذي يفتح الباب لإمكان قيام تحقيقات أو توجيه اتهامات لدوافع وأغراض سياسية.
3- ضم جريمة العدوان إلى اختصاص المحكمة، وهى جريمة لم يتم الاتفاق على تعريفها بعد حيث لم يستطع مندوبو الدول التوصل إلى تعريف موضوعي ومقبول للعدوان، وتم تأجيل الاتفاق عليه لسبع سنوات قادمة، الأمر الذي يهدد بتقويض دور ومسئوليات مجلس الأمن، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. ولهذا اقترحت الولايات المتحدة ضرورة الربط ما بين قرار مجلس الأمن بتكييف أعمال العدوان وبين قدرة المحكمة على اتهام الأفراد بارتكاب جريمة العدوان.
4- عدم وجود فترة زمنية للإعفاء من اختصاص المحكمة، وهو انتقاد يمثل اهتمام السياسة العامة بالمجهول، بمعنى مدى عدالة وكفاءة المحكمة في الممارسة والعمل، والهدف من وجود هذا الإعفاء الوقتي للدول غير الأعضاء هو إعطاء الدولة فرصة اختبار مدى كفاءة وفعالية أو خطورة أداء المحكمة قبل أن تقبل باختصاصها. وهو شرط غير موجود في النظام الأساسي، وإن كان عدم الاتفاق على تعريف موضوعي للعدوان يمثل إعفاءً لسبع سنوات.
وفى حقيقة الأمر فإن الدول التي ترتكب أشد الجرائم خطورة هي التي تخشى من المساءلة اللاحقة عن السلوك المعاقب عليه، إذ يقتصر اختصاص المحكمة – بموجب م 5/1 – على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، فللمحكمة بموجب النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية: جريمة الإبادة الجماعية – الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.
ولهذا فلا مجال لاعتراض البعض بأن الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة هي جرائم جديدة ولا يوجد لها أساس في القانون الدولي العرفي، وأنها تمثل نوعًا من الاتهام من قبل الأكاديميين والمنظمات غير الحكومية ضد العسكريين، لأنه يمكننا أن نجد في محاكمات نورمبرج ومعاهدة الإبادة العنصرية واتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول والثاني أمثلة لهذه الجرائم التي شاركت الولايات المتحدة في صياغة مشروعها ثم لم تصدق عليها أصلًا أو بعد مرور زمن طويل، خاصة أن النظام الأساسي للمحكمة يعرف بشكل دقيق وموضوعي ماهية الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة (م6 – م8)، ولعدم الاتفاق على التعريف الموضوعي فقد تركت جريمة العدوان لاتفاق لاحق بموجب م5/2.
كذلك لا مجال للقول بأن الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة هي جرائم غامضة جدًا، لأنها نفس الجرائم التي تطلب الولايات المتحدة من قواتها ضرورة الامتناع عن ارتكابها، فهي من ثم جرائم محددة تمامًا في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ونجدها كذلك في الوثائق العسكرية التي تطبقها المحاكم داخل الولايات المتحدة وحول العالم لسنوات. لكن ما أثار قلق الولايات المتحدة هو تجريم العدوان على أهداف عسكرية بشكل يمثل ضررًا غير متناسب للأفراد المدنيين، وأن هذا المعيار قد يكون شخصيًا أمام أية محكمة دولية.
أما الاعتراض بأن المحكمة يمكنها ممارسة اختصاصها رغم عدم رضا وموافقة الدولة التابع إليها الفرد، فيمكن الرد عليه بأن اختصاص المحكمة الدولية هو اختصاص لاحق للاختصاص الجنائي للدولة، وأن الدولة يمكنها وقف أو استبعاد اختصاص المحكمة إذا قامت بواجباتها في الاتهام والمحاكمة. وهو أمر تشعر الولايات المتحدة بعدم الارتياح إليه، خاصة فيما يتعلق بمعيار الحكم على أداء الدولة لاختصاصها الجنائي في الاتهام والمحاكمة[67].
على أن الفهم العميق لاعتراضات الولايات المتحدة على ميثاق المحكمة يظهر من خلال سياساتها وقواتها العاملة بالخارج. ففضلًا عن إمكانية تعرض أفراد القوات الأمريكية للاتهام، فإن نظام روما ينشئ خطرًا بأن الرئيس وغيره من القيادات الأمريكية يمكن أن يتعرضوا لاتهام المحكمة بارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية، خاصة لو قامت اللجنة التحضيرية للمحكمة بصياغة مفهوم محدد لجريمة العدوان.
بتعبير آخر فإن القيادة الأمريكية تتعرض لخطر الاتهام بارتكاب العدوان عن القرارات ذات الصلة بالأمن القومي أو المسائل التي تتعلق بالاستجابة للإرهاب أو مبدأ بوش عن الحرب الاستباقية ضد أسلحة الدمار الشامل.
ومنها على سبيل المثال قصف السودان في 20 أغسطس 1998 وتحت مبرر حق الدفاع عن النفس، فلو كانت السودان عضوًا بالمحكمة لأمكنها اتهام الولايات المتحدة بجرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية، لأن الجريمة وقعت على إقليمها واستهدفت أهدافًا مدنية بالأساس (مصنع الشفاء للأدوية)، وهو ما يعطى للمحكمة اختصاصها طبقًا للمادتين 12 – 13 لو كانت دخلت حيز النفاذ في ذلك الوقت.
خاصة أن شعور الولايات المتحدة بمشروعية القصف والتدمير إنما يعنى أنها لم تجر أية تحقيقات، أو اتهامات لاحقة حول استهداف أهداف مدنية بالأساس، الأمر الذي يعطى للمدّعي العام للمحكمة الحق في بدء الإجراءات لتقاعس الدولة المعنية عن اتخاذ تلك الإجراءات بالتحري والاتهام والإدانة.
كذلك الأمر لو كانت المحكمة الجنائية في حيز النفاذ حين استهدف حلف الناتو المصانع ومحطات الكهرباء والماء والتليفزيون وسائر الأهداف المدنية في يوغوسلافيا تحت ذريعة الاستخدام المشترك، خاصة لعدم وجود تبرير قانوني واضح لاستخدام القوة ضمن عمليات التدخل الإنساني، وفى إقرار محكمة يوغوسلافيا لمحاكمة مجرمي الحرب بأن الناتو قد ارتكب أفعالًا تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وإن لم ترق إلى جرائم الحرب.
على حين يظل الأمر ماثلًا في اتهام القوات الأمريكية بارتكاب جرائم الإبادة وضد الإنسانية والعدوان في حالة العراق، الأمر الذي يخضعهم لاختصاص المحكمة بمجرد انضمام العراق إلى نظام روما ووقوع الجرائم تلك على إقليمه، وعدم الحاجة إلى إثبات تقاعس الولايات المتحدة عن ممارسة اختصاصها في الاتهام والإدانة.
وهى تلجأ إلى مسوغات لا تصلح مبررًا لموقفها المعادى للمحكمة، فلا يمكن ادعاء المسئولية الفريدة لأمريكا عن حماية السلم والأمن الدولي مبررًا لارتكاب جرائم حرب، فضلًا عن أن القوات الأمريكية ليست هي الوحيدة الموجودة في مناطق حرب خطيرة، و إنما هي مجرد جزء صغير من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، و التي يتوقع من جنودها الالتزام بالمعايير العالمية.
وأحيانًا تشير إدارة بوش إلى سوء استخدام جريمة العدوان، و التي لو وافقت أغلبية أعضاء المحكمة على تعريف لها، فإن المحكمة يمكنها إقامة اختصاصها عليها بعد سبع سنوات، حيث ترى واشنطن أن هذه السلطة يمكن أن تسيس وتصادر اختصاص مجلس الأمن الدولي في إعلان أعمال العدوان. وذلك بالرغم من أن م 5/2 تشترط أن أي تعريف للعدوان يجب أن يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، ومن ثم يخضع لدور مجلس الأمن والذي يمكن للولايات المتحدة في إطاره الاعتراض على أي توصيف غير مناسب لفعل العدوان.
وأخيرًا فإن إدارة بوش تستند إلى مسوغات إنسانية لتبرير عدم الانضمام وضرورة الحصول على ضمانات إعفاء القوات الأمريكية المشاركة في حفظ السلم والأمن الدوليين، بأن البنتاجون سوف يتقاعس عن نجدة الشعوب و الأقليات التي في حاجة للتدخل خوفًا من الاتهامات غير المشروعة للقوات الأمريكية، لكن البنتاجون لم يفكر مرتين في الاتهام في قصف البوسنة وكوسوفو، حتى لو كان هذا سوف يمثل خطر اتهام القوات الأمريكية أمام محكمة يوغوسلافيا.
حاصل القول: إن إدارة بوش لا يهمها سوى المصلحة القومية، ولن تخاطر بتحكيم خارجي على أفعالها كدأب كل الإدارات السابقة، ولأنه لا يوجد أي مفهوم حديث للعدالة يسمح لهذه السلطات الاستثنائية بالتهرب من الاتهام، فإن وجهة نظر الإدارة تمثل عدوانًا على قواعد القانون والعلاقات الدولية”[68].
فالدولة المارقة اتخذت في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وبغية التهرب من تبعاتها سياسات جديرة بالملاحظة والاعتبار لدلالتها العميقة على الرؤية الأمريكية للعالم بعد أحداث سبتمبر، وفى تحويل سلوكها إلى مكانة تعترف بها الجماعة الدولية ولو قسرًا، والتي تمثلت في ثلاث مسائل أساسية:
المسألة الأولى – دعم قانون حماية أفراد القوات المسلحة الأمريكية الذي يمنع التعاون مع المحكمة الجنائية، ويعطي للولايات المتحدة حق قطع المعونات العسكرية عن الدول الأعضاء في قانون روما، ويخول الإدارة سلطة استخدام كافة الوسائل الضرورية لإعادة أي شخص تعتقله المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وهو القانون المعروف بقانون غزو لاهاي.
المسألة الثانية – ممارسة الضغوط على مجلس الأمن بمناسبة تجديد بعثة حفظ السلم في البوسنة، للمطالبة بإعفاء القوات التابعة للأمم المتحدة، والتي تنتسب إلى دول ليست أطرافًا في نظام روما الأساسي من الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.
المسألة الثالثة – عقد اتفاقيات ثنائية مع عدد كبير من الدول تقتضي عدم تسليم رعايا الولايات المتحدة الأمريكية أو نقلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وهى أمور تعكس بحق نظرة الإدارة الحالية إلى مكانة الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقاتها بالعالم، وتطويعًا لعدد كبير من النصوص القانونية التي لا تستجيب لرغبة الدولة المارقة، خاصة أنها لجأت إلى نصوص نظام روما الأساسي الذي رفضت الانضمام إليه لمشروعية رغباتها بالحصانة.
قانون حماية أفراد القوات الأمريكية بالخارج[69]
إن البدايات الحقيقية لهذا القانون هي تخوف الولايات المتحدة الأمريكية من اختصاص المحكمة، وهو أمر ممتد إلى كافة المؤسسات والآليات الدولية التي يمكن أن تشكل قيدًا على المغامرات العسكرية الأمريكية بالخارج؛ حيث يرى البعض أن أسباب هذا التخوف تعود إلى:
1. أن محكمة العدل الدولية قد أصبحت ذات طبيعة سياسية غالبة في قراراتها بالنظر إلى أن اختيار قضاتها يتم عن طريق الجمعية العامة التي أصبحت مسيسة كذلك، فالأجهزة الأساسية للأمم المتحدة غالبًا ما تجد نفسها مسيسة أكثر من الأجهزة ذات الطابع السياسي. وأنه بمجرد تعيين القضاة فإنهم يتصرفون حسب خلفياتهم الحضارية والسياسية على عكس ما هو متوقع منهم.
2. أن محكمة يوغوسلافيا في تحقيقاتها حول مدى ارتكاب حلف الناتو لجرائم حرب في كوسوفو 1999، كانت تتبنى استراتيجية إظهار أن المحكمة ليست ضد الصرب، على حين أن الوحدات الأقل الأخرى قد تم شغلها من قبل دول معادية للولايات المتحدة، ومنها على سبيل المثال طرد الولايات المتحدة الأمريكية من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مايو 2001 ومكتب مكافحة المخدرات وحلت مكانها دول مثل إيران والبرازيل وبيرو والهند، واضطرار الولايات المتحدة من الانسحاب إلى مؤتمر دوربان[70].
وفى أغسطس 2002 وقع بوش قانون حماية أفراد القوات الأمريكية الذي يحدد طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين المحكمة الدولية، حيث أوضح أن الهدف من هذا القانون هو أن القوات متعددة الجنسيات العاملة في دولة ما عضو في اتفاقية روما يمكنها أن تطلب اختصاص المحكمة حتى لو كانت الدولة التي يتبعها هؤلاء الأفراد لم تنضم إلى الاتفاقية[71].
وهكذا فإن الاتفاقية قد تنشئ ترتيبات يمكن أن تخضع القوات الأمريكية العاملة في الخارج لاختصاص المحكمة حتى لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية غير منضمة إليها، وهذا لا يتعارض فقط مع القانون الدولي للمعاهدات، وإنما قد يؤثر على قدرة أمريكا على استخدام قواتها للوفاء بمتطلبات والتزامات حلفائها، أو المشاركة في عمليات حفظ السلام بما فيها التدخل الإنساني لإنقاذ أرواح المدنيين.
فالهدف من القانون هو منع التعاون مع المحكمة الدولية بعدد كبير من الوسائل؛ حيث يحظر القسم 2004 من هذا القانون على أية محكمة أمريكية أو ولاية أو حكومة محلية أو وكالاتها أو الحكومة الفيدرالية تسليم أي مواطن أمريكي إلى المحكمة، أو السماح بإجراء أية تحقيقات للمحكمة على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، ومنع نقل أية معلومات ذات صلة بالأمن القومي إلى المحكمة.
على حين يمنح القسم 2011 للرئيس سلطة التعاون مع المحكمة حالة بحالة ودون تفويض من الكونجرس، على أن يقوم بإبلاغ الكونجرس في حدود 15 يومًا بكل حالة على حدة، ويسمح القسم 2015 للولايات المتحدة بالتعاون فيما يتصل باتهام أفراد أجانب، إذ لا يوجد ما سوف يمنع الولايات المتحدة من تقديم المساعدة إلى الجهود الدولية لاستقدام صدام حسين وأسامة بن لادن وأعضاء القيادة والجهاد أو أي أجانب متهمين بارتكاب جرائم إلى عدالة المحكمة.
أما القسم 2005 فهو يسعى إلى تنظيم تعاون الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة وباقي الدول الأخرى لحماية أفرادها من اختصاص المحكمة، حيث يحظر مشاركة أمريكا في بعثات حفظ السلام ما لم يقرر الرئيس:
أ- أن مجلس الأمن قد أعفى قوات الولايات المتحدة من اختصاص المحكمة الدولية بموجب السلطات المخولة للمجلس.
ب- أن المحكمة ليس لها اختصاص جنائي فيما يتعلق بأقاليم الدول التي يتم نشر أفراد القوات الأمريكية على أراضيها.
ت- أن الدول التي يتم نشر القوات الأمريكية على أراضيها قد دخلت في اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة بالموافقة على عدم تقديم أفراد القوات الأمريكية إلى المحكمة.
وابتداء من أول يوليو 2003 فإن القسم 2007 سوف يمنع المعونات العسكرية الأمريكية عن الدول التي صدقت على اتفاقية المحكمة ما لم:
1. يستثن الرئيس دولة ما لأغراض المصلحة القومية الأمريكية.
2. تدخل الدولة في اتفاقية ثنائية توافق فيها على عدم تقديم أفراد القوات الأمريكية إلى اختصاص المحكمة.
3. تكن إحدى دول الناتو أو حليف كبير من غير الناتو (مصر واستراليا وإسرائيل واليابان) أو كوريا.
لكن القسم الأكثر إثارة للجدل هو القسم 2008 الذي يخول الرئيس سلطة اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والمناسبة لتخليص الأفراد المذكورين في القسم (2) من القانون من الاتهام أو السجن عن طريق أو بناء على طلب المحكمة الدولية. وهؤلاء الأفراد هم: أفراد القوات الأمريكية والحلفاء أو الأفراد الذين يتم اتهامهم أو اعتقالهم لأفعال رسمية عندما كانوا ضمن تلك القوات، وهو الشرط المعروف بغزو لاهاي والذي أثار جدلًا كبيرًا في أوساط الحلفاء.
وبناء على ذلك أرسلت السفارة الأمريكية في لاهاي بيانًا ذكرت فيه أننا لا يمكننا أن نحدد بدقة ماهية الظروف التي قد تحتاج فيها الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ فعل عسكري ضد هولندا أو أي حليف آخر بالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين دول حلف الناتو.
على حين رأت هولندا أن القانون الجديد الذي يشار إليه بأنه قانون غزو لاهاي غير مقبول، وبالرغم من أننا لا نعتبر أن الغزو الأمريكي لهولندا هو تهديد مباشر، فإن اللغة التي صيغت بها عبارات القسم كانت غير مقبولة.
وفى مقابل السعي بكافة الوسائل إلى فك أسر أفراد القوات الأمريكية أو حلفائها المتهمين بارتكاب أشد الجرائم خطورة على الجماعة الدولية، ترفض الإدارة الأمريكية بإصرار الاعتراف بوضع أسرى الحرب لمعتقلي القيادة وطالبان في جوانتنامو[72].
حيث أكدت الإدارة الأمريكية في 18 يناير 2002 عدم إمكان تطبيق اتفاقية جنيف الثالثة على أسرى حرب أفغانستان في جوانتنامو، استنادًا إلى أن أفغانستان لم تكن بالدولة الفاعلة في الحرب وأن الطالبان لم يعترف بهم كحكومة رسمية، ثم تراجعت في 7 فبراير معلنة أن اتفاقية جنيف الثالثة يمكن أن تطبق على أسرى طالبان دون القاعدة؛ بسبب أنه كان هناك نزاع مسلح بين طرفين عضوين بالاتفاقية، ولكن بالنظر إلى انتهاك طالبان لقوانين الحرب ولصلاتهم الوثيقة بالقاعدة يجب حرمانهم من وضع أسرى الحرب.
بتعبير آخر، فإن بوش حدد أن اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى والتي تشارك أفغانستان والولايات المتحدة بها، تنطبق على النزاع المسلح بين طالبان وأمريكا، على حين أن الاتفاقية لا تنطبق على النزاع المسلح في أفغانستان أو في أي مكان آخر بين القاعدة وأمريكا، لكن ليس لأي من أسرى طالبان أو القاعدة وضع أسرى الحرب طبقًا للاتفاقية، وإن كانوا سوف يعاملون بموجب المبادئ الإنسانية العامة للاتفاقية[73].
ويلاحظ أن الولايات المتحدة لم تنشر أي دفاع قانوني عن هذا الآراء، ولا يمكننا أن نفهم أسباب قرار بوش بعدم كفالة وضع الأسرى لطالبان، حيث أعلن المتحدث الرسمي أنه طبقًا للمادة الرابعة من اتفاقية جنيف فإن طالبان ليس لهم وضع أسرى الحرب، لأن الوصف يرتبط بضرورة أن يقودها شخص مسئول، وأن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد، وأن تحمل الأسلحة بشكل ظاهر، وأن تلتزم في عملياتها بقوانين وأعراف الحرب.
وبالطبع فإنه كان يلخص مضمون الفقرة (أ) 2 من هذه المادة التي تتعامل مع “أفراد المليشيا الأخرى والوحدات المتطوعة بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المسلحة “، متجاهلًا الإشارة إلى الفقرة الأولي من نفس المادة التي تتعامل مع “أفراد القوات المسلحة لأحد طرفي النزاع أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءًا من هذه القوات المسلحة “، فهل أعضاء طالبان ليسوا بأعضاء في القوات المسلحة لأحد الطرفين أو على الأقل جزءًا من الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءًا منها؟
ولهذا تشكلت مجموعة من رجال الدين والأساتذة والمحامين، وتقدمت بدعوى أمام محكمة كاليفورنيا الفيدرالية في 20 يناير 2002، نيابة عن معتقلي جوانتنامو، والتي رفضت الدعوى استنادًا إلى عدم وجود صلة بين أصحاب الدعوى والمعتقلين، وأن مكان الاعتقال يقع خارج الاختصاص الإقليمي للمحكمة، وأنها لا يمكنها أن تحيل الدعوى إلى أية محكمة فيدرالية أخرى، وهو ما أكدت عليه محكمة الاستئناف [74].
وقامت المحكمة بالاستناد إلى حكم المحكمة العليا الشهير في عام 1950، حول عدم اختصاص المحاكم المدنية على السلطات العسكرية في التعامل مع الأعداء خارج الاختصاص الإقليمي، لأن المعتقلين في جوانتنامو لهم نفس وضع تلك القضية، فهم أجانب وأعداء محاربون، أسروا خلال الحرب خارج الولايات المتحدة وهم الآن خارجها أيضًا، وأنهم منذ أسرهم تحت السلطة المطلقة للعسكريين، وأنها تعكس ضرورات عملية لها صلة بالأمن القومي يجعل من غير المناسب لأي محكمة مدنية أن تتخذ سابقة خطيرة بإعطائهم مثل هذا الحق في المحاكمة[75].
ومن ثم فإن القضية ما إذا كان أسرى جوانتنامو يمكنهم أن يقيموا الاختصاص أمام أي محكمة يعتمد -ليس على طبيعة ادعائهم- وإنما على ما إذا كانت قاعدة جوانتنامو البحرية تحت سيادة الولايات المتحدة أم لا، فأصحاب الدعوى يرون أن المعتقلين الآن ضمن الاختصاص الإقليمي للولايات المتحدة، وبالتالي لهم الحق في المحاكمة، لكن هناك فارق كبير ما بين السيادة وبين الاختصاص الإقليمي، وأن المحكمة قد رأت أن قاعدة جوانتنامو خاضعة لسيادة كوبا وإن مارست عليها الولايات المتحدة كامل اختصاصها وسيطرتها، طبقًا لمعاهدة عام 1903 بين الطرفين.
قرار رقم 1422 في 12 يوليو 2002
ثم كان على الإدارة الأمريكية ضرورة الحصول على ضمانات بعدم الاتهام من قبل المحكمة، ففي رأى وزارة الخارجية أن أشد مؤيدي المحكمة على قناعة بأن بعض البلاد سوف تتردد في المشاركة في عمليات حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة، إذا تعرض أفرادها لخطر اتهامهم من قبل المحكمة لأفعال تتعلق بمهام البعثة، وأن حل تلك المسألة يكمن في قرار دولي من مجلس الأمن عند إنشاء قوات حفظ السلم بإعفاء القوات المشاركة من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأن الولايات المتحدة سوف ترفض المشاركة في أية عمليات لحفظ السلم مستقبلًا إذا رفض مجلس الأمن تقديم مثل هذه الضمانات للقوات الأمريكية[76].
وفى هذا المقام، واستغلالًا لقرار مجلس الأمن رقم 1357 لعام 2001، فإن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلم في البوسنة والهرسك سوف تنتهي في 21 يونيو 2002 مع قيام الرغبة في تجديد مهام البعثة، كما حدث بشكل دوري منذ عام 1996. ولكن نظرًا لتغير الظروف، فيجب على الإدارة أن تسعى للحصول على الحصانة الدائمة من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للقوات الأمريكية المشاركة في البعثة، وكذلك الحصول على الحصانة الدائمة من اختصاص محكمة يوغوسلافيا، خاصة في ضوء قرار الأخيرة بالتحقيق في مدى ارتكاب حلف الناتو جرائم حرب في عمليات كوسوفو[77].
ويجب ألا يعتبر مثل هذا الطلب من قبل الولايات المتحدة أمرًا غير مقبول، لأن اتفاقيات دايتون ذاتها – التي شكلت الأساس القانوني لإنشاء بعثة حفظ السلم هناك- نصت على إعفاء الأفراد المشاركين من الاختصاص الجنائي لمحاكم البوسنة والهرسك، ولأن البوسنة في طريقها إلى التصديق على نظام روما، ومن ثم إمكان طلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فيبدو من المعقول أيضًا أن نطلب من مجلس الأمن ضمانة الإعفاء من اختصاص محكمة يوغوسلافيا الدولية، قياسًا على الشرط الموجود في اتفاقيات دايتون عن اختصاص محاكم البوسنة.
ولهذا تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية في 17 مايو بهذا الاقتراح لمجلس الأمن للحصول على ضمانة حماية أفرادها في بعثة حفظ السلام في تيمور الشرقية، كجزء من استراتيجية أوسع لضمان الحصانة في كل عمليات حفظ السلم، وهو الاقتراح الذي لاقى عدم موافقة سائر أعضاء المجلس، بعدها مارست الولايات المتحدة ضغوطها بالتهديد بالانسحاب من تيمور الشرقية.
وفى أول يوليو استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ثلاث مرات في مجلس الأمن ضد قرار بتمديد عمل قوات حفظ السلم في البوسنة لدفع باقي الأعضاء للموافقة على طلبها بإعفاء جنودها المشاركين في تلك القوات من المحاكمة، وهو تاريخ بدء نفاذ نظام روما الأساسي. وقد وضع الطلب الأمريكي بالحصانة واشنطن في مواجهة حلفائها داخل المجلس، حيث أن الدول الأوروبية الأربع بالمجلس هي فرنسا وبريطانيا وايرلندا والنرويج قد صادقت بالفعل على معاهدة روما، وأبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها إذا وافقت على منح حصانة للأمريكيين في بعثات حفظ السلام فإنها ستكون بذلك قد انتهكت التزاماتها.
وهكذا استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لمنع تجديد بعثة حفظ السلم في البوسنة، بدلًا من أن تنسحب من تلك القوة، وأنها معنية بتلك المسألة للغاية لأنها تخص حماية الأمريكيين الذين يخدمون في شتى أنحاء العالم، وأن إدارة بوش تساورها الشكوك بأن المحكمة تشكل خطرًا على الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها العاملة في حفظ السلام.
ويعلق باول على الموقف الأمريكي بأن بلاده تُتهم ظلمًا بالتفرد في كل مرة تتخذ موقفًا مختلفًا عن موقف أصدقائها وحلفائها. ففي كل مرة تفعل شيئًا ليس متناغمًا مع الآخرين تُتهم بالتفرد، و هذا اتهام يستطيع أيًا مَن كان أن يوجهه لنا، كل مرة نفعل شيئًا مختلفًا عما تعتبره الدول الثماني عشرة الأخرى في حلف الناتو أو الدول الأربع عشرة في الاتحاد الأوروبي، الشيء الأفضل الذي يتعين القيام به.
ومن أجل التوصل إلى تسوية اقترحت الولايات المتحدة على المجلس استخدام الضمانات الواردة في المادة 16 من نظام روما، والتي تنص على أنه لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو اتهام بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهرًا بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابق من الميثاق، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها.
حيث رأت الولايات المتحدة أنه يمكن لمجلس الأمن – طبقًا للمادة السابقة – أن يطلب من المحكمة عدم إجراء تحقيق أو اتهام لقوات حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة من الدول التي لم تصدق على معاهدة روما. وأنه يمكن تجديد ذلك بشكل تلقائي ما لم يعترض عليه أحد الأعضاء الدائمين بالمجلس.
وهى صيغة تخالف مضمون المادة 16 والتي تفترض عدم التجديد التلقائي، وعلى أن يتم التجديد بشكل صريح سنويًا، وتحت الانتقادات العنيفة من باقي أعضاء المجلس سحبت الولايات المتحدة اقتراحها بالتجديد التلقائي، وقبلت إعفاءًا من اختصاص المحكمة قابل للتجديد لمدة عام واحد.
وفى 12 يوليو 2002 أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1422، عملًا بموجب الفصل السابع من الميثاق يطلب – بناء على م 16 – من المحكمة الجنائية الدولية إرجاء أي تحقيقٍ أو اتهامٍ يتعلق بأفراد ينتمون إلى دولة ليست طرفًا في النظام الأساسي (حيث لم يقتصر القرار على القوات الأمريكية فحسب)، وتشارك في عمليات ينفذها مجلس الأمن أو يأذن بها لمدة 12 شهرًا تبدأ من أول يوليو 2002، ويعتزم تجديد هذا القرار سنويًا تحت نفس الشروط، طالما استمرت الحاجة إليه[78].
ولهذا فقد أثبتت تطورات الأحداث أن مادة 16 من النظام الأساسي تعد من أخطر مواد الاتفاقية وأكثرها حساسية من ناحية، وأشدها استخدامًا ضد المقصود منها من ناحية ثانية، لأنها تتعلق بالمواقف التي تختص بسلطة مجلس الأمن في وقف بدء التحقيق أو الاتهام من قبل المدعي العام، الأمر الذي كان له أثره الكبير والسلبي على اختصاصات المحكمة على عكس المقصود منها.
حيث نلاحظ من خلال مشروعات المادة السابقة أن الهدف منها هو إنقاص سلطات المجلس عبر المادة ذاتها، ولهذا خضعت لمجموعة من التوازنات التي انحرفت بها كثيرًا عن المشروع الذي قدمته لجنة القانون الدولي عام 1994، حيث كان نص المادة 23/3 من هذا المشروع يتضمن عدم اختصاص المحكمة بالاتهام الناجم عن موقف يخضع لتقييم المجلس على أنه يمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين أو عملًا من أعمال العدوان طبقًا للفصل السابع من الميثاق[79].
وقد عارض عدد كبير من المفوضين نص المادة على أساس احتمال تدخل المجلس في اختصاصات المحكمة والتأثير على أدائها لمهامها باستقلال، وأن المحكمة يمكن أن تحرم من ممارسة اختصاصها في موقف بعينه إذا استمر تحت نظر المجلس لفترة غير محددة، وأن استخدام أحد الأعضاء الدائمين لحق النقض قد يحرم المحكمة من اختصاصها، ويخضعها للدوافع السياسية التي تحكم غالبًا قرارات المجلس.
ولهذا سعت الدول إلى التوفيق ما بين المشروع الأصلي وما بين سلطات المجلس فيما يعرف باقتراح سنغافورة، والتي اقترحت في لجنة الإعداد في أغسطس 1997 تعديل العلاقة بين المجلس والمحكمة، وهو الاقتراح الذي أصبح أساس المشروع الثاني للمادة 23/3. حيث تضمن الاقتراح عدم بدء الاتهام أو التحقيق في مواقف تحت نظر المجلس بموجب الفصل السابع للميثاق، ومن ثم فإن للمحكمة أن تباشر اختصاصها بالتحقيق والاتهام ما لم يقرر المجلس رسميًا – وبموافقة 9 أعضاء وضمن الفصل السابع- وقف هذه الإجراءات من قبل المحكمة[80].
وبالتالي فإن وقف اختصاص المحكمة كان يهدف إلى عدم التدخل القضائي على نحو قد يضر بترتيبات المجلس في المسائل التي يعتبرها تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وأن إجراءات المحكمة لا يمكن وقفها إلا بجهد متضافر من أعضاء المجلس بأغلبية 9 أعضاء، فضلًا عن اقتراح كندا أن يكون تعليق اختصاص المحكمة لمدة 12 شهرًا.
بتعبير آخر فإن الهدف من المادة 16 هو تأكيد استمرار قيام المحكمة بإجراءات الاتهام والتحقيق، ما لم يقرر المجلس أن التدخل القضائي أو التهديد به يمكن أن يضر بجهود المجلس لتحقيق السلم والأمن الدوليين، أو في التعامل الفاعل مع أعمال العدوان.
لكن نظام روما لم يحدد لنا ماهية التحقيق أو الاتهام وماهية الفرق بينهما، وهناك غموض في صياغة المادة فيما يتعلق ببدء التحقيق أو الاتهام، وحول سلطات المجلس في تعليق اختصاصات المحكمة، وحول التجديد وعدد المرات، وحول مدى رقابة المحكمة على مشروعية استناد المجلس إلى الفصل السابع من الميثاق لمنع المحكمة من ممارسة اختصاصاتها، وحول مدى إمكان استناد المدعي العام إلى نص المادة 53 في عدم الأخذ بتعليق المجلس لاختصاصات المحكمة، وحول المدة التي يظل فيها موقف ما تحت نظر المجلس وبما لا يعنى المماطلة في استعادة المحكمة لاختصاصها في هذا الموقف[81].
ولهذا عكست الصياغة الأخيرة لنص المادة الأخذ بالاعتبارات السياسية وأولويتها على الاعتبارات القانونية، وأن سلطة المجلس في تعليق اختصاص المحكمة إنما تؤكد الدور الحاسم للمجلس في التعامل مع المواقف التي تتعارض فيها اعتبارات الأمن والعدالة، وأن مادة 16 تمنح المجلس فرصة غير مسبوقة للتأثير على أعمال الجهاز القضائي، كما ظهر في القرار 1422.
حيث أثبتت المادة 16 أنها من الناحية العملية لها تأثير مخالف لما كان يقصده واضعو المادة 23 من مشروع لجنة القانون الدولي، وإن كانت صياغة المادة ليست المسئولة وحدها عن هذه النتيجة، حيث عكست آراء الدول عدم الخشية من تجاوز المجلس لاختصاصاته، لأنه سوف يحتاج إلى 9 أصوات لتمرير قرار بإيقاف اختصاص المحكمة بما فيهم الأعضاء الخمسة، ولهذا كان إصدار قرار 1422 رغم كل ذلك إنما يعكس نوعًا من الخلل في أداء المجلس، وتغليبه لاعتبارات عملية وسياسية.
حيث هددت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض ضد تمديد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلم في البوسنة والهرسك بدلًا من أن تسحب قواتها منها، لو لم يتم تمرير القرار بالتعليق، وهكذا حصلت الولايات المتحدة بمفردها وبشكل غير مباشر على نفس سلطات المادة 23/3 من المشروع من خلال المادة16.
وبالرغم من تبني القرار، فقد عكست تصريحات أغلبية المفوضين الشعور بالفشل والتراجع عن فكرة المحكمة الدولية، حيث أشارت الأغلبية – بما فيهم أعضاء المجلس- إلى النتائج الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن تبني مثل هذا القرار، والآثار السلبية على القانون الدولي وعلى مصداقية قرارات مجلس الأمن، بعد تبني هذا القرار [82].
مجمل القول: إن القرار قد تم تبنيه رغم معارضة الجماعة الدولية، ومناشدة أكثر من مائة دولة لمجلس الأمن بعدم الموافقة، حيث ثارت الشكوك حول مدي اتفاق القرار مع الرموز والقيم الأساسية للقانون الدولي، أو اختصاص مجلس الأمن في تعديل المعاهدات دون موافقة الدول الأطراف، وفى العمل كجهاز قضائي في تأويل المعاهدات الدولية، إلا أنه من الواضح أن الضغوط السياسية هي التي فرضت وبهذه الطريقة الأخذ بالقرار، لمنع الولايات المتحدة من استخدام حق النقض ضد قوات حفظ السلم في البوسنة والهرسك، والتي تشكل مصلحة حيوية للجماعة الدولية هناك.
وبالرغم من أن الولايات المتحدة قد نجحت من الناحية السياسية في تحقيق أهدافها، إلا أنها فشلت في إيجاد مبررات قانونية تتفق وجوهر نظام روما الأساسي ولا يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، باعتبار أن القرار ينقصه عنصر جوهري وهو عدم وجود ما يمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين أو عملًا من أعمال العدوان يبرر تصرفات المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق[83].
لكن قد تكون الحاجة إلى المحافظة على السلم والأمن في البوسنة والهرسك أو الحرص على استمرار عمليات حفظ السلم في غيرها من الأقاليم هي المبرر الأساسي وراء انسياق الجماعة الدولية لرغبات الولايات المتحدة بالتعليق لاختصاصات المحكمة الدولية، إلا أن هذه الرغبة لا تمثل بالتأكيد تهديدًا للسلم بالمعني القانوني الدقيق، ومن باب أولى إذا كانت تلك الرغبة تمثل تبريرًا لتبني القرار استنادًا إلى المادة 16 كما هو نص القرار[84].
فجوهر تلك المادة يتطلب أن المواقف التي تنطوي على تهديد السلم والأمن الدوليين – وهو مبرر تصرف المجلس بموجب الفصل السابع- يجب التعامل معها حالة بحالة، وأي تفسير مخالف إنما يعني أن المجلس سوف يستبعد اختصاص المحكمة بدون أية مبررات حقيقية للتهديد لأطول فترة ممكنة، ومن ثم فإن الفقرة الثانية من القرار تمثل تعديلًا لنص المادة 16، الأمر الذي يطرح التساؤل مجددًا حول صلاحيات المجلس في تعديل المعاهدات الدولية بموجب الفصل السابع.
وقد يكون حقًا وصدقًا أن لمجلس الأمن صلاحية إنشاء أجهزة وآليات قضائية استجابة للمواقف التي تنطوي على تهديد السلم والأمن الدوليين؛ لكن هذا لا يعني مد صلاحيات المجلس إلى التدخل في أداء تلك الأجهزة لمهامها ولا الإجراءات التي تتبعها من أجل ذلك، وهو ما حسمته بحزم المحكمة الدولية لمحاكمة مجرمي البوسنة والهرسك في عديد من أحكامها وقضاياها[85].
إلا أن ما يمنع تعليق اختصاص المحكمة أو منح الدول غير الأعضاء بالمحكمة حصانة هو ما يتعلق بمناقضتها لفكرة القواعد الآمرة Jus Cognes والتي تمثل الإلزام للكافة Erga Omnes، لأن اختصاص المحكمة قاصر علي الجرائم الأشد خطورة على الجماعة الدولية، والتي تضعها في مرتبة أسمي من غيرها من القواعد، فهي قواعد آمرة تضع التزاماتها على الكافة بعدم منح أية حصانة لمرتكبي تلك الجرائم[86].
ومن ثم فإن القرار يتنافى مع مبدأ الإلزام للكافة؛ لأنه يعفي أفراد القوات المشاركة في حفظ السلم من الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي من اختصاصها، ومع قيام الافتراض بأن تلك الجرائم تمثل إلزامًا للكافة، والرغبة في تجديد تعليق اختصاص المحكمة إنما يعني إضفاء المشروعية على تلك الحصانة.
وأخيرًا فإن الفقرة الثالثة من القرار تلزم الدول الأعضاء بألا تتخذ أية إجراءات تتنافى مع الفقرة الأولي أو التزاماتها الدولية، وهى فقرة غامضة وواسعة الدلالة، وتفرض مجموعة من التساؤلات ابتداء من تحديد ماهية الدول الأعضاء، وماهية الأفعال التي لا تتفق مع الفقرة الأولى أو الالتزامات الدولية، وأخيرًا المعنى المقصود بالامتناع[87].
إلا أن السياق المقبول لهذه الفقرة قد يعنى التزام كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات تتنافى مع جوهر الفقرة الأولى: استدعاء اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادتين 13 / أ و14/أ من نظام روما. ولأن قرار المجلس ملزم للجماعة الدولية؛ فإن كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة – سواء كانوا أطرافًا أو غير أطراف في المحكمة الدولية – سوف تمتنع عن التعاون مع المحكمة، بما يعنى قيام التعارض بين التزاماتها القانونية لغير صالح المحكمة الدولية[88].
اتفاقيات الحصانة وعدم التسليم
وأخيرًا فقد سعت الولايات المتحدة إلى عقد اتفاقات ثنائية مع مجموعة من الدول التي وقعت أو صدقت على نظام روما الأساسي بعدم تسليم مواطنيها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتتخذ هذه الاتفاقات ثلاثة أشكال: منها ما وقعته مع إسرائيل في 4أغسطس 2002 (بعد سحب الأخيرة أيضًا لتوقيعها على النظام الأساسي) وموريتانيا (17 أغسطس) والهند (26 ديسمبر) ونيبال (31 ديسمبر)، والتي تضمنت التزام الطرفين بعدم تسليم رعايا (وليس فقط أفراد القوات المسلحة العاملين ضمن قوات حفظ السلام) الطرف الآخر إلى اختصاص المحكمة الجنائية[89]
على حين أن الشكل الثاني منها لا يقوم على التزامات متبادلة، حيث لا تمنع الولايات المتحدة من إمكان تسليم رعايا الطرف الآخر لاختصاص المحكمة، في مقابل التزام الأخيرة بعدم التسليم، ومثالها الاتفاقات التي عقدتها في أغسطس مع كل من رومانيا وطاجيكستان، وفى سبتمبر مع كل من الدومينيكان والكويت والبحرين وجزر مارشال و أوزبكستان وهندوراس وميكرونيزيا وبالاو، وأفغانستان، وفى أكتوبر مع السلفادور وغامبيا، وفى نوفمبر مع سري لانكا، وفى يناير 2003 مع جيبوتي وفى فبراير مع جورجيا [90].
ويصدق الشكل الثالث والأخير على اتفاقها مع تيمور الشرقية قبل أن تصبح عضوًا بالأمم المتحدة، والتي وقعتها في 23 أغسطس، والتي تتضمن شرطًا إضافيًا بعدم التعاون مع دولة ثالثة لاتهام أو تسليم رعايا الولايات المتحدة إلى اختصاص المحكمة الجنائية.
بينما لا زالت الولايات المتحدة تمارس ضغوطها على سائر الدول الأخرى لتوقيع اتفاقات الحصانة، ومنها على سبيل المثال البوسنة والهرسك وشيلى وقبرص و الدنمارك وبلغاريا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وأوكرانيا ويوغوسلافيا[91].
وأخيرًا فإن هناك دولًا عديدة -ولها ثقلها في الجماعة الدولية- رفضت التوقيع على اتفاقات الحصانة تلك، معتبرة إياها خرقًا لالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، ومنها النمسا وكندا وكولومبيا وكرواتيا وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا وأسبانيا والسويد وترينداد وتوباجو[92].
وقد عبرت تلك الدول عن مجموعة من المبررات القانونية التي تدعم موقفها الرافض لعقد اتفاقات حصانة تتعارض بالقطع مع التزاماتها بموجب المحكمة الجنائية، وأن الولايات المتحدة تسعى إلى تدمير عالمية الاختصاص الجنائي بتكالبها على عقد مثل تلك الاتفاقات.
إذ تستند الولايات المتحدة في عقدها لاتفاقات الحصانة إلى تأويلها الخاص لنص المادة 98 من نظام روما الأساسي في فقرتها الثانية، حيث “لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها الطلب على نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولًا على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم.”
لكن هذه الاتفاقات لا تتفق مع أغراض المادة 98/2 لأنها تمنع الدول الأطراف من الوفاء بالتزاماتها طبقًا لنظام روما، وتشكل خرقًا للمواد 27 و 86 و 87 و 89 من النظام، ومادة 18 من قانون المعاهدات، وتخلق نوعًا من التعارض في الالتزامات ما بين اتفاقيات جنيف والإبادة الجنسية والأنظمة القومية لتسليم المجرمين الخاصة بكل دولة.
ذلك أن مادة 98 إنما كانت تعكس موقف بعض الدول المؤيدة للمحكمة، والتي تتعلق باحتمال قيام تعارض ما بين نظام روما وبين الالتزامات الأساسية للدولة بموجب القانون الدولي (الحصانات الدبلوماسية)، أو بموجب الاتفاقات الدولية (وهى بالأساس وفى نية الأطراف اتفاقات وضع قوات الناتو داخل الدول المنضمة للمعاهدة)، وهى اتفاقات سابقة على المحكمة الجنائية ومعترف بها، ومن ثم فإن عقد اتفاقات جديدة أو تجديد القائم منها في هذا المجال المحدود لا يتعارض مع نظام روما.
والدليل على أن نية الأطراف كانت تتجه إلى تلك الاتفاقات على وجه القصر هو كلمة “الدولة المرسلة”، وهى اصطلاح يتكرر كثيرًا في اتفاقيات وضع البعثات أو القوات للإشارة إلى الدولة التي ترسل بعثات عسكرية للإقامة على إقليم دولة أخرى تسمى بالدولة المضيفة، والتي لا تغطى سوى الأفراد المنتمين إلى تلك البعثات بشكل ضيق ومحدود.
وبالرغم من أن نية الدول الأطراف أن تنطبق المادة على اتفاقات وضع القوات فقط أو على تجديدها، فإن أية اتفاقات أخرى يجب على الأقل أن تتفق مع مبادئ وأغراض نظام روما، حيث كان الهدف من نص المادة هي الاتفاقات القائمة فعلًا وإمكان تعارضها مع التزامات المحكمة، أي أنها تهدف إلى حل التعارض القانوني الذي يمكن أن يثور بسبب اتفاقات وضع القوات، ولم يقصد بها أن تنشئ وضعًا لاتفاقات جديدة تعرقل من تعاون الدول الأطراف مع المحكمة.
ولذا فقد وقعت الولايات المتحدة اتفاق روما من أجل أن تشارك في وضع قواعد الإجراءات والأدلة، وحاولت في كل الدورات فرض تصورها للمحكمة وإجراءاتها، ومنها هنا اعتبار عقد اتفاق الحصانة مع الأمم المتحدة على أنه يدخل ضمن “الاتفاقات الدولية” التي تستبعد اختصاص المحكمة بموجب المادة 98/2.
حيث أكد مندوبها على أن القاعدة 195/2 من قواعد الإجراءات والأدلة والتي تتصل بمتطلبات تطبيق المادة 98/2، تفسح المجال أمام الولايات المتحدة لعقد اتفاقات دولية مع الأمم المتحدة لحماية أي مواطن أمريكي من التحقيق أو الاتهام من قبل المحكمة. ثم تقدمت في الدورة الرابعة والخامسة بمشروع قاعدة تسمح للمحكمة بالدخول في اتفاقات تمنع تسليم مواطني دولة غير عضو إلى اختصاص المحكمة، والذي لاقى اعتراض 39 مندوبًا من أصل 45 [93].
ويمكننا في النهاية الإشارة إلى بعض الانتقادات التي توجه إلى الاتفاقات الثنائية التي عقدتها الولايات المتحدة بهدف إعفاء مواطنيها أو أفراد القوات المسلحة من التحقيق أو الاتهام من قبل المحكمة الجنائية الدولية، خاصة ما يتصل بمضمون تلك الاتفاقات والآثار القانونية التي يمكن أن تترتب عليها بالنسبة إلى عالمية الاختصاص الجنائي:
1- أن تفسير الاتفاقات الدولية يجب أن يكون بحسن نية وبما يتفق مع السياق العادي وبما لا يتعارض مع أهداف وأغراض الاتفاقية، لأن الهدف الأساسي من نظام روما هو تقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب أشد الجرائم خطورة على الجماعة الدولية إلى اختصاص المحكمة، وهو ما يتم عن طريق الدول الأعضاء بأنفسهم أو عن طريق المحكمة كحل أخير، وأن أية اتفاقات قد يترتب عليها حرمان المحكمة من اختصاصها بالتحقيق أو الاتهام بسبب عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها على التعاون إنما يتناقض مع أهداف وأغراض المحكمة.
2- أن مادة 98/2 لا تسمح بعقد هذا النوع من الاتفاقات التي تفرضها الولايات المتحدة عبر العالم، لأن هذه الاتفاقات الثنائية إنما تهدف إلى منع التسليم لاختصاص المحكمة وليس عودة هؤلاء إلى الولايات المتحدة للتحقيق أو الاتهام، فهي تسعى إلى تعديل أو إلغاء نص المادة عن طريق تمييع مفهوم “الدولة المرسلة” الذي يشكل جوهر تلك المادة، فهذه الكلمة تتكرر كثيرًا في اتفاقيات وضع القوات والبعثات العسكرية مما يعكس نية المشرع في أن تقتصر عليها فقط، خاصة أن تعريف الأفراد الذين يشملهم الإعفاء الأمريكي يتجاوز بكثير نطاق الأفراد المشار إليهم في اتفاقات القوات أو البعثات[94].
3- أن اتفاقات وضع القوات والبعثات العسكرية المعنية بالمادة 98/2 تركز على اختصاص الدولة الأولى بالتحقيق والاتهام، لكنها لا تستبعد اختصاص غيرها بالتحقيق أو الاتهام، فهي اتفاقات تعالج -بتعبير آخر- أولوية الدولة بالاختصاص دون استبعاد غيرها من جهات التحقيق أو الاتهام، ومن ثم تتفق مع نظام روما الذي يعطى للاختصاص القومي الأولوية في الاتهام والتحقيق[95].
4- يجب الأخذ في الاعتبار نص المادة90 من النظام الأساسي، لأنها تتعلق بتعدد وتعارض طلبات التسليم لتقديم شخص ما إلى الاتهام، حيث تلتزم الدولة الطرف في حالة تلقيها طلبًا من المحكمة بتسليم شخص بموجب المادة89، وطلب من دولة أخرى بتسليم نفس الشخص عن ذات السلوك الإجرامي، بإعطاء الأولوية لطلب المحكمة حسب الفقرة الثانية، خاصة لو كانت الدولة الأخرى غير عضو بالمحكمة حسب الفقرة الرابعة[96].
5- عدم نية الولايات المتحدة إجراء التحقيقات أو الاتهام عن الجرائم التي ترتكب بالخارج، لأن نصوص الاتفاقات تلك نصت على أن الحكومة تعرب عن نيتها في التحقيق والاتهام “حيثما كان ذلك مناسبًا” للجرائم التي ترتكب من قبل موظفيها وأفرادها العسكريين وسائر الرعايا الآخرين. لكن اختصاص المحاكم الأمريكية بالجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة هو اختصاص قاصر وغامض وغير محدد [97].
*****
الهوامش:
[1] Thomas Schelling، What Makes Green House Sense?، Foreign Affairs، May 2002، Vol.81/3، P.P. 2-10.
[2] Contemporary Practice of the US Relating to International Law، Loss of US Seat on the UN Human rights Commission، American Journal of International Law، Oct.2001، Vol.95/4، P.P.877-878.
وكان تعليق الولايات المتحدة على القرار أن السودان المتهم بارتكابه جرائم الرق والعبودية وانتهاكات الحقوق الدينية قد انتخب عضوًا في اللجنة التي حافظت الولايات المتحدة على عضويتها منذ عام 1947، وإن كان بعض المراقبين يرون في التصويت انتقاد الجماعة الدولية للاتجاه المنفرد للولايات المتحدة في مجال القانون الدولي، بما فيه رفضها التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات الأخرى.
[3] S Murphy، Contemporary Practice of the US Relating to International Law، American Journal of International Law، Oct.2002، Vol. 96/4، P.P. 975-977.
[4] John Rhinelonder، The Conference on the Legal Status of the ABM Treaty، Comparative Strategy، 2001، Vol. 20، P.P. 203-213.
Rein Mullerson، The ABM Treaty: Changed Circumstances، Extraordinary Events، Supreme Interests and International Law، International & Comparative Law Quarterly، 2001، Vol.50/1، P.P.
[5] Kristen Paris، The Expansion of the Biological Weapons Convention: the History of a Verification Regime، Houston Journal of International Law، Spring 2002، Vol.24، P.P. 509-550.
[6] See Cornell International Law Journal Spring Symposium 2003، US Unilateralism: International Law، Security and Policy post 9/11.
M.Bertold، H.Mey، Unilateralism in Theory and Practice، Comparative Strategy، 1998، Vol. 17، P.P.197-207.
Michael Mc Faul، The Liberty Doctrine، Policy Review، Apr. 2002، Issue 112، P.P. 3-22.
[7] انظر في مفهوم الدول المارقة ونماذجه التاريخية والمعاصرة:
Thomas Henriksen، The Rise and Decline of Rouge States، Journal of International Affairs، Spring 2001، Vol.54، No.2، P.P. 349-370.
[8] Michael Klare، Rogue States and Nuclear Outlaws: America’s Search for a New Foreign Policy، (New York: Hill & Wang، 1995، P.P. 12 et seq.)
Paul Hoyt، The Rogue State Image in American Foreign Policy، Global Society، Apr. 2000، Vol.14/2، P.P. 297et seq.
[9] حيث أكدت الإدارة الأمريكية على أنها تعترض بشدة على ضم الهند أو باكستان إلى نادى الدول النووية أو إلى اتفاقية منع الانتشار كدول نووية، لكنها لا ترغب في خلق منبوذين، وأن غرض فرض العقوبات هو التأثير على السلوك وليس العقاب، وأنها لن تستخدم لإحداث نوع من الانهيار الاقتصادي أو عدم الوفاء بالمتطلبات الإنسانية الأساسية.
[10] Paul Hyot، Op. Cit.، P.306
Michael Klare، Making Enemies for the 90s: The New “Rogue State Doctrine”، Nation، Aught 1995، Vol.260/18، P.P. 625-628
[11] Ibid، P.P. 307 et seq.
[12] Robert S. Litwak، What ‘s a Name? The Changing Foreign Policy Lexicon، Journal of International Affairs، Spring 2001، Vol.54/2، P.P. 375 et seq.
[13] Eric O’Malley، Destabilization Policy: Lessons from Regan on International Law، Revolutions and Dealing with Pariah Nations، Virginia Journal of International Law، Winter 2003، Vol.43، P.P. 319-362.
[14] Anthony Lake، Confronting Backlash States، Foreign Affairs، March 1994، Vol.73/2، P.P. 45-55.
[15] Robert Litwak. Op. Cit.، P.384
[16] Mark Strauss، A Rogue by Any Other Name، Chronicle of Higher Education، Dec.2000، Vol.16/11 ، P.P.11-14.
Guo Fenghai، From “Rogue States” to “ States Deserving Special Concern”: Anything changed?، http://www. Bjreview.com.cn/bjreview/en/200137/globalobserver-200137
Patrick Martin. State Department Drops the Term “ Rogue States”-cynicism and crisis inUS Foreign Policy، http://www.wsws.org/articles/2000/june2000/rogue-j24
Michael Klare، An Anachronistic Policy: The Strategic Obsolescence of the “Rogue Doctrine”، Harvard International Review، Summer 2000، Vol.22/2، P.P. 46-53.
Meghan O’Sullivan، Sanctioning Rogue States، A Strategy in Decline? Harvard International Review، Summer 2000، Vol.22/2، P.P. 56-61.
وتقدم تلك الكتابات عددًا من المبررات وراء إسقاط إدارة كلينتون لمصطلح “الدول المارقة “، منها علي سبيل المثال أن المصطلح هو مفهوم أمريكي ليس له من سند في القانون الدولي، ولهذا كان يتم تطبيقه بانتقائية شديدة، فضلًا عن معضلة التطبيق للمؤشرات، فكيف يمكن أن نصف الهند وباكستان بعد أن استوفت أحد تلك المعايير وهو حيازة أسلحة الدمار الشامل؟، وأن توجهات السياسة الخارجية نحو الدول المارقة قد نجم عنها خسائر سياسية ملحوظة في عدم الرضا العالمي حول تطبيق الجزاءات عليها أو إتباع إجراءات التدمير والعزل، وأن مفهوم الدولة المارقة يحد بشكل صارخ من المرونة في السياسة الخارجية إزاء تلك الدول.
[17] انظر على سبيل المثال
Noam Chomsky، Rogue States: The Role of Force in World Affairs، (Cambridge، MA، South End Press، 2000).
Raju Thomas، Bombs، Sanctions and State Destruction: US Action in a Unipolar World، World Affairs ، Jan.1999، Vol.3/1، P.P. 123 et seq.
على حين تخرج الكتابات التي ترصد سلوكيات الدولة المارقة على شبكة الإنترنت عن الحصر، وهى تستخدم عناوين من قبيل merica the Chief Rogue State- Rogue State par Excellence
[18] Michael Hirsh، Bush and The World، Foreign Affairs، Sep/Oct. 2002، Vol. 81/2، P.18.
John Ikenberry، America’s Imperial Ambition، Foreign Affairs، Sep/Oct. 2002، Vol. 81/2، P. 44.
[19] Jermy Telman، Should we read Carl Schmitt Today?، Berkeley Journal of International Law، 2001، Vol. 19، p.p. 127- 160
خاصة فيما يتصل بأن التمييز الأساسي للسياسة هو ما بين الصديق / العدو، وأنه عندما تفشل الدول في صياغة مثل هذا التمييز؛ فإن غيرها من الثنائيات تتداعى إلى الظهور، من قبيل التمييز ما بين الخير والشر، وبين الحضارة و البربرية. وطبقًا لهذا فإن كيفية تقديم مبررات لشن الحرب هو جوهر دولة شميدت، وأن الدولة لا يمكنها أن تدخل حربًا من أجل المبادرات الأخلاقية أو الدينية، فالحرب هي استجابة لتهديد جوهري لوجود الدولة.
[20] C. Brown، The Fall of the Towers and International Order، International Relations، Aug. 2002، Vol.16/2، P.P. 263-267.
[21] Fraser Cameron، Utilitarian Multilateralism: The Impact of 11 September 2001 for US Foreign Policy، Politics، May 2002، Vol.22 /2، P.P. 68- 75.
[22] Philip H. Gordon، NATO after 11 September، Survival، Winter 2001-2002، Vol.43/4، P.P. 1-18.
[23] Brett Bowden، Reinventing Imperialism in the Wake of September 11، Alternatives، Summer 2002، Vol.1/2، P.P. 28-46.
[24] Ibid ، P.31
[25] Ibid، P.32
[26]Larry Diamond، Winning the New Cold War on Terrorism، Institute for Global Democracy، Policy Paper No.1، March 2002، P.P.6-8
بل إن رئيس تحرير وول ستريت افترض إن الإمبريالية الأمريكية يمكن أن تكون أفضل استجابة للإرهاب، وأن أحداث سبتمبر هي نتيجة لعدم كفاية الانخراط الأمريكي في العالم، وأن أفغانستان وغيرها من الدول المضطربة في حاجة إلى نوع من الإدارة الأجنبية المستنيرة.
[27] Fraser Cameron، Op. Cit.، P.69
وهو يرى أن الهجوم الإرهابي قد أعاد تشكيل أولويات السياسة الخارجية على نحو ربطت الولايات المتحدة نفسها به بتحالفات متنوعة من الدول بغض النظر عن انتمائها أو موقفها من قضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان، حيث أكد بوش في خطاب 12 ديسمبر 2001 أن تهديدًا جديدًا للحضارة بدأ يزيل الخطوط القديمة للمنافسة والخصومة والاستياء بين الأمم، وأن أمريكا وروسيا يقيمان علاقات تعاون جديدة وتتحالف أمريكا مع الهند بصورة متزايدة في سلسلة من القضايا، وتضطلع ألمانيا واليابان بأدوار جديدة تتناسب ووضعهما الديموقراطي.
[28] Michael Hirsh، Op. Cit.، P. 22.
Ralf Carter، Leadership at Risk: the Perils of Unilateralism، American Political Science Review، Jan.2003، Vol.36/1، P.P. 67 et seq.
Michael Hunt، In the Wake of September 11، The Clash of what ?، American History، Sept. 2002، Vol.89/2، P.P. 9 et seq.
[29] John Dumbrell، Unilateralism and America First ?: President George W. Bush’s Foreign Policy، Political Quarterly، Jul.2002، Vol.73/3، P.P. 276 et seq.
[30] Fraser Cameron، Op. Cit. P.P. 70 et seq.
إذ يقرر أن الولايات المتحدة رغم حاجتها إلى “الجماعية” في محاربة الإرهاب، إلا أنها تنزع إلى “التوحد” في كل شيء، وأنها لم تبد أية إشارة عن تراجعها عن موقفها -المعارض لأقرب الحلفاء- من مسائل كيوتو والاختبارات النووية والمحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي يسميه بالجماعية المتوحدة Utilitarian Multilateralism.
[31] Mohamed El Zeidy، The United States Dropped the Atomic Bomb of Article 16 of the International Criminal Court Statute: Security council Power of Deferral and Resolution 1422، Vanderbilt Journal of Transnational Law، Oct.2002، Vol.35/5، P.P. 1503-1344.
[32] Thomas Schilling، What Makes Green House Sense ? Foreign Affairs، May 2002، Vol.81/3،
P.P. 2-10
John Dumberll، Op. Cit. P.P. 277 et seq.
[33] Daniel N. Nelson، Transatlantic Transmutations، The Washington Quarterly، Autumn 2002، Vol.25/4، P.P. 51 et seq.
S. Smith ، The End of the Unipolar Moment، September 11 and the Future of World Order، International Relations، Aug. 2002، Vol.16/2، P.P. 171-183.
Charles Krauthammer، The Unipolar Moment Revisited، The National Interest، Winter 2002/2003، Issue 70، P.P. 6 et seq.
وهو متابعة وإعادة قراءة لمقال سابق نشره عام 1991
Charles Krauthammer، The Unipolar Moment، Foreign Affairs، Jan. 1991، Vol. 70/1، P.P. 23-34.
[34] John Ikenberry، Op. Cit. P.P. 45 et seq.
S. Guzzini، Foreign Policy Without Diplomacy: The Bush Administration at a Crossroads، International Relations، Aug. 2002، Vol.16/2، P.p. 291-297.
[35] Condaleezza Rice، Promoting the National Internet، Foreign Affairs، Jan 2000، Vol. 79/1، P.P.48 et seq.
حيث تؤكد على أن الاتفاقيات والمؤسسات متعددة الأطراف لا يجب أن تشكل غاية في حد ذاتها، وأن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تصلح لتكوين التحالفات الأقوى، وأن إدارة كلينتون كانت تواقة للبحث عن حلول جماعية لكل المسائل، ولهذا تسارع بالتوقيع على الاتفاقيات الجماعية، وان لم تكن في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، والمثال على ذلك هو كيوتو، وهى اتفاقية لا تضم الصين وتعفى الأقطار النامية من معاييرها التحكمية وتعاقب الصناعات الأمريكية، ومن ثم فلا يمكنها بحال من الأحوال أن تكون في صالح الولايات المتحدة.
وبالطبع فإن هذا لا يمنع من توقيع اتفاقيات جماعية رمزية، فطبقًا للجنة الشئون الخارجية هناك 52 اتفاقية ومعاهدة تنتظر التصديق، بعضها قد يعود إلى عام 1949، لكن ليس من العزلة في شيء القول بأن الولايات المتحدة لها دور خاص ولا يجب أن تنضم إلى كل الاتفاقيات والمعاهدات التي تقترح أية دولة أو مؤسسة ضرورة عقدها.
[36] John Kemberry، Op. Cit. P.P 47-49.
[37] Ibid، p.p. 45 et seq.
L. Hagel، The World Redefined، Mediterranean Quarterly، August 2002، Vol. 1313، p.p. 12- 21.
H. Elsehans، The International System Since September 11: Ultra stability – Ultra imperialism، Asien Afrikd Latin Amrika، Jan. 2002، Vol. 3013، p.p. 193- 217.
Glenn Hastedt، Definitions of Responsibility and American Foreign Policy، American Political Science Review، Jan2003، Vol. 36/1، P.P. 47 et seq.
A. J. Hurrell، There Are no Rules (George Bush): International Order After September 11، International Relations، August 2002، Vol. 1618، p.p. 185 – 204.
[38] James Kitfield، The New New World Order، National Journal، Nov.2002، Vol.34/44، P.P. 3192-3198.
[39] Charles Krauthammer، The Unipolar Moment Revisited، P.P. 8 et seq.
لأن بريطانيا عندما فرضت سلامها الإمبراطوري كان لديها أسطول بحري أكبر من الدولتين التاليتين لها، على حين تنفق الولايات المتحدة على التسلح ما يفوق العشرين دولة التالية لها، بما يجعلها خارج المنافسة، وأن أحداث سبتمبر أكدت ذلك لأنها أتت بعد حرب كوسوفو التي شكلت قمة الأداء التكنولوجي وعمق الفجوة ما بين الولايات المتحدة وحلفائها.
والملاحظ أن الخبرة التاريخية للهيمنة أنها تولد تحالفات مضادة من الدول الأقوى في محاولة جادة أو يائسة لإحداث نوع من التوزان الدولي، لكن خلال العقد الأول من القطبية الأمريكية لا يوجد مثل هذا التحالف، فلا يوجد لنا أعداء كبار.
[40] John Ikenberry، America’s Imperial Ambition، Op.Cit.، P.P.49-50
“There are things we know that we know، There are known unknowns، That is to say there are things that we know we don’t know، but there are unknown unknowns، there are things we don’t know.Each year we discover a few more of things unknown unknowns.”
[41] Ibid، P.46.
[42] Ibid، P.47
[43] Ibid.، P.P. 53 et seq.
S. Guzzini، Op. Cit.، P.P. 294.
[44] Joseph Nye، The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower can’t Go it Alone، (New York: Oxford Univ. Press، 2002، P.P. 17 et seq.)S
[45] Michla Pomerance، US Multilateralism: Left and Right، Orbis، Spring 2002، Vol.46/2، P.P. 351 et seq.
[46] Joseph S. Nye، Seven Tests Between concert and Unilateralism، The national interest، Winter 2001، Vol. 2، P.8.
[47] Ibid، P.P. 8-9.
Franz Nuscheler، Multilateralism Vs. Unilateralism (Bonne: Development & Peace Foundation، 2001، P.P. 12 et sq.).
[48] Stewart Patrick، Don’t Fence me in: The Perils of Going it Alone، World Policy Journal، Fall 2001، Vol.18/3، P.P. 2-3
[49] Ibid، P.3
[50] Ibid، P.7
S. Smith، Op. Cit.، P.P. 176 et seq.
[51] Kristen Paris، Op. Cit.، P.p. 528-530.
[52] US Withdrawal from the ABM Treaty، Arms Control Today، Jan.2002، Vol. 32/1، P.P. 21 et seq.
[53] John Quigley، The New World Order and the Rule of Law، Syracuse Journal of International Law & Commerce، Spring 1992، Vol.18/1، P.P. 75 et seq.
Richard Nelson، International Law and US Withholding of Payments to International Organizations، American Journal of International Law، Oct.1986، Vol. 80/4، P.P. 973 et seq.
Steven Holloway، US Unilateralism at the UN: Why Great Power do not Make Great Multilateralists، Global Governance، Sep.2000، Vol.6/3، P.P. 361-382
[54] Christopher H. Lytton، Lessons from the Sward Bears: the Evolving Paradigm of the United States’ s Military Participation in United Nations’ Operations، Tulsa Journal of Comparative & International Law، Fall 2001، Vol. 9/1، P.P.195-212.
Joseph Nye، The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower can’t Go it Alone، Op. Cit.، P.P. 34 et seq.
[55] Matthew Barrett، Ratify or Reject: Examining the United States Opposition to the International Criminal Court، Georgia Journal of International & Comparative Law، Fall 1999، Vol. 28/1، P.P. 113-114.
[56] M. Barrett، Op. Cit.، P.P.116-117.
[57] John Schmesty ، Florida Federal Court Rules that the International Covenant on Civil and Political Rights does not bar United States from Prosecuting Persons already Convicted for some Crime in another Country، International Law Update، Jan. 1999، P.12.
William Schabas، Invalid Reservations to the International Covenant on Civil and Political Rights: is the United States Still a Party?، Brooklyn Journal of International Law، 1995، Vol.21، P.p. 277 –289.
[58] Anthony D’Amato، Nicaragua and International Law: The Academic and the Real، American Journal Of International Law، Jul.1985، Vol.78/3، P.P.657-664.
[59] أعلن بوش في في 11 يونيو 2001 أنه بالرغم من دعمه لضرورة خفض غازات الانبعاث، إلا أنه لا يتفق مع شروط البروتوكول التي تعفي الدول النامية من قبيل الهند والصين والتي تعد من أكثر الدول مصدرًا للغازات الضارة، كما أنه لا يوافق على النسب التحكمية للتخفيض، لإضرارها بالصناعة الأمريكية.
Joseph Nye، The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower can’t Go it Alone، Op. Cit. P.P. 56 et seq.
[60] Stewart Patrick، Op. Cit.، P.P. 13-14
[61] امتنعت الولايات المتحدة عن التصديق على اتفاقية قانون البحار في 19يوليو 1982، لتعارضها مع المصالح الأمريكية في التعدين العميق لقاع البحار، لهذا لم تستطع المشاركة في انتخاب أعضاء لجنة الرصيف القاري أو أعضاء المحكمة الدولية لقانون البحار أو لجنة قاع البحار، كما أن الاتفاق الملحق الذي كان يهدف إلى التغلب على الاعتراضات التي منعت الولايات المتحدة من التصديق، وبعد دخوله حيز النفاذ في يوليو 1996قد سمح للدول التي شاركت في صياغته ولم تصدق عليه بعد بالتقدم إلى السلطة المختصة بقاع البحار في مدة لا تتجاوز نوفمبر 1998، وهى بالأساس 14 دولة، نجحت 10 دول منها في التصديق خلال تلك المدة وهى ألمانيا واليابان وروسيا والصين والهند وفرنسا وهولندا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا، وفشلت أربع وهى الولايات المتحدة وبلجيكا وكندا وبولندا.
Margaret Temlinson، Recent Development in the International Law of the sea، The International Lawyer، Summer 1998، Vol. 32، P.P. 599et seq.
S. Oda، Some Reflections on Recent Development in the Law of the Sea، Yale Journal of International Law، Winter 2002، Vol.27/1، P.P. 217-222.
[62] Michael Mastandumo، Extraterritorial Sanction: Managing Hyper-Unilateralism in US Foreign Policy، in Stewart Patrick et al. (eds.)، Multilateralism and US Foreign Policy: Ambivalent Engagement، (Boulder: Lynne Riener، 2002، P.P. 292-322).
[63] Joseph Nye، Seven Testes between Concert and Unilateralism، Op. Cit.، P.10-12
[64] K. Ruth، R. Wedgwood، Is American’s Withdrawal from the New International Criminal Court Justified?، World Link، Jul/ Aug. 2002، Vol. 15/4، p.p. 14-20.
[65] انظر على سبيل المثال
David J. Scheffer، The United States and International Criminal Court، American Journal of Internationals Law، 1999، Vol. 93/
James Taulbee، A Call to arm Declined: the United States and the International Criminal Court، Emory International Law Review، Spring 2002، Vol.14، P.P. 105-113.
Joel F. England، The Response of the United States to the International Criminal Court: Rejection، Ratification or Something else; Arizona Journal of International & Comparative Law، Fall 2001، Vol. 18، p.p. 941 – 977.
David Forsyth، The United States and International Criminal Justice، Human Rights Quarterly، Nov. 2002، Vol.24/4، P.P. 974-991.
Joseph Nye، The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower can’t Go it Alone، Op. Cit. P.P. 116 et seq.
[66] David Forsyth، Op. Cit.، P.P. 976 et seq.
Michael Scharf، The ICC’s Jurisdiction over the National of Non-Party States: A Critique of the US Position، Law & Contemporary Problems، Winter 2001، Vol.46/1، P.P. 67 et seq.
[67] م 19 /2 الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو قبول الدعوى من قبل:
(ب) الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى لكونها تحقق أو تباشر المقاضاة في الدعوى أو لكونها حققت أو باشرت المقاضاة في الدعوى.
Michael Scharf، Op. Cit.، P.P. 69 et seq.
[68] K. Roth، R. Wedgwood، Op. cit، P. 20
[69] Joel England، Op. Cit.، P.P. 963 et seq.
S.Murphy، Contemporary Practice of the United States Relating the International Law، American Journal of international Law، Oct. 2002، Vol. 96/4، P.P. 975-977.
[70] M. Tia Johnson، The American Service member’s protection Act، Protecting whom ?، Virginia Journal of International Law، Winter 2003، Vol. 43/1، p.p. 456- 457.
[71]Sedn Murphy، Contemporary Practice of The United States relating to International Law، American Journal of International Law، Oct. 2002، Vol. 96/4، p.p. 975- 977
[72] Contemporary Practice of the US Relating to International Law، American Journal of International Law، Apr2002، Vol.96/2، P.P. 475 et seq.
Jeremy Rabkin، After Guantanamo: the War over the Geneva Convention، The National Interest، Summer 2002، Vol. 15، P.P. 15-26.
[73] G. Aldrich، The Taliban، Alqaeda Determination of Illegal Combatants، American Journal of International Law، Oct.2002، Vol.96/4، P.P. 891 et seq.
[74] Coalition of Clergy v. Bush، 189 F. Supp.1036، 2002.
United States Court of Appeals for the Ninth Circuit، Coalition of Clergy، Lawyers and Professors، vs. George W. Bush et al، No.02-55367.
The Federalist Society for Law and Public Policy Studies، Wrong Claim، Wrong Party، Wrong Court، Assessing the Petition brought by a Coalition of Clergy، Lawyers & Professors on behalf of Detainees held by the US Military in Guantanamo Bay، Cuba.
[75] US Supreme Court، Johnson v. Eisentrager، 339، US 763 (1950).
[76] Contemporary Practice of U.S relating to International Law ، Effort to Obtain Immunity from ICC for U.S Peace Keepers، American Journal of International Law، Jul 2002، Vol. 96/3، p.p. 725.
[77] Ibid، P. 726
Marc Weller، Undoing the Global Constitution: UN Security Council Action on the International Criminal Court، International Affairs، Oct. 2002، Vol.78/4، P.P. 693 et seq.
[78] Mohamed Elzeidy، The United States Dropped the Atomic Bomb of Article 16 of the International Criminal Court Statute: Security Council power of deferrals and Resolution 1422، Op. Cit.، P.P. 1505 et seq.
يتضمن القرار بعد الديباجة ثلاث فقرات، يطلب المجلس في الفقرة الأولى –متصرفًا بموجب الفصل السابع من الميثاق، واتساقًا مع أحكام المادة 16 من نظام روما الأساسي، أن تمتنع المحكمة الجنائية الدولية لمدة اثني عشر شهرًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2002، عن بدء أو مباشرة أية إجراءات للتحقيق أو المقاضاة، في حالة إثارة أي قضية تشمل مسئولين أو موظفين حاليين أو سابقين تابعين لدولة مساهمة ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، فيما يتصل بأي عمل أو إغفال يتعلق بالعمليات التي تنشئها الأمم المتحدة أو تأذن بها، إلا إذا قرر مجلس الأمن ما يخالف ذلك. ويعرب في الفقرة الثانية عن اعتزامه تمديد الطلب بنفس الشرط في أول يوليو من كل عام ولفترة 12 شهرًا جديدة طالما استمرت الحاجة إلى ذلك، مقررًا في الفقرة الأخيرة أنه على الدول الأعضاء ألا تتخذ أية إجراءات تتنافى مع الفقرة الأولى ومع التزاماتها الدولية.
[79] William Lietzaw، International Criminal Law after Rome: Concerns from a US Military Perspective، Law & Contemporary Problems، 2001، Vol.64، P.P. 119-
[80] Mohammed Elzeidy، Op. Cit.، P.1509
[81] Ibid، P.P. 1514-1517
[82] أشار مندوب كندا إلى قلق حكومته إزاء تمرير إعفاء قوات حفظ السلم من الاتهام عن الجرائم الأكثر خطورة على الإنسانية، وأن المسألة التي ناقشها المجلس أكبر بكثير من مجرد المحكمة الدولية، بل إن المبادئ الأساسية للقانون الدولي هي موضوع الشك والتحايل، وأن المجلس ليس من سلطاته إعادة كتابة المعاهدات الدولية أو تعديلها ضد رغبة الدول الأعضاء فيها، وأن القرار يحتوى على عناصر التجاوز في اختصاصات المجلس. فالمسألة التي يناقشها المجلس ليست مجرد تمديد البعثة، وإنما التأثيرات السلبية المحتملة لهذا القرار على تكامل نظام روما الأساسي، وعلى مصداقية قرارات المجلس، وعلى مشروعية القانون الدولي فيما يتصل بالتحقيق والاتهام في أخطر الجرائم على الإنسانية.
انظر كافة التصريحات والمداولات على موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت
Htt://www.un.org/icc/index.htm
[83] Ibid، P. 1524
[84] Ibid، P. 1531.
يقدم المجلس طلب التجديد والإعفاء لأطول فترة ممكنة طالما كان ذلك ضروريًا، بمعني أن المجلس سوف يستبعد اختصاص المحكمة ليس فحسب لمدة 12 شهرًا، وإنما لمدة غير محدودة وغير معلومة، وهو ما يتعارض مع نص م16 من النظام الأساسي، لأن التجديد يجب أن يكون استنادًا إلي ظهور موقف يمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين أو عملًا من أعمال العدوان يستوجب تصرف المجلس بموجب اختصاصاته في الفصل السابع من الميثاق، وهو أمر لا يمكن حسمه مقدمًا وقبلها ب12 شهرًا على الأقل.
[85] Ibid، P.1532
[86] Ibid. P.1533
[87] Ibid، P. 1537
[88] Ibid، P. 1538
وهو ما يطرح أيضًا مدى مشروعية القرار 1422 فيما يتجاوز فترة الإثنى عشر شهرًا حتى يوليو 2003، كما هي القراءة الصحيحة لنص المادة 16، الأمر الذي يعنى قيام تعارض آخر ما بين ضرورة التزام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالقرار وبين التفسير الصحيح للمادة16 والتي لا تسمح بفترة تعليق أو إعفاء لما يتجاوز الإثنى عشر شهرًا القادمة.
[89] Amnesty International، International Criminal Court: US Effort to Obtain Impunity for Genocide، Crimes against Humanity and War Crime، August 2002، P.13.
وقد بررت إسرائيل موقفها الرافض للالتزام بنظام روما بالصراع في الشرق الأوسط، وأن السبب الأهم لهذا القرار هو احتمال التحيز السياسي من جانب المحكمة، وأن هناك أكثر من دليل على إمكان قيام عدد كبير من العرب بذلك كنوع من الدعاية، وأن المحكمة يمكنها اتهام إسرائيل بسبب محاربتها للإرهاب ولمجرمي الحرب بينما يرسل ياسر عرفات ومعاونوه الانتحاريين للقيام بهجمات إرهابية دون أدنى اتهام، وأن الولايات المتحدة تهدف من خلال اتفاقاتها إلى حماية أفرادها العاملين في قوات حفظ السلم، على حين كل فرد تقريبًا في إسرائيل هو في عداد القوات المسلحة.
[90] Ibid، P.14
[91] لم تتوافر لدى الباحث معلومات إضافية حول الدول التي لا زالت لم توقع بعد على اتفاقيات الحصانة، وإن لم ترفضها، ولذا فإن القائمة الموجودة قد تتغير بعض الشيء إما بالموافقة على الدخول في الاتفاقات، خاصة بالنسبة للأعضاء الجدد في حلف الناتو، أو أنها أخذت جانب الجماعة الأوروبية الرافضة لعقد تلك الاتفاقيات.
[92] Ibid، P.P. 16 et seq.
[93] Christopher Hall، The First Five Sessions of the UN Preparatory Commission for the International Criminal Court، American Journal of International Law، Apr.2000، Vol.94/2، P.P. 773-786.
[94] لأن اتفاقات القوات أو البعثات تشمل بحمايتها أفراد القوات العاملة و أقاربهم من الدرجة الأولى فقط، على حين أن الاتفاقات التي تعقدها الولايات المتحدة تتجاوز ذلك بكثير لتغطى الأفراد العاملين والسابقين والموظفين المدنيين من رعاياها، والمقاولين وكل من شارك في أعمال لها صلة بالقوات الأمريكية من غير مواطنيها، بل وتشمل – على نحو يذكرنا بالامتيازات الأجنبية والحماية- كافة الأفراد الموجودين داخل الإقليم بغض النظر عن سبب وجودهم، سواء كان العمل الشخصي أو السياحة، ولا يوجد أي مفهوم للدولة المرسلة يمكن أن يغطى مثل هذا التفسير الواسع للأشخاص المشمولين بالحماية، فضلًا عن عجز الدولة الأخرى عن القبض على مواطنيها أو اتهامهم أو تسليمهم لاختصاص المحكمة الدولية لمجرد أنهم شاركوا –بأية صورة- في أي شيء لصالح القوات الأمريكية.
[95] بتعبير آخر فإن أغراض اتفاقيات الحصانة الأمريكية تتعارض بالأساس مع اتفاقيات وضع القوات والبعثات العسكرية، لأن الهدف من اتفاقيات القوات هو تحديد المسئولية عن التحقيق والاتهام في الجرائم التي ترتكب من قبل أفراد القوات المسلحة للدولة المرسلة والموجودين على إقليم الدولة المضيفة، وليس من أجل إضفاء الحصانة على قوات الدولة المرسلة عن جرائم ترتكب على إقليم الدولة الثانية، لأن الاتفاقيات الأخيرة لا تعالج اختصاص الولايات المتحدة، وإنما فقط منع الدولة الثانية من القبض أو اتهام أو نقل الأشخاص المتهمين إلى المحكمة الجنائية.
فاتفاقيات الناتو على سبيل المثال تضمن اختصاص الولايات المتحدة المنفرد على أفراد قواتها عن المسئولية بأفعال تشكل انتهاكًا للقانون العسكري الأمريكي والتي ليست ضمن قانون الدولة المضيفة، على حين تختص محاكم الدولة المضيفة بكامل الاختصاص على تلك القوات المسئولة عن ارتكاب أفعال تعد انتهاكًا لقوانين الدولة المضيفة وإن كانت لا تشكل انتهاكًا للقانون العسكري الأمريكي.
[96] وحتى لو قررت الدولة الاستجابة لطلب دولة غير عضو بالتسليم، وكان على الدولة العضو التزامًا دوليًا قائمًا بذلك، فإن التسليم يخضع كذلك لمجموعة من الإجراءات والشروط الواجب أخذها في الاعتبار، وأن هذا التوازن في المصالح يمكن أن يحدث فقط في حالة وجود طلب رسمي بالتسليم عن نفس السلوك الإجرامي، على أن اتفاقيات الحصانة تستبعد نص المحكمة لأنها لا تهدف إلى عودة مواطنيها المتهمين بارتكاب أشد الجرائم خطورة لأغراض التحقيق والاتهام والإدانة من خلال آليات التسليم الرسمية، وإنما تستهدف فقط الحصانة والإعفاء من اختصاص المحكمة.
[97] فالمحاكم الفيدرالية ليس لها اختصاص واضح بالنظر في كل هذه الجرائم التي ترتكب من قبل المدنيين أو جرائم الإبادة التي يرتكبها بالخارج أفراد القوات الأمريكية الذين ليسوا من رعاياها أو على المدنيين الأجانب، وليست كل مؤشرات جرائم الحرب المنصوص عليها في نظام روما معروفة بوضوح ودقة على أنها جرائم في القانون الفيدرالي عندما ترتكب بالخارج، وأن الجرائم ضد الإنسانية- عدا التعذيب- التي ترتكب بالخارج ليست ضمن القانون الفيدرالي، وليس للمحاكم الأمريكية اختصاص اتهام الأشخاص بجرائم في القانون الدولي العرفي ليس لها تعريف دقيق كجرائم في القانون الداخلي.
وحتى بالنسبة للجرائم التي تخضع لاختصاص المحاكم الأمريكية، فإن الولايات المتحدة أعربت عن نيتها في الاتهام والتحقيق حيثما كان ذلك مناسبًا، الأمر الذي يخضع لاختصاص للسلطة التقديرية وليس لحكم القانون.