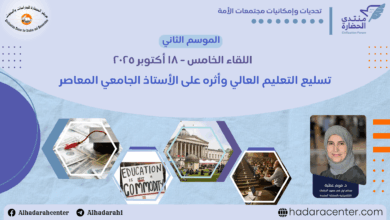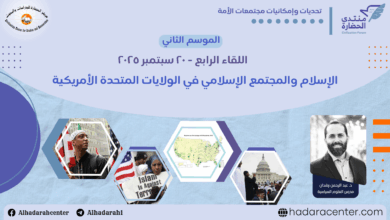الدولة والمجتمع والإسلام في أفريقيا
منتدى الحضارة 2 - اللقاء الثالث

تقديم (د. مدحت ماهر):
هذا هو اللقاء الثالث لمنتدى الحضارة للعام 2025 – 2026 حول العالم الإسلامي: مجتمعاته وثقافاته، موصولًا بالأبعاد السياسية والاقتصادية والاستراتيجية الأخرى. اللقاء الأول التأسيسي كان مع د. نادية مصطفى حول تحديات الأمة في ربع القرن الأخير[1]، ثمَّ كان اللقاء الثاني حول إندونيسيا مجتمعًا وثقافةً مع د. أماني لوبيس[2]. والآن ننتقل إلى وسط الأمة وقلبها المهم جدًّا (أفريقيا). وأفريقيا أحيانًا تُسمى بالقارة المنسية، لكنها تُسمَّى أيضًا قارة الإسلام، لأنها قارة ذات أغلبية مسلمة. ولأفريقيا قصتها الطويلة والثرية مع الإنسان والإسلام والعالم، وضمن موازين القوة السياسية والفكرية، ما يجعلها في الوعي العام قارة ثانوية ومنسية، ولكنها في منظورنا الحضاري عنصر أساسي في الأمة، وفي المنظومة العالمية. والسؤال الأساسي في أجندتنا عن أفريقيا هو مفهوم الفاعلية والمفعولية.
ومدخلنا اليوم هو مدخل المجتمع والثقافة وعلاقتهما بالدولة في أفريقيا. والمركز عُني بأفريقيا كلًّا وأجزاءً، سواء مواكبة لمناسبات عالمية أو أفريقية أو من باب رسم الخرائط، بما يشمل القارة أو أحد أقاليمها، سواء بنشر الدراسات والتقارير، أو بعقد منتديات ولقاءات حول قضايا وموضوعات أفريقيا، منها عن الجديد في الدراسات الأفريقية، والتطورات في غرب أفريقيا[3].
ولعل من أبرز من بدأ هذا الاهتمام في المركز عن أفريقيا هو الدكتور محمد عاشور[4]، محاضر اليوم، وهو عالم في الدراسات الأفريقية، وأستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي بجامعة القاهرة. له عدَّة مؤلَّفات وكتب عن “الحدود السياسية وواقع الدولة في أفريقيا”، و”استراتيجيات إدارة التعدُّدية الإثنيَّة في أفريقيا”، و”التكامل الإقليمي في أفريقيا: الدوافع والآفاق”. كما أن له عدَّة ترجمات أخرى، منها كتابا “اللامساواة”، و”العنصرية وكراهية الأجانب في تنزانيا”. والدكتور محمد حاصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 2008، وجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب الشبان. والدكتور عاشور منذ شبابه وهو يحرص على نفع غيره، والتحرك لصالح أفريقيا وكان له مبادرة لخدمة الطلاب الأفارقة في مصر.
ملخص محاضرة (د. محمد عاشور):
هذه المحاضرة هي محاولة للإحاطة بواقع دراسة الدولة والمجتمع والإسلام في أفريقيا، وذلك وفق إطار ثلاثي يشرح سبع خطايا وسبع وصايا وسبع قضايا ذات صلة بموضوع المحاضرة؛ الهدف الأساسي منها هو إثارة النقاش والأسئلة أكثر من منه تقديم الإجابات الجاهزة حول هذه النقاط. أما تقسيم المحاضرة فكان أيضًا ثلاثيًّا:
القسم الأول منها: عن الأخطاء السبعة التي يقع فيها من يتعامل مع موضوعات الدولة والمجتمع والإسلام في أفريقيا، ومنها: التبسيط المفرط أو التوحيد القسري لممارسات الإسلام في القارة، والاختزال الديني، والقول بمركزية الدولة (في العلاقة الثلاثية: الدولة – المجتمع – الإسلام)، وتجميد الزمن والهوية، والهوس الأمني في التعامل مع الظواهر الإسلامية. وأكَّد هذا القسم على أن الإسلام في أفريقيا ليس صورة موحَّدة، فالإسلام في السنغال يتجسَّد في الطرق الصوفية، بينما في شمال نيجيريا يرتبط بالمحاكم الشرعية والمؤسسات، أما الصومال فالأمر مختلف. كما أن الإسلام في أفريقيا ليس ظلًّا أو انعكاسًا للإسلام العربي أو الإسلام في الشرق الأوسط، مع التأكيد أن المقصود بالإسلام هنا هو “الممارسات”، فالمحاضرة انطلقتْ من أنه إسلام واحد في جوهره وعقيدته، ولكنه يختلف في ممارساته.
أما القسم الثاني من المحاضرة: فتناول الوصايا المنهجية السبعة التي على الدارس والقارئ والباحث في أفريقيا استيعابها عند التعامل مع هذه الموضوعات، وهي تمثِّل تقريبًا طرف النقيض من الأخطاء السابقة، منها: مراعاة أن ممارسات الإسلام تتنوَّع وفق السياق، والجذور التاريخية، وألا توضع أفريقيا في سلة واحدة، مع عدم حصر التحليل في الدولة (فليست هي الفاعل الوحيد أو حتى الأهم في الشأن الديني)، وضرورة الالتفات إلى دور المرأة، وعدم تبنِّي السرديات الجاهزة، بالإضافة لأهمية البدء من الداخل (كن محليًّا) (فالقرية قبل القارة، والزاوية قبل الظاهرة)، فالفهم الجاد يبدأ من الاستماع.
أمَّا القسم الثالث: فشرح سبع قضايا تعكس تطبيقًا لهذه الوصايا المنهجية، كما تعكس سبعة أوجه للتدين كما يُعايش ويُمارس في أفريقيا تتجسد في علاقة الإسلام بالتواصل مع الآخر، وحرية العقيدة (الردَّة)، والأسرة والتربية، والهوية، وتعاقب الأجيال، والثقافة العامة، والسياسة.
وفيما يلي نص المحاضرة:
محاضرة الدولة والمجتمع والإسلام في أفريقيا
أ. د. محمد عاشور
أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي – كلية الدراسات الأفريقية العليا – جامعة القاهرة
خالص التقدير لأسرة مركز الحضارة للدراسات السياسية ولأستاذتي الجليلة أ. د. نادية مصطفى، على تلك الدعوة الكريمة للالتقاء بحضراتكم، والإسهام بلبنة في جهود المركز المشكورة والمتواصلة في ميدان البناء والعمران الحضاري.. والشكر موصول للحضور الكريم مباشرةً وعبر الفضاء الأثيري. من خلال الحديث في موضوع شائق وشائك وهو:
الدولة والمجتمع والإسلام في أفريقيا
فهو شائق لأنَّه يفتح أبوابًا واسعة لفهم تفاعل الدين مع السياسة والمجتمع في قارة تتميَّز بالتنوُّع الثقافي والديني واللغوي الهائل. وشائك لأنه يمسُّ قضايا تمسُّ السلطة، والهوية، والقيم، ما يجعله ساحةً للتجاذب الفكري والسياسي والاجتماعي في آن واحد.
وسوف نتناول تلكم العلاقة بين الإسلام والدولة والمجتمع في أفريقيا، ليس من زاوية منفصلة لكل طرف، بل من منظور التفاعل المتبادل بينها. فالإسلام في القارة ليس مجرد عقيدة متسامية فوق الواقع، ولا أداة تابعة للسلطة، بل فاعل حيٌّ يفاوض الدولة، ويتجذَّر في المجتمع، ويُعاد تشكيله باستمرار من خلال تفاعلاته.
ولضبط مقاربة هذا الموضوع، قُسمت المحاضرة إلى ثلاث محطات أو محاور رئيسة: تبدأ بكشف الأخطاء الشائعة التي تُربك الفهم، ثم تقدم “الوصايا” المنهجية لتصحيح المسار، وتنتهي بنماذج تطبيقية توضح كيف يُعاش الإسلام في أفريقيا داخل فضاء المجتمع والدولة.
وأود القول إنه طوال الإعداد لهذه المحاضرة كان يحضرني قول المسيح في إنجيل متى، الإصحاح العاشر، الآية 34: «لا تظنوا أني جئت لألقي سلامًا.. ما جئت لألقي سلامًا بل سيفًا» وفي رواية أخرى «انقسامًا»، وعليه، فإنني ما جئت لأقدم إجابات نهائية، بل لإثارة الأذهان والنقاش والتساؤلات!!
ومن هنا تبدأ خطوتنا الأولى بالتخلية قبل التحلية؛ أي كشف الأخطاء الشائعة قبل بلورة فهم أعمق وأكثر توازنًا لعلاقة الإسلام بالمجتمع والدولة في أفريقيا. فالكثير من الدراسات والسياسات والإعلام رسمت صورًا مشوَّهة وقوالب نمطية فُرضت على الواقع الأفريقي من خارجه.
لذلك جاء القسم الأول بعنوان الخطايا السبع، وهي ليست ذنوبًا مقصودة، بل زلات فكرية ومنهجية تنشأ من استشراق متعسِّف، أو رؤية أمنية ضيقة، أو اجتهاد ديني منغلق، لكنها جميعًا تنتهي إلى نتيجة واحدة: إسلام حيٌّ ومتجذِّر يُقدَّم وكأنه خطر أو نسخة ناقصة. هدف هذا القسم إذن ليس الإدانة بل النقد الموضوعي تمهيدًا لبناء مقاربة أدق وأقرب إلى الواقع في الأقسام التالية، والآن نعرض هذه الخطايا واحدة تلو الأخرى.
المحور الأول
الأخطاء/الخطايا السبع – التخلية قبل التحلية
قبل محاولة بلورة أدوات أو تقديم نماذج تفسيرية، تقتضي المقاربة العلمية البدء بكشف الأخطاء المنهجية والفكرية التي شاعت في دراسة الإسلام في أفريقيا. هذه الأخطاء -أو “الخطايا”- ليست مقصودة بالضرورة، بل تنشأ غالبًا عن إسقاطات استشراقية، أو رؤى أمنية ضيقة، أو مقارنات معيارية غير منصفة. غير أن خطورتها تكمن في أنها تنتج صورًا مشوهة، وتؤثر في السياسات والبرامج البحثية، بل وتُغذِّي تصوُّرات عامة تختزل التجربة الإسلامية الأفريقية في قوالب لا تعكس واقعها.
وعليه، يشكل هذا القسم خطوة أولى ضرورية، غايتها النقد التصحيحي لا الإدانة، تمهيدًا للانتقال لاحقًا إلى الوصايا المنهجية والنماذج التطبيقية. ونبدأ هنا بأبرز هذه الأخطاء وأكثرها شيوعًا.
الخطيئة الأولى: التبسيط المفرط أو التوحيد التعسفي
من أبرز الأخطاء التعامل مع القارة وكأنها كيان ديني أو ثقافي واحد. إذ يُختزل “الإسلام في أفريقيا” في صورة موحدة، متجاهلًا التنوع الهائل بين دولها ومجتمعاتها. فالإسلام في السنغال يتجسد في الطرق الصوفية، بينما في شمال نيجيريا يرتبط بالمحاكم الشرعية، وفي الصومال يُدار عبر العشائر. هذا التنوع يجعل من أي تعميم مفرط مصدرًا لتشويه السياسات والتصورات.
الخطيئة الثانية: الاختزال الديني
كثير من الأدبيات تقدِّم الإسلام الأفريقي كنسخة باهتة من الإسلام العربي أو كخلفية للتطرُّف. بينما الواقع يكشف أن التجربة أعمق وأكثر استقلالًا: فالطرق الصوفية غربًا نظَّمت المجتمع والسياسة، والزوايا السواحلية شرقًا انصهرت مع التجارة والثقافة البحرية. تجاهل هذه الحيوية يعيد إنتاج صورة الإسلام كتهديد أو كنسخة ناقصة.
الخطيئة الثالثة: مركزية الدولة
تُفترض الدولة خطأً كفاعل وحيد في المجال الديني، بينما كثير من المجتمعات الإسلامية الأفريقية تدار شؤونها عبر الطرق الصوفية، الجمعيات، العلماء، أو الزعامات التقليدية. في السنغال مثلًا، الكلمة العليا دينيًّا للطرق لا للوزارة، وفي الصومال يتولَّى الشيوخ الدور الأبرز في غياب الدولة. إهمال هذه التعددية يؤدي إلى قراءة قاصرة للواقع.
الخطيئة الرابعة: تجميد الزمن والهوية
يتعامل بعض الباحثين مع المجتمعات الإسلامية وكأنها كيانات ثابتة لا تتغير، بينما الواقع يكشف ديناميكية مستمرة. الصوفية جدَّدت أدواتها عبر الإعلام الرقمي، وشباب المدن صاغوا خطابًا إصلاحيًّا جديدًا، ومسلمو جنوب أفريقيا طوَّروا هُوية مركَّبة تجمع التديُّن بالمواطنة. الهُوية هنا ليست جامدةً بل متجدِّدةً مع السياقات.
الخطيئة الخامسة: التنصل من المسؤولية
يُلقى باللوم كاملًا على الاستعمار في أزمات الدين والدولة والمجتمع، في حين أن النخب المحلية أسهمت بعد الاستقلال في تعميق الانقسامات أو عرقلة الإصلاح. حصر المسؤولية في الماضي الاستعماري يُنتج شللاً أخلاقيًّا ويمنع نقد الذات وإطلاق مبادرات إصلاحية نابعة من الداخل.
الخطيئة السادسة: الهوس الأمني
كثير من الخطابات الرسمية والإعلامية الغربية تُقدِّم الإسلام في أفريقيا كتهديد أمني دائم، فتُختزل نيجيريا في “بوكو حرام” والصومال في “الحرب على الإرهاب”. هذا المنظور الأمني يغفل أدوارًا بنَّاءة قام بها المسلمون، مثل تحويل المساجد إلى ملاذات آمنة خلال مجازر رواندا. الرؤية الأمنية البحتة تحرم الدولة والمجتمع من طاقات دينية إيجابية.
الخطيئة السابعة: فرض النموذج المعياري الواحد
يُقاس الإسلام في أفريقيا أحيانًا على النموذج الليبرالي الغربي لعلاقة الدين بالدولة، وكل ما يخرج عنه يُعتبر انحرافًا. فيُنتقد تطبيق الشريعة في نيجيريا رغم أنه استجابة محلية، وتُشيطن الطرق الصوفية في السنغال رغم دورها التوازني. هذا الإسقاط المعياري يتجاهل إمكانية بناء “حداثات محلية” من داخل المرجعيات الإسلامية الأفريقية.
المحور الثاني
الوصايا السبع
الوصية الأولى: فرِّق بين وحدة الإسلام وتعدُّد نماذج التطبيق
الإسلام في جوهره منظومة واحدة من العقيدة والعبادات، لكن تجلياته في الواقع الأفريقي تتَّخذ أشكالًا متنوِّعة بحسب السياق المحلي. ففي السنغال يبرز الإسلام من خلال الطرق الصوفية مثل المريدية والتيجانية، بينما يظهر في نيجيريا عبر المحاكم الشرعية والشبكات التعليمية التقليدية. وفي جنوب أفريقيا يتجلى الإسلام في مؤسسات مدنية وقانونية، أما في تنزانيا فيتماهى مع الثقافة السواحلية الساحلية. هذا التنوع لا ينفي وحدة المرجعية، لكنه يؤكِّد أن التطبيق ليس نسخة واحدة مكررة، بل استجابة سياقية لبيئات اجتماعية وسياسية متباينة.
الوصية الثانية: ضع التجربة في سياقها التاريخي
لا يمكن فهم الحاضر الديني والسياسي دون استحضار الجذور التاريخية. الإسلام دخل أفريقيا منذ القرن السابع عبر التجارة والدعوة السلمية، وأنتج ممالك إسلامية في الغرب، ومراكز علمية في “تمبكتو”، وأنماطًا حضرية ساحلية في الشرق، وأنظمة تعليمية تقليدية في الوسط، ومؤسسات مدنية حديثة في الجنوب. هذا الإرث الطويل يفسِّر تنوُّع المشهد الحالي بين الصوفية والشريعة والإصلاح والحركات الشبابية.
الوصية الثالثة: لا تضع أفريقيا كلها في سلة واحدة
القارة ليست كيانًا دينيًّا أو ثقافيًّا موحَّدًا، بل فسيفساء من التجارب. ففي نيجيريا يختلف شمالها الذي يُطَبِّقُ الشريعة عن جنوبها الحضري المتنوِّع دينيًّا، بينما يغيب دور الدولة في الصومال لصالح شيوخ العشائر، ويهيمن الإسلام الصوفي في السنغال، وتبرز المؤسسات المدنية القوية في جنوب أفريقيا. أي تحليل يختزل هذا التنوع في نموذج واحد يقع في خطأ منهجي يطمس الفروق الدقيقة بين المجتمعات.
الوصية الرابعة: لا تحصر التحليل في الدولة فقط
في كثير من الدول الأفريقية، ليست الدولة هي الفاعل الوحيد أو حتى الأهم في إدارة الشأن الديني. ففي السنغال تمسك الطرق الصوفية بزمام التأثير الاجتماعي والسياسي والديني، وفي تنزانيا تلعب الجمعيات الإسلامية الدور الأبرز، وفي جنوب أفريقيا تتحرك مؤسسات المجتمع المدني في مساحات واسعة خارج قبضة الدولة. حتى في نيجيريا، حيث تطبق الشريعة في بعض الولايات، يبقى دعم العلماء المحليين والأمراء التقليديين شرطًا لفاعلية أي نظام ديني.
الوصية الخامسة: راقب الأبعاد المتعلقة بالمرأة
لا تختزل أدوار المرأة المسلمة في أفريقيا بين ثنائية الضحية أو رمز الحداثة. فالنساء فاعلات في التعليم الديني والأسواق والجمعيات الخيرية والمؤسسات الأكاديمية. في نيجيريا مثلًا، تدير النساء مدارس قرآنية وأسواقًا محلية، وفي السنغال أَسَّسْنَ جمعيات تمزج بين الحجاب والعمل الاجتماعي، وفي جنوب أفريقيا يطالبن بالتمثيل في المجالس الدينية، بينما في شرق أفريقيا يَقُدْنَ مبادرات تربوية وصحية. إنصاف التجربة النسائية يتطلب رؤيتها كجزء أصيل من تشكيل التدين والمجتمع، لا كملحق به.
الوصية السادسة: لا تتبنَّ السرديات الجاهزة
الخطاب الإعلامي والسياسي الدولي كثيرًا ما يفرض روايات مسبقة، مثل ربط الإسلام بالتطرف أو اعتباره خصمًا لحقوق الإنسان. التحليل الجاد يبدأ من سؤال أساسي: من يكتب هذه السردية؟ ولمصلحة من؟ ففي أفريقيا، قدَّم المسلمون نماذج في الوساطة السلمية، والتعليم، والتنمية، وحماية الفئات الضعيفة، وهي حقائق تغيب عندما يختزل الإسلام في صور أمنية أو أيديولوجيَّة ضيِّقة.
الوصية السابعة: ابدأ بالداخل وكن محليًا قبل أن تكون عالميًّا
الفهم الرصين للإسلام في أفريقيا يتطلَّب الانطلاق من الداخل قبل القفز إلى التعميمات الكلية أي القرية قبل القارة والزاوية قبل الظاهرة، وهذا يشمل عدة مستويات متكاملة:
- الإصغاء قبل الحديث: فالاستماع لشيوخ القرى، وطلاب المحاضر، والشباب على المنصات الرقمية يكشف طبقات عميقة من المعنى لا تراها المقاربات الخارجية السريعة.
- احترام الاجتهادات المحلية: مثل نظام “المحضرة” التعليمي في موريتانيا، أو البيعة الصوفية في السنغال، أو إدماج القيم الإسلامية باللغات المحلية في أوغندا وتنزانيا، أو استخدام الخطاب الحقوقي في جمعيات جنوب أفريقيا. هذه الاجتهادات تعبِّر عن تفاعل حيٍّ بين الدين والواقع بدل الجمود أو التقليد الأعمى.
- قراءة المفكرين المحليين: مثل سليمان باشير دياني (السنغال) في الفلسفة والدين، وبوبكر باري (السنغال) في التاريخ السياسي، وعثمان عمر كين (السنغال/هارفارد) في الاقتصاد والهجرة، وأمينوالو (نيجيريا) في الحركات الإسلامية، وسعدية شيخ وفاطمة سيدات (جنوب أفريقيا) في قضايا الأدوار الاجتماعية للمرأة (الجندر) والهوية، وعبد الكريم جرشي (تنزانيا) في التعليم الديني. هذه الأصوات تفهم سياقها بعمق لا توفِّره المصادر الخارجية وحدها.
- تحليل التجارب الداخلية المتنوِّعة: ففي نيجيريا تتباين الممارسة الدينية بين كادونا الحضرية وكانو الصوفية والقرى المتأثِّرة بجماعات متشدِّدة. وفي السنغال تختلف دكار المركزية عن الأقاليم البعيدة، وفي تنزانيا يتمايز إسلام زنجبار الساحلي عن مدن الداخل، أما في جنوب أفريقيا فتتعايش تجارب مسلمي كيب تاون ذوي الأصول الماليزية مع مسلمي جوهانسبرغ من أصول هندية ومسلمي السود الجدد.
المحور الثالث
من المبادئ إلى الحياة اليومية: قضايا تطبيقية
بعد أن عالجنا في القسم الأول الخطايا التي تُشَوِّهُ فهم الإسلام في أفريقيا، وتوقَّفنا في القسم الثاني عند الوصايا المنهجية التي تساعد على إعادة بناء هذا الفهم بشكل متوازن ومحترِم للسياق، ننتقل الآن إلى القسم الثالث من هذه المحاضرة: النماذج التطبيقية للتديُّن الإسلامي كما يُعاش ويُمارَس داخل المجتمعات الأفريقية.
فالتحليل لا يكتمل دون الانتقال من التجريد إلى التجسيد، ومن النقد إلى الوصف، ومن المبادئ إلى الممارسة الواقعية.
وهنا، لا نسعى إلى تقديم قائمة نهائية أو حصرية، بل نعرض سبعة أوجه أساسية تُجَسِّدُ كيف يتفاعل المسلمون في أفريقيا -أفرادًا وجماعات- مع دولهم ومجتمعاتهم ودينهم. وتلك الأوجه هي:
- الإسلام التواصل مع الآخر.
- الإسلام وحرية العقيدة (الردة).
- الإسلام والأسرة والتربية.
- الإسلام والهوية.
- الإسلام وتعاقب الأجيال.
- الإسلام والثقافة العامة.
- الإسلام والسياسة.
القضية الأولى: الإسلام والتواصل مع الآخر في أفريقيا
يمثِّل التنوُّع الديني والثقافي إحدى القضايا المحورية التي تتقاطع فيها أدوار الدولة، والمجتمعات المحلية، والمؤسسات الدينية الإسلامية. فالإسلام، كقوة دينية واجتماعية، لم يتعامل مع المسيحية أو الديانات التقليدية باعتبارها خصمًا دائمًا، بل كان شريكًا في إدارة فضاءات مشتركة تشمل التعليم، والصحة، والتنمية، بل وحتى المصالحة السياسية. وفي المقابل، لعبت الدولة أحيانًا دور الوسيط أو الحامي، وأحيانًا دور الطرف المنحاز أو الضعيف، بينما قاد المجتمع المدني والجماعات الدينية الكثير من المبادرات المباشرة على الأرض. هذه التفاعلات تبرز كيف أنَّ العلاقة بين الدولة والمجتمع والإسلام والآخر الديني في أفريقيا علاقة معقَّدة، تتأثَّر بالتاريخ والسياسة والتحوُّلات الاجتماعية.
ففي نيجيريا، مثلًا، أُسِّسَتْ لجانٌ محليَّة تضمُّ ممثِّلين مسلمين ومسيحيِّين تحت إشراف السلطات المدنية لاحتواء النزاعات في ولايات مثل كادونا، ما يوضح التعاون بين أجهزة الدولة والمجتمع الديني. وفي السنغال، شجَّعت الدولة الطرق الصوفية المسيطرة اجتماعيًّا على بناء علاقات سلمية مع المجتمعات المسيحية، خصوصًا في إقليم كازامانس الذي عرف تاريخًا طويلًا من التعايش. أما في تنزانيا وكينيا، فقد ساعدت الهياكل البلدية والحكومات المحلية في حماية النسيج الحضري في زنجبار حيث تتعايش الهويات الدينية ضمن إطار وطني يجمع الجميع.
وفي مجالات التنمية، تعاونت المؤسسات الإسلامية والمسيحية في لعب دور محوري، أحيانًا بالتوازي مع الدولة وأحيانًا بملء فراغها. ففي أوغندا، تأسست الجامعة المسيحية–الإسلامية كمبادرة مشتركة ساهمت فيها منظمات دينية وحكومية لتوسيع فرص التعليم في المناطق المحرومة. وفي مالي، تعاونت الجمعيات الإسلامية والمسيحية مع أجهزة الدولة لتقديم الإغاثة خلال أزمة 2012، بينما في كينيا، عمل مجلس الأديان المشترك بالتنسيق مع وزارة الصحة على حملات توعية لمكافحة الأوبئة في الأرياف، ما يعكس من ناحية واقع الانفتاح ومن ناحية ثانية تداخل الأدوار بين الدين والدولة في إدارة الشأن الاجتماعي.
وعلى ذات الصعيد المتمثِّل في بناء المساحات المشتركة نجد أنه في غانا، مثَّل مجلس الأديان المشترك فضاءً مدعومًا من الدولة لمناقشة قضايا المواطنة والعدالة الاجتماعية، حيث يجتمع العلماء المسلمون والقساوسة المسيحيون لصياغة مواقف أخلاقية مشتركة. وفي تنزانيا، دعمت الحكومة الجمعيات الإسلامية التي تبنَّت خطابًا وطنيًّا يربط بين الانتماء الديني والدولة الحديثة، بما يعزِّز فكرة المواطنة المتساوية. أمَّا في نيجيريا، فقد لعبت المنظَّمات الإسلامية، بالتنسيق مع السلطات المدنية، دورًا في المصالحات بعد أحداث العنف في جوس عام 2010 عبر إصدار بيانات مشتركة مع الكنائس تدعو إلى التهدئة وبناء الثقة.
لكن العلاقة لم تَخْلُ من معوِّقات تعكس تعقيد التفاعل بين الدولة، والمجتمع، والمؤسسات الدينية. ففي نيجيريا، أضعفت هجمات بوكو حرام قدرة الدولة والجماعات الدينية على بناء الثقة المتبادلة. وفي إفريقيا الوسطى، أدَّى ضعفُ الدولة أمام صراعات الموارد إلى تحوُّل النزاعات إلى حرب طائفية بعد 2013. أما في مالي، فقد قوَّضت المواجهات المسلَّحة بين الحكومة والجماعات المتشدِّدة تاريخًا طويلًا من التعاون بين المسلمين والمسيحيين. كما ساهمت التدخُّلات الخارجية والخطابات الإعلامية المسيَّسة في تأجيج الانقسامات، ما حَدَّ من قدرة الفاعلين المحليِّين على صياغة حلول سلمية.
يوضِّح هذا المشهد أنَّ التواصل بين المسلمين والآخر الديني في أفريقيا يتجاوز كونه تفاعلًا ثقافيًّا إلى كونه قضية دولة ومجتمع ودين في آنٍ واحد. فنجاح مبادرات التعايش والتحالفات التنموية وحوارات الاعتراف المتبادل يتوقَّف على توازنٍ دقيقٍ بين دور الدولة كضامن، ودور المؤسسات الدينية كجسور اجتماعية، ودور المجتمعات المحلية كفضاء حيٍّ للتجربة اليومية. وحين يختلُّ هذا التوازن بفعل الصراعات أو التدخُّلات الخارجية، تتراجع إمكانات بناء المساحات المشتركة لصالح الانقسام والتوتر.
القضية الثانية: الإسلام وحرية العقيدة (الردة) في أفريقيا جنوب الصحراء
تُعَدُّ حرية العقيدة، بما في ذلك الدخول في الإسلام أو الخروج منه، إحدى القضايا التي تكْشف بوضوح طبيعة العلاقة المتشابكة بين الدولة والمجتمع والمؤسسات الدينية الإسلامية في أفريقيا جنوب الصحراء. فالقضية تقف عند مفترق حسَّاس يجمع بين النصوص الشرعية والتقاليد الفقهية من جهة، والدساتير الحديثة والقوانين الوضعية من جهة أخرى، وبين ضغوط المجتمعات المحلية والخطابات الحقوقية الصاعدة عالميًّا. في هذا الإطار، يتَّضح أنَّ الموقف من الردَّة ليس شأنًا دينيًّا صِرْفًا، بل هو نتاج لتفاعل ديني–اجتماعي–سياسي يتغير بتغيُّر السياقات الوطنية والأنماط التاريخية للحكم والتديُّن.
فعلى سبيل المثال نجد أنه في مالي والسنغال، تعاملت الطرق الصوفية –التي تتمتع بثقل اجتماعي وسياسي كبير– مع قضايا الرِّدَّةِ بروح تصالُحية، مُقَدِّمَةً مبدأ السلم الأهلي على الصدام الديني، وهو ما ينسجم غالبًا مع سياسات الدول التي تسْعى لتفادِي النزاعات الطائفية.
في المقابل، شهدتْ نيجيريا جدالات بين علماء سلفيِّين تقليديِّين يُطالبون بتطبيق حرفي للنصوص، وبين دُعاة حضريِّين شُبَّانٍ طرحوا اجتهادات جديدة تُمَيِّزُ بين البُعد العقيدي للرِّدَّةِ كمسألةٍ إيمانيةٍ، والبُعد السياسي الذي ارتبط تاريخيًّا بالخيانة أو التمرُّد ضد الدولة. أما في كينيا وأوغندا، فقد لعبت الجامعات الإسلامية بالتنسيق مع هيئات الإفتاء الرسمية دورًا في تطوير قراءات مقاصدية تراعي مبدأ “لا إكراه في الدين”، بما يربط بين التراث الفقهي ومتطلبات الدولة الحديثة.
وفيما يتَّصل بموقف الدساتير الأفريقية من مسألة الحرية الدينية نجد أنه في بلدان مثل جنوب أفريقيا وغانا وكينيا، نصَّت الدساتير بوضوح على حرية المعتقد، ما دفع المجالس الإسلامية وهيئات العلماء إلى خوض حوارات مع الدولة حول كيفية التوفيق بين هذه المبادئ الدستورية والأحكام الشرعية التقليدية. وفي تنزانيا، قَدَّمَ مجلس العلماء المسلمين مذكرات رسمية للبرلمان تؤكِّد أنَّ الإيمان لا يكون حقيقيًّا إلا إذا كان قائمًا على القناعة، لا على الإكراه القانوني، وهو خطاب يجد صداه في الدساتير الأفريقية الحديثة. أما في نيجيريا، حيث تطبِّق بعض الولايات الشريعة الإسلامية، فما تزال النقاشات حادَّة حول ما إذا كان يجب اعتبار الردة جريمة مدنية تعاقب عليها الدولة أم مسألة إيمانية فردية لا تتدخَّل فيها السلطات.
وعلى صعيد الواقع العملي والتطبيق يمكن الإشارة هنا لبعض النماذج والأمثلة الواقعية؛ ففي كينيا، أصدرت المحكمة العليا حكمًا لصالح شاب اعتنق المسيحية بعد أن تلقَّى تهديدات مجتمعية، مؤكِّدَةً التزام الدولة بالدستور وحماية حرية الأفراد الدينية. وفي مالي، خلال أزمة 2012، حاولت جماعات مسلَّحة فرض عقوبات صارمة على متَّهمين بالردَّة في مدينة “تمبكتو”، لكن أعيان المجتمع والزعامات الصوفية أقنعوا السلطات المحلية بتجنُّب الصدام، مفضِّلين حماية السلم الاجتماعي على تطبيق العقوبات القاسية. أمَّا في جنوب أفريقيا، فقد عمل مجلس القضاء الإسلامي ضمن بيئة قانونية تعدُّدية على إدارة قضايا التحوُّل الديني بما يوازن بين المرجعية الإسلامية وحقوق المواطنة في الدولة الديمقراطية.
رغم هذه التطورات، ما تزال هناك بيئات محلية، خصوصًا في الأرياف أو المناطق المتأثِّرة بالصراعات، تتعامل مع قضية الردَّة بعيون سياسية وأمنية، معتبرةً إياها تهديدًا للنظام الاجتماعي أو ولاء الدولة، لا مجرد خيار ديني فردي. كما تؤدِّي الخطابات الإعلامية المسيَّسة إلى تضخيم الحوادث الفردية وتحويلها إلى معارك أيديولوجية، ما يعقِّد قدرة العلماء والمشرِّعين ومنظمات المجتمع المدني على بناء توافقات رصينة بين القيم الدينية والحقوق المدنية.
القضية الثالثة: الإسلام والأسرة والتربية
تمثِّل الأسرة في المجتمعات المسلمة بأفريقيا حلقة وصل أساسية بين الدين والمجتمع والدولة، إذ تشكِّل المجال الأول الذي تتجسَّد فيه القيم الدينية، وتنتقل عبره أنماط التنشئة الاجتماعية والتعليمية من جيل إلى جيل. ومن خلال الأسرة، تتكوَّن علاقة الفرد بالمجتمع الأوسع، وتُبْنَى أُسُسُ الهوية الدينية والثقافية.
ففي نيجيريا، لا يزال التعليم القرآني في البيوت أو عبر الكتاتيب يلعب دورًا محوريًّا في حفظ النصوص وتعلُّم القيم الإسلامية منذ سن مبكرة. وفي السنغال، أسهمت المحاضر الريفية في تخريج أجيال من حفظة القرآن والعلماء، مَا وَفَّرَ أساسًا متينًا للهوية الإسلامية. هذا الدور التربوي جعل الأسرة وسيطًا رئيسًا بين الدين والدولة، فهي التي تُغَذِّي المجال العام بالقيم الأخلاقية والدينية. وما يقال عن السنغال يقال عن تنزانيا مع فارق الأدوات حيث يتم غرس القيم عبر الأهازيج الدينية والحكايات والقصص الديني.
غير أنه يلاحظ أن أنماط الزواج والأسرة نفسها لم تَبْقَ ثابتة. فقد أدَّت الهجرة نحو المدن الكبرى، وانتشار التعليم الحديث، وصعود الاقتصاد النقدي إلى تفكيك البنى التقليدية للأسرة الممتدَّة، وحلول الأسرة النووية الأصغر حجمًا محلَّها في كثير من السياقات. في كينيا وتنزانيا، أثَّرت العمالة في المدن الساحلية على أنماط الزواج وتوزيع الأدوار داخل الأسرة، بينما أدَّى التعليم المختلط ووسائل الإعلام الحديثة إلى صعود قيم فردية جديدة تناقش مسألة الطلاق، وتربية الأطفال، وعمل المرأة خارج البيت. هذه التحوُّلات أوجدت توتُّرًا بين القيم التقليدية ومتطلَّبات الواقع الجديد، خصوصًا حين تتصادم بعض الممارسات مع القوانين المدنية أو مع حقوق المرأة كما تنصُّ عليها الدساتير الحديثة.
إلى جانب الأسرة، لعبت المؤسسات التعليمية أدوارًا أساسية في صياغة الهوية الدينية. فالمحاضر التقليدية في غرب أفريقيا مثل تمبكتو أو فوتا تورو كانت مراكز إشعاع علمي منذ قرون، بينما شكَّلت المدارس القرآنية والزوايا في شرق أفريقيا فضاءات تربط بين التعليم الديني والاقتصاد المحلي والثقافة السواحلية. ومع دخول الاستعمار ثم الدولة الحديثة، ظهرت الجامعات الإسلامية الكبرى مثل جامعة كانو في نيجيريا أو جامعة الملك فيصل في تشاد، إلى جانب كليات الشريعة في جامعات الخرطوم ودار السلام وكيب تاون. هذه المؤسسات أتاحت تعليما حديثًا يجمع بين العلوم الدينية والدنيوية، لكنها في الوقت نفسه واجهت تحديات تتعلق بالمناهج، وازدواجية المرجعيات، وضعف التمويل، فضلًا عن التسييس أحيانًا.
رغم هذا التنوع، تبقى هناك معوِّقات تؤثِّر على قدرة الأسرة والمؤسسات التعليمية على أداء أدوارها بفعالية. من أبرزها الفقر الذي يحرم الأسر من فرص التعليم الجيد، وتسييس الشأن الديني الذي يحوِّل المدارس الدينية أحيانًا إلى ساحات صراع أيديولوجي، فضلًا عن تأثير العولمة الذي ينقل قيمًا وأنماطًا اجتماعية جديدة قد تُضعف المرجعيات المحلية التقليدية. كما أنَّ ضعف التنسيق بين الدولة والهيئات الدينية والمجتمع المدني يعيق صياغة سياسات تعليمية متوازنة تراعي الهوية الدينية ومتطلبات التنمية معًا.
القضية الرابعة: الإسلام والهوية في أفريقيا جنوب الصحراء
تشكِّل مسألةُ الهوية في أفريقيا جنوب الصحراء تقاطعًا معقَّدًا بين الدولة والمجتمع والإسلام، إذ لم يعد الانتماء الديني قائمًا في عزلة عن الانتماءات القومية أو اللغوية أو العرقية، بل أصبح جزءًا من شبكة واسعة تشمل المواطنة الحديثة والتحولات السياسية والعولمة الرقمية. هذا التداخل أنتج هُويات مرنة ومتغيِّرة تتفاعل مع سياسات الدولة وحراك المجتمع المدني وأدوار المؤسسات الدينية، ما يجعل دراسة الهوية الدينية مدخلًا أساسيًّا لفهم العلاقة بين الأطراف الثلاثة.
من أبرز السِّمات هنا الطابع المركَّب للهُوية عبر المزج بين الديني والوطني واللغوي. ففي السنغال، يشارك المسلم السنغالي في الحياة السياسية ويتحدَّث الولوفية أو البولارية، بينما يحتفظ بانتمائه للطريقة المريدية أو التيجانية، ما يخلق فضاءً متعدد الطبقات تتكامل فيه الانتماءات الدينية والقومية والمحلية تحت إشراف الدولة الحديثة. وفي نيجيريا، المسلم الهوساوي أو اليورباوي منخرط في خطاب المواطنة لكنه مرتبط أيضًا بجماعته الدينية، ما يضعه أحيانًا في قلب التوتُّرات بين الدولة والجماعات. أمَّا في تنزانيا، فيرى المسلم السواحلي نفسه جزءًا من هوية بحرية عابرة للحدود تستند إلى قرون من التواصل التجاري والثقافي، ما يوازن بين الولاء الوطني والانتماء الحضاري الأوسع.
كما أسهمت الهجرات الداخلية والخارجية في تشكيل هُويات عابرة للدولة. ففي السنغال، لعبت الطرق الصوفية مثل المريدية والتيجانية دورًا رئيسيًّا في تشجيع الهجرة، حيث يموِّل المهاجرون في أوروبا مشاريع التعليم والصحة والزراعة في مدينة طوبى، جامعِين بين القيم الحديثة والولاء الديني التقليدي. وفي شمال نيجيريا، أوجدت الهجرات إلى مدن مثل كانو وأبوجا طبقة متعلمة من الشباب المسلمين المنخرطين في الاقتصاد الحديث، فيما أسَّس المهاجرون في بريطانيا والخليج مساجد ومراكز تربطهم بالبلد الأم وتمول التعليم والتنمية، ما غذَّى النقاشات حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي زنجبار والساحل الكيني، أنتجت الهجرات إلى الخليج وأوروبا هوية سواحلية عابرة للحدود، يوظِّف شبابها وسائل التواصل لنشر خطابات إصلاحية حول الديمقراطية والتعليم وحقوق المرأة. وفي دول مثل أوغندا ومالاوي وجنوب أفريقيا، حيث المسلمون أقلية، أصبحت المؤسسات الدينية شريكًا أساسيًّا للدولة في التعليم والصحة والعمل الأهلي. ففي جنوب أفريقيا، أسس مجلس القضاء الإسلامي والمدارس والجمعيات الخيرية بنية تحتية تحافظ على الهوية الإسلامية وتعمل ضمن الأطر القانونية للدولة التعدُّدية. أمَّا في أوغندا، فقد نظَّمت الجمعيات الإسلامية مبادرات للتعليم والصحة والتنمية الريفية، ما جعلها فاعلًا مدنيًّا يتكامل مع مؤسسات الدولة.
لكن هذا التفاعل يواجه معوِّقات عدَّة. فالضغوط السياسية في بعض الدول تجعل الانتماء الإسلامي محل ريبة، خاصة عند تقاطع الحركات الإسلامية مع المعارضة. كما تؤدِّي التوتُّرات الدينية، كما في ولايات الوسط في نيجيريا، إلى مواجهات بين المسلمين والمسيحيِّين، بينما تدفع العولمة الثقافية الشباب نحو قيم فردانية واستهلاكية تخلق فجوة مع أنماط التديُّن التقليدي.
تكشف هذه الخبرات أن الهُوية الدينية في أفريقيا تتشكَّل ضمن فضاءات سياسية واقتصادية وثقافية متداخلة، تتأثر بالعولمة والهجرة والتحولات الرقمية، لكنها تبقى جزءًا من مشاريع الدولة والمجتمع الأهلي، ما يجعلها عنصرًا محوريًّا لفهم حاضر الإسلام ومستقبله في القارة.
القضية الخامسة: الإسلام وتعاقب الأجيال
يشكِّل تعاقبُ الأجيال في المجتمعات المسلمة بأفريقيا جنوب الصحراء ساحة مركزية لفهم العلاقة المركَّبة بين الإسلام والدولة والمجتمع. فانتقال القيم والممارسات الدينية من جيل لآخر لا يحدث في فراغ، بل يتأثر بالبنى السياسية، والتغيرات الاجتماعية، والتحولات الثقافية والاقتصادية. ومن هنا، فإن دراسة هذا المحور تكشف كيف يحافظ الإسلام على استمراريته التاريخية، ويواكب في الوقت نفسه متغيرات الدولة الحديثة والمجتمعات الحضرية الجديدة.
فعلى صعيد مسألة الاستمرارية والتجديد نجد أنه في مناطق مثل “كانو” و”سوكتو” في نيجيريا، و”دكار” في السنغال، ما تزال المؤسسات الدينية التقليدية –المحاضر القرآنية، والزوايا الصوفية، والجمعيات الدعوية– تقوم بدور رئيس في صياغة القيم الاجتماعية التي تستند إليها شرعية الدولة وأعراف المجتمع. لكن هذه المؤسسات نفسها تبنَّت الإعلام الرقمي والتعليم النظامي الحديث، ما يعكس تفاعلها مع الدولة الحديثة التي تفرض نظمًا تعليمية وقانونية جديدة. هنا يظهر الإسلام كجسر بين القيم الأخلاقية المتوارثة ومتطلبات الحياة السياسية والمدنية المعاصرة.
في المقابل نجد تصاعدًا لظاهرة الدُّعاة الجدد والإعلام الرقمي باعتبارهم فاعلين في المجال العام، ففي مدن مثل لاجوس، ونيروبي، وجوهانسبرج، يوظف دعاة شباب الإعلام الرقمي لصياغة خطاب ديني يتجاوز قوالب السلطة التقليدية، سواء سلطة الدولة أو سلطة النخب الدينية. ويناقش قضايا مثل المواطنة، والعدالة الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، ما يجعل تلك الحركات والجماعات طرفًا جديدًا في العلاقة بين الدين والدولة والمجتمع، حيث تراقب السلطة وتنتقد السياسات أحيانًا، وتقترح رؤى إصلاحية أحيانًا أخرى.
وقد أسْفرت تلك الظواهر عن تفاعلات وعمليات تأثير وتأثُّر بين أطراف العلاقة ففي السنغال وغانا، على سبيل المثال، بدأ شيوخ الطرق الصوفية والجمعيات التقليدية في استضافة ناشطين شباب لاستخدام التكنولوجيا والإعلام الرقمي في نشر تعاليمهم، فيما انخرط الشباب في مؤسسات إغاثية وتعليمية ذات جذور تقليدية. هذه الشراكات توضِّح أنَّ العلاقة بين الإسلام والدولة والمجتمع ليست خطية، بل هي شبكة من التفاعلات، حيث يقدِّم الجيل الجديد أدوات جديدة للتأثير العام، بينما توفِّر المؤسسات التقليدية الشرعية والخبرة التاريخية.
رغم هذه الجسور، تعترض العلاقة بين الأجيال عدَّة عقبات: في مقدِّمتها التوترات ما بين الدولة والتنظيمات والمؤسسات الإسلامية قديمها وحديثها، حيث تتوجَّس بعض الحكومات من المنابر المستقلة التي تنتقد سياساتها أو تطرح قراءات دينية غير خاضعة للرقابة الرسمية.
وتمثِّل الفجوة الثقافية بين الأجيال تحديًا آخر حيث يرى التقليديون أنَّ الخطاب الشبابي يفتقر للعمق الشرعي، بينما يرى الشباب أنَّ المؤسسات الدينية بطيئة في مواكبة تحولات المجتمع والدولة.
ويمثِّل تسييس الدين تحديًا ثالثًا على هذا الصعيد، وذلك حينما تستغل أطراف سياسية بعض القيادات التقليدية أو الشبابية لإضفاء شرعية دينية على مواقفها، ما يثير انقسامات داخل المجتمع.
القضية السادسة: الإسلام والثقافة العامة
تشكِّل الثقافة العامة في المجتمعات الأفريقية فضاءً تتقاطع فيه السياسة والدين والمجتمع، حيث لا ينحصر حضور الإسلام في مؤسسات التعليم أو المساجد وحدها، بل يمتدُّ إلى الفنون، واللغة، والعادات اليومية، والممارسات الرمزية. ومن خلال هذا الحضور المتعدد، يصبح الإسلام فاعلًا ثقافيًّا يؤثر في تشكيل الهوية، وتوجيه القيم، والتفاعل مع الحداثة والتقاليد في آن واحد. وفي إطار بحث العلاقة بين الدولة والمجتمع والإسلام، تساعدنا دراسة هذه الأبعاد الثقافية على فهم كيف يتجاوز الإسلام حدوده المؤسسية ليصبح جزءًا من الحياة اليومية والخيال الجمعي، مع ما يرافق ذلك من مقومات وفرص، وكذلك من تحديات ومعوّقات.
فعلى صعيد التديُّن الشعبي والفنون: يظهر الإسلام في الثقافة الشعبية عبر الأناشيد الصوفية، والموسيقى الدينية، والاحتفالات بالمناسبات الإسلامية مثل المولد النبوي، والتي تمزج بين الروحاني والدنيوي. ففي السنغال، تحوَّلت مدائح الطرق الصوفية إلى فنون جماهيرية يتابعها الملايين من خلال مهرجانات مثل غران ماغال طوبى الذي يحضره ملايين المريدين سنويًّا، ويحظى بدعم رسمي من الدولة لما يمثله من سياحة دينية واقتصادية. وفي نيجيريا، يقدِّم قطاع “نوليوود الإسلامي” أفلامًا دينية تتناول قضايا الأخلاق والدين، ويؤثر في النقاشات العامة حول التدين الشعبي والتحديث. أما في تنزانيا، فتنتشر فرق الإنشاد الديني في رمضان وعيد المولد، وتلقى حضورًا واسعًا حتى في المدن الكبرى.
وعلى صعيد اللغة والهوية: تعد اللغة أداة مركزية في ترسيخ الهوية الدينية والثقافية. وفي تنزانيا وكينيا، ساهمت اللغة السواحلية في دمج المفردات الإسلامية في الثقافة المحلية، حيث نجد أسماء الأماكن، والتحيات اليومية، وحتى الأمثال الشعبية ذات جذور عربية-إسلامية، مثل تحية “السلام عليكم” التي أصبحت مألوفة حتى لدى غير المسلمين. في النيجر ومالي، ولعبت العربية واللغات المحلية بالحروف العربية (العَجَمي) دورًا في التعليم التقليدي ونقل الثقافة الإسلامية قبل الاستعمار، ولا تزال تحتفظ بمكانة رمزية رغم تراجعها أمام الفرنسية والإنجليزية في العصر الحديث. كما أن بعض الحكومات، مثل حكومة تنزانيا، اعتمدت سياسات لدعم السواحلية كلغة وطنية موحَّدة، ما ساعد في دمج الهوية الإسلامية داخل خطاب قومي جامع.
وفيما يتصل بالحداثة والتقاليد: نجد أنه في المدن الكبرى مثل لاجوس ودكار ونيروبي، يتفاعل الإسلام مع مظاهر الحداثة مثل الإعلام الرقمي، والجامعات الحديثة، والأنماط الجديدة للباس والعمران، بينما تحافظ المناطق الريفية على طرق صوفية تقليدية وأنظمة تعليمية محلية كالكتاتيب. ففي جنوب أفريقيا، أنشأت الجمعيات الإسلامية قنوات إذاعية رقمية لبث خطب الجمعة والبرامج التعليمية، ما أتاح للشباب خطابًا دينيًّا يتناسب مع الحياة الحضرية الحديثة. وفي المقابل، لا تزال قرى في شمال نيجيريا أو مالي تتمسَّك بالتعليم القرآني التقليدي كنظام أساسي لبناء الهوية الدينية. هذا التعايش بين الحداثة والتقاليد يولِّد مساحات للتفاوض بدل الصراع، حيث تجد الطرق الصوفية نفسها مضطرَّة لاستخدام وسائل الإعلام الاجتماعي لجذب الشباب والحفاظ على نفوذها.
ورغم هذه الحيوية الثقافية، تواجه العلاقة بين الإسلام والثقافة العامة عدَّة معوِّقات من بينها أن البعض يرى في الفنون الدينية المعاصرة خروجًا عن الورع التقليدي، بينما يتَّهم آخرون التعليم الديني المحلي بالجمود أمام التحديث. كما تؤدِّي سياسات بعض الحكومات، التي تفضِّل لغات المستعمر أو تهمِّش اللغات المحلية، إلى إضعاف الجسور الثقافية التي تربط الإسلام بالهُوية الوطنية. أضفْ إلى ذلك أن وسائل الإعلام العالمية كثيرًا ما تقدِّم مظاهر التديُّن الشعبي بصورة فلكلورية سطحية، متجاهلة عمقها الروحي والاجتماعي؛ الأمر الذي يقلِّص فاعليَّته، لا سيما مع الأجيال الجديدة.
القضية السابعة: الإسلام والسياسة
في إطار العلاقة المركَّبة بين الدولة والمجتمع والإسلام، لم يكن حضور الإسلام في أفريقيا مقتصرًا على العبادات أو التعليم الديني، بل امتدَّ ليؤدِّي أدوارًا سياسية واجتماعية متباينة بحسب السياقات. ففي بعض الحالات، يعمل الإسلام كمصدر للقيم العامة وموجِّهٍ أخلاقي، وفي حالات أخرى يمارس دور القوة الاجتماعية المستقلة التي تراقب السلطة وتطالبها بالإصلاح والمساءلة، بينما في سياقات ثالثة يتحوَّل إلى شريك في الحكم وصنع القرار. هذا التنوُّع يعكس ثراء التجربة الإسلامية في القارة ويكشف تفاعلات متشابكة بين الدين والدولة والمجتمع المدني.
ففي بلدان مثل السنغال ومالي، قدَّمت الزوايا الصوفية والعلماء المسلمون مرجعية أخلاقية توجِّه الحياة العامة والسياسية دون أن يتحوَّلوا إلى أحزاب أو سلطات حاكمة. فعلى سبيل المثال، لعبت المريدية في السنغال دورًا في تعزيز قيم السلم الأهلي وضبط التوتُّرات الاجتماعية، كما لجأت الحكومات المتعاقبة إلى القيادات الدينية طلبًا للدعم الأخلاقي في أوقات الأزمات. هذا النموذج يجعل الإسلام إطارًا للقيم العامة، لا أداةً للصراع السياسي المباشر، لكنه في الوقت نفسه يوفِّر شرعية مجتمعية لا تستطيع الدولة تجاهُلَها.
وعلى صعيد آخر، لعبت التنظيمات الإسلامية والمجتمع الديني دور الرقيب الاجتماعي الذي يطالب بالإصلاح ويحاسب السلطة دون أن يسعى بالضرورة إلى تقاسم الحكم معها. ففي جنوب أفريقيا، مثلًا، أسهمت الجمعيات الإسلامية في مراقبة التزام الدولة بقيم العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات الدينية بعد سقوط نظام الفصل العنصري، بينما في السنغال، وقفت بعض الحركات الشبابية ذات الخلفية الإسلامية –مثل حركة يونَّامار– ضد محاولات التمديد الدستوري للرئيس عبد الله واد عام 2011، وطالبت بإصلاحات سياسية أوسع، مستخدمة خطابًا يمزج بين المرجعية الدينية ومفاهيم المواطنة الحديثة.
وفي حالات ثالثة، انتقل الإسلام من مجرد مرجعية أخلاقية إلى شريك فعلي في السلطة أو في مؤسسات صناعة القرار. في نيجيريا، على سبيل المثال، جاء اعتماد الشريعة في بعض الولايات الشمالية منذ مطلع الألفية نتيجة لتحالفات بين الحركات الإسلامية والحكومات المحلية، حيث أسْهم العلماء المسلمون في صياغة القوانين وإدارتها. أمَّا في تنزانيا، فقد شاركت الجمعيات الإسلامية في تطوير التعليم والصحة ضمن اتفاقيات رسمية مع الدولة، ما جعلها شريكًا في التنمية وصياغة السياسات الاجتماعية، لا مجرد قوة ضغط من الخارج.
رغم هذا التنوُّع، تواجه أدوار الإسلام السياسية في أفريقيا تحديات عدَّة. فالدول تخشى أحيانًا من تنامي قوة التنظيمات الإسلامية بما قد يهدِّد توازناتها الداخلية، كما أنَّ بعض الحركات الإسلامية تُعاني من انقسامات فكرية أو ضعف في الخبرة المؤسَّسية، ما يَحُدُّ من فاعليَّتها في الحكم أو المعارضة. يضاف إلى ذلك أنَّ توظيف بعض النُّخب للخطاب الديني في صراعاتها السياسية يُفقده مصداقيَّته الأخلاقية، ويُثير مخاوف الأقليات الدينية والفاعلين المدنيِّين الآخرين.
وهو ما يستدعي منا تحليلًا دقيقًا لطبيعة العلاقة بين الإسلام والسياسة في كلِّ بلد، بعيدًا عن التعميم، مع إدراك أن التديُّن في أفريقيا ليس غريبًا عن المجال العام، بل جزءٌ منه، سواء كان ذلك بالمشاركة، أو التوجيه، أو الرقابة والمعارضة.
في ختام هذه الورقة أودُّ التأكيدَ على أن ما سَعَيْتُ إلى توضيحه في هذه المحاضرة هو أن الإسلام في أفريقيا لا يمكن فهمه إلا من خلال تتبُّع خيوط العلاقة المعقَّدة التي تربطه بالمجتمع والدولة، لا باعتباره عنصرًا خارجيًّا يُسقَط على الواقع، بل كفاعل حيٍّ يتشكَّل ضمنه ويُعيد تشكيله. فالدين ليس مجرد منظومة عقيدية، بل هو لغة مجتمعية تُصاغ بها العلاقات، وتُبنى بها المعاني، وتُعَبِّرُ من خلالها الجماعات عن ذاتها في مواجهة تحديات الواقع. والمجتمع ليس خلفية سلبية للدين، بل هو الحاضن الذي يمنح التديُّن أشكاله، وسياقاته، وشرعيته. أما الدولة، فليست دائمًا مصدر التنظيم أو السيطرة، بل كثيرًا ما تكون طرفًا تفاوضيًّا، يتأثَّر بالتديُّن الشعبي بقدْر ما يسْعى إلى ضبطه.
لقد قامت هذه الورقة على ثلاثية مترابطة: هي تفكيك الخطايا السبعة، التي تُشَوِّهُ إدراكَنا لعلاقة الإسلام بالدولة والمجتمع في أفريقيا، وطرح سبع وصايا، كبوصلة لإعادة بناء الفهم على أساس من التواضع والسياق والاحترام. وأخيرًا، عرض سبع قضايا تطبيقية، جسَّدت هذا التفاعل الحي بين المفاهيم الثلاثة، كما يُعاش في الحياة اليومية لا كما يُصاغ في النظريات الجاهزة. وكلي أمل أن أكون قد نجحت في تقديم ما يستحق الاستماع وما يثير الأذهان والنقاش.
اتجاهات النقاش
أثارت المحاضرة عدَّة أسئلة ونقاشات بين الحضور، كما جلبت تعليقات متنوعة، منها ما يتصل بتكوين الباحث في الشؤون الأفريقية، حيث أشارت بعض المداخلات إلى أن الباحث يحتاج أن تكون له تجربة وواقع مُعايش في أفريقيا، وبالتالي نحتاج إلى منحة للطلاب المهتمين بالشؤون الأفريقية تمكِّنهم من الاحتكاك بالواقع الأفريقي عبر زيارة هذه الدول الأفريقية، وهي جزء مهم من صناعة الباحث الذي نحتاجه.
ومنها ما يكمل جوانب تتعلَّق بفهم القارة الأفريقية وجوارها الحضاري، إذ لأفريقيا جوارين؛ جوار استعماري أساسه مصلحي مادي بحت، وجوار أصلي حضاري ممثلٌ في شرق أفريقيا والجزيرة العربية، فهناك اتصال دائم ومستمر بينهما، وبين المغرب العربي وغرب أفريقيا. ولكن جزءًا أساسيًّا في تشكيل رؤيتنا ومعرفتنا هو ارتباطنا بالخرائط الغربية (سواء الجغرافية أو حتى الأجندة البحثية).
كما اتصل بعضها بدور الاستعمار وتأثيره في القارة وفهم قضاياها المعاصرة انطلاقًا من خطورة التغريب في المجتمعات الأفريقية، رغم أنه كان مصاحَبًا دائمًا بمقاومة عسكرية ومدنية. ومقاومة هذه التحديات ترتبط بالتجديد والإصلاح في عالم الأفكار، ومنها إصلاح الرؤية إلى المرأة ومكانتها انطلاقًا من الإطار الديني الإسلامي، ومسألة احترام الوقت، وتجديد النظم السياسية لسياساتها، خاصة في علاقتها بالقوى الغربية.
كما أشارت بعض التعليقات إلى طبيعة سياسات دول العالم الإسلامي تجاه أفريقيا، مؤكِّدة أنها بحاجة لتنسيق الجهود فيما بينها، وذلك لتكون قائمة لا على أساس التنافس والصراع، وإنما على أساس خدمة أفريقيا من ناحية، والاستفادة من تراجع النفوذ الغربي في القارة من جانب آخر، والاستفادة من الثروات والفرص الموجودة في القارة من جانب ثالث.
كما طُرحت بعض الأسلة عن دور البُعد الدولي في معادلة الإسلام والمجتمع والدولة في أفريقيا، ودوره في رسم صورة الإسلام في أفريقيا، وآلية ممارسته، وهل خدمت هذه التدخلات الإسلام ونشره، أم كانت جزءًا من تأجيج الصراعات خاصة في ظل استخدام بعض الدول لجانب تمويل بعض الطوائف الإسلامية على حساب أخرى من أجل تحقيق أهداف سياساتها. وكذلك، عن تأثير الإسلام والمسلمين في الدول التي فيها حراك سياسي كبير، وانقلابات عسكرية من دول غرب أفريقيا (بوركينا فاسو – مالي – النيجر)، وهل كان للإسلام دور في إذكاء هذا الحراك أم لا؟ وكيف؟
تعليق د. مدحت ماهر: أفريقيا في رؤية الإسلام.. أو أفريقيا الكتاب والسنة
عندما نبحث في القرآن والسنة عن الأرض والقارات لا نجد ذكرًا للقارات فيها، فلم تُذكر مثلًا قارة آسيا أو أفريقيا بالاسم، ولكن نجد ذكر الأرض المباركة والأرض المقدسة، وأدنى الأرض وأقصى الأرض، وأوسط الأرض التي جاءت فيها النبوات. وهنا نلاحظ أن ذكر أفريقيا جاء في السنة النبوية من مدخل الحبشة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “اتركوا الحبشة ما تركوكم”. والحبشة كانت غالبًا رمزًا لكلِّ التكوين الأفريقي.
وفي تفسيري أن هذا يتَّفق مع ما طرحتْه المحاضرة، أي بمعنى انظروا لهم (للأفارقة) بعيونهم. والتجربة الإسلامية كانت تترك الإفريقيين وشأنهم بخلاف تجربة الاستعمار الأوروبي. ومن هنا يمكن أن نوضح أن أفريقيا و(الأفارقة) في السنة، جاءت في السياقات التالية:
- يُطلق عليها اسم السودان، أو الحبشة، أو الأحباش، أو أرض الحبشة، أو بني أرفدة (على أساس إن كان لهم جد أفريقي عربي)
- أنهم ينبغي أن يحرروا، أي لا تفرضوا نفسكم عليهم.
- أنهم يحبون اللعب والرقص والغناء حتى في قلب ممارسة التدين الإسلامي. فكانوا يرقصون في المسجد، والصحابة يرون أن المسجد للعبادة، وسيدنا عمر لما رآهم على هذا الحال أمر بتركهم وفقًا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم.
- عبر التاريخ كثيرًا ما يُظلمون ولا يَظلمون، فسيدنا بلال ظُلم لإسلامه، ولكن من عظمة الإسلام أن جعل رمز الحبشة هو المنادي باسم الإسلام (وهو المؤذن)، والأذان من شعائر الإسلام الظاهرة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «إن بأرض الحبشة ملِكًا لا يُظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجًا ومخرجًا مما أنتم فيه».
وهذه المعاني تعطي سمات مُحسنة لظن المسلمين بعضهم ببعض، وبالأفارقة بوجه خاص، وهي تحتاج لأن نطرقها وندرسها.
تعليق د. نادية مصطفى:
هذه السلسلة عن المجتمعات الإسلامية، وثلاثية الدولة والمجتمع والإسلام، انطلقت من سؤال رئيس: ما موضع الإسلام من منظومات التجدُّد الحضاري الذي نسعى إليه ونفتقده سواء في مستواه السياسي والاقتصادي أو الثقافي أو مجتمعين معًا؟
ونحن وفق رؤيتنا الحضارية نقول: إن الداخل مهم، والبيني أهم، والخارجي مهم لكن يتجلَّى تأثيره على مستوى الأمة على حسب العلاقة بين الداخلي والبيني.
وهذه المحاضرة تُقدم مفهومًا جديدًا عن السياسة بصفة عامة، بالتطبيق على حالة أفريقيا في إطار العلاقة الثلاثية بين الدولة والإسلام والمجتمع، وفي إطار ثلاثية الخبرة التاريخية المتعلِّقة بدخول وانتشار الإسلام (ما قبل الاستعمار)، وأثناء الاستعمار، وما بعده.
ولكن هل لنا أن نتساءل: ما مصدر التعميمات والتشويهات حول أفريقيا والمجتمع والإسلام؟ هل كتابات أفريقية وعربية؟ أم كتابات أجنبية؟ أم كتابات أفريقية متأثرة بالكتابات الأجنبية (الإنجليزية والفرنسية خاصةً)؟
ومن ثمَّ، فقد تصدَّرت إشكالية العروبة والزنوجة في كل ما يخص تناول أفريقيا، فدائمًا ما يكون هناك فصل بين أفريقيا العربية، وأفريقيا جنوب الصحراء، حتى إن هذه المحاضرة ركَّزت على أفريقيا جنوب الصحراء وليس كل أفريقيا.
وسؤال آخر عن اتحاد دول أفريقيا، هل دائمًا الاتحاد هو الطريق الوحيد الذي سيُفضي إلى القوة في حالة أفريقيا؟ أم أن هناك نموذجًا أو نماذج أخرى غير الاتحاد قد تحقِّق القوة للقارَّة وشعوبها دون تحقيقها على النمط الأوروبي / الغربي (الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلنطي)؟ فهل القبلية والتنوُّع هي وراء العسكرة والتخلُّف كما يقول الغرب؟
وبعد هذه المحاضرة، يبقى على الباحثين بعد استعراض جزئي لتفاصيل القضايا والموضوعات المتعلقة بالإسلام والدولة المجتمع هو الوصول إلى أنماط بشأن هذه القضايا لنتوصل إلى الوضع الحالي عن صورة الإسلام في المجتمعات الأفريقية، التي تحتفظ بنمط معين عن الإسلام، أقرب إلى الإسلام الفطري للمجتمعات بعيدًا عن نموذج الدولة القومية القوية. وهو ما يدفع في الأخير إلى الحديث عن الأمة كمستوى للتحليل، وعن الإسلام كحضارة جامعة لمكونات متنوعة للأمة من آسيا لأفريقيا إلى أوروبا وأمريكا.
تعقيب ختامي من د. محمد عاشور:
أشار د. محمد عاشور في تعقيبه بشأن الاستعمار وتأثيره إلى أن القول بأن التأخُّر والمشكلات التي وقع فيها العالم الثالث والأمة الإسلامية والمجتمعات في أفريقيا هو الاستعمار يؤدِّي إلى ثلاث نتائج سلبية، رغم عدم نفينا لمسؤولية الاستعمار عن مآلات الأمور في هذه المجتمعات، هذه النتائج هي:
- إعفاء النخب الحاكمة من مسؤوليتها تجاه هذه التحديات تحت دعوة الاستمرار في مواجهة الاستعمار لأنه لم يخرج من القارة، فلا يكلمنا أحد عن الفساد وسوء الإدارة وغيرها لأننا في مواجهة مع الاستعمار.
- تضليل المجتمعات والشعوب، وتغذية فكرة الضحية، وصرفهم عن المشكلات الأساسية من تعليم وصحة و..، وتوجيه الوعي العام الداخلي نحو الخارجي بدلًا من المشكلات الداخلية.
- إنكار النجاحات الأفريقية، فمثلًا رواندا رغم أنها خرجت من إبادة وحروب أهلية، فإنها وصلت لأن تكون الدولة الأولى في الطرق والمواصلات في أفريقيا، ويوجد نموذج غانا وبتسوانا في الديمقراطية، وجنوب أفريقيا حققت جوانب نهضوية كثيرة إلى حدٍّ ما.
أما عن دور التعدُّدية الإثنية في أفريقيا، فأكَّد الدكتور عاشور، أنها ليست سببًا في حدِّ ذاتها دائمًا في الحروب والصراعات، فالتعددية هي مُعطى، يمكن أن يكون عاملًا للوحدة، كما يمكن أن يكون عاملًا للصراع. فالحضارة الإسلامية قامت على شعوب وأعراق متنوعة وأقامت بينها وحدة تأسَّست عليها الحضارة.
وفي الأخير، أوضح أننا لا زلنا مستهلكين للإنتاج الغربي عن أفريقيا، مع وجود اتجاهات نقدية للانتقال من مستوى “السياسات العليا High politics” إلى مستوى الموضوعات الجزئية والمجتمعات المحلية، والكيانات من غير الدول داخل القارة، مع استمرارية الاهتمام بالأبعاد المتعلقة بالدين والثقافة واللغة والحضارة وتأثيرها على السياسية. ولكن لا يزال لعمليات التمويل أثر في تحديد وجهة الدراسات الأفريقية، فمن “يمول هو من يُحدد النغم”. وإن كان هذا البُعد تراجع في الوقت الراهن، لكن قلة التمويل تحدُّ من الوصول إلى نتائج عميقة ودقيقة بشأن المجتمعات الأفريقية، التي تحتاج الأبحاث فيها إلى تمويل من أجل السفر والتنقُّل بين دول ومجتمعات القارة.
—————————————–
الهوامش:
[1] انظر تقرير اللقاء على موقع المركز:
– التحديات الداخلية والخارجية أمام العالم الإسلامي.. المسار عبر ربع قرن، https://cutt.us/GXyEr
[2] انظر تقرير اللقاء على موقع المركز:
– المجتمع والثقافة في مجتمعات جنوب شرق آسيا.. إندونيسيا نموذجًا، https://cutt.us/l2Ctj
[3] انظر تقارير هذين اللقاءين على موقع المركز:
– عبير ربيع، الجديد في الدراسات الأفريقية، 27 نوفمبر 2025، https://cutt.us/AXSSR
– أحمد علي سالم، التحولات السياسية في غرب إفريقيا: مداخل للفهم، https://cutt.us/9C5I9
[4] يمكنكم مطالعة الدراسات والتقارير التي كتبها أ. د. محمد عاشور بالتعاون مع مركز الحضارة على النحو التالي:
(أ) الأعمال المنشورة ضمن حولية أمتي في العالم:
– زيارة الرئيس الأمريكي لإفريقيا بين الضغوط الداخلية ومساعي الهيمنة، العدد الأول.
– النزاع الإثيوبي – الإريتري: الأسباب الداخلية والانعكاسات الإقليمية والدولية، العدد الأول.
– التطورات السياسية في نيجيريا ومعضلة التحول الديمقراطي في إفريقيا، العدد الأول.
– الصومال: عقد من الصراع، العدد الثاني.
– السودان: تنافس المبادرات وصراع الإرادات، العدد الثاني.
– قمة سرت الإفريقية الطارئة ومشروع الوحدة الإفريقية: آفاق الفكرة وقيودها، العدد الثاني.
– حول مفهوم الأمة وتحدياتها في إدراكات الطلاب الأفارقة الدارسين في الأزهر، العدد الثاني.
– مشكلات التعددية الدينية والإثنية في جنوب السودان (بالمشاركة مع د. حمدي عبد الرحمن)، العدد الثالث.
– أحداث اليوم الأمريكي وقضايا المسلمين في إفريقيا، العدد الخامس.
– جولة بوش الإفريقية: المحاور والأهداف، العدد السادس.
– أفريقيا بين التنافسات الدولية والأوضاع الداخلية، العدد الثامن.
– الإسلاميون والحكم في نيجيريا: تجربة محمد بخاري نموذجًا، العدد الرابع عشر.
– الإسلاميون والحكم في الصومال: فشل التجربة أم إفشالها؟، العدد الرابع عشر.
(ب) الأعمال المنشورة ضمن فصلية قضايا ونظرات:
– الاستقطاب في السياسة السودانية ودوره في صناعة الأزمة، قضايا ونظرات، العدد الرابع والثلاثون – يوليو 2024.
– تحديات ومآلات الإقليمية الأفريقية، قضايا ونظرات، العدد السابع والعشرون – أكتوبر 2022.
– ثمار شد الأطراف: سياسة إسرائيل تجاه أفريقيا، قضايا ونظرات، العدد الثامن – يناير 2018.
– سد النهضة: تحولات وتحديات، قضايا ونظرات، العدد الأول، مارس 2016.
تقرير اللقاء من إعداد الباحث/ أحمد خليفة