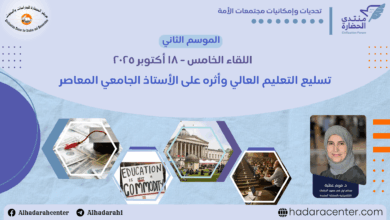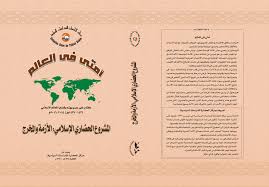المجتمع والثقافة في مجتمعات جنوب شرق آسيا.. إندونيسيا نموذجًا
منتدى الحضارة 2 - اللقاء الثاني

تقديم د. مدحت ماهر:
يأتي هذا الموسوم الجديد من منتدى الحضارة ليدور حول: “الإسلام والثقافة والمجتمع في العالم الإسلامي” وهي موضوعات وأبعاد في غاية الأهمية ذات صلة بالمنظور الحضاري الشامل، وإن كان مركز الحضارة للدراسات والبحوث يُعنى أكثر بالأبعاد الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية فإن هذه الأبعاد غير منفصلة عن الاجتماعي والثقافي والحضاري بمعناه الأوسع. وهذا اللقاء هو ثاني لقاءات منتدى الحضارة هذا العام. الأول كان مع الأستاذة الدكتورة نادية مصطفى حول: التحديات الداخلية والخارجية أمام العالم الإسلامي.. المسار عبر ربع قرن[1]؛ ليضع الإطار العام والسياق الأكبر لهذا الملتقى. واليوم نحن مع لقاء مهم يتَّصل بمناطق العالم الإسلامي في الشرق عن: “المجتمع والثقافة في مجتمعات جنوب شرق آسيا.. وبخاصة في إندونيسيا”.
ومُحاضِرة هذا اليوم هي الأستاذة الدكتورة أماني برهان الدين لوبيس، رئيسة مجلس العلماء الإندونيسي لشؤون المرأة والشباب والأسرة (منذ ٢٠١٦ حتى الآن)، ورئيسة سابقة لجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا – إندونيسيا (٢٠١٩-٢٠٢٣). ولدت د. أماني في مصر ثمَّ سافرت إلى إندونيسيا، ومنها عادت إلى مصر لتكمل دراستها في الأزهر الشريف؛ فالتحقت بمراحل التعليم الإعدادي والثانوي بمصر كما حصلت على ليسانس اللغات والترجمة من جامعة الأزهر بمصر عام 1988. وبعدها حصلت على الماجستير والدكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلامية من جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا.
واهتمام مركز الحضارة بمجتمعات ودول العالم الإسلامي بدأ مع أول حولية من حوليات “أمتي في العالم” (صدرت 1999)، واستمرَّ هذا الاهتمام بشرق آسيا وإندونيسيا ممتدًّا عبر إصدارته المختلفة في الحولية، وفصلية قضايا ونظرات[2].
تقديم د. نادية مصطفى:
بعد الترحيب بالضيفة الكريمة، أود أن أشير إلى أن هذا اللقاء هو لقاءٌ شاهدٌ على تفاعل الأمة عبر الشعوب، وعبر الحدود من خلال مؤسسة الأزهر الجامعة لنا جميعًا، ومن خلال المؤسسات الإندونيسية الإسلامية التعليمية التثقيفية التي تمتدُّ أيديها دائمًا خارج إندونيسيا الى أرجاء الأمة كما يمتدُّ أبناء الأمة بأيديهم إليها عبر الحدود. كما أعبر عن اعتزازي بوصفي امرأة مسلمة بامرأة تعلَّمت وسافرت وجاهدت في مجال العلم والفكر على أكثر من مستوى. وهذا علامة من علامات وضع المرأة في الإسلام، وتأثيرها في مجتمعاتها، ابتداءً من النواة الصغيرة (الأسرة)، وصولًا لأعلى المؤسسات في المجتمعات والدول.
إن مجال اهتمامنا الفكري والعملي في مركز الحضارة هو الأمة، وأمتي في العالم من منظور حضاري إسلامي، وهو منظور للنظر والتدبُّر والتأمُّل، يخترق التخصُّصات البينية؛ فبالرغم من أنَّنا ننطلق من تخصُّص العلوم السياسية، ولكننا عبر البينية الممتدَّة بين فروع العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية والعلوم الشرعية نقدِّم بحوثنا ودراساتنا وفق ما تسمِّيه أستاذتنا المرحومة الدكتورة منى أبو الفضل ضمن مجال «الدراسات الحضارية».
ونحن وقد سبق لنا الاهتمام بالقضايا الساخنة (ذات الطبيعة الصلبة): قضايا السياسات العليا مثل الحروب والاقتصاد والدبلوماسية والصراعات فإننا لم نغفل أبعاد الدين والثقافة والهوية في إطار هذه القضايا، ودراستها أحيانًا بصفة مستقلة. وهذا المنتدى يهتمُّ بالقضايا الأخيرة على مستوى الشعوب وعبر المجتمعات الإسلامية لننقل الاهتمام من الجوار الحضاري الضيق ممثلًا في تركيا وإيران إلى نطاق حضاري أوسع.
وهنا أودُّ أن أُشير إلى ثلاثة أمور، الأمر الأول: هو أن الدول الإسلامية تنتمي إلى عقيدة واحدة، وإن اختلفت سياقاتها الإقليمية ونظمها السياسية والاقتصادية، وفي قلب هذا كان لإندونيسيا وضعها الخاص. فإندونيسيا وشرق آسيا بصفة عامة في ذاكرتنا التاريخية عن وصول وانتشار الإسلام فيها لها خصوصية تختلف تمامًا عن ذاكرتنا التاريخية عن الإسلام والدعوة إليه في الجوار الإيراني التركي الشامي، ومن قلب الجزيرة العربية لشمال أفريقيا إلى أوروبا.
والأمر الثاني هو أن إندونيسيا الآن هي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد المسلمين. وأيضًا من حيث التنوع المجتمعي عرقًا وديانة على نحو يدار بتناغم إلى حدٍّ بعيد.
أمَّا الأمر الثالث فيُشير إلى أن إندونيسيا لمن درس دستورها علماني، أي لا تقول إنها دولة إسلامية، أو أن الشريعة الإسلامية هي مصدر للقانون كما في معظم الدول العربية. وذلك منذ دستورها في عهد الاستقلال 1945 وعبر التعديلات المتتالية التي جرتْ عليه طيلةَ ثمانين عامًا حتى الآن. وهي أيضًا دولة إسلامية شهدت مرحلة حكم عسكري. أو شبه عسكري مع سوكارنو وحتى 1998.
كما أن لإندونيسيا معنا ذاكرة مشتركة في مؤتمر باندونج 1968وحركة عدم الانحياز، ممثلة في قادتها سوكارنو ونهرو وعبد الناصر وتيتو. كل هذه الأمور التي جرت خلال الستينيات، ولذا نتذكَّر إندونيسيا عبر محطات مختلفة في تطورها السياسي الداخلي وعلاقتها الدولية. ولكن يظل في النهاية سؤالان مهمَّان:
1- كيف سيقود نمط الثقافة والدين والهوية المجتمع والدولة في إندونيسيا في ظلِّ هذا الإطار السياسي الحديث وفي ظلِّ هذا التنوُّع في التركيبة المجتمعية في ظلِّ كونها أكبر دولة إسلامية. فما الخصوصية في هذا النمط؟ هذا أمر يشغلنا دائمًا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية.
2- هل تشهد مجتمعاتكم ومؤسساتكم التعليمية في مستوياتها المختلفة الإسلامية تدخلات خارجية في هذا المجال على غرار ما وجهناه في عالمنا العربي عبر أكثر من قرنين، لكن خلال العقود الثلاثة الأخيرة أضْحى شديد الوضوح الآن في عالمنا العربي والإسلامي استهداف العقيدة واستهداف اللغة واستهداف الهُوية واستهداف ركائز الثقافة التي تساعد على بناء المجتمعات وعلى المقاومة الحضارية بصفة عامة، فكيف تعاملت التجربة الإندونيسية مع هذا الأمر؟
محاضرة د. أماني لوبيس:
في البداية أستطيع أن أقول، إن اتصال إندونيسيا بالإسلام كان منذ عصر صدر الإسلام أي منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأننا نعرف أن فترة النبوة 23 سنة كانت كافية جدًا لنشر الإسلام في جميع أنحاء العالم حين ذاك. وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك صلات تجارية بين الجزيرة العربية وبعض جزر إندونيسيا وكانت الملاحة تتم عبر هذه الجزر مع جميع أنحاء العالم وظلت متواصلة لم تنقطع أبدًا.
لمحة عن جمهورية إندونيسيا
إن إندونيسيا دولة أرخبيلية تضم أكثر من 17 ألف جزيرة، سبعة آلاف منها مأهولة بالسكان، يعيش فيها ما يزيد عن 280 مليون نسمة، 87% منهم مسلمون. وتحتوي البلاد على أكثر من 700 مجموعة عرقية وأكثر من 1100 لغة، وهذا يجعلها من أكثر الدول تنوعًا في العالم. ولكل جزيرة اسمها وثقافتها وعاداتها. وتعدد الثقافات وقبولها هو جزء من محددات سلوك الأفراد. والحكومة تراقب وتحمي هذه الجزر بنظام دقيق يشمل الذكاء الاصطناعي والقوات البحرية. كما أن هذا التنوع لم يمنع من بناء شعور وطني موحد، وهو ما ساعد على قوة الدولة ومكانتها بين دول مجموعة العشرين.
وإندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، وتُعرف بمواقفها المشرِّفة تجاه القضايا الإسلامية، وبالتمسك بالقيم الأخلاقية والدينية على مستوى الشعب والنظام التعليمي والثقافي، ما ينبئ عن أن الشعب الإندونيسي شعب متدين. ويتبنَّى منهج الوسطية في الإسلام، ويحاول الجمع بين مواكبة العصر وتطبيق الشريعة الإسلامية. وتطبيق الشريعة في إندونيسيا ليس بالنص في الدستور على أن الإسلام هو الدين الرسمي، ولا يوجد أن القرآن مصدر كل التشريعات، وهذه الصيغة وُضعت منذ الاستقلال عام 1945 لضمان شمولية الدولة لكل أطياف المجتمع، واحترام الأديان الأخرى، فإندونيسيا مجتمع منفتح.
احتفلنا هذا العام (2025) بالذكرى الثمانين لاستقلال إندونيسيا. ومصر كانت أول دولة تعترف باستقلالنا، وكان للملك فاروق والحكومة المصرية دور مهم في دعم الطلاب الإندونيسيين بالأزهر، والمطالبة بالاعتراف الدولي بالدولة الجديدة وقتها. هذه العلاقة التاريخية جعلت الروابط بين مصر وإندونيسيا قوية على المستويين الشعبي والرسمي، ولذا كان مؤتمر باندونج وقمة عدم الانحياز تعبيرًا عن الصلات الوثيقة بين إندونيسيا ومصر وكافة الدول التي تسعى للتخلص من الاستعمار. ونحن في إندونيسيا لم نأخذ من المحتل الهولندي أي شيء سوى إن الديانة المسيحية بقيت في المجتمع بعد رحيله.
تُعد التنمية في إندونيسيا مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب. لا نتبع نظامًا شيوعيًّا أو اشتراكيًّا كاملًا، ولكن كان لإندونيسيا تيار مختلف عن ذلك. ولا يعتمد الشعب الإندونيسي كليًّا على الحكومة في تنفيذ مشروعاته الاقتصادية وبرامجه الاجتماعية، بل للشعب مبادراته وريادته في هذين المجالين؛ لأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا التي تديرها النساء، إذْ تشكِّل النساء نحو 70% من القوى العاملة في هذا القطاع وهن قوة فاعلة في المجتمع والاقتصاد، خاصة في وقت الأزمات. وقد ساعدنا هذا على الصمود خلال أزمة كورونا، وحصلنا على إشادة البنك الدولي بقدرتنا على الحفاظ على الاستقرار المالي.
وإندونيسيا جمهورية ديمقراطية، باعتراف دولي، وهي أولى الدول الإسلامية في هذا الميدان وفقًا للمؤشرات الدولية المعنية بالديمقراطية، إذ للمجتمع المدني دور أساسي في دعم برامج الحكومة، من خلال الجمعيات والمنظمات الأهلية والدينية التي تغطي التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. ولكن مع ذلك تزداد التحديات مثل الفقر والجهل ونقص الخدمات الصحية، ولكن هناك جهود مستمرة للتغلُّب عليها.
مقومات الثقافة في إندونيسيا
يعترف الدستور بست ديانات رسمية، هي: الإسلام، والكاثوليكية، والبروتستانتية، والهندوسية، والبوذية، والكونفوشية. كما أن هناك ديانات أو ممارسات اعتقادية لكن لم ينص عليها الدستور. إذ لدينا مفهوم “المواطنة الحاضنة للتنوع”، بحيث تمارس كل جماعة دينية تقاليدها ضمن قوانين تراعي خصوصياتها. ويتم بحث سبل إمكانية تطبيقها في مجال التعليم بمساعدة وسائل الإعلام في معالجة الإقصاء والتمييز، والمسببات الأساسية للتطرف والعنف والفقر والجهل. ومن أبرز ما يميز إندونيسيا هو التزام الآداب العامة ومراعاة تعليم الشباب الخلق السليم، فمثلًا هناك قانون ضد “الخلاعة” منذ 2014 يُطبّق في المناطق المسلمة، بينما تسمح جزيرة بالي (تُستثنى) ذات الأغلبية الهندوسية بلباسها التقليدي، ودفاعًا عن الهوية الإندونيسية المدنية.
ومن هذا المنطلق فإن نمط الهوية الثقافية الإندونيسية، يشمل الثقافة، والمعتقدات، والقيم، والعادات، والفنون، والأدب. وتأخذ الهوية الإندونيسية من القيم التي أجمعت عليها الشرائع السماوية كلها ممثلة في: العدل، والتسامح، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، والصدق في الأقوال والأفعال، وبر الوالدين، وحرمة مال اليتيم، ومراعاة حق الجوار، والكلمة الطيبة، مظلَّةً لها، وذلك لأن مصدر التشريع السماوي واحد، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: «الأنبياء إخوة لعلَّات أمهاتهم شتى ودينهم واحد» (مسند الإمام أحمد).
وتنتشر المعاهد الإسلامية في البلاد، والتي تتراوح بين تقليدية، وحديثة. هذه المعاهد، سواء كانت تقليدية تعتمد على الجلوس على الأرض وقراءة كتب التراث، أو نظامية بمناهج حديثة، تُعتبر حاضنة للهوية الإسلامية، وتخرِّج أجيالًا من القادة الذين يكْملون تعليمَهم في الجامعات الحديثة، ما يخلق توازنًا بين الأصالة والمعاصرة، وينطبق ذلك على القرى الصغيرة وحتى المدن الكبيرة ذات العمران الحديث.
وتُترجم هذه المقومات في عدَّة مبادرات ومعتقدات وأنشطة، منها:
1- التعاون العلمي والانفتاح الثقافي بين الجامعات وفق مبدأ التكامل المعرفي.
2- دورات وبرامج حل النزاعات وهي منتشرة في إندونيسيا: فمنذ أحداث 11 سبتمبر 2001، ندرس “حل النزاعات” كمقرر في بعض الجامعات لتعزيز السلم.
3- الاحترام المتبادل.
4- تكريم الأسر السعيدة: تُعد الأسرة هي محور المجتمع الإندونيسي، فسياسات الغرب تؤكِّد على حقوق المرأة والأطفال وحقوق الإنسان للأفراد، لكنها لا تركِّز على الأسرة، ونحن في إندونيسيا ندعم الأسرة (عبر تقوية وتمكين الأسر، وفق مفهوم الأمن الأسري من منظور إسلامي).
5- مأسسة الأنشطة الشبابية: لا بد لكل فرد في المجتمع الإندونيسي أن ينتمي إلى مؤسسة وذلك منذ الصغر حتى الوفاة؛ لا بد من الانضمام لمؤسسات دينية واقتصادية وسياسية.
6- تقديم دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج: فهذه ثقافة أساسية في إندونيسيا، ويوجد لدينا هيئة نصح الأزواج (قبل المحاكم)، وتقوم على تسوية النزاعات بين الزوجين؛ وهي خطوات تهدف لتقليل معدلات الطلاق. كما تم سنُّ تشريع برفع سن الزواج إلى 19 عامًا، ولا بد أن تسجل في مكتب الشؤون الدينية التابع للحكومة.
7- تمكين المرأة في مجالات الحياة، والمساواة في النشاطات الاقتصادية.
8- منع التشدد والانحراف، وذلك بتنظيم وإشراف من قبل الحكومة على كل المستويات حتى الأحياء الصغيرة للتعامل مع مشكلات مثل غلق كنيسة أو مسجد من قبل أتباع الديانات الأخرى وخلافات مع الجيران.. إلخ. ومع ذلك قد أعطت الحكومة المركزية الصلاحيات للجمعيات أو المجتمع في الأحياء لحلِّ مشكلاتهم بأنفسهم.
· التحديات الكبرى التي تواجه إندونيسيا
إن إندونيسيا، مثل أي دولة، تواجه مجموعة من التحديات الكبرى، بعضها طبيعي وبعضها اجتماعي واقتصادي وثقافي. من أبرز هذه التحديات:
1- الكوارث الطبيعية: موقع إندونيسيا الجغرافي يجعلها عرضة للزلازل والبراكين والفيضانات.
2- الفجوة التعليمية بين الذكور والإناث: خاصة في المناطق النائية ذات التضاريس الصعبة التي تعيق الوصول إلى المدارس.
3- النزاعات المجتمعية: غالبًا ليست دينية بحتة، بل ناجمة عن فجوات اقتصادية أو هجرات داخلية تؤدِّي إلى تنافس بين السكَّان الأصليِّين والمهاجرين من جزر أخرى.
4- العنف باسم الدين: يظهر أحيانًا نتيجة أحداث أو ضغوط خارجية، لكنه ليس سمةً عامةً للمجتمع، وغالبًا ما يكون مرتبطًا بعوامل اجتماعية واقتصادية أخرى.
5- تعدُّد الثقافات وتبايُنها: ما يتطلَّب جهودًا مستمرة لضمان التفاهم والتعايش السلمي.
6- الهوية والثقافة الإسلامية: هناك محاولات لطمس الهوية أو إضعاف القيم الدينية في إندونيسيا، فإندونيسيا بوصفها دولة إسلامية مستهدفة من هويتها فكثير من مكوِّنات الهوية مستهدفة.
7- الجوار الإقليمي والوحدة القومية: إندونيسيا لديها حدود مع 11 دولة، وهو ما يفرض عليها تحديات سياسية كبيرة للحفاظ على وحدتها القومية.
8- التحديات الرقمية: انتشار وسائل التواصل الاجتماعي يجلب تهديدات مثل الإدمان، والجرائم الإلكترونية، والتأثيرات السلبية على الأسرة، والإباحية.
9- التقزُّم وسوء التغذية: حيث هناك ما يقرب من 12% من المواليد يعانون التقزُّم، وتقوم الحكومة بتدشين برامج للتوعية بالتغذية السليمة للأمهات والأطفال، خاصة في أول 1000 يوم بعد الولادة.
10- الفقر والبطالة: رغم التقدم الاقتصادي، لا تزال هذه المشكلات قائمة في بعض المناطق، منها انخفاض الكفاءة وتأثيره على جودة الأعمال وفرص الشباب.
11- ضعف التواصل على المستوى الأسري، وزيادة معدلات الطلاق خلال الخمس سنوات الأولى من الطلاق، إذ تصل النسبة إلى 23%.
الحفاظ التعايش السلمي
إندونيسيا تحاول الحفاظ على التعايش السلمي بين أعراق وأديان متعدِّدة عبر عدَّة أمور، منها:
١- الاحترام المتبادل لدى أبناء الشعب المتنوعة الأعراق.
٢- تفعيل الحوار بين الثقافات المختلفة وطنيا ودوليا.
٣- تحقيق التعايش السلمي والعيش المشترك واحترام التعددية.
٤- إعطاء الحلول المناسبة لعلاج العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، عن طريق رفع كفاءات الإبداع والإنتاج والمحافظة على البيئة.
٥- تحقيق السلم والأمن الاجتماعي أي الأمن الأسري الأمن الغذائي والأمن الصحي.
٦- إدماج مادة مقارنه الأديان في المناهج الدراسية منذ الابتدائية حتى المرحلة الجامعية، هي خبرة إندونيسية.
٧- تطبيق التكامل المعرفي في كسب العلوم والتصرف على مقاربات مختلفة للتعامل مع التجديد والابتكار.
· إنعاش الضمير الإنساني
نعمل دائمًا بالتوازي مع الحفاظ على مبدأ التعايش السلمي على إنعاش وإحياء الضمير الإنساني والهوية الإسلامية عن طريق:
١) تعزيز الوجدان الإسلامي في التعبُّد والمعاملات. ففي جانب العبادات، يوجد في كلِّ مركز تجاري أو مكتب أماكن مخصصة للصلاة للرجال والنساء، وهو بمثابة امتداد للصحوة الإسلامية في إندونيسيا منذ الثمانينات. أما في جانب المعاملات فهناك قوانين خاصة بالزكاة والوقف والحج، أُقِرَّتْ بعد نقاشات برلمانية مطولة، وتعتبر الفتاوى الصادرة عن مجلس العلماء الإندونيسي مرجعًا ملزمًا في جميع مجالات الحياة المختلفة، وتعطي مرجعًا دينيًّا متطورًا، وكانت إندونيسيا سبَّاقة في إصدار فتوى للحفاظ على الحيوانات المعرَّضة للانقراض في 2014، وتُرجمتْ إلى أكثر من لغة. وهناك فتاوى لحماية البيئة، والتصدِّي للعنف الجنسي ضد الأطفال، فأصدروا فتوى بإعدام من يعتدي على الأطفال جنسيًّا.
٢) تعزيز التضامن والتعايش بين أفراد المجتمع وبين الدول النامية لبناء مستقبل حافل بالتقدُّم في المستقبل.
٣) تنفيذ مبادئ الأخوة الإنسانية التي نادى بها إعلان الأخوة الإنسانية الذي وقع عليه فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا فرنسيس في عام 2019.
٤) وإنعاش تطبيق التعاليم الإسلامية السَّمْحَةِ في جميع مناحي الحياة. مثل:
أ) الحلال في الطعام والأدوية والمستحضرات التجميلية.
ب) الاقتصاد الإسلامي.
ج) التمويل الإسلامي.
د) التكنولوجيا الخضراء.
اتجاهات النقاش:
طرح المشاركون عدَّة أسئلة بغرض فهم خصوصية الثقافة والإسلام في إندونيسيا، منها:
أسئلة عن الخلفيات الفكرية والأيديولوجية للمؤسسات التعليمية الأجنبية في إندونيسيا؟ وشروط منحها الاعتماد؟ وعن التثاقف بين الأديان؟ وأثر التقاليد فيها؟ وعن طبيعة العقلية الشرق آسيوية والتديُّن في إندونيسيا؟ وعن وزن الجماعة الصينية في الاقتصاد الإندونيسي؟ وتأثيره على نمط المجتمع؟
ومنها ما يتصل بتفاصيل عن المجتمع، مثل نسبة العنوسة والطلاق في إندونيسيا؟ وموقع جمعية نهضة العلماء في الحياة السياسية والعلمية في إندونيسيا؟ وعلاقة بعض كبار مسؤوليها بمركز شيمون بيريز للسلام بإسرائيل.
وأيضًا عن المقارنة مع مجتمعات ودول أخرى في شرق آسيا مثل ماليزيا، التي يُنظر إلى الإسلام فيها غالبًا على أنه غير منفصل عن الهوية الملاوية، ويعزَّز ذلك من خلال الإطار الإسلامي للدولة: هل فصل الإسلام عن الثقافة الملاوية يمكن أن يجعله أكثر قربًا من غير المسلمين مثل الصينيين والهندوس، وبالتالي يسهم في تقريب الفجوات الكبيرة بين الإثنيات؟ وإن كان الأمر كذلك، فكيف يمكن تحقيق ذلك دون الانزلاق نحو نموذج حكم علماني؟ وما أوجه الشبه مع حالة إندونيسيا؟
كما أورد المشاركون مجموعة من التعليقات تمثَّلت في أن المحاضرة تبيَّن من خلالها أن هناك عملية تحصين للهوية الإسلامية على المستوى الداخلي، كحفظ الحقوق والحريات والأمن الأسري والسؤال هل هناك استراتيجية للتحصين الحضاري في مستوياته الخارجية للنموذج الإندونيسي بما يسمح له بتطويره وتعميمه في أقطار إسلامية أخرى ذات خصائص مشابهة لإندونيسيا، في ظل التحديات والتهديدات التي تستهدف إندونيسيا في مستويات إقليمية وعالمية كالتحديات الجيوسياسية في المنطقة والاقتصادية العالمية، وحالة الأمن القومي الإندونيسي والاستقرار الإقليمي.
كما تطرَّق بعضها إلى طبيعة العلاقات بين مصر وإندونيسيا واستفادة مصر من التجربة الإندونيسية، ففي الفترة من بعد استقلال مصر من ١٩٢٢ إلى ١٩٥٢ حدثت معارك دبلوماسية حضارية كبرى مسكوت عنها، من أهمها دور مصر في استقلال إندونيسيا، إذ انطلقت منها أكبر مظاهرة طلابية في العالم حدثت في الأربعينيات تدعم إعلان استقلال إندونيسيا ، وفي نفس الوقت تنادي بحق الفلسطينيين، كما قام عمال الموانئ المصرية بمقاطعة السفن الهولندية، وبالأمم المتحدة تحالفت مصر والهند لتأييد الاستقلال، ومن الأعمال المخابراتية غير المشهورة توجيه عبد الرحمن باشا عزام لقنصل مصر في مومباي بالهند لتحميل طائرة أسلحة هبطت بأدغال إندونيسيا للمقاومة.
ومنها ما سلط الضوء على دور مصر والأزهر في إندونيسيا، ففي جزيرة تُسمى لومبوك، جزيرة الألف مئذنة أو ألف مسجد لاهتمام أهلها ببناء المساجد ومعاهد القرآن الكريم، وكذلك من قدر الله أن يكون محافظ الجزيرة من خريجي الأزهر ويقدم رؤية حول ما أسماه بشكل آخر للسياحة وهي السياحة الشرعية.
كذلك فإن لدى الدبلوماسيين الإندونيسيين سياسة في الاعتزاز بالهوية الريفية والفلاحين، وهذا العنصر مفتقر في سياسة مصر الخارجية – بالمقارنة، على الرغم من كونها مكونًا أساسيًّا من مكونات الهوية المصرية. بالإضافة إلى ذلك تحتاج مصر إلى الاستفادة من تجربة الحكم المحلي في إندونيسيا وهو قادر على تمكين الشباب وظهور كوادر من النساء القويات.
وكذلك التعلم من فاعلية وقوة المجتمع في إندونيسيا. فضلًا على ضرورة الاهتمام بدور السينما الحضارية، فإندونيسيا لديها فلمين أو أكثر عن الأزهر، ونحن نحتاج لهذا النمط من السينما. وكذلك من المهم بناء حوار مع الديانات الشرق آسيوية حتى لا يكون هناك صراع على أسس ديني. فهناك طاقة حضارية مُعطلة بسبب طبيعة النظر إلى العلاقات بين مصر وإندونيسيا ناتج عن الرؤية السياسية والتاريخية القاصرة بينما لو وضعنا النظارة الحضارية لوجدنا أن هناك ترابطًا حضاريًّا وثقافيًّا ومعرفيًّا وتجاريًّا في إطار الرؤية الحضارية.
وعليه، فإنه من الرؤية الاستراتيجية الحضارية للعالم الإسلامي ضرورة حث الطاقة الحضارية الكامنة بتفعيل دور الملايو و الجاويين لصناعة نمط حضاري للعالم الإسلامي، لذلك تلاحظ أن أمريكا تحاول ذلك عبر نظرتها إلى أن الإندونيسيين يقدِّمون نموذجًا مسالمًا، لكن من الرؤية الحضارية الإسلامية يمكن أن تقدِّم للأمة الإسلامية حضارة المعاهد والمدارس والكتاتيب والجامعات الإسلامية والأوقاف حولها للزراعة والتجارة وأنشطة البحار وهو ما يحتاج إلى تعاون واسع بين أطياف الأمة ومكوناتها المختلفة من عرب وترك.
كما شدَّد بعض المشاركين على أهمية أن يكون هناك تواصل بين المدرسة الحضارية (ممثلة في مركز الحضارة) مع المؤسسات الثقافية والتعليمية الموجهة إلى الطلاب مثل الأزهر (الوافدين ومنهم الإندونيسيين) لإبراز الجانب الحضاري في تناول القضايا والعلوم الاجتماعية.
كما أكَّدت التعليقات على أن الأمة تحتاج إلى نموذج لقيادة التغيير في العالم الإسلامي، نموذج يكون منطلقه وإطاره الحضاري هو الإسلام، ولعل إندونيسيا هي من أقرب المجتمعات التي يمكن أن تقدم هذا النموذج الذي يؤكد قوة مجتمع المسلمين في هذا البلد.
تعقيب الدكتورة أماني لوبيس:
أوضحت الدكتورة أماني لوبيس أن نظام التعليم والاعتماد الأكاديمي في إندونيسيا، يندرج ضمن صلاحيات ثلاث وزارات، هي: وزارة الشؤون الدينية (تشرف على التعليم الإسلامي، ومقارنة الأديان، ودراسات الأديان)، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التعليم العام (الأساسي والمتوسط). وهناك هيئة وطنية للاعتماد الأكاديمي، والنظام موحَّد على مستوى البلاد، مع وجود اعتمادات دولية لبعض الجامعات، تخضع لاعتمادات خارجية؛ وبالتالي، يُسمح بالجامعات الأجنبية لكن بشروط، منها أن يكون تملك المؤسسات والأراضي للإندونيسيين وحدهم؛ إذن فالتعاون مع مؤسسات محلية إلزامي.
وكذلك أوضحت أنه يوجد احترام متبادل بين أصحاب الأديان، مع أنشطة مشتركة (إفطار المسلمين في الكنائس في رمضان، دعوة المسيحيين للأعياد الإسلامية، ولكن بصفة عامة (الثقافة العامة) لا يحتفل المسلمون بعيد الميلاد. ولدينا مؤسسات إسلامية (فنادق، ومستشفيات، ومطاعم، وأماكن سياحية) تلتزم بالشريعة، مع مراقبين شرعيين من مجلس العلماء. ولا نتساهل في الالتزام بعلامة الحلال والغذاء الحلال محليًّا ودوليًّا.
وأكَّدت أن إندونيسيا ليست مثل ماليزيا في مسألة الأعراق. فالمسلمين – في إندونيسيا – من جميع الأعراق، ولا يوجد بينهم انفصال مثل ماليزيا حيث إنهم هناك يعتبرون أن كل الملاويين مسلمين. ولذا -خلافًا لماليزيا- لا يرتبط الانتماء العرقي بدين محدد في إندونيسيا.
كما أكَّدت على حيوية التعليم الديني وحضور الإسلام في التعليم، إذ يوجد في إندونيسيا ما يقرب من 42 ألف معهد ديني في جميع أنحاء البلاد، تضم أكثر من 10 ملايين طالب وطالبة. والإسلام راسخ في المجتمع، والدولة ليست علمانية بالكامل، كما يشارك أساتذة الشريعة في مراجعة القوانين داخل البرلمان (قوانين مثل الخلاعة وحماية الطفل استغرقت سنوات من النقاش قبل إقرارها)، والحكومة والبرلمان لا ينفصلون عن المنظمات والمؤسسات الإسلامية.
أما عن نسبة العنوسة فهي منخفضة بسبب سهولة الزواج، حيث لا توجد تكاليف باهظة، فيمكن الإقامة مع أهل الزوج أو الزوجة، ولكن ذلك يختلف بين المدن والقرى، أما عن نسبة الطلاق فقد ارتفعت من 12% (2015) إلى نحو 23% حاليًّا، وحاليًّا تُحشد الجهود في إندونيسيا لبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، ومعالجة نسب الطلاق.
أما العلاقة مع إسرائيل، فهي مواقف فردية لبعض الأفراد، وتضخِّمها وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولكن من يزور إسرائيل نقوم في مجلس العلماء بفصل الأفراد الذين يقومون بهذا الفعل. ومع ذلك لم تسلم إندونيسيا من الصهيونية؛ فالصهيونية قريبة من إندونيسيا فهي موجودة في قلب سنغافورة، أما الموقف الرسمي فيدعم حل الدولتين والتعايش السلمي، مع سياسة خارجية مرنة تتَّسق مع الثقل الحضاري والسياسي للدولة.
تعقيب د. نادية مصطفى:
لدى تعقيب حول الخيوط الناظمة لما ورد في محاضرة الدكتورة، تبدأ من الاختلاف بين نمط الاستعمار الهولندي لإندونيسيا عن نمط الاستعمار الإنجليزي لمصر وبالتالي ما نتج عنه من نمط الاستقلال. وتوجد ثلاثة خيوط ناظمة تبيِّن طبيعة خصوصية المجتمع الإندونيسي:
أولها- عن القيم المشتركة والضمير الإنساني، فالمجتمع الإندونيسي يقوم على قيم إنسانية مشتركة بين جميع مكوناته العرقية والدينية، مع أغلبية مسلمة (ما بين 80 – 90%) صبغت قيم المجتمع الإندونيسي بالطابع الإسلامي. وهذا يتداخل مع الحديث عن ما يسمى “القيم الآسيوية” ومنها: الروح الجماعية والتعاون – التنظيم والانضباط – احترام الإنسان وكرامته -الاهتمام بالهوية والحفاظ على الاستقرار، وهذه السمات موجودة في مجتمعات شرق آسيا مثل الصين واليابان، لكن إندونيسيا تحتفظ بها ضمن إطارها الخاص الذي يحافظ على الإسلام كمكون أساسي للقيم المشتركة.
ثانيها- حرية حركة وتنظيم وانتماء للتنظيمات والمؤسسات يكفلها القانون والدستور والنظام الديمقراطي الحاكم، الذي يعلن احترام الأقليات ويؤسس لمواطنة حاضنة، وهذا مهم جدًّا دفع بحرية الدعوة ومن ثمَّ ترجمه في تكوين الجمعيات والمنظمات الأهلية، لممارسة الدعوة والتعليم، والعمل الخيري، بما يشمل المؤسسات ذات المرجعية الإسلامية. فضلًا عن نمط اللامركزية والقائم عليه من مرجعية إسلامية، هذا النمط محارَب أو مقيَّد في كثير من الدول العربية والإسلامية، وذلك في شتى المجالات من تعليم ودعوة واجتماع وليس في المجال السياسي وحسْب، بينما في إندونيسيا هو جزء أصيل من الحياة العامة.
ثالثها- أن هناك وضعية للإسلام كدين ومرجعية في نظم التعليم والثقافة والقانون من دون أن يُقال إنها مرجعية إسلامية مفروضة على غير المسلمين، والمثال الذي ذُكر على قانون الخلاعة (واستثناء جزيرة بالي، دالٌّ على ذلك). وكذلك دَلَّ عليه وجود تكامل معرفي في عدَّة جامعات ومؤسسات علمية، بالإضافة إلى وجود العديد من الجامعات التعليمية الإسلامية، وكذلك فتاوى العلماء التي لا تقتصر على شؤون العبادات ولكن تمتد إلى جميع مجالات الحياة، مثال حماية البيئة وحقوق الحيوان وغيرها.
وهذا يدفع إلى القول بالخصوصية الحضارية للمجتمع الإندونيسي الذي لديه استراتيجية للتحصين الحضاري يشارك فيها الجميع مع الحكومة حتى لو كان يحكمها حزب قومي علماني أو إسلامي، ويكفي أن هناك مجلس علماء ينزل إلى قضايا الناس بمرجعية إسلامية ذات رحابة إنسانية، وهذا التعدد والتعارف والحوار والعمل التنموي والمجتمعي هو من صميم القيم الإسلامية الإنسانية المشتركة. ومع ذلك لم يسلم النموذج من التدخلات الخارجية، فالقوة الأجنبية إذا وجدت مجتمعًا متجانسًا ومتناغمًا يحاولون التدخُّل في الأمور الصغيرة لمحاولة جعل المجتمع والدولة لا تراعي حقوق الإنسان.
—————————————–
الهوامش:
– سلوى دعادر، الأزمة المالية في جنوب شرق آسيا بين حالتي ماليزيا وإندونيسيا، العدد الأول، حولية أمتي في العالم.
– أحمد عادل، ماليزيا وإندونيسيا: تطورات ما بعد الأزمة المالية في جنوب شرق آسيا، العدد الثاني، حولية أمتي في العالم.
– محي الدين قاسم، إندونيسيا: من الاستقلال إلى مخاطر التفكيك، العدد الثالث (الأمة في قرن)، حولية أمتي في العالم.
– أحمد خلف، واقع الأحزاب والحركات الإسلامية وتأثيرها في إندونيسيا، العدد الرابع عشر، حولية أمتي في العالم.
– عمر سمير، قمة الثماني الإسلامية: هل التقت رؤى 2030 للتنمية المستدامة الوطنية؟، فصلية قضايا ونظرات، العدد 37.
تاريخ اللقاء: 2 أغسطس 2025
إعداد تقرير اللقاء: الباحث أحمد عبد الرحمن خليفة