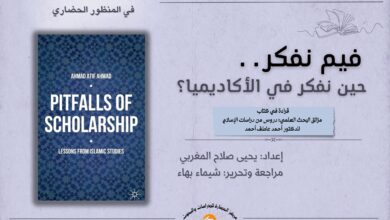قراءة في كتاب “في مصادر التراث السياسي الإسلامي “
دراسة في إشكالية التعميم قبل الاستقراء والتأصيل
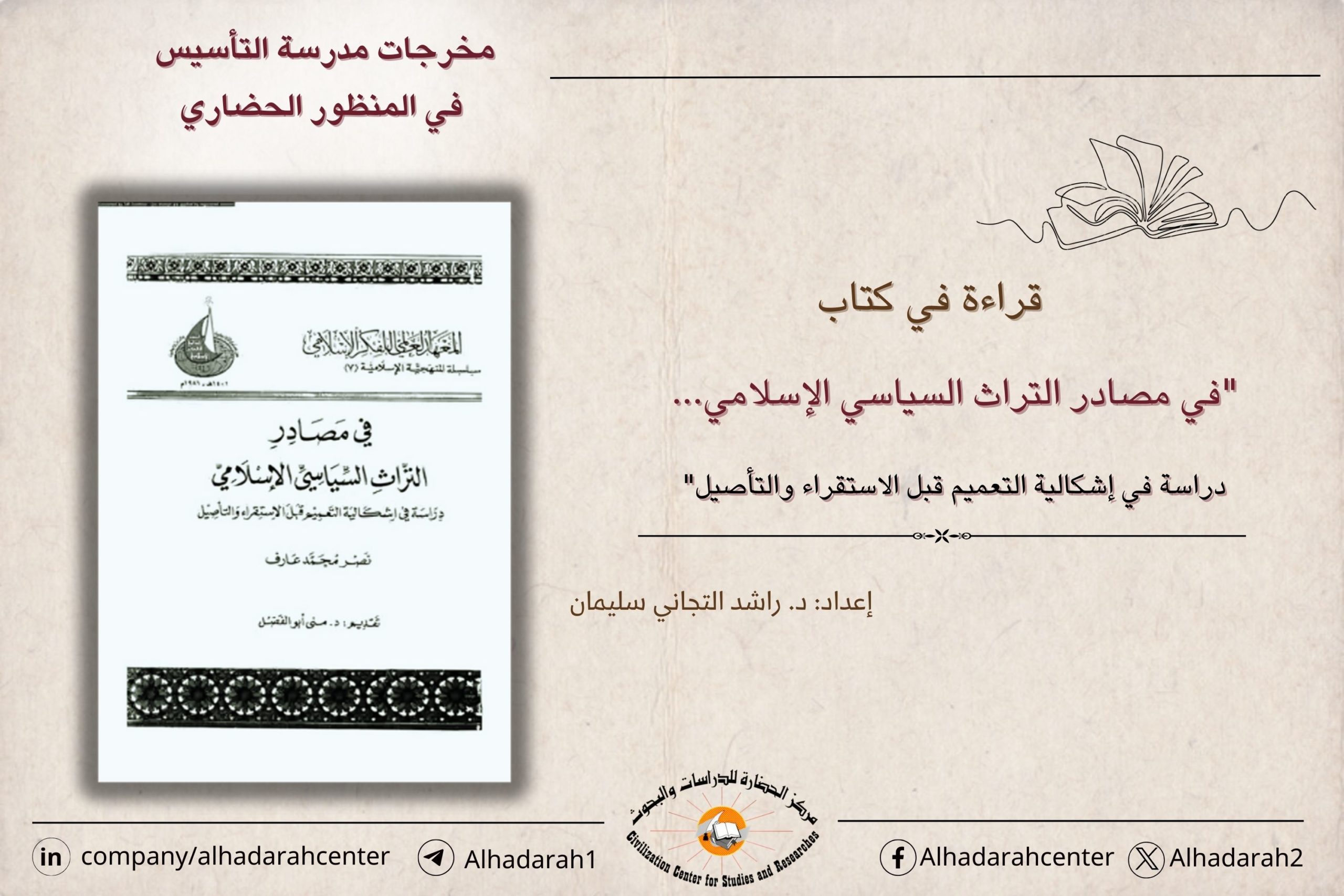
مقدمة***:
الحمد لله الذي تكفَّل بحفظ مصدر ومرجعية تراث هذه الأُمّة خلال السِّنين بشهادة: {إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحِجْر: 9]، وجزم بنفي الضَّلال عمَّن كانوا بهديه مُسْتَمْسِكين، وجعل الآخذين منه أقرب إلى الحقّ ما كانوا منه مُسْتَلْهِمين، وبعد.
يُعَدُّ كتاب (في مصادر التُّراث السِّياسيّ الإسلاميّ) من الكتب المتميِّزة في مجال تأصيل المعرفة؛ وذلك لمعالجته واحدة من أكثر أزمات المعرفة التي نواجهها في عصرنا الحالي، وهي (أزمة منهجيّة الأخذ من التُّراث الإسلاميّ والرَّبط بين الوحي والواقع). حيث قدَّم الكتاب نموذجًا في حقل العلوم السِّياسية، لكنه يصلح للتَّعميم في مختلف ضروب المعرفة الإنسانيّة، من خلال دراسته المنهجيّة لمصادر التُّراث السِّياسيّ الإسلاميّ.
مؤلِّف الكتاب هو الباحث المصريّ الدّكتور نصر مُحَمَّد عارف المولود بمدينة سوهاج عام 1961، والحاصل على درجة “البكالوريوس” من كُلّيّة الاقتصاد والعلوم السِّياسيّة بجامعة القاهرة عام 1984، ودرجتيْ “الماجستير” و”الدّكتوراه” في الفلسفة من الجامعة نفسها بين عاميْ 1986 و1988. عمل عميدًا ومديرًا لعدّة كُلّيّات ومعاهد بمصر ودولة الإمارات العربيّة المتّحدة، ورئيسًا لمكتب المعهد العالميّ للفكر الإسلاميّ بمصر، كما عمل أستاذًا زائرًا لبعض الجامعات الأمريكيّة.
صدر هذا الكتاب في طبعته الأولى عام 1415 هـ -1994م بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي هيرندن فيرجينيا، وجاء ترتيبه السَّابع ضمن (سلسلة المنهجيّة الإسلاميّة) التي نشرها المعهد، ويتألَّف من (244) صفحة من القطع المتوسط.
محتويات الكتاب:
يتكون الكتاب من تقديمٍ وتمهيدٍ وفصلين على النحو التالي: الفصل الأول: حول منهجية التعامل مع مصادر التراث السياسي الإسلامي، ويتكون من ثلاثة مباحث: الأول: موقع المصادر التراثية في الدراسات المعاصرة عن الفكر السياسي الإسلامي: دراسة كمية، والثاني: منهجية الدراسات المعاصرة في التعامل مع التراث السياسي الإسلامي، والثالث: حول الضوابط المنهجية لدراسة التراث السياسي الإسلامي.
أما الفصل الثاني: مصادر التراث الإسلامي المباشرة وغير المباشرة، فيشمل مبحثين: الأول: المصادر غير المباشرة أو غير المتخصصة، الثاني: المصادر المباشرة أو المتخصصة، هذا بجانب خاتمة.
منهجية الكاتب:
تتمثل الخطوات الإجرائية التي اتبعها الكاتب في القيام بمسحٍ لما يلي:
- الكتب التي تؤرِّخ للمؤلِّفين وتعطي أمثلة لأهمّ كتاباتهم أو حصرًا لها.
- كتب التَّاريخ، وهذا للكتب فيما قبل عصر الطَّباعة.
- فهارس خزائن المخطوطات، وفيها قام المؤلِّف بإجراء جَرْد يَدَويّ لفهارس المخطوطات.
- الكتب التي ترصد المخطوطات المطبوعة والمنشورة، حيث اطَّلع المؤلِّف على بعضها.
- الاطّلاع على الكتب والمخطوطات الموجودة في مصر، ومعرفة محتوياتها.
- مراجعة المؤلَّفات المعاصرة المتعلِّقة بالفكر السِّياسيّ الإسلاميّ التي استطاع المؤلِّف الوصول إليها، ومعرفة مصادرها، وتحديد المصادر التُّراثيّة السِّياسيّة التي اعتمدت عليها في الوصول إلى ما وصلت إليه من خلاصاتٍ وأفكار.
تلك هي الخُطُوات الإجرائيّة التي اتّبعها المؤلِّف، ومن الواضح أنَّها لم تصل إلى كلِّ مظانّ المادة العلميّة المبتغاة المتمثَّلة في مصادر التُّراث السِّياسيّ الإسلامي، وقد أشار المؤلِّف إلى أنَّها أكثر بكثير ممَّا وصل إليه، ولذلك قيَّد دراسته بعدّة قيود منهجيّة تحكم تعميماتها ونتائجها:
- وصلت هذه الدِّراسة إلى النَّتائج التي توصَّلت إليها اعتمادًا على الوسائل التي سبقت الإشارة إليها، ومن ثمَّ فإنَّ أيّة زيادة في هذه المصادر تعني أنَّ هناك احتمالًا للوصول إلى مصادر جديدة أخرى أو تحقيق وجود مصادر غير موجودة.
- ركَّزت هذه الدِّراسة على الأبعاد الدَّاخليّة للسِّياسة، وليس العلاقات الدَّوليّة؛ إذ تلك لها حقلها الخاصّ ومصادرها الخاصّة.
- هذه الدِّراسة محكومة بحدود اللُّغة العربيّة، فلم يقم المؤلِّف بحصر ما أُنتج باللُّغات التَّاريخيّة والمعاصرة الأخرى.
- ما اطّلع عليه المؤلِّف اطّلاعًا مباشرًا من مصادر التُّراث هو فقط ما وجده في مصر، أمَّا الباقي؛ فقد ألمَّ به من فهارس المخطوطات التي أورَدَتْه.
قضايا الكتاب الرئيسية:
قدَّمت الدّكتورة منى أبو الفضل -العالمة الرَّائدة والمتميِّزة في دراسات المنهاجيّة- هذا الكتاب، مؤكِّدةً أنَّ للحديث عن التُّراث الإسلاميّ ومصادره مداخل عديدة يمكن أنْ تُشكِّل منطلقات للتَّناول. ولعلَّ في مُقَدِّمَة هذه المداخل ما اصطلح على تسميَّته بـ “جدليّة النَّصّ والواقع”؛ ذلك أنَّ التُّراث الإسلاميّ -عند فريق من الباحثين- ـيشمل النَّصّ الإسلاميّ الموحى المنزل على رسول الله “صلى الله عليه وسلم” المتمثِّل في كتاب الله، وببيانه في سُـنَّة رسول الله “صلى الله عليه وسلم”، كما يشمل سائر ما أنتجه العقل المسلم من خلال تفاعله مع هذيْن المصدريْن الأساسيّيْن لمعرفته، ومع الواقع الذي عاشه، واللُّغة العربيّة التي مثَّلت وعاء ذلك النَّصّ، ووسيلة الإفصاح عن مكنونه وبيان معانيه. فحَوْل النَّصّ الموحى استطاع العقل المسلم أنْ يبني مجموعة من المعارف والعلوم التي استندت إلى النَّصّ في مرحلة تكوينها، ثُمَّ تحوَّلت إلى وسائل لفهمه وأدوات لتفسيره وتأويله وتنزيله على الواقع المعاش. والكُتَّاب الذين يرون “التُّراث” شاملًا لذلك كلّه؛ يغلب أنْ يكونوا من أولئك الذين تأثَّروا بالمفهوم الغربيّ الاستشراقيّ للتُّراث، الذي درج على عدم التَّفريق بين النَّصّ المعصوم المحفوظ (القرآن العظيم) وبين ما انبثق عن النَّصّ أو بُنِي عليه أو استند عليه بشكلٍ من الأشكال. لذلك يضع هؤلاء “المعاصرة” مقابل “التُّراث” بحسبانهما نقيضيْن، إذ كلٌّ منهما -في نظرهم- يُمثِّل فلسفةً ومنهجًا ونظام حياة، في مقابل هؤلاء يقف فريق من الباحثين المسلمين الذين لا يرون جواز إطلاق لفظ “التُّراث” على النَّصّ الموحى إلَّا بالمعنى اللُّغويّ المحدَّد.
إنَّ السِّياق الحضاريّ العربيّ الإسلاميّ يفرض إعادة تعريف كلٍّ من “النَّصّ” و”الواقع” على نحوٍ يخرج الأصول المرجعيّة لهذا التُّراث من دائرة حرفيّة المدوّنات المنطوقة ومن شكليّات المبنى اللَّفظيّ، ويأخذ في الحسبان الأبعاد الغيبيّة المتعلِّقة بتنزيل النَّصّ وتحقُّق الواقع، وكذلك التَّشكُّلات المفصليّة لواقع عصر التَّنزيل الذي ارتبط بالتَّنزيل القرآنيّ وببيان متلقي الوحي. كما أنَّه يقتضي التَّمييز بين المنطلق المعرفيّ الوضعيّ الماديّ الذي يدور الخطاب المعرفيّ المعاصر في إطاره، والذي تولَّدت من حواراته الدَّاخليّة أطروحة هذه الإشكاليّة، وبين الخطاب الإسلاميّ الذي ينطلق من المعرفة التَّوحيديّة التي تجعل من علاقة الخالق بالخلق والإنسان بالحقّ حجر الزَّاوية لسائر العلاقات الدُّنيويّة التي تمتدّ على مدى تقاطعات الزَّمان والمكان. وعليه؛ فإنَّ تفرُّد وتمايز التُّراث الإسلاميّ في الفكر السِّياسيّ يرجع إلى تمايز هذا التُّراث في تشكُّله، فضلًا عن تمايز مفردات “النَّصّ” و”الواقع” الذي تعامل معه.
تتساءل د. منى: كيف تكشف الصِّياغة للإشكاليّة موضع البحث عن سياقٍ من شأنه أنْ يصادر على قراءتنا للتُّراث الفكريّ الإسلاميّ، ويفرض عليه تشوُّهات هي ليست منه في شيء؟ وكيف تتأتَّى مراجعة هذا السِّياق على نحوٍ يجعله أقرب نفعًا في التَّعامل مع ظواهر العمران البشريّ عامّةً وواقع الخبرة الحضاريّة الإسلاميّة خاصّةً؟ وما الدَّور الذي يمكن أنْ نقوم به -نحن أبناء هذا التُّراث الإسلاميّ- في تصحيح مناهج التَّعامل مع محصلة التُّراث الإنسانيّ ومداخله، من خلال إعادة قراءة مصادرنا الفكريّة وربطها بمساق حاضرنا المعاش وتصوُّرنا؟
وترى د.منى أنَّ هذه التَّساؤلات وغيرها -التي تَعْرِض للباحث في مصادر الفكر والتَّنظير الإسلاميّة- تستوجب تناولًا ليس هذا مقامه، إلَّا أنَّنا نستطيع من خلال وقفاتٍ قصيرة أنْ نُحدِّد ملامح التَّناول البديل الذي يُمكِّن من استقراء واستجلاء مصادر الفكر السِّياسيّ الإسلاميّ.
وتقول أيضًا: حين يسألونك عن التُّراث؟ فقل: هو الثَّمين الذي لا تُدرك قيمته إلَّا بافتقاده وتفقُّده، وهو الزَّاد الذي لا تحصل الحداثة إلَّا به. وعندما يسألونك عن الحداثة؟ فقل: هي الفتنة التي لا يُردّ بأسها ولا تُرشد إلى هداها بغير التُّراث.
هكذا يدور السِّجال وتحتدّ النَّبرات في لحمة الخطاب المعاصر ليُفصح عن بنيةٍ من المتلازمات ونسيجٍ من المتقابلات المتشابكات، هي -في الحقيقة- مفتاح لخريطةٍ من المتغيِّرات الفكريّة والاجتماعيّة التي تُشكِّل ملامح العصر وصبغة المعاصرة في منطقتنا الحضاريّة العربيّة الإسلاميّة اليوم.
ليست الخطورة أنْ تتعدَّد الاجتهادات في مجال التُّراث أو أنْ تختلف الآراء وتتنوَّع المداخل والمقتربات، فذلك كلّه -لا شكّ- قابل لأنْ يكون زادًا لإثراء التُّراث، ولأنْ يكون أداةً في بناء صرح الفكر الحضاريّ الجديد للأُمّة، وشاهدًا على استعادة فعاليّتها الحيويّة، وقابل لأنْ يُحسب لصالح نهضتها وتجديد بنيّتها الفكريّة، لا أنْ يُحسب عليها؛ لكن الخطورة تكمن في بنية خطاب التُّراث وواقعه ومنطلقاته، وهي مشكلة ترتبط بـ (واقع) الصِّراع الحضاريّ المعاصر وبـ (موقع) أُمّة الكتاب والشُّهود الحضاريّ -بما تُمثّله من تراث- من العالميّة المعاصرة بكلّ ما تحمله الأولى من خصائص موضوعيّة مناهضة للخصائص التي تتمثَّل في الأخيرة.
في تمهيده يُقرِّر المؤلِّف –ابتداءً- أنَّ نهضة أيّة أُمَّة من الأُمم موقوفة على مدى قدرتها على تطوير منهاجيّة معرفيّة تُحدِّد لها مسالك التَّعامل مع مثاليّاتها وعقائدها وموروثها وواقعها ومجمل ما يحيط بها من أفكارٍ وأحداثٍ ومتغيِّرات، وتُمكِّنها من الوصول إلى الحقيقة في مظانّها ومتوقُّعات وجودها، بحيث تسلك كلَّ سبيل يوصلها إلى أيّة مفردة تُسهم في إجلاء الحقيقة، ومن ثمَّ حُسْن معرفة الواقع دونما إغفال أو تجاهل لكثيرٍ أو قليلٍ من مكوِّنات الظَّاهرة موضع البحث والتَّحقيق والدِّراسة، من غير تعجُّل أو تسرُّع في التَّعميم، قبل استكمال البحث والتَّنقيب عن كلِّ ما له علاقة بالموضوع، سواءً بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة، لتكون الأحكام والتَّعميمات مبنية على أُسس معرفيّة سليمة، تعكس واقع الظَّاهرة ومفرداتها بغير تحيُّز يفرض رغبات الذَّات على الموضوع، ويجعل الواقع صورةً لما تبتغيه الذَّات، فيرى الباحث واقعًا خَلَقَه لنفسه استجابةً لرغباته وأفكاره المسبقة ومسلَّماته.
بالنَّظر إلى واقعنا العربيّ الإسلاميّ، نجد أنَّ أخطر مكامن الخلل فيه تتمركَّز في بنيّته المعرفيّة المنهجيّة. فعلى الرَّغم من كثرة الإنتاج “العلميّ”، إلَّا أنَّ انعدام المنهج والنَّسق المعرفيّ يجعل ذلك الإنتاج “العلميّ” رُكامًا يزيد في التَّشويه والضَّبابيّة أكثر ممَّا يُسهم في وضوح الرُّؤية المؤدِّية إلى الإصابة في الفعل.
هذه الحالة ليست قاصرة على فصيلٍ فكريّ دون آخر، فقد أوضح هذا البحث أنَّه حتَّى أولئك الذين يتدثَّرون برداء المنهج العلميّ بمفهومه الأوروبيّ لم يتعدَّ تعاملهم معه حدود الشَّعار إلى المضمون الحقيقيّ للمنهج. فجميع من كَتَبَ عن الفكر السِّياسيّ الإسلاميّ أو التُّراث السِّياسيّ الإسلاميّ أو إحدى ظواهره لم يطّلع على أكثر من (18%) من المصادر المباشرة لهذا التُّراث، متجاوزًا بذلك أبسط قواعد المنهج العلميّ، وأوّلها قاعدة: (الاستقراء قبل التَّعميم)، التي أجمع عليها مفكِّرو الشَّرق والغرب قديمًا وحديثًا، معتبرين أنَّ التَّعميم دون مبرِّر أو مسوِّغ من استقراءٍ وحصرٍ تفكير غير علميّ وغير منطقيّ، فقد أُطلقت تعميمات سلبيّة أو إيجابيّة على التُّراث السِّياسيّ الإسلاميّ من خلال الاطّلاع على ما لا يزيد بأيّ حالٍ عن (6%) من مجمل مصادره المباشرة، بل إنَّ هناك من لم يرجع إلى أيّ مصدر مباشر وملأ الأرض ضجيجًا حول الإسلام والسِّياسة.
إنَّ تناول مصادر التُّراث السِّياسيّ الإسلاميّ بالتَّنقيب والبحث والدِّراسة يستلزم بدايةً تحديد موقع هذه المصادر من الكتابات المعاصرة في الفكر السِّياسيّ الإسلاميّ أو إحدى ظواهره التي تتعرَّض -بدرجةٍ أو بأخرى- لموقع الظَّاهرة السِّياسيّة في تاريخ الفكر عند المسلمين؛ وذلك لأنَّ شرعيّة القيام بمثل هذه الدِّراسة موقوفة على مدى إلمام الدِّراسات المعاصرة بهذا التُّراث قبل أنْ تصل إلى تعميماتٍ حوله. إذ لو كانت هذه الدِّراسات تتّبع منهجيّة رصينة، لكانت تستقرئ قبل أنْ تُعمِّم، وتبحث قبل أنْ تُقيِّم، وتلم بشتات الموضوع قبل أنْ تُحدِّد موقعه في البنية المعرفيّة لعلم السِّياسة.
في دراسةٍ كمية لموقع مصادر التراث السياسي الإسلامي في دراسات المعاصرين تناول الكاتب بالحصر كم المصادر التُّراثيّة التي اعتمدها الباحثون المعاصرون في بناء نتائجهم وتعميماتهم، وتحديد نسبتها إلى مجمل ما استطاع المؤلِّف الوصول إليه من هذه المصادر، والتي قد يكون هناك منها ما لم يستطع الوصول إليه. توصَّل المؤلِّف إلى (307) ثلاثمائة وسبعة من مصادر تراثيّة مباشرة في علم السِّياسة -كما عرفه المسلمون- منها (105) مائة وخمسة كتابًا مطبوعًا بنسبة (%34.5)، و(127) كتابًا مخطوطًا محدَّد المكان بنسبة (%41.5)، و(75) مصدرًا لم يستطع المؤلِّف بعد إثبات وجودها التَّاريخيّ والوصول إلى تحديد أماكنها، بعد اطّلاع المؤلِّف على (74) كتابًا معاصرًا تتناول الفكر السِّياسيّ الإسلاميّ أو إحدى ظواهره لتحديد موقع المصادر التُّراثيّة من هذه الكتابات، وقد خرج بالنَّتائج التَّالية:
- إنَّ أكثر الكتب التي لعبت دورًا محوريًّا في حياتنا الثَّقافيّة المعاصرة، وأثَّرت على تصوُّرات الكثيرين ومواقفهم من الفكر السِّياسيّ الإسلاميّ، وأثارت أسئلة عديدة لم يكن لها من موضع في العقل المسلم مثل: هل هناك سياسة في الإسلام؟ أم أنَّه تمامًا مثل المسيحيّة الأوروبيّة؟ وهل عرف الفكر الإسلاميّ إنتاجًا فكريًّا سياسيًّا؟؛ أكثر هذه الكتب لم يستقرئ شيئًا من مصادر التُّراث السِّياسيّ الإسلاميّ.
- إنَّ الكتابات المعاصرة لم تستقرئ التُّراث السِّياسيّ الإسلاميّ بدرجةٍ معقولة تقرِّبها من حدود المصداقيّة؛ كما أنَّ تنوُّع الباحثين لم يُنتج تنوُّعًا في المصادر. حيث إنَّ أكثر من (80%) ممَّن كَتَبَ في علم السِّياسة الإسلاميّ لم يرجع لأكثر من عشرة مصادر أو (3.5%) ممَّا توصَّلت إليه هذه الدِّراسة؛ وفي الوقت ذاته يُكرِّرون المصادر نفسها.
حول الضوابط المنهجية لدراسة التراث السياسي الإسلامي، دعا الكاتب لتحقيق التَّفاعل المنهجيّ مع التُّراث السِّياسيّ الإسلاميّ واقترح النَّظر في مجموعة الضَّوابط المنهجيّة التَّالية:
- ضرورة فهم حدود العلاقة بين الفكر والواقع الذي برز فيه.
- ضرورة التَّفرقة بين (الفقه السِّياسيّ) و(الفكر السِّياسيّ).
- منهجيّة التَّعامل مع المفاهيم التُّراثيّة، حيث يأتي إسقاط الدَّلالات المعاصرة للمفاهيم السِّياسيّة -التي هي انعكاس تامّ للمفاهيم الأوروبيّة المترجمة- على المفاهيم التُّراثيّة، وتُفْهَم الثَّانية بدلالات الأولى، ومن ثمَّ تُلْبَس مفاهيم التُّراث مضامين مفاهيم علم السِّياسة المعاصر، وتُفرض عليها الدَّلالات نفسها.
من أهم ما تناوله الكتاب الفصل والتَّفرقة بين نوعيْن من مصادر هذا التُّراث، على أنْ يُفْصَل بينهما طبقًا لمعيار تخصُّص المادة المكتوبة في حقل العلوم السِّياسيّة ومدى قدرتها على الدمج بين الواقع والتنظير، وإفراد الظاهرة السِّياسيّة بالمعالجة والبحث، وليس تناولها في ثنايا أو ضمن سياقات أخرى. هذان المصدران هما: (المصادر المباشرة أو المتخصِّصة) التي تعالج الظَّاهرة السِّياسيّة بصفةٍ أصيلة وباقترابٍ فكريّ وليس فقهيّ، و(المصادر غير المباشرة) التي تحتوي أجزاء سياسيّة ليس بالأصالة؛ وإنَّما بالتَّبعيّة وأحيانًا الهامشيّة.
- المصادر غير المباشرة أو غير المتخصصة، هي المصادر التي لا تُعالج الظَّاهرة السِّياسيّة بالأصالة، وإنَّما تعرض لها في سياقٍ آخر كجزء من ظاهرة عامّة، سواءً كانت فقهيّة أم تاريخيّة أم فلسفيّة أم كلاميّة أم لُغويّة، وتتمثَّل في:
- تفاسير القرآن وشروح الحديث.
- كتب الفقه؛ سواءً الموسوعية أو المختصرة.
- كتب أصول الفقه.
- أبواب “الإمامة” في كتب علم الكلام.
- خُطَب الخلفاء الرَّاشدين -رضي الله عنهم- وعهودهم إلى الأمراء والولاة.
- الكتب الموسوعيّة التي تتناول “بانوراما” من الأفكار والموضوعات.
- كتب التَّاريخ.
- كتب الأدب الشَّعبيّ أو السِّيَر الشَّعبيّة وسِيَر العلماء والصَّالحين.
- كتب التَّعريفات ومعاجم اللُّغة.
- المصادر المباشرة أو المتخصصة، وهي موضوع هذه الدِّراسة وعلّة وجودها، وعليها ينبغي أنْ يقوم أيّ بحث في الفكر السِّياسيّ الإسلاميّ أو إحدى قضاياه. وهذه المصادر تُمثِّل ما استطاع المؤلِّف الوصول إليه من خلال سلوك الخُطُوات التي ذكرها في منهجيّة الدِّراسة. ومن ثمَّ، فلن يمكن الادّعاء بأنَّها كلّ ما وُجد في التُّراث الإسلاميّ من مؤلَّفاتٍ سياسيّة، إذ إنَّ هذه الدِّراسة لم تتضمّن جميع المصادر ولم تمسح من خزائن المخطوطات الإسلاميّة إلَّا القدر اليسير. ولكن الدراسة اتسمت بأنها:
- غطَّت الكتب التي توصِّلت إليها جميع فترات التَّاريخ الإسلاميّ وجميع أماكنه ومذاهبه، فهي ممثّلة لمختلف الفترات التَّاريخيّة ومختلف المذاهب والأقاليم.
- وضع تسلسُّل للمؤلِّفين، وتناول نبذة مختصرة عن حياة المؤلِّف واهتماماته العلميّة وتخصُّصاته، ثُمَّ يلي كلّ مؤلِّف الكتب التي ألَّفها مُرتّبة في تسلسلٍ مستقلّ عن تسلسل المؤلِّفين.
- ذكر المؤلِّف بأسمائه وألقابه كاملة؛ حتَّى يسهل بعد ذلك التَّأريخ له من قبل أيّ باحث آخر.
- تحديد أماكن وجود الكتب التي أمكن التَّوصُّل إليها، وسنوات طبعها إنْ كانت مطبوعة، وأرقامها إنْ كانت مخطوطة في خزائنٍ معلومة.
أهم إسهامات الكتاب:
- تكمن الإضافة الحقيقيّة لهذا الكتاب -بعد توضيحه لأزمة الحقل المعرفيّ (التُّراث السِّياسي)- إلى تشخيص المصادر والأسباب، وإلى معرفة الظَّواهر والأعراض بعد ربطها بأسبابها، بوضع العقل المسلم -دينًا وحضارةً- أمام مسؤولياته الكاملة عن هذا التُّراث.
- يضم الكتاب قائمة بيلوجرافية مستوعبة لحشدٍ كبير من مصادر تراث الفكر السِّياسيّ الإسلاميّ مطبوعًا ومخطوطًا.
- يتمحور هذا الكتاب حول أولى قواعد المنهج العلميّ، وهي قاعدة: (الاستقراء قبل التَّعميم)، حيث إنًّ الفكر السِّياسيّ الإسلاميّ ظاهرة تاريخيّة تتعلَّق بعصورٍ ماضية لا نستطيع دراستها أو ملاحظتها بطريقٍ مباشر. لذلك؛ فإنَّ وسيلة البحث في هذا الموضوع أساسها استقراء ما كُتِبَ في هذا الفكر وما كُتِبَ عنه، وكذلك إجراء مسح تاريخيّ للفكر الإسلاميّ من خلال مصادره الموثّقة؛ سعيًا للبحث عن ماهية الموضوع وعناصره، دون الاكتفاء بالبحث عن أشخاص أو أسماء كُتُب بعينها أو اتّخاذ مواقف مع أو ضدّ.
- كشفت هذه الدِّراسة أنَّ هنالك عمليّة -عمديّة أو غير عمديّة- لطمس تاريخ المسلمين وتراثهم، ولم تُبرز منه إلَّا القليل النَّادر، الذي لا يمكن البناء عليه بصورةٍ متزنة مستقيمة. وذلك أنتج -بصورةٍ تلقائيّة- حالةً من افتقاد المرجعيّة، ورغبةً في الهروب من الذَّات؛ لأنَّها خاوية لا تحمل شيئًا، ولا تُمثِّل أرضيّة صلبة يقف عليها باحث علم السِّياسة. ومن ثمَّ كان إدماج هذا الجيل في إطار المرجعيّة الأوروبيّة -بتاريخها وتراثها وفكرها- عملًا تلقائيًّا ومنطقيًّا، إذ لا بُدّ من أرضيّة ينطلق منها الفكر، ولا بُدّ من بناء سابق يُشيَّد عليه ويُراكم. أمَّا البدء من لا شيء -بعد أربعة عشر قرنًا-فأمر يُثير اليأس والتَّوتُّر، ويؤدِّي إلى الانكفاء على الذَّات والانكماش عليها أو خلعها والتَّخلُّص منها والذَّوبان في الآخر ذي العُمْق التَّاريخيّ والتَّواصل الفكريّ.
- لا بُدّ أنْ تنطلق محاولة بناء علم سياسة إسلاميّ معاصر من فهم وتحليل وقراءة معرفيّة على أُسس منهجيّة لهذا التُّراث، وذلك قبل الشُّروع في اجتهادٍ جديدٍ قد يستهلك طاقات وجهودًا تُعيد أو تُكرِّر ما تُوصِّل إليه، إذ إنَّ بناء علم سياسة إسلاميّ يستلزم بدايةً تحديد عناصر ثلاثة، هي: من نحن؟ ماذا نملك؟ وماذا نأخذ من الآخر؟
استدراك على الكتاب:
يُلاحظ عدم اهتمام الكاتب بما يكفي بتوضيح المفاهيم الأساسية التي تمحور حولها وتحديد معانيها ودلالتها، ويمكن الإشارة إلى تعريفات موجزة لبعضٍ من تلك المفاهيم:
- التراث: هو ما ورثه المسلمون في أجيالهم الحالية من الأجيال السابقة، أو هو ما تركه السابقون في صدر الإسلام الأول من معارف وأفكار وقيم ونظم وعلوم بعد وفاة الرسولﷺ.
- السياسة: هي القيام على الأمر مما يُصلحه، والأمر هو أمر العامة.
- التراث السياسي: هو ما ورثه المسلمون من معارفٍ، وأفكارٍ، ونظمٍ، وقيمٍ متعلقة بأمر العامة من أجيالهم السابقة.
- الاستقراء: هو منهج للبحث يُتوصل به لقواعد كلية عامة من خلال تتبع الظواهر الجزئية.
ومما يجب الالتفات إليه أيضًا استكمالا لإسهام هذا العمل العلمي:
- جميع ما تُوصِّل إليه من خلاصات وتعميمات وتقويمات حول الفكر السِّياسيّ الإسلاميّ في حاجة إلى إعادة نظر في ضوء كميّة المصادر التي اعتمد عليها الكتاب.
- من المفيد أنْ تُكرَّر هذه الدِّراسة في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة الأخرى، سواءً بالخُطُوات المنهجيّة نفسها أو بالتطوير عليها، وذلك حتَّى نستطيع أنْ نُحقِّق (إسلاميّة المعرفة) في هذه العلوم على أُسسٍ راسخة أساسها التَّواصل مع الذَّات بعقلٍ منفتح على الآخر ومعطيات العصر، حتَّى لا نفقد الوجهة والاتّجاه.
__________
هوامش
* د. نصر محمد عارف، في مصادر التراث السياسي الإسلامي.. دراسة في إشكالية التعميم قبل الاستقراء والتأصيل)، تقديم: د.منى أبو الفضل، سلسلة المنهجيّة الإسلاميّة (7)، (هيرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، 1415هـ -1994م).
** أستاذ مشارك بقسم العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية.
*** هذا العرض لكتاب “في مصادر التراث السياسي الإسلامي…” هو أحد تكليفات “مدرسة التأسيس في المنظور الحضاري” التي نظمها مركز الحضارة للدِّراسات والبحوث في الفترة سبتمبر – ديسمبر 2024.