فيم نفكر حين نفكر في الأكاديميا؟
قراءة في كتاب مزالق البحث العلمي: دروس من دراسات الإسلام للدكتور أحمد عاطف أحمد
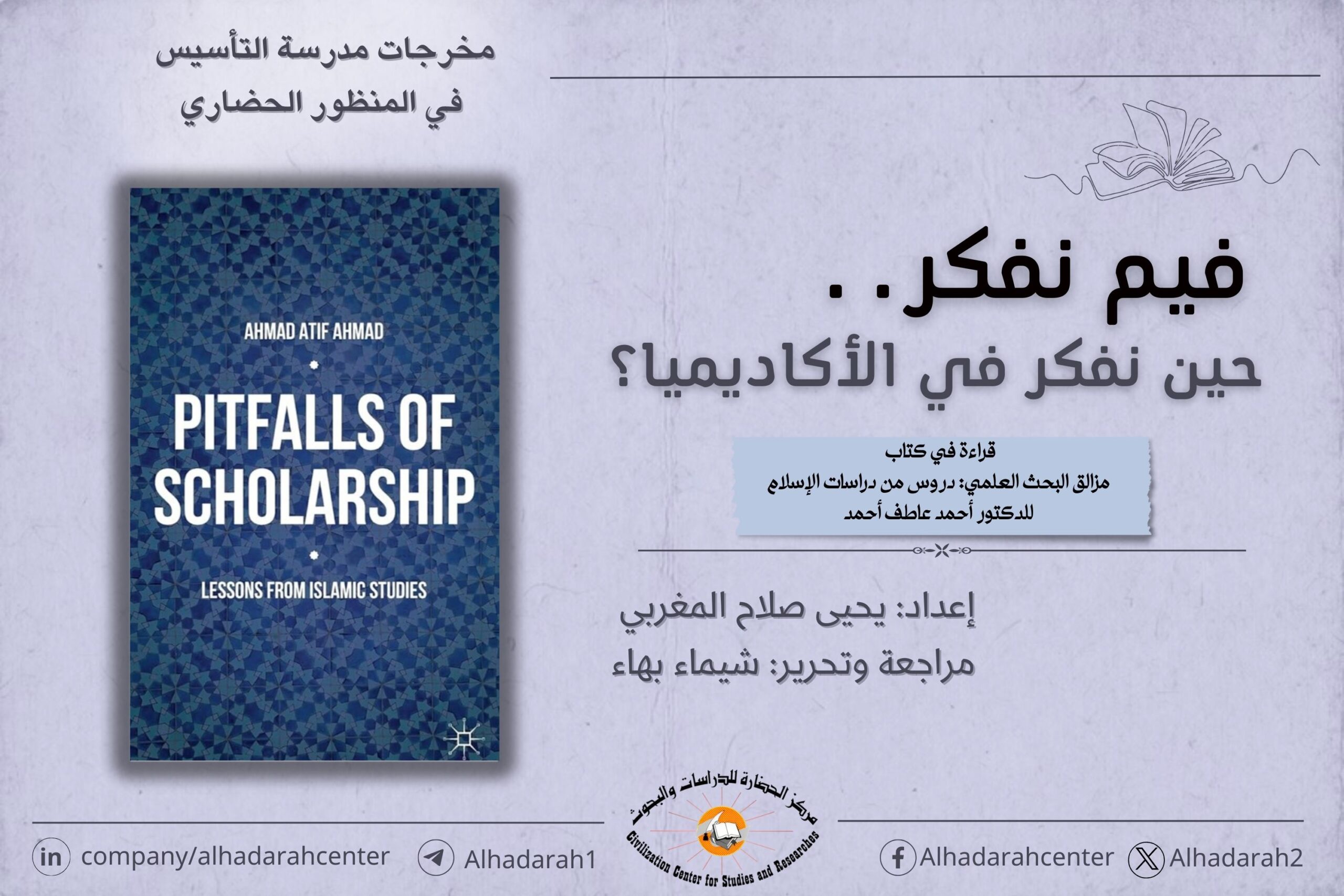
مقدمة*:
تُواجه الدراسات الإسلامية العديد من التحديات سواء في داخل العالم الإسلامي أو خارجه، ومن أبرز تلك التحديات، خاصةً في الغرب، سيطرة الرؤى الاستشراقية على مستوى المضمون والمناهج. ويُعد تسجيل الخبرات الأكاديمية مسألة في غاية الأهمية على هذا الصعيد؛ إذ ربما تسهم في معالجة الإشكاليات ذات الصلة.
في هذا الإطار، يأتي هذا الكتاب الذي أُلف في فترةٍ انتقالية من مسيرة الدكتور أحمد عاطف أحمد المهنية؛ إذ شهدت تغييرات في بيئته الأكاديمية أتاحت له حزمةً من النقاشات المهمة حول التعليم والثقافة والعلوم الإنسانية وعلاقة ذلك كله بالديموقراطية والقومية والأديان، مكّنته النقاشات من تأملاتٍ فكرية مختلفة قرر تسجيلها في هذا الكتاب.
من منظورٍ نقدي شخصي، يتناول الكتاب تفاعل المؤلف مع التقاليد الأكاديمية الإسلامية والغربية على حدٍ سواء، ويعرض خبراته الحياتية بأسلوبٍ أكاديميٍ دقيق. يسعى الكتاب إلى استكشاف التحديات المعرفية والمنهجية التي تواجه دراسات الإسلام في الأوساط الأكاديمية المعاصرة، مما يجعل من هذا العمل إسهامًا مهمًا في هذا المجال.
تعريف بالكاتب
الدكتور أحمد عاطف أحمد هو أستاذ دراسات الدين في جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا. بدأ دراسته الأكاديمية بتركيزٍ كبيرٍ على الفقه الإسلامي والقانون الحديث، وكان متأثرًا بشكلٍ خاص بإرث د.عبد الرزاق السنهوري ومساهماته في القانون المدني المصري. ومع مرور الوقت، توسع نطاق اهتماماته ليشمل دراسات أوسع في الإسلام، حتى أصبح أحد أبرز العلماء الذين يربطون بين المعرفة الإسلامية الكلاسيكية والأفكار الأكاديمية المعاصرة في الولايات المتحدة.
لعبت تجربة الكاتب في العيش بين ثقافتين -التقاليد الإسلامية والأكاديميا الغربية- دورًا أساسيًا في تشكيل رؤيته الأكاديمية. وقد تميزت أعماله بأسلوبٍ هادئٍ وعميق؛ حيث يتجنب الانجرار وراء النقاشات الاستقطابية، ويُقدّم رؤى نقدية جديدة. من بين أعماله البارزة كتابه “فتور الشريعة”، الذي يستعرض الإجابة عن سؤال قابلية الشريعة الإسلامية للزوال من المجال العام عند مفكري الإسلام القدماء، إضافةً إلى هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ويُعد الأكثر تعبيرًا عن تجربته الشخصية وتأملاته الفكرية. وقد أكسبته حكمته الهادئة في الكتابة ونمطه الأكاديمي مكانة مرموقة، ما جعله مصدر إلهام للكثيرين، منهم بالتأكيد المراجِع نفسه.
تعرفت على د.أحمد عاطف من خلال الاستماع لكلمته في مؤتمرٍ لتجديد الخطاب الديني عقده الأزهر الشريف، هو تحديدًا المؤتمر الذي دار فيه السجال الشهير بين شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة حول تجديد الخطاب الديني. لفت انتباهي الكلمة الهادئة للدكتور عاطف المتجاوزة للخلافات بين الرجلين (والمدرستين)، والتي تقول كلامًا ربما يجده المستمع بديهيًا لا خلاف حوله، وربما من منظور آخر تجده عبقريًا لا يُتوصل له إلا بنَفَسٍ هادئ. وانجذابًا لذات النفس الهادئ كانت قراءتي الأولى لكتابه فتور الشريعة، التي مثلت رحلة أنطلق منها إلى مطالعة كثير من مقالات الدكتور ولقاءاته ومحاضراته المسجلة.
هذا النفَس الهادئ للمؤلف في التناول يُمثل بالنسبة لي حلًا واضحًا لمعادلة المزج بين رفض البحث المحموم عن التخلص التام من التحيزات المسبقة توصلًا إلى موضوعية زائفة بشكلٍ تنمسخ معه هوية الباحث تمامًا، وكذلك التأني الحذر والتوقف الصارم مع هذا الانحياز الذي تصالحنا معه كي لا يُشوش أحكامنا ولا يحرمنا من رؤية شيءٍ حسَنٍ عند من ننحاز ضدهم، أو شيءٍ سيءٍ عند من ننحاز لهم. الهدوء والتعقل والحكمة هي إذن أبرز معالم منهج الدكتور أحمد عاطف.
مجال الكتاب، ومنهج الكاتب
يأخذنا كتاب “مزالق البحث العلمي” إلى نقطة تلاقٍ بين دراسات الإسلام ومجالات المعرفة الإنسانية الأوسع. في مسار البحث يتناول الكتاب نقدًا معمقًا للأساليب والأطر الفكرية التي يقوم عليها البحث الأكاديمي المعاصر حول المعارف المنتجة غربيًا في العلوم الطبيعية والإنسانية، ثم نأتي إلى المساجلة الواقعة داخلها بين الطبيعيات والإنسانيات، ثم البحث في مدى إفساحها مجالًا لفهم المعارف المنتجة خارج العالم الغربي (المعارف الإسلامية مثالًا)، خاصةً في السياقات الأكاديمية الغربية. يبني الدكتور أحمد هذا النقد على ضوء سنواتٍ من المناقشات مع زملائه وطلابه، ليعرض تجاربه الشخصية بوصفه عالـِمًا يُزاول العمل الأكاديمي في الولايات المتحدة.
لا يقتصر نطاق الكتاب على دراسات الإسلام فقط، بل يتوسع ليطرح تساؤلات أساسية حول طبيعة البحث العلمي ذاته. ومن خلال مقارنة بين التقليد الفكري الإسلامي والمعايير الأكاديمية الغربية، يدعو الدكتور أحمد القراء إلى التفكير مجددًا في الأطر التي يدرسون من خلالها. هذه الرؤية المتوازنة تجعل الكتاب مرجعًا لا غنى عنه لأي شخصٍ يسعى لفهم أو نقد الأطر الأكاديمية المعاصرة، وخاصةً في المجالات التي تجمع بين الثقافات أو تتطلب مقاربات متعددة التخصصات.
لا ينطلق النقد الذاتي الموضوعي للكاتب -وأتذكر هنا وصف د.عبد الوهاب المسيري لتجربة سيرته الذاتية بأنها غير ذاتية وغير موضوعية- من إطار رؤية العالـَم الإسلامية والنموذج الحضاري الإسلامي حصرًا، بل هو يؤكد في مقدمة الكتاب أن أفكاره انبنت على خروجه عن مجال تخصصه أكثر بكثير مما انبنت على اقتصاره عليه. النقد هنا إذن بعيون الشاهد الحضاري، لا بذهن الناقد الإسلامي فقط. أو بكلماتٍ أوضح، هذه تأملات ممارس للعمل الأكاديمي (محاضرًا، وكاتبًا، ومناقشًا) يمنحه مروره بين العالـَميْن قدرةً على تأملهما من منظورٍ مختلف، لا ينحاز بحكم النشأة لعالمه الإسلامي فيغفل مزايا الحياة الأكاديمية المعاصرة، لكنه كذلك لا ينظر لها منبهرًا بشكلٍ يمنعه من إبصار (مزالقها).
مرتكزات الكتاب
– بين عالمين
أستاذ الأديان المهتم بالجوانب القانونية والتشريعية من الحضارة الإسلامية الذي ألف هذا الكتاب، لم يكن كذلك طوال عمره. في لحظةٍ ما كان طالبًا للدراسات العليا في القاهرة يدرس تراث مشروع السنهوري باشا (أبي القانون المصري المتوفى 1971). ففي عام 1949 أصبح القانون المدني الذي وضعه السنهوري هو المطبق في الأراضي المصرية، يصف السنهوري إنتاجه للقانون المدني أنه نتاج دمج القانون الفرنسي المصري الحديث (المطبق وقتها لعقودٍ في المحاكم المختلطة في مصر) مع التقاليد التي عرفتها مصر لقرونٍ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، مع سماح معقول للذات للاطلاع على مدونات قانونية معاصرة كذلك والأخذ منها بقدر الاحتياج.[1]
يدرس إذن طالب الدراسات العليا تراث السنهوري، ثم ينطلق إلى دراسة القانون المصري الحديث، ثم يحصل على شهادة الماجستير ويخرج من مصر ليعمل أكاديميًا بصفته باحثًا في الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية.
في أمريكا، ومع الاحتكاك الدائم بالمجتمع العلمي، يمر عبر عدة جامعات قبل أن يستقر في نهاية المطاف في جامعته الحالية (كاليفورنيا، سانتا باربرا)، ويرصد الكثير من الأحداث التي تربط بين الإسلام والغرب، وكيف لمجال دراسته أو تدريسه أن يُسهم في رصد هذه الوقائع أو لا يغير من رصدها شيئًا. هذا وصولًا إلى عام 2015 (لحظة إنتاج هذا الكتاب) التي اعتزم فيها تسجيل وقائع اللحظة الحالية المتعلقة بالتفكير الشرعي الإسلامي في عالم الولايات المتحدة اليوم، ومساهمة ذلك في تشكيل المدرسية scholarship في عالم الأكاديميا الغربية، ومساهمة هذا العالم وانحيازاته في فهم هذا التراث (غير الغربي).
– هل يمكن عزل الدارس عن مدرسيته؟
بالنظر إلى النشاط الذي يمكن للدارس Scholar أن يمارسه في بيئة المدرسية Scholarship بين التعلم والقراءة والاستماع للمحاضرات أو إنتاج هذه المواد أو مطلق النقاشات الأكاديمية، يبرز السؤال الأهم المتعلق بنهاية عصر هذا الشكل من الأكاديميا: فهل تؤذن مؤسسة الجامعة والمعهد العلمي بالانتهاء بشكلها المعاصر؟
بالنظر لأعداد باحثي ما بعد التخرج في الولايات المتحدة وحدها يوجد 1.4 مليون باحث مسجل في الجامعة في عام 2012 [2]، فنحن الآن نعيش زمن (العلماء) من الناحية العددية البحتة قطعًا (يوجد على كوكب الأرض اليوم علماء أكثر من أي وقتٍ مضى). ولكن من جهة نظرٍ أخرى، فإن تعريف هؤلاء العلماء اليوم يختلف -قليلًا- عن تعريفنا لهم منذ قرونٍ مضت؛ فالعالم اليوم هو متخصص في فرعٍ معرفيٍ ضيقٍ للغاية، وتقتصر قراءته فيه على أهداف وظيفية بحتة، ولا يجد في نفسه الجرأة للبحث والقراءة الجادة خارج فرعه المعرفي؛ إذ القراءة خارجه لن تُفيد تخصصه وعمله اليومي في المدرسية.
على الجانب الآخر، يبرز لنا مفهوم “المثقف”؛ وهو القارئ غير المتخصص، وتختلف أوصافنا حول جدية قراءته، وإلى أي مدى تقترب معارفه من معارف المتخصص. يغلب على ظننا أنه يظن في نفسه في الغالب معارف أعظم مما يحمله على الحقيقة. القارئ المثقف قد يسمح لنفسه بالحديث في القضية بمجرد قراءة مقالة حولها تقريبًا، ويسمح لنفسه بوصف بحثه عن القضية بحثًا بمجرد استخدام شريط البحث جوجل على انترنت هاتفه النقال.
إلى جانب هاتين الحالتين، نجد الكثير مما يصفه الكتاب بمغالطة الشخصنة المطورة: أشكال حديثة من مغالطة الشخصنة تتنكر في أوصاف غير سيئة السمعة، لكنها تقوم بما قامت به مغالطة الشخصنة على الدوام. على سبيل المثال: التشكيك في كل رأي يخالف الاعتقاد السائد لصالح الاعتقاد السائد. ينضاف إلى كل هذا متلازمة الحرص على الصورة الأكاديمية بأعظم من الحرص على مضمونها الأكاديمي نفسه؛ وهي ظاهرة سكّ لها الكاتب اسم (متلازمة الهارفاردية Harvardosis).
فما الذي قد يحمله الدارس في مدرسيته إزاء بيئة علمية شبيهة؟ وهل يستطيع العالم تقديم نفسه خارج إطار كونه باحثًا عن طريق إجابة جزئية لسؤال جزئي، ليس بالضرورة حاملًا لإجابات يحتاجها العالم لأسئلته الكبرى، ولا يطالبه عمله البحثي بإنتاجها؟ غير أنه على الجانب الآخر، عليه -ولا شك- أن يتحرر من مصادرات مؤسسته الجامعية على إجابات هذه الأسئلة الكبرى بإجابات محددة سلفًا لا يمكنه الاختلاف معها؟ هذا ما يستكشفه الكتاب من خلال تطرقه لمسائل أربع هي:
- الحداثة المتأخرة وحدود المدرسية فيها (الفصل الأول: الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه).
- صراع المعرفة الشخصية والأكاديمية مع الافتراضات والقناعات الاجتماعية (الفصل الثاني: ضمير المتكلم الأول).
– الهوس بأساليب البحث في الأكاديميا الحديثة (الفصل الثالث: الطريقة والاكتشاف والمعرفة).
– تطلعات التعليم الحديث واكتساب الجودة فيه بالمعنى الديمقراطي (الفصل الرابع: الديموقراطية، الأديان، القومية، الفوضى).
الإسلام في عقول دارسيه.. فرصة إن أحسنت ضبط زاوية النظر
لا يعِد الكتاب هنا بتقديم صورةٍ مختلفة عن الإسلام بوصفه دينًا، بالرغم من أن كاتبه أستاذ في الأديان. كما أنه لا يُقدم النظر إلى الإسلام من منظور (حضاري مقارن) كالمعهود في المقارنة بين بيئتين تعليميتين. إن الكتاب يقدم لنا الإسلام بوصف الدارسين Scholars والمدرسية Scholarship فرصة لإعادة النظر في المفاهيم المسيطرة على المدرسية الغربية، فقط إن أحسنت توجيه النظر إلى التراث الإسلامي ذاته، لا القراءات الثانوية المنحازة ضده (من وجهة نظر استشراقية) أو المنحازة لتجميله (من وجهة نظر نقد الاستشراق).
يتناول المؤلف كيف أن دارس الطبيعيات المعاصر مأزوم برغبته الدائمة لأن يجد إجابة لأسئلةٍ كبرى تتجاوز معرفته الطبيعية مثل (كيف حدث الانفجار العظيم وإلام أدى؟)، كذلك الأمر بالنسبة لرغبة فيزيائي الكم المعاصر في الإجابة عن طبيعة الحياة لمجرد دراسته للكوارك وطبيعة حركته، كما نجد كيف أن عالم الأعصاب الذي قد يُظن أن حدود بحثه العلمي لن تتجاوز التكوين المادي لتلافيف الدماغ البشري لا يمكنه بطبيعة الحال أن ينهي بحثه بأن يجزم بأن الدماغ البشري برمته ظاهرة مادية.
إن المخاوف الإبستمولوجية -كما يصفها الكاتب- وجهت العديد من المفكرين في العالم برمته (ولا فارق هنا تحديدًا بين الدارس المسلم وغير المسلم) إلى إعادة استكشاف الأسئلة المعرفية الكبرى. علماء مثل الجويني والغزالي الفارسيين، ابن رشد الأسباني، ديكارت الفرنسي، كانط الألماني، جميعًا كانوا مفكرين في حقل المعرفة الإنسانية الأول: المعرفة ذاتها.
من هنا يبدأ الجميع رحلته، وليس بالضرورة ينهونها في نفس المنطقة. لكن ما يمكننا وصف الدارسين المسلمين حياله (وليسوا استثناءً قاطعًا عن جل معارف عصور ما قبل الحداثة في قارات العالم القديم) هو أنهم انتهوا إلى حالة أكثر تواضعًا مع المعارف السابقة عليهم، لم يصفوها بوصف العصور الغابرة والوسطى على سبيل المثال. فالمأزق الأيديولوجي عندهم ينتهي في اللحظة التي يعترفون بها بأنهم -كالسابقين تمامًا- “متأكدون من بعض الأشياء، متأكدون تقريبًا من البعض الآخر، وليسوا متأكدين على الإطلاق من المعظم”. ليس ثمة خوف من كوننا نجهل المعظم؛ لأن -في الخبرة الإسلامية مثلًا- “الله أعلى وأعلم”، ويمكن لغير المؤمن بالخالق أن يستعيض عنها بعبارات من نوعية “المعرفة الكاملة خارج النطاق البشري”.
يرى الكاتب أن تدريس التاريخ الإسلامي ومؤسسات الحضارة الإسلامية (المؤسسات القانونية أو الفقهية منها هي الأكثر لمعانًا كونها محل اهتمامه الدراسي) هو امتياز يجب على كل من حازه التباهي به، بالتأكيد للأمر بعض معوقاته؛ مثل: عدم إقبال الطلبة على هذا الحقل الدراسي، لكن الأمر كذلك له ميزاته. المعلمون في هذا المجال يتعرفون على ذات العالم الذي يساعدون طلابهم في التعرف عليه، وبالتالي فإنهم يتعرفون على أنفسهم في هذا الحقل الدراسي. وفي حال كونهم متخلصين من الانحيازات المشوشة (لا الانحيازات البسيطة التي لا يكاد يُزيلها إنسان عن نفسه)، فإنهم يستمتعون بخوض مناقشاتٍ يومية لا تنتهي بحسمٍ تسوقه أحداث الوضع الراهن. الأسئلة في هذا الحقل المعرفي أعمق من أن تحمل إجاباتها البسيطة مواقع البحث ودوائر المعارف الإلكترونية على الانترنت.
إن إعادة زيارة معارف ومفاهيم توحي المدرسية المعاصرة أنها محسومة؛ مفاهيم مثل (العلم) و(الطب) و(القانون) و(التاريخ) بل و(الحرية)، من بوابة غير معاصرة وغير غربية، يُتيح التنقيب عن معارف متجددة في علم اجتماع المعرفة. فقط بامتلاك أدوات التنقيب المناسبة لذلك لن يكون الأمر ضربة لازب بكل تأكيد، فالمدرسية الغربية كانت ولا زالت مشحونة بشكلٍ دائم بمجموعة من الافتراضات الغربية حول الإسلام وعالمه لا زالت تشوش النظرة إليه. لكن بمجرد تعلم كيف تتعامل بثقةٍ مع الأسماء اللامعة في الدراسات الإسلامية وكيف تبحث دائمًا في المصادر الأصلية دون أحكامٍ مسبقة، ستجد كنزًا ربما تُصادف فيه فرصًا كثيرة.
هيكل الكتاب وأهم فصوله
في الفصل الأول “الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه”، يبدأ الكاتب بتساؤلٍ مثيرٍ للتأمل ربما: متى نحن؟ ليس في السؤال ثمة خطأ مطبعي، فليس المقصود (أين نحن؟) بل (متى؟). وهو التساؤل الذي يبحث في موقعنا من قسمة تاريخ البشر إلى حداثة وما قبل الحداثة… متى إذن تنتهي الحداثة ويبدأ العصر التالي لها؟ يُجيب الكاتب في نهاية الفقرة بإجابةٍ حصيفة: “نهاية الحداثة يجب أن تكون بنهاية التحقيب periodization”؛ لأن التحقيب بدوره هو درة الاعتسافات الحداثية. بمعنى آخر، ستنتهي الحداثة في اللحظة التي نتوقف فيها عن التساؤل عن نهاية الحداثة.
ليس الغرض الرئيس من الفصل إذن البحث عن مدى اقتناع الكاتب بمصطلحات مثل (الحداثة، ما قبلها وما بعدها، والعصور الوسطى، والعصور القديمة) بذاتها، لكن لبحث كيف اختلفت أفكارنا في اللحظة التي أعلنا فيها أننا في عصرٍ مختلف؟ وإلى أي مدى لا زلنا نصف أفكارنا بأنها مميزة ومختلفة في الثقة والحسم والطمأنينة بالنسبة لما قبلها أو بعدها؟
كيف ننظر إلى مؤسسة القانون الدولي وعموميتها مثلًا؟ هل هي ظاهرة فجة الاختلاف عن قانون الشعوب الذي طبقه الرومان مثلًا في العصور الوسطى؟ وكيف تنظر الحداثة إلى وجود الدين في المجال العام؟ بلا شك أن الحداثات المبكرة وجدت في الدين خصمًا مثاليًا، لكن المناخ الذي ساقته الحداثة انتهى بنا اليوم إلى أن يعود الدين -وبقوة- إلى المجال العام في داخل الدول التي بدأت الكفاح ضده بالأساس. هل التميز يتعلق بمسألة حقوق الإنسان إذن؟ في الحقيقة قد عشنا طويلًا كفاية لنرى كيف كان انتهاكها في البلاد التي تحاضر العالم حولها يجعل من الأمر أسوأ بجدارة.
فلننظر إلى موضوع الكتاب إذن: كيف أثرت الحداثة في المدرسية؟ الحرية الأكاديمية في الجامعات معيار جيد للتقييم مثلًا. لكننا نجد أن المجال الأكاديمي يميل إلى تقييد هذه الحرية بمجرد أن يعلو صوتها وينتشر ويفهمه غير المتخصصين. على جانب آخر، يعاني دارس الدراسات الإسلامية طوال الوقت من سوء الفهم المتعمد في كثيرٍ من الدراسات. وفقًا للكثير من الدارسين الأوروبيين، فإن الشريعة الإسلامية في حال نجحت في أن تقنعهم بأنها ليست منحولة من تراث يهودي أو روماني أو فارسي، فهي ليست إلا سلسلة طويلة من التمييز ضد المرأة والكراهية لغير المسلمين وأي شيء غير عقلاني ممكن.
نعم بدأت الأكاديميا -وبسبب النقد ما بعد الحداثي- في أخذ منحى أقل تطرفًا إزاء الدراسات ذات المصادر غير الغربية؛ ومنها دراسات الإسلام بالطبع، لكن هذا جاء من باب النقد الذي هو فرع عن الخطاب الأصلي يثبت وجوده بنقده، لا يلغيه، ولن يستطيع إلغاءه؛ لأن مشروعه بالأساس نقدي لا يُلزم نفسه بطرح البديل. لا يجري التمييز إزاء منتجات حضارية مخالفة وحسب، بل يحدث طوال الوقت مثلًا بين الدراسات الطبيعية والدراسات الإنسانية. وفي هذا الإطار أيضًا يسمح الدارس للعلوم الطبيعية لنفسه بأن يبدأ تعريف تاريخ العلم الذي يدرسه بقرن أو قرنين أو ربما بعض قرن من الزمان، يفتخر بجهله بما يسبق هذه الفترة، ثم ربما هو يعلن كشفًا جديدًا في العلم يُطابق كشفًا ظهر في الفترة التي يراها غير علمية بوضوح.
في الفصل الثاني “ضمير المتكلم الأول”، يتناول الكاتب التوتر بين السعي الفردي للعلم وتوقعات المجتمع من المعرفة. يُقدم نقدًا ديناميكيًا؛ حيث تطالب المعرفة العامة الجامعات بالامتثال للمعايير الاجتماعية، مما يهدد نزاهة الاستقلال الأكاديمي. يتعمق الفصل في استكشاف الصراعات بين البصيرة الشخصية والمعايير الجماعية، مستندًا إلى سياقاتٍ فلسفية وقانونية وتاريخية.
يطرح الفصل مفهوم التصوف الأكاديمي، حيث يُصبح العلم غير مفهوم للعامة، مما يخلق عزلة بين الأكاديميا والمجتمع. لا شك أن المحاسبة العامة ضرورية، لكن إخضاع الدقة الأكاديمية لآراء عامة الناس يضعف مهمة الجامعة في توسيع حدود المعرفة. هذا النقد يتناغم مع التقاليد الفكرية الإسلامية، حيث توازن علماء مثل الغزالي بين التأمل الصوفي والتفاعل مع المجتمع.
تتجلى قوة هذا الفصل في استكشافه الدقيق لمسؤوليات العالم المزدوجة: تقدم المعرفة، والتواصل بفعالية مع جماهيرٍ متنوعة. يستخدم الكاتب أمثلة تاريخية مثل داروين والغزالي، حيث تُظهر رحلاتهم الفكرية عزلة العلماء الطليعيين. لا يتفق الكاتب بالضرورة مع ما انتهت إليه رحلة الغزالي، لكنه يؤكد على أن المهم في الرحلة هو دافعها لا نتائجها.
من الجدير بالذكر أن هذا النقاش يتضمن نقدًا إسلاميًا ضمنيًا للممارسات الأكاديمية الحديثة، كما يرسم أحمد عاطف أوجه تشابه بين التحديات المعرفية في الأكاديميا الغربية وتلك التي واجهها علماء الإسلام القدامى. هذا التأمل يتماشى مع الهدف الأوسع للكتاب، وهو التوفيق بين الأنماط الإسلامية والغربية للمعرفة مع الحفاظ على وفائها لخصوصياتها. بشكلٍ عام، يُعد هذا الفصل تأملًا عميقًا في أخلاقيات وأهداف العلم، مما يجعله قراءةً أساسيةً لأي شخصٍ يتأمل في الدور المتغير للجامعات في المجتمع. فلا يزال النهج الدراسي المعتمد في الأكاديميا الغربية اليوم، هو المعيار الأمريكي للعلوم؛ سواءً أكان مقبولًا أو غير مقبول، معيبًا أو غير معيب. ولعل رحلة الغزالي تقدم لنا كيف يمكن للباحث أحيانًا أن يُعاني من الالتزام بالمعيار الاجتماعي السائد، إن أصابه الشك المناسب فيها.
يستكشف الفصل الثالث “الطريقة والاكتشاف والمعرفة” تقاطعات التحيزات الشخصية والعمل العلمي، وينتقد وهم الموضوعية الكاملة في البحث الأكاديمي. إنه يتحدى فصل الباحث عن سياقه، مع التأكيد على حتمية التأثيرات الشخصية على البحث. يناقش المؤلف الطبيعة المتناقضة للمنح الدراسية، ويسلط الضوء على التوترات بين الذاتية والصرامة الأكاديمية. يقدم هذا النقد في نقاطٍ أربع هي:
- انتشار النفي دون مساهمات ذات مغزى.
- التشكيك تجاه التماسك والأنظمة.
- الهوس بالمفارقة التاريخية.
- الشعور السائد بـ”عصر النهايات”، الذي يتميز بالسخرية وغياب الهدف من المدرسيات.
ينتقد الفصل فكرة المفارقة الزمنية التي تفرض فروقا زمنية صارمة، وغالبًا ما تنخرط في تحليلات متحذلقة أو متناقضة. يمتد النقاش إلى المعضلات المنهجية، مؤكدًا أن الالتزام الصارم بالأساليب الرسمية غالبًا ما يخنق الإبداع الفكري والاكتشاف. في النهاية، يدعو الفصل إلى تحقيق توازن بين المنهجية الصارمة والانفتاح على الذاتية والمفارقات المتأصلة في العمل العلمي. يشرح المؤلف بشكلٍ فعال القضايا الحرجة في المدرسيات المعاصرة، ويقدم رؤى محفزة للتفكير حول التوترات المتأصلة في البحث الأكاديمي. إن نقد وهم الموضوعية مقنع بشكلٍ خاص؛ لأنه يؤكد على التأثير الذي لا مفر منه للعوامل الشخصية والسياقية.
موضوع الفصل الرابع “الديموقراطية، الأديان، القومية، الفوضى” هو تأثير التفكير الجماعي والقومي، المجهز بحججٍ غريبة -لم تخضع لاختبارٍ مفحص- بأن الديمقراطية هي رهان آمن لتوليد المعرفة الآمنة في عصرٍ يقترب من عبادة التكنولوجيا والهندسة. خذ الديمقراطية ضامنًا للعدالة، أو أساسًا لتوليد شخصية مستقرة ومرنة للمجتمع، أو أساسًا لدعم المعرفة والاكتشاف؛ وهي تفشل دون عناءٍ على الجبهات جميعها. خذ الأديان الوطنية التي لا تترك مجالاً للأفراد ليتنفسوا، وستجد أيضًا الحرية والثورات والفوضى، ستكون النتيجة في غالب احتمالاتها مزيدًا من الدمار والفوضى.
للكتاب فصل أخير بعنوان “سيرة ذاتية” لا يستمر في عرض أفكار الكتاب بقدر عرضه لسيرة أفكار كاتبه، قصته والقيود التي ورثها خلالها حتى لحظة كتابة الكتاب، يحمل الفصل نصيحة غالية هي استخدم ولكن بحذرٍ وعناية. يعود الكاتب ليؤكد في خاتمة أنه بالرغم من كل هذه الانتقادات، فإنه في المجتمعات الديمقراطية والقومية وغير المنضبطة، يجب حماية المساحة المخصصة لمؤسسة الجامعة؛ لأنها أحسن رهاناتنا في العصر الحالي. نحن نتبصر بعيوب (مزالق) المدرسية، ونحسن رؤيتها بعين المتفحص الذي تلقى درسًا أو أكثر من الدراسات الإسلامية؛ لكننا قطعًا لا ندعو لإلغائها، ولن نفعل حتى يتوفر بديل أفضل لها.
منهج الكتاب في النقد في مرآة الدراسات المماثلة
لا يعني تعرض الكاتب لهذه القضايا بالنقد أنه متبنٍّ للظاهرة النقدية أو دراسات ما بعد الحداثة، في الواقع -وكما يصفها الكاتب- فإن “ما بعد الحداثة هي الابن العاق للحداثة الذي أطلق النار على والده ثم انتحر”. لذا؛ فإن في كل نقد يُقدمه الكاتب للمدرسية التي كابدها غرب المحيط (في الولايات المتحدة) أو شرقه (في مصر)، فإن نقده لا ينـزع عن خاطره ضرورة الأكاديميا والمدرسية في الحياة المعاصرة، فإن توفير تعليم عال لحوالي 30 في المائة من مواطني الولايات المتحدة الشباب، ودفع حدود المعرفة الإنسانية، أغراض لا يمكن التنازل عنها ببساطة مهما بلغت حدة نقدنا للمزالق التي تحف هذه العملية.
وقفة نقاش مقارنة
في ضوء ما تم استعراضه ننتقل إلى مقارنة نقدية بين ما قدمه الكاتب مع كتابين مهمين كُتِبا في نفس الحقل المعرفي هما “الاستشراق” لإدوارد سعيد[3] و”الإسلام والغرب وتحديات الحداثة”[4] لطارق رمضان.
بينما يُبرز إدوارد سعيد في عمله “الاستشراق” نقده الثوري للخطاب الغربي الذي يُعيد تشكيل صورة الشرق بصورةٍ نمطية مُختزلة، يتعمّق الدكتور أحمد عاطف في نقد الممارسات الأكاديمية الإسلامية نفسها، فيعمل على تسليط الضوء على المزالق التي تُعيق البحث العلمي في مجاله. يُظهر سعيد كيف تُستخدم المنهجيات الغربية في تأطير الشرق ضمن حدودٍ ضيقة تُهمّش الجوانب الإنسانية والثقافية فيه، بينما يؤكد عاطف على أن النقد الحقيقي لا ينبغي أن يقتصر على رفض ما هو خارجي، بل يجب أن يشمل إصلاحًا نقديًا من الداخل يُعيد توازن العملية البحثية في المؤسسات الإسلامية. في هذا الإطار يتضح الاختلاف في المنهج؛ إذ يعتمد سعيد على أدوات تحليل الخطاب والنظريات النقدية مثل ما بعد الاستعمار، بينما يتبنى عاطف منهجًا يجمع بين التحليل التاريخي والنقد المنهجي الذاتي. بهذا التباين، يُقدم عمل عاطف قراءة شمولية تجمع بين نقد الخطاب الخارجي وإصلاح الممارسات البحثية الداخلية، مما يثري الحوار الأكاديمي ويُضيف بُعدًا إصلاحيًا جديدًا.
وعلى صعيدٍ آخر، ينتقد طارق رمضان في كتابه ” the West and the Challenges ,Islam of Modernity” النظرة الحداثية الغربية التي تُغرق الحضارة الإسلامية في معايير العلوم الطبيعية والتقنيات الحديثة، مُبرزًا كيف يؤدي ذلك إلى إغفال الأبعاد الإنسانية والروحية الأساسية. بينما يسعى رمضان إلى إعادة تأصيل الخطاب الإسلامي في مواجهة التحديات الثقافية والسياسية الغربية، يُوجه عاطف انتقادًا منهجيًا لممارسات البحث العلمي الإسلامي نفسها، مؤكدًا على ضرورة تحديث الأساليب الأكاديمية من الداخل دون أن يُغفل أهمية الحفاظ على التراث العلمي والثقافي الإسلامي. يُظهر هذا الاختلاف أن كلا النهجين يُكمل أحدهما الآخر؛ فالرؤية التي يُقدمها رمضان تُعيد النظر في الصورة الغربية المُضخمة، بينما يركز عاطف على إصلاح النظم الداخلية، مما يُفضي إلى حوارٍ نقدي متوازن يجمع بين النقد الخارجي والإصلاح الذاتي.
ما بعد القراءة
يُعد كتاب مزالق البحث العلمي مساهمة متميزة في مجال دراسات الإسلام والنقد الأكاديمي. نجح الدكتور أحمد عاطف أحمد في جسر الهوة بين التقاليد العلمية الإسلامية والغربية، مقدمًا وجهة نظر شخصية بعمق ومع ذلك ذات صلة عالمية. يضيف الكتاب من خلال نهجه التأملي -الذي يسلط الضوء على تحديات “التصوف الأكاديمي” والتوتر بين المعرفة الشخصية والاجتماعية- بعدًا مهمًا للنقاشات المعاصرة حول دور الجامعة.
من وجهة نظر المراجع، يُعد الفصل الذي يتناول “الضمير المتكلم المفرد” أبرز فصول الكتاب؛ حيث يُعالج -وبشكلٍ ساحر- الذاتية، واغتراب العلماء الذين يسعون لموازنة مساعيهم الفكرية الشخصية مع توقعات المجتمع. كما تُظهر إضافة الدكتور أحمد لشخصيات مثل الغزالي قدرته على دمج الفكر الإسلامي الكلاسيكي في نقاشات إبستمولوجية معاصرة. أما انتقاداته لدمقرطة التعليم، فرغم ما تتسم به من دقةٍ واحترام، تتميز بجرأتها في التأكيد على أهمية الحفاظ على صرامة البحث العلمي في مواجهة تيارات الشعبوية. الغزالي في عيون الكاتب في هذا الفصل مثل تجربة الأكاديمي وكيف تُشكل المعرفة قوته وإعادة ترميم شكوكه، لا يرى الكاتب الغزالي صديقًا -وهو يكثر من إضفاء هذا الوصف على كثير من المفكرين المسلمين وغير المسلمين عبر التاريخ- بل هو يراه مرشدًا بدرجةٍ أعلى. ومن الممتع للعقل والوجدان أن ترى وصف الكاتب للأزمة في حياة شخص يسترشد به.
أبرز ما يُميز الكتاب هو نقده الإسلامي للأكاديميا الغربية؛ من خلال مقارنة التقاليد الفكرية الإسلامية بالممارسات الأكاديمية الغربية، ومن ثم يتحدى الكاتب القراء لإعادة النظر في الافتراضات المعرفية الكامنة وراء كلا المنهجين. أيضًا من مميزات هذا العمل منهجيته، التي تدمج بين الفلسفة والقانون والتاريخ، فتقدم مثالًا على التعددية التخصصية مع بقائها راسخة في الرؤية الإسلامية للعالم.
رغم أن الكتاب يبرز في تقديم نقد غني ومعمق، إلا أن بعض الجوانب كان من الممكن تطويرها بشكل أكبر. على سبيل المثال، يدعو النقاش حول “التصوف الأكاديمي” إلى استكشاف أعمق للحلول العملية لسد الفجوة بين الأكاديميا والمجتمع. كما كان يمكن للكتاب أن يستفيد من المزيد من التفاعل الصريح مع كيفية تقديم الإبستمولوجيا الإسلامية لأطر بديلة للتحديات الأكاديمية المعاصرة. علاوة على ذلك، رغم أن منهج الدكتور أحمد في نقد البحث الغربي يتسم بالتفكير العميق، قد يجد بعض القراء أن المقارنات مع التقاليد الإسلامية أقل قوةً في بعض الفصول. ومن ثم، فمن شأن تعزيز هذه الروابط أن يرفع من تأثير الكتاب، خاصةً لدى القراء غير المُلمين بتاريخ الفكر الإسلامي.
يُعد كتاب “مزالق البحث العلمي” للدكتور أحمد عاطف أحمد نقدًا ذاتيًّا ودعوة للعمل للعلماء الذين يتنقلون بين التفاعل المعقد بين المعرفة الشخصية والاجتماعية. يتجاوز الكتاب الحدود التخصصية، مقدمًا رؤى ذات قيمة متساوية لدراسات الإسلام والفلسفة والعلوم الإنسانية بشكلٍ عام. كما أنه من خلال استكشاف موضوعات مثل دمقرطة التعليم، والتوتر بين البحث الفردي ومتطلبات المجتمع، والنقد للممارسات الأكاديمية الغربية، يدعو الدكتور أحمد القراء لإعادة التفكير في الأسس الإبستمولوجية للأكاديميا الحديثة. إن استخدامه للتقاليد الفكرية الإسلامية كعدسة للنقد له دلالة خاصة، إذ يُظهر أهمية استمرار هذه التقاليد في معالجة القضايا المعاصرة.
يعد هذا الكتاب قراءة ضرورية للأكاديميين والطلاب وصناع السياسات الذين يسعون لفهم تحديات وفرص البحث العلمي في عالم معولم. إذ يُوفر الدكتور أحمد من خلال رؤيته المعمقة خارطة طريق لتعزيز التفاعل الفكري عبر الفجوات الثقافية والإبستمولوجية.
يمكن للكتاب أن يفيد في سياق الأكاديميا الإسلامية -في دول العالم الإسلامي- التي غالبًا ما تُقلد النماذج الغربية تقليدًا أعمى، تواجه تحديات لوجستية ولغوية وإبداعية تحول دون تطوير مناهج بحثية نقدية تستجيب لخصوصياتنا الثقافية والتاريخية. يمكن كذلك الاستفادة من الطرح الذي يقدمه الكتاب من خلال تبني منهجية منفتحة تُدمج بين أدوات النقد الغربية الحديثة وبين التجربة التراثية الإسلامية الأصيلة. إذ يجب إعادة تأصيل البحث العلمي في مؤسساتنا عن طريق نقد ذاتي يعيد النظر في طرق التدريس والبحث، ويشجع على الابتكار في صياغة النماذج العلمية بما يتناسب مع الواقع العربي. هذا النهج لن يكون مجرد تقليد لما هو أجنبي، بل هو تعديل إبداعي يأخذ في اعتباره المزايا العلمية للمنهج الغربي، مع ضرورة مراعاة الفروق اللغوية والثقافية التي تميزنا. بهذه الطريقة، يُمكن للطرح النقدي أن يتحول إلى أداة فعالة لإصلاح الأكاديميا العربية الإسلامية، فتصبح أكثر قدرةً على اللحاق بالتطور العالمي دون فقدان هويتها، مما يُتيح للباحثين بناء جسر حقيقي بين تراثنا وبين متطلبات العصر الحديث.
في الختام، يُعد كتاب “مزالق البحث العلمي” شهادة على قوة التأمل الفكري والتواضع الأكاديمي، ويذكرنا بأن السعي وراء المعرفة، رغم ما يحيط به من تحديات، يبقى مسعى نبيلًا يعبر الحدود ويلهم التغيير.
—————————————
الهوامش:
.Ahmad Atif Ahmad, Pitfalls of Scholarship: Lessons from Islamic Studies, (New York: Palgrave Macmillan, 2016 *
- ويمكن الاطلاع على الكتاب عبر الرابط التالي: https://2cm.es/R-OAتنويه: الترجمة الشائعة لكلمة Scholarship هي بطبيعة الحال (المنحة الدراسية) وهي بالطبع ترجمة غير معبرة عن المعنى المراد في عنوان الكتاب وعبر فصوله، فاخترت استعمال لفظة (البحث العلمي) في العنوان ليكون واضحًا، غير أني عبر صفحات المراجعة أعدل عن هذا الاستعمال إلى استعمال كلمة (المدرسية).
هذا العرض لكتاب “مزالق البحث العلمي: دروس من دراسات الإسلام” هو أحد تكليفات “مدرسة التأسيس في المنظور الحضاري” التي نظمها مركز الحضارة للدِّراسات والبحوث في الفترة سبتمبر – ديسمبر 2024.
[1] للمزيد حول عبد الرزاق السنهوري وأثره في القانون المصري، بل وربما في قوانين العالم العربي ككل:
السنهوري.. حارس القانون، الجزيرة الوثائقية، 20 يناير 2020، متاح عبر الرابط التالي:https://2cm.es/R-PP
للمزيد عن تأثر الكاتب بالسنهوري ووصفه لعمل السنهوري القانوني والتشريعي: لقاء الكاتب في برنامج عصير الكتب: بلال فضل، حوار مع أحمد عاطف أحمد، برنامج (عصير الكتب)، 7 أبريل 2018، متاح عبر الروابط التالية: الجزء الأول: https://2cm.es/R-QL ، الجزء الثاني: https://2cm.es/UEsH ، الجزء الثالث: https://2cm.es/UEt8
[2] Derek Bok, Higher Education in America, (United Kingdom: Princeton University Press, 2013).
[3] إدوارد سعيد، الاستشراق، محمد شاهين (تقديم)، محمد عصفور(ترجمة)، (القاهرة: دار الآداب، 2022).
[4] Tariq Ramadan, Islam, The West and the Challenges of Modernity, (UK: Markfield; Leicester, Kube Publishing Ltd; The Islamic Foundation, 2009).






