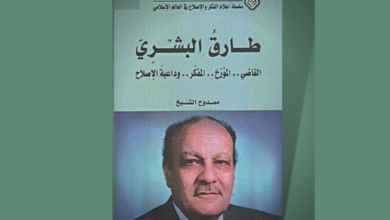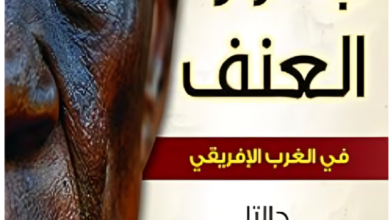عرض كتاب “ميلاد مجتمع” للمفكر مالك بن نبي*
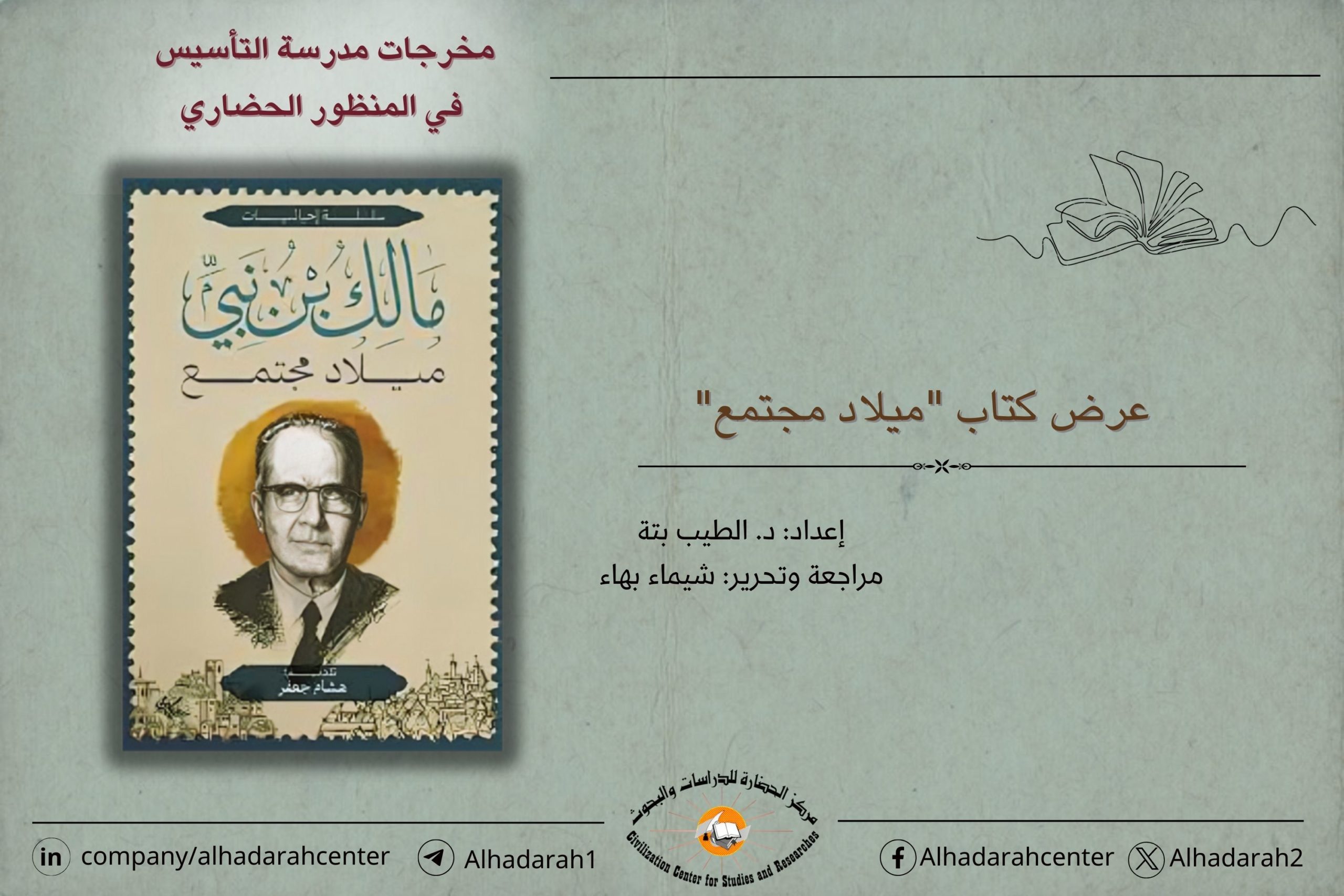
مقدمة*:
تتعدد كتابات مالك بن نبي بشأن دورة حياة المجتمعات والحضارات ومساراتها، لكن كتاب “ميلاد مجتمع” يكشف قدرة بن نبي على الرصد والكشف لمسألة غاية في الأهمية تُعد الانطلاقة الأولى لبناء الحضارة؛ وهي مرحلة الميلاد، وقد حاول الباحث قراءة هذا الكتاب، وسبر أغواره، وتلخيص أهم ما أراد بن نبي إيصاله لنا، ربما نتمكن من استعادة مجتمعاتنا لتولد من جديد عبر وعيٍ رشيد.
أولا- التعريف بالكاتب:
مالك بن نبيّ، مفكّر جزائري له إسهامات كبيرة في الفكر الإسلامي الحديث، وفي دراسة المشكلات الحضارية، حيث أسّس لعدّة مفاهيمٍ فلسفية واجتماعية اعتُبرت سابقة في عصره. وُلد مالك بن نبي في 1 يناير سنة 1905، بمدينة قسنطينة شرقي الجزائر في أسرةٍ محافظة، لأبٍ موظف بالقضاء الإسلامي بمدينة تبسة، ووالدةٍ تشتغل بالحياكة.
كانت بداية دراسته في أحد كتاتيب ولاية تبسة في شمال شرقي البلاد، موازاةً مع تعليمه الابتدائي في المدرسة الفرنسية، وبعدما أنهى تعليمه الإعدادي، ونظرًا لتفوّقه الدراسي، حصل على منحةٍ دراسية، ليُزاول تعليمه الثانوي في مسقط رأسه بقسنطينة حتى تخرجه.
شكّلت مدينة قسنطينة، التي كانت معهدًا للعلوم الإسلامية في تلك الحقبة، بداية انفتاحه على مختلف الثقافات، فسافر بعد تخرّجه عام 1925 إلى فرنسا، ولكنّه عاد إلى مدينته التي نشأ فيها بعد تجربة قصيرة.
اشتغل مالك، في مدينة تبسة، مساعد مكتب في محكمة المدينة لفترةٍ من الزمن، وفي عام 1927 التحق بمدينة آفلو بولاية الأغواط للعمل في محكمتها. في عام 1928، تعرّف بن نبي على الشيخ عبد الحميد بن باديس، رائد الحركة الإصلاحية في الجزائر، ومؤسّس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وفي فرنسا اهتمّ بمشكلات أمته ووطنه، مدفوعًا بشغفه في تحليل الحضارات وتطوّرها.
عاد مرّةً أخرى إلى فرنسا لمواصلة دراسته عام 1930، ولكنّه لم يتمكّن من الالتحاق بمعهد الدراسات الشرقية، فانتسب إلى مدرسة اللاسلكي وحصل على شهادة مهندس في الكهرباء عام 1935.
في فرنسا، انخرط بن نبي في النشاط الفكري والسياسي بين الجزائريين المغتربين، وتعرّض للاستجواب من طرف الشرطة الفرنسية، بعد إلقائه أوّل محاضرةٍ هناك بعنوان “لماذا نحن مسلمون؟” في أواخر ديسمبر 1931.
أثناء دراسته في فرنسا، تعرّف مالك بن نبي على زوجته الفرنسية التي أطلقت على نفسها اسم خديجة بعد إسلامها، لكنّه لم يُنجب منها، وفي هذه الفترة، ألّف الشاب عدّة كتب ومؤلّفات.
كان مالك بن نبي، من بين مؤسّسي “جمعية الوحدة المغاربية” وممثلًا عن الجزائر فيها، تحت إشراف الأمير شكيب أرسلان، وفي مارسيليا أشرف على “المؤتمر الجزائري الإسلامي”.
هرب من فرنسا إلى مصر بعد اندلاع الثورة الجزائرية وأقام بالقاهرة، وتزوّج مرّةً ثانية في عام 1956، واستغلّ هذه الفترة للدفاع عن ثورة التحرير بقلمه وفكره. بعد عودته إلى الجزائر عام 1963، تقلّد مالك بن نبّي عدة مناصب أكاديمية، أهمها منصب مستشار للتعليم العالي، ومدير لجامعة الجزائر، ثم مدير للتعليم العالي، هذا إلى استقالته عام 1967، ليتفرّغ للتأليف والكتابة.
اهتمّ مالك بن نبي، بمجالي النهضة والدراسات القرآنية، فأثرى قاموس الفكر الإسلامي بالمصطلحات والنظريات، وقدّم إسهاماتٍ بارزةٍ في تجديد الفكر الإسلامي المعاصر، وصاغ نظريّته في علم الاجتماع على مبدأ الفاعلية والتصدّي، في تكامل مع ما أسماه القابلية للاستعمار، وهي أبرز النظريات التي اشتُهر بها.
لمالك بن نبي، أكثر من ثلاثين مؤلّفًا في الفكر وعلوم الاجتماع، منها “الظاهرة القرآنية” عام 1946، و”شروط النهضة” عام 1948، و”النجدة… الشعب الجزائري يُباد” عام 1957، و”الصراع الفكري في البلاد المستعمَرة” عام 1959.
نُشر له بعد وفاته كتابان، هما “دور المسلم ورسالته في القرن العشرين” عام 1977 و”بين الرشاد والتيه” عام 1978. وقد تُوفي مالك بن نبي في الجزائر، يوم 31 أكتوبر 1973، ودُفن في مقبرة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.[1]
ثانيًا- سياق تأليف الكتاب:
بالرجوع إلى المقدمة التي خطها الكاتب بقلمه نجد أنه كتب مؤلَّفه في شهر أبريل من عام 1962، بما يعني أنه يُغطي الفترة الزمنية التي تسبق استقلال الجزائر بأقل من ثلاثة أشهر، حيث إن الجزائر استقلت رسميًا في الخامس من شهر يوليو من عام 1962. ويبدو أن المفكر مالك بن نبي ألف كتابه “ميلاد مجتمع” كنصيحةٍ وتوجيهٍ وإرشادٍ للنخبة التي ستتولى الحكم في الجزائر حتى تنتبه إلى ضرورة توفير ما يكفي من الشروط لميلادٍ حقيقي وصحي للمجتمع الجزائري، خاصةً أن هذا الأخير قد تعرض لاحتلال قاسٍ، حيث إن فرنسا الاستدمارية تفننت في محاولة استئصال الشعب من جذوره واستهدفت كيان الإنسان الجزائري ومكونات هويته، فحاربت اللغة والدين والتاريخ، كما استبدلت الجهل بالعلم والمرض بالصحة والموت بل الإبادة بالحياة، وفي المقابل من المعروف أن مالك بن نبي كرس جهده وعقله وتجربته في رسم السبيل الذي يقود نحو بناء الحضارة من خلال الحفر في مشكلاتها وبيان طرق معالجتها.
ثالثًا- منهجية الكتاب:
وضع الكاتب مؤلَّفه هذا في أحد عشر فصلا، جاءت مرتبة ترتيبًا منهجيًا ومنطقيًا، بل حتى إنها جاءت بترتيبٍ هندسيٍ بديع يعكس طبيعة تكوينه التقني؛ إذ درس مالك بن نبي في الجامعة –كما سبق الذكر- تخصص كهرباء؛ وهو ما ظهر جليًا في منهجية عرضه لموضوعات كتبه وتآليفه المختلفة وطريقة تحليله للأفكار وصكه للمصطلحات التي تُميزه عن غيره من المفكرين.
كما أن الكتاب يستخدم منهجية تحليلية لفهم شبكة العلاقات الاجتماعية في المجتمع الجزائري، ويضع في اعتباره التغيرات التي طرأت على المجتمع في ذلك الوقت. كما يستند الكتاب إلى مصادر تاريخية مختلفة، بما في ذلك المصادر الأوروبية والإسلامية. وتلك السمات ستتضح مآلاتها عندما نستعرض الأفكار الأساسية التي تضمنها الكتاب محل الدراسة.
ونُنبه إلى أن كتابه هذا حمل عنوانًا مثيرًا للعديد من القضايا والمفاهيم: “ميلاد مجتمع… شبكة العلاقات الاجتماعية”، وقد شرح مالك بن نبي خلفية هذه التسمية في الصفحة الخامسة بالقول: (.. وهي تشمل في الواقع بمقتضى هذا العنوان، وبصورةٍ منهجية، المفاهيمَ النظرية التي ترجع إليها العناصر التاريخية الخاصة بميلاد مجتمع).
والملاحظ منهجيًا أن الكاتب تطرق أولا لبداية تكوين المجتمع، ثم نشأته وأنواعه، مرورًا بالعوامل المساعدة على نهضته، وصولا إلى المؤثرات التي تؤثر في مسيرته نحو التقدم والنهضة.
رابعًا- الأفكار الأساسية في الكتاب:
جاءت أبرز موضوعات الكتاب تحت العناوين الآتية:
النوع والمجتمع، ابتداءً، ومن المتعارف عليه منهجيًا، وبخاصة عند الأستاذ مالك بن نبي، فقد انطلق في شرح المفاهيم المفتاحية لدراسته وفي مقدمتها “المجتمع”، حيث عرفه على أنه تجمّع أفراد ذوي عاداتٍ متحدة يعيشون في ظلّ قوانين موحدة ولهم المصالح نفسها، أما كلمة “ميلاد” فيُشير بها بن نبي إلى بداية تطور الجماعة الإنسانية، وقد نبه إلى أنه ليس بالضرورة يؤدي بها للتقدم، فيمكن أن يقودها إلى وضعٍ يتسم بالتخلف.
وبشأن التاريخ والعلاقات الاجتماعية، يُقدم بن نبي تعريفًا للتاريخ الذي يعني التغيير الذي تتعرض له الذات والمجال الذي يُحيطها، ويرى أيضًا أنّ هناك عدة عوامل تمارس تأثيرها على الحركة التاريخية وصناعة التاريخ، وتتم تبعًا لتأثير العوالم الثلاثة (عالم الأشخاص، عالم الأفكار، وعالم الأشياء)، والارتباط فيما بينها.
وتحت عنوان أصل العلاقات الاجتماعية، يشرح الكاتب المقصود بـــــــ: “شبكة العلاقات الاجتماعية” على أنها نتيجة الظروف والشروط التي تُحدثها الحركة التاريخية؛ وهي العمل التاريخي الأول الذي يقوم به المجتمع ساعة ميلاده، كما أنّ الشخص هو الذي يبني الحضارة، وفي الوقت نفسه هو نتاج الحضارة، ويدين لها بكل ما يملك من أفكارٍ وأشياء.
كما تناول مالك بن نبي مسألة: طبيعة العلاقات، حيث يرى أنّ الحضارة تبدأ في مجالٍ تتركب فيه الأفكار والأشياء والنشاط في زمانٍ ومكانٍ معينين، والتغيير الاجتماعي -بحسبه- يبدأ بتغيير الفرد في المجتمع. وأشار بن نبي إلى أنّ اجتماع الأشخاص في ظرفٍ ومكانٍ معين هو تعبير مرئي عن العلاقات، وقدّم مثالا بصلاة الجمعة، ورأى أنّ أغلب هذه العلاقات تُعدّ علاقات ثقافية، بالإضافة إلى وجود العلاقة الاقتصادية… وأهم ما تطرق إليه المؤلف أنّ كل ما له صلة بعالم الأشخاص، والأفكار، والأشياء، هو علاقة مشروطة لوجود ثقافة. وقد كان لمالك بن نبي رأي آخر عن الفكرة الماركسية بخصوص العامل الاقتصادي؛ حيث يرى أنه لا يؤثر سوى في المستوى الاجتماعي.
أيضًا عالج الكاتب إشكالية: الثروة الاجتماعية، حيث يرى أنّ مقياس غنى المجتمع هو الأفكار لا الأشياء. وتخضع تفاعلية الأفكار لشبكة العلاقات، فكلما كانت شبكة العلاقات أوثق كان العمل فعالا. وتُعدّ كل مرحلة من مراحل النمو الاجتماعي متميزة بعنصرٍ ثقافي محدد غالبًا، وتكون ثقافة مجتمع ناشئ ثقافة أخلاقية عكس حين أُفُوله؛ إذ نجده يغرق في نزعةٍ جمالية تبتعد عن أصول الجمال الحق.. ومما تجدر الإشارة إليه على جانب آخر أن المجتمعات الحديثة تُحقق انسجامها حيث شبكة العلاقات الاجتماعية حكومية غير شخصية.
كما ركز بن نبي على مسألة المرض الاجتماعي؛ حيث يُصاب المجتمع بمرض اجتماعي إذا ما تمزقت شبكة العلاقات؛ الأمر الذي يرجع إلى تضخم الذوات، فيُصبح العمل الجماعي مستحيلا. ذلك أن كل علاقة فاسدة بين الأفراد تُولّد عُقَدا كبيرة، ولها نتائج سريعة في عالم الأفكار والأشياء والأشخاص، كما أنّ من أسباب تمزق العلاقات؛ إحداث خلل بالقانون الخُلقي في المجتمع.
وحول الدين والعلاقات الاجتماعية، يرى مالك بن نبي أنه يبدأ انطلاق تاريخ مجتمع معيّن بظهور فكرة دينية، والتي نُطلق عليها “العارض” أو “الظرف الاستثنائي”؛ وهي تجمع الإنسان، والتراب، والوقت، وهو التركيب الذي يتفق مع ميلاد مجتمع. وقد أشار الكاتب إلى أنّ العلاقة الروحية بين الإنسان والله (تعالى) هي أساس العلاقة الاجتماعية، فالعلاقة الاجتماعية التي تربط الفرد بالمجتمع هي ظلّ العلاقة الروحية في المجال الزمني، فعندما تقوى العلاقة الدينية تقلّ درجة الفراغ الاجتماعي.
وقد أفرد الكتاب مساحة لشبكة العلاقات والجغرافيا، ويقصد المؤلف بذلك أنّ تأثير فكرة دينية محددة يرتبط ببعض الشروط الجغرافية، وقدم مثالا عن ذلك بــــــــــــــ: “الفكرة المسيحية” التي غادرت فلسطين بحثًا عن الظروف المواتية لها في أوروبا الغربية.
وناقش الكتاب ثنائية: العلاقات الاجتماعية وعلم النفس، إذ يرى بن نبي أنّ هناك تبادلا بين الانعكاسات الفردية والعلاقات الاجتماعية؛ لأن الفرد والمجتمع يعملان في الاتجاه نفسه، وأن الفرد لكي يدخل في شبكة علاقات معينة ينبغي عليه أن يُجسد في ذاته واقعًا نفسيًا معينًا، فنفسية الفرد في المجتمعات التاريخية على الأقل مفعمة بالنزعة الدينية، بحيث يتدخل العنصر الديني في تكوين الطاقة النفسية الأساسية لدى الفرد ثم تُوجه هذه الطاقة تبعًا لمقتضيات النشاط الخاص بهذه “الأنا”.
كما عالج الكتاب فكرة التربية الاجتماعية، وانطلق الكاتب من تساؤل يتصل بما إذا كان هناك منهجٌ يهدي سير المجتمع، وقال إنه إنْ كانت هنالك تربية اجتماعية فإنّ قواعدها العامة ينبغي أن تُستمد من علم التاريخ، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، واستشهد بقول الرسول “صلى الله عليه وسلم”: “لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها”. أي إنه يمكن بناء نظام تربوي اجتماعي، ولكن ينبغي أن تكون لدينا أفكار جد واضحة عن العلاقات والانعكاسات التي تُنظم استخدام الطاقة في مستوى الفرد والمجتمع.
ومن أهم ما تطرق إليه الكتاب تلك الثنائية الملتبسة والحرجة المتمثلة في: شبكة العلاقات الاجتماعية والاستعمار. هنا نجد أن شبكة العلاقات الاجتماعية عند بن نبي هي الّتي تؤَمِّن بقاء المجتمع وتحفظ له شخصيته، أما الاستعمار فغالبًا ما يُحاول هدمها وتمزيقها، وأعطى الكاتب مثالا عن الاستعمار الفرنسي للجزائر.
خاتمة:
علينا نحن الباحثين الوعيُ بأهمية ميلاد المجتمع، ذلك أنه من صحت بدايته صحت نهايته. ويعد مالك بن نبي من المفكرين الرواد الذي اهتموا بكل ما يتصل بالحضارة، بناءً وهدمًا، ورأى أن لكل مجتمع لحظة ميلاد، ولا يمكن للمجتمع أن يكون صحيحًا وسليمًا إلا إذا كانت ظروف ولادته طبيعية.
ومع أن الكتاب قديم في التأليف (عام 1962) إلا أن أهميته متجددة، والاهتمام به من قبيل الواجب. وإذا تساءلنا عن وجه الارتباط بين أفكار الكتاب وواقع المجتمعات الإسلامية اليوم فسنجد ارتباطًا قويًا وواضحًا؛ حيث إن مالك بن نبي يُركز في نظريته العامة على الأفكار ودورها الاستراتيجي في بناء المجتمع المتحضر، فالأفكار إما أن تكون باعثة على العمل والحركة والتجديد وإما أن تكون سببًا في سيادة الكسل والخمول والتقليد. والقرآن الكريم -بمنطق مالك بن نبي- جاء بقيمٍ وتعاليمٍ حيةٍ وفعالة حولت مكة من بيئةٍ ميتة اجتماعيًا وعلميًا وسلوكيًا، فأحدثت فيها تغييرًا عميقًا ونوعيًا في الأنفس والطباع والقناعات والسلوكيات، وكانت النتيجة أن تخلصت من جاهليتها وتحولت إلى بيئة عملية ورسالية.
والعوامل المحددة لهذا التحول عند مالك بن نبي هي طبيعة الأفكار التي يحملها هذا المجتمع أو ذلك، فهو يرى أن الأفكار التي تُعيق حركة المجتمع إما أن تكون أفكارًا قاتلة أو ميتة، ويُوضح مالك الفرق بينهما فيقول: “إن كل مجتمع يصنع بنفسه الأفكار التي ستقتله، لكنها تبقى بعد ذلك في تراثه الاجتماعي “أفكارًا ميتةً” تُمثل خطرًا أشد عليه من خطر “الأفكار القاتلة”، إذ الأولى تظل منسجمة مع عاداته وتفعل مفعولها في كيانه من الداخل، إنها تُكَوّن ما لم نُجرِ عليها عملية تصفية، الجراثيم الفتاكة التي تفتك بالكيان الإسلامي من الداخل، وهي تستطيع ذلك لأنها تخدع قوة الدفاع الذاتي فيه”.
ويطرح بن نبي شروطًا أساسية لدخول أي مجتمع طور الحضارة وهي: أولا- انتصار الأفكار السليمة على الأفكار الميتة والقاتلة. ثانيًا- وضوح المنهج المتبع، مع اتسامه بالأصالة في تنمية الفرد والجماعة. ثالثًا- أن يسلم المجتمع من خطر القابلية للاستعمار. رابعًا- التفاعل الإيجابي بين عناصر الحضارة الثلاثة (إنسان- تراب – زمن).
لكن مجتمعاتنا الإسلامية اليوم لا يختلف اثنان بأنها في ذيل الترتيب العالمي، وعلى أنها تابعة لا متبوعة، مقودة لا قائدة، متخلفة لا متقدمة، مستهلكة لا منتجة، ومن أسباب ذلك أن الأفكار السائدة في مجتمعاتنا أغلبها إما قاتل أو ميت، فاقدة للفعالية ومُعيقة للعمل والحركية والتجديد. وكأن المصطلح الذي صكه مالك بن نبي وهو: “إنسان ما بعد الموحدين” لا يزال الأقدر على توصيف عالمنا الإسلامي اليوم.
_______________
هوامش
* مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، (دمشق: دار الفكر، 1986).
* باحث في العلوم السياسية.
* هذا العرض لكتاب “ميلاد مجتمع” هو أحد تكليفات “مدرسة التأسيس في المنظور الحضاري” التي نظمها مركز الحضارة للدِّراسات والبحوث في الفترة سبتمبر – ديسمبر 2024.
[1] المفكر الجزائري مالك بن نبي، المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، 6 يونيو 2020، متاح عبر الرابط التالي:
https://2u.pw/FODaVpVT