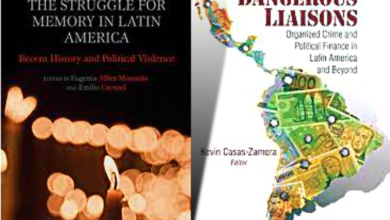عرض كتاب “التَّوحيد جوهر الحضارة الإسلاميّة”*

مُقَدِّمَة*:
“التَّوحيد جوهر الحضارة الإسلاميّة” هو كُرَّاس مستل من كتاب: “أطلس الحضارة الإسلاميّة”، وهو آخر عمل علميّ أنجزه الشهيد الأستاذ الدكتور إسماعيل الفاروقيّ –رحمه الله- بمشاركة زوجته لويس لمياء الفاروقيّ، وقد صدر باللُّغة الإنجليزيّة عن دار ماكميلان للنَّشر عام 1986، ثُمَّ ترجمه د. عبد الواحد لؤلؤة إلى اللُّغة العربيّة وراجعه د. رياض نور الله، ونشره المعهد العالمي للفكر الإسلامي نشرًا مشتركًا مع مكتبة العبيكان في طبعته الأولى باللُّغة العربيّة في العام 1419 هـ – 1998م في (730) صفحة من الحجم الكبير.
هذا الكُرَّاس هو الفصل الرَّابع من ذلكم الأطلس، وهو يتألَّف من (58) صفحة، ويحتوي على مُقَدِّمَة، وسبعة عناوين، يمكن جمعها في عنوانيْن اثنين، تحت كلّ منهما عدد من المبادئ أو الأبعاد، حيث تناول فضيلته في العنوان الأوّل: التَّوحيد بوصفه النَّظرة المُفسِّرة للعالم، وبنظرةٍ عامة منه إلى الواقع والحقيقة والعالم والزَّمان والمكان والتَّاريخ البشريّ، بيّن أنّ التَّوحيد يشمل خمسة مبادئ: الثُّنائيّة، والإدراكيّة، والغائيّة، وقُدْرة الإنسان وطواعية الطَّبيعة، والمسؤولية والحساب، أما في العنوان الثاني، وهو: التَّوحيد بوصفه جوهر الحضارة، فأوضح الفاروقي أنّ له جانبين أو بُعْدين، هما: (المنهج) و(المحتوى)، يشمل الجانب الأول، ثلاثة أُسس، هي: (الوحدة)، و(العقلانيّة)، و(التَّسامح). وتُحدِّد هذه الأُسس شكل الحضارة الإسلاميّة، أمّا الجانب الثَّاني: وهو جانب المحتوى: حيث يشمل: التوحيد بوصفه أوَّل مبدأ في: الفلسفة الماوراطبيعيّة، وفلسفة الأخلاق، وعلم القيم، ووحدة الأُمَّة، وأوَّل أساس في الجماليّات، هذا بالإضافة إلى خاتمة الكتاب.
أبرز الكرَّاس أهمية التَّوحيد المتجلية في إسباغه الهوية المميِّزة والمتفرِّدة للحضارة الإسلاميّة، وربطه جميع مُكوِّناتها معًا؛ ليجعل منها كيانًا عضويًّا متكاملًا يُسمَّى: “الحضارة”، كما عرَّف التَّوحيدَ بأنَّه: (الإيمان العميق الخالص أنَّ الله تعالى هو الخالق الواحد المطلق المتعال، وربّ الكائنات جميعًا وسيّدها). أو بالعبارة البسيطة المتوارثة هو: (الاعتقاد والشَّهادة أنْ: لا إله إلَّا الله).. كما بيَّن أنَّ المسلمين عدَّوا التَّوحيد أهمّ المباديء الأساسيّة التي تضمّ وتحكم بقيّة المباديء، كما وجدوا فيه المنبع الرَّئيس المتحكِّم في جميع الظَّواهر في الحضارة الإسلاميّة. وأخيرًا يخْلُص الكرَّاس إلى أنَّ كُلَّ ما في الإسلام من: تنوُّع، وغنى، وتاريخ، وثقافة، ومعرفة، وحِكْمة، وحضارة، يجتمع في هذه الجُمْلة الجامعة: “لا إله إلَّا الله”، مُؤكِّدًا أنَّ هذه الكلمة الواعية تحمل أعظم المعاني وأغناها في الإسلام.
مؤلِّف هذا الكرَّاس هو الأستاذ الدكتور إسماعيل راجي الفاروقيّ -رحمه الله-، واحد من أشهر المُفكِّرين المسلمين، وهو مُتخصِّص في دراسة الإسلام والأديان في العالم، وُلِدَ في مدينة يافا الفلسطينيّة عام 1921، وحصل على بكالوريوس الفلسفة في الجامعة الأمريكيّة ببيروت عام 1941، وشهادتيْ “الماجستير” و”الدّكتوراه” في الفلسفة من جامعة إنديانا بالولايات المُتّحدة الأمريكيّة عام 1952، جاء إلى القاهرة وأقام بها أربع سنوات قضاها في دراسة العلوم الإسلاميّة بالأزهر الشَّريف. اشتغل بتدريس فلسفة الأديان في المعهد المركزيّ للبحوث الإسلاميّة في باكستان، وفي جامعة سيراكيوز الأمريكيّة، وماكجيل الكنديّة، ترأس الكُلّيّة الإسلاميّة الأمريكيّة في شيكاغو، وعمل أستاذًا في قسم الدِّين بجامعة تيمبل في بنسلفانيا، ناضل سنوات طويلة في سبيل أنْ يكون للإسلام موقع في الأكاديميّة الأمريكيّة للأديان (AAR) ونجح في ذلك، وعمل رئيسًا لقسم الإسلام في الأكاديميّة، وكوَّن مجموعات بحثيّة في دراسة الإسلام.
كان يُصِرّ على استخدام المصطلحات القرآنيّة، مثل: “الصَّلاة” و”الزَّكاة” و”القبلة” و”المسجد” و”التَّوحيد”، بلفظها العربيّ دون ترجمة، ويرى أنْ تبقى كذلك وتدخل إلى اللُّغات الأخرى بهذا اللَّفظ؛ لما يرى فيها من التَّعبير عن حضارة الإسلام. ألَّف الفاروقيّ عددًا من الكُتُب الموسوعيّة في تاريخ الأديان والأديان المقارنة وفلسفة الأديان، من بينها: “الأطلس التَّاريخيّ لديانات العالم”، و”الدِّيانات الآسيويّة الكبرى”، و”الأخلاق المسيحيّة”، و”التَّوحيد وتمثُّلاته في الفكر والحياة”. ونشر معظم بحوثه ومؤلَّفاته باللُّغة الإنجليزيّة وبعضها باللُّغتيْن العربيّة والفرنسيّة. ساهم الفاروقيّ في إنشاء عددٍ من المؤسَّسات، على رأسها المعهد العالميّ للفكر الإسلاميّ، وكان أوَّل رئيس له. اسْتُشْهِد الفاروقيّ وزوجته لويس لمياء الفاروقيّ -رحمهما الله تعالى- عام 1986 في حادثٍ لفَّه الغموض، ارتبط بنشاطاته في التَّوعية بالقضيّة الفلسطينيّة ووقوفه في وجه جماعات الضَّغط الصُّهيونيّة[1].
وقد اعتمدتُ في عرض هذا الكرَّاس على نسخة المعهد العالميّ للفكر الإسلاميّ (هيرندن -فرجينيا)، في طبعته الأولى 1436ه – 2015م، واستعنتُ بالكتاب الأصل (أطلس الحضارة الإسلاميّة) أحيانًا، ملتزمًا بقواعد العرض التي تتوخَّى المحافظة على ترتيب الموضوعات والأفكار الرَّئيسة، لكني عمدتُ إلى بعض التَّصرُّفات اليسيرة، منها:
- إعادة ترتيب محتويات الكتاب على النَّحو الذي أُثبته في هذه القراءة؛ ِلَما تبيَّن لي من صلاحيته بعد المراجعة والمقارنة مع الأصل ومع تدرُّج الموضوعات وترتيبها.
- شرح بعض المصطلحات والألفاظ في الهامش.
- استخلاص النَّتائج التي توصَّل إليها المُؤلِّف، وإيراد بعض التَّوصيات التي تخدم خطّ المؤلَّف.
أولًا- التَّوحيد بوصفه نظرة تُفسِّر العالم
في مبتدأ حديث الدكتور الفاروقي عن التوحيد بوصفه نظرة تُفسِّر العالم، وبنظرة عامة إلى الواقع والحقيقة والعالم والزَّمان والمكان والتَّاريخ البشريّ، بيّن فضيلته أنّ التَّوحيد يشمل عددًا من المبادئ، وهي على النحو التالي:
المقصود من مبدأ الثّنائية، (الخالق) و(المخلوق)، ففي المرتبة الأولى لا يوجد سوى واحد أحد، هو الله المطلق القادر، وحده الدَّائم المتعال، لا شبيه له، باقٍ إلى الأبد، لا شركاء له ولا أعوان. وفي المرتبة الثَّانية يوجد المكان والزَّمان والعالم والخليقة، وهي تضمّ: جميع المخلوقات، وعالم الأشياء، والنَّبات، والإنس، والجنّ، والملائكة.
وأكّد أنّ هاتين المرتبتين من خالق ومخلوق مختلفتان غاية الاختلاف من حيث طبيعة وجودهما، ومن المستحيل قطعًا أنْ يتّحد الواحد بالآخر، وعليه فإنّ بيان فضيلته لهذه الثنائية والتفريق بين مرتبة الخالق والمخلوق يُوضّح ميزة الإسلام الفريدة في هذا الإطار، ومن ثمرات هذه الثنائية استشعار قدرة الله المطلقة، وما سواه مخلوق ضعيف محتاج إلى خالقه، فيتفكر المخلوق في آلاء الخالق وقدرته التي خلق بها السموات والأرض وما فيهما وما بينهما من مخلوقاتٍ مختلفة الأجناس والأنواع، فينبعث الإيمان بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وتفرِّده سبحانه بجلب النِّعم ودفع النِّقم وأنّه مستحق وحده سبحانه للعبادة المطلقة، فيستغني الإنسان عن المخلوقين، ويكفّ عن سؤالهم استشرافًا.
المبدأ الثاني: الإدراكيّة:
وهي تتّصل عند الإنسان بالفهم، بوصفه وسيلة المعرفة، ويشمل الفهم جميع وظائف المعرفة، من: ذاكرة، وتخيُّل، وتفكير، وملاحظة، وحدس، واستيعاب، وما إلى ذلك. ومن ثمّ بيّن أنّ موهبة الفهم موجودة عند جميع البشر، وهي من القوَّة بحيث تفهم إرادة الله؛ ومن ثمّ أشار في هذا المبدأ إلى الفصل الوجوديّ بين (الله) و(الإنسان)، وإلى استحالة اتّحادهما من خلال التَّجسُّد أو التَّأليه أو الذَّوبان. وهو لا يُنْكِر إمكان التَّواصل بينهما -الخالق والمخلوق- عن طريق النُّبوَّة بإيصال أمر إلهيّ للإنسان ويُنتظر من الإنسان أنْ يُطيعه، أو التَّواصل بينهما عن طريق العقل أو الحدس، فيراقب الإنسان مخلوقات الله ويتأمَّل فيها، فيستنتج أنْ يكون له خالقًا مُدبِّرًا رازقًا، هذا هو سبيل الإدراكيّة أو العقلانيّة.
ولمّا كان العقل هو أداة الفهم والإدراك، وبه تُوجَّه الإرادة إلى الامتثال على فهم أدلَّة التَّكليف، فتأتي أهميته في الإسلام ومنزلته، حيث خصّ الله أصحاب العقول بالمعرفة التامة لمقاصد العبادة، ويلحظ المتدبر في نصوص القرآن الكريم ربط كثيرٍ من نصوصه بين تشريعات الأحكام ومقاصد تلك الأحكام، وهذه المقاصد يستنبطها أصحاب العقول التَّامّة وتُعرف بمقاصد الشَّرع[2]، كما أنّ في هذا المبدأ، الفصل الوجوديّ بين (الله) و(العالم)، ملاحظة تمييز التَّوحيد عن جميع النَّظريّات التي تؤلّه الإنسان أو تؤنسن الله، سواء عند الإغريق أو الرُّومان أو الهندوس أو البوذيّين أو المسيحيّين.
من خلال مبدأ الغائية فإن المتأمل في عبارات الفاروقي، يخرج بالمعاني التالية:
- طبيعة الكون ذات غاية، فلم يُخْلَق العالم عبثًا، وكُلّ ما هو موجود إنَّما وُجِد بقَدَرٍ يناسبه، ويُؤدِّي غاية كونيّة مُعيَّنة.
- الإنسان تتحقَّق فيه إرادة الخالق دومًا، كما تُطبّق أنساقه ضرورة القانون الطَّبيعيّ.
- الوظائف الجسديّة والنَّفسيّة عند الإنسان مُكمِّلة للطَّبيعة، وتخضع لما يحكمها من قوانين.
- الوظائف الرُوحيّة عند الإنسان مثل: الفهم، والعمل الأخلاقيّ، تقع خارج حدود الطَّبيعة المُقرَّرة، وتعتمد على صاحبها وتتبع قراره.
- تحقيق إرادة الله في الجوانب الرُوحيّة له قيمة نوعيّة مختلفة عن تحقُّقها بالضَّرورة عند المخلوقات الأخرى.
- غايات الله الأخلاقيّة وأوامره للإنسان تمتلك أساسًا في العالم المحسوس؛ لذا فإنَّ لها جانبًا نفعيًّا.
المبدأ الرابع: قُدْرة الإنسان وطواعية الطَّبيعة:
المتأمل في تناول العلّامة الفاروقي لمبدأ قُدْرة الإنسان وطواعية الطَّبيعة، مع قصر العبارات، يجد أنّه قد جمع فيها ما يوفي المقصود، ويصل إلى المراد بأقصر طريق، ويمكن عرضها في النقاط التالية:
- بما أنَّ كُلَّ شيءٍ خُلِق لغاية فإنَّ تحقيق تلك الغاية ينبغي أنْ يكون ممكنًا، وبغير هذا الإمكان ينهار التَّكليف أو الالتزام الأخلاقيّ.
- الإنسان بوصفه صاحب الفعل الأخلاقيّ يجب أنْ يكون قادرًا على تغيير نفسه وأمثاله من البشر والمجتمع حوله؛ لكي يُحقِّق الأمر الإلهيّ.
- يجب على جميع المخلوقات أنْ تكون قادرة على تحقيق ما يجب أنْ يكون؛ أي إرادة الله أو نسقه الكامل في هذا المكان وهذا الزَّمان.
المبدأ الخامس: المسؤولية والحساب:
استنبط العلامة الفاروقي في مبدأ المسؤولية والحساب عددًا من المعاني، ويمكن إجمالها في الآتي:
- إذا كان الإنسان مطَالبًا بتغيير نفسه ومجتمعه ومحيطه لكي تتماشى كُلّها مع النَّسق الإلهيّ، وكان قادرًا على فعل ذلك؛ يلزم بالضَّرورة أنْ يكون الإنسان مسؤولًا.
- الحساب أو تحقق المسؤولية، شرطٌ لازم للالتزام والإلزام الأخلاقي، وهو يصدر عن الطبيعة المعيارية نفسها.
- كما ألمح فضيلته في هذا المبدأ أنّ هنالك يومًا عظيم هو يوم الحساب والجزاء، وسرد في الهامش بعض الآيات القرآنية التي تشير إلى ذلك، حيث تُوضع موازين القسط والعدل الإلهي لأعمال الناس وأقوالهم التي كانت في الدنيا، وما كانوا عليه من توحيدٍ وشركٍ واستقامةٍ وانحراف، فتُستردُّ الحقوق ويٌرفعُ الظلم، والمسلم حين يتيقّن أنّ هنالك يوم يلقى فيه الله، فيسأله عن كلّ شيءٍ، يعمل على تهذيب نفسه، وتقدير المسؤولية الملقاة على عاتقه[3].
وفي كل ما ذكر د. الفاروقي أشار د.العلواني[4] إلى الظن الخاطئ لكثيرٍ من المشتغلين بقضايا المعرفة بعد عصر التنوير أنّه لا علاقة بالتوحيد والشرك والإيمان والكفر بالمعرفة واعتبار أن القضايا اللاهوتية لو استُبعدت تمامًا من الدائرة المعرفية لكان أولى، فهؤلاء لم ينطلقوا في تأسيس رؤيتهم من أيّ منطلقٍ معرفيّ، إضافة إلى نفورٍ غير مبرر من مبدأ المسؤولية الأخلاقية في جوهره واستبعاد كل ما هو غير حسي وملموس على نحوٍ مباشر من معادلة العلم والمعرفة.
ثانيًا- التَّوحيد بوصفه جوهر الحضارة
أما في العنوان الثاني، وهو: التَّوحيد بوصفه جوهر الحضارة، فأوضح د. الفاروقي -رحمه الله- أنّ له جانبين أو بُعْدين، هما: (المنهج) و(المحتوى).
يشمل هذا الجانب ثلاثة أُسس، هي: (الوحدة)، و(العقلانيّة)، و(التَّسامح). وتُحدِّد هذه الأُسس شكل الحضارة الإسلاميّة.
1- الوحدة:
من خلال الأساس الأول وهو الوحدة، يمكن التأكيد على الثوابت الآتية:
- من الضَّروريّ وجود مبدأ يُوحِّد العناصر المختلفة ويكتنفها في إطاره، مثل هذا المبدأ يُحِّول الخليط من علاقات العناصر مع بعضها ببعض إلى بنية منتظمة تتميَّز فيها مراتب الأفضليّة أو درجات الأهميّة.
- من المهمّ أنْ تقوم الحضارة بهضم العناصر الغريبة عنها، وإعادة تشكيلها واستيعابها، بشكلٍ متّسق غير متنافر؛ وذلك دليل على حيويّتها وحركيّتها وإبداعها.
- أيضًا إن التَّوحيد أو مبدأ وحدانية الله المطلقة وترفُّعه وغائيته، يعني أنَّ الله تعالى وحده هو الجدير بالعبادة والطَّاعة، والإنسان المطيع يحيا حياته في ظلّ هذا المبدأ، ويسعى أنْ تكون جميع أفعاله متّسقة معه؛ لتحقيق الغاية الإلهيّة.
2- العقلانيّة:
ذكر المؤلف أنّ العقلانيّة، هي إحدى مُكوِّنات جوهر الحضارة الإسلاميّة، وبوصفها مبدأ منهجيًّا، تقوم على ثلاثة قوانين:
- الأوَّل: رفض جميع ما لا يتطابق مع الواقع، وهذا القانون يحمي المسلم من الظَّنّ، ومن أيّ ادّعاء بالمعرفة لا يسنده دليل.
- والثَّاني: إنكار التَّناقضات المطلقة، وهذا القانون يحمي المسلم من التَّناقض البسيط من جهة، ومن التَّناقض الظَّاهر من جهةٍ أخرى. والعقلانيّة لا تعني تقديم العقل على الوحي، بل رفض أيّ تناقض بينهما. وفي هذا السياق يُشير د. علواني أنّ التوحيد يحصر مصادر المعرفة بمصدرين اثنين لا ثالث لهما: الوحي والوجود، والعقل بينهما وسيلة وأداة معرفة واستنباط وحدس وإدراك، وفي الوقت ذاته يصنف التوحيد المعرفة إلى سمعيات، ينحصر مصدر معرفتها بالسمع والنقل، وإلى تجريبيات وطبيعيات، والسمعيات هي المصدر الوحيد لسائر الأمور الغيبية، والعقل البشري لم يؤهل للتحرك في عالم الغيب، وعالم الأمر البشري، وهو مطالب بالاستماع إلى الرسل والنظر فيما يأتون به وتدبر معجزاتهم للوصول إلى الإيمان[5].
- والثَّالث: الانفتاح على الأدلَّة الجديدة، فإنَّه يحمي المسلم من الحَرْفيّة والتَّعصُّب، كما يميل به إلى التَّواضع الفكريّ، فيحمله إلى إلحاق عبارة: “الله أعلم” بما يثبت أو ينكر من قول.
الأساس الثالث الذي ذكره المؤلف هو التسامح، وبوصفه مبدأ منهجيًّا ضمن جوهر الحضارة الإسلاميّة يفيد ما يلي:
- القبول بالحاضر، حتَّى يثبت بطلانه، وهو بهذا المعنى يتعلَّق بنظريّة المعرفة، كما يتعلَّق بفلسفة الأخلاق، وبوصفه مبدأ قبول مرغوب حتَّى يثبت بُطْلان الرَّغبة فيه، ويُطْلَق على الحالة الأولى اسم: “السَّعَة”، وعلى الثَّانية اسم: “اليُسْر”.
- في كُلٍّ من (السَّعَة) و(اليُسْر):
- حماية للمسلم من الانغلاق بوجه العالم، ومن النَّزعة المحافظة المميتة.
- حثّ للمسلم على أنْ يُقْبِل على الحياة والتَّجربة الجديدة.
ج. تشجيعًا للإنسان على تناول الحقائق الجديدة بعقله المُتفحِّص وجهده البنَّاء؛ وبذلك يُغني تجربته ويثري حياته، كما يدفع بثقافته وحضارته دومًا إلى الأمام.
- اليقين بأنَّ الله لم يترك النَّاس دون أنْ يُرسل إليهم رسولًا من بين أنفسهم ويُعلِّمهم، وأنَّ عليهم عبادة الله وطاعته، كما يُحذِّرهم من الشَّرّ وأسبابه.
– القناعة بأنَّ لدى النَّاس جميعًا إدراكًا فطريًّا يُعينهم على معرفة الدِّين الحقّ، وتبيُّن إرادة الله وأوامره.
– في مجال الدِّين يُحيل التَّسامح المواجهة والإدانات المتبادلة بين الأديان إلى دراسة علميّة متعاضدة تتناول نشوء الأديان وتطوُّرها؛ لغرض فصل التَّراكمات التَّاريخيّة عن معطيات الوحي الأصليّة.
– في مجال الأخلاق يكون اليُسْر حصانة للمسلم ضدّ أيّة ميول تُنْكِر الحياة، وتُوفِّر له الحدّ الأدنى من التَّفاؤل اللازم للحفاظ على الصّحّة والتَّوازن.
الجانب الثَّاني: جانب المحتوى:
قسّم المؤلف جانب هذا المحتوى إلى أقسامٍ عدّة، وهي: التوحيد بوصفه أوَّل مبدأ في الفلسفة الماوراطبيعيّة، وفلسفة الأخلاق، وعلم القيم، ووحدة الأُمَّة، وأوَّل أساس في الجماليّات.
- التَّوحيد بوصفه أوَّل مبدأ في الفلسفة الماوراطبيعيّة:
من خلال استعراض المؤلف لهذا المبدأ، فإنّ المتأمل فيه يخرج بالتالي:
- شهادة التَّوحيد تعني أنَّ الإيمان بأنَّ الله هو وحده الخالق الذي أعطى كُلَّ شيءٍ وجوده، وأنَّه السَّبب الأعلى في كُلِّ حدث، والمآل الأخير لكُلِّ الموجودات، وأنَّه هو الأوَّل والآخر.
- القول بهذه الشَّهَادة عن رضا وقناعة وفهمٍ واعٍ لمحتواها يُؤدِّي إلى إدراك أنَّ جميع ما يُحيط بنا من أشياء وأحداث، وكُلَّ ما يجري في الميادين الطَّبيعيّة والاجتماعيّة والنَّفسيّة هو من عمل الله وتنفيذ لغاية من غاياته.
- قوانين الطَّبيعة هي أنساق الله التي لا تُجارى، ما يعني أنَّ الله ممسك بخيوط الطَّبيعة من خلال الأسباب، والكون بأسره هو في الحقيقة تفتّح هذه القوانين في الطَّبيعة أو تطبيقها؛ لأنَّها هي أوامر الله.
- يترتَّب على ذلك بالضَّرورة القول:
- إنَّ التَّوحيد يُفيد إلغاء أيَّة قوّة فاعلة في الطَّبيعة إلى جانب الله، الذي تكون مبادرته الأزليّة هي القوانين الثَّابتة في الطَّبيعة.
- التَّوحيد يعني نزع القداسة عن مجالات الطَّبيعة وإضفاء صفة غير دينيّة عليها.
- التَّوحيد نقيض الخُرَافة أو الأسطورة، وهما عدوان للعلم الطَّبيعيّ والحضارة.
- التَّوحيد يجمع خيوط السَّببيّة كافّة ويُعيدها إلى الله تعالى وحده، لا إلى القوى الخفيّة.
- التَّوحيد بوصفه أوَّل مبدأ في فلسفة الأخلاق:
كذلك فإنّ من خلال استعراض المؤلف لهذا المبدأ، يمكن استخلاص ما يلي:
- أشار القرآن الكريم إلى أنَّ الله تعالى قد حمَّل الإنسان أمانته، وهذا الائتمان الإلهيّ هو تنفيذ الجُزْء الأخلاقيّ من الإرادة الإلهيّة.
- التَّكليف أو المسؤولية التي فُرضت على الإنسان دون سواه لا تقف عند حدودٍ إطلاقًا، فهي تشمل الكون بأسره، والجنس البشريّ كُلّه هدف لفعل الإنسان الأخلاقيّ.
- يُؤكِّد الإسلام أنّ التَّكليف هو أساس إنسانيّة الإنسان ومعناها ومحتواها، وقَبول الإنسان بتحمَّل هذا العبء يرفعه فوق مستوى بقيّة المخلوقات.
- هنالك بون شاسع بين إنسانيّة الإسلام وغيرها من الإنسانيّات:
أ. مذهب الإغريق في الإنسانيّة -مثلًا- يقوم على الإغراق في المذهب الطَّبيعيّ إلى حدّ تأليه الإنسان ومثالبه معًا؛ من ناحيةٍ أخرى؛ فإنَّ المسيحيّة كانت على النَّقيض من ذلك، حيث نزلت بقَدْر الإنسان من خلال “الخطيئة الأصليّة”، وأعلنته “مخلوقًا هابطًا” أو “كُتْلة خاطئة”، أمَّا الهندوسيّة؛ فقد قسَّمت الجنس البشريّ إلى طبقاتٍ، وخصَّصت الطَّبقات الأدنى لغالبيّة الجنس البشريّ، وأطلقت عليهم اسم: “المنبوذين”، إذا كانوا من أهل الهند، واسم: “ماليتجا” أو “المُدنَّسين” دينيًّا إذا كانوا من بقية البشر، وجعلت الطَّائفة الأسمى عندهم هم “البراهمة”. ثُمَّ جاءت البوذيّة فحكمت على حياة البشر على أنَّها عذاب وتعاسة لا نهاية لهما، وأنَّ واجب الإنسان الوحيد هو أنْ يسعى للتَّخلُّص من ذلك الوجود بضبط النَّفس والجهد العقليّ.
ب. لكن إنسانيّة التَّوحيد -التي جاء بها الإسلام- وحدها هي الأصيلة الخالصة، فهي وحدها التي تحترم الإنسان بوصفه إنسانًا مخلوقًا، دون تأليه أو تحقير، وهي وحدها التي تُحدِّد قيمة الإنسان بما يُزيِّنه من فضائل.
3-التَّوحيد بوصفه أوَّل مبدأ في علم القيم:
تعتبر دراسة منظومة القيم من القضايا المهمة؛ وذلك لأنّها تمس مباشرةً جوهر الإنسان من جهة، ومجال التدافع الحضاري من جهةٍ ثانية.
من خلال التأمل في هذه الوحدة، مما ذكره العلّامة الفاروقي -رحمه الله- يمكن الخروج بالتالي:
- تأكيد القرآن الكريم أنَّ كُلّ ما في الكون قد سُخِّر لمصلحة الإنسان؛ فالخليقة كُلّها مسرح يُؤدِّي فيه الإنسان فعله الأخلاقيّ، والإنسان مسؤول عن تطوير قُدُراته وقُدُرات البشريّة حوله، وأنْ يُعمر العالم ويُطوّره.
- البشرية بحاجة إلى موازنة وتنظيم سعي الإنسان لكي يُؤدِّي به إلى تحقيق متناسق للقيم جميعًا، حسبما يُناسبها من نظام الأفضليّة، لا بدافع الاستعجال أو العاطفة أو الحماسة؛ وإلَّا سيُؤدِّي سعيه إلى مأساة أو نتيجة سطحيّة.
- كانت حماسة الحضارة الغربيّة للمذهب الطَّبيعيّ قد حملتها إلى التَّطرُّف في قَبول طبيعة دون أخلاق وكأنَّها حالة خارقة، وحيث كان صراع الإنسان الغربيّ مُوجّهًا ضدّ الكنيسة وجميع ما تمثّله، فقد أخذ ما تقدُّمه هذه الحضارة في مجال العلم باعتباره يُعَدُّ تحرُّرًا من رِبْقة الكنيسة.
- الحضارة الحقَّة المتوزانة ليست سوى توكيد للعالم تحكمه أخلاق فطريّة، لا يتنافى محتواها الدَّاخليّ أو قيمها مع الحياة والعالم والزَّمان والتَّاريخ والعقل، مثل هذه الأخلاق لا يُقدِّمها سوى التَّوحيد من بين المذاهب الفكريّة المعروفة عند الإنسان.
4-التَّوحيد بوصفه أوَّل مبدأ في وحدة الأُمَّة:
بيّن المؤلف في هذا السياق الحقائق التالية:
- يُؤكِّد التَّوحيد أنَّ المؤمنين هم في الحقيقة جماعة إخوة واحدة، ويعتصمون بحبل الله جميعًا ولا يتفرَّقون، ورُؤيتهم واحدة، وثمَّة توافق في فكرهم وقرارهم وموقفهم وشخصيّتهم، والأُمَّة أخوة شاملة لا تعبأ باللَّون أو الهويّة العِرْقيّة، وفي حدود هذه الرُّؤية يكون جميع النَّاس سواسية لا يفضل بعضهم على بعضٍ إلَّا بالتَّقوى.
- نظام الأُمَّة نظام كونيّ يشمل حتَّى غير المؤمنين من النَّاس، إضافة إلى كونه نظامًا اجتماعيًّا، وهو نظام سلام، منفتح أبدًا أمام جميع الأفراد والجماعات الذين يؤمنون بمبدأ الإقناع، ويبحثون عن نظام عالميّ تكون فيه الأفكار والثَّروات والنَّاس أحرارًا في الحركة والانتقال.
- السَّلام الإسلاميّ نظام عالميّ يتفوَّق كثيرًا على نظام الأُمم المُتّحدة، ذاك الذي وُلد بالأمس، وقد أجهضته مبادئ “القوى العظمى”، وتقوم تلك المباديء بدورها على السِّيادة الوطنيّة، وعلى نسبيّة في القيم والأخلاق.
- ظهر نجاح الأمم المُتّحدة في قيامها بالدَّور السّلبيّ في منع أو إيقاف الحرب بين أعضائها، وحتَّى هنا يبدو هذا النظام عاجزًا؛ لأنَّه لا يمتلك جيشًا إلَّا عندما يتّفق أعضاء القوى العظمى في مجلس الأمن على تقديم جيش لغرضٍ مُعيَّن.
- على النَّقيض من ذلك فقد وُضع السَّلام الإسلاميّ في دستورٍ دائم على يد النَّبيّ الكريم e في المدينة المُنوَّرة في الأيَّام الأولى للهجرة، فقد كرّم ذلك الدُّستور الأقلّيّات ضامنًا لهويّتهم ومؤسَّساتهم الدِّينيّة والاجتماعيّة والثَّقافيّة.
5-التَّوحيد بوصفه أوَّل أساس في الجماليّات:
من خلال التأمل في هذه الوحدة، مما ذكره العلّامة الفاروقي يمكن الخروج بالتالي:
- الله تعالى هو غير الخليقة وغير الطَّبيعة إطلاقًا، فهو المتعال الأوحد الذي لا شيء يُشْبِهه، ولا يمكن أنْ يُماثله أيّ إبداع جماليّ مهما يكن.
- في حالة الطَّبيعة الحيّة، خاصّة الإنسان، يكون الشَّيء الجميل هو الذي يقترب من الجوهر البدئيّ أشدّ اقتراب ممكن، وهنالك ما يُسمَّى بـ: “الخبرة الجماليّة”، وهي إدراك جوهر البدئيّ الماوراطبيعيّ عن طريق الحواس.
- أمَّا الفنّ؛ فعمليّة تسعى لتكتشف في داخل الطَّبيعة ذلك الجوهر الماوراطبيعيّ لتُمثّله في شكلٍ منظور، والفنّ هو أنْ تُدْخِل في الطَّبيعة عُنْصرًا هو غير الطَّبيعة، وأنْ تُعْطِي ذلك العنصر الشَّكل المنظور الذي يناسبه.
- الإنسان بطبعه يتذوَّق الشَّيء الجميل، ويقع النَّاس تحت حُكْمه، ويرون الشَّيء الجميل في الطَّبيعة البشريّة قد ارتفع إلى درجة التَّسامي، وهو ما سمَّاه الإغريق باسم: “التَّأليه” أو إحالة البشريّ إلى إلهة.
- الإنسان الغربيّ المعاصر لا يصبر كثيرًا على أيِّ إله عندما يتعلَّق الأمر بشؤون ما رواء الطَّبيعة. لكن عندما يتعلَّق الأمر بالأخلاق والسُّلوك، فإنَّ الآلهة التي يخلقها من تعظيمه المشاعر والميول البشريّة هي التي تتحكَّم بأفعاله في الواقع. هذا هو الذي يُفسِّر السَّبب في أنَّ أبرز الممارسات الجماليّة عند قدماء الإغريق كانت تُعنى بفنون تمثيل الآلهة في صور تُمجِّد عناصر وصفات ومشاعر بشريّة، نجدها في الفنون المنظورة في “فنّ النَّحت”، وفي الفنون المُتخيّلة في “الشِّعْر” و”الدِّراما”.
- قام بعض المستشرقين بالطّعن في الإسلام بادّعائهم أنَّ الإسلام لم يعرف الفنون التَّشخيصيّة مثل: “النَّحت” و”الرَّسم” و”الدِّراما”؛ وعلَّلوا ذلك بأنَّ الإسلام يخلو من أيّة آلهة مُتجسِّدة لأنشطتها في صراعها مع بعضها البعض أو مع الشَّرّ. لكن ما قصدوا به الطَّعن في الإسلام هو في الحقيقة امتياز الإسلام الأوَّل، وإنَّ مجد الإسلام الفريد أنَّه يخلو تمامًا من عبادة الأصنام، ومن الخلط بين (الخالق) و(المخلوق).
- التَّوحيد لا يُعارض الإبداع الفنّيّ أو التَّمتُّع بالجمال، بل على النَّقيض من ذلك يبارك الجمال ويُشجِّعه. وفي المقابل يعتقد الفنان المسلم بأنْ لا شيء في الطَّبيعة يمكن أنْ يُمثِّل الله تعالى أو يُعبِّر عنه، وقد تحقَّق للفنان المسلم إنجازه الإبداعيّ ومن ذلك الإدراك بأنَّ الله جلّ جلاله لا يمكن التَّعبير عنه بصريًّا هو أعلى هدف جماليّ ممكن أمام الإنسان.
- ابتكر الفنان المسلم[6] “فنّ التَّزيين” وحوَّله إلى “الزَّخرفة العربيّة” أو “التَّوريق المُتشابك”[7]، وهو تشكيل لا يُطوِّر بُعْدًا واحدًا، بل يمتدّ في جميع الاتّجاهات إلى ما لا نهاية. وفي هذا تفسير لاتّصاف أغلب الأعمال الفنّيّة التي أنتجها المسلمون بالتَّجريد[8].
- طوَّر هذا الفنَّان “الخطّ العربيّ” ليجعل منه زخرفة عربيّة لا حدود لها، وينطبق القول نفسه على “الهندسة المعماريّة” المسلمة، حيث تكون جبهة البناء عنده زخرفة عربيّة، ومثلها المسقط الرَّأْسيّ وخط الأُفق ومُخطَّط الأرضيّة[9].
- إنَّ التَّوحيد عند جميع الفنَّانين المؤمنين بنظرة الإسلام للعالم والكون هو العامل المشترك الأوحد بينهم، مهما كانوا متباعدين جغرافيًّا وعِرْقيًّا.
خاتمة:
تناول هذا الكُرَّاس تحليل التَّوحيد بوصفه الجوهر والمبدأ الرئيس في الحضارة الإسلاميّة، الذي يمنحها هوّيتها، ويربط جميع مُكوِّناتها معًا ليجعل منها كيانًا عضويًّا متكاملًا نسميه: “حضارة”. كما تضمَّن التَّوحيد بوصفه نظرة تُفسِّر العالم، وأوَّل مبدأ في كُلٍّ من: الفلسفة الماوراطبيعيّة، وفلسفة الأخلاق، وعلم القيم، وفي وحدة الأُمَّة، وأوَّل أساس في الجماليات.
خرج الكُرَّاس بالنَّتائج والتَّوصيات التالية:
أولًا- النَّتائج:
- جوهر الحضارة الإسلاميّة هو الإسلام، وجوهر الإسلام هو التَّوحيد، أي أنَّ الله هو الخالق الواحد المطلق المتعال، ربّ الكائنات جميعًا وسيّدها. هذان مبدآن إسلاميّان أساسيّان وواضحان غاية الوضوح.
- لم يتطرَّق الشَّك إلى المبدأيْن السَّابقيْن عند كُلّ مَنْ ينتمي إلى الحضارة الإسلاميّة أو ساهم فيها، ولم يتعرَّضا للتَّشكيك فيهما إلَّا عند المُنصِّرين أو المستشرقين وغيرهم في حملات عدائهم للإسلام.
- يشتمل التَّوحيد على عددٍ من المبادئ، وهي: الثُّنائيّة، والإدراكيّة، والغائيّة، وقُدْرة الإنسان وطواعية الطَّبيعة، المسؤولية والحساب.
- التَّوحيد بوصفه جوهر الحضارة، له جانبان أو بُعْدان، هما: (المنهج) و(المحتوى)، يُحدِّد الجانب الأوَّل أشكال تطبيق المبادئ الأولى وتوظيفها في الحضارة، ويشمل ثلاثة أُسس، هي: الوحدة والعقلانيّة والتَّسامح. وتُحدِّد هذه الأُسس شكل الحضارة الإسلاميّة، بينما يُحدِّد الجانب الثَّاني (المحتوى) المبادئ الأولى نفسها.
- المسلمون مهما يكن مستوى ثقافاتهم هم على ثقة مطلقة بأنَّ الحضارة الإسلاميّة تنطوي على جوهر، وأنَّ هذا الجوهر قابل للمعرفة والتَّحليل والوصف.
- ممَّا يشين أيّة حضارة جمعها عناصر أجنبيّة عنها بشكلٍ متنافر من دون إعادة تشكيل أو استيعاب لها. لكن إذا نجحت الحضارة في تحويل تلك العناصر الأجنبيّة وتمثُّلها في نظامها، فإنَّ عمليّة التَّمثُّل هذه تغدو دليلًا على حيويّتها وحركيّتها وإبداعها.
- التَّوحيد نقيض الخُرافة أو الأسطورة، وهما عدّوان للعلم الطَّبيعيّ والحضارة، فالتَّوحيد يجمع خيوط السَّببية كافّة، ويعيدها إلى الله تعالى لا إلى القوى الخفيّة، وكون قوانين الطَّبيعة هي أنساق الله التي لا تُجارى.
- إنسانيّة التَّوحيد وحدها هي الأصيلة الخالصة، فهي وحدها تحترم الإنسان بوصفه إنسانًا مخلوقًا، دون تأليه أو تحقير، وهي وحدها تُحدِّد قيمة الإنسان بما يُزيِّنه من فضائل، وتبدأ تقييمها بالإشارة الصَّريحة إلى الموهبة الفطرية التي أسبغها الله على النَّاس جميعًا استعدادًا لقيامهم بواجبهم النَّبيل.
- ضمانة توكيد العالم التي تكفل له إنتاج حضارة متوازنة دائمة قادرة على إصلاح ذاتها، هي الأخلاق، ومثل هذه الأخلاق لا يقدّمها سوى التَّوحيد من بين المذاهب الفكريّة المعروفة عند النَّاس.
- أُخوَّة الإسلام لا تعبأ باللَّون أو الهوية العِرْقيّة، وفي حدود هذه الرُّؤية يكون جميع النَّاس سواسية لا يفضل بعضهم على بعضٍ إلَّا بالتَّقوى.
- وضع الإسلام السّلام الإسلاميّ في دستور دائم على يد النَّبيّ الكريم e في المدينة المنوَّرة في الأيَّام الأولى للهجرة، ولا يعرف التَّاريخ أيّ دستور مدّون آخر كرَّم الأقلّيّات كما فعل دستور المدينة.
- مجْدُ الإسلام الفنّيّ والإبداعيّ والجماليّ الفريد أنَّه يخلو تمامًا من عبادة الأصنام وتجسيد الإله وتصويره وتمثيله، كما تميّز الفن الإسلامي بخلوّه من الخلط بين الخالق والمخلوق.
ثانيًا- التَّوصيات:
- ضرورة ضبط المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالتَّوحيد باعتباره جوهر الحضارة الإسلاميّة.
- ضرورة السّعي إلى تغيير الإنسان نفسه وأمثاله من البشر والمجتمع حوله بوصفه صاحب الفعل الأخلاقيّ؛ لكي يُحقِّق الأمر الإلهيّ، ويتماشى مع النّسق الإلهيّ.
- إعداد أوراق عمل بحثيّة تتناول رُؤى منهجيّة في التَّفاعل بين الحضارات.
- توجيه علماء وأساتذة العلوم الطَّبيعيّة والتَّجريبيّة أنْ يُقدِّموا علومًا نابعةً من إيمانهم ومنتميةً إلى دينهم وبيئتهم، وإبراز ما انتهى إليه علمهم جمعًا بين هداية الوحي والخبرة البشريّة.
- العمل على نشر الوعي بالقيم الأخلاقيّة، مثل: الأمانة، والإنسانيّة، والحُرِّيَّة، والتَّكليف، والمسؤولية، وغيرها، وربط ذلك بالتَّوحيد وتأثير ذلك الوعي في تحديد اتّجاهات البشريّة مستقبلًا.
6- إعادة صياغة الدّساتير ومواثيق حقوق الإنسان والقوانين لتستوعب حقوق وواجبات المواطنة والأقلّيّات المنصوص عليها في القرآن الكريم والسُّنَّة النَّبويّة الشَّريفة.
__________________
هوامش
* د. إسماعيل راجي الفاروقيّ، التَّوحيد جوهر الحضارة الإسلاميّة، (هرندن -فرجينيا (الولايات المتحدة): المعهد العالميّ للفكر الإسلاميّ، الطبعة الأولى، 1436هـ – 2015م). وهذا الكراس مستل من أطلس الحضارة الإسلامية: د. إسماعيل راجي الفاروقيّ، د. لويس لمياء الفاروقيّ، أطلس الحضارة الإسلامية، ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة، مراجعة: د. رياض نور الله، (هرندن -فرجينيا (الولايات المتحدة): المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الرياض: مكتبة العبيكان، 1419 هـ – 1998م)، وقد صدرت من هذا الأطلس طبعة ثانية مزيدة ومنقحة عام 2024.
** أستاذ مساعد في قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب – جامعة الخرطوم، وعضو مركز أجيال لبناء القيم والتعلم.
* هذا العرض لكتاب “التوحيد جوهر الحضارة الإسلامية” هو أحد تكليفات “مدرسة التأسيس في المنظور الحضاري” التي نظمها مركز الحضارة للدِّراسات والبحوث في الفترة سبتمبر – ديسمبر 2024.
[1] انظر: المحررون، مقدمة: من هو إسماعيل الفاروقي: تعريف موجز بالشهيد إسماعيل الفاروفي، (في)، د. فتحي حسن ملكاويّ ود. رائد جميل عكاشة ود. عبد الرَّحمن أبو صعيليك (تحرير)، إسماعيل الفاروقيّ وإسهاماته في الإصلاح الفكريّ الإسلاميّ المعاصر، (هرندن -فرجينيا: المعهد العالميّ للفكر الإسلاميّ، الأردن: دار الفتح للدِّراسات والنَّشر، 2014)، ص ص 11-17، وص ص25-27.
[2] مُحَمَّد هاشم كماليّ، الدَّليل المبسَّط في مقاصد الشَّريعة، ترجمة: عبد اللَّطيف الخياط، (لندن ـ واشنطن: المعهد العالميّ للفكر الإسلاميّ، الطبعة الأولى، 2011)، ص ص11-15.
[3] الصافات: ٢٤.
[4] د. طه العلواني، مفاهيم ومبادئ المنهجية الإسلامية “التوحيد ومبادئ المنهجية”، (في): د. عبد الحميد أبوسليمان وآخرون، المنهجية الإسلامية، (القاهرة: دار السلام بالتعاون مع المعهد العالميّ للفكر الإسلاميّ، الطبعة الأولى، 2010)، ص ص 259- 347.
[5] المرجع السابق، ص ص 397- 407.
[6] لمزيد من الاطلاع على أمثلة الفن الإسلامي في هذا السياق، راجع: جورج مارسييه، الفن الإسلامي، ترجمة: عبلة عبد الرزاق، مراجعة: عاطف عبد السلام، (القاهرة: المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى، 2016)، ص ص35-70.
[7] التَّوريق المتشابك أو الرّقش من أهم الزخارف الإسلامية المستخدمة في فن العمارة وباقي الفنون الإسلامية المختلفة، وقد تداخل مصطلح “التوريق” مع العديد من المصطلحات المميزة للزخارف الإسلامية مثل “الأرابيسك” و”التوشيح”. انظر: سامر سليمان، ما هو فن التوريق، موقع مجلة سيدتي، تاريخ النشر: 13 يناير 2022، تاريخ الاطلاع: 29 نوفمبر 2024، الساعة :22:35، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/zDOzcfDd
[8] التَّجريد في المصطلحات الفلسفيّة يعني عملية التَّفكير التي من خلالها تبتعد الأفكار عن الأشياء. ويستخدم التَّجريد إستراتيجيّة التَّبسيط، التي من خلالها تُترك التَّفاصيل التي كانت ماديّة سابقًا غامضة أو مبهمة أو غير معروفة؛ وبالتَّالي يتطلَّب الاتّصال الفعَّال حول الأشياء المجرَّدة تجربة بديهيّة أو مشتركة بين المتّصل ومتلقي الاتّصال. انظر: تجريد، موقع ويكبيديا الموسوعة الحرة: تاريخ آخر تعديل: 12 سبتمبر 2024، الساعة: 20:24، تاريخ الاطلاع: 29 نوفمبر 2024، الساعة 11:26، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/twPS3ZsE
[9] هذا كلام مجمل للمؤلِّف عن الفنون الإسلاميّة اقتضاه المقام، لكن له تناول تفصيليّ لهذه الفنون في كتابه: أطلس الحضارة الإسلاميّة الفصول من (20) إلى (23) التي تناولت: فنون الخطّ، والزّخرفة، وفنون المكان، وفنّ الصوت أو هندسته. فلتراجع هناك، ص ص 507-666.