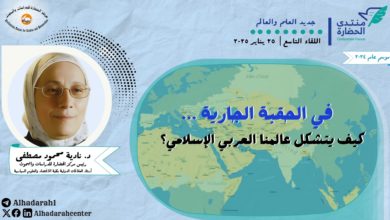تجديد النقاش في عالمنا العربي من الانتفاضات إلى الطوفان
اللقاء الأول من منتدى الحضارة لقضايا العلم والعالم

تقديم:
د. مدحت ماهر
هذا هو اللقاء الأول من المرحلة الثانية من منتدى الحضارة لقضايا العلم والعالم، والذي كان منقسمًا في العام الماضي إلى منتدى علمي، وملتقى قضايا عملية، وبعد تبين اتصال وتداخل المسارين بشكل كبير تقرر أن يتم ضمهما في مسار واحد؛ وهو منتدى الحضارة لجديد العلم والعالم. وعقد اللقاء يوم السبت الموافق 11 مايو 2024.
هذا المنتدى هدفه الأساسي متابعة “الجديد” في العالم؛ ولا نعنى بالعالم “الغرب” فقط كما اعتدنا خلال قرن فائت؛ فالعالـم يشمل الغرب وغيره، والمسلمون جزء منه. في هذا الإطار، نتابع في هذا المنتدى “الجديدَ”، ونحاول أن نعرف ماذا يَطرح من أسئلة؟ وماذا عندنا من أطروحات ومحاولات إجابة، أو حتى مساحات للنقاش حول هذا الجديد.
ويُقدم هذا اللقاء أ. هشام جعفر، وهو -في إطار الجماعة الفكرية المثقفة المصرية- أستاذ وخبير في شؤون السياسة والمجتمع والثقافة المصرية والعربية والإسلامية، وأيضا الإنسانية المعاصرة. يتميز أ. هشام -بعد أصول الانتماء الوطني والإسلامي والإنساني- بالالتزام بالمنهجية العلمية، والأمانة الشديدة في النقل، كذلك يتميز نمطه الثقافي والفكري بالاقتحامية و”الجديدية”؛ فدائمًا عنده الجديد؛ سواء في الأطروحات والأفكار أو الأسئلة، ويتميز بدرجة عالية من الشجاعة العلمية والأدبية والنقدية، والاستثارية للنقاش؛ فيحفز من أمامه دائما على التفكير والنقاش فيما يطرحه، كل ذلك مع أسلوب أدبي رائق وشائق في الكتابة والحديث، ودائما مرتبط بالواقع.
د. نادية مصطفى
بعد الترحيب بالحضور والضيف الكريم، أضافت الدكتورة نادية أن عنوان موضوع اليوم يفتح آفاقًا كبيرة للتفكير الواسع.. المتجدد .. متعدد المداخل، ويفتح طرقًا جديدة للتفكير في العالم، وأن طوفان الأقصى منذ بدايته يفرض نفسه على جميع القضايا العالمية التي احتلت الاهتمام من قبله كثيرا، وما زالت تحتل الاهتمام، ولكنه اختبرها بطريقة جديدة وبطريقة فعالة تعيد بناء المفاهيم بعد أن فككتها.
فالعالم مفتوح بعضه على بعض بفعل قنوات الاتصال والتواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الأمور، التي اقتربنا منها منذ أكثر من ثلاثين عاما تحت اسم العولمة والعالمية؛ سواء بوصفها أدوات أو أيدولوجيا أو أجندة قضايا أثَّرت على مفاهيم القوة وأدوات التواصل وأساليب الصراع وأدواته، بطريقة نستطيع أن نقول إنها قلبت موازين العلاقات الدولية، كما قلبت طرق التفكير في العلاقات الدولية على نحو غير مسبوق.
إلا أن طوفان الأقصى جاء ليختبر الكثير من المفاهيم والعمليات، ويدفع لإعادة النظر والتفكير في كثير من الأمور، ربما لا نشعر بهذا في نطاقنا العربي والمصري، ولكنه يحدث في العالم الخارجي. فرغم أن القضية قضيتنا، فإن الآخرين يتناولونها أكثر منا؛ إما بمشاركة المعتدي وتحفيزه على أهلنا في غزة وفلسطين، وإما برفض هذا العدوان الغاشم والإبادة الجماعية، وتقديم وافر التحية والتقدير للمقاومة في غزة وفي فلسطين كلها.
على أن تجديد التفكير في العالم على ضوء طوفان الأقصى وما أحدث من متغيرات وإعادة رسم خرائط، لا ينفصل عن التجديد في التفكير في منطقتنا العربية على ضوء خبرتها التاريخية وما تواجهه من تحديات في قلب العالم، وعبر عقد ونصف من الزمان وعلى ضوء ما تشهده الآن من أحداث جسام، وهو ما يحاول الباحث القيام به في هذا اللقاء.
كلمة أ. هشام جعفر
يتناول هذا اللقاء مراجعة للأفكار الأساسية في خمسة كتب خطها الباحث خلال السنوات الخمس الماضية؛ بعضها صدر بالفعل، وبعضها لم يصدر.
وفي ملاحظة مبدئية؛ تمنى المتحدث ألا يُؤخذ ما كتبه من منظور بحثي أكاديمي، وإنما من أجل تجديد النقاش والجدل العام في مصر وفي المنطقة العربية بشكل أساسي. ولا يعني هذا أنه لا يستند إلى نتائج بحوث، وإنما لأن أحد الأدوار التي يمكن للباحث أن يقوم بها هو أن يجدد النقاش العام في ظل سياقات إضعافه وتصحيره.
وتستند فكرة النقاش العام إلى إنتاج معرفة يمكن أن نطلق عليها معرفة تحرُّرِية، تدمِج بشكل أساسي احتياجات ومتطلبات الناس العادية، وليس ما تفرضه السلطة أو ما تتصوره وتدركه النخب العامة.
وتضمنت كلمة المتحدث أربعة محاور موضوعية؛كل محور يعبر عن مضمون أحد كتبه المشار إليها وهي كالتالي:
المحور الأول: سردية الربيع العربي ورهانات الواقع (2021)
تناول مقالات كُتبت في 2020، وخرجت في سياق الموجة الثانية من الربيع العربي ٢٠١٩، ثم سياق كورونا وما فرضه من أسئلة متعلقة بأدوار الدولة والرقابة فيها وعلاقتها باحتياجات الناس، وأولويات الإنفاق العام .. وسياق آخر وهو انكسار الموجة الأولى من الربيع العربي التي بدأت ٢٠١١/٢٠١٠.
تناول المحور الأسئلة التالية:
- هل لا تزال الثورة مستمرة؟ في هذا الجزء تناول عددا من الرسائل المهمة عن سردية/جوهر الربيع العربي وليس أزمات إدارة الفترة الانتقالية.
- ما هو النموذج الانتفاضي العربي؟
- ما الذي سيطر على الموجة الأولى من الربيع العربي من استقطابات إسلامية علمانية؟ وكيف نفكر فيها؟
- خاتمة المحور تحت عنوان: يا محتجي العالم اتحدّوا…[1]
أ)جوهر الربيع العربي:
يحاجج الباحث بأن جوهر الربيع العربي هو تطلُّع الشعوب نحو قيمتين أساسيتين: الحرية (الديمقراطية…) –العيش الكريم، وهي الديمقراطية بمعناها السياسي والاجتماعي.
ولتحقيقهما لا بد من مكون ثالث: (تحرير الإرادة الوطنية) من الهيمنة الإقليمية والدولية، لأننا كنا إزاء ثورة مضادة تقودها الأطراف الإقليمية؛ الأمر الذي انعكس على مسألة طوفان الأقصى وعلاقته باستعادة خطاب الاستقلال الوطني.[2]
واستند الباحث إلى تفاصيل واقعية بتتبع استطلاعات الرأي؛ حيث وجد أن هناك تطلع أساسي لهذين المكوّنين لدى الشعوب، فبرغم أزمات الربيع العربي، فإن قطاعًا معتبرًا من المواطنين العرب لا يزال مؤمنًا بهذا الجوهر.
ب) النموذج الانتفاضي العربي:
مقتبسًا من الأستاذ المسيري الذي استخلص (النموذج الانتفاضي) من الانتفاضة الفلسطينية الأولى 1987، وجد الباحث عددًا من المكونات الأساسية التي تتعلق بهذا النموذج:
1- (الإنسان/السر): الذي نفخ الله تعالى فيه من روحه ويظهر ذلك في:
أولا: عدم القدرة على التنبؤ بسلوكه وتصرفاته، وثانيا: تعقيد الدوافع والأسباب المحرّكة التي لا يمكن تفسيرها بشكل مادي فقط وفي نفس الوقت لا يمكن إغفال الجوانب المادية (مادية ومعنوية)، وثالثا: الاهتمام بخصوصية الإنسان بأبعاده الفريدة المركبة وبخصوصية السياق الذي يعيش فيه.
2- السمات الأساسية المرتبطة بواقعنا:
- تعقيد الواقع: فقد نجد فعلا صغير -أو نتصور أنه صغير- يُحدث تغييرا في مجمل النظام، كما حصل مع بوعزيزي في الانتفاضات العربية. ومثله أيضا في طوفان الأقصى الذي قد يؤدي إلى نقلات نوعية في النظم شديدة التعقيد والترابط والتماسك، ولارتباطه بسياقات متعددة فقد يؤدي إلى تغييرات يصبح من الصعب تخيلها أو حتى متابعتها.
- التناغم: أو ما نطلق عليه التناسق بين مكونات متعددة؛ حيث نجد نظريات كثيرة لتفسير الربيع العربي وغيره، لكن لا بد أن نكتشف كيف يحدث التناسق بين عوامل مختلفة ويحدث فيما بينها تراكم متعلق بالتاريخ فيُحدث تأثيرا مختلفا لا نتوقعه أو نتخيله.
وهو الأمر الذي حدث في الانتفاضات الأولى؛ حيث لم تكن هناك مؤشرات إلى احتمال قيام انتفاضات، حتى بعد انتفاضة تونس لم يكن من المتوقع انتقالها لدول أخرى، ومع الثورة المضادة توقعنا انتهاء الربيع العربي ثم اندلعت في 2019 موجة ثانية. وما يجري في فلسطين الآن يُسكَّن أيضًا في إطار موجات الربيع العربي المتعاقبة.
3- الانتقال بأيديولوجيا الهوية إلى خطابات وسياسات المعاش:
يرى الباحث أن من أهم سمات النموذج الانتفاضي العربي الانتقال بأيديولوجيا الهوية إلى خطابات وسياسات المعاش. فما يسيطر على المواطنين في المنطقة والعالم ليس أيديولوجيات الهوية، وإن كانت خطابات الهوية تُستغل أحيانا للتغطية على خطابات المعاش (التي ترتبط بأسئلة الناس الصغرى من أجل العيش الكريم). في حين أن خطابات المعاش تستعيد معنى الكرامة والعدالة والوطن والحرية ممتزجًا بالحاجات الأساسية من خبز ومأوى وصحة دون أن ينفصل عنها.
فعلينا أن ندرك مساحات الارتباط بين القيم المحركة للناس وكذلك مستويات معيشتهم، فلا نتصور تحقق الكرامة مع زيادة نسبة الفقر، أو العدالة مع سوء توزيع الدخل والفرص والموارد في المجتمع.
والمطلوب الآن -في تقدير المحاضر- ليس الحديث في المرجعيات الفكرية والأطر السياسية العامة وإنما تقديم سياسات عامة وبرامج تفصيلية من شأنها أن تعالج مشاكل الناس الواقعية وتجيب عن أسئلتهم الصغرى. فالسياسة الآن باتت تدور حول معاش الناس وجوهرها انتقال الخاص إلى العام، وتأثير العام في الشخصي.
4- مراجعة مفهوم السياسة:
يرى الباحث أن الأزمة في المنطقة أزمة سياسية، ليس بالمعنى المباشر الذي يتعلق بالسلطة السياسية فقط وإنما الاستبداد بمعناه الشامل، الذي يتبدى في جميع مظاهر حياتنا.
والسؤال لنا كجماعة بحثية: هل ما ننتجه من المعرفة يخدم التحرر من الاستبداد أم يكرّسه؟
5-الحرية والاحتفاء بالتعددية:
الحرية اسم جامع لظواهر وقيم كثيرة؛ حيث نكون بصدد غياب للمركز أو السلطة بمعناها الواسع والمطلق، ويعني هذا انقضاء فكرة الخطاب السديد والقول النهائي والتحول لفكرة القول المناسب أو الملائم في ظل ظرف زمني ومكاني ومجتمعي معين. والمقصود هنا ليس مساحات المطلق الديني، وإنما ما نقدمه من تفسيرات وتأويلات منسوبة إلينا، وهي متغيرة ومتحولة إلى حد كبير. يرتبط ذلك بإعلاء النزعة الشبكية التي تفترض التنوع والتعدد.
6- حضور النساء الطاغي:
بمقدار ما يتحرر المجال الاجتماعي الحاضر فيه النساء بمقدار ما سيكون لهن تأثير على تفكيك بنى الاستبداد، فحضور النساء يعيد تشكيل قضاياهن على أرضية وطنية، كما شهدنا في موجتي الربيع الأولى والثانية.
خلاصة الأمر أن حضور النساء الطاغي في النموذج الانتفاضي أدى إلى أن قضايا المرأة يتم إدراكها على أرضية وطنية، كما تصبح قضايا المرأة سبيلا لتفجير القضايا الوطنية التي تهم عموم المواطنين.
ج) الاستقطاب الإسلامي-العلماني
سيطر الحديث عنه على مدار القرنين الماضيين، والحقيقة أننا بحاجة للتفكير في هذه الثنائية وفي الثنائيات التي حكمت القرن العشرين كله، باعتبارها على المستوي الواقعي مساحات للتداخل يحدث بينها امتزاج وليست مساحات متعارضة. والأمثلة على هذا الامتزاج كثيرة؛ ففي فترة كورونا –على سبيل المثال- تدخلت الحكومات في إدارة الاقتصاد وصرف معونات، فهل عبر ذلك عن نظام رعاية اجتماعية أم نظام اشتراكي؟ كذلك التداخل بين رجال الأعمال الغربيين والصين، وما تطرحه العقلية الأمريكية الآن من إدارة التنافس مع الصين وليس الصراع. وغيرها من أمثلة تدل على أن الثنائيات الجامدة التي كانت مسيطرة من قبل أصبحت غير موجودة في الواقع.
وعند مناقشة فكرتيْ الإسلامية والعلمانية نحتاج لتفكيك هذا الاستقطاب، لأن الواقع على غير ذلك؛ حيث نجد تداخلا بين الإسلامية والعلمانية في مجالات الحياة المختلفة وهياكل الدولة والمجتمع والتشريعات والمؤسسات وغيرها. في حين أننا نجد أن الاستقطابات التي اشتعلت بقوة في الربع الأخير من القرن العشرين وبرزت في الانتفاضات العربية تغطي على استقطابات أهم متعلقة بجوهر الربيع العربي: الفكرة الديمقراطية بجناحيها السياسي والاجتماعي؛ حيث غلب الصراع حول السياسة بمعنى ثقافي وليس السياسة بمعنى التأثير على مجمل الواقع، نتيجة ضعف هياكل السياسة وفي بناها الأساسية فلا يتحول هذا الجدل لتأثير على السياسة الواقعية.
يرتبط ذلك بمشكل تاريخي وتنظيمي يتعلق بالمسألة الديمقراطية بجناحيها السياسي والاجتماعي، والتي لا يمكن تحقيقها إلا في إطار تحرير الإرداة الوطنية من هيمنة الإقليمي والدولي، وهنا يصبح السؤال: كيف يمكن بناء تيار ديمقراطي وطني متسع من مرجعيات فكرية متعددة؟
أوضح المحاضر كذلك أهمية ما يمكن أن نطلق عليه إعادة الفرز والتصنيف، فنحن لسنا بصدد صناديق مغلقة إسلامية أو علمانية، وإنما نجد في كل طرف مجموعات تقدمية أو تحررية تحافظ على التوزيع العادل للموارد ومجموعات أخرى تدعم الاستبداد والتسلط والسياسات النيوليبرالية في المجتمع.
د) يا محتجّي العالم اتحدّوا 2020:
الفكرة الأساسية التي يريد الباحث التأكيد عليها في هذا الجزء هي أن المعضلات الأساسية التي يواجهها البشر الآن هي معضلة واحدة وتأخذ مظاهر متعددة. وعلى الرغم أننا متأخرون في إدراك هذا فحركات الاجتجاج العالمي تدركه بعمق.
فالأفكار التقاطعية التي تؤمن بها الحركات الاحتجاجية، وتعريفها للعدالة والسلطة والقوة وإدراكها المتسع غير المتمحور حول السلطة السياسية فقط؛ سمحت لها بخلق أرضيات مشتركة، أو ما يطلق عليه البعض “تأثير تشاركي” Collective impact، وهو ما ظهر في احتجاجات طوفان الأقصى.
كيف خلقوا هذه الأرضية؟ من خلال قدرات تحليلية ومدارس علمية بذلت جهدا بحثيا واقعيا وأنتجت أفكارًا تخلق هذه الأرضيات المشتركة. علي سبيل المثال؛ حدث شكل من أشكال التقاطع في coup 27 في شرم الشيخ، بين حركات حقوق الإنسان والعدالة المناخية، إدراكا منها أنه لا يمكن أن نتحدث عن عدالة مناخية دون مراعاة حقوق الإنسان.
ومن ثم، يؤكد المحاضر أن علينا أن ندرك الأرضيات المشتركة، فنزع الإنسانية الحاصل للمعارضين في سجون الدول المستبدة نفسه يحصل مع السود والسكان الأصليين.. ما استدعى احتجاجا عولميا بمشاركة أطراف متعددة.
المحور الثاني: لمن السياسة اليوم؟
تناول المحاضر في هذا المحور أفكارًا أساسية أهمها:
إعادة تعريف السياسة، وكيف يمكن إحياء السياسة بأشكال وخصائص جديدة، وما العوامل التي تساعد على الاستبداد بها؛ أو ما يطلق عليه المستشار البشري “تأسيس علم الاستبداد”؛ لما لذلك من أهمية في تعريف الاستقلال الوطني.
أ) إعادة تعريف السياسة:
يرى الباحث أنه في حين أننا نشهد إعادة تعريف للسياسة من مداخل جديدة من حيث خصائصها وفواعلها وخطاباتها وأولوياتها، فهذا لا يعني سد الفجوة بين التصورات والفعل، إذ تظل القدرة على ترجمة هذه التصورات الجديدة إلى فعل سياسي محدودة؛ لاعتبارات تخص منهج النظر للسياسة، بالإضافة إلى مواريثنا المتعلقة بالبنى والهياكل والأشخاص.
ويناقش كيف يجري استعادة السياسة الآن في ما يطلق عليه “فجوات الخطاب الرسمي وفجوات المصالح” التي تنشأ؛ حيث نشهد تحلل هياكل الدولة إلى شبكات مصالح. ويحاجج بأن فكرة التماسك التي نتصورها عن هياكل الدولة أو حتى في المؤسسات والأحزاب تحتاج لإعادة نظر، فالحقيقة أن الهياكل المختلفة تتراوح بين التجزئة والوحدة.
في هذا الإطار، يرى الباحث أن السياق الأوسع لإعادة تعريف السياسة سياق نيوليبرالي يعيد صياغة أدوار الدولة، ووظائفها والمساحات التي يجب أن تملأها أو تنسحب منها، ما يعني إعادة انفتاح مؤسسات الدولة على الربح والاستهلاك والريع والرأسمالية الدولية خاصة الخليجية منها، مع انتفاء مقاومة بيروقراطية الدولة للترتيبات النيوليبرالية.
ب) يشير الباحث كذلك في هذا المحور إلى مظاهر اختراع السياسة بعد انتزاعها وتظهر جلية في خمس خصائص:–
- تشرذم الاستقطابات: فقد نؤيد اتجاها في قضية أو موقف معين ونصبح ضده في موقف آخر؛ على سبيل المثال المسلمين في الغرب يؤيدون المحافظين أحيانا بسبب حظر التعليم الجنسي في المدارس ويخالفونهم أحيانا أخرى بسبب مواقفهم من القضية الفلسطينية.
- تقديم مدخل القضايا على الأيديولوجيات الكبرى الشاملة، فمنذ أواخر العقد الماضي بدأ العالم يتوزع حول مجموعة من القضايا: حقوق الإنسان، الجندر، البيئة وغيرها؛ مقابل تهميش الأيديولوجيا التي تتضمن منطقا شاملا يجيب عن أسئلة الوجود الكبرى مثل علاقة الإنسان بالكون والحياة.
- كل القضايا أصبحت مطروحه للنقاش، بخلاف ما كان سائدا من قبل من وجود موضوعات غير قابلة للتفاوض والمساومة والجدل.
- خلق معيارية جديدة: وسائل التواصل الاجتماعي لا تؤدي فقط لاستعادة الجدل العام الذي صادرته السلطة، ولكن أيضا يجري خلق معايير جديدة يتم من خلالها تقييم المواقف والسلوكيات والسياسات والإجراءات وتقديم سرديات أخرى تتحدى الروايات السائدة أو المهيمنة، ويجري فيها القضاء على المركز والمرجعيات والرموز؛ حيث لا قداسة لأحد وإنما المعيار هو القناعة والقبول والنفع والعملية. في طوفان الأقصى -علي سبيل المثال- نرى كيف تم تحدي السردية الإسرائيلة المهيمنة منذ سنوات طويلة من خلال تقديم سرديات بديلة.
5- من السياسة إلى السياسات: نشهد تحولا من السياسة باعتبارها عملية مؤسسية تضطلع بها نخبة محدودة عادة (الرئيس/الحاكم ومجموعة ضيقة حوله) إلى عمليات سياسية متعددة يقوم بها أصحاب مصلحة، لذا يصبح من المهم في السياسة رسم الخرائط التفصيلة لأصحاب المصلحة في كل قضية، لندرك المصالح المتباينة والأرضيات المشتركة. فمن المهم مراجعة السياسة من مدخل السياسات العامة؛ حيث يصبح المطلوب من الفعل السياسي التأثير على السياسات العامة بما تتضمنه من أولويات الإنفاق العام حتى لا تكون دولةً بين مجموعة ضيقة من أفراد المصالح.
خلاصة الأمر أن المعايير المرجعية للسياسة الآن لم تعد أيديولوجية، بل يومية حياتية، ولم تعد ثابتة غير قابلة للتغيير، ويختفي معها الإجماع المهيمن أو الرواية السائدة؛ وعليه فإن الباحث يرى أن ما يستحق المتابعة هو كيفية إعادة صياغة وتشكيل الإطار المعياري للسياسة بين نموذجين: الاختلاف والتمرد من جهة والضبط والتحكم من جهة أخرى؛ حيث توجد مؤسسات تسعى للضبط والتحكم، لا تقتصر على السلطة السياسية فقط، ولكن تمتد إلى مؤسسات مجتمعية مثل الأسرة، المدرسة، المؤسسات الدينية، الأطراف المهيمنة في الاقتصاد…
المحور الثالث: الصراع على روح الإسلام في المنطقة
يتناول عددًا من القضايا المهمة:
أ) ما هي روح الإسلام؟
بالرجوع للنموذج الانتفاضي، وجد الباحث أن هناك صراع حول النفوذ والهيمنة على من يمثل الإسلام المعتدل في المنطقة والعالم، إلا أن جوهر الإسلام كما تقدمه الأطراف المختلفة واحد فهو: نيوليبرالي- غير ديمقراطي- متسامح مع الخارج/ التطبيع -إقصائي في الداخل- ويمزج القوة الصلبة بالقوة الناعمة وهذا بالنسبة للسنة والشيعة، كما يظهر في اليمن وليبيا وسوريا ومن قبل العراق والآن السودان من قبل الأطراف التي تدَّعي تمثيلا للإسلام.
ب) معركة القرن الـ21: تحرير الإسلام من الدولة، على مدار القرن العشرين كانت هناك محاولة من الإسلاميين للانتقال بالإسلامية إلى الدولة أو السلطة، في حين أن ما ينادي به الباحث هو تحرير المجال الديني من هيمنة الدولة؛ لذا فقد عنون خاتمة كتابه: “نحو مجال إسلامي تعددي حر ومستقل”، ناقش فيه كيف ندير التعددية التي هي جوهر الفكرة الحضارية الإسلامية الممتدة على مدار قرون، وأكد أنه في واقعنا المعاصر لا يمكن التحكم أو السيطرة على المجال الديني، لتعدد أنماط التدين وأشكالها؛ لذا يصبح السؤال هو: كيف ندير هذه التعددية؟ وقدم الباحث في كتابه قواعد تحتاج إلى حوار مطول تقوده مؤسسة الأزهر بما يضمن عدم توظيف الديني في الصراعات السياسية والتحزب السياسي.
ج) إخفاق الإسلاميين ونهاية سردية الإسلام السياسي: يشير الباحث في هذا الإطار إلى ما شهده عام 2019 من احتجاج ضد الإسلاميين في السلطة، وكذلك داخل الحراك الشبابي، في بعض الدول العربية مثل العراق– لبنان- السودان- والجزائر بسبب ما مارسوه من استبداد.
لذا، دعا الباحث إلى التحرر من فكرة “الاستثناء الإسلامي”، لأن فكرة الاستثناء التي حكمت النظر إليهم لها تأثيرات غير إيجابية خصوصا في الغرب؛ حيث يوجد شكل من أشكال التواطؤ على فكرة الاستثناء الإسلامي لتحويلها لظاهرة أمنية وسياسية وربطها بالإرهاب.
وبالتالي فإننا نحتاج إلى التفكير في بدائل [للتمثيل التقليدي أو المعتاد] للإسلاميين، كوننا في إزاء ظاهرة تدين جديد في أوساط الشباب له خصائص مختلفة عما كان مطروحا من قبل.
ويشير الباحث في هذا الإطار إلى أن التركيز على الإسلاميين جعلنا نغفل ظواهر أخرى، مثل: كيف يعيش المسلم إسلامه في الزمن المعاصر (الفرد والأسرة والمجتمع وهياكل الدولة والمؤسسات)، وأن نلاحظ استجابات ودروسا مهمة في هذا الصدد.
د) العلاقة بين المجال الديني ودعم الاستبداد: يظهر ذلك في استخدام الجدل الديني للتغطية على أزمة السياسة، من خلال إثارة الجدل الديني حول الثوابت ومن ثم إحداث “تسييل” في السياسة.
مثال هذا التسييل نراه جليا في واقعنا الآن على ضوء طوفان الأقصى؛ حيث شهدنا إعادة تعريف/تسييل من هو العدو؟ فحينما نشهد هجوما على ثوابت دينية، يكون هدفه الأساسي إعادة صياغة المنطقة سياسيًا؛ مثلا فكرة أن “الاقتصاد يجب أن يقود” هدفها الأساسي “شرق أوسط جديد” لا يرفض التطبييع مع إسرائيل بعيدا عن الأيديولوجيا.
المحور الرابع: هل نحن عاجزون حقا؟ من الانتفاضات حتى طوفان الأقصى
وناقش فيه الباحث كيفية استعادة خطاب الاستقلال الوطني ولكن بمعنى جديد؛ ليس في جوهره، ولكن في حقيقة الأطراف الخارجية التي تسلبنا إياه؛ حيث أصبح هناك تشابك بينها على مستوى هياكل الدولة والمستوى الإقليمي. ومن ثم فالتساؤل: ما موقعه من النيوليبرالية أو الرأسمالية المعولمة ومصالح أطراف أخرى في المنطقة؟
وبالتالي من المهم تفكيك ورسم خرائط الاستقلال الوطني في تطوراته الجديدة، بما يجعلنا منفتحين على القوى المحتجة المناهضة للسياسات المضادة للاستقلال، سواء في الغرب أو دول الجنوب؛ مع التحفظ على وصف “الجنوب” لأن المفهوم لم يعد صالحا لوصف سلوك كل الدول التي كانت تنتمي إليه تاريخيا.
وختاما أشار المتحدث إلى أن ما يجب أن نهتم به في المستقبل هم الأجيال الشابة (جيلz وما تلاه)، لما سيكون لهم من تأثير كبير في المستقبل؛ سواء على المستوى العالمي أو في المنطقة، كما أننا لا نملك كباحثين الخرائط الكافية لمعرفة كيف يفكر، وكيف يتفاعل، وكيف يعيد رسم السياسة ويتفاعل معها؛ وهو الأمر الذي يحتاج لجهد بحثي جماعي.
هوامش
[1] تقاطع هذا العنوان مع آخر مقال نشره الباحث عن الاحتجاجات الطلابية في الغرب، حاول فيه استخلاص (9) ملامح للنموذج الانتفاضي الذي تقدّمه احتجاجات الطلاب، والذي يشبه إلى حد كبير نمط ميدان التحرير، وكثير من خصائص الانتفاضات العربية بموجاتها المتعاقبة، المقال بعنوان الاحتجاجات الطلابية.. بعْث روح ميدان التحرير، الجزيرة نت، 9 مايو 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/HXeMA6WU
[2] كتب عنه الباحث مقالتين تحاولان استعادة المفهوم مع قدر من التجديد:
– غزة واستعادة خطاب الاستقلال الوطني، الجزيرة نت، 16 أبريل 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/6B6V5DFP
– مصر بعد الحرب على غزة: من عقيدة الأمن القومي إلى خطاب الاستقلال الوطني، مصر 360، 16أبريل 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/Ph370ONa
إعداد تقرير اللقاء : الزهراء نادي