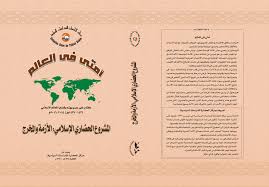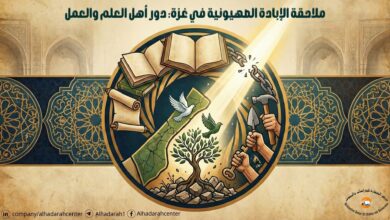القيم من عدسة التعليم العالي: التسليع وأثره على الأستاذ الجامعي المعاصر
منتدى الحضارة 2 - اللقاء الخامس
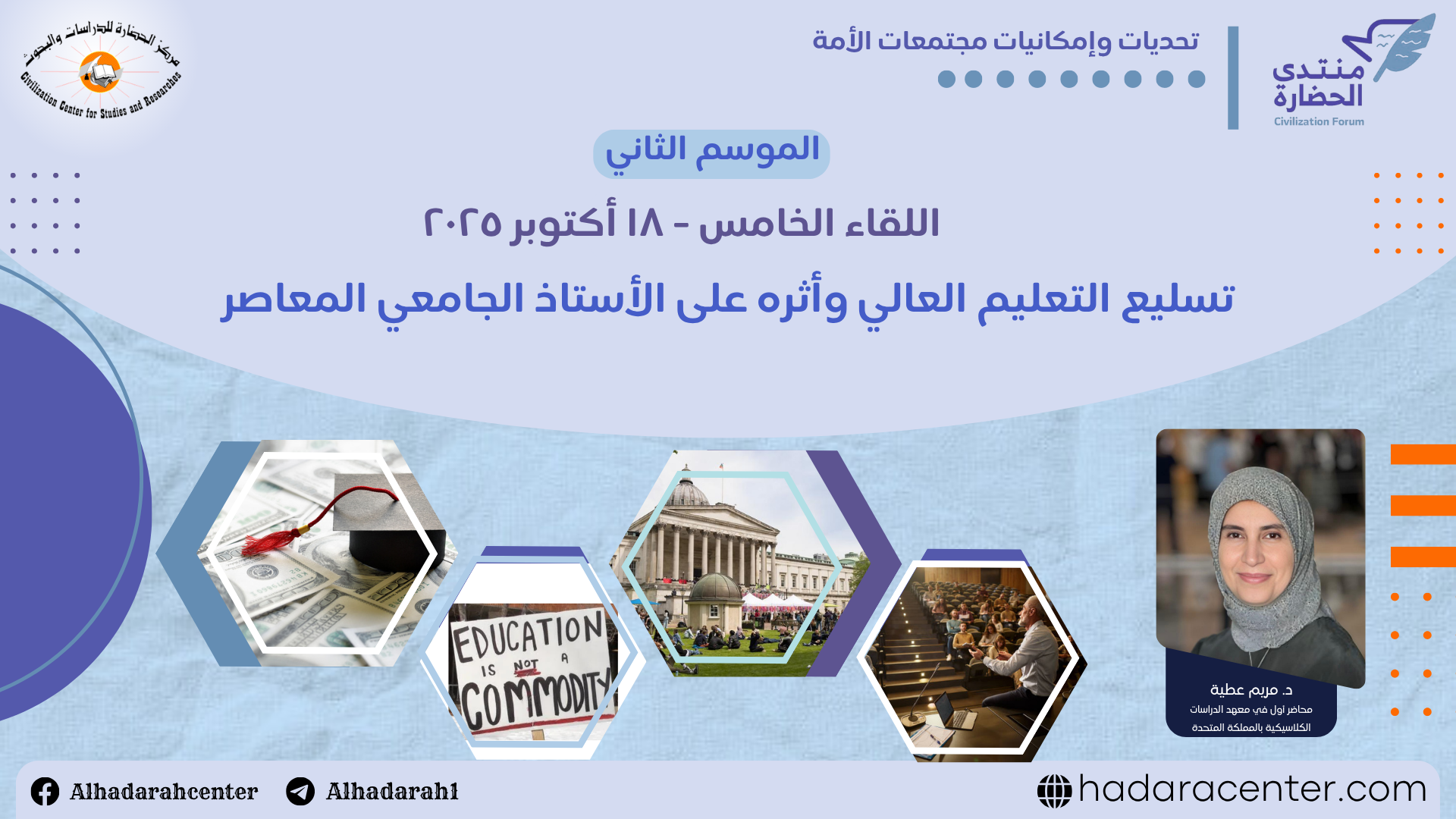
تقديم د. مدحت ماهر:
هذا هو اللقاء الخامس من الموسم الثاني لمنتدى الحضارة، والذي يتناول أحوال المجتمعات الإسلامية عبر العالم. وقد سبقته لقاءات أخرى تناولت أوضاع المجتمعات المسلمة في اليابان، وإندونيسيا وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية. وقد عرضت هذه اللقاءات للأوضاع والتحديات المختلفة التي تواجه المجتمعات المسلمة، سواء كانت أغلبيات أو أقليات، واستعرضت الفرص المتاحة وكيفية الاستجابة لها. اليوم، ننتقل للحديث عن أوروبا، ولكن من منظور إنساني وعالمي، ومن رؤية إنسان مسلم يعتز بإسلامه ليس فقط كعقيدة وقيم ولكن بوصفه مرجعًا معرفيًّا. فيعرض قضية مهمَّة تتعلَّق بالقيم من عدسة التعليم العالي، خاصة الخبرة الأوروبية والغربية التي لا تزال تقود مسيرة التعليم العالي في العالم. وعنوان هذا اللقاء هو “تسليع التعليم العالي وأثره على الأستاذ الجامعي المعاصر”.
نستضيف الدكتورة مريم عطية[1]، المحاضر الأول في معهد الدراسات الكلاسيكية بالمملكة المتحدة. وتتميَّز الدكتورة مريم بمسار مهني مهم يشمل تطوير كفاءات أعضاء هيئة التدريس، وقيادة البرامج الدراسية، وتصميم المناهج التعليمية، والإشراف الأكاديمي على طلاب الماجستير والدكتوراه. وهي حاصلة على الزمالة العليا من أكاديمية التعليم العالي البريطانية، وشاركت في العديد من المشاريع البحثية والتدريبية الدولية في عدَّة دول من بينها مصر واليابان وغانا ونيجيريا.
تدور اهتماماتها البحثية حول التعليم العالي مع تركيز خاص على أثر النظريات التربوية الكلاسيكية في تطوير السياقات التعليمية المعاصرة، وكذلك التعليم العالي في ظل ظروف الاحتلال، وهو موضوع ذو أهمية كبيرة.
تقديم د. نادية مصطفى:
أعتبر هذا اللقاء ذا أهمية خاصة لي لأسباب عدَّة، أهمها المحاضر والموضوع. فموضوع التعليم العالي يمثل تحديًا حضاريًّا كبيرًا يقع في قلب التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها المسلمون في العالم، سواء في دولهم أو خارجها، وتحت أي ظروف. فهو موضوع يجسد أبعاد الهوية والدين والثقافة، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإنسان وقيمه ومنظوماته التي تحكم سلوكه كطالب أو أستاذ جامعي في سياقات زمنية ومكانية وحضارية وسياسية محدَّدة.
إن هذا المجال كان دائمًا موضع اهتمامنا، حتى وإن كنا أساتذة علوم سياسية، لأننا ننطلق من رؤية حضارية شاملة تتجاوز النظرة الضيقة للصراع السياسي. فاقترابنا من هذا المجال وما يتَّصل به من قضايا مثل التربية، والتربية المدنية، والخطاب الديني، والخصوصيات الثقافية، امتدَّ عبر مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (2002 – 2014). وكان دائمًا الجدال بين المنطلقات المادية، والمنطلقات القيمية الغائية، بينما كانت محاولتنا هي الالتزام برؤية حضارية نقدية واسعة.
والآن نحن أمام خبرة مختلفة تمثلها الدكتورة مريم عطية، بخصائصها العلمية والأكاديمية، مكمِّلَةً وداعمةً لهذا النهج. وهي إنسانة مسلمة مجتهدة في سياق غربي برؤية حضارية إسلامية إنسانية، تمثِّل نموذجًا مهمًّا للدخول إلى المجتمعات الغربية بقوة ناعمة تسهم في مجال التجدُّد الحضاري. وأنا أراها نموذجًا للمسلمة العالمة التي تواجه التحديات وتسعى لمقابلتها دون أن تستوعب في الإطار المحيط، بل تجتهد لتقديم سبيل لها ولغيرها، سواء في المجتمعات الأكاديمية الغربية أو خارجها، لجعل العالم أكثر عدالة وحرية وإنسانية.
محاضرة د. مريم عطية: “تسليع التعليم العالي وأثره على الأستاذ الجامعي المعاصر”
محاور المحاضرة:
- ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ وﺗﺘﺒﻊ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ واﻧﺘﺸﺎرها
- رﺻﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺗﺄﺛﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ دوﻟيًّا
- ﺗﺘﺒُّﻊ أﺛﺮ اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻋلى اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ (اﻟﻤﺴﻠﻢ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ)
- ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﺮح ﻗﻴﻤﻲ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﻖ اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪِّي للتحديات اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ التي تواجه الأستاذ الجامعي
في البداية تنطلق المحاضرة من فرضية وتساؤل، أمَّا الفرضية فهي أن “ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺒﺤﻮث واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻜﺮي ﻣﻌﻴﻦ” وأمَّا التساؤل: “فما هو اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺬي ﻳُﻮﺟِّﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻴﻮم؟
أولًا- تعريف النيوليبرالية:
تشير النيوليبرالية إلى نظرية في الممارسات السياسية والاقتصادية تؤمن بأن رفاهية الإنسان يمكن تعزيزها بإطلاق الحريات والمهارات الريادية الفردية ضمن إطار مؤسسي يتميز بقوة حقوق الملكية الخاصة والأسواق والتجارة الحرة. هذا التعريف، الذي أورده هارفي، يتَّسق مع وصف رينيه جينو للحضارة الحديثة بأنها حضارة كمية عام 1927، حيث يتركَّز الاهتمام على الجانب الاقتصادي والمادي. ومصطلح النيوليبرالية قد استخدم بمعناه السلبي من قبل النقاد اليساريين (إذ دﺧﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎضي ﻓﻲ إﺷﺎرة إلى اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻤﺎرجرﻳﺖ ﺗﺎﺗﺸﺮ وروﻧﺎﻟﺪ ريجان)، في حين يفضِّل مؤيِّدوها تسميات أخرى مثل الاقتصاد الحر.
تهدف النيوليبرالية إلى تشكيل فرد ريادي (Entrepreneurship) قادر على اتِّخاذ قرارات مستقلَّة ومحسوبة وخاضع للمساءلة. وتستخدم استراتيجيات مثل الخصخصة وتصدير المنتجات والبرامج والخدمات التعليمية لتوليد الدخل، ما يحول التعليم العالي إلى سلعة تُباع وتُشترى. وتتبنَّى الأطر التنفيذية في التعليم العالي منطق السوق، حيث يؤمن مؤيدو النيوليبرالية بأن المنطق الاقتصادي يجب أن يسود جميع مجالات المجتمع، بما في ذلك التعليم. ويُعتقد أن التركيز على المعايير والمنافسة والإدارة يرفع الجودة. ومن الأمثلة البارزة على تبني هذه الأيديولوجية دول مجلس التعاون الخليجي، التي استثمرت بشكل كبير في إصلاحات تعليمية قائمة على مبادئ النيوليبرالية، ما أثر بشكل كبير على الأطر التعليمية التقليدية فيها[2].
ثانيًا- أثر النيوليبرالية على الأستاذ الجامعي (دوليًّا)
أصبحت النيوليبرالية الأيديولوجية الأخطر وفقًا لهنري جيرو، تهدِّد التعليم كمنفعةٍ عامةٍ وتقوِّض غايتَه الأساسية. وتصف أماندا برو بيئة التعليم العالي الحالية بالتغير السريع والتحديات المتزايدة، ما ينعكس في المساءلة الصارمة، وتزايد أعباء العمل، والمنافسة المستمرة، وتدويل التعليم العالي، والتوجه الواضح نحو تسليعه. وقد أدَّت هذه التأثيرات إلى تعزيز ثقافات أكاديمية قائمة على “الأدائية” أو “الإنجازية “(Performativity)، والتي تركِّز على الأداء الظاهري كمقياس للكفاءة والجدارة، ما يؤدِّي إلى بيئات تعليمية تتَّسم بالضغط العالي والثقة المتدنِّية (High stress, Low trust educational environments) كما يشير ستيفن بال.
وتصف إدواردز الجامعات بأنها أصبحت أشبه بالأسواق التجارية، حيث استبدلت المصلحة العامة والقيم الجماعية بحوافز فردية ومقاييس تنافسية وأهداف كمية. وقد أدَّى تسليع التعليم العالي إلى تآكل تدريجي في الجوانب الروحية والأخلاقية والاجتماعية للعملية التعليمية. فالطلاب يُنظر إليهم كزبائن، والأكاديميون كمقدِّمي خدمات، ما يحوِّل العلاقة إلى مجرد مقايضة تجارية، وهذا يتنافى مع القيمة العُليا للعلم والتعلُّم. كما تضرَّرت علاقات الزملاء الأكاديمية بسبب التنافسية المتزايدة على ترتيب الجماعات والحصول على المنح البحثية والتمويلية، ما يؤدِّي إلى حالة من عدم الأمان الوجودي وفقدان للمعنى والإدراك لما هو مهم في العمل الأكاديمي.
ومع زيادة التسليع والخصخصة والمنافسة، أصبحت السياسات المؤسساتية ذات الطابع التجاري تهدد هوية الجامعات التقليدية، التي كانت أدوارها تاريخيًّا مرتبطة بأهداف غير ربحية مثل تعزيز التعليم كمنفعة عامة وترسيخ القيم المجتمعية والعدالة الاجتماعية. وفقًا لدراسة قام بها أستاذ جامعي سعودي، أوضحت آثار النيوليبرالية على التعليم العالي السعودي والأستاذ الجامعي هناك، الذي كان له دور مجتمعي تاريخي واضح، ولكنه الآن يعاني من الارتباك.
ثالثًا- النيوليبرالية والحداثة وتأثيرهما على الأستاذ الجامعي.. فهم الصورة الأوسع
إن النيوليبرالية هي امتداد للحداثة، وتستدعي مفهوم “التشيؤ” الذي تحدث عنه عبد الوهاب المسيري، حيث يصبح كل شيء سلعة تُباع وتُشترى، ومنها العلم. وقد تحدث المسيري عن “المادية الصلبة” و”المادية السائلة(Post-modernism) “ التي تؤدِّي إلى التشكُّك والتجزئة، حيث يصبح الإنسان “غاية بلا غاية”، فهو غاية في حدِّ ذاته، وليس له غاية أخرى. وهذا يفسِّر حالة “عدم الأمان الوجودي” التي يمرُّ بها الأستاذ الجامعي، كما ذكر ستيفن بال. وفهم الصورة الأوسع للعلاقة بين النيوليبرالية والحداثة وما بعد الحداثة يساعد على فهم تحديات أخرى مثل العلمانية، السيولة الجنسية، الإسلاموفوبيا، العنصرية، والصهيونية، وتأثيرها على الأستاذ الجامعي.
إذن، تؤثِّر النيوليبرالية وأخواتها على الأستاذ الجامعي، فتجعله يتساءل عن علاقته بربِّه وقيمه ومرجعيته، وعن ثقته بنفسه ودوره، وعن علاقته بمحيطه. هل الهدف من وجوده في الجامعة هو جلب المزيد من الطلاب والأموال، أم خدمة المجتمع وإعداد أجيال جديدة؟ هذه العلاقات المتداخلة تتأثَّر بشكل كبير باللحظة التاريخية التي نمرُّ بها.
رابعًا- مقاومة التحديات وتقديم طرح قيمي من التراث الإسلامي
إن هذه التحديات السابقة ليست بلا مقاومة. فالأستاذ رياض شاهجهان، الأستاذ المسلم من أصل بنجلاديشي، يدعو إلى تعزيز الجانب الإنساني وتنمية الاكتفاء الذاتي النفسي والروحي ورعاية الروابط الإنسانية، وتجاهل الإلحاح المستمر على الإنجاز المتزايد، وفصل القيمة الذاتية للمعلم عن مقاييس الأداء النيوليبرالية.
كما يرى هنري جيرو أن المثقفين الذي يعملون في الجامعات يجب أن يمثِّلوا ضمير المجتمع، فهم يشكِّلون الظروف التي تتعلَّم من خلالها الأجيال القادمة، ويمارسون أنشطة تربوية أخلاقية وسياسية وليست مجرد تقنيات محايدة. وتؤكِّد أماندا برو على دور البحوث العلمية في نشر الوعي بمخاطر النيوليبرالية، إذ تُعَدُّ الكتابات الأكاديمية -من وجهة نظرها- إحدى الوسائل لمواجهة حالات عدم اليقين والاضطراب الناتجة عن العمل داخل بيئات أكاديمية ذات طابع تجاري شديد، حيث يمكن أن تُتيح هذه الكتابات فضاءات لانتقاد الأعراف والممارسات الراسخة.
بالإضافة إلى ذلك، توجد أهمية خاصة لوحدات التطوير الأكاديمي في الجامعات، حيث يجب ألا يقتصر دورها على الجوانب التقنية للتدريس، بل يجب أن تتيح الفرصة للأساتذة والباحثين لطرح تساؤلات نقدية حول الجوانب المقلقة في السياقات الأكاديمية المعاصرة وتعزيز قدراتهم على التفكير النقدي بشأن سبل تغيير هذه السياقات. فهذه الوحدات يجب أن تكون مساحة للمقاومة ومنصة للتفاعل مع الفضائل الأكاديمية الجوهرية (المساهمة في تطوير المجتمعات، وربط الطلاب بالفضائل الأخلاقية).
خامسًا- طرح قيمي من التراث الإسلامي:
يمثل هذا طرحًا قيميًّا من التراث الإسلامي لمواجهة هذه التحديات، على أساس أهمية الاستفادة من هذا التراث ليس فقط للمسلمين بل للإنسانية جمعاء، وهو قابل للإضافة والتعديل. وأستشهد بالباحث الألماني سيباستيان جونزا، الذي يرى أن إهمال النظريات والفلسفات والحركات الفكرية التي نشأت في ثقافات وحضارات غير الغربية هو قصور بالغ يؤدي إلى عدم الاستفادة من حلول لمشكلات قديمة. حيث يرى جونتر أنه “يكمن جانب من المشكلة في وجود ميل في البحوث التربوية الغربية المعاصرة إلى إهمال النظريات والفلسفات والحركات الفكرية التي نشأت في ثقافات وحضارات غير الحضارة الغربية”. ومن ثمَّ يشدِّد على الحاجة الملحَّة لدراسة نقدية منهجية وغير متحيِّزة للقيم والمفاهيم الإسلامية، خصوصًا تلك المتعلِّقة بالنظريات والفلسفات التربوية التي طوَّرها العلماء المسلمون.
واخترت هنا الإمام الغزالي كنموذج، نظرًا لخبرته كأستاذ في التعليم العالي في المدرسة النظامية ببغداد. كما استعرض موقفه من تسليع التعليم العالي في جانبه النظري الذي ظهر في كتبه، خاصة “إحياء علوم الدين”، حيث يتحدث عن أخطار الانشغال بطلب الجاه وانتشار الصيت وجمع المال. كما برز الجانب التطبيقي في كتابه “المنقذ من الضلال”، حيث يشاركنا تجربته الشخصية.
ففي كتابه “إحياء علوم الدين” نجد أبوابًا مثل “كتاب العلم” و”كتاب النية والإخلاص والصدق”، تناول الغزالي بالتفصيل قضية اهتمام بعض العلماء بالمآرب الدنيوية، مثل: جمع المال، وتحصيل الجاه والسلطان، وحشد الأتباع والمريدين. كما أوضح أن العلماء هم من أكثر الفئات عُرْضَةً للوقوع في مخاطر تتعلَّق بصدق النوايا والإخلاص، وذلك نتيجةً للبيئات التي يعملون فيها، والتي تتضمَّن عوامل جذب قوية نحو هذه الأمور.
وبينما نجد التنظير في “إحياء علوم الدين”؛ فإننا نجد الجانب التطبيقي في كتابه “المنقذ من الضلال”. في هذا الكتاب، يشاركنا الإمام الغزالي تجربته الشخصية العميقة كـ “أكاديمي” بارز مَرَّ بهذه الاختبارات الوجودية. وقد وددت أن نستمع إلى كلماته المضيئة ونتفكَّر فيها، حيث قال في وصف مراجعته لنفسه:
“ثم تفكرت في نيتي في التدريس، فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت. فتيقَّنت أني على شفا جُرُفٍ هارٍ، وأني قد أشفيت على النار إن لم أشتغل بتلافي الأحوال”.
إن هذه الكلمات تثبت نقاء سريرة الإمام، فقد أراد أن يُشركنا في تجربته، رغم أنه كان بإمكانه إخفاء هذا الصراع الداخلي. لقد أسفرت هذه المراجعة عن تركه للتدريس في المدرسة النظامية المرموقة واعتزاله لفترة، ليعود بعدها شخصًا مختلفًا تمامًا روحيًّا وفكريًّا.
لقد اختار مشاركتنا هذا “القصور” لأنه معلم حقيقي. والمعلم لا يهتمُّ بنظرة الناس إليه، بل كان مهتمًّا فقط بنقل التجربة لنتعلَّم منها. وبهذا، لم يكن الإمام الغزالي مجرَّد “معلِّم”، بل كان “مربِّيًا للمعلِّمينTeacher Educator”، حيث فتح لنا هذا الباب على دواخله وكشف لنا ما كان يمرُّ به.
وعند تحليل عبارات الغزالي حول “طلب الجاه” و”انتشار الصيت”، نجدها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بما ناقشناه حول أثر النيوليبرالية (Neoliberalism) والمادية على المعلِّم المعاصر.
يمكننا عقد مقابلتين واضحتين (وهناك غيرهما الكثير) بين طرح الإمام الغزالي ومنطق الأكاديميات النيوليبرالية:
المقابلة الأولى: (الأدائية) مقابل (الصدق)
- الأكاديميا النيوليبرالية: تركِّز بشكل مهووس على الأداء الظاهري (Performativity) وكما يوضِّح المنظِّر التربوي ستيفن بال فإن هذا التركيز المفرط أدَّى إلى “هويات وقيم وأشكال جديدة من التفاعل”، وسبَّب نوعًا من “عدم الاستقرار الداخلي” لدى الأستاذ الجامعي. ويضيف “بال” إنه في ظلِّ هذه المنظومات، “لم يعد الصدق هو الهدف”، بل تُستبدل المبادئ كلِّيًّا بـ“المرونة” (Plasticity)؛ أي أن يطوِّع الأكاديمي نفسه حسب معطيات الواقع ومقتضيات المصلحة المادية. إذ أصبحت “الكفاءة وليس الصدق” هي القيمة الأعلى في هذا النظام الأدائي؛ فالمطلوب شخص “منتج” و”فعال” (Efficient) بغضِّ النظر عن صدقه، الذي قد يُنظر إليه كعائق.
- أما الإمام الغزالي -في المقابل- فيؤكِّد في “كتاب النية والصدق والإخلاص” أن “النية والصدق والإخلاص هي جوهر كل عمل”. لا يوجد لديه “مرونة” أو تصنُّع، بل يتَّخذ اتجاهًا قيميًّا واضحًا يرفض مهارات تسويق الذات والتظاهر بصورة “قابلة للبيع”، وهو ما تروِّج له ثقافة التسليع.
المقابلة الثانية: (الاختصاصي بلا روح) مقابل (روح العمل)
- الأكاديميا النيوليبرالية: يصف عالم الاجتماع ماكس فيبر المهنيين في العصر الحاضر بأنهم “اختصاصيون بلا روح” تحوَّلوا إلى مجرد “تقنيِّين” (Technicians) يؤدُّون مهامَّهم بصورة آلية باردة.
- أما طرح الإمام الغزالي: فإنه يُطلق على “النية” وصف “روح العمل”. هذه المقابلة بين “انعدام الروح” في السياقات المادية، و”أصل الروح” في العمل عند الغزالي (الموجودة أيضًا في كتاب النية والإخلاص والصدق) هي مقابلة جوهرية وعميقة.
أختم بالتأكيد على أهمية الاستقاء من التراث الإسلامي، ليس لخدمة المسلمين فحسب، بل لخدمة الإنسانية جمعاء. إن الظرف التاريخي الذي نمر به الآن قد أصبح مناسبًا تمامًا لتقديم طرح قيمي بديل، وذلك لعدَّة أسباب:
- الحاجة الماسة لبديل عن الطرح المادي السائد الذي يعيش أزمة.
- تصاعد الدعوات لـ “تحرير التعليم العالي” من المعارف والهياكل الاستعمارية المهيمنة.
- نداءات من الطلاب أنفسهم، خصوصًا في الجامعات الغربية، تطالب بمصادر معرفية جديدة ومختلفة عن المصادر الغربية التقليدية.
في ظل هذا الاضطراب الذي تمرُّ به المؤسسات التعليمية، وفي ظلِّ هذه الدعوات، أرى ضرورة دفع البحوث العلمية في اتجاه الاستقاء من تراثنا الإسلامي. وما قدَّمتُه اليوم ليس إلا مثالًا بسيطًا على ذلك يمكن تطويره والبناء عليه.
سادسًا- تجربة شخصية وممارسات عملية:
من واقع تجربتي الشخصية، اتخذت الخطوة الأولى في مواجهة تسليع التعليم العالي، وهي المراجعة الفردية لدورنا وأهدافنا في العمل الأكاديمي. ثمَّ عندما عملت في إحدى وحدات تطوير التعليم في الجامعات الإنجليزية كنت أساعد الأساتذة في القيام بعملية المراجعة، والتساؤل بشأن دورهم، وما يريدوا أن يحقِّقوه من التواجد في الجامعة، وكيف يمكن أن يشكِّلوا بحوثهم (بناء أجندة بحثية). أحيانًا لا يستطيع الإنسان أن يغير في منظومة الجامعة، ولكنني كنت أحاول دائمًا أن أحث على أهمية التواصل مع الزملاء والطلاب من منطلق قيمي وإنساني.
وكنت دائمًا ما أنصح زملائي (بالنشر مفتوح الوصول Open Access Publishing) لضمان العدالة المعرفية، فمثلًا عندما نقوم ببحوث في الجامعات الغربية، كنا نذهب مثلًا إلى نيجيريا وأوغندا وغيرهما، ونتعامل ونتشارك مع باحثين هناك، فنقوم بكتابة البحوث ونرسلها إلى الناشرين الغربيين وينشرونها. فنجد مثلًا أن الباحث النيجيري أو الغيني الذي تعاون معي لا يستطيع أن يدخل على هذه البحوث ولا يقرأها ولا يستفيد بها أصلًا. لماذا؟ لأن الناشر عنده يحتاج إلى دفع. فأصبحت الآن لا أنشر بحوثي -قدر الإمكان- إلا في “الفئة مفتوحة الوصول” (Open Access)، والحمد لله نجحت في ذلك إلى حَدٍّ كبير. إلا إذا كان الناشر يقبل أن يكون البحث مفتوحًا للجميع. وأحيانًا أكتب إليهم وأقول لهم إنه لا يجوز أن يتم حجب البحث هذا عن زملاء من كذا وكذا.. بعضهم يوافق ويفتح البحث للآخرين، وبعضهم لا يوافق.
وقد تعاونت مع مايكل بيترز، الأستاذ في التربية في الفلسفة التربوية لإصدار دورية علمية في التربية تكون “مفتوحة الوصول” للباحثين في البلدان التي لا يستطيع الباحثون فيها الدفع مقابل الحصول على المقالات، وقد نشرت فيها دعمًا لهذا النشاط.
الجانب الآخر الذي أساهم فيه هو دعم الطلاب. فأنا كثيرًا عندما كنت أشرف على طلاب الماجستير والدكتوراه، لم أكن فقط أتوقَّف عند الوقت المحدَّد لمناقشة المنجز من الرسالة، ولكن كان هناك نوع من التواصل بيننا. كنت أريد أن أكون صادقة مع نفسي في قيمي التي أتبنَّاها.
نقطة أخرى هي المشاركة مع أكاديميِّين غربيِّين في التدريس عن بُعد في غزة، وهذا التعاون مع غزة قائم بفضل الله منذ عام 2014، حيث اشتركت في مشروع بحثي كبير، قادته جامعة جلاسكو آنذاك لتطوير كفاءات المعلمين هناك. وكانت النية أن تقوم الجامعة بعمل مركز لتعليم اللغة العربية عن بعد، كوسيلة لإيجاد فرص عمل للمدرسين هناك، وأيضًا بطريقة غير مباشرة مواجهة الاحتلال. كما أقوم حاليًّا بتدريس تطوعي في الجامعة الإسلامية بغزة، رغم الدمار ورغم الحرب ورغم الجوع ورغم كل شيء.
وفي الحقيقة أنا سأقول لكم شيئًا وهو أنني أنا التي تعلَّمت من هؤلاء الأبطال في الحقيقة، وتعلَّمت من زملائي الأكاديميِّين الذين يدرسون من الخيام، ويدرسون في ظلِّ الجوع، وتعلَّمت من الطلاب الذين يمشون ساعات طويلة فقط لأجل الوصول إلى إشارة إنترنت لحضور المحاضرات. وقد نشرت مع زملاء لي بحثين أو ثلاثة عن خبراتنا السابقة في تدريب المعلمين في الجامعة الإسلامية بغزة.
ولكن بعد فترة من العمل في الأكاديميات الغربية، ونتيجة للضغوط التي يجدها الإنسان من البيئات التي تكلَّم عنها ستيفن بال عندما قال إنها بيئات “High stress, Low trust” (ضغط عالٍ، ثقة منخفضة)، انسحبت من الجامعات الكبيرة في الحقيقة، وأنا أعمل الآن في “في معهد الدراسات الكلاسيكية” حيث وجدت فيه ضالَّتي إلى حَدٍّ كبير.
وأنا أقوم حاليًّا بإجراء بحوث عن: أثر النظريات الكلاسيكية التربوية القديمة على المنظومة التعليمية الكبرى، وكيف يمكن أن نستفيد منها في تطوير التعليم المعاصر دوليًّا. وأتبنَّى في ذلك منظورًا قيميًّا، يستفيد منه المسلم وغير المسلم.
فكما نحاول أن نفيد يجب ألا ننسى أن هناك مجالًا كبيرًا للاستفادة من الآخرين، وذلك من باب التواضع الفكري الذي يدعو إلى تأمُّل ما يقوم به آخرون. وأضرب مثالًا على ذلك عندما كنت في غانا، كنت قد دعيت لإلقاء محاضرة حول “ممارسة المراجعة الذاتية للنفس” (Reflective Practice)، وهو موضوع يدعو المدرس أن يراجع أهدافه ومبادئه… كنوع من تطوير المعلم. فكان من بين الحضور أستاذ يعمل في جامعة غانا. وقال لي: “يا أستاذة، أنتِ ما تقولينه هذا عندنا في غانا منذ آلاف السنين”. قلت له: كيف؟ قال لي عندنا رموز ثقافية نستخدمها وتعبر عن مبادئ المجتمع، منها رمز لمراجعة النفس يسمى “سانكوفا” (Sankofa). وهو رمز طائر، يطير إلى الأمام ورأسه إلى الخلف يحمل بيضة. قال لي هذا الرمز يقول إنك عندما تمضي إلى الأمام في حياتك، فلا تنسَ أن تنظر إلى الخلف من حين إلى آخر، تستجلب معك كل ما هو غالٍ وثمين ولا تنساه ولا ترميه وراءك، وتأخذه معك في رحلتك إلى الأمام، لأن ذلك سينفعك كثيرًا. ومن هنا يمكن أن يستفيد الإنسان من ثقافات أخرى يجد فيها الكثير من الثراء.
فرغم أن التراث العلمي في هذا المجال (المراجعة الذاتية – Reflection) غربية إلى حَدٍّ كبير، حيث يؤكِّد على المعلم أو الأستاذ الجامعي أنه عندما يقوم بهذه المراجعة أن يكتبها ويراجعها مع “Mentor” (موجه) لتطوير أدائه العلمي. ولكن أنا وجدت عندما تحدَّثت مع الزميل في غانا أن مفهوم “السانكوفا” أبعد من ذلك، وأعمق من ذلك، لأن “السانكوفا” عندهم ليست فقط مفهومًا فرديًّا، ولكنها أيضًا مفهوم جمعي، تدعو الشعوب إلى مراجعة أنفسها وهي تتقدَّم إلى الأمام، تدعو الحضارات إلى الأخذ بأجمل ما فيها وهي تمتدُّ وتتقدَّم. كذلك عندما أسافر لإلقاء محاضرات، دائمًا أستقي من الثقافات التي أسافر إليها. وأستحثُّ أبناءها على الاستقاء من تراثهم التربوي ومقارنته بما أقدِّمه.
التعقيبات واتجاهات النقاش:
شارك في النقاش والتعقيب على المحاضرة مجموعة من الأساتذة والباحثين، فيها يلي أبرز ما جاء في تعليقاتهم:
· د. كريم حسين:
كنت أتأمَّل في موضوع المحاضرة وموقع “التعليم” من المفاهيم السائدة في العالم الآن. المفهوم الغالب هو مفهوم “الاستدامة” (Sustainability)؛ الأمم المتحدة وضعت رؤية 2030، والدول القومية وضعت رؤيتها الخاصة. لكن مفهوم الاستدامة، كما كانت تعلِّمنا أستاذتنا الدكتورة ليلى البرادعي (رحمها الله)، هو أننا نعمل في الحاضر ونحافظ على حقوق الأجيال القادمة.
لكن هذا المفهوم، حين ننظر إليه بالرؤية الحضارية، نجد أن ما يقابله في جانبنا الحضاري هو مفهوم “الاستخلاف”. في عملية الاستخلاف، نحن نتحرك في الحاضر، ونتَّجه إلى المستقبل، ولكن يضاف إلى ذلك بُعدان آخران: أننا نرجع إلى دروس الأمم التي قبلنا ودروس تاريخنا، وبُعد الاتصال بالسماء. فربنا سبحانه وتعالى يقول: (ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) [يونس: 14].
حين نضع مسألة التعليم في إطار هذا “الاستخلاف”، وننظر إلى الماضي، أعتبر أن التجربة المصرية مهمة جدًّا. فنموذج أحمد عرابي عندما تم نفيه إلى جزيرة سيلان (سريلانكا)، ومكث هناك عشرين سنة. ماذا فعل هذا القائد العسكري؟ لقد أنشأ مدارس سماها “مدارس الزاهرة”، وكانت لديه رؤية جميلة بأن تجمع هذه المدارس بين التعليم الديني (مثل الأزهر) والأدوات الحديثة واللغات. لقد فعل شيئًا سبق به بعض المعاهد الأزهرية بأكثر من مائة سنة.
هذه التجربة تعلمنا درسًا هامًّا حول الدور الذي نخاف عليه اليوم في التعليم العالي: وهو دور “المجتمع الأهلي”. فكرة أن يُطرح على المؤسسات الأهلية (سواء في بريطانيا أو مصر أو غيرها) الاتجاه نحو تأسيس الجامعات. فعندما فعل عرابي ذلك، كان محمد عبده في نفس الوقت يتكلَّم عن إصلاح التعليم لمواجهة الاستعمار، وجمال الدين الأفغاني يتكلَّم عن “الجامعة الإسلامية”.
من الذي نفذ الفكرة بعد ذلك؟ مصطفى كامل. لقد أسَّس “الجامعة”، التي هي “جامعة القاهرة” الآن. أسَّسها كجامعة “أهلية”، ليس بالمنطق السائد الآن (أن الحكومة أنشأتها)، بل بمعنى أنها نبعتْ من المجتمع. هذا درس مهم يمكن أن يقوم بعمل مساحة من التوازن.
الأمر الثاني، هو دور الجامعات في تاريخنا المصري والإسلامي. نحن كمنطقة نتعرَّض لهجمات متنوِّعة وعدوان عسكري. كان دور شباب الجامعات في مواجهة هذا العدوان بالغ الأهمية. مثلًا: في العدوان الثلاثي على مصر، وفي مواجهة الاستعمار قبل 1952، وفي حرب أكتوبر (خاصة في السويس بعد الثغرة)، وحتى في أيام الظاهر بيبرس عندما تراجعت القوات النظامية، دخلت القوات الشعبية والعلماء (مثل أبي الحسن الشاذلي) لصد لويس التاسع. هذا يقول إن للجامعة، كما ذكرت الدكتورة مريم، أدوارًا اجتماعية أخرى.
أخيرًا، أنا لا أرى أن الإصلاح يكون فقط من خلال الحكومة، بل ربما يكون من خلال القطاع الخاص. لكننا نواجه تحدِّي أن العاملين في القطاع الخاص تحرِّكهم أدوار فردية (النيوليبرالية التي تحدَّثْتِ عنها).
نحن محتاجون إلى حالة من “الحوار” مع رجال الأعمال والقطاع الخاص، فيما يتعلَّق بالمسألة القيمية والدور المجتمعي في إصلاح التعليم. هذا في رأيي قد يحقِّق نتائج أفضل من الدور الحكومي في إصلاح العملية التعليمية. ولي تجارب مع عدد من رجال الأعمال الذين يملكون جامعات، ورأيت أن لهم أدوارًا جيدة للغاية حين يتم هذا الحوار معهم.
· د. لبنى الغريب:
لدي ثلاث نقاط وملاحظات متضمنة مجموعة من الأسئلة:
1- أريد أن أسأل عن تداعيات التسليع والأيديولوجية النيوليبرالية ليس فقط على المعلم وإنما على المناهج التي يتم تدريسها؟ ومن ثمَّ على الخريجين؟
2- نحن نقرُّ أن هناك أزمة في الغرب، ونموذجهم المعرفي، وهم أنفسهم يقرُّون بها ويسعون لإيجاد بديل مع امتلاكهم لأدوات ذلك فهم لديهم ما يُعرف “بعلم العلم”، الذي يتضمَّن طرقًا لإنتاج العلم وتسويقه. فالسؤال هنا، هل نحن مستعدُّون لطرح البديل بطريقة قابلة للتنفيذ؟ وهل مسعى نموذجنا هو العالمية؟
3- من المهم الاعتبار إلى دلالة الأرقام، وليس اعتبارها نزعة سلبية دائمًا، فالمشكلة هي الممارسات الخاطئة في توظيف دلالات الأرقام، منها اللهث وراء التصنيفات دون الالتفات إلى الهدف والغاية من وراء ذلك. والأهم هو محاولة دمج المادي (الكمي) بالقيمي. فمن المهم معرفة كيفية قياس القيم لدى الأستاذ الجامعي (كيف نقيس الصدق والنية؟) فإذا كان يمكن تقدير وقياس الأداء فكيف يمكن قياس الجانب القيمي؟
· د. عبد الرحمن رشدان:
سأتحدث عن التحديات التي تواجه الأكاديمي المسلم في الغرب؛ وهي ثلاثة:
1- ضغط النشر مقابل تقديم رؤية إسلامية، إذ يجد الأستاذ صعوبة في النشر في المجالات الأكاديمية الرائدة، ومن ثمَّ صعوبة في التوظيف والترقية.
2- الضغوط المالية التي تؤثر على العلاقة مع الطلاب، فالانفجار في البرامج الأونلاين (عن بُعد) سحب الكثير من الطلاب من الجامعات الحضورية، وأدَّى إلى ضغط مادي على الجامعة، ومن ثمَّ إدارات الجامعات أصبحت تضغط على الأساتذة لنجاح الطلاب، ففي حالة الخلاف مع الطالب (رأي الطالب هو الذي يُقَدَّم)، وهو ما يؤكِّد فكرة العلاقة بين الزبون ومقدِّم الخدمة (Customer and service provider)
3- التحدي المتعلق بالحفاظ على دور التربية (الدور التربوي للمعلم) داخل الإطار الأكاديمي، فالنظام الغربي لا يوجد فيه وقت لقيام الأستاذ بأي دور تربوي مثلما يحدث في العالم العربي، فهي علاقة إنسانية (وقت شخصي) يصنع الرؤية عند الباحث؛ فالبرنامج اليومي للأستاذ الجامعي في أمريكا لا يسمح له وقته بالتواصل مع الطالب خارج إطار المحاضرة. ومن رأيته يقوم بذلك إما الأساتذة اليهود أو العرب ولكن يكون ذلك على حساب وقته المهني وتطوُّره الوظيفي.
· السفير معتز أحمدين:
لدي تعقيبان؛ الأول حول مسألة القياس، حيث أرى ضرورة المزاوجة بين قياس الكفاءة وبين القيم التي لا يمكن قياسها، مع تفعيل المحاسبة لمن يفتقر لهذه القيم، وهو أمر قد نجده في الغرب أكثر منا بسبب انتشار الفساد. النقطة الثانية هي الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها المباشر على تسليع التعليم، وهي ظاهرة نراها بوضوح في مصر الآن (كمنح الشهادات مقابل المصاريف)، لكنها ليست جديدة، بل كانت موجودة في دول أوروبا الشرقية سابقًا، ولا تزال موجودة في الغرب عبر الجامعات المغمورة تحت عنوان ما يُسَمَّى “الدكتوراه بالمراسلة”.
إن ما أدهشني في العرض هو الإشارة إلى أن المؤسسات الغربية الكبرى تُعاني من نفس هذه المشاكل. فخبرتي الشخصية في الماجستير (في جامعة SOAS) كانت مختلفة تمامًا، حيث كان عدد الطلاب محدودًا جدًّا، وكان الأساتذة قريبين جدًّا ومتاحين للطلاب، ما يثير استغرابي حول ما أُشير إليه حول عدم وجود وقت لديهم. ومع ذلك، أتفهم أن تجربة الفساد وتسليع التعليم، وإن ارتبطت بالنيوليبرالية، فهي ظاهرة بشرية عامة وموجودة في تاريخنا أيضًا، متمثِّلة في نموذج “علماء السلطان”. وتبقى المشكلة الحقيقية ليست في الظاهرة بحدِّ ذاتها، بل في كيفية مواجهتها، ومحاسبة المتجاوزين، ونبذ هذا السلوك.
· د. عمار جيدل:
لدي مجموعة من الملاحظات والتعليقات:
- السياسات التعليمية تنبجس عن رؤية تظهر أنها متكاملة، ولهذا فإن وجود النموذج القاعدي في البلاد الاسلامي مدخل أساسي للبيان التطبيقي للرؤية الإسلامية للتعليم.
- وإذا وجد هذا فيلزم أن يُتَعَهَّدَ بالتطعيم، لأن فساد النية أو إفسادها تجري في الإنسان في هذا الفضاء مجرى النفس (إقبال الدنيا وإدبارها).
- حامل المشروع شرط أساسي للمشاركة الفعلية الفعَّالة في التعليم، والذي نراه أن الاستاذ هو من صنع مؤسسات أكاديمية تُشَيِّئُ كل شيء.
- وبالرغم من الظروف غير المحفِّزة، فإن المرابطة في قلعة القيم وبيان أهميتها للإنسانية أمر يحتاج البذل حيث أقامنا الله.
- التعليم العالي في التصور النيوليبرالي عبارة عن تكوين قطع غيار آدمية لخدمة الليبرالية، خدمة الشيء للشيء لا لأمر آخر.
· عمر خلف:
لدينا مشكلة عويصة في مصر والمنطقة حيث تسليع التعليم يجري على قدم وساق سواء عبر التوسع في الجامعات الأهلية أو الخاصة، والتي تعتصر الطلبة وأهاليهم ماليًّا، والأسْوأ أن أُجور الأساتذة في مصر تبقى متدنِّية جدًّا وتتدهور أحوالهم مع كل موجة تضخُّم، ممَّا يجعلهم بحاجة دومًا لعملٍ إضافي. ومع محاولات حوكمة الجامعات وتكميم معايير التقييم تغيب أي قيمة للجزء الإنساني المرتبط بالقدوة وبالعلاقات مع الأساتذة التي هي أكبر من مجرد تعليم ومحاضرات وإنما جزء من تعليم مستمر وتعزيز أدوار قيادية في المجتمعات، بل ويتعامل بعض الطلبة مع الأساتذة بطرق غير لائقة، المشكلة كيف يحول النظام غالبية الأساتذة إلى أدوات للتسليع وتحويل العمل بالتعليم لعملية أكل عيش وكيف يمكن مواجهة ذلك والتخفيف من آثاره؟ هل المشكلة في طريقة وأنظمة الاختيار للأساتذة وترقياتهم أم في السياق العام؟
· تعقيب د. مدحت ماهر:
إن قضية العلم والتعلُّم والتعليم بين الحضارات، وبالأخصِّ في مرحلتنا الإنسانية الحاضرة التي يتصدَّر فيها الغرب المشهد، تضعنا أمام مفترق طرق جوهري وصراع عميق بين رؤيتين: الأولى هي “التعليم كسلعة” أو “خدمة” (وهي الوجه الآخر للسلعة بالمفهوم الاقتصادي المعاصر)، والثانية هي “التعليم كرسالة”، التزامًا بالمقولة الخالدة: “كاد المعلم أن يكون رسولا”.
وعند ذكر مفهوم المراجعة يبرز مفكر إسلامي عظيم آخر، لاحقٌ للغزالي ولكنه سابقٌ لنا جميعًا: ابن خلدون. إذ يتكلم ابن خلدون عن “العلم مفاوضة”، أي أنه “أخذ وعطاء” وتفاعل، وبهذا ينمو العلم عبر ثلاثية: التحصيل، والتعليم، والمفاوضة.
هذه الثلاثية في طرحه شديدة الأهمية، وهي تقدم منظورًا مكمّلًا لطرح الإمام الغزالي. فبينما يركز الغزالي على “العالِم” و”المتعلم” (البُعد الفردي الأخلاقي والروحي)، نجد ابن خلدون (ويصح أن يسمى إمامًا في هذا الباب) يتكلم عن “صنعة العلم” وعن القوانين الحاكمة للتعلم والتعليم (البُعد الاجتماعي والنظامي).
ويُعد الفصل السادس من مقدمته مليئًا بالرؤى العميقة في هذه المساحة.
فإذا كان الإمام الغزالي يركز على التعليم “من الداخل”، باعتباره عالمًا متعلِّمًا يعاني معنويًّا وروحيًّا لتثبيت وتصحيح نيَّته ووجْهته، فإن ابن خلدون، يتجاوز هذا إلى قضية التعليم كـ “صنعة من صنائع العمران”. هو ينظر للتعليم “من الخارج” كعالم اجتماع عمراني حقيقي. ويرى كيف ينشأ التعليم لاحتياج مجتمعي، وكيف يتطوَّر مع تطوُّر السياقات الاجتماعية والحضارية. وأشار إشارة لطيفة ومهمَّة جدًّا: أنه عندما احتاج التعليم في الحضارة الإسلامية للمال، كانت “الأوقاف” في ظهره. هذا معنى مهم جدًّا يواجه فكرة “التسليع”، حيث نرى كيف أن “القيم” الموجودة في المجتمع هي التي تصبُّ مباشرةً داخل الأكاديمية.
الأمر الثاني هو قضية “غايات العلوم” نفسها: فالعلوم الطبيعية كانت مهمَّتها “معرفة الكون”، ثم “التحكم في الكون”، والآن تحوَّلت كلها إلى “تقنية” بهدف “إراحة الإنسان”. أما العلوم الاجتماعية والإنسانيةفكانت تهدف لـ “فهم الإنسان”، ثم تحوَّلت إلى “الضبط الاجتماعي” مع الحداثة، والآن، في ظل النيوليبرالية، عادت أيضًا إلى فكرة “إراحة الإنسان”.
نحن محتاجون أن نوضِّح غاياتنا ومقاصدنا: ما الذي نريده من العلوم الاجتماعية اليوم؟ هل هو “إراحة الإنسان” أم “الضبط الاجتماعي”؟ ولذا يجب أن تَصُبَّ هذه المراجعات (للغزالي وابن خلدون) في مشروع علمي عملي لإصلاح التعليم.
وأعتقد أن الإضافة الأساسية والكبرى في هذا اللقاء هو أن منظورنا يتأكَّد وينمو ويتَّسع. من المهمِّ جدًّا أن نضع واحدة من المهام المستقبلية لنا: كيف يتم “التشبيك” وألا يتم في سياق فردي.
التجربة التي قُدِّمَتْ تقول إن المشترك الأساسي بيننا هو في المقاصد والمنطلقات، مع تنوُّعنا في المجالات والخبرات. ومهم جدًّا أن يُبنى هذا التكامل على “وعي مشترك” و”إفاضة المعلومات فيما بيننا”، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب: “أفيضوا المجالس بينكم”.
تعقيب ورد د. مريم عطية:
أولًا- ليس هناك تعارض بين الاستقاء من الحضارة الغربية والمنظور الإسلامي. فلقد شاركت مؤخَّرًا في كتاب محرَّر بفصلٍ عن التطوير الأكاديمي أقترح فيه استخدام مبادئ من الإمام الغزالي في برامج التطوير الأكاديمي الغربية، تمامًا كما نستخدم “اليقظة الذهنية” (من البوذية)، وكما نستخدم مفهوم “سانكوفا” (Sankofa) (من التراث الغاني). يجب أن تكون لدينا الشجاعة أن نقدِّم ما عندنا بفخر واعتزاز، والمتلقِّي يأخذ أو يترك.
ثانيًا- نقطة مهمَّة في النشر، أنا خبرتها فيما يخصُّ عملَنا التربوي في فلسطين (وخاصة غزة)، حيث كانت كثير من دور النشر تعتذر لأسباب واهية. ولكن، من يُكثر الطرق على الباب يُفتح له في النهاية. الآن، هناك الكثير من الدوريات التربوية تكتب عمَّا يحدث في فلسطين، أكثر ممَّا كنَّا نتمنَّى. وهناك مقالات تنتقد النظام الإسرائيلي ومساندة الغرب له.
الأمر نفسه في الناحية الإسلامية؛ بدأ المجال يُفتح. لقد قرأت هذا العام مقالة ممتازة للباحث (جوزيف لمبارد) في جامعة حمد بن خليفة، في واحدة من أفضل الدوريات في العالم في التعليم العالي (Teaching and learning in Higher Education)، يتكلَّم فيها عن “الإسهام المعرفي الإسلامي للتعليم”، والمقال متاح للجميع (Open Access). فالأمر يبدأ من (أعود مرة أخرى للغزالي) النوايا والإخلاص والصدق، والله يفتح على المجتهد ويوفقه، وأن يتعاون الإنسان مع من يشاركه الأفكار.
ثالثًا- فيما يخص لماذا استشهدت بالغربيِّين؟، أوضِّح أنَّني مطَّلعة على كتب أساتذتنا (د. سعيد إسماعيل علي وغيره). ولكني رأيت أن الأقوى في هذا السياق أن يأتي النقد من أهل السياق أنفسهم (أي من الغربيِّين)، ليس من خارجه.
رابعًا- فيما يخص البحث عن بدائل، فلقد أشرتُ إلى التقابُل بين النظام المصري والغربي. اسمحوا لي أن أقدِّم نماذج أخرى:
منها نموذج اليابان: في مشروع بحثي حول طلاب الدكتوراه في اليابان، تبيَّن أن الطلاب سعداء جدًّا بالإشراف الحاصل لهم، رغم أن النظام الياباني يُوصف بأنه “تقليدي” و”هرمي”. لماذا؟ لأن المشرف “يأخذ طلابه تحت أجنحته”، ومتواجد عندما يحتاجونه، ويأخذهم معه للمؤتمرات، ويتعامل معهم اجتماعيًّا خارج الجامعة. هذه هي الوظائف التي كان الأستاذ الجامعي التقليدي يقوم بها! وعندما سألَنا الأساتذة اليابانيون: “كيف نطوِّر أنفسنا (مثل الغرب)؟”، قلت لهم بصراحة: “تطوَّروا في اتجاهكم؛ لأن تبنِّي النيوليبرالية عندكم سيهدم هذه المبادئ التي استمررتم عليها”، (هذا لا يعني عدم وجود مشكلات في اليابان كالتسلط والأبوية، ولكن الأغلب كان سعادة بالإشراف). في المقابل، البحوث في الغرب تشير إلى ارتفاع رهيب في “المشكلات النفسية” والوحدة بين طلاب الدكتوراه، بسبب تآكل “المجتمعات العلمية” الذي سبَّبه النظام النيوليبرالي.
والنموذج الثاني عن فلسطين: أعتقد أن الحصار الشديد الذي تعرَّضت له غزة ربما حماها من كثير من المؤثِّرات النيوليبرالية. ما رأيته من تعامل الأكاديميِّين مع الطلاب فيه الكثير من “الرسالية”. هم يدرسون الآن (وكانوا يدرسون خلال الحرب) دون تقاضي رواتب، ودون وجود جامعات أصلًا، مع استشهاد زملائهم. كانوا يأخذون الطلاب زملاءهم ويطلبون متطوِّعين. عندما نسألهم: لماذا تفعلون ذلك؟ يقولون: “هذا دوري. هذا جهادي. الممرض في المستشفى والخباز في المخبز، وأنا يجب أن أكون لطلابي”. هذا المفهوم عن “المنظومة المتكاملة” ورؤية المعلِّم لنفسه هو الدرس.
أما عن المشروع البديل؛ أنا أُعيد السؤال لنا جميعًا: هل ساهم كلُّ واحدٍ منَّا في مشروع بديل؟ المشروعات البديلة لا توجد من فراغ، يقوم بها أشخاص، حتى ولو بخطوات. أولى هذه الخطوات هي الوعي، ثم نأخذ خطوة أخرى، وتكمل بعدنا الأجيال.
نقطة أخرى عن ابن خلدون، إن اختياري للغزالي كان بسبب التقارب المباشر مع خبرة النيوليبرالية (المال والجاه) التي تعرَّض لها هو، ونحن أيضًا معرَّضون لها. لكن ابن خلدون قدَّم الصورة الكبيرة (الماكرو)، ومن أهم نقاطه أن “التعليم لا يمشي مع القهر”. ونحن نعيش قهر فرض السياسات والأساليب.
خامسًا- بخصوص معايير اختيار العاملين في وحدات التطوير الأكاديمي، هي طبعًا قائمة على الخبرة بالنظريات (الغربية) ومهارات التدريس. ولكن، كما قال زميلي “روس وايت”، ما نقوم به هو “فعل إنساني” (Human Doing) وليس “كينونة إنسانية” (Human Being). نحن نعلِّمك “كيف تعمل” (تضع خطة، تدير فصلًا)، ولكن لا نعلِّمك “كيف تكون”. ابن جماعة الكناني في كتابه “تذكرة السامع والمتكلم” لديه فصل كامل عن “آداب المعلم في نفسه” (قبل أن يكون مع الطلاب). هذه الـ “Human Being” هي ما نحتاج للتركيز عليه.
سادسًا- الأثر على الطلاب؛ كان هناك سؤال عن تداعيات النيوليبرالية على الطالب. أعتقد أن الطلاب ظُلموا ظلمًا شديدًا: فرُفعت عليهم المصاريف، فأصبحوا يشعرون أنهم دفعوا ثمنًا كبيرًا (وضعتهم دائمًا في خانة المدين)، كما أن النظام نفسه وضعهم في سياق “الزبون”، والجامعة هي منتجع (يشتريه الطلاب)؛ فأضحت الجامعات تستثمر في “حمامات السباحة” (Swimming pools) والسكن الفاخر لجذب الطلاب، وليس مثلًا في تطوير الأساتذة ومكاتبهم بنفس الاهتمام. كما أصبحت أدوات التقييم (الاستبيانات) تقيس رضا الطلاب كأنهم في منتجع سياحي: “هل تعجبك الكافتيريا؟ هل يعجبك السكن؟”. وكان نتيجة ذلك أن الطالب أصبح ينظر للتعليم نظرة مادية بحتة (أدفع مالًا، آخذ شهادة، أحصل على وظيفة). ولا ألوم الطلاب كثيرًا، فالمنظومة هي التي جعلتهم هكذا. لكن دورنا كأساتذة هو أن نعيد الجانب الإنساني والقيمي لطلابنا، لأنهم في النهاية بشر. وهذا النظام بالرغم من أنه أوجد وَحْشَةً في العلاقات، فإن علينا أن نعمل “فيما بين الفوارغ أو الشقوق” ونحاول أن ندخل الضوء، لنكون صادقين مع مبادئنا.
تعقيب ختامي من د. نادية مصطفى:
دائمًا ما أبحث عن أمرين عقب كل محاضرة: الرسالة العامة التي وصلتني، والخيوط الناظمة الأساسية بين كل المداخلات والمحاضِر.
بالنسبة للتصور العام، شعرتُ بأُلْفَةٍ واتحاد مع المحاضرة وشعرت بالخبرة المشتركة. لماذا؟ لأنها تكلمتْ عن نقاط متقاطعة ومندمجة مع خبرتنا نحن في مجال معرفي مختلف (علم السياسة والعلاقات الدولية) وفي سياق سياسي واجتماعي مختلف.
كنت أستمع كما لو كنت أستمع لنفسي منذ 40 عامًا، حين كنت أحضِّر ومعي فريقي هذه الخبرة والتفاعل عن مشروع العلاقات الدولية في الإسلام وخبرة البحث فيه وتأسيس منظور حضاري في العلم. وما زلنا نُعاني حتى الآن من كثير من هذه الأمور. حقيقةً، مجال التربية والتعليم العالي ربما يكون أكثر تحديدًا من مجال السياسة، لأننا لم نستطع تغيير الكثير، مما يجعلنا نرجع مرة أخرى إلى الجزئيات التي تبني السياسة “من أسفل”، مثل التعليم والهوية.
الخيوط الناظمة في المحاضرة:
- الخيط الأول: ضرورة المنظور الفكري؛ لقد بدأت الدكتورة مريم عطية بأنه لا يوجد تعليم عالٍ، كسياسات واستراتيجيات، بدون منظور فكري. هذا أمر غائب عن أذهان “الوضعيين” (Positivists) و”الواقعيين” الباحثين عن حلول، الذين يتكلمون في كيفية إصلاح وتطوير التعليم العالي بمنظور نيوليبرالي، وهم يعتقدون أنهم يتكلمون عن “الأصلح” و”الأوفق” و”العالمي”، أيًّا كان مصدره ونتائجه.
- الخيط الثاني: النقد الغربي الداخلي؛ لقد أوردَتْ إحالات لعلماء تربية غربيِّين، سواء من تحدَّثوا عن النيوليبرالية أو الذين انتقدوها نقدًا معرفيًّا ومرجعيًّا وعمليًّا. هؤلاء نقَّاد غربيون يختلفون مع المنظور الفكري السائد لديهم، ويشفقون على مجتمعاتهم من مخرجات هذه النظم. وهذا يفتح الباب على المراجعات النقدية الغربية في كل العلوم الاجتماعية، وكيف نجد بيننا وبينها قواسم مشتركة، فـ“الإنسان” و”الفطرة” مشتركة.
- الخيط الثالث: المدرسة العربية الإسلامية في التربية؛ هنا أودُّ أن أُضيف، أن لدينا مدرسة في التربية عربية إسلامية (قامت في أحضان المعهد العالمي للفكر الإسلامي) أنتجت الكثير في هذا المجال. على رأسهم أساتذة كبار تعلمتُ منهم، مثل الدكتور عبد الرحمن النقيب (والسلسلة التي أخرجها)، والدكتور سعيد إسماعيل علي، والدكتور فتحي الملكاوي. ولكن د. مريم عطية قدَّمت من واقع خبرتها بالتعامل مع المصادر الغربية، وهذا جيد جدًّا. الفارق الأساسي -رغم الاشتراك في “الإنساني” ونقد “الوضعية” و”المادية”- هو أن الفريق الغربي ما زال في معظمه علمانيًّا (Secular) لا ينظر إلى المصادر القيمية من الأديان.
- الخيط الرابع: دمج التراث الإسلامي (الغزالي وابن خلدون) مع الإسهام الغربي؛ فالدكتورة مريم عطية تحدَّثت عن الاستقاء من التراث الإسلامي، وضربَتْ مثلًا بالغزالي (وأُضيف إليه ابن خلدون). ونحن نعلم أنه يوجد أيضًا في تراثنا “فقهاء السلطان” و”المنافقون” الذين يتاجرون بالعلم في كل زمان ومكان. لكن أتمنى أن يحدث “اندماج” لهذا الطرح. ففي خبرتنا بتدريس العلوم السياسية من منظور حضاري، بدأنا كما فعلت د. مريم: نعرِض الغربيَّ ونوجِّه له النقد، ثم نأتي بالإسلامي، ثم انتقلنا إلى المقارنة.
آخر ملاحظة، وهي التي تنتظم حولها كل المداخلات: كيف تتم مواجهة تحديات (أو تهديدات) هذا النمط النيوليبرالي على نظمنا التعليمية؟
لقد أشارت د. مريم عطية إلى ما يجري في السعودية، وأنها وجدت أمرًا مناظرًا في كازاخستان وغانا، من استيراد النظم الغربية باعتبارها “عالمية”. لماذا؟ لأن النظم القائمة تؤمن بصلاحية هذا النمط. لقد عايشت هذا لأكثر من 15 عامًا في مركز البحوث ورئاسة قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كنا نحذِّر ونحذِّر، ولكن في النهاية كان يصل إلى المناصب من لا يعبأون بهذا الأمر، فيسري الأمر كما لو لم يتكلَّم أحد عن التطوير القيمي في مقابل “سوق العمل”.
سؤالي: إذا كان في الغرب أيضًا من ينقض النيوليبرالية فكرًا وسياسةً، فما الفارق بين قدرتهم على التأثير هناك وقدرتنا نحن على التأثير هنا؟
أعتقد أن هناك عوامل مثل الحريات الأكاديمية والسياسية، ودرجة الفساد، ووجود المؤسسات المدنية البديلة.
المعضلة تكمن إذن في: هل الحل هو الخروج وإنشاء مؤسسات بديلة، أم في “الرباط على الثغر” والمقاومة من الداخل؟ نحن فعلنا الثانية طيلة 40 عامًا. والدليل هو ما أشار إليه الزملاء: حين تحاول أن تنشر في الخارج محتوى علميًّا من رؤية حضارية إنسانية شاملة، فإنك تواجه صعوبة ورفضًا. نحن نحاول منذ 3 سنوات نشر كتاب عن “مدرسة حضارية في علم العلاقات الدولية”، والمشكلة ليست في الرفض، بل في “الفهم” (عند بعض المحكِّمين لما نقدِّمه).
وفي الأخير، لا بدَّ من “الرباط على الثغر”. الجدال بين النماذج المعرفية الوضعية والقيمية هو حوار دار عبر القرون وعبر الحدود ولم ينقطع. وكما كانت تقول أستاذتنا د. منى أبو الفضل (رحمها الله): الجغرافيا لا تهم، ليس شرقيًّا وغربيًّا، بل هو “نموذج معرفي توحيدي رأسي” في مقابل “نموذج معرفي أفقي”، وكلاهما يوجد في الشرق والغرب على حَدٍّ سواء.
[1] لمعرفة المزيد حول الدكتورة مريم عطية وأهم أعمالها انظر:
– Attia, Mariam (PhD alumna), LANTERN, https://lantern.humanities.manchester.ac.uk/?page_id=448
– Dr Mariam Attia Bio, The Classical Institute, https://www.theclassicalinstitute.co.uk/dr-mariam-attia-bio
[2] Osman Barnawi, Neoliberalism and English Language Education Policies in the Arabian Gulf, (New York: Routledge, 2018).
تقرير اللقاء من إعداد الباحث/ أحمد عبد الرحمن خليفة