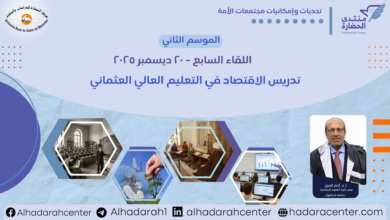الإسلام والمجتمع الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية
منتدى الحضارة 2 - اللقاء الرابع
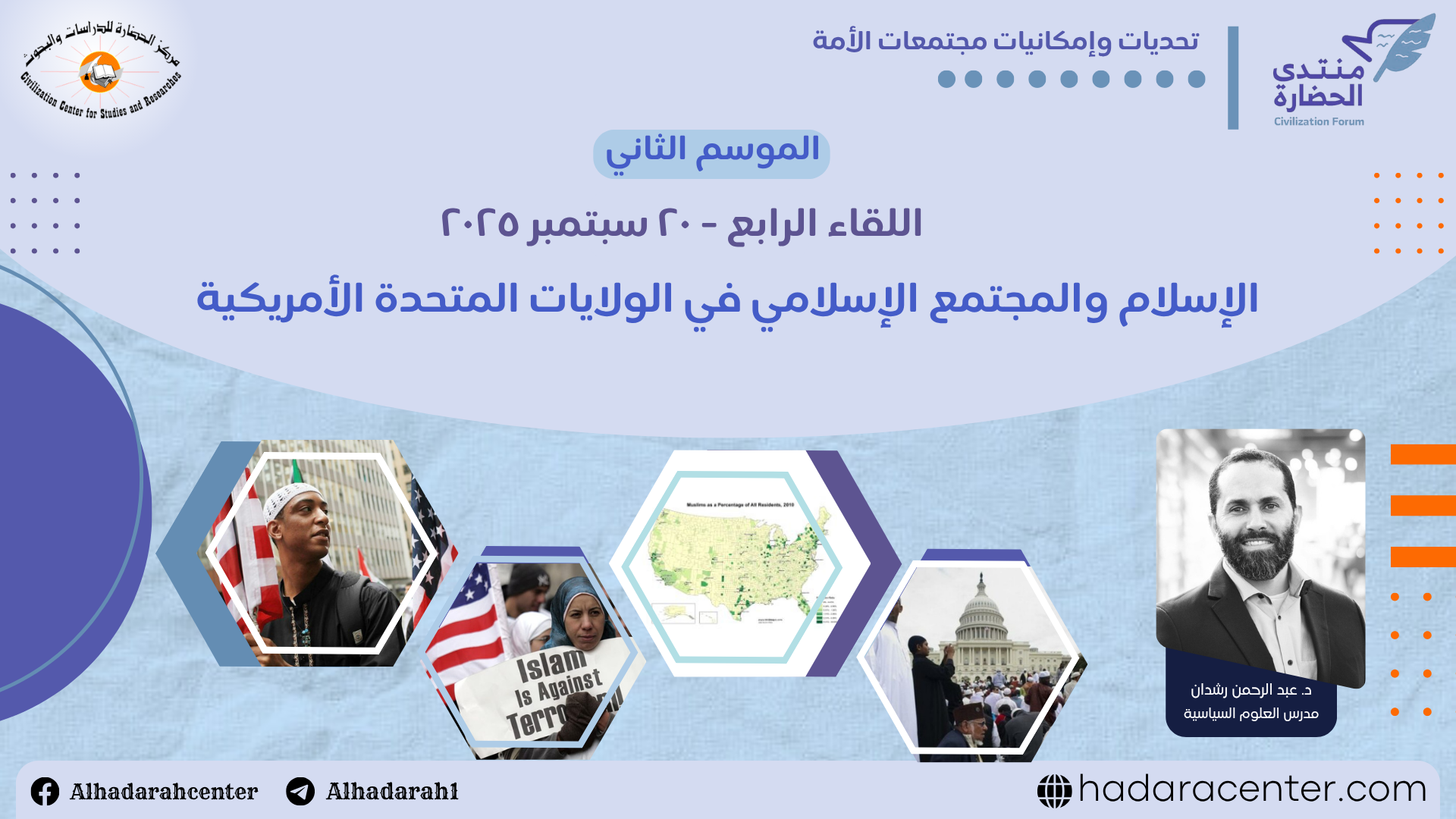
تقديم: (أ. د. نادية مصطفى ود. مدحت ماهر)
هذا هو اللقاء الرابع من منتدى الحضارة، تحت عنوان “الإسلام والمجتمع الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية”. فإذا كان اللقاء الماضي والذي سبقه عن ديار الإسلام أو المسلمين بوصفهم أغلبية في هذين البلدين، فإننا اليوم مع أحوال المسلمين في دولة لا يحظون فيها بالأغلبية من حيث العدد؛ في ديار كان يطلق عليها في الفقه “ديار الكفر” و”دار الحرب”. وكان الفقه الموروث يرى أن المسلم لا يقيم في هذه الديار، باعتبار أنها كانت مُفعَمةً بالمعنى الثقافي والديني بما يؤثر على إسلامه، فكان الفقه المتوارث أن للمسلمين ديارهم ولغير المسلمين ديارهم. وقد شهد القرنان الأخيران، وبالأخص النصف الثاني من القرن العشرين، تحولات كبيرة إما بسبب وقوع أراضٍ كانت في يد المسلمين تحت أيدي غير المسلمين مثل وسط آسيا، ولكن التحول الأبرز كان مع الحرب العالمية الثانية وهجرة المسلمين إلى بلاد غير مسلمة لأسباب سياسية واقتصادية أو تعليمية أو ثقافية. أقام هؤلاء الأفراد وتلك الجماعات ثمّ تحولوا إلى أجيال، ومعهم تطور الفقه ليحتوي هذه التطورات والمستجدات، ونشأ بذلك “فقه الأقليات المسلمة”.
والولايات المتحدة الأمريكية هي وريثة أوروبا في قيادة الغرب، فالذاكرة التاريخية والمعرفية عن الغرب أصبحت تربط بين أوروبا والولايات المتحدة. ومع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لها تأثير كبير في قضايانا الكبرى، وبخاصة القضية الأهم: القضية الفلسطينية، فإن للمسلمين في الولايات المتحدة قصة مهمة يجب النظر في شؤونها وفي قدرتهم على التأثير في هذه البلاد. ومن خلال الاطلاع على الإحصاءات المتعلقة بالمسلمين في الولايات المتحدة، يتضح حجم ما يتعرضون له من تحديات (وفتن)، تحتاج منا إلى فهم أوضاعهم والتعامل معها.
ومحاضر هذا اليوم هو الدكتور عبد الرحمن رشدان، باحث ومدرس العلوم السياسية، له ما يقرب من عقد من الخبرة في مجال التدريس والبحث وتقديم الاستشارات السياسية في المجال الأكاديمي. ود. عبد الرحمن حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة، ودرجة الماجستير في الشؤون الدولية من جامعة كولومبيا، ودرجة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وله أبحاث عديدة منشورة. كما يتبنى الدكتور عبد الرحمن منهجية تقوم على أن “الثقافة هي التي تشكل السياسة”، وينصب اهتمامه الأكبر على شؤون الأمة خاصة عبر مؤسسة “أمتكس”.
ومحاضرة اليوم تندرج ضمن مجال معرفي هو “الإسلام والغرب”، وهو ليس موضوعًا، ولكنه مجال معرفي متعدد المداخل، يدخله المهتمون بالسياسة والمستشرقون وأصحاب الرؤى الفقهية أو الثقافية المختلفة. وهي مساحة استراتيجية كلية، يمكن تفكيكها، ولكنها تُعامل ككتلة مصمتة في الغرب (على أنهم غرب، ونحن إسلام). ولمركز الحضارة اهتمام كبير بهذه المساحة، يمكن ملاحظته عبر الرجوع إلى موقعه الإلكتروني وإصداراته المتنوعة.
محاضرة د. عبد الرحمن رشدان (الإسلام والمجتمع الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية[1])
في البداية، أنطلق من مجموعة من التحيزات والخبرات المتراكمة عن المجتمع والإسلام والسياسة في أمريكا، والتي بدأت سياحةً في التسعينيات عندما زرت الولايات المتحدة، ثمّ بوصفي طالب ودارس في الجامعة الأمريكية، وصحفي عمل على شؤون المسلمين في أمريكا، وهي الفترة التي قمت خلالها بالعديد من المقابلات مع قادة المجتمع الإسلامي هناك، ثمّ الدراسة والتدريس في الجامعة في أمريكا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه؛ ليكون إجمالي ما عشته في أمريكا هو 12 عامًا. ومنذ عام 2016، انتقلت مع زوجتي للعيش في المجتمع الأمريكي، واكتسبت الجنسية الأمريكية. وأدركت حينها المجتمع إدراكًا نابعًا من المعايشة، إدراكًا للواقع تحت الضغوط، وبانخراطي في هذه المراحل في النشاط المجتمعي وقطاع العقارات، تنقلت بين 4 ولايات بالإضافة إلى زيارات لولايات أخرى.
وأمريكا مجتمع كبير، يُحدد مكان وقوفك مد بصرك وما يمكن أن تراه، والولايات فيها مختلفة الأنماط، وداخل كل ولاية مجتمعات متباينة، ومن ثمّ لا يمكن من واقع المشاهدات والملاحظات فقط وصف المجتمع ككل، وإنما لا بد من الاعتماد على الدراسات والبحوث الميدانية والأكاديمية لتقديم رؤية أوسع للواقع. وانطلاقًا من التحيزات السابقة، سيكون هناك تركيز أكبر على سلبيات المجتمع الإسلامي في الولايات المتحدة. أما النقاط التي تتناولتها المحاضرة فهي:
- من هم المسلمون في أمريكا؟
- الأولويات
- التحديات
- إشكالية الهوية لدى النشء
- نضوج الهوية عبر الأجيال
- تربية وحراسة الهوية الناضجة
- تفعيل الدور في العالم الإسلامي
أولًا: من هم مسلمو الولايات المتحدة؟
بداية التواجد الإسلامي في أمريكا كانت مع تجارة العبيد الأفارقة ونقلهم إلى الولايات المتحدة، وقد وصل عددهم خلال ثلاثة قرون (السابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر) إلى ما بين 600 ألف و1.2 مليون مسلم، ولا تزال آثارهم باقية في الولايات المتحدة. وبعد انتهاء العبودية، أخذ وضع المسلمين شأنًا آخر، كان مع تأسيس أول مسجد للمسلمين في ولاية أيوا عام 1915 (سُمي بالمسجد الأم). كما ظهرت حركة “أمة الإسلامNation of Islam ” بوصفها من أوائل الحركات الاجتماعية المسلمة التي ظهرت في الولايات المتحدة. ثمّ جاءت مرحلة رئيسية في تواجد المسلمين مع قانون الهجرة والجنسية الصادر عام 1952 وتعديلاته عام 1965، الذي سمح للمهاجرين أن يأتوا من مناطق مختلفة من العالم.
ومع هذا القدوم، أسَّس المسلمون جمعيات ومؤسسات إسلامية، من أهمها -والتي لا يزال لها حضور في المجتمع- رابطة الطلاب المسلمين (MSA – 1963)، والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA – 1982)، والدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية (ICNA – 1968)، والجمعية الإسلامية الأمريكية (MAS – 1993)، وأخيرًا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR – 1994). وتُعد الأخيرة من أهم المنظمات المعنية بالحقوق والحريات والجانب القانوني للمسلمين في أمريكا. وأخيرًا، كان أحدث تطور هو دخول المسلمين لمناصب سياسية على مستوى البلديات والولايات وحتى المستوى الفيدرالي، ومن نماذج أعضاء الكونجرس المسلمين: رشيدة طليب وإلهان عمر.
ويتوزع المسلمون في مناطق كثيرة في الولايات المتحدة، ولكن التواجد الملحوظ لهم (كمجتمعات كبيرة) والذي يظهر في الزي والمطاعم والمحلات التي تبيع الحلال، وتتجلى فيه ثقافة المجتمع سواء أكانت عربية أم باكستانية أم غيرها، يوجد في نيويورك الكبرى، وميتشيجان، وشيكاغو (إلينوي)، ونيوجيرسي، وهيوستن (تكساس)، ولوس أنجلوس (كاليفورنيا). وتتحول فيها أحياء بالكامل إلى عربية أو باكستانية، وربما لا يعرف القاطن فيها اللغة الإنجليزية، حتى إن هناك حيًّا في نيويورك يُطلق عليه “القاهرة الصغيرة”.
وتوضح الخريطة التالية تعداد وتوزيع المسلمين في الولايات الأمريكية.
ملاحظات على الخريطة:
- كلما زادت حدة اللون الأخضر، عنى ذلك نسبة أكبر من المسلمين.
- علامات النجوم الحمراء هي الولايات المتأرجحة والمهمة في تحديد نتائج الانتخابات الأمريكية، ومعظمها يوجد فيها مسلمون بكثافة.
وتوجد تقسيمات فرعية مختلفة للمسلمين في أمريكا. فمثلًا، حسب الجنسية والمولد، نجد أن نصف المسلمين الموجودين في الولايات المتحدة (حسب إحصاء 2017) وُلدوا داخل أمريكا، بينما يحمل 36% الجنسية ولكنهم لم يولدوا فيها، ويعيش 14% فيها كمهاجرين لا يحملون الجنسية.
وعلى أساس الأصل أو العرق، ينقسم المسلمون إلى فئات منها: مَن هم من أصول أفريقية (وهم الأكثرية من حيث النسبة)، والبيض (وغالبًا ما يُضم العرب معهم)، والآسيويون، وذوو الأصول الهندية. أما عن تعداد المسلمين في أمريكا، فلا يوجد إحصاء رسمي للدين في التعداد الأمريكي، ما يصعِّب التقدير. كذلك فإن الاستطلاعات تعاني من ضعف العينة وتردد الأفراد في الإفصاح عن إسلامهم، كما أن المسوح المؤسسية تميل للمبالغة لاقتصارها على الممارسين النشطين. فمركز بيو للأبحاث يقدم تقديرًا منخفضًا (3.5-3.8 مليون) بسبب ضعف العينة وتحيز المسح، بينما شخصيات مثل د. إحسان باغبي يقدِّمون تقديرًا مرتفعًا (7-9 مليون) لاعتمادهم على أعداد المساجد وحضورها.
وما يمكن قوله إن العدد الحقيقي الأقرب أن يكون بين التقديرين، أي بين (3.5 مليون و9 مليون) حسب منهجية البحث وتعريف “المسلم”.
ويشير التوزيع العمري للمسلمين إلى أنهم من أكثر الفئات شبابًا داخل الولايات المتحدة، إذ تبلغ نسبة من أعمارهم بين 18 و24 عامًا حوالي 23% من المسلمين. كما تظهر البيانات أنهم من أكثر الفئات في معدل الإنجاب بين الأمريكيين، حيث يصل المعدل إلى 2.4 طفل لكل أسرة، بينما هو 2.1 طفل لكل أسرة أمريكية.
كما توضح الاستطلاعات أن أولويات المسلمين هي ذاتها أولويات الأمريكيين بصفة عامة. فلدى المسلمين تحديات اقتصادية تتعلق بإيجاد فرص عمل وتدني الدخل، تليها تحديات تتصل بالحريات المدنية والرعاية الصحية. وبالتالي، وفقًا للإحصاءات، لا يوجد تفاوت كبير بين ما يهتم به المسلمون وما يهتم به المجتمع الأمريكي، وهو ما يتجلى في تدني الاهتمام بالسياسة الخارجية بالنسبة للمسلمين الأمريكيين، الأمر ذاته الذي ينطبق على مجمل المجتمع. فالأولوية إذن، هي المعيشة بكل تفاصيلها، وبما يضمن العيش بحرية، في حماية من العنصرية، مع ممارسة الدين، وعيش حياة متزنة.
ثانيًا: أهمية الدين في حياة المسلمين في أمريكا وتحديات المجتمع الإسلامي
تظهر الاستطلاعات أن 42% فقط من المسلمين يرتادون المسجد مرة أو أكثر أسبوعيًّا، ولكن يعتقد 87% من المسلمين في أمريكا أن الإسلام مهم في حياتهم. أما فيما يتعلق بموقفهم من كون الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع في أمريكا، فيرى 12% منهم أنها يجب أن تكون المصدر الأساسي للقانون، و33% يرون أنها يجب أن تكون مصدرًا من المصادر، بينما يرى 51% أنه لا يجب أن تكون لها علاقة بالقانون الأمريكي. يشير هذا إلى أن أهمية الدين في الحياة العامة للمسلمين ليست مرتفعة جدًّا، وهذا هو منطق التفريق بين “المجتمع المسلم” و”المجتمع الإسلامي” الذي يهتم بالإسلام في كافة تفاصيل حياته، ويواجه مجموعة من التحديات، منها:
- انتشار قيمة الفردانية: وهي تصعِّب من مهمة الوالدين في التربية؛ لأن أبناء المسلمين الذين تربُّوا ووُلدوا في هذه البيئة متأصِّلة فيهم قيم الفردانية، فيكون ردُّهم على أي توجيه تربوي هو: “أنا مواطن ولي حقوق”. وكذلك، يصبح الاهتمام بالآخرين أو المصالح العامة أمرًا لا يعنيهم، بل هو من تدبير الحكومة.
- التعارض بين القانون والشريعة: في حالات الطلاق مثلًا، يحدث خلاف ولا يتم الرجوع إلى الشريعة أو القبول بأحكامها، لأنها في النهاية غير ملزمة أمام القانون، وهو ما يدفع الزوجات للجوء إلى القانون وليس الشريعة.
- النظام المالي المخالف للشريعة: شراء منزل وسيارة من الأمور الأساسية في أمريكا لاتساع الولايات، وهذه الأمور لن تكون ميسرة إلا عن طريق القروض الربوية، وتندر الخيارات غير الربوية جدًّا. حتى إن بعض الجهات التي تُقدم نفسها على أنها غير ربوية لم يعتمد منها مجمع فقهاء أمريكا الشمالية إلا مؤسستين (Guidance, UIF)، وذلك في حالات الضرورة والحاجة فقط! وهذا يجعل شراء البيت صعبًا جدًّا على المسلمين، وتأثيره على استقرارهم كبير جدًّا، مما يجعل بعض العلماء والفقهاء يجيزون التعامل مع البنوك الربوية حتى يستقر المسلمون في بيوت ويستطيعون بناء مجتمعات مستقرة، ويبقى لهم تأثير في المجتمع؛ لأن حياتهم تحت الإيجار هي حياة مؤقتة تستلزم الانتقال المستمر، فيكون هناك مفسدة على المسلمين إجمالًا وتأثيرهم. وهذا التحدي ينسحب على كافة المعاملات المالية.
- المراقبة الحكومية والحريات المدنية: حتى وقت قريب (قبل 10 سنوات تقريبًا)، كان يُفرض على أئمة المساجد التعاون مع الجهات الأمنية وكتابة تقارير عن المسلمين. كان هذا شيئًا معتادًا، وهو ما كان يفتت المجتمعات من الداخل ويحد من الدعوة داخل المساجد.
- العنصرية: لا توجد إحصائيات تربط لون بشرة المسلم بحالات الاعتداء، لأن المسلمين يتعرضون للاعتداء لأمرين: لكونه مسلمًا، ولكونه ملوَّنًا. فمثلًا، المسلم اللبناني قد تكون حالات الاعتداء عليه أقل من المسلم السنغالي.
- الدين وفرص العمل: مثلًا، فرص المحجبات في الحصول على عمل أقل بنسبة 40% بسبب الحجاب فقط. والمسلمة غير المحجبة فرصتها أعلى من المحجبة، وطبعًا غير المسلمة فرصتها أعلى بكثير من المسلمات. يرى 57% من الأمريكيين أن القيم الإسلامية تتعارض مع الطريقة الأمريكية في الحياة، ورغم أن هذه النسبة قلَّت كثيرًا عن السنوات الماضية، فإنها تشير إلى وجود حالة عداء أو ارتياب في المسلمين وقيمهم. ولذلك، تظهر الإحصائيات أن 62% من المسلمين يتعرَّضون لحالات الاعتداء والتمييز ضدهم (وهي الأعلى بين الديانات الأخرى).
- تحديات نفسية: خاصة للمهاجرين الجدد، وبالأخص لدى النساء، وهي حالة الانبهار بالغرب، تحديدًا في سنواتهم الأولى، حيث يكون الجانب المادي أولوية لديهم. عندما يرون الجانب الظاهر فقط من حياة الأمريكيين، تتكون لديهم قناعة بأن الحجاب أو النقاب أو الإسلام هو الحاجز أمام الانخراط في هذا المجتمع وتجاوز العنصرية. فيتحول الانبهار إلى دونية، ويحدث تغيير في الأسماء “المسلمة” إلى مقابل أمريكي: إسماعيل يصبح “سام”، ومحمد يصير “مو”. كان لي تجربة شخصية حينما كنت أعمل في العقارات وقمت بإعلان عن منزل في جورجيا باسم “عبد الرحمن”، لم نتلق أي تواصل لمدة 3 أسابيع، ولكن فور تغيير الاسم إلى “مايك” انهالت الطلبات علينا وتم تأجير المنزل.
- تحديات الزواج واستمراره: كلاهما يمثل تحديًا. إذ تشير إحصائية إلى أن 35% من المسلمين الأمريكيين عُزَّاب لم يسبق لهم الزواج. وأتوقع أن 90% من هذه النسبة هم من النساء؛ ذلك أن المرأة المسلمة الأمريكية لا تملك خيار الزواج من غير المسلم، في حين أن الرجل المسلم لديه هذا الخيار. وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي 15% من الرجال المسلمين في أمريكا يتزوجون من غير المسلمات. هذه بحد ذاتها مشكلة. إذن، الزواج بحد ذاته يمثل تحديًا، وعندما يتم، فغالبًا ما يكون ضمن نفس العرقية أو الأصل. لذا، فإن خيارات المرأة المسلمة ضمن المجتمع المحلي محدودة للغاية، وهذا يسبب مشكلة كبيرة. ومن آليات الحل المطروحة: إنشاء مجموعات عبر الإنترنت، ودور إمام المسجد، وقواعد بيانات للراغبين في الزواج. وهذا الأمر مرهق جدًّا. وعندما يتم الزواج، كم زيجة تستمر؟ أظن أن هناك إحصائيات لاحقة عن معدلات الطلاق، لكن الإحصائيات هنا تشير إلى 6%، وأظن أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك، فبعض حالات الطلاق تتم رسميًّا في المحاكم، وبعضها يتم في المسجد فقط ولا يصل إلى المحاكم لأسباب قانونية.
ثالثًا: تربية النشء وعلاقته بترك الإسلام
هذا موضوع بالغ الأهمية، لأن الجيل الناشئ الآن هم قادة المجتمع بعد عشرة أو خمسة عشر عامًا. وهذا الطرح هو بناءً على رؤيتي وخبرتي وليس دراسة.
في البداية، أوضح أن البيئة الحاضنة للنشء، من وجهة نظري، تتألف من: الأسرة، والمسجد، والمدرسة. أما البيئة المضادة التي نحارب ضدها، فهي التيار العام والثقافة الأمريكية، والقيم والقواعد السائدة في المجتمع الأمريكي بشكل عام، والدولة بقوانينها. ففي بعض الأوقات، تكون الدولة محاربة للأسرة وقيم الأسرة وقيم الإسلام.
لنبدأ أولًا باقتباس قالته الدكتورة ياسمين مجاهد، وهي شقيقة الدكتورة داليا مجاهد، وهي من كبار الباحثات المصريات اللاتي عملن في مجال الإحصاءات؛ فمعظم الإحصائيات التي تُجرى في أمريكا عن المسلمين عملت عليها الدكتورة داليا مجاهد في مركز “بيو (Pew)، وياسمين مجاهد هي من كبار الأصوات النسائية في المجتمع الأمريكي.
قالت ياسمين مجاهد ذات مرة كلمة أثَّرت فيَّ كثيرًا: “جئت إلى هنا أبحث عن الذهب فخسرت الألماس”، وتقصد بذلك أبناءها. هذا أمر طبيعي ومتكرر؛ فالمسلم الذي يهاجر إلى أمريكا يبحث عن المال ورغد العيش، أو على الأقل عيش كريم يتمكَّن فيه من ممارسة الحريات المدنية والسياسية. ولكن في سبيل ذلك، قد يخسر أهم ما يملك وهو الأولاد.
(أ) الأسرة: البيئة الحاضنة الأولى للنشء
الأسرة في أمريكا هي غالبًا إما أسرة نووية (صغيرة) أو أسرة ممتدة، لكن لا يخفى عليكم، أن الأساس هو الأسرة الصغيرة المكونة من الأب والأم والأولاد، هي الغالبة على معظم الأسر المسلمة. ومع ذلك لم أجد إحصائيات مفصلة تتحدث عن الأسر الممتدة مقابل الأسر النووية بين المسلمين. ولكن من خلال المشاهدات، يغلب طابع الأسرة الصغيرة (النووية). وتعاني هذه الأسرة من مجموعة إشكاليات:
- التنقل المستمر وغياب الأسرة الممتدة:
ذلك لأن طبيعة العمل في أمريكا يتطلب التنقل بين الولايات، ومن السهل جدًّا على الفرد أن ينهي الجامعة ثم يجد عملًا في ولاية أخرى، أو حتى يسافر للدراسة في جامعة بولاية مختلفة. فتجد كثيرًا من الأسر يتفرق أبناؤها في ولايات مختلفة. لذلك، فإن جمع أسرة ممتدة من أعمام وعمات وأولادهم في مكان واحد يصبح صعبًا جدًّا، ويتطلَّب أن يكون لديهم عمل مستقر في ولاية واحدة وألا يحتاجوا للانتقال بحثًا عن سكن أو معيشة.
- دور الزوجين والمساواة في القانون الأمريكي: الطاعة والقوامة
يتعلق هذا الأمر بدور الزوجين في الأسرة، ومشكلة المساواة والقوانين. يركز المجتمع الأمريكي بثقافته على المساواة والفردية؛ حيث تُعامل المرأة على قدم المساواة مع الرجل. من المتوقع والطبيعي (لكنه قد يكون مستغربًا لدينا) أن يكون لكل زوجين حساب بنكي مشترك واحد، حيث يضع كل منهما راتبه فيه ويصرفان منه معًا. فعندما أذهب لأشتري شيئًا وأُسأل عن حسابنا المجمع ولا أمتلك واحدًا، يعتبر ذلك أمرًا مستغربًا جدًّا. فالذمة المالية عندنا منفصلة، بينما في المجتمع الأمريكي، الذمتان مرتبطتان. لذلك، يُتوقع من المرأة أن يكون لها دور في الإنفاق المنزلي شأنها شأن الرجل. هذا الإنفاق قد يسحب قليلًا من قدرة الرجل على قيادة المنزل أحيانًا، لأنه قد لا يرى لنفسه وجهًا في القيادة إذا لم يكن هو القائم الوحيد على الإنفاق.
وينسحب على ذلك أيضًا مسألة طاعة الزوج، حتى المسلمات الأمريكيات، سواء كن من أصول عربية أو باكستانية (وهما أكبر الجاليات المسلمة في أمريكا)، وقد تربين في الثقافة الأمريكية، نرى لديهن نفورًا من طاعة الزوج. وهذا ينبع من منطلق الفردانية، ومن منطلق “أنا إنسانة ولدي حقوق”. وتُعتبر العلاقة الزوجية كشركة؛ “أنا أضع في هذا البيت جهدًا ومالًا مثلك تمامًا، فما هو وجه الطاعة المطلقة؟”. وقد رأينا هذا الأمر في حالات كثيرة جدًّا من الطلاق والخلافات.
ويُعتبر هذا الأمر أشبه بالفيروس، ففي غياب التربية والتنشئة الإسلامية السوية، وغياب الفهم من الزوج وقدرته على تحمل المسؤولية (بألا يدع زوجته تدفع أي شيء في البيت إلا برضاها وكمساهمة منها وليس كفرض عليها)، فإن الأمر يحتاج إلى معالجة عميقة.
- قوامة الوالدين على الأبناء أو تدمير الأسرة عبر القانون!
في التربية الأسرية للمسلمين في الولايات المتحدة تظهر مسألة قوامة الوالدين على الأولاد. في أمريكا، من يرفع يده على ابنه يُسجن مباشرة. القضية هنا هي من سيُبلِّغ؟ حدث أمر في مجتمعنا: رجل بوسني، كانت زوجته مريضة في المستشفى أو ما شابه، فاعتنى بأولاده. وكانت هناك مستشارة اجتماعية في المدرسة لديها نفور (أو كراهية) خاصة تجاه المهاجرين المسلمين، فكانت تتابع الولد. في إحدى المرات، كان الولد يذاكر في البيت بجانب الطاولة، فغضب منه والده وضربه، فارتطم سن الولد بالطاولة وانكسر. في اليوم التالي، ذهب الولد إلى المدرسة، فسألته المستشارة الاجتماعية عما حدث، فأخبرها بالواقعة. على الفور، حضرت الشرطة إلى المنزل، واقتادت الأب ووضعته في الحجز (السجن)، وذهب الولد إلى أسرة بديلة غير مسلمة. واضطر الأب إلى اقتراض 20,000 دولار ليخرج نفسه مؤقتًا (بـ “بيل” أي كفالة) ليتمكن من المثول أمام المحكمة لاحقًا ومحاولة استعادة ابنه. هذا موقف صغير جدًّا يشير إلى الحضور الغائب للدولة في منزل المسلم في الغرب؛ فالدولة موجودة في تفاصيل الحياة اليومية. القضية فقط من سيُبلِّغ من أفراد الأسرة ليطالب بحقه وفق القانون الأمريكي، وهذا يزيد من تصدع العلاقات داخل الأسرة، لأن القانون يسمح بذلك. فلو ضربت ابني، وإذا عرف ابني أن هناك قانونًا يقف معه، فقد يرفع السماعة وهو في حالة غضب، وبذلك تنتهي الأسرة! الأمر نفسه ينطبق على ضرب الزوجة.
ذكر الدكتور صلاح الصاوي، وهو رئيس “AMJA” (مجمع فقهاء أمريكا الشمالية)، كلمة قيمة جدًّا في المؤتمر الأخير حول حال الأسرة في عام 2024. “كان من معالم الفقه ألا تُقطع الأيدي في الغزو، وألا تُقام الحدود في أرض العدو؛ لكي لا تُدرِك من تُقام عليه الحدود حمية الشيطان فيلتحق بمعسكر الكفار”. يعني في حالة المعيشة في بلاد غير المسلمين، لو طبقنا الشريعة وطبقنا الحدود، فإن ذلك قد ينفِّر المسلم خارج الشريعة ويجعله يلتحق بالمعسكر الآخر، الذين قد يراهم أكثر عدلًا من تطبيق الشريعة الإسلامية بالنسبة لبعض المسلمين.
هذا يفسر كثيرًا من حالات الخروج من الإسلام بين النشء. العنف المنزلي الذي نعتبره في المجتمعات العربية والباكستانية (اللتان تمثلان أكبر جاليتين في أمريكا) أمرًا عاديًّا، حتى الضرب الخفيف لتأديب الولد، يُعتبر في الإطار الأمريكي خطًا فادحًا.
وتشير الإحصائيات إلى أولويات المسلمين في حياتهم: هل هي أن نكون “Good parents” (آباء صالحين)، أم المال (الجانب المادي والمعيشي)، أم عيش حياة دينية، أم أن نكون متاحين؟ أعلى رقم لدى المسلمين هو 67% لأولوية “أن أكون أبًا صالحًا”، ولكن تعريف “الأب الصالح” يعتمد على الثقافة التي جاء منها.
هذه الاختلافات قد تؤدي أحيانًا إلى تدمير الأسرة بسبب تدخل القانون. أنا طبعًا لا أقول إن ضرب الأولاد أو ضرب الزوجة أمر جيد، لكني أقول إن تدخل الدولة في داخل المنزل أمر مدمر، ويجب معالجة هذه الأمور عن طريق إمام المسجد مثلًا أو جهة مختصة، بحيث لا تتدخل الدولة ولا تُدمر الأسرة بسبب مخالفة للقانون!
علاقة الأزواج وتأثيرها على استقرار الأسرة، قريب مما ذكرتُه سابقًا بخصوص العنف الأسري وضرب الزوجة أو العنف الزوجي عمومًا. إنها حالات نرى منها كلا الطرفين، والمجتمع يتسامح معها كونها أمرًا معتادًا، فالمجتمع المهاجر يعتبر هذا شيئًا عاديًا، حيث يرى البعض أن للرجل الحق في ضرب زوجته في بيته.
بينما يضع القانون معايير صارمة وعواقب قد تدمر الأسرة. وفي المقابل، إذا توجهت الزوجة إلى إمام المسجد، فغالبًا ما يقف الإمام مع الأعراف الاجتماعية وليس لديه القدرة على فعل شيء، أو أن خياره الآخر هو إبلاغ الشرطة وتدمير الأسرة. لذلك، فإنه غالبًا ما يصمت، أو إذا كان المجتمع متماسكًا بعض الشيء وكان الإمام قائدًا ذا نفوذ (كما سأتحدث لاحقًا)، فإنه يستطيع تحريك الأطراف الأخرى لمنع هذا السلوك.
ثم نأتي إلى تغيير أدوار النوع الاجتماعي (الجندر) الذي ذكرته سابقًا، وفكرة من هو القائد في المنزل. هل نحن متساوون في القيادة؟ أم أن الرجل هو القائد؟ وطبعًا هناك مشاكل فقهية أخرى لن أثقل عليكم بها، وقد عالجتها “AMJA”.
اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال وأثرها على القوامة: يجب أن تُفهم القوامة في إطار مختلف تمامًا في أمريكا عن فهمها في دولة ذات أغلبية مسلمة، حيث يدعم القانون مبادئ الشريعة الإسلامية. ومن القضايا المهمة هي الذمة المالية المنفصلة في العلاقة بين الزوجين في الغرب، وحق “الكد والسعاية” خارج إطار الرعاية الزوجية. أي: إذا اجتهدت الزوجة وعملت وشاركت في تكاليف المنزل، هل يعتبر هذا دينًا على الزوج أم لا؟ وإذا كان دينًا، فمتى يُطلب به؟ وهل الزوج مدرك لذلك، أم أنه يلجأ إلى القانون الأمريكي عندما تسوء الأمور وتخرج عن السيطرة، ثم يلجأ إلى الشريعة عندما يكون الأمر شيئًا آخر؟
- الطلاق وتعدد الزوجات بين الشريعة والقانون الأمريكي:
قد تؤدي إجراءات القانون المدني المتعلقة بالطلاق إلى مشكلات عدة في الأسرة، فمن المعلومات التي تحصل عليها المسلمات المهاجرات حديثًا هي فكرة أنه “إذا طلقت زوجي، يمكنني أن آخذ نصف ثروته”. وهذا في الأساس قد يدمر الأسرة قبل أن تبدأ، ففي حالة الهجرة أو عند الوصول إليها، يفكر البعض في الجانب المادي. تفكر المرأة أولًا، عندما يقتني زوجها منزلًا، “ربما أستطيع أن أطلقه وآخذ نصف المنزل لأعيش حريتي وأحقق الحلم الأمريكي”. وهذا أمر يدمر الأسر. وبالطبع، كل هذا يؤثر على الأطفال، وكذلك حالات الطلاق.
أما التعدد (تعدد الزوجات) هو أمر غير قانوني في أمريكا ويُعاقب عليه بالسجن حسب الولاية. لكن المسلمين الذين يرغبون في التعدد في أمريكا يضعونه في إطار “الصديقة”. فلو سُئل الرجل من الشرطة وقال: “هذه صديقتي وليست زوجتي”، فإن الأمر ينتهي عند ذلك ولا توجد مشكلة، خاصة إذا كان المسجد قد أجرى زواجًا عرفيًّا. وبالتالي، لا يوجد أي إثبات على أنها زوجته. وقد تسبَّبت حالات الزوجة الثانية في طلاق واحدة من كل سبع حالات (زيجات).
- تأثير كل ذلك على الأطفال:
ما هو تأثير الثقافة الوافدة التي يأتي بها معظم المسلمين ويستقرون بها في أمريكا على أبنائهم؟ هل هذا سبب لخروجهم من الإسلام أم لا؟ فالإسلام النقي الذي يراه الناس هو عبارة عن شعائر وعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. بينما هناك أمور ثقافية أخرى يفرضها الأهل الذين قدموا من دول مختلفة، ويقولون إنها جزء من الإسلام، في حين لا يراها الأبناء كذلك. وهكذا، يتشكَّل “الإسلام في الثقافات” مقابل “الإسلام النقي”. وفيما يلي نماذج واقعية على ذلك:
- مكرَّم، على سبيل المثال، وهو من خلفية فلسطينية، يقول إن ممارسات عائلته الإسلامية مربوطة بالثقافة بشكل أساسي. على سبيل المثال: بعد صلاة العيد، يُعتبر من الضروري زيارة الأجداد. فالأهل يرون هذا جزءًا من الدين. يصبح الأمر جزءًا من الفكر، وعندما يحدث الصراع بين الاثنين (الدين والثقافة)، قد يربط الولد الثقافة بالدين، وبالتالي يترك الدين كلِّيًّا من باب قهر الأهل على تطبيق ما يرونه في الأساس ثقافة.
- هيذر، وهي أمريكية بيضاء مسلمة، والمسلمون البيض غالبًا ما يتميزون بـ “النقاء”، أي إنهم يمارسون الإسلام بعيدًا عن التأثيرات الثقافية مقارنة بالمسلمين المهاجرين. ذلك أن المهاجرين يدخلون الإسلام مع خلفية ثقافية مسبقة، بينما البيض لا تكون لديهم هذه الخلفية الثقافية، بل ثقافتهم قد تكون مخالفة للإسلام، فيتركون ثقافتهم ويلجأون إلى الإسلام. هؤلاء يستقيمون على الإسلام ومبادئه الأساسية. وهناك نقاش حول الرؤية للإسلام. فهي تقول إن المسلمين الأمريكيين غير المهاجرين يميلون إلى التركيز أكثر على المبادئ الجوهرية للإسلام والعودة إلى جوهره، على عكس الطرق التقليدية ذات الطابع الثقافي في ممارسة الدين. وأرى أن غير المهاجرين يُعيدون الإسلام إلى كونه أسلوب حياة مميزًا عن الممارسات الثقافية.
(ب) المدرسة وتربية النشء في الولايات المتحدة:
هي الكارثة بحق! وسنوضح ذلك فيما يلي: بدايةً، التعليم للمسلمين في أمريكا يتبع ثلاثة أنماط رئيسية: التعليم الحكومي، والتعليم المنزلي، والتعليم الإسلامي.
- التعليم الحكومي:
هو في الغالب مجاني تقريبًا، أي بدون تكاليف مادية تُذكر. ومن لا يستطيع دفع التكاليف المادية، تتكفَّل به الدولة، وهو أمر مغرٍ اقتصاديًّا جدًّا. ولكن، يقع العبء الكامل لتأمين الهوية الدينية للطفل على عاتق الأهل. ومعظم الأسر يعمل فيها الأب والأم، مما يعني عدم وجود وقت كافٍ لتخصيص التربية الدينية للأطفال. لذلك، يستقر الأمر على المسجد، حيث يُرسل الأطفال إلى مدرسة الأحد بالمسجد. ويُتوقع من المسجد أن يقوم بدور التربية الإسلامية من الألف إلى الياء. وهذا هو الحال في معظم الأسر المسلمة التي تُلحق أبناءها بالمدارس الحكومية، إلا إذا كان المستوى الاجتماعي أو المادي للأسرة عاليًا بعض الشيء، فيتوفر لديهم الوقت الكافي للتعامل مع الأبناء أو يكون وعيهم أعلى.
يوجد تضارب منهجي مع الالتزامات الدينية؛ فالثقافة الجنسية أصبحت أمرًا منتشرًا جدًّا؛ حيث يتم تعليم الأطفال في المرحلة الابتدائية مناهج الثقافة الجنسية بتفاصيلها. فالطفل الذي لا يعلم شيئًا عن الجنس يتم تعليمه، ويُلفت انتباهه إلى هذه الأمور. وفي الجانب الآخر، لدينا طلاب غير مسلمين يعتبرون ممارسة الجنس في سن صغيرة في المرحلة الابتدائية أمرًا غريبًا، لكنه بدأ ينتشر. لصديقي ابن يبلغ سبع سنوات، طلبت منه فتاة سنها تسع سنوات ممارسة العلاقة!
ترى الحكومة الأمريكية أن الوعي الجنسي في سنٍّ مبكرة أفضل، وأن العلاقات الجنسية تبدأ مبكرًا. وهذا بالطبع كارثة للمسلمين، لأنه في بعض الأحيان لا يُتاح للأهل سحب أبنائهم من هذه المحاضرات لأسباب قانونية. وحتى لو أوقف الوالدان ابنهما واستمعا إليه، فما هي قدرة الوالدين ونضجهما على فهم هذا الأمر بشكل منضبط وسحبهما من هذه البيئة، مع بقائه في المدرسة؟
أمر آخر في التعليم الحكومي هو جودة التعليم والجو التعليمي حسب المناطق. ففي بعض المناطق، تكون المدارس متدنية المستوى للغاية، تنتشر فيها المخدرات والعلاقات [المحرمة]، وتنتشر فيها العنصرية، وعدم وجود نظام صارم في التعامل مع الأولاد. بينما توجد مدارس أخرى منضبطة تقل فيها هذه السلبيات. ولكن طبعًا، هذا النمط من المدارس يوجد في المناطق ذات المستوى الاجتماعي العالي، لأن المجتمع المحيط بها ينفق على المدارس. وبالتالي، فإن معظم المدارس في المناطق الفقيرة تكون متدنية المستوى، بينما تكون المدارس في المناطق الغنية أفضل في انضباطها.
الإحصائية تتحدث عن العنصرية والتنمر (Bullying) في المدرسة، سواء باللفظ أو بالفعل. تشير إحصائية عام 2017 إلى أن المسلمين كانوا أكثر الفئات عرضة للتنمر في العام السابق. فـ 42% من الأطفال المسلمين، من سن الحضانة إلى الثانوية، تعرضوا للتنمر في المدارس الحكومية. الحديث هنا عن المدارس.
- التعليم المنزلي (Home Schooling)
هذا خيار يتم تداوله بين المجتمعات، ما بين “هل نُدرس في المنزل أم نُلحقهم بالمدارس؟”. التعليم المنزلي يزداد عمومًا في أمريكا. وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى زيادة نسبة التعليم المنزلي في أمريكا، حيث بلغت 3.4% من الأمريكيين بشكل عام يتبعون هذا النمط. السبب الأبرز لذلك يتعلق ببيئة المدرسة. فالسبب الأعلى للتوجه إلى التعليم المنزلي هو بيئة المدرسة، ومن الأسباب الرئيسية هو الجانب الأخلاقي (Moral)، أي ما يتعلق بالدين أو بالمبادئ التي تُدرس في المدرسة. المشكلة هنا هي أنه يتطلب تفرغًا من الأم أساسًا. فالأم لا يمكنها أن تعمل وتُدرس لأولادها في نفس الوقت، لذا يجب أن تكون الحالة الاجتماعية تسمح للأم بالتفرغ. وحتى لو تفرغت، هل تملك الأم الوعي الكافي والقدرة على التعليم في المنزل؟ وإذا تم ذلك، فإنه قد يؤدي إلى عزلة للأولاد. فالأطفال في التعليم المنزلي يقضون وقت التعليم كله في المنزل، إلا إذا انخرطوا في مجتمعات تجمعهم في مناطق معينة ويقومون بالدراسة خارج المنزل. هذا الأمر يتطلب تنسيقًا عاليًا ويعتمد على البيئة التي يعيشون فيها. لذلك، لا يُعتبر حلًّا جوهريًّا.
- التعليم الإسلامي (المدارس الإسلامية)
الحل المفترض للمسلمين في أمريكا هو المدرسة الإسلامية. فمع أهميتها، نجد أن عدد الطلاب المسلمين الملتحقين بها قليل جدًّا. فمن إجمالي عدد المسلمين في أمريكا (الذي يتراوح تقديراته بين 4 ملايين و9 ملايين)، يوجد فقط ما بين 26,000 و35,000 طالب في المدارس الإسلامية، التي يبلغ عددها الإجمالي 235 مدرسة إسلامية. المشكلة في المدارس الإسلامية، والسؤال الرئيسي هنا: هل هي ملاجئ آمنة للأطفال؟ أم هي جيتوهات دينية؟ أم هي نوع من الفقاعة التي نضع فيها الأولاد، متخيلين أنهم سيتلقون التعليم الديني مع التعليم الأكاديمي/المدرسي ويخرجون مها أشخاصًا أسوياء؟ المشكلة في المدارس الإسلامية (وهذا أمر قد تفاعلت معه كثيرًا، وزوجتي تعمل في مدرسة إسلامية منذ حوالي ثماني سنوات، وقد ذهبت أنا شخصيًّا إلى مدرسة إسلامية عندما كنت صغيرًا وإلى مدرسة حكومية كذلك، وأولادي دخلوا مدارس حكومية، وابني التحق بكليهما، حكومية وإسلامية) هي:
- ازدواجية المنهج: يجب على المدارس الإسلامية أن تلتزم بالمنهج الحكومي، ثم تضيف عليه المنهج الإسلامي. وهذا يمثل عبئًا إضافيًّا على الأطفال وعلى المدرسين، كما يجد الابن نفسه بين تناقض المنهجين. فالمناهج لا تتكامل مع بعضها. فمناهج التعليم الحكومي ومناهج التعليم الإسلامي لا تختلطان، فيذاكر الولد شيئًا معارضًا للإسلام أحيانًا، ويذاكر شيئًا متوافقًا مع الإسلام. وقد لا يكون المدرس مدركًا لكيفية الربط بينهما.
- غياب تطوير المناهج: لا يوجد تطوير في مناهج المدارس الإسلامية. فالمفترض أن يُنظر إلى المنهج الدراسي كله من رؤية إسلامية مختلفة، ترى عزَّة المسلمين وتاريخهم، وتضع أمثلة للقدوة. فكما يرى الولد “مارتن لوثر كينج” كقائد في أمريكا، يجب أن يرى قيادات إسلامية أو أمثلة من التاريخ الإسلامي يمكنه الاقتداء بها. وفي العلوم مثلًا: يمكن أن نُدرس لهم تاريخًا إسلاميًّا، ولكن ما هو التداخل بين الإسلام والعلوم؟ هل يوجد منهج للعلوم من وجهة نظر إسلامية؟ ليس فقط أن يخبرنا بمن هم العلماء المسلمون، بل كيف نفكر في العلوم من منطلق إسلامي. فهذه الأمور غير متطورة بالصورة الكاملة.
- الموارد والتمويل: هذا أمر أساسي، لأن المدارس الإسلامية مصروفاتها عالية. وهي تصرف على رواتب المدرسين، والمدرسون يتقاضون رواتب متدنِّية، لأنه لا يمكن للمدارس رفع المصاريف على الأهالي. وعندما تكون رواتب المدرسين متدنِّية، فإن المدرسين الذين يعملون في المدارس الإسلامية لا يكونون مؤهلين تأهيلًا كاملًا. وكثير منهم، أو معظمهم، في رياض الأطفال (في الولايات المتحدة هنا)، غير مؤهَّلين ولا يملكون شهادات تأهيل للتعليم المدرسي. فنرى نفس الثقافة الموجودة في الدول المهاجرة؛ المدرسون يتعاملون مع الأطفال كأنهم آباء يفرضون على أولادهم في المنزل، من منطلق ثقافي متوارث. فلا تجد الرؤية أو الصدر الواسع الذي يستقبل الطفل ويتعامل معه بصورة ذهنية ولديه الصبر. لا، هو يريد أن يتعامل كأب يفرض على أولاده. وعمومًا، الانطباع الذي تكوَّن لديَّ من المعيشة هناك والتفاعل هو أن كل شخص يأتي من دولته وثقافته ويفرضها على الآخرين ويستقر على ذلك. لا أحد يتغير.
- الحوكمة والقيادة المدرسية: توجد إحصائيات حول قدرة القيادات المدرسية في المدارس الإسلامية، وهي إحصائيات ليست جيدة. فالعديد منهم غير مؤهَّلين لقيادة المدارس وإدارتها. وكثير من المشاكل المعروفة في العالم العربي والإسلامي تتكرَّر في المدارس الإسلامية الموجودة.
- تمويل المدارس الإسلامية: هو تحدٍّ آخر تظهره بعض الإحصاءات، التي تشير إلى أن 45% من المدارس الإسلامية تمويلها مستقل، بينما 29% منها مرتبط تمويله بالمسجد ولكنه مستقل إداريًّا، و21% منها تمويله مرتبط بالمسجد بشكل مباشر. المشكلة في نسبة الـ 21% أنه إذا حدثت مشكلة في المدرسة الإسلامية، وأردت أن أُربي أولادي تربية إسلامية مختلفة عما تقدِّمه المدرسة، وتوجَّهت إلى المسجد، فهو نفسه الجهة التي تدير المدرسة وتضع المنهج. فتصبح مشكلة هنا. وهذا طبعًا يزيد العبء على المساجد في جمع التبرعات والتمويل.
- المؤهلات الدراسية للمدرسين: وهذه أيضًا مشكلة كبيرة تؤدِّي في النهاية إلى تدنِّي المنهج أو طريقة التعليم للمسلمين في أمريكا. الشهادات المهنية قليلة جدًّا في المدارس الإسلامية. بالإضافة إلى الرواتب المتدنية. فتظهر الإحصاءات أن 26% من المدرسين ليس لديهم أي مؤهل تربوي يؤهلهم للتدريس في مدارس الولايات المتحدة، وأن 36% منهم لديهم مؤهل جزئي للتدريس، من المؤهِّلات التي تسمح لهم بالتعيين كالمدرسين في المدارس الحكومية، بينما 10% فقط لديهم مؤهل كامل.
(ج) المسجد والأدوار المتنوِّعة في المجتمع:
متى يذهب المسلمون للمسجد؟ سنجد أنهم يلجأون إليه في أحوال مختلفة. فقد يكون اللجوء إلى المسجد في حالات الاعتداء المنزلي العنف الأسري.
إذن، دور المسجد في أمريكا مختلف نوعًا ما مقارنة بدوره في دول العالم الإسلامي، لأن الدولة التي تقوم ببعض الأدوار التي لها علاقة بالإسلام في الدول الإسلامية غير موجودة في أمريكا. ولذا يقع كل العبء على المسجد. فالمسجد لا يقتصر دوره على الصلوات، بل يمتد ليشمل المساعدات المادية، وتوفير عيادات لمن لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات، وتوثيق الزيجات، وتنظيم المناسبات الاجتماعية، بالإضافة إلى المدرسة التي يديرها، ومدرسة يوم الأحد، هذا هو أقل ما يمكن أن يقدمه مسجد مركزي في أمريكا.
- الأئمة في المساجد:
الأئمة لديهم فعاليات وأنشطة، ولكن توجد مشكلة في تمويل المسجد وإدارة الأئمة. ذلك أن الجهة التي تتولى التمويل هي نفسها التي توجه الإمام، لأن المساجد في القانون الأمريكي تُعتبر مؤسسات خاصة، كالأعمال التجارية. فالمؤسسة الخاصة يملكها مجلس الإدارة (Board) الذي يدفع راتب الإمام. فإذا وجه مجلس الإدارة المنتخب (الذي يمول المسجد) الإمام في أي اتجاه ولم يمتثل، فإن لديهم كامل الحرية في طرده. ونرى الكثير من الحالات، وهي متكرِّرة للغاية في ولايات مختلفة، قصصًا وممارسات وأمورًا رأيتها بنفسي، تدور حول الصراع بين مجلس الإدارة والإمام. فالإمام يرغب في الاستقلال وقيادة المجتمع، بينما يقف مجلس الإدارة حائلًا لأسباب سياسية، أو لأسباب تتعلق بالتأثير في المجتمع باتجاه معين، أو بسبب اختلاف أيديولوجي فيما بينهم.
إن حرية الإمام في أمريكا مرتبطة بتمويل المسجد. وتمويل المسجد يأتي غالبًا من رجال الأعمال الموجودين في المنطقة التي أُنشئ فيها المسجد. ووفقًا لتفكيرهم ومعتقداتهم يتَّجه الناس. بناءً على ذلك، وبناءً على دور المسجد الذي شرحناه سابقًا، فإن الدور الصحيح لإمام المسجد في أمريكا هو أن يكون قائدًا مجتمعيًّا وليس مجرد إمام لإقامة الشعائر. لأن الحاجة إلى الإمام كإنسان أو كجهة تقف أمام القانون الأمريكي في حالات تتطلَّب تدخُّل الشريعة هي حاجة ماسَّة وشديدة. لذا، هو بحاجة إلى التعليم، والثقافة، والقدرة على قيادة الناس وتوجيههم في اتجاه معين. وهذه مشكلة تواجه الأئمة في الغرب، فهم أحيانًا غير مؤهلين التأهيل الكافي للقيام بهذه الأدوار.
- الصراعات داخل المساجد:
الصراعات بالطبع لها علاقة بالتوجهات الدينية. فهناك مساجد معينة في الولايات معروفة بتوجهها السلفي، أو الصوفي، أو للأفرو-أمريكيين مثلًا. فعندما صليت مرة صلاة الجمعة في مسجد في منطقة كلها من المسلمين الأفارقة، كانت طريقة صلاة الجمعة مختلفة قليلًا. فقد يتخللها ضحك أو حديث بطريقة مختلفة تعكس ثقافة متباينة، وأحيانًا يُنظر إلى من هم خارج هذه الثقافة في الصلاة أو في المسجد بصورة قد تحمل عنصرية أو على الأقل ارتيابًا.
رابعًا: التربية ما بعد المدرسة.. وتحقيق الاتزان
ننتقل إلى الأمر الهام هنا، وهو ما بعد تلقي التربية في الأسرة والمسجد والمدرسة. إذا نشأ المسلمون في أمريكا باهتمام شديد من الوالدين بالتنشئة والتربية الإسلامية، ووضعهم في الإطار الصحيح، مع تربية منضبطة من ناحية عزلهم عن المجتمع الأمريكي وثقافته الفاسدة، ما يحدث هو أن دخول الجامعة يصبح بمثابة “بالون الاختبار”. فالشباب إما أنهم ينفصلون عن الثقافة الأم التي تربوا عليها تمامًا، وبالتالي، يعيدون تقييم الثقافة الأمريكية، وأثناء إعادة التقييم هذه، يتم الانخراط والتماهي في المجتمع، أو أن تكون التربية السابقة تربية عقلانية، وبالتالي لم يكن التفاعل منعزلًا عن الثقافة الأمريكية المحيطة. فقد كان الولد يذهب إلى المدرسة والمسجد، ولكنه كان لديه أصدقاء غير مسلمين وكان يعرف كيف يتعامل معهم. لم يكن هناك خوف من إظهار هويته كمسلم. وبالتالي، سيكون التفاعل ناضجًا ولن نجد فكرة الانعزال والدونية في رؤيته لنفسه مقارنة بالآخرين.
ما يحدث هو أن المسلمين، بسبب عقلية المهاجر، يرون أننا يجب أن نعزل أنفسنا ونعيش بنفس الثقافة التي كنا نعيش فيها في بلد المنشأ (البلد الأم). وبالتالي، يعزلون أبناءهم، ثم يدخلون المدرسة ويحدث التفاعل مع الثقافة الأمريكية. فنصل إلى أرقام صادمة مثل 23% من المسلمين تركوا الإسلام.
ولذا، مرحلة الجامعة من أهم المراحل للمسلم الأمريكي. فكرة التحول الأيديولوجي في حياة المسلمين (وهذه دراسة لا تتعلق بالمسلمين تحديدًا) تتم بين مرحلة الثانوية المتأخرة (أي آخر مرحلة في الثانوية) وحتى أوائل العشرينات. وهذه مرحلة تتغير فيها أفكار الشخص ومعتقداته. وفي هذه المرحلة، يترك الابن أهله غالبًا لقبوله في جامعة بعيدة عن البيت، وغالبًا ما تكون خارج الولاية تمامًا. فيسافر، وهنا، وفقًا لما تربى عليه وما فهمه عن الثقافة الأمريكية، تحدث المشكلة التي قد تؤدي إلى ترك الإسلام.
فإما أن نربي تربية منغلقة تمامًا، أو تربية بلا ضوابط، حيث يُترك الأبناء في مدرسة حكومية ويُسمح للآخرين بتعليمهم دون أي وقاية. أو تكون التربية وسطية، تتضمن تربية إسلامية مع تفاعل مع غير المسلم والمجتمع الخارجي بصورة نقاش مستمر طوال مراحل التربية، بحيث تكون لدى المسلم مناعة من الانخراط أو الانبهار بالمجتمع والدخول فيه دون أي ضوابط.
تاريخيًّا، مَرَّ المسلمون في أمريكا بهذه المراحل، والأعداد تختلف حسب الأجيال:
- المرحلة الأولى: الهجرة والبحث عن العيش الكريم. هذه هي المرحلة الأساسية، حيث يكون الاهتمام بالمال واستقرار الحياة.
- المرحلة الثانية: الاندماج والاستيعاب الثقافي. يرغب المهاجر في الاندماج والشعور بأنه جزء من المجتمع. وفي هذه المرحلة، قد يفقد هويته إذا لم تكن لديه تربية قوية للهوية من البداية.
- المرحلة الثالثة: التحول التياري واليقظة الهوياتية؛ بعد أن يبدأ في الاندماج في المجتمع، قد يدرك، حسب خلفيته، أنه مختلف. وأنه كمسلم يمتلك حلولًا للمشاكل الموجودة في المجتمع الأمريكي. فيبدأ في الالتفات إلى الهوية الأساسية وهي الإسلام، وتحدث لديه “يقظة في الهوية”.
- المرحلة الرابعة: الاتزان، بعد ذلك، يبدأ في الموازنة بين الإسلام الثقافي والإسلام النقي. ما الذي كان جزءًا من الإسلام من الثقافة؟ وما هو الإسلام النقي؟ وما الذي يمكنه التواصل به مع المجتمع الأمريكي؟ وما هو الجيد في المجتمع الأمريكي؟ وما هو الفاسد فيه؟ إنها مرحلة اتزان صعبة جدًّا.
هذه المرحلة تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين لفهم الهويتين، الهوية الإسلامية والهوية الأمريكية، للوصول إلى بناء متوازن بين الطرفين. هذا الموضوع حدث بتفاوت، ولكن لو سألنا المسلمين الأمريكيين “هل أنت فخور بانتمائك لدينك؟” بين الأمريكيين كلهم، أجاب 86% من المسلمين بـ “نعم”، مقابل 67% من اليهود، و95% من الإنجيليين البيض، و72% من الأمريكيين عامة. وعندما سألنا المسلمين: هل لديك هوية إسلامية قوية؟ أو هوية أمريكية قوية؟ أجاب 89% من المسلمين بأن لديهم هوية إسلامية قوية، و85% قالوا إن لديهم هوية أمريكية قوية. وهذا أمر جيد، لأنه يدل على أنهم لم يعزلوا أنفسهم عن الطرفين، وهم مهتمون بهما، ويرون إمكانية للتواصل بين الهويتين.
وعبر الأجيال، تطورت شخصيات مشهورة تُمثل هذا الاتزان، منها نعمان علي خان، وهو من كبار الدعاة الأمريكيين. يركز في تفسير القرآن، ولكنه عندما يتحدث، يتحدث كأمريكي، ويتناول الدين كشيء يحل المشاكل المجتمعية، ولديه الوعي والالتزام. ومهدي حسن، بغض النظر عن مدى تديُّنه، فهو مسلم. واسمه “مهدي حسن” سبب له مشاكل كثيرة، لكنه قادر على مواجهة المجتمع الأمريكي ونقده والتفاعل معهم دون أي حرج أو شعور بالدونية. وإدوارد ميتشل أحمد، (على اليمين)، وهو محامٍ كان موجودًا لدينا في جورجيا. هو أمريكي أفريقي أسلم. كونه محاميًا يقف أمام المحاكم ويدافع عن المسلمين، ترى فيه العزة والاتزان بين الطرفين: المسلم والأمريكي، وعدم التضاد بين الاثنين.
خامسًا: المجتمع الإسلامي والانتقال من الدفاع إلى الهجوم (الإصلاح)
إن الهوية الناضجة للمسلم في أمريكا يجب أن تنتقل من الدفاع إلى الهجوم. فالدفاع عن النفس في مواجهة المجتمع الأمريكي، نحتاج أن نتحول من الدفاع عن أنفسنا وتأمين أساسيات الحياة في أمريكا، إلى الهجوم على الثقافة الأمريكية لإصلاحها. هذا الأمر لا يتم إلا بفصل الإسلام عن ثقافة المهاجرين. فلا يصح أن يكون الإسلام في أمريكا إسلامًا باكستانيًّا أو إسلامًا عربيًّا، وتُربى الأجيال الجديدة بنفس الثقافة الخارجية (التي أتت من ثقافة غير أمريكية).
ما يجب أن يتم هو فصل الإسلام في عقل المهاجر الذي سيربي أبناءه ويستقر في البلد، فصل الثقافة عن الإسلام النقي. ثم تقييم الثقافة بمنظور شرعي محايد ثقافيًّا، ما هو الصحيح وما هو الخطأ؟ ثم نقيم الثقافة الأمريكية، ونستقي منها ما يوافق الشرع، ونرفض الآخر. ثم إزالة التعارض بين الهويتين، أي لا يصح أن يرى المسلم الأمريكي أن هناك تعارضًا بين هويته كمسلم وهويته كأمريكي. هذا سيسبب شعورًا بالدونية أو الهزيمة، أو يجعله يتجه نحو الثقافة الأمريكية ويتخيل أن الثقافة الإسلامية أو اسمه أو هويته تمنعه من النجاح في المجتمع.
ننتقل إلى استخلاص الصالح من الثقافة الأمريكية ودمجها مع أسس الشريعة، لتكوين هوية أمريكية إسلامية متوازنة. ثم التفاعل مع المجتمع الأمريكي كبيئة دعوية من منطلق إصلاح.
هذه الدعوة لا تعني بالضرورة أن يقف أحدهم داعيًا كإمام للمجتمع الأمريكي إلى الإسلام، ولكن كما تقول الأدبيات الكلاسيكية: المهندس داعٍ في مجاله، والطبيب داعٍ في مجاله. الأخلاقيات المسلمة عندما تُدمج في رؤيته في مجال الهندسة، فإن المنتج الهندسي الذي سيخرج منه كمسلم، مع استخدامه لآليات الحضارة الموجودة في أمريكا، سيخرج منتجًا مختلفًا. سيصمم المدينة بصورة مختلفة لأنه يفهم الشريعة، ويفهم أولويات الشريعة، ويفهم معنى حق الجار، ويفهم معنى المصالح العامة، وكل هذا سينعكس في هويته. وبالتالي، سيخرج منتجًا مختلفًا عن المنتج الأمريكي يحل مشكلة أمريكية، وهذا في حد ذاته دعوة للدين الذي هو الإسلام في أمريكا، ليصلح ما فسد من الثقافة الأمريكية، بدلًا من أن يصارع الأمريكيين.
(أ) التحديات أمام تحقيق هذه الهوية:
ولكن، هناك مشكلة في أننا لكي نصل إلى هذه الهوية، لدينا عدم وضوح في مؤسسة الأسرة، ومؤسسة المسجد، ومؤسسة المدرسة. ومثال سريع، توجد مشكلة كبيرة في موضوع النضوج. أنا شخصيًّا كنت أدرس في مدرسة الأحد (Sunday school) بمسجد في جورجيا. وكان المنهج كتابًا يحتوي على قصص عن الإسلام وقصص الصحابة، حسب المرحلة العمرية. فكنت أنا من تلقاء نفسي أُدخل فكرة التفاعل مع غير المسلمين في القصص. فأقول له: “هذا الصحابي، لو كان يعيش الآن، كيف كان سيتفاعل؟ أنت أيها الولد الذي تبلغ سبع سنوات، كيف ترى السيد المسيح؟ لو قال لك أحدهم إن الإسلام كذا، ماذا يجب أن تقول؟” كنت أحاول أن أفهمه كيف يتم التفاعل مع غير المسلم.
بعد ذلك، حدث تجديد في مناهج المسجد الدراسية، وعرضت عليهم وقلت لهم: “يجب أن يكون لدينا منهج لتربية الهوية، لتربية المسلم الناضج في أمريكا”. بالطبع، قوبل اقتراحي برفض شديد جدًّا، لأن الأهل يرسلون أبناءهم إلى المدرسة لتعليمهم القرآن. والمسجد، لكي يكون صالحًا وناجحًا في نظر الأهل، يجب أن يعود الولد إلى المنزل وهو يحفظ سورة الفلق وسورة الفاتحة ويكمل حفظ القرآن، ويعرف قراءة الآيات، ويعرف التحدُّث باللغة العربية. أنا كنت أقول: “هذا بالإضافة إلى ذاك”. ولكن بسبب ضيق الوقت في المدرسة الإسلامية، تم تنحية أي تربية للهوية. طبعًا، هم بعقلية المهاجرين، لا يعرفون كيف نربي، وماذا نفعل؟ فهناك موضوع الشك وفكرة الأولويات. والإمام نفسه لا يرى أن هناك مشكلة في الهوية.
(ب) الاختيارات المتاحة للمسلمين في أمريكا:
أرى أن هناك اختيارين للمسلمين للعيش في أمريكا:
- العيش بعقلية المهاجر المؤقت: هي العقلية التي عاش بها الكثيرون، وأنا كنت أعيش بها. هذه العقلية (ملايين المسلمين الأمريكيين يعيشون بها) تقوم على أنني جئت لسبب معين وسأنهي أموري ثم سأعود إلى بلدي. عقلية “المؤقت” هذه تعني أنني لن أختلط في السياسة، ولن أبني، ولن أختلط في التفاعل المجتمعي، ولن أبني مجتمعي الخاص، لأنني أقيم هنا كضيف. فيصبح المهاجر المؤقت يربي أبناءه بعقلية الهجرة، يربيهم على ما تربينا عليه في مصر [كمثال]. “نحن هكذا راحلون”. ثم يختلط الابن بالمجتمع، وبعد 10 سنوات يكتشف أنه بحاجة إلى 10 سنوات أخرى، ويتربى أبناؤه على تنشئة خاطئة. ويصبح هذا المسلم غير فاعل في حياته كلها، لأنه لا يرى لنفسه دورًا، ويرى أمريكا كبلد للعيش، بلدًا مؤقتًا لتحقيق منفعة مادية أو علمية.
- وإما أن تكون أمريكيًّا ومسلمًا بلا تعارض بين الهُويتين: هذا هو الاختيار الثاني. وللأسف الشديد، كثير من المهاجرين يختارون الخيار الأول (عقلية المهاجر المؤقت) الذي يغذِّي كلَّ مشكلة.
سادسًا: المسلمون الأمريكيون بوصفهم فاعلًا في الأمة الإسلامية
إذا نضجت هوية المسلمين الأمريكيين ورؤاهم، فسيجد المسلمون الأمريكيون لديهم مصادر وقدرة على تغيير العالم الإسلامي. فالأموال والتنمية الاقتصادية الموجودة في أمريكا، وعدد المسلمين الأغنياء كبير جدًّا. وكمية الزكاة التي تُدفع في أمريكا ضخمة جدًّا. المسلمون لديهم القدرة على التأثير في السياسة الخارجية الأمريكية. ولديهم القدرة على تطوير البحث العلمي والعلم والتعليم في العالم الإسلامي، وفي مجال الأعمال. فلو أدرك المسلمون الأمريكيون هذا النضوج الهوياتي الذي يجمع بين الإسلام والهوية الأمريكية، وتمكَّنوا من مفاصل صنع القرار في أمريكا، وتمكَّنوا من أعمالهم، وعرفوا كيف يخرجون من الدفاع إلى الإصلاح في المجتمع الأمريكي، فإن هؤلاء المسلمين سيصبحون في أمريكا أداة لإصلاح الأمة المسلمة. وأظن أن هذا كان من الأسباب الرئيسية التي جعلت مركز الحضارة يركِّز على هذه الخيارات وربطها بالأمة الإسلامية. يصبح “عمر” الإمام “عمر”، الذي كان سيدًا في قومه في أفريقيا عندما ذهب كعبد) يصبح إدوارد ميتشل أحمد سيدًا في قومه في أمريكا بعد أن تتم مراحل النضوج بعد 300 سنة أو نحو ذلك.
مداخلات الحضور:
- السفير/ معتز أحمدين:
لدي ثلاث ملاحظات عن المحاضرة، انطلاقًا من فهمي لطبيعة المجتمع الأمريكي:
- المجتمع الأمريكي هو مجتمع متعدد الثقافات، وبالتالي لا يمكن فصل الإسلام عن مجتمع المهاجرين لحل بعض التحديات، ولكن الإسلام جزء من هويتهم، يعرفون أنفسهم من خلاله.
- شعرت أن هناك تفضيلًا للمسلمين البيض أو الأمريكيين الأصل (أو معتنقي الإسلام حديثًا)، على حساب المسلمين المهاجرين أو ذوي أصول إسلامية متجذرة.
- أستغرب من التحليل السياسي لبعض المسلمين، وتأييدهم للحزب الجمهوري، رغم عدم احترام الحزب الجمهوري لهم.
- د. أحمد نبيل:
لدي مجموعة من الملاحظات من واقع خبرتي ومعايشتي للمجتمع الأمريكي، والمسلمين فيه:
1- التمييز ضد المسلمين، هو جزء أساسي من سمات المجتمع الأمريكي، فالتمييز متأصِّل في المجتمع، حتى المهاجر القديم يمارس التمييز ضد المهاجرين الجدد.
2- يواجه المسلمون في الولايات المتحدة معضلة كبيرة جدًّا في المجتمعات التي يختارونها للعيش إما مجتمعات محافظة مثل تكساس، نورث كارولينا، ذات طابع الجمهوري تحفظ قيم الأسرة، أو يعيشوا في ولايات ليبرالية مثل نيويورك وكاليفورنيا، إلى جانب الفرص الاقتصادية، وهو ما ينعكس على الخيارات السياسية لهم. قبل 11 سبتمبر كان المسلمون متواجدين بقوة داخل الحزب الجمهوري شأنهم شأن غير المسلمين القادمين من الشرق الأوسط. وجزء من هذه القصة هو التقارب على مستوى قيم الأسرة، والأمور الغريبة عن المجتمعات الإسلامية. لكن بعد 11 سبتمبر كان القرب من الحزب الديمقراطي أصبح خيارًا مفروضًا تقريبًا على المسلمين، نتيجة الكراهية الشديدة التي وجدوها داخل الحزب الجمهوري، وهذا يفسِّر سبب وجود حنين، وإمكانية للعودة إلى الحزب الجمهوري، ولكن أودُّ الإشارة إلى أن الكتلة التصويتية والعددية للمسلمين لم تكن لتحسم انتخابات 2024.
3- يواجه المسلمون تحديات لدورهم في المجتمع، ومدى انخراطهم للانضمام للمؤسسات مثل الجيش والمخابرات الأمريكية مع التزامهم الديني، وذلك ليس فقط بسبب قضية غزة، ولكن أيضًا بسبب مدى أخلاقية العمليات التي يقوم بها الجيش الأمريكي في مناطق مختلفة من العالم.
4- مع ترامب نشهد انتكاسة كبيرة في حقوق كل الأقليات في المجتمع الأمريكي، بدأت من 2016، وهي جزء من الصراع على هوية المجتمع الأمريكي: من صاحب هذا البلد؟ الرجل الأمريكي يشعر بخطورة شديدة، فتراجعت نسبته من 80% إلى 60% في مقابل الأمريكيين من أصول وجنسيات مختلفة.
فمن المهم أن نضع قضية المسلمين، وقضاياهم في إطار سياق أكبر، ومن ثمَّ يلزم بحث قضايا المسلمين إلى جانب قضايا الأقليات الأخرى التي تواجه تحديات إلى الأخرى، وبحث سبل التعاون معهم.
- عبد الرحمن فهيم
هناك تشابه يبدو بين المسلمين في الدول الإسكندنافية والمسلمين في الولايات المتحدة، السؤال هنا عن التغيرات في نظرة بعض مكونات المجتمع تجاه بعض القضايا، ومثالها البارز ما يحدث في غزة، والعلاقة مع إسرائيل، وتجمع بعض الطبقات المختلقة مع المسلمين ضد تدريس بعض المواد في المدارس للأطفال التي تتضمن حديثًا عن الشذوذ والجندر، فهل كان للمسلمين دور في هذه التغيرات؟
- د. أحمد علي سالم
أعادتني المحاضرة إلى سنوات الدراسة في الولايات المتحدة حينما أقمت هناك ما يقرب من 6 سنوات للحصول على الماجستير والدكتوراه. وهنا سأورد ملاحظتي بشأن التمييز بين الإسلام النقي، والإسلام الثقافي، فأنا أشك إذا كان هناك مثل هذا التمييز، فهذا صعب جدًّا، بغض النظر إذا كان هذا الأمر جيدًا أم سيئًا. هذا شيء مجرد ربما لا يوجد والله أعلم.
لماذا الثقافة شيء سلبي خاصة في المجتمع الأمريكي؟ لأنها مصدر للخلاف.. ولكن أتفهم سبب طرح المحاضر لذلك بسبب المشاكل التي تعود لعدم رغبة أو قدرة المسلمين القادمين من بلاد أخرى عن التخلي عن بعض الأسس الثقافية وقبول أو تفهم الوضع المختلف، بما يدفعهم لتطوير رؤية وفقه تجاه بعض المسائل، ولكن ربما الحل هو ترشيد التعامل مع الثقافة وليس إلغاؤها بشكل كامل.
فيما يتعلق بقضية الالتزام بالأحكام الشرعية، وكلام د. صلاح الصاوي، ومجمع الفقه الإسلامي مهم، ولكن ربما ينقل عن الفقه السابق أن تواجد المسلمين بشكل مؤقت، ولكن هذا الأمر تغير، فالمسلمون أصبحت إقامتهم دائمة، والحل هو تطوير فقه الأقليات.
ومن أجمل الأشياء في المحاضرة أنها وضعت الجانب السياسي في حدوده، فالجانب السياسي ليس هو ضمن الاهتمامات اليومية للمسلم الأمريكي، فالتنشئة والتعامل مع الآخر والمدارس.
إلى أي حد تُطرح هذه الموضوعات للنقاش داخل المجتمعات الإسلامية؟ والمهم أكثر أن تُعرض للمسلمين داخل أمريكا وأن يتلقوها برغبة في الانفتاح ورغبة في التطوير.
وطرح حلول (خريطة الطريق) بهذه الطريقة قد يؤدي لمزيد من الخلافات. ثمن الأخطاء في أمريكا غالٍ، فالبعض يُفضل الانسحاب. والمهم ألا نجلد ذاتنا أكثر من اللازم، فالأمر خاضع للتجربة والخطأ.
وفي الخارج، تحتاج إلى جانب روحي قوي، يرتبط بزيادة التعلق بالله، والدعاء، وإحياء قيم الإخاء والترابط.
- د. كريم حسين
مواجهة التحديات التي أشارت إليها المحاضرة، تتطلَّب أن يقوم المسلمون (مثل د. عبد الرحمن) ومن يحملون نفس الهم أن ينشئوا المجتمع الخاص بهم (المساجد – المدارس – الشركات – ..)، ويقوم المجتمع على أساس هدف الدعوة. ويكون ذلك على أساس اقتصادي وضمن قواعد عالم الأعمال التي لا يمكن استمرار الدعوة في أمريكا إلا بها.
- د. نسيبة أشرف
رسمت المحاضرة في ذهني صورتين متقابلتين لمجتمعين: مجتمعات إسلامية تحت الاستبدادية، ومجتمعات أخرى غير مسلمة يعيش فيها المسلمون تحت تحديات الهوية… كما أثارت في ذهني أسئلة عن: ما الدور الإيجابي الذي يلعبه المجتمع المسلم في أمريكا رغم كل هذه التحديات؟ وفي التفاعل مع قضايا الأمة؟ والتأثير في السياسة الخارجية الأمريكية؟ وهل لأبناء الجيل الثاني من المسلمين هناك على رغبتهم في هجرة عكسية للرجوع إلى دول مسلمة؟
- د. مدحت ماهر
مسألة التحديات التي تواجه المسلمين في أمريكا، أصبحت جزءًا من العولمة وجدل الخصوصية والقيمية، وهي حتى تواجه المسلمين في الخليج، بل وحتى داخل البلد المسلم الواحد، حيث أضحت هناك تقسيمات فرعية حتى داخل المدينة الواحدة، خاصة في قضية التعليم. فالقضية أصبحت صراعًا قيميًّا، والعالم لن يُقسم جغرافيًّا بقدر ما يُقسم قيميًّا، وأي قيم آمنة؟
وما أريد أن أقوله نريد أن نُعْمِلَ المنظور الحضاري من مدخل مقاصدي بوصفه منهجية رصد وتحليل وتفسير وتقويم وأحيانًا استشراف وقراءة مآلات وإرشاد وتوجيه. وذلك انطلاقًا من مفهومي: الحفظ السلبي (حفظ الأشياء والأشخاص على أصولها)، والحفظ الإيجابي (زيادة ونماء وربح في الأشياء). وعودة مرة أخرى إلى النقاش حول تعريف أرض الإسلام: هل هي أرض الأغلبية المسلمة؟ أم التي فيها قيم الإسلام؟ أم التي يحكم فيها الإسلام؟ كما لدي سؤال عن وضع الاقتصاد الإسلامي في الولايات المتحدة ممثلًا في شركات ومؤسسات أعمال لها دور وأثر في المجتمع؟
- تعقيب د. عبد الرحمن رشدان
شكرًا جزيلًا على هذا الاشتباك والتفاعل الكبير مع ما قلته، ولكن سأكتفي بالتوضيح أن المقصود من فصل ما هو ثقافي عن ما هو متعلق بتعاليم الإسلام النقية، هو في إطار عملية التربية والتنشئة حتى لا يحدث خلط بينهما يؤثر على تفاعل المسلمين بشكل سلبي مع المجتمع، أو الذوبان في المجتمع، وهو فصل ذهني في التربية والدعوة، وليس عن الحياة مجملة. والمثال على ذلك أننا لا نريد أن تأخذ الدعوة شكلًا تقليديًّا في زيٍّ معيَّن وكتب إسلامية، ولكن نريد من يتحدث مع الأمريكيين بلغتهم وبالأمثلة التي يفهمونها، حتى لا تظل الدعوة غريبة عن المجتمع الأمريكي، وهو ما يُحدثه خلط الدعوة بالثقافة. فالمطلوب تكوين مجتمعات إسلامية تستطيع أن تربي أبنائها أن أمريكا بيتها والإسلام هو جزء من شخصيتها، ويكون التفاعل مع المجتمع على هذا الأساس.
تعقيب ختامي (أ. د. نادية مصطفى)
إن العرض في هذه المحاضرة عرض متكامل ومترابط، ويجيب عن أسئلة كثيرة منذ البداية وحتى النهاية؛ أي منذ بداية وجود المسلمين في الولايات المتحدة، ابتداءً بعصر العبيد ثم ما تلا ذلك من تطورات من حيث التأسيس والمؤسسات، سواء المسجد أم المؤسسات الإسلامية أم التمثيل في الكونجرس. والمحاضرة في مجملها، من بداياتها وحتى نهاياتها، عبر الانتقالات المتتالية من حيث: رسم خريطة الوجود الإسلامي نفسه من حيث العدد والتوزيع والعرق، ثم الأولويات، ثم التحديات على مستوى الأسرة والمجتمع، وبالتركيز خاصة على البعد العقيدي والثقافي في هذا الأمر، وصولًا إلى النقاط الأخيرة التي طُرحت عن كيفية نضوج الهوية الإسلامية عبر الأجيال، وكيفية ضمان استمرارها، وخصائص وملامح المسلم المتوازن بهويته في مجتمع مفتوح شديد التعقيد والتنوُّع.
هذه الصورة الكلية، من تأسيس الوجود بالأعداد والأرقام والتوزيعات، انتقالًا إلى المشكلات والتحديات الصغيرة والكبيرة، وصولًا إلى ما يجب أن يكون وكيفية تحقيقه، جعلت المحاضرة ممتعة جدًّا بالنسبة لي، كما أجابت لي عن أسئلة كبرى أتيت بها إلى هذه المحاضرة انطلاقًا من أهداف هذا الملتقى، وهي:
- كيف يمثل مسلمو المناطق المختلفة جزءًا من الأمة؟
- وكيف أن خصوصية وتميز كل مجموعة من مسلمي العالم وفقًا للزمان والمكان وطبيعة التحديات لا تفصلهم ولا تخرجهم من نطاق الأمة؟
- وكيف بوجودهم هذا، بمشاكلهم وإمكانياتهم ومواردهم، يحققون رشادًا لأنفسهم حيث يحملون إسلامهم معهم، ولأمتهم عبر أرجاء العالم؟
إننا دائمًا نقول إن مسلمي الشرق الذين كانوا يعيشون في كيانات مسلمة، ثم تم الاستيلاء عليها (كما في حال مسلمي روسيا ثم الاتحاد السوفيتي، أو مسلمي الصين، أو مسلمي جنوب شرق آسيا في دول غير مسلمة أو في أفريقيا)، لهم طابع ومشاكل وخصوصية تختلف عن نظائرهم في الغرب. حيث يبدو لنا أن الغرب، أوروبا وأمريكا، يختلف نظرًا لاختلاف تاريخ المسلمين فيه، وفي ذهننا المسلمون الذين هاجروا إلى هناك من دول إسلامية بهويتهم ومرجعيتهم، ولكن يجب أن نضيف إليهم المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام من أهل هذه البلاد.
إن هناك فارقًا بين التجربتين: الأولى أكثر تسلطية، حيث مُنعوا من إظهار هويتهم أحيانًا أو اقتُلعوا من جذورهم، في حين أن مسلمي الغرب، سواء الذين اعتنقوا الإسلام من أهله، أو الذين هاجروا في موجات مختلفة، أو الذين سُلبوا كعبيد منذ البداية وكانوا في جذورهم مسلمين، يعيشون تجربة مختلفة بحكم نظرتنا إلى الغرب ذاته وكيف أنه مجال رحب للحريات والحقوق والتفاعل.
وقد أشار الدكتور عبد الرحمن رشدان إلى مسألة العنصرية والتمييز انطلاقًا من هذا السياق التاريخي، لكنني أرى أن للعنصرية معاني متعددة. فقد شعرت أن انغلاق المسلمين أنفسهم على أفهام تقليدية دون رغبة في التجديد، ربما يكون خطرُه عليهم أكبر من العنصرية التقليدية للمجتمع الأمريكي.
في المحاضرة، اكتشفنا كيف يواجه المسلمون تحديات نابعة من طبيعة هذه المجتمعات الغربية الحرة، المتعددة، المتنوعة، ذات الأطر والمؤسسات القانونية، وذات القوانين التي تُطبق على الجميع. ولكن وجدنا أيضًا، كما اتَّضح قرب نهاية المحاضرة، كيف أن المشاكل والتحديات الخاصة بهذا الغرب يمكن علاجها وإدارتها برشاد، على النحو الذي يبين أمرًا هامًّا، وهو كيف أن المسار عبر 60 عامًا (نقصد هنا المهاجرين في الولايات المتحدة مثلًا) تنضج به التجربة، وتنضج به الهوية. والأهم هو أن هذه التجربة تبيِّن أن الإسلام في المجتمعات الغربية ليس عائقًا أمام اندماج المسلمين ليصبحوا قوة مؤثرة وفاعلة من أجل أنفسهم ومن أجل قضايا أمتهم؛ لأن المشكلة ليست في الإسلام ذاته أو في قيم المجتمعات التي يذهب إليها المسلمون، ولكن في الفهم الرشيد للإسلام وكيفية عيشه في مجتمعات مختلفة في إطار فقه إسلامي متجدِّد يُراعي اختلاف الزمان والمكان والتحديات، حتى لا يصبح المسلمون إما مستوعَبين تمامًا، وإما يعيشون في “جيتو”(Ghetto).
وبالتالي، التواجد في الغرب ليس بالضرورة نهاية وتآكلًا لإسلام المسلمين، بحيث ينفصلون عن الأمة بالضرورة، ولكنهم يستطيعون أن يعيشوه ويمارسوه. والدكتور عبد الرحمن رشدان وضع خيارات أمام المسلم هناك، وَعَدَّدَ سُبُلًا لاندماجه في المجتمع دون أن يفقد إسلامه وهُويته، بل أن يصبحوا جسرًا لكيفية فهم الإسلام وفهم المجتمع وكيفية عيشه. وطبعًا، هذه الأمور لا تحتاج إلى جهود فردية واعية ومتعلِّمة فقط، ولكنها تحتاج إلى جهود مؤسسية. أعتقد أنها تنضج الآن في الولايات المتحدة بطرق متعدِّدة، بحيث تساعد المسلمين الذين يريدون عيش إسلامهم ليس كثقافة ولكن كمرجعية.
وهنا أشار الدكتور عبد الرحمن إلى ملاحظة مهمَّة جدًّا، وهي كيف أن الذين يتحوَّلون من المسيحية إلى الإسلام من أهل البلاد، الأمريكيِّين البيض، يعيشون الإسلام كمرجعية وليس كثقافة. طبعًا، هذه نقطة ورؤية مهمة جدًّا.
وقد أشارت المحاضَرة في آخرها إلى مجموعة عناوين: “تربية وحراسة الهوية الناضجة”، و”نضوج الهوية عبر الأجيال”، ثم “مسلمو أمريكا كفاعل في الأمة الإسلامية”. وهذه الأسئلة كنت أفكر فيها: أن هؤلاء المسلمين في أمريكا، بالرغم من كل تحدياتهم وتنوعاتهم ومحاولاتهم للنضوج عبر الأجيال، هم جزء من هذه الأمة. لماذا؟ لأن المعيار الذي حُدِّثنا عنه، والمعيار الذي عرَّفوا به أنفسهم، هو: هل هم أمريكيون مسلمون أم مسلمون أمريكيون؟ من المهم جدًّا، بدلًا من أن نظل نقول: “هؤلاء عرب مسلمون أمريكيون”، أو “هندو-باكستانيون مسلمون أمريكيون”، أو “أفارقة-أمريكيون مسلمون أمريكيون”، أن يصلوا إلى أن يقولوا: “نحن أمريكيون مسلمون” أو “مسلمون أمريكيون”. هذا مهم جدًّا، لأن المعيار سيظل هو درجة قربهم أو بعدهم عن أصول إسلامهم ومرجعيتهم. وأن يكون لديهم ميزان يقتربون ويبتعدون عنه، سواء كثقافة أو كمرجعية، وهذا مهم جدًّا.
[1] مراجع المحاضرة:
Khaled A. Beydoun, Antebellum Islam, Howard Law Journal, No. 141, (December 2014), Available at: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2536258, pp. 1-58.
American Muslims 101, Institute for Social Policy and Understanding (ISPU), Accessed: 15 September 2025, available at: https://ispu.org/american-muslims-101/
U.S. Muslims Concerned About Their Place in Society, but Continue to Believe in the American Dream, Pew Research Center, 26 July 2025, Available at: https://cutt.us/i6j8u
Muslim Voters Voted Overwhelmingly For Biden, Support Key Democratic Priorities, Change Research & EMGAGE, 12 November 2025, Available at: https://cutt.us/UtTkq
Sofia Ahmed, and Kevin M. Gorey, Employment Discrimination Faced by Muslim Women Wearing the Hijab: Exploratory Meta-Analysis, Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work, No. 32 Vol. 3, pp. 115-123, doi:10.1080/15313204.2020.1870601
Rober P. Jones, How Immigration and Concerns about Cultural Change are Shaping the 2016 Election | PRRI/Brookings Survey, Public Religion Research Institute (PRRI), 23 June 2026, Available at: https://cutt.us/eWuZ6
صلاح الصاوي، فتاوى فقهية في نوازل أسرية، ورقة مقدمة إلى المؤتمر العشرين لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا – هيوستن، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (أمجا)، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/ebzfv
Fiqh Responses to Challenges Facing Muslim Families in the West, Assembly of Muslims Jurists of America (AMJA), The 20th Conference of AMJA, August 2024, available at: https://cutt.us/ftdix
صلاح الصاوي، التحديات التي تواجه الأسرة المسلمة في الغرب، قناة Flint Islamic Center على اليوتيوب، 21 نوفمبر 2024، متاح على الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=WWjQiGiTGhU
Muna Ali, Young Muslim America: Faith, Community, and Belonging, (Oxford: Oxford University Press, 2018).
Yvonne Y Haddad, Farid Senzai, and Jane I Smith (Eds.), Educating the Muslims of America, (Oxford: Oxford University Press, 2009).
Religious affiliation and religious switching, (in): Gregory A. Smith (et al.) Decline of Christianity in the U.S. Has Slowed, May Have Leveled Off, Pew Research Center, 26 February 2025, Available at: https://cutt.us/QqANM
Abdelrahman Rashdan, What Goes First for American Muslims? A Guide to A Better-engaged Community, AboutIslam, 8 October 2020, Available at: https://cutt.us/Dydod
تقرير اللقاء من إعداد الباحث/ أحمد عبد الرحمن خليفة